أضغاث أحلام
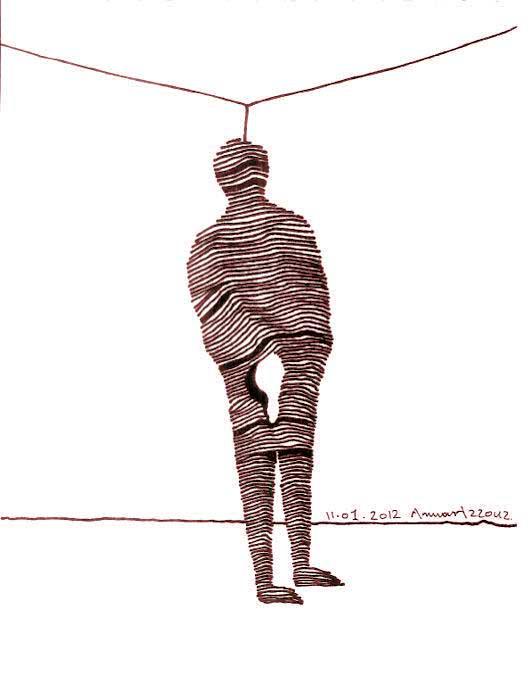
أبو أحمد، رجل المخابرات ذو الشارب المبتذل والقميص المكوي بعناية، ظهر عرَضًا في كابوس أرجنتيني من سكان واحدة من ضواحي بوينس آيرس. الرجل الأربعيني الذي كان حضوره في غرف التحقيق وأقبية فروع المخابرات أشبه ما يكون بحلول غضب إلهي – هو تجسيد لغضب آلهة من نوع آخر على كل حال – كان ضائعًا في شوارع مدينة كيلمس الجانبية جنوب العاصمة، يبحث عن فردة شحّاطته [1] الضائعة هي بدورها على الرصيف المقابل لملعب نادي كيلمس [2]، النادي الأبرز وليس الوحيد في المدينة. زجاج قوارير البيرة متناثرة في كل مكان. وحتى تبلغ حرارة ترحيب ذلك الشارع القذر والمعتم في تلك الليلة الشتائية الممطرة والباردة ذروتها، تطأ قدم المحقق الفذّ – الجلّاد على وجه الدقة – الحافية سيئة الحظ براز كلب ما يزال دافئا. كان لأرجنتيني أصيل لو وطأ تلك الكعكة المقززة الخارجة لتوها من الفرن – منتعلًا حذاءه بكل تأكيد – أن يشتم الأم المقدسة بصوت مسموع وأن يُتبعها في سره بالقول إن ذلك سيجلب له الحظ.
حلمت حلم ذلك الشخص الأرجنتيني بفعل التخاطر المحض. كلانا لم يزر الأرجنتين قط، أنا وأبو أحمد السوري. لا يتكلم الإسبانية لا بطلاقة ولا بصعوبة حتى، لا يتكلم منها ولا طلقة. بدا كالأبله تلك الليلة، مغسول القدر، وضيعًا – كما هو فعلًا -.
رآها تطل بهيئتها الذليلة من فوهة حاوية القمامة. ضحكت سنّه المسوّسة لجلدتها المهترئة وصاح بزخم إغريقي: وجدتها!
على الناحية المقابلة تحلّق حول عمود الإنارة ثلة من مشجّعي البارّا برافا [3] يحتسون الكحول ويقهقهون بعنف يخدش سكون الليل محتمين من حبائل أمطار اللعنة بمظلّة متجر مغلق. لاحظ أحد الشبّان اهتمام عنصر “المهمّات الاستخباراتية الخاصة” بفردة الشحّاطة الكئيبة، فسبقه إليها وتناولها بيده اليسرى، بينما كان يهزُّ بيده اليمنى.. أقصد يحمل بيده اليمنى عبوة كوكاكولا بلاستيكية فارغة منزوعة الملصق ومشطورة، كان صاحبنا قد ملأها نبيذًا من النوع الرديء.
– وين يا حلو؟ [4]
قال له بلهجة سورية واضحة لا لبس فيها ولا لكنة. تجمّد رجل المخابرات الخارق في مكانه وأخذ يرطن بكلام ثقيل مطموس المعالم كذلك اليوم التعس. الشاب الذي كانت تفوح منه رائحة التعرّق الممتزجة برائحة جعة ما بعد الظهر و”عبق” نبيذ اللحظة الراهنة والممتزج بدوره برائحة الرطوبة غير المحتملة، رمى فردة الشحّاطة أمام أبو أحمد وقال له بصرامة أسدية الانتماء بعثيّة النهج:
– قول لا إله إلا كيلمس ولاه. [5]
انحنى رجل الكوابيس أمام فردة شحّاطته الأثيرة يريد التقاطها وهو يردد في سره: لا إله إلا بشار، لا إله إلا بشار [6….]
– ليك ملّا وضعيّة! [7]
قبل أن ينهي جملته تلك كان رفاقه قد اصطفوا على شكل رتل كمواطني أي شعب “متحضّر” في انتظار الحافلة أو كمجنّدي أي وحدة من جيوش الموت من العالم الأول إلى العاشر، وكان أوّلهم قد أنزل سحّاب سرواله.
[1] شحّاطة: في بعض مناطق بلاد الشام، حذاء مفتوح. شبشب.
[2] أحد نوادي الدرجة الثانية في الأرجنتين.
[3] مجموعات عنيفة من مشجّعي كرة القدم. لها ارتباطاتها بالسلطة السياسية وعادة ما يقترن اسمها بالجرائم وأحداث العنف.
[4] إلى أين تذهب يا جميل؟
[5] ولا أو ولاه أو ولاك. تستخدم عادة للتحقير.
[6] إمعانا في إذلال السوريين المنتفضين في وجه الدكتاتور، كثيرا ما كان الشبيحة ورجال الجيش والمخابرات يجبرونهم على ترديد هذه العبارة.
[7] يا لها من وضعية جيدة!
أضغاث أحلام 2
أبو أحمد، عنصر المخابرات العتيد، حلم يوما بعينين جميلتين وقرر أن يعتزل الفن، فن التعذيب. شعر في صدره للحظة بحلاوة التوبة. ابتسم ثغره نائما وهو لا يعرف الابتسام مستيقظا، فهو إما أن يعبس أو أن يضحك ضحكا فاحشا. أحسّ بجناح حريري يمسح صدره بنور ربّاني، فكأن قلبه راح يتطهر ويغوص في بحر من سلام ورضا. وراح يمرّ في مخيلته شريط لا نهاية له من وجوه تضيء كوجوه القديسين والصالحين، كانت وجوه المعتقلين الذين شاء لهم قدرهم المشؤوم أن يمروا بين يديه، ترمقه بنظرات صفح وعطف.. نعم، إنه يستحق العطف فعلا، كان سجانا مسجونا، طاغية مستعبَدا.. يشعر بجناح حمامة السلام يثقل فوق صدره، بل يبدو أن الطائر قفز وجثم فوقه. تغيّرت هيئة العينين الجميلتين وباتتا تقدحان شررا. استيقظ فزعا.
شو صار؟
ما فيه شي أبو أحمد عم غطّيك، خفت تاخد برد.
لك الله ياخدني من هالعيشة حتى أخلص منّك ومن وجهك.
عادت حمامة السلام والعينان الجميلتان والوجوه السمحة إلى أقبية عالمه الداخلي وعاد أبو أحمد إلى العالم الواقعي وتمنت أم أحمد أن تعود إلى دار أهلها..
ترجمة فورية
فتحت عينيّ على ظلام غرفتي وأذنيّ على زعيق المنبه. إنها الخامسة والنصف. خطيبتي نائمة بجانبي. ليست الساعة التي أستيقظ فيها في الأيام العادية فاليوم من أيام النخبة، ليس بعاديّ على الإطلاق.
بعد أسبوعين من البحث والاستقصاء ومشاهدة الخطب المصوّرة على يوتيوب وتحضير مسارد المصطلحات في شتى المواضيع التي من المحتمل أن يتطرق إليها المؤتمرون – أو المتآمرون – ها قد بلغتُ صبيحة اجتماع القمة الذي كان عليّ أن أترجم ترجمة فورية كلماته الترحيبية الحارّة وخطب الزعماء المشاركين فيه، اللطفاء منهم والسمجين، وأنا – للأسف – بكامل قواي العقلية.
كنت معتادًا على التدابير الأمنية التي تصحب هذا النوع من الملتقيات الدولية. ولكنها كانت ذلك الصباح على مستوى أعلى بكثير مما اعتدته بما لا يترك مجالا للمقارنة.
وصلت إلى نقطة تجمّع وانطلاق المترجمين قبل الموعد بربع ساعة ولم أكن أول الواصلين. شيئا فشيئا بدأ أبناء جلدتي من متعددي اللسان يصلون تباعا. تبادلت التحية والمجاملات مع زملائي من لغات أخرى الذين شاركوني العمل في غير مناسبة وتعرّفت إلى زملاء لم أكن قد عملت معهم في السابق وعلى رفيق السلاح في خندق/كابينة الترجمة العربية والذي كان مستوردا من الخارج، في تحدّ سافر للمناخ الاقتصادي الذي تهيمن عليه الانعزالية والتدابير الحمائية والذي فرد ظلاله على التوقعات والتخمينات حيال اجتماعات هذا الملتقى رفيع المستوى ومخرجاته.
كنا جميعا متفقين على أن الجوّ مشحون باختلافات وتناقضات جديرة بتفجير حرب عالمية جديدة.
“مجموعة من أكثر الأشخاص سلطة ونفوذا في العالم، يا لها من مسؤولية”. قال أحدهم.
رفيقي كان قد تكبد عناء المجيء من مصر. شكا من طول الرحلة ومن إجراءات المطار التي باتت لا تحتمل، وخاصة عندما يأتي أحدهم من تلك البقعة من العالم.
“لا بدّ أن الإجراءات مضاعفة كونك تركيّا”. زعق أحدهم.
“عربيّ”. صحّحت.
“نعم، مسلما كنت أقصد القول”. زاد من الشعر بيتا!
“لست مسلما في الواقع”. عقّب صاحب العلاقة.
“لن تستغلّا اجتماع هذا الكم من ممثلي الغرب في مكان واحد لتفجير قنبلة يا شباب أليس كذلك؟” مازحةً لترطيب الجو، زعقت أخرى.

ضحك زميلي ربّما ردّا للشبهة أو لمباغتة التعليق وعدم اعتياده على سماع هذا النوع من النكات الممجوجة، أما أنا فشعرت في معدتي بنخزة طفيفة ولكنها مزعجة، كتلك التي أشعر بها بعد بضع مرات من تكرار تمرين المعدة الذي أمقته وبالكاد أكرّره عشرًا. فكّرت في سرّي: عربي ومسلم! ينقصني فقط أن أكون امرأة سوداء البشرة وسحاقية لتجتمع فيّ كل عناصر السوء!
تملّكني هاجس الخوف من أن تحدث فعلا عملية إرهابية ذلك الصباح. حدث هام، زعماء أقوياء مجتمعون، ما الذي يمنع الإرهاب من أن يضرب حيث تتوفر شروط كهذه؟ أن يكون هنالك أشخاص أبرياء مثلي لا ناقة لهم ولا جمل؟ طز!
دخلت اللعبة شيئا فشيئا. تخيّلت أحد أفراد الطاقم من أصل عربي مسلم، ثمة الكثير ممن لديهم أصول عربية في هذا البلد وبعضهم مسلمون. كما أن هناك بعض المعتنقين للإسلام من السكان الأصليين أو من سلالة المستعمرين أو المهاجرين أو الأجيال الجديدة الناتجة عن تزاوج أولئك جميعهم. سيقوم هذا الشخص الافتراضي باختراق أمني وسيفجّر القاعة وسأتفحم أنا ولوحة المفاتيح ومكبر الصوت داخل الكابينة دون أن يكترث بنا أحد.
سحقا لموهبة التخيّل هذه التي فُطرت عليها ما أرذلها من موهبة. سأنسى الموضوع.. هي تهيؤات، ليست سوى تهيؤات. سيجري كل شيء على أحسن ما يرام وستكون الترجمة سهلة لأنها عامّة غير تقنية. كما أن السياسيين يتكلّمون بالعموميات وأكاد أعلم سلفا ما سيصرّح به كل واحد منهم. ليس عليّ أن أقلق.
ولكنني الآن قلق. وكان عليّ أن أجتاز راكبا حافلة المترجمين ثلاث نقاط للتفتيش. يا لها من إجراءات! كل ذلك يشعرني بالمزيد من القلق.
ما زلت قلقا. أتخيل خطيبتي وقد بلغها خبر الانفجار في مركز المؤتمرات. ما أتعس الخيال من ملَكة. ألا يكفي أنني دفنت أحلامي القديمة في أن أكون كاتبا وغمست نفسي في مجال تقنيّ؟ ألهذا يطاردني الخيال ويلهب في زوايا نفسي المظلمة جذوة القلق؟ ألأنّي عراقيّ أتوقّع الأسوأ دائما وأميل إلى السوداويّة؟
ما زلت قلقا. عليّ الآن أن أبدأ الترجمة. سأتمالك نفسي. إنني لا أسمّي كابينة الترجمة خندقا عن عبث. إنني جنديّ هنا، إما أن أقتل أو أُقتل. سأقتل قلقي إذا وأبدأ: الله أكبر!
مرّت الساعة الأولى. مرّت ساعتان. تبادلت بعض الرسائل مع خطيبتي في الوقت الذي كان يترجم فيه رفيقي. كلمات الحبّ والشوق التي اعتادت إرسالها لي يوميا وفي أيّ وقت تردّدت في خلَدي وأحدثت في أعماقي رنينا مضاعفا داعبني من الداخل.
خرجنا لأخذ الاستراحة الأولى. احتسيت كوبين من القهوة لأنعش أعصابي ودردشت مع صديقتين تترجمان إلى اللغة الفرنسية. تبادلنا التعليقات الفكهة وضحكنا.
الاستراحة الثانية كانت مخصّصة لتناول طعام الغداء.
كان المتحدّث الأول بعد الغداء من الوزن الثقيل وكان من المتوقع أن يلقي خطابا دسما. هو دور رفيقي في الترجمة. جلست في المنطقة الوسطى بين الاسترخاء والتأهّب أراقب العرض. إنه زعيم شعبويّ عتيد وإن كان قليل الخبرة. سيحسدني الكثيرون على هذه اللحظات – أو ربما هذا ما كنت أظنّه – يا له من شرف!
رُفع الستار عن عرض الرجل السبعيني المتحدّر من العرق المتفوّق، المحب للظهور والمفعم بالنرجسية. بدأ كلامه بنبرة عادية راحت تتصاعد سريعًا حتى بلغت مستوى غاية في السوريالية. لم تكن الجلسة متلفزة. مجريات الاجتماع على درجة عالية من السرية وإن كان سيصدر في نهاية أعمال القمة بيان صحفي – أو هكذا كانت تأمل الدول المشاركة -.
أيها السادة: لا معنى للتظاهر بأنّ كلّ شيء يجري على أحسن حال وأن العلاقات بين دولنا طبيعية فهي ليست كذلك. إنني شجاع إلى الدّرجة التي تتطلّبها تسمية الأمور باسمها. إننا نعيش حربا أيها السادة، حربا غير معلنة. وما العيب في أن تندلع الحرب؟ إنّما الحرب رياضة العالم المفضّلة. كلما اختنق اقتصاد الكوكب فتحت له الحرب كوّة للعبور إلى مرحلة جديدة. في العقود القليلة الس.. سا..
انهار رفيق السلاح من هول ما يسمع وأشار إليّ بعينيه أن آخذ موقعه على أرض المعركة فاستكملت:
في العقود الأخيرة كنّا نتحارب بواسطة الآخرين واخترعنا أمساخا خرجت عن سيطرتنا. لقد حان الوقت للعودة إلى المواجهة المباشرة. سأقدّم لأممنا المتصارعة فرصة العمر.
صمت لبرهة. بدأت القاعة تضجّ بانفعالات مختلفة. لم يأخذ بعضهم الكهل المتعجرف على محمل الجد وراحوا يتضاحكون فيما بينهم بينما ظهرت علامات القلق على فريق آخر وأخذوا يتهامسون.
أشار “نجم العرض” إلى أحد مساعديه فأتاه بمغلّف صغير تناوله بيده اليمنى ورفعه إلى أعلى وتابع فتابعت:
هنا عندي لكم هدية تذكارية كفيلة بتغيير مسار التاريخ.
أخرج ما بداخل المغلّف وهو يقهقه بضحكة هستيرية وسط ذهول الحاضرين. كان جهاز تحكّم عن بعد. ضغط على الزرّ.
أُسدل الستار وانتهى العرض. انتهى كل شيء في الواقع.
بعد دقائق معدودة ظهر الخبر العاجل على شاشات القنوات الإخبارية ومواقع الصحف الإلكترونية: “تفجير إرهابي يسفر عن مقتل زعماء عدد من الدول. تقارير أوّلية تشير بأصابع الاتّهام إلى مترجم اللغة العربية إيراني الجنسية(!)”
ترجمة فورية ٢
أعرف الكثير من نوادر المترجمين الفوريين. حدثتني زميلة أنها بعد يوم طويل من العمل لا تشاهد البرامج على أيّ شاشة كانت ولا تستمع إلى البرامج الإذاعية من أيّ نوع كان لأنها إن استمعت إلى هذه أو شاهدت تلك بدأت الترجمة في ذهنها بشكل أوتوماتيكي. زميل آخر روى لي أثناء عملنا في ترجمة مؤتمر حول الجرائم الدولية وسبل التعاون الدولي، أنه كان يمضي ليالي أيام المؤتمر محققا في جرائم شتى غريبة من نوعها في أحلام لا تبلغ حدّ الكوابيس ولكنها مضنية نوعا ما.
ولكن ما أعايشه أمر مختلف وشديد الخطورة. بل إنني أكاد أهجر الترجمة الفورية ومؤتمراتها وكبائنها لما يسببه لي من خوف وقلق. صحيح أن هذه المهنة تحقن في دم الواحد منّا جرعة لا يستهان بها من الأدرينالين كل عشرين دقيقة وهو أمر مستحب وتطلبه النفس البشرية المازوشية بطبعها، إلا أنّ لكلّ شيء حدودا إن تجاوزها المرء دخل حيّز الخطر الفعلي.
بدأ كل شيء عندما اكتشفت في نفسي قدرة عجيبة يا ليتني لم أكتشفها! قدرة على خوض مسارين متوازيين للترجمة الفورية في الوقت نفسه: من لغة المتحدّث إلى لغة الجمهور ومن لغة المتحدث المنطوقة إلى قصده الحقيقي بالتزامن! أحقن في مكبر الصوت ما يفترض أن يسمعه المتلقي وأهمس لنفسي في ذات الوقت بمحتوى خطاب المتحدّث، ما يدور في خلده فعليًّا لحظة التلفظ بمفردات خطابه واحدة إثر الأخرى.
على سبيل المثال، من خطاب افتتاحي مفعم بالحماس في مؤتمر متعلق بالتغيّر المناخي:
لن نألوا جهدا في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن الحياة ومقوماتها على كوكبنا الجميل. (ترجمة إلى الخارج).
سنتظاهر بالقيام بما تيسّر من إجراءات كفيلة بتصديق دفاعنا عن الحياة ومقوماتها على جحيمنا الأرضي. (ترجمة إلى الداخل).
إن الحفاظ على الحياة البرية والبحرية والعمل على خفض منسوب بصمة الكربون والانتقال إلى أشكال إنتاج نظيفة وصديقة للبيئة والتحول إلى أسلوب حياة لا يؤدي إلى تراكم المزيد من النفايات غير القابلة للتحلل لهو مسؤولية منوطة بنا جميعاً؛ (ترجمة إلى الخارج).
إن الحفاظ على الحياة البرية والبحرية والعمل على خفض منسوب بصمة الكربون والانتقال إلى أشكال إنتاج نظيفة وصديقة للبيئة والتحول إلى أسلوب حياة لا يؤدي إلى تراكم المزيد من النفايات غير القابلة للتحلل هو مسؤولية الحالمين والسذّج؛ (ترجمة إلى الداخل).
وإننا كدول أكثر رخاء لدينا مسؤولية مضاعفة تجاه العالم بسبب ماضينا الصناعي. (ترجمة إلى الخارج).
أما نحن كدول مهيمنة فلا يعنينا الأمر ما دامت جيوشنا قوية ومواردنا وفيرة. (ترجمة إلى الداخل).
هل يمكن تخيّل نشاط أكثر استهلاكًا للقدرات الذهنية من هذا؟ يجب على دماغي أن ينظّم حركة الترجمتين المتزامنتين، الخارجة والداخلة، بحيث لا يرتطمان كشرطيّ المرور. هل يمكن تخيل حجم الفضيحة الناجمة عن تطفّل الجمهور على فحوى ترجمتي الخاصة؟ أن يسمع الجمهور مثلًا رئيس وفد دولة ما يتلفظ بعبارات اللامبالاة والسخرية من أعضاء وفود دولة أخرى؟ أو أن يسمع النساء المشاركات في مؤتمر تمكين المرأة كم الاستخفاف بهن الذي يضمره الكثير من المشاركين لهن؟ وكذلك فيما يخصّ حقوق المثليّين والمتحولين ومعاناة الدول الفقيرة من الديون وحريّات شعوب الدول الفاشلة والتي تقرنها الذهنية العامة بعالم الحيوان؟ سيكون ذلك فظيعًا! أو ربّما يكون رائعًا! لا أدري..
تلقيت عروضًا سخيّة من عدة أجهزة للاستخبارت، كذلك من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية..
ولكنّني أظنّ أنني سأختار في النهاية بين العمل كمساعد معالجة نفسية أو مفسّر للنصوص الدينية أو مؤرّخ أو صاحب حساب على إنستغرام!
اكتشاف
ما بال قطتي “بقلاوة” المرقطة كنمر تلهو بحبات طعام القطط التي أضعها لها في الوعاء البرتقالي؟ أتراها نسيت أيام الضنك التي عاشتها في الخرابة حيث ولدت وعاشت شهورها الأولى في هذا العالم القاسي فبطرت النعمة؟ أم أنها تقوم بذلك لمجرد اللهو والعبث بالحبة الطافية على وجه الماء كحشرة صغيرة؟
كثيرا ما نهرتها ولكنها لم تعرني اهتماما، ومتى كانت القطط ممّن يعيرنا نحن البشر اهتمامها؟ ولا ألومها فلو كنت في مكانها لما اكترثت لثلّة من المنافقين المتقلّبين.
في ذلك اليوم دخلت المطبخ حتى أتأكّد للمرة الثالثة من أنني قفلت مفتاح الغاز المركزي قبل أن أغادر الشقة. كنت قد ملأت الأوعية بالكثير من الطعام، فمن المفترض أن أترك القطط وحدها لمدة طويلة نسبيا. كانت بقلاوة تعاين الوضع عن كثب. تناولت بين مخالبها حبة من وعاء الطعام ورمتها في وعاء الماء، وشرعت تحركها داخله ثم راحت تحتسي السائل بنهم من حول الحبة وقد انتفخت بعد أن امتصت قليلا منه.
يا لجهل الإنسان ونزقه! في لحظة تجلٍّ أذابت طبقة أو اثنتين من الدهن المتراكم على دماغي، أدركت أن قطتي المدللة كانت تكتشف الحساء!




