أمجد ناصر في مُلاحقة العَلامة
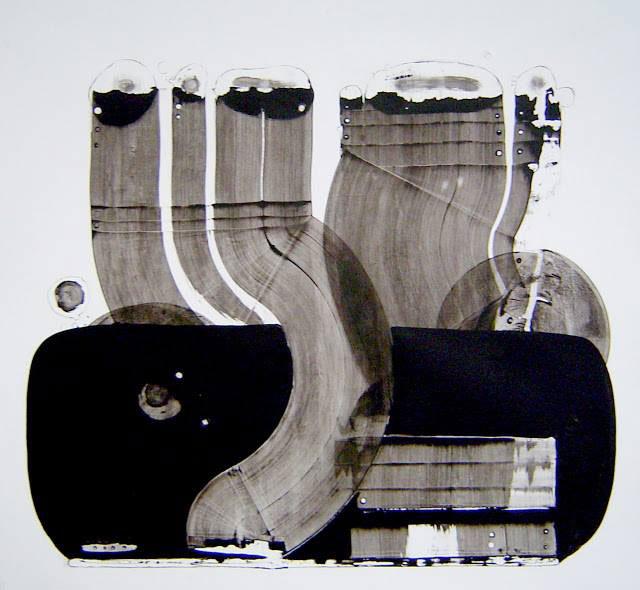
يُلاحق الشاعر الأردني أمجد ناصر (1955 – 2019) علاماته الكونية في ديوانه “كُلَّما رأى علامة” الصادر سنة 2005 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ليصبح ترقّب العلامات هو جوهر التجربة وشعلتها، فحالة الانتظار موصولة ببشارة المعنى الضمنيّ للعلامة، هذه المعاني التي تتصل بالاختيار الأمثل، والإرشاد الكونيّ لمستقبلٍ أكثر ازدهاراً. لكن للعلامة أسرارها المكنونة، وتأويلاتها المُتعددة في فضاء التفسير، ففي رحلة الاقتناص تتسيَّد حالة القلق الدائم والإحباط المدقع من عبثية الانتظار، أو في أسوأ الخيبات؛ التأويل الخاطئ للعلامة.
وباعتبار العلامة معنى غامضاً ومطمئناً في آن، ارتبطت العلاقة بشكلٍ طرديّ بين ظهورها الجليّ وتحقق الأمل، كما يقول الشاعر:
“الأمل ليلٌ آخر لم يعد
مستطلعو الفجر من جبهته.
انتظرتُ.
لكن الإشارةَ،
طلعة الضوءِ
تلويحة اليد
ضلّتْ طريقها.”
يتشكّل معنى العلامة في كونها أملاً، لكنه أمل يتوارى، لأن محاولات الانتظار الرتيبة لم تحقق رجاءها، والأمل ما هو إلا ليل حالك لا فجر بعده، لتصبح سيرورة الآمال والزمن -المهدور في الترقب – حلقة مفرغة أمام العلامات المفقودة، وهي في أضعف حال؛ علامات ضئيلة (إشارة – ضوء – تلويحة)، لكنها الوهج الذي يمنح النفس الطمأنينة، لذا يستحيل للطمأنينة أن تتحقق بغيابها.
يقول في نص آخر:
“واقفُ تحتَ بُرجِكِ المرصودِ
بين السّهمِ والعين الآمرةِ.
علامةٌ تُميتُني
علامةٌ تُحييني
والحَيْرَةُ وحدَها يقيني.
يدٌ أقصرُ من فرحةِ الأختِ تمتدُّ إليَّ
فأرفع يدي، هكذا لنهارٍ
بلا إمارةٍ.”
تُهيمن فكرة العلامة لتصبح هي الحكم والفيصل، على الرغم من معناها المُبهم، إذ صار استقراء العلامات هو الغاية، لكنها مخاطرة معقودة باستسلام مطلق للاّوضوح “والحيرة وحدها يقيني”، فنظرة المحبوب تُرسل معانٍ غائرة بين الوصل والتمنّع. وبين هذين التناقضين (الإحياء والإماتة) تتسع مقبرة الإحباط.
وفي رحلة التقصي عن العلامات، تُصقل الحكمة، يقول:
“العلامةُ تظهرُ لمن يتولّى؛
تقودُ الأعمى إلى ما رأته يداه
وتمنحُ اللاهي مُستحقات اليقظة.”
أمام لهفة قراءة العلامات وتصيّدها في كل ملامح الحياة، يظهر معنى “التولّي” والإعراض بشكلٍ يتصادم مع حالة التشوّق المستعرة، فالمترقب لم ينل علامته، وأدرك باحتراقهِ أن العلامة تُمنحُ لمن نسيها، في حين تظهر حالة العمى لتصبح رمزاً في ثنايا القصائد، فهل مُنح الأعمى موهبة استبصار العلامات؟ أم أن عمى القلب حاجبٌ لنور العلامة؟
يقول في مقاطعٍ قصيرة عنوانها “ثلاث إشارات في طريق الأعمى [4]:
“الثلاثُ
قلن لمن ظنَّ نفسه مكيناً على الأرض:
امشِ هوناً!
**
ثلاث قُبّرات فرَّت أمام الأعمى
الذي يغذُّ الخُطى..
الهاوية تُرِهفُ السمع.
**
الإشاراتُ الثلاثُ التي صادفتني
على الطريق أومأتْ إلى الجبل
لكنني مضيتُ إلى الوادي
قِصَرُ نظرْ!”
تتكثف العلامات لتصبح ثلاثاً بزيادة التوكيد، فهذه العلامات التي تحاول أن تحمل معانٍ ضمنية في الإرشاد، كدعوتها للحكمة “امش هوناً” أو استحثاثها للمجد “أومأتْ للجبل” أو تنبيهها للنجاة من السقوط “فرّت أمام الأعمى”، لكن مُتلقي العلامة عجولٌ، وأعمى، وضعيف بصرٍ لم تستطع كل هذه الإشارات إنقاذه، فالمشي بعُجالةٍ كان مآله الندم، والمضي في الوادي كان اتجاهاً خاطئاً نحو الحضيض، وما الهاوية التي تترقب سقوطه إلا الهلاك بعينهِ.
يجيء تتبع العلامة بوصفه موضوع عتابٍ، فالأم قلقة على ابنها الذي ما فتئ يُلاحق العلامات، تقول الأم:
“ماذا جنت يداكَ من طيرانك الخرافيِّ
فوق الشتاء والصيف؟
العلامةَ
هل لها غيرُ ما أعطتهُ لسابقين
شبّوا
وشابوا
وأوحشوا بنات نعشٍ قبلكَ؟“.
تحاول الأم تفكيك منطقها في استحالة أن يعلق المرءُ مصيره بالعلامات، وإلا قد جنى على نفسه بالتيه، وتستشهد بالأولين الذين شبوا وشابوا بانتظار العلامة التي لا تجيء. وتجدر الإشارة هنا بأن مطلع الديوان كان الإهداء متفرداً بالأم الراحلة: (إلى فضّة، أمي، ذاهبة لتؤنس التراب)، الأم التي كانت وصيّتها أن يكف ابنها عن ملاحقة العلامات، لتأتي القصائد كرسالة اعتراف بالهلاك التي تحقق، فالقصائد تتراوح بين إيمانٍ متشبث بأصغر الإشارات، ومونولوجيات تحطّم الفكرة المستحوذة “عيني لا تغرّها العلاماتُ” [7]، ىبالإضافة إلى حالة التفاجؤ من سرعة مرور العمر، وظهور الشيب، واقتران هذه الأسئلة الوجودية من جدوى الأمس، وأضواء الغد أو ظلامه.
وفي نهاية المطاف تتجلى العلامة بوصفها مرشداً وهادياً تُطمئن الضال والحائر، كما استرشد الرحّالة بالنجوم، واقتفى البُداة بالأثر، وتبين بذلك أن علامات الكون لا يمكن التقاطها إلا ببصيرة القلب وحدها، وإن عُميت البصيرة، أدرك المرءُ جرف هاويته، فـ”الهاوية تُرِهفُ السمع”.




