أولى الساعات
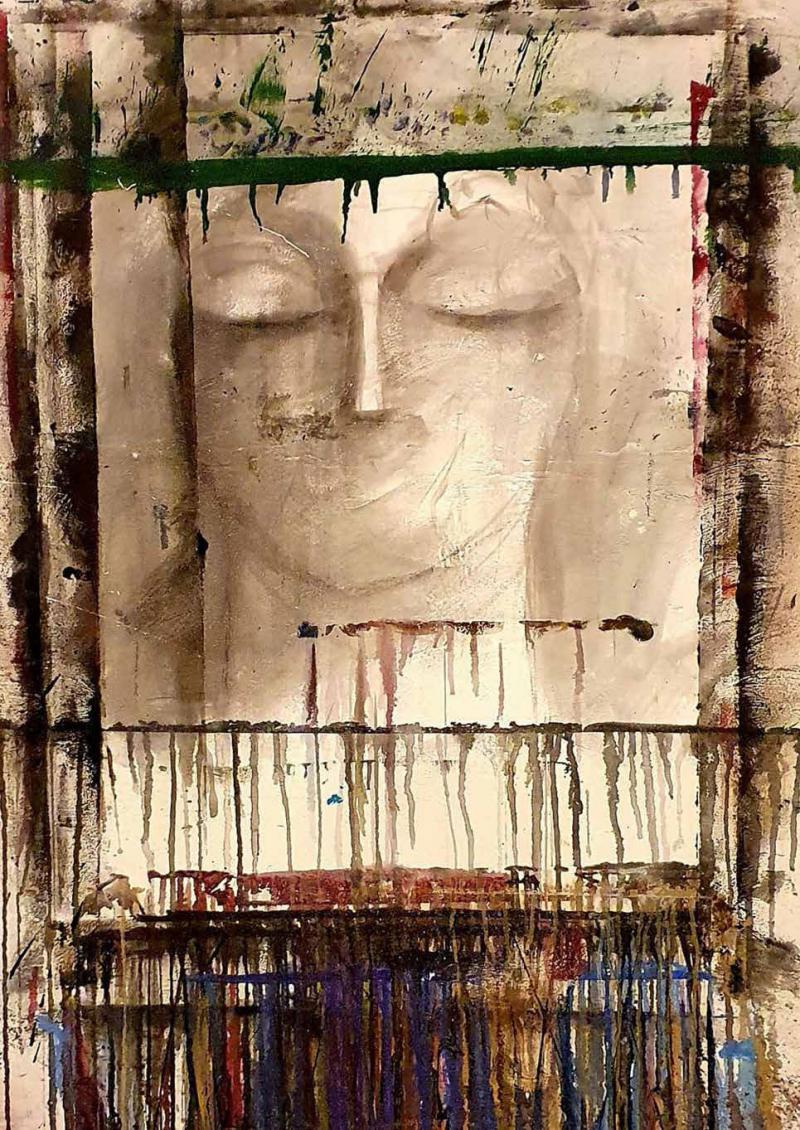
“… ومؤكّدٌ أنه ليس هنالك من أثرٍ
مهما صَغُر شأنه في الماضي،
إلا وله شيء من علاقة بالمأساة الراهنة”.
(إشبنغلر)
لم تنكتب على سماء العام 2010 أيّ كتابات نبوئيّة بخصوص مستقبل منطقتنا العربية. لا ولم تنعب طيور الظلام طوال ليل ذلك العام، ولا تقصّفت الأشجار، ولا طارت العلاجيم في السماء، ولا تنكّرت الشياطين على هيئة ” أخوات القدر”. لا ولم يتبيّن لأكثر المتبصّرين شطارةً أن في أفق التعاقب الروتيني للأيام ولمجرى الأحداث السياسية والاجتماعية تغييرات قادمة وشيكة، وأن بعضها من النوع المصيريّ.
وقلّةٌ من أهل مخيم اليرموك كانوا مع اقتراب ذلك العام من نهايته قد سمعوا بمدينة “سيدي بوزيد” التونسية، ويُقالَ الشيءُ ذاته بخصوص أهالي “سيدي بوزيد”. على أنه لا هؤلاء ولا هؤلاء، ولا أحد في العالم ربّما تخيّل، مجرّد تخيّل، أن قيام أحد رجال الشرطة في تلك المدينة التونسية النائية، بتحطيم عربةٍ لبيع الخضار، وإيقاع أبلغ الإهانات بصاحبها، سيؤدّي إلى ثورات شعبية عارمة، تهزّ أرجاء واسعة من العالم العربيّ.
فمثل تلك الواقعة، وما هو أبلغ منها، هي مما يُشاهَدُ حدوثُهُ، على مدار الساعة، في أغلب شوارع المدن العربية وساحاتها، ومعظم دول العالم الثالث، ليس فقط في تلك الأيام بل وإلى يوم الناس هذا، دون أن تُؤدّي، في الأعمّ، إلا إلى أن يبتلع منْ وقعت عليه الإهانة لسانه، وإلى أن يلوذ باقي الباعة بالفرار، ويتفرطع المتسوّقون محتمين بالأزقة الجانبيّة كي لا يصيبهم نصيبٌ من غضب الشرطة، التي إن غضبت فلا مَرَدّ لغضبها.
وأما لماذا قاد إحراق البائع التونسي الغلبان “محمّد البوعزيزي” لجسده إلى ما قاد إليه، ولماذا هذه الحادثة وليس غيرها، ولماذا حدث ما حدث في هذا المكان وليس في غيره، وفي هذا التوقيت بالذات وليس في زمنٍ آخر، فإنها وكثيرٌ غيرها، من الأسئلة التي تُشكّل إرباكاً حتى لأعظم المفكّرين والمؤرّخين. ذلك أننا لسنا هنا بإزاء ظاهرة طبيعية تخضع للقانون الذي يقول “في الظروف المماثلة تحدث أمورٌ مماثلة”.
لذا تراهم في الغالب يستنجدون بالمجازات الشعرية. فالمؤرخ العربي ابن خلدون يستحضر في حديثه عن التعاقب الحتمي للدورات الحضارية، أطوار حياة الانسان، الفرد، و”هذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيّد إلى الوقوف ثم إلى سنّ الرجوع… إلى أن يتأذّن الله بانقراض الدولة” (ناجية بوعجيلة “حفريات في الخطاب الخلدوني” المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، ط1 2015 ص 220).
وأما كارل ماركس فيلجأ لمجاز “الحمْل” ووفقاً لرؤيته تكون حادثة “إحراق” البوعزيزي لجسده بمثابة “الداية” التي أوكلت لها اللحظة الثورية الملائمة مهمة إخراج جنين النظام الاجتماعي والاقتصادي الجديد من رحم النظام القديم. وبدوره، يأخذ الثوري الروسي لينين المجاز الشعري الذي أسلمه له ماركس فيتحدّث كيف أن المجتمع الروسي القديم، قبل الثورة البلشفية، كان حاملاً بجنينين، لأبوين مختلفين، وبوزنين مختلفين”. (أليكس دوتوكفيل “النظام القديم والثورة الفرنسية” ترجمة وتقديم: خليل كلفت. المركز القومي للترجمة. القاهرة 2010. صفحات المقدمة من 9 حتى 55). وإذا تناولنا بدورنا ذلك المجاز، مجاز “الجنين” فيصح أن نقول بخصوص الثورات العربية التي ابتدأت مع نهاية عام 2010 إن رحم المجتمعات العربية كان حاملاً، قبل أن تندلع تلك الثورات بألف جنينٍ وجنين، لألف أبٍ وأب.
وأما لماذا أقمنا ذلك الربط التعسفيّ بين حدثين يفصلهما عامان عن بعضهما البعض، وبين مكانين يبعدان عن بعضهما البعض آلاف الكيلومترات:
سيدي بوزيد ومخيم اليرموك؟
فلأنه في التاريخ الذي أحرق فيه محمّد البوعزيزي نفسه، يوم 17 كانون الأول 2010، ولكن بعد عامين كاملين، أيْ في 17 كانون الأول من عام 2012 فرّ مئات الألوف من سكان مخيم اليرموك من منازلهم، تاركين خلفهم تراثاً وتاريخاً يمتد لستة عقود من العيش فوق الأرض السورية، بحلوه ومُرّه. وإذا كان اتفاق ذينك الحدثين لجهة اليوم والشهر اتفاقاً تصادفيّاً ما في ذلك من شكّ، إلا أن بينهما لجهة الجوهر علاقة سببيّة أكيدة. ثمة نتيجة هي: دمار مخيم اليرموك وتشتّت أهله في المنافي.
وثمة سبب هو: الثورات العربية التي أعقبت حادثة البوعزيزي.
وكي لا نُتّهم بالتمركز حول الذات، فسوف نسارع للقول إنه وإلى تاريخ سقوط المخيم كانت مدنٌ عربية أكبر وأعرق تاريخياً من مخيم اليرموك قد تدمّرت عن بكرة أبيها، وأوطاناً عربية بأكملها سقطت وتحطمت عشرات القطع من جرّاء تلك الثورات. وإذا التفتنا بعد هذه الإشارة الضرورية إلى ما يخصّنا كفلسطينيّين فسنجد أنفسنا مضطرين، بدورنا، للاستنجاد باللغة الشعرية في تعاملنا مع كمٍّ آخرَ كبيرٍ من الألغاز، ومن أكبرها اللغز التالي: لماذا مخيم اليرموك؟
أيكفي أن نقول إن الميتة التراجيدية التي واجهها نهاية عام 2012، وتماماً في الذكرى الثانية لإحراق البوعزيزي لنفسه، وبعلاقة سببيّة من تلك الحادثة، كانت قد حلّت به لأنه كان قد بلغ:
في اتساع عمرانه، وتنوّع تركيبته السكانية، ودوره الرياديّ على أكثر من صعيد، لا بالنسبة إلى أهله فحسب، بل وحتى بالنسبة إلى محيطه السوري، والعربي أيضاً، حدوداً مخيفة، تخطّت وظيفته كمخيمٍ للسكن، مما حَتَّمَ له، دون شفقة، ذلك المصير المأساويّ، وتلك النهاية المروّعة التي تليق بأبلغ التراجيديات الإغريقية، أمام أعين البشرية جمعاء، وفوق خشبة مسرح كبرى هي العالم!
على أن مثل هذا الكلام، وما يشبهه من كلام، يبقى أقرب إلى العواطف والشعر، ما لم يجرِ تدعيمه بحقائق ملموسة. وسنرجئ مثل ذلك التدعيم إلى نصٍّ آخر، ونمضي الآن، ودون أن نخوض في كثيرٍ من التفاصيل، لنقول إن الحركات الاحتجاجّية التي قامت في بعض الدول العربية ابتداءً من أواخر عام 2010، وفي الشهور الأولى من عام 2011، نجحت سريعاً، وهذا أيضاً أحد ألغاز ما سميّ لاحقاً بـ”الربيع العربيّ “، في الإطاحة بالنظامين التاريخيّين في كلّ من تونس ومصر، وبدا أنها مرشّحة للنجاح في كلّ من اليمن وليبيا.
وكان سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس قد مهّد الطريق لسقوط نظام حسني مبارك في مصر. غير أن سقوط نظام مبارك هو الذي ترك أعظم الأثر في تطوّر الأحداث اللاحقة في غير مكانٍ من العالم العربيّ. فها أنّ نظاماً له وزنه التاريخيّ، ويشتبك، بفضل اتفاقيات كامب ديفيد ومتعلّقاتها، بعلاقاتٍ تحالفٍ متينة مع إسرائيل ومع الغرب، يتهاوى، بفضل تضحيات الجماهير المصريّة. وها أن الغرب قد اضطرّ للقبول بنتائج إصرار الجماهير المصرية، ورغبتها في إحداث تغييرات في حاكميها، وفي طرائق حكمهم.
وعندما كتبتُ في السطور الأولى عن كيف أن سماء عام 2010 لم تظهر عليها أيّ كتابات تُنبئ بما سيجري لاحقاً، فإن لاوعيي كان يستعير صورة مستمّدة من مذكرات الكاتب النمساوي ستيفان زفايج، الكاتب المعروف، والمقروء جيّداً من أبناء جيلنا، جيل الستينات والسبعينات من القرن العشرين.
ففي الفصل التاسع من مذكراته المعنونة “عالم الأمس”، يصف ذلك الكاتب الساعات الأولى على ابتداء الحرب الكونية الأولى، صيف عام 1914، بالقول إنه لم يسبق له طوال حياته أن عاش “صيفاً أرفهَ، وأجملَ، بل وأصيفَ من ذلك الصيف. كانت السماء طوال الأيام والليالي حريرية الزرقة، والهواء عليلاً… والمروج دافئة، عابقة بالأطياف، والغابات داكنة، كثيفة، ناضرة الخضرة… ثم، وعلى نحوٍ مفاجئ توقّفت الموسيقى، وتوقف كلّ شيء، وتغيّرت الحياة ومصائر ملايين البشر، إثر اغتيال الأمير فرانز فردنان، وريث التاج النمساوي، وزوجته، في صربيا، عشية يوم الـ29 من تموز من عام 1914، وهو الحدث الذي كان بمثابة الشرارة التي أشعلت نيران الحرب الكونية! (ستيفان زفايج “عالم الأمس”. ترجمة عارف حديقة. دار المدى. سوريا. 2007 ص 167).
وبدوري، فإنني لن أضيف إلى هذا الوصف الرائع لصيف 1914، والذي هو بدوره استيحاءٌ رائع للصورة التي رسمها كارل ماركس لـ”العاصفة العاتية التي تنقضّ فجأةً تحت سماءٍ صافية” (ستيفان زفايج).
لن أضيف وصفاً آخر في رسمي ليوم الجمعة الـ16 من آذار 2011، وهو اليوم الذي اعتُبر لاحقاً بداية ثورة السوريّين. فقد كانت سماؤه صافية الزرقة، مع برودة خفيفة يمكن أن تنسحب من الأجواء بارتفاع الشمس في السماء أكثر فأكثر، مما كان يغري بحفلة شواء تتمّ إما على برندة البيت، أو في أحضان الطبيعة.
وتصادف في العاشرة من صباح ذلك اليوم، ويبدو أن المصادفة، هي قانوننا كبشر فوق ظهر هذا الكوكب، أن أتصل فيما كنت أنتقي من السوق المركزي في مخيم اليرموك كامل ما يلزم حفلة الشواء المزمعة من مستلزمات، أبوفراس، صديق، ومسؤول حكومي سابق:
– أيوه أبوبسّام. شو عندك اليوم؟
– ولا شي. ليش؟
– جاي عَ بالك اتطُش؟
– أنا اللي جاي عَ بالي أطشّ!
– يالله. أصبح بانتظارك.
ومنذ ابتداء أحداث “الربيع العربيّ” وإلى غاية ذلك اليوم، كانت ليالينا، ونهاراتنا، في البيوت، والشوارع، والمقاهي، والدكاكين، وفي طوابير تحصيل ربطات الخبز، وقناني الغاز، وفي انتظار سرافيس الركوب، والكزدرة على شارع الثلاثين، أو ونحن نتعشّى في مطعمٍ من المطاعم الزاهية على طريق مطار دمشق الدولي، تنقضي وسط شغفٍ وقلقٍ، وتباينٍ عميقٍ في الآراء، بين الأصدقاء، وداخل أفراد الأسرة الواحدة، تباينٌ وصل في كثيرٍ من الأحيان إلى حدود الخصام والصدام، ونحن نتحلّق أمام شاشات التلفاز، التي بعد أن كانت لا توجد إلا في البيوت والمقاهي، إذ بها تملأ الشوارع والدكاكين، أبواب الرزق، وصرنا، أكنا داخل البيت أم خارجه، وأينما تنقّلت عيوننا، وإلى أيّ جهةٍ اتجهت أسماعنا، لا نرى ولا نسمع غير البثّ الحيّ للجماهير العربية، تحتلّ شوارع المدن العربية: في تونس أولاً، وبعدها كرّت المسبحة إلى كلٍّ من مصر، واليمن، وليبيا. وكان السؤال الذي لا سؤال غيره في رؤوس الجميع، السؤال الذي كان يطلّ بغتةً وسط كلّ نقاش، ولدى سماعنا لأيّ خبرٍ جديد، أو عندما نشاهد التغطيات الإعلامية تنطّ من هذا البلد العربيّ إلى ذاك، هو: هل ستشهد سوريا في المقبل من الأيام ما يشهده غيرها من الدول العربية؟
وفي بداية أمره كان الإعلام السوري قد احتفى أيّما احتفاء بسقوط نظامي بن علي ومبارك، وتركّز خطابه حول اللازمةٍ التالية:
إن الثورات التي تعصف الآن إنما تعصف في أنظمة حكم عميلة للغرب، وأن الغرب تخلّى عن أدواته التقليدية لأنها تعفّنت، واستنفذت المهام الموكلة إليها، وأما النظام والشعب في سوريا فهما موحدان حول أهداف وطنية وثورية واحدة وراسخة، وأنه ما من قوة على الأرض بمقدورها أن تزعزع تلك الوحدة!
وهكذا، ففرصة التسكع مع أبو فراس كانت ستمنحني إمكانية استيضاح أمور كثيرة. ولفَت انتباهي ونحن نطشّ في شوارع دمشق دون هدفٍ محدّد، في سيارته، سيارة المرسيدس الحكومية، قِلّةُ السائرين في شوارع المدينة. صحيحٌ أنه يوم عطلة، والبشر في الشوارع يكونون في العادة أقلّ مما يكونون عليه أيام الدوام الرسمي، وأنهم، في العادة يتريثون بعد الخروج من المساجد، لتبادل الأحاديث، أو لشراء الخضار والفواكه:
– تعا نقّي بإيدك!
والإبطاء في يوم العطلة يكون في وجهٍ من وجوهه انتقاماً من جانب البشر ضدّ كثرة المشي الذي يكون قد مورس في أيام الدوام. والحياة تخلص والشغل لا يخلص، وأن على الإنسان أن يحترم برهة تعطُّله عن العمل، ويمتصّ إلى آخر رشفة ما في يوم العطلة من راحة، ومُتاحات التواصل الاجتماعيّ مع الأهل والأصدقاء، وإمتاع الروح وإعادة وصلها مع أمّنا الأرض.
منها وإليها
ويومها كان موسم السيارين إلى بساتين “غوطة دمشق” قد أوشك أن يحلّ. فنستمتع فيه بمرأى أشجار المشمس والخوخ والفواكه بأنواعها، وهي التي كانت قبل أسابيع فقط حطباً مشكوكاً في الأرض، فصارت في النصف الأوّل من شهر آذار زهريةَ اللون. أوّل البراعم. أولى الأزهار والأوراق تزيّن الأغصان، حتى في الأشجار المزروعة في الحدائق العامة، وعلى جوانب الطرقات الكبرى في المدينة.
بَيْدَ أن حركة الناس بعد ظهر ذلك اليوم كانت تبدو لعين الناظر المدقّق: متوتّرة، عجولة، كأنهم يبحثون عن شيء ما، أو يهربون من شيء ما. لا تريّث كسول، ولا مماحكات مع باعة البسطات. تلويحاتُ أيدٍ في طرفٍ من الشارع، تُقابلُها تلويحات أيدٍ في الطرفٍ الآخر. استعجال في الذهاب إلى البيوت، واستعجالٌ في الخروج منها.
وكنا خلال كزدورتنا التي لم تترك شارعاً من شوارع دمشق وغوطتها إلا وزارته قد فصفصنا عظام الأوضاع في الدول العربية، ووقفنا مطوّلاً أمام الوضع في ليبيا، وكيف أن تطوّر الأحداث في ذلك البلد العربيّ قد بات يهدّد النسيج الهشّ الذي يشدّ المكوّنات القبليّة الليبية إلى بعضها البعض، وكيف أن تطوّر الأوضاع إن تطوّرت أكثر، ماضٍ، ربما، إلى تفكيك ذلك البلد، ولأن يصبح ملعباً لـ”لعبة الأمم”.
وقلت أسأله، ولم يكن لي في حقيقة الأمر من غاية من مشوارنا هذا، الذي ضيّع على الأولاد والأحفاد في البيت حفلة شواءٍ معتبرة، إلا أن أسأله حينما تأتي اللحظة المواتية للسؤال:
– أيْ. صَعي يا أبوفراس… شو بِدّي إسألك. جماعتك فوق. قصدي أصحابك في القصر… شلون شايفين الأوضاع في سوريا؟ ولوين برأيهن رايحة البلد؟
وكنا لحظة طرحي لذلك السؤال قد صرنا قريبين من قبّة السيّار، المواجهة للقصر الجمهوري، فوق ظهر قاسيون، فأبطأ من سرعة سيارته إلى أن أوقفها تماماً. وأخرج علبة سجائر. وناولني سيجارة. وله سيجارة:
– عن أيش بِدّك إياني جاوبك؟ يعني شو حابب تسمع غير اللي حكيناه لهلّأ؟ كأنك حابب تسمع شي معيّن؟
فقلت:
– يعني. هادا اللي صار في تونس ومصر وليبيا، وهلّلأ في اليمن، يعني ممكن برأي الجماعة فوق يصير عنّا مِتلُه في سوريا؟
فأجاب على الفور:
– أفّ. طبعاً. طبعاً!
ثم أردف بعد صمت طويل:
– طيّب. إنت يا أحمد كاتب ومثقف ما شالله عنّك، من أيام ما كِنّا بالجامعة. وعضو باتحاد الكتاب العرب، وبتفهمها عَ الطاير… يعني بيكفّي قلّك إنو الجماعة فوق (وأومأ برأسه جهة القصر الجمهوري) خايفين كتير…ومرعوبين كتير. بيكفّي هيك؟ وإلّلا بِدّك إياني إحكيلك كمان؟
وكان العابر في قلب مدينة دمشق، والمدن السورية الأخرى، قبل يوم الجمعة الـ18 من آذار من عام 2011 قد باتَ يلحظ خُلُوّ الشوارع، بل وحتى المحارس أمام الدوائر الرسمية، من مظاهر الخشونة المعهودة. وكان الهمس، بل وحتى الكلام الصريح قد بلغ كلّ الآذان من أنّ السلطات المعنيّة وجّهت تعليماتٍ صارمة، نَبهّت الوزير قبل أن تنبّه آذِن الوزارة، بضرورة تفادي ما مِن شأنه إقلاق راحة المواطنين، أو الاصطدام بهم تحت أيّ ذريعة كانت.
وحتى قبل هذا التاريخ كان المكلّفون بحراسة فروع الأمن قد راحوا يظهرون أمام مباني فروعهم الأمنية ببزات رسمية سوداء، أو رمادية، مع ربطات عنق أنيقة. وعلى سبيل المثال، فقد صار مبنى فرع أمن الدولة في دوار كفرسوسة، وهو مبنى سريالي، على هيئة هرمٍ مقلوب، يتزيّن ليلاً، في السنين الأخيرة، بالأضواء من كلّ لونٍ وشكل، كأنك في حضرة ملهىً ليليّ.
وكان البعض في القيادة السورية، كما أخبرني أبو فراس في حوارنا الذي تابعناه في منزله حتى مساء ذلك اليوم، يرون بأن على الرئيس بشار الأسد أن يتدارك الأمر، ويسارع على الفور بإحداث تغييرات من العيار الثقيل، كأن يتمّ على سبيل المثال تأميم شركة “سيرياتل” للاتصالات، التي يملكها ابن خالته رامي مخلوف، واعتبارها “شركة مساهمة سورية.. يتولّى إدارتها مِرْفَقٌ عامٌ مُلْكَ الدولة، وتُجمّد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في سوريا والخارج.. وتحتفظ الهيئة (التي ستشرف على سيرياتل) بجميع موظّفي الشركة المؤمّمة ومستخدميها وعمالِها الحاليين…”… إلى آخره!
وإلى تاريخ ذلك اليوم، يوم الـ18 من آذار من عام 2011 لم تكن قد حدثت بعد على كامل الأرض السورية أحداث كبرى لافتة. غير أنه، وقبل شهرٍ، وفي الـ17 من شباط من ذلك العام جرى حدثٌ في دمشق، ومَرّ مرور الكرام، ولم ينتبه كثيرون إلى دلالاته الخطيرة إلاّ لاحقاً. ففي ذلك اليوم تظاهر تُجّار سوق الحريقة في دمشق؛ السوق العريق، والقلب المالي النابض لا لدمشق فقط، بل لعموم سوريا. فإلى ذلك السوق ومنه يُضَخّ ويُنْضَحُ يومياً، مليارات الليرات السورية من أموال الشارين السوريّين وأموال الشارين العرب والأجانب من زوّار الشام، ممن يتوجّب عليهم أثناء زيارتهم لـ”شام شريف” أن يمرّوا على سوق الحميدية، والحريقة فرعٌ منه، لشراء الملابس، وهي في العادة تكون أرخص من تلك التي تُباع في بوابة الصالحية، أو الحمرا، أو باب توما، ولا تنسى أن تختتم زيارتك لذلك السوق العريق بزبديّةٍ من “بوظة بكداش”، أو بعض أقراص الصفيحة من “مطعم أبو العزّ” في المسكيّة!
كانت تظاهرة تجار “سوق الحريقة” في اليوم المشار إليه طعنة في الصميم للنظام السوري ولرمزه. فما معنى أن يتجرأ تجار دمشق ويهتفوا بملء حناجرهم:
– الشعب السوري ما بينذّلّ؟
ومتى كان باستطاعة أحدٍ في سوريا، كائناً من كان، أن يقف وسط سوقٍ عامٍ، أو خاصٍّ، أو حتى داخل غرفةٍ مغلقة من غُرَف منزله، ويصرخ بأعلى صوته:
– الشعب السوري ما بينذلّ؟
وفي أيّ وقتٍ صُرِخَ بذلك الهتاف؟ صُرِخَ به بعد نحو أسبوعين من التصريحات التي كان الرئيس قد أدلى بها لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وقال فيها لمراسل تلك الصحيفة:
إن الثورات التي تعصف في العالم العربي تجري داخل أنظمة حكم متعفّنة، ومرتبطة بالغرب، وأما في سوريا فالشعب والنظام موحّدان حول أهدافٍ ثورية، وطنية، واحدة، ولا يمكن لقوة خارجية أن تزعزع تلك الوحدة، أو أن تدقّ فيها أيّ أسافين!
وفي ذلك اليوم، يوم الـ17 من شباط جرى تطويق تلك التظاهرة التي تسبّب بها شرطيُّ مرورٍ أرعن، انهال بالضرب، على نحوٍ لامبرر له، على ابن أحد التجّار، وكان ذلك الولد المدلّل يحاول لحظتها أن يَصُفّ سيارته في مكانٍ قريبٍ من متجر والده. وسريعاً، حضر إلى مسرح التظاهرة مسؤولون كبار من القصر الجمهوري. وبغية إرضاءِ المشاعر الجريحة للتجّار، وإخماداً لنار غضبتهم، جرى أمام حشود المحتشدين تلقين ذلك الشرطي درساً لن ينساه ما حيي.
وينبغي لأيّ تحليلٍ موضوعيّ أن يضيف في هذا المقام إنه لو لم يكن محمّد البوعزيزي؛ البائع التونسي الغلبان، قد أحرق نفسه قبل ذلك التاريخ ببضعة شهور، ولو لم تكن قد حدثت الثورات العربية من جراء ذلك الإحراق، لكان الشرطيُّ السوريّ قد أوسع ابنَ التاجرِ السوريّ ضرباً، وضرب معه أباه، وكلّ من يجرؤ من التجار على أن يُطلّ برأسه من دكانته، أو لكان ذلك التاجر قد قَصَرَ الشرّ، وأدخل ابنه عنوةً إلى الدكان وهو يوبّخه:
– ولك فوت يا ابني عَ المحلّ. خلصنا بقى.
وكانت المرّة السابقة التي تحرّك فيها تجار دمشق، الذين كان يحلو لنا أن نَصِفَهم أيام شبابنا الثوريّ العاصف، وفي نقاشاتنا السياسية الحامية بأنهم جُبْناء، وذلك لأن كارل ماركس كان قد قال بأنّ “رأس المال جبان”، ثم ما حاجة أمثالنا إلى أمثال هؤلاء الأثرياء ونضالُنا في أصله مُوجّهٌ ضدهم، كانت تلك المرة في ربيع عام 1964 عندما اشتعلت احتجاجات فوق كامل الأرض السورية ضد سلوكات حزب البعث، الذي كان ما يزال حديث العهد بتسلّم السلطة في سوريا.
وخلافاً لما جرى بتاريخ الـ17 من شباط عام 2011 مع تجّار سوق الحريقة، فقد جرى في ربيع عام 1964، وكان حزب البعث ما يزال فتيّاً، وينبض عنفاً، جرى فضّ إضراب التجار الذي عَمّ معظم المدن السورية، بقوة العنف الثوريّ المسلح. فتمّ تحطيم أَقفال المحلات التي أضربت، وجرى الاستيلاء على ما كان فيها من بضائع. وزُجّ بالكثيرين من أصحابها في السجون. وظلّ معظمهم مسجونين إلى اليوم الذي وقعت فيه حرب حزيران الكارثية في الخامس من حزيران عام 1967.
وأيامها قامت مجموعاتٌ من كوادر بعثية، وممن أطلق عليهم اسم “الحرس القومي” وهم مجاميع من الغوغاء والأفّاقين، ومقتنصي الفرص، جرى استلهام نموذجهم من تجارب بعض الدول الاشتراكية، قام أفرادٌ من هؤلاء اللصوص المؤدلجين بإدارة المتاجر المصادرة، التي سُجِن أصحابُها، وبالأخصّ الكبرى منها، والعبث بما احتوت عليه من أرزاق الناس وبضائعهم، وجرى التعامل معها باعتبارها أسلاباً تعود في أصلها للشعب السوري. وأن الشعب مُمّثلاً بطلائعه الثورية قد وضع يد الشعب السوري على ما كان قد سلَبَهم إياه التجارُ السوريون الجشعون.
وأن يُهتَفَ بهتاف:
– الشعب السوري ما بينذلّ.
في مثل ذلك المكان الحيويّ والنابض من قلب دمشق، حتى وإن جرى تطويقُه بغمضة عين، وبتبويس اللحى، وبعلقةٍ ساخنة لن ينساها شرطيّ المرور الأرعن ما حييَ، إنما عنى شيئاً واحداً، وحيداً، وهو أن أبواب سوريا، كانت قد شُرّعت، ابتداءً من برهة ذلك الهتاف، على المجهول. وأن أيّ تغييرٍ قد يُقدِم عليه النظام السوريّ، حتى ولو كان من العيار الثقيل، سوف لن يقدّم ولن يؤخّر كثيراً، وذلك لسببٍ بسيط، هو أنه لا يجيء في الأوان، بل بعد فوات الأوان. وأنه قد صار جليّاً أن الزمن الذي كان باستطاعة شرطيّ فيه أن يُرَوِّعَ حيّاً أو مدينةً بكاملها، حتى وهو غافٍ في مَحرَسه أو في سيّارة دوريته، قد ولّى هو الآخر إلى غير رجعة.
أرأيتُ ساعتها، وأنا أستمع إلى أبو فراس يحكي عن الخوف، وعن الخوف من الخوف، دمار مخيم اليرموك ، وتشتّت أهله في المنافي؟
وسأُدّعي كاذباً لو زعمتُ بأنني رأيت عُشْرَ الذي جرى لاحقاً.




