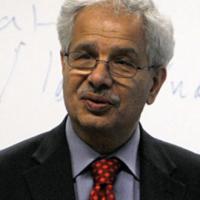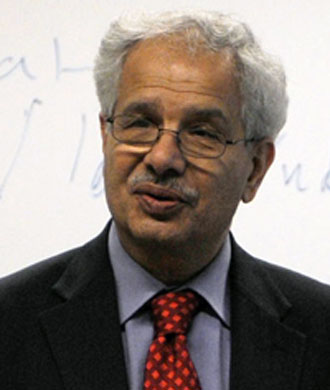الرواية المغايرة الرواية الواعية بذاتها

“أولاد الغيتو: اسمي آدم”..إلياس خوري
تشتبك “أولاد الغيتو” مع كتابات آخرين كغسان كنفاني وأميل حبيبي، وجبرا إبراهيم جبرا وغيرها، وأولها نص المؤلف الآخر، «باب الشمس» بشخوصه الذين يظهر بعضهم ثانية لاستكمال وتصحيح ما لم يكتمل من قبل. كما أنها تشتبك مع «رجال في الشمس»، لا كأشخاص، ولكن كمجتمع يغلق أذنيه وأسماعه عن ذلك الطرق على جدران خزان الموت. أما البقية من الروايات والسير التي يذكرها مغلف آدم دنّون ومعها الإحالات على أفلام تنحرف بشكل ما عن أصولها والمحاضرات المزعومة والأبحاث الفعلية عن مجازر اللدّ (ص «»») وبعدها بعقود صبرا وشاتيلا فكلها تمر في الذاكرة-الجرح التي يحتويها هذا المغلف، أي الرواية المغايرة، أو الحكاية-السيرة.
يقول آدم في واحدة من هذه الاشتباكات مصححاً ما يقوله جبرا في (السفينة) “لا الذاكرة جرح في الروح لا يندمل، عليك التأقلم مع صديده الذي ينزّ من شقوقه المفتوحة” (ص «»»).
ربما لم يكن إلياس خوري بحاجة إلى قرابة سبعين صفحة لعرض ما ذكره صاحب الأغاني وابن الجوزي في المنتظم عن “وضاح اليمن”، وقصة موته في صندوق الصمت لكي يطأ “الصمت” الذي يجعل من حياته وحبه مأساة، كما يجعل من موت منكوبي «رجال في الشمس» كذلك، ومن ثم بلوغ الصمت الذي أحاط بمحرقة (الفلسطينيين في اللد وغيرها من مدن وقرى فلسطين وبمقتله، جامع/مسجد دهمش ص ص «»»- «»») (يوم الحشر اللدّاوي -»»»). لكنه فعل ذلك. “وضاح اليمن” كرواية لم تنجز تطالب بتفسير ما وهي في حالها الآن توطئة جعلها آدم دَنّون مقدمة لروايته، الرواية-الناجية من حريق الانتحار الذي طاله ومحتويات سكنه باستثناء المخطوط الناجي كنجاة مأمون الأعمى كشاهد وحيد على قصة طفل ملقى تحت شجرة الزيتون، ليسميه “الناجي”، ويسميه الأهالي “آدم”،وتسميه أمه بالتبني “حسن” تيمناً بزوجها الشهيد بعد حين. أما التبرير فيشغل عدة أسطر ليجعل من هذه الحكاية أساسية لغيرها، وبضمنها صوت إدريس خوري أستاذاً في جامعة نيويورك تأتيه طالبته الكورية المفضلة بما خلّفه الحريق الذي يحاكي ما جرى للشاعر راشد حسين في نيويورك فعلاً. ليست هذه نية أبي حيان التوحيدي عند حرق كتبه. لأن التوحيدي أتاح انتحار بعض منه: لا جسده وكيانه المعنوي. يقول آدم دنّون “لماذا صمت الوضاح في الصندوق، ولم يصرخ طالباً الرحمة؟ (ص «»)؛ وهو السؤال الذي يخص به رواية غسان كنفاني ولكن بطريقة أخرى (ص «») ويأتي الجواب تبريراً للرواية على أنها خرق للصمت “روايتي سوف تقود إلى الصندوق” (ص «»). أما سؤاله، فيختلف عن ذلك الذي انتهت إليه “رجال في الشمس»، لأنه يسأل من (“عتمة الداخل، حيث يختلط ظلام الروح بظلام العالم”. هنا تقوم الحكاية بتفكيك عناصرها لتعيدنا إلى الراوي، بائع سندويشات الفلافل على مقربة من الجامعة الذي أحبته الطالبة الكورية. أراد آدم، أي البائع القارئ-المتعلم ، السماح للالتباس في هويته: فهو اسرائيلي عند زبائنه وفلسطيني مع نفسه يحتج على ما قيل وكتب عن «»»» لأن ما كتب لم يبلغ ما رآه وخبره وسمعه من مأمون الذي يعمل أستاذا الآن ويحاضر عن التاريخ وعن محمود درويش؛ وكذلك من أمّه بالتبني. ليس هذا فقط لأن السرد الذي في متناوله ذكر أمراً وتناسى أمراً آخر هو «ترسيمة الفلسطيني الأخرس» (ص «»») في نص الروائي الإسرائيلي س. يزهار المعنون “خربة خزعة” المنشور سنة «»»» عندما لم يزل كاتبها “ضابط استخبارات الكتيبة التي نفذت مجموعة الهجمات على القرى الفلسطينية بين المجدل وبيت حانون وتطهيرها من سكانها” (ص «»») فجر «» تشرين الثاني «»»».
تلك الرواية، بترجمتها في عدد مجلة شؤون فلسطينية المكرس لعام «»»»، ستكون النص التحتي/الفرعي لـ”أولاد الغيتو” لأنها تأتي بتلك الترسيمة التي لا تعدو أن تستعيد مشهداً توراتياً لليهود الغابرين وتسقطه على الفلسطيني القتيل والمقهور والمطرود “كل أولئك العميان والعرجان والعجزة والأطفال سويّة، كانوا كما لو أنهم يطلعون من مكان ما في التوراة” (ص «»»)، هكذا يكتب يزهار وهو يستغرب غياب إرميا واحد “كنت أبحث عما إذا كان بين كل هؤلاء إرميا واحداً أيضاً، غاضب ومتقد، يطرق في القلب غضباً، وينادي الإله العجوز اختناقاً، من فوق قاطرات المنفى” (ص «»»). كان يزهار يستعيد مقتلة مسجد دهمش عندما “داهمتنا بعد ذلك امرأة تحمل في حضنها طفلة رضيعة وهزيلة… تابعت ترقيص ذلك المخلوق التعس المقمط بأسمال ملطخة بالخراء” (ص «»»). أما آدم دَنّون فيقول “ماذا أستطيع أن أكتب فوق نصّه؟ أنا أعرف اسم المرأة التي رقصت ورقّصت ابنتها مّرتين في غيتو اللّد” (ص «»»). والمهم للروائي المفترض أن يهدم الصمت، فإذا لزم إنشاء الدولة الصهيونية اختراع شعب بديل، أوروبي الخصائص على أنقاض الصورة التوراتية لليهودي الطريد، فلتُسقط هذه الصورة الأخيرة على الفلسطيني “يزهار أعلننا يهوداً ليهود إسرائيل، وهذه كانت رسالة روايته” (ص «»»).

مثل هذه الرواية “خربة خزعة” وغيرها تحضر في رواية “أولاد الغيتو” كنصوص تحتية/جانبية، لكنها أكثر من ذلك أيضاً لأنها تثير الذاكرة مرة وتستهوي التخييل مرة أخرى. هذا سر إعجابه بأنطون شماس في “أرابيسك”، وهو إعجاب لا يخفيه المؤلف لأن شماس “ترك الذاكرة تتنامى إلى أن أوصلته إلى قمة التخييل” (ص «»»). ولتبرير حضور وضاح اليمن الذي شغل قرابة سبعين صفحة ومن ثم غيابه عن النص ألقى اللوم على الذاكرة التي استدعاها “صمت” وضاح في الصندوق، وصمت الفلسطيني أو صمت الآخرين عما يجري في خزان “رجال في الشمس». يبرر بديل الروائي الذاكرة والتخييل ومن ثم الرواية المغايرة وتعايشها مع النصوص التحتية كما يلي “الروائيون حين يبدأون كتابة عمل جديد، يكونون على قناعة تامة بأنهم يصنعون الحكاية من الخيال، لكنهم سرعان ما يجدون أنفسهم أمام انفجار ذاكرتهم… فــ… يذيبون الذاكرة في الخيال” (ص «»»). هكذا يرى “جوهر لعبة إميل حبيبي كلّها، فالرجل لم يكتب سوى ذاكرته بعدما قام بتقطيعها إلى فلذات صغيرة، استخدمها كما يستخدم الميكانيكي قطع غيار قديمة من أجل إصلاح محرِّك سيارة معَطل” (ص «»»).
هذا هو جوهر الاشتغال في “أولاد الغيتو: اسمي آدم” كرواية واعية بذاتها. ليس هناك ضرورة لادعاء الابتكار والكشف والإلهام، فصنعة السرد في مثل هذه الحالة تقارب صنعة الميكانيكي مع فارق واحد، هو أن تترك للذاكرة أن تستجمع ما تشاء وتخلطه بالتخييل. ولهذا يقول آدم عن نفسه “كبائع فلافل يحاول أن يكتب رواية عن شاعر مغمور لفَّه الصمت” ما يلي “قادتني الكتابة إلى حيث تشاء، ووجدت نفسي أخرج من صندوق وضاح اليمن كي أدخل في صندوق حكايتي” (ص «»»). لكن هذه تتخذ من سيرة طفل متروك من أكثر من خمسين ألف عائلة طريدة من اللدّ بدايتها والتباسها، لأنه آدم وناجي وحسن، ولأنه “الروائي” الذي يكتب الآن نصاً “رواية لا تشبه الروايات، لأنها تنتمي إلى جنس أدبي لا أعرف له اسما، ولست متأكداً من وجوده أصلاً” (ص «»»). هذا الجنس المغاير هو الرواية الواعية بذاتها، الرواية المغايرة؛ فهو ينطلق من مقتلة مسجد دهمش الرهيبة التي تفتح فيها فرق الهاغاناه والبالماح النار على المتجمهرين ليموت الجميع ويُجبر المتبقون على البقاء داخل غيتو الأسلاك الشائكة (ص ص «»»-»»») أو الفرار (ص»»». ص»»». ص»»». ص»»». ص»»». ص»»». ص»»». ص»»») لا يختلف على طبيعة المقتلة، ولكن تفاصيل مقتل هذا الفرد أو ذاك التي ينقلها جريح لم يرصد تحت أكوام الجثث هو الخاضع لوهم البصر (ص «»»).
تتفق الروايات على أن من قاد مذبحة اللدّ أو أمر بها هو قائد اللواء الثالث للبالماح شموئيل كوهين (ص «»»). وكان لا بد لمثل هذا الابتداء وتعزيزه بالمتوفر من الكتابات والشهادات (ص «»». ص «»». ص «»») لتكسب الرواية الواعية بذاتها قدرة التوصيل بمراوغاتها الكثيرة. لكن “ترسيمة الفلسطيني الأخرس» التي جاءت الراوي من س. يزهار، كما يقول، أسقطت على حكاية وضاح اليمن وصندوق الموت حيث لفّه الصمت وتواطأ عليه الضحية والخليفة القاتل. هذا الإسقاط وراء تأويل “رجال في الشمس» على أنها أيضاً مقروءة بشكل معكوس، فلماذا يصمت العالم إزاء هذا السجن، الغيتو، سواء في الخزان أو في التابوت والقبر أو بين أسلاك «»»» التي تحيط بالمتبقين من أهل البلاد.
الترسيمة المذكورة هي البنية التحتية للرواية داخل الرواية ضمن عملية ترقيع واسعة يظهر فيها الروائي الفاعل متواطئاً مع الروائي الأستاذ، مختلفاً معه، متنازعاً، ونسخةً عن الشاعر راشد حسين وانتحاره في نيويورك. ولهذا تأتي تساؤلات بديل الروائي، بائع الفلافل في نيويورك آدم دنّون، محض تبريرات لما هو آت، لما حفزته “خربة خزعة”. صمت وضاح حفزه “إلى تحويل هذا المخطط إلى عمل روائي. روايتي سوف تقود إلى الصندوق. وهي تشبه في ذلك رواية غسان كنفاني ‘رجال تحت الشمس’، التي أوصلت أبطالها إلى خزّان صهريج الماء كي تطرح عليهم سؤال اللماذا. سؤال كنفاني جاء من خارج الخزان، أما سؤالي فسيكون من عتمة الداخل” (ص «»). الناجون من مذبحة اللدّ («»»-»»») أمثال د. ميخائيل قلة، لأن الفرقة «» التي قادها موشيه دايان أنهت مذبحتها في ساعة (ص «»»). ولم يتبق غير أنفار منهم الطفل آدم “ابن المدينة الذبيح” (ص «»»). الذي سمع روايات المذبحة من الآخرين، ومن أمه بالتبني. أما الغائب من المروي والذاكرة المثقوبة فهو ما يحتم التنقيب لمعرفة “لوثة الدم” التي جاء بها منفذو المذبحة (ص «»»). وعلى الرغم من لزوم اتخاذ “موقف المتفرج” (ص «»») كما فعل أبو تمام (ص «»»)، سيعلن آدم “حكايات الغيتو لا تنتهي”، لا لأنها “تحتاج إلى آلاف الصفحات” (ص «»»)، ولكن لأن الحكاية “هي الحياة نفسها” (ص «»»)، ولأنه في النهاية “مجرد راوٍ” لما شاهد وعاش (ص «»»).
رواية “أولاد الغيتو” تلعب بامتياز لعبة الروي أو الواعي بنفسه، وتعتمد مجموعة من النصوص والمحكيات والذكريات والتقارير، لكنها في النتيجة خرقت الصمت وبعثت الحياة في صفحات أريد لها أن تطمس مع الذاكرة الواهنة لجيل أخذ بالانقراض. وإذا كانت أرشفة المحرقة النازية اليوم هي الشغل الشاغل الذي تعتمده الصهيونية لغلق باب التساؤلات في ما جرى ويجري منذ «»»»، فإن “خربة خزعة” وأعداد مجلة “شؤون فلسطينية” وغيرها من نصوص وروايات، تجعل” أولاد الغيتو” على عتبة الخرق، خرق الصمت واستنطاقه.
مصائر..ربعي المدهون
يفترض هذا العنوان أن التدفق السردي العربي الهائل في الألفية الثالثة حتمته ظروف موضوعية وأخرى طارئة أو مؤقتة، فالظرف الموضوعي يقارب ما يعنيه (كانت) وبعده ميشيل فوكو بـ”حالة الإمكان” و”التحقق”. وهو في هذا المقال محصلة التغيرات الشديدة التي تهز المجتمعات وتربك بنيتها وتلغي كثافتها السكانية وتحتم الهجرات الكبرى. وأسبابها تتفاوت ما بين الغزو الخارجي والاحتراب الداخلي والتعامل الوثيق مع الرساميل العالمية وغياب داعي الوحدات القومية وظهور الفضائيات التي تمثل أو تعارض الأوضاع المذكورة وشيوع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي. أما الطارئ فهو التشجيع والدعم والتظاهر الإعلامي. ولا يقلل العامل المؤقت من قيمته معرفياً وثقافياً، فهو دافع ومحرك.
لكنني معنيٌّ هنا بأمر آخر لافت للإنتباه لا يتعلق بالرواية الفائزة بجائزة بوكر لهذا العام، أي “مصائر” لربعي المدهون، فحسب، وإنما ب”مصائر” و “أولاد الغيتو” من روايات “النص”، أو “ما وراء الرواية”، أو الرواية المغايرة “الرواية داخل رواية”، أي الرواية الواعية بذاتها. وكنت قد تعاملت مع هذه الظاهرة سنة «»»»، في العام الذي ظهر فيه كتاب Patricia Waugh ؛ وتوسعت في ذلك في كتابي “ثارات شهرزاد : فن السرد العربي الحديث” (دار الآداب «»»»). وتناول الفصل السادس “مخلوقات” فاضل العزاوي الجميلة، و”لعبة النسيان” لمحمد برادة، و”القصر المسحور” لطه حسين وتوفيق الحكيم، و”عالم بلا خرائط” لجبرا ابراهيم جبرا وعبدالرحمن منيف، و”التجليات” لجمال الغيطاني، و”صراخ في ليل طويل” لجبرا و”الحرب في برّ مصر” ليوسف القعيد و”شرق المتوسط” لعبدالرحمن منيف.
والرواية الواعية بذاتها هي التي تستدعي النصوص الأخرى، وبينها نصوص المؤلف، الذي يمكّن شخصياته لتناقش أمراً وتختلف مع المؤلف وغيره. ويكون النص الفرعي “التحتي” هو الغالب، بينما يتوارى الروائي وهو يحرك شخوصه. وما حضوره هنا وهناك إلاّ بقصد إذكاء “صنعة” الروي، واللعب على المعيش والمتخيل؛ وهو بحضوره الطارئ أو المعلن يتعمد الانزواء مرة والتباهي مرة أخرى، فهو المغبون أو المتسلط. والقصد أن ظاهرة الرواية المغايرة “رواية النص، أو الواعية بذاتها” ليست جديدة. لكن الجديد هو خروجها على الصمت، فالرواية الواعية بذاتها تأخذ أحياناً دور الناقد والقارئ. وغالباً ما تعتمد الأصوات والحوار للتساؤل في أمور فنية وأخرى حياتية ووجدانية وتسحب البساط من تحت أقدام الساسة والمنظّرين لتتساءل في التاريخ والمفاهيم والأحداث. وهي وإن بدت في ظاهرها من ملامح “ما بعد الحداثة” في ظهورها الغربي، إلاّ أنها تسلك ذلك لتسفيه بَطر “ما بعد الحداثة” وتغنّيها بموت السرديات الكبرى. وعندما يكون الموضوع بجسامة الصمت المطبق الذي رافق «»»» وحوّلها إلى نقطة تعريف فحسب، نكبة، فإن خرق جدار الصمت وتملّي بعض ثنايا الخراب العظيم الذي طال الآلاف من الضحايا في “مقتلة” بعد أخرى وشمل القرى والأحياء وجغرافية بلاد شاملة ليس أمراً اعتيادياً. هنا تأتي أهمية الرواية الواعية بذاتها لأنها ستضع التاريخ أمام نفسه.

ولكاتب الرواية الواعية بذاتها أن يقول ما يريد متسللاً مرة وصريحاً مرة أخرى ليخبرنا عبر الصوت والنظرة والمقابلة بين الساكن الجديد والمالك السابق، المهاجر والمواطن الأصلي، بقصة أخرى طالها الصمت، وتواطأ عليه المجتمع الدولي وحتى المحلي، بينما أخرجه “المستوطن” من حساباته ضمن أسطورة وطن ما قبل ألفي عام، أرض الميعاد، فالرواية المغايرة “الواعية بذاتها” تحفر بين طيّات الصمت وجعجعة الخطاب البائر.
لم يغب المؤلف ولا ينبغي له أن يغيب في مثل هذه الكتابة “مصائر” مثلاً التي لا تعدو أن تكون رواية في داخل رواية، أو شراكة سردية بين الشخوص، بصفتهم كتابا أيضاً، أي مدونين لما يرون ويسمعون ويشهدون: وليد نازحاً محظوظاً ( في لندن) وجنين مقيمة تكتب هي الأخرى في مساءلة البقاء في الوطن، شأن بطل الشخصية الكاتبة جنين “باقي هناك” في حكايتها “فلسطيني تيس» ( ص ص «»»-»»»). وبهذا التقابل بين نازحٍ وباقٍ يُريد المدهون أن يتقصى خطابي النكبة، مهمشاً المحنة الكبرى، المقتلة في تعبير آدم في “أولاد الغيتو” عندما حلّت المجازر العظمى والدفن الجماعي للآلاف من الفلسطينيين. تستمد رواية “مصائر” أثرها كسردٍ واعٍ بذاته من ثنائيات التقابل وتداخلها لتقدم لنا مشهد الخراب كما يبلغه الخطاب المزدوج. مشهد الخراب يستدعي المزيد الذي عرفه وخبره الناجون من المجزرة-المقتلة. وبينما يحرصُ المستوطنون القادمون من أوروبا وبعض أنحاء البلاد المجاورة على بيع مأساتهم لحكومتهم (ص «»») لكسب المزيد من الامتيازات، يتشرد أهالي البلاد وتؤول “حقيقة فلسطين مدفونة تحت ركام من الظلم” (ص»»»). هناك إحالات طفيفة إلى رواية أهداف سويفIn the Eye of the Sun؛ ويَبقى الجانب الأهم في “مصائر” يتعلق بالجغرافيا الفلسطينية إزاء ما هي عليه الآن، لا من حيث ما تعكسه التغييرات من إبدالات سياسية-ثقافية-عرقية-دينية، ولكن أيضاً من حيث وضع تأريخ للجغرافية الملغاة (كسقوط عكا- «»- مايو، «»»»)، وسقوط (المجدل عسقلان، « نوفمبر- «»»»)، وهكذا نرى ما نرى من خلال شخوص مصنوعين سرداً وهم يتفرجون على منازلهم عند غيرهم ممن يشرح لهم بشكل مضحك ما ألفوه وعرفوه ملكاً لآبائهم وهويةً وعدةَ أداء وفعل، كالرحا مثلاً “تفرجنا على أنفسنا” (ص «»). عينُ النازح-المتفرج تنتمي إلى ماضٍ وتتواطأ صمتاً عن حاضر يطردهم ولا يتعامل معهم حتى كأنصاف مواطنين. وبين الماضي والحاضر تلتبس الهويات؛ وتبرر الرواية الواعية بذاتها ذلك ضمناً على أنه تحصيل حاصل (ص «»»). لا أدري لماذا جئ بغسالة (الشرف القبلي) إلى هذا الميدان بعدما بدت التساؤلات الأساس تدور حول هذا الالتباس، فهل بمقدور أحد في الماضي البقاء والصمود؟ ومواجهة أبشع أنواع البطش والتمييز؟ هل الهرب والنزوح هو ما تبقى (لكم)؟ هل أصبح الفلسطيني ضحية الضحية التي استيقظت على الدمار الذي طالها في أوروبا لتزرعه أينما حلّت في “أرض الميعاد”؟ لم تكن هذه معادلة “مصائر”، (ص «»») فالمأزق جرح ينزف، ومعه تنزف الذاكرة الباحثة عبثاً عن بديل، لكنها تعترف ضمناً للباقين في فلسطين بإرادة تبدو عبثاً و(تياسة) للنازحين (ص «»») أو ممن يفكرون بذلك تحت وطأة المعاملة وسوئها.
تعرض “مصائر” عبرَ أصواتها لواقع مفروض، لكنها لم ترتق إلى “المأساة”، مأساة “المقتلة” التي لم تصل إلى الآخرين، وبقيت أرشيفاً غائراً في عمق “منكوب”. ولهذا تجئ “أولاد الغيتو” متممة ومصححة، واضعة الأمور في “نصاب” ما يهدم جدران الصمت عبرَ مراوغات سردية تميزها كرواية واعية بذاتها (أي رواية مغايرة). وإذا كانت “مصائر”رتحيل على نص داخلي، أي رواية مزعومة، فإن النص التحتي يتشكل من كتابات آخرين كغسان كنفاني وأميل حبيبي، وجبرا إبراهيم جبرا، علاوة على المشاهدات والمرويات والمسموعات.
فهرس..سنان أنطون
لا أدري إن كانت المصادفة وحدها هي التي جمعت بين أستاذين في جامعة نيويورك ليعقدا مباراة في كتابة “الرواية المغايرة”، أو الواعية بذاتها، لكني وجدت أصداءً في العملين تخص “المخطوط” و”الذاكرة” والحياة والروي والتماهيات بين المؤلف وشخصيته الظل أو بديل المؤلف وصوته، كما هو حال نمير البغدادي في “فهرس» سنان أنطون. يستعيد نمير البغدادي سيرة ذاتية للمؤلف، دراسته في هارفرد، تعيينه في كلية دارتموث النخبوية، ثم في جامعة نيويورك. وهو كذلك أيضاً في التنويه بمشروعه السردي عن “المغيسل” الذي ظهر في روايته “يا مريم…” والتي قام بترجمتها إلى الإنكليزية بعنوان “مغسلجي”، أو “غاسل الجثامين” (ص ص»».»»). وهو المؤلف أيضاً عندما يحيل إلى الفلم الوثائقي البكر الذي أعده عن الاحتلال ودمار المكتبات (ص ص «»-»»). وهو كذلك في الإشارة إلى ذلك الأستاذ العراقي المحبوب صاحب الولع بالمخطوطات والنوادر، محمد باقر علوان (ص ص «»-»»). ويظهر المؤلف كثيراً في الاقتباسات الشعرية الأثيرة لديه عن أبي نواس، كما أكثر إلياس خوري من الأخذ عن أبي تمام ووضاح اليمن وآخرين. وإذا كان إلياس خوري قد اتخذ من “خربة خزعة” نصاً تحتياً لأرشيفه الذي يردم ثغرات روايته “باب الشمس»، فإن “فهرس» هي ترميم من نوع آخر. فهي أصداء سيرة ذاتية يريد المؤلف الخلاص منها ووضعها في “فهرس» ودود، شذراته واقتباساته وإحالاته، لا سيما نصوص التوحيدي الذائعة في الغربة والغريب وقصة حرقه لكتبه كما رواها في رسالة له بهذا الشأن. حضر النصّان في “فهرس» بتمامهما.

لم يكن بائع الفلافل آدم دنّون يتباعد كثيراً عن المؤلف، فهو أيضاً القارئ والناقد والكاتب الذي يماطل داعي الرواية ويقرر التساؤل في متنه السردي وفي النقد الدارج عن الكتابة والذاكرة وشعرية محمود درويش. وكذلك حال منير البغدادي. لكن هذا الأخير يستعيد السيرة الذاتية للمؤلف ويضعها عند تقاطعات لم تزل تبحث عن أجوبة نهائية. فأيهما يستحق الأولوية في سلم الاهتمامات، الكتابة أم الدرس والبحث الأكاديمي؟ وأين يقف المؤلف إزاء القضايا الشائكة في هذا العصر؟ وإذ يكون موضوع إلياس خوري الأثير هو عام «»»» والصمت الذي يحيطه، فإن موضوع سنان أنطون الأثير هو العراق الذي شغله في جميع رواياته وأشعاره، وهو في ذلك ابن العراق البار وأحد مثقفيه الشباب المبرزين. لكن “فهرس» رواية واعية بذاتها لأسباب أخرى غير التلاقي والافتراق في جامعة نيويورك ودروب منطقتها ومقاهيها وباراتها، وأهم هذه الأسباب ذلك التماهي المرسوم عن قصد بين بائع الكتب ودود عبدالكريم وبين نمير بغدادي بصفته “بديل” سنان أنطون سارداً بلسانه وصوته. فليس مشروع ودود لوضع فهرس اللحظات والدقائق وحده الذي يراد له أن يشكل إطار المؤلف (المرجعي- ص «»») “سألت نفسي… إنْ كان هوسي بودود وبمخطوطته يتحكم بأولوياتي ويحدد لي ما يثير انتباهي هنا في نيويورك”. هو الآخر يحتفظ “دائماً بقصاصات من الجرائد أو المجلات” (ص «»)، ليصاب “بعدوى الأرشفة”، ويقوم بتدوين كل شيء “كنت أُدوّن كل شيء (ص «»») وبوده منذ سن العاشرة لو “يقرأ الجميع ما أكتبه” (ص «»»). وبلغ التماهي مبلغاً حتى رأى ما بين الأحلام والكوابيس “أننا كنّا شخصاً واحداً. تجمعنا أنا واحدة” (ص «»»). ويضيف (ص «»») “أقلّب الدفتر وأكتشف أن كلماتي صارت تشبه كلمات ودود في كثير من المواضيع». أما ودود فقد خصه بملاحظة تقول “لا توجد نهايات حقيقية، كما لا توجد بدايات حقيقية. إنْ هي إلاّ حدود وهمية وإشارات وعلامات نضعها نحن لننظم ضياعنا في هذا الوجود العشوائي، نُلبسه زي المعنى لنغطي عريه” (ص «»»). أما النتيجة فهي “فهرس» على أساس أنها رواية عن ودود عبدالكريم، الكتبي في شارع المتنبي، الذي سيرحل في انفجار دمّر الأخضر واليابس في شارع المتنبي، المكتبات والكتب وباعتها “وخطرت لي فكرة كتابة رواية عن ودود وعن مشروعه. ويمكن أن يكون هناك تناص مع فهرسه واقتباس لمقاطع منه” (ص «»).
لم تكتمل حياة ودود عبدالكريم. كما أن رسالته وشذراته لا تشكل رواية بالمعنى المتعارف عليه قبل الموجة (ما بعد الحداثة). ولولا تداخله مع سيرة منير البغدادي لبدا ترقيعات متقطعة تصلح في نصوص شعرية فلا علاجه النفسي بعد ما حل بعائلته ولا تماهيه في هذا الأمر مع الكاتب (ص ص «»»-»»») يتيح للسرد أن يستجمع بعضه بصفة أو بأخرى. وإذا ما افترضنا “الرواية المغايرة” تأسيساً نصياً على سابق أو نص تحتي، كغربة أبي حيان التوحيدي أو حرقه كتبه مثلاً والتي جاءت بكاملها نصوصاً منقولة، لكان من المجدي عقد مقاربات أوسع بين حياة ودود وحاضره كتبياً إذ تبقى السيرة الشخصية للمؤلف السارد مهيمنة تهضم ما غيرها وتحتويه سرداً وكأنها تخشى غلبة الآخر الذي أفصحت عن تماه كلي به. وعندما نقرأ لودود ما يلي لا يتبين لنا كثيراً أنه يقدم حياة غنية تماماً “لا أخفيك سراً أنني شعرت بشيء من الزهو. فلطالما فكّرت أن حياتي، ما مضى وما تبقى منها، جديرة بأن تكون رواية رائعة، لا بل حتى فلماً سينمائياً مبهراً” (ص «»).
لكنه ينتهي إلى القول “نحن مخطوطات ومسودات كتب ولكن، لكي نكتمل ونقرأ، يجب أن نموت” (ص «»). ولو جرى تمكين القارئ من رؤية دواخل ودود والتمعن أكثر في تكوينه النفسي والمعرفي والحياتي معادلاً للسارد لبدت محمولات التصريح المذكور أكثر تحققاً داخل هذا “الفهرس». وكان لا بد أن ينتهي القارئ، كما ينتهي ودود، إلى “منذ سنوات وأنا أبحث عنّي فيّ ولا أعثر، بل أتبعثر وأتبعثر” (ص «»).
“فهرس» تقع في هذا “التبعثر” و”الترقيع». وتتسامى في لحظات أسلوبية عالية تتيحها دربة المؤلف وسعة اطلاعه على الموروث. ولو أن الناشر أطلق عليها تسمية “رواية غريبة”، أو “مغايرة”، أو ميتارواية لَسهُلَ الأمر على القارئ لمعرفة أنه إزاء تداخل نصيّ تلتقي فيه المشاهدات، كتلك التي تخص “المشرد النخبوي”( ص»»، «»») والرحلة إلى بغداد، والجولات في محيط نيويورك وداخلها، والقراءات والاقتباسات عن الكتاب الأثيرين كالتوحيدي وأبي نواس وآخرين.
“فهرس» هي في المحصلة سيرة ذاتية تهضم ما غيرها، كما يهضم صاحبها القراءات والمشاهدات ويصقلها بدراية أسلوبية متميزة تعززها “قفشاته” العامية وهو يسعى إلى أن يفصح عن “داء الفهرس» الذي سيجعله باحثاً ومنقباً ومؤرشفاً باستمرار، فلا يبدو “الفهرس» مكتملاً ولا ينبغي له والمؤلف في مهمته الشائكة تلك.
عطارد..محمد ربيع
يشكل إغراء “الرواية المغايرة” أو “الواعية بذاتها” دافعاً قوياً لتكراره بشكل أو بآخر. لكنه تنويع واحد تتفاوت فيه التطبيقات والأساليب. وما يصدق على “توالدات” الرواية المذكورة يمكن أن يلاحظ في تنويع آخر، ليس على البنية الفنية في رواية النص التحتي الذي يزيح غيره في النتيجة، ولكن في توالدات الشخوص داخل الماكنة الضاربة لأمن الدولة الوطنية في ظل الحروب والغزوات الصغرى، أي حروب الإنابة. فالقمع “الوطني” يولّد محترفين وقتلة ومرتزقة يحترفون المهنة دون تساؤلات في موضوع الحق والباطل، الصواب والخطأ. الاحتراف خطوة مهمة في “الارتزاق”، والمحترف يكرر نفسه ويتوالد عبر ماكنات القمع ليكون في النتيجة حلقة مهمة في “قيام الساعة”. ليس التوالد الأسلوبي هو المهم هنا وإنما التوالد بين الفواعل، فثمة تنويع آخر على “الولادة” السردية، ميدانها الفاعل الذي يحصر بصوته وتكوينه منذ أن تمعن في مشهد الدم وشهده كتقديم تتخذه الذاكرة تكويناً سيميائياً من الدم وفقدان الأمل. لكن الأهم في رواية محمد ربيع “عُطارد” هي أن شخصها القناص، ابن الشرطة منذ يناير «»»»، والقتل العشوائي للمتظاهرين، شخصها هذا هو ابن الماكنة التي لم تعد تسحرها الخطابات الرنانة و”المقاومة” بعدما احترفت القنص ورأته مزاملة اعتيادية تبرر المهارة الفنية للقناص. قلب محمد ربيع الخطاب المثالي للدولة القومية ووعوده الخلابة وتصريحاته المتواصلة عن “الجماهير”، ليأتي بما يمكن أن يؤول إليه “القمع»، أي قمع، كتوليد للاحتراف، وتجريد للمرء من “الإنسانية” ومعايير العدل والأحقية. انقلب سحر الخطاب منذ أن تجسد في قنص عشوائي. وما الأفواج المدربة في هذا الميدان إلا قطيع، ماكنة مدربة يأتيها “Drone” وآخر برسالة متغيرة لتحويل الأهداف، توسيعها، تحديدها، أو تركها مطلقة ليأتي “القنص” مجازاً للقتل العشوائي. لم يجرد محمد ربيع ذلك الكابوس من “مثالية” المقاومة الوطنية للاحتلال الافتراضي لجمهورية فرسان مالطا، والمرتزقة المدربين على الاحتلال بمهارة المرتزق الذي لا أرض له غير مهماته في حروب الإنابة الدولية الجارية اليوم. هكذا يأتينا محمد ربيع بـ”بطله” المفترض الضابط السابق، أحمد عُطارد، الذي يتلبس من الكوكب جحيمه كلما يسرت له الفرصة للتصرف بحرية في “القنص”. يصف عُطارد دوره ودور صحبه بأنهم “ملائكة موت”، يواجهون المحتل الآن، لكنهم لا يتورعون عن القتل العشوائي (ص «»). كل ذلك يتم على أساس توليد الفوضى أولاً، وإتاحة الفرصة للعصابات والقتلة لاستكمال المهمة، تمهيداً لتمرد، لم يتحقق بعد. تماهى خطاب أحمد عُطارد بخطاب القوى الكبرى التي رأت “الفوضى الخلاقة” أساسية للبلدان لتبني نفسها من الحطام.

رواية محمد ربيع “عُطارد” تضع “التوليد” القمعي في دورته، لأن الماكنة تخلق “فرانكنشتاين” بعدة نسخ، وهي نسخ لا تتفاوت كثيراً إلا من حيث الانهماك الكلي في “القنص” وسرعة الأداء وطيشه. لكن قوة هذه الرواية لا تكمن في موضوعها، أي تخيلها من داخل ماكنة القمع، حيث تقوم قيامة الدنيا. تكمن قوتها في بلوغ داخل الشخصية والتي لا تبدو غريبة. فأحمد عُطارد لا يبدو غريباً في وضع قائم، كسقوط الماكنة ومعها الدولة في أيدي المرتزقة الغرباء. إنه بانهماكه ودقته وولعه بأسلحة القنص واعتلائه أعلى برج القاهرة حيث مقره ومجموعته بدا عميقاً مكتملاً شخصاً. وزاد صوته متكلماً وصراحته في التعامل مع حرفته من هذا الاكتمال والمصداقية. كما زادت تفاصيل يناير «»»» وما تلاها من تصفيات مشابهة للخصوم السياسيين وغيرهم من هذه المصداقية. هنا، تجاور الرواية أنماط “الرواية العلمية” الجيدة، لكنها تتجاوز ذلك عندما تضع كل أمر في مكانه وكأنه بمنتهى الواقعية اللازمة لتصديقه. والأهم من ذلك أنها تشتغل ضمن إطار الاحتمالات التي تفتحها ماكنات القمع الهوجاء وتربيتها للجريمة داخل أجهزتها تحت عذر “الأمن” و”الاحتراز» والمواجهة و”العدو الخارجي”. وتظهر تصريحات المسؤولين لضباطهم الآن عند استرجاع يناير «»»» وأغسطس «»»»، ومعها تكهنات بمثيلات في المستقبل، بمثابة الخطاب الرسمي الداخلي الذي يبرر أقصى العنف ويسوقه بمباركة الأجهزة القضائية و “الشعب والنيابة” (ص «»).
ويمنح محمد ربيع قنّاصه ازدواجية اختيارية، فهو الذي يختار قناع بوذا، لكنه يعيد تحويله إلى قناع في الجحيم حيث تختلط الأدوار (ص «»)، ويأخذ من الإرث المسرحي القديم ما يريد ومن الإغريق والرومان ما يشتهي ليبصر نفسه “إلهاً إغريقياً يقتل من يشاء” (ص «»-»»). أما فعل الكربون فهو مرحلي، سبات وظلام، لأن اليقظة تستقدم القنص بصوره المختلفة. والفريد في رواية “عُطارد” أن أحمد عطارد يمنح صوته تلقائية استثنائية تمر على “رجل الزبالة” (ص «»»/»»») وعلى فريدة وأنسال وزهرة التي تفقد ملامح وجهها كأنها صور اعتيادية ما دام الحاضر هو الجحيم. وإذا كانت “السخرية” تلامس هذا السرد من بعيد، فإنها تتوالد هي الأخرى في ذهن القارئ، أما عُطارد فيدرج كل أمر من أحاديث “الجلاء” و”الاحتلال” ومن ثم تعيينات رؤوس المقاومة (ص «»») في الوزارة الجديدة وكذلك القتل العشوائي “إرسال الناس إلى الجنة” (ص «»») باعتيادية. تتصاعد تلك السخرية وتهجر الهامش نحو المتن في مقطع من السيرة الذاتية لأحمد عطارد عندما تصل هذا المفصل أي الجلاء، ومن ثم “الحكم الوطني”، والجنرال المصري المجهول الذي تأتيه الرتب تباعاً فيكون رئيساً يقبله ويصفق له الجميع، حتى وإن بدا قصيراً (ص «»»). تكون الطفلة زهرة، المهجورة التي راح أهلها بين ضحايا الضرب العشوائي هي الرمز للمشهد الجديد، فانغلاق حواسها كاملة (ص «»») له فعل الكربون. كلاهما يحيلان إلى ظلام وبلادة حواس حيث المتع الزائفة (ص «»»). أما التساؤلات في الحاضر والمستقبل والدولة بعد مبارك (ص ص «»»-»»») فتنتهي بقدوم فرسان مالطا الذين ينسحبون عند الضرورة لوضع المراد في نصابه.
سيرة أحمد عطارد الذاتية لا يمكن أن تكتمل، فابتداؤها عند مشاهد القصابين وانخراطها في القتل والقنص و”المقاومة” يعني وضع صاحبها وأمثاله في دوامة ماكنة الموت. يختفي القانون ومعه مفهوم الدولة الطوباوية، ويكون المشهد محض تنويعات على الجحيم الذي حلّ الآن.
هنالك دربة ودراية معرفية في هذه الرواية، وفي تنويعها على هذا “النمط” من البطولة أي فرانكنشتاين “الدولة” ؛ وهي تضيف بعداً مهما لما بدأه العراقي أحمد سعداوي في “فرنكشتاين في بغداد”. إذ لم يأت المؤلف إلى الكتابة بدون عدة معرفية لها ميزة الوعي السياسي، والبحث التدقيقي في “القنص” والسلاح وجغرافية القاهرة والفئات الاجتماعية المختلفة التي تتساوى في الجحيم الحالي أمام فوهات الأسلحة التي يتقنها القناص ويخبرها آخرون. وعندما تشيع “المعارك الجماعية والفردية” بين هؤلاء (ص ص «»» و»»») يكون الجحيم قد أطبق تماماً مادام هناك سدنة وراء ذلك يظهرون بأقنعة مختلفة (ص «»».»»».»»»)؛ بينما ظهر فيها قناع بوذا محض صورة مفارقةٍ ساخرة تبطن ما تُبطن. هذه رواية نقلت السرد العربي إلى المواجهة، مواجهة الجحيم الذي لا يتورع صحبه عن وضع لمسات المثالية عليه.
خان الشابندر..محمد حياوي
إذا كانت ثمة إحالة ما في رواية محمد حيّاوي الرابعة “خان الشابندر” فإنها تحيل إلى رواية الاحتلال التي تميز الكتابة العراقية منذ «»»»، لكنها تستذكر ما كتبه عبدالستار الناصر في قصة قصيرة ذكية تلتقط أشباح ضحايا الحرب مع إيران. إذ تعنى هذه الرواية بالأشباح، الأشباح الذين يملأون الفضاء الخرب والأنقاض في منطقة الميدان، فالشوارع والمنازل المتآكلة استحالت إلى ركام يلتقط الحي أنفاسه بينه على مضض بينما تنزوي بائعات الهوى بين هذا الخراب في غرف لم تزل قابلة للسكنى. لا يجول في هذا الخراب ويصول غير “الميليشيات” المتقاتلة على حصة ما داخل هذا الخراب. لكنها، أي “خان الشابندر” تأتي دون تخطيط كاستجابة لما كتبه محمد ربيع في “عُطارد”، فهي النتيجة الحتمية لشغلة القنص، تلك التي تمارسها الميليشيات بعدما نزع الاحتلال الغطاء عن الدولة، غطاءها الأمين وتركها ساحة يصول فيها ويجول من يريد. وعلى الرغم من اختلاط اسم الشبح الأول “سالم” و”حاكم”،(ص «».»») في الإشارة إلى القاص حاكم الذي هرب من الجيش وأعدم سنة «»»»، فإنه واحد من بين الآلاف الذين يراهم السارد العائد لتوه صحفياً عراقياً مقيماً في الخارج يبحث عن علامات ما شدته إلى بغداد القديمة “صرت أرى أشباحاً يمرّون، وما فتئت أصوات خفق الأجنحة الكبيرة تتردد في أرجاء المنزل.. المنزل الآيل للسقوط” (ص «»). وشأن صاحب السرد في رواية علي بدر “حارس التبغ”، لا بد له من “نيفين” يشتغل معها في جريدة، أو وكالة صحفية ولا بد من جولة بغدادية، تتخذ من الطفلة بائعة الكعك زينب دليلاً لاقتفاء التضاريس المندثرة لبغداد ” من الصدرية حيث البيوت الفقيرة مروراً بمنطقة الفضل ثم الشورجة وصولاً إلى شارع المتنبي” (ص «»).

تلجأ رواية “خان الشابندر” إلى تصعيد توترها من خلال التقابل بين نفوس تتآكل هي الأخرى كالمنازل والشوارع وبين الأشباح، أما ساحة الحركة فهي المهددة دائماً والتي تضيف إلى تجربة القدوم إلى هناك بعداً آخر هو بُعد الخطر؛ إذ لم يعد الأشباح يهددون أحداً. إنهم يطلبون الرحمة الآن. فهم ليسوا متوالدين عن بطل أحمد سعداوي، أي منتوج هادي العتاك، فرنكشتاين. لآ. الخطر يأتي من “لوثة” الدم التي تصبح حرفة لها منظماتها وقراراتها حسب ما أراد له الاحتلال القابع منعزلاً يتفرج على المشهد بارتياح. هذا التقابل من جانب وبروز العصابات من جانب هو سمة “خان الشابندر”. أما أولئك الذين يبحثون عن حياة ما، فهم ينازعون في رمقهم الأخير شأن المصري المقيم “أبو حسنين” الذي ينهمك بإصلاح الفوانيس والمدافئ التي عادت لتطل من جديد بعد أكثر من أربعين سنة من الغياب “فالمدينة تملأها الملائكة وأرواحهم الهائمة يجلبها النور” (ص «»). وعندما تغيب الكهرباء ، يكون هذا الكلام مفهوماً.
ويجعل المؤلف من شخصياته الأخرى ذات صدارة ما وهو يمنح “لوصة” (أي إخلاص) و”هند” و”أم صبيح” و”ضوية” مساحة سردية واسعة لتحكي الواحدة منهن قصتها من العذاب والشقاء واحتراف الدعارة باباً وحيداً للحياة تتحقق فيه ذواتهن بشكل أو بآخر. لكن نجاح “خان الشابندر” يقوم على الشخصية الشبحية أولاً. وإذا كان مشهد الدمار الذي طال بيت المومسات عَلق منفذ الهروب الوحيد داخل حائط خرب مثيراً تفصيلاً حيث وضع فيه الروائي الغرافيكي طاقته التصويرية والتخطيطية ( ص ص «»-»»)، فإن الشخصية الشبحية التي يمنحها صاحب الغرافيك شكلاً هي شخصية “مجر عمارة” التي تتآخى مع “هادي العتاك” في رواية أحمد سعداوي. هنا يظهر السارد باسمه “علي” ومهنته “صحفياً”، لاستدراج مجر عمارة للكلام (ص «») ” كانت طريقته الباردة في ردّ التحية لا تشجع البتة على المضيّ في الحوار معه”.
يقول في وصفه “كان منظره غريباً بعض الشيء، إذ عصب رأسه بعصابة حمراء مرقطة على طريقة القراصنة” (ص «»). تاجر العتيق هذا يحاكي “هادي العتاك” عند أحمد سعداوي، لكنه الآن شبح يتلبس شكلاً يتواصل معه الآخرون. مجر عمارة هو الوسيط الوحيد في عالم أشباح يردّ عليهم التحية بثقة العارف بهم (ص «»). عالمه العتيق هو وحده الحي في مشهد الخراب.
تستكمل رواية “خان الشابندر” حلقات الخراب الذي يسعى الروائيون والشعراء إلى بلوغه بطريقة أو بأخرى، وهو من خلال عينه المنظمة للأشكال والأماكن يمنح هذا الخراب وجوداً تنزوي أمامه الموجودات الأخرى وبضمنها ساكنه البشري. فعندما يكون “الدمار” بهذه السعة و”الموت” ضارباً بلا رحمة. لم يعد رسم “الأشخاص” كفواعل سردية ممكناً أو محتملاً. كما أن حركة السرد توتره، تسرقها عاصفة القصف الهمجي التي تعلو على كل حركة أخرى. ولم يتبق من “التجربة” غير أن يخوضها السارد ما بين الموت والحياة، متسائلاً هو الآخر عما إذا كان قد رأى ما رأى من خراب، وبضمنه ذلك الضوء الذي يشير إليه “أبو حسنين” ويفترض رؤيته مع مجر عمارة فوق سطح مفترض حيث يشعل مجر “كانونه” بجمره ووهجه، بينما راح مجر عمارة يهمس بلغة “ملائكة الضياء” وهي “تُسبّح لملك النور” (ص «»»). لم ير الصحفي أيّ ملائكة “لم أر سوى الظلام المطبق على سطوح الخرائب المُهدَّمة” (ص «»»). كانت هذه شراكة محمد حياوي في رواية الاحتلال، حيث تنتهي إلى ما يقوله مجر “الحيرة خفق الروح الملتاعة لتعْرف… لكن الخوف قلة إيمان” (ص «»»). هذه الدورة التي تمر بها السرديات بتنويعاتها وتوالداتها تتسع كل يوم والكتّاب يسعون إلى إسقاط شكل ما على ما لا يتخيله عقل من قبل عندما ظنوا أن “الدولة الحديثة” تمضي قدماً ضرورةً، وما العثرات إلاّ محض محطات في التجربة. أما البعد الآخر لغياب العقل فلا يجد غير الخراب تمثيلاً، وهو التمثيل الذي تختفي عنده البطولات التي ميزت الرواية “ملحمة بورجوازية” من قبل.