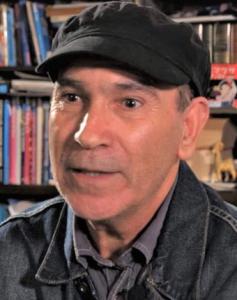العلمانية أو الطوفان

وساهمت الأطروحة الثانية في عودة التدين السياسي الجماهيري عموما والمد الأصولي الإخواني خصوصا والذي ركب بمكر موجة العودة العفوية لممارسة الشعائر الإسلامية وتغذّى منها أحسن تغذية خلال العشريتين الأخيرتين، فهل انتظر العرب الاستعمار كي يدخلهم في مرحلة الانحطاط؟
لقد كانوا مقيمين ومستقرين في أزمة حضارية منذ القرن الخامس عشر، بل ويجزم المؤرخون أن الحضارة العربية الإسلامية قد توقفت عن الإبداع مع حلول القرن الثاني عشر. فهل من المعقول أن نتمادى في رد التخلف الثقافي والعلمي والاقتصادي إلى الاستعمار أو مؤامرة اليهود والنصارى؟ ألا يسبق الانحطاط الاستعمار دائما؟ ألم تكن معظم المجتمعات العربية في حالة يرثى لها من الوهن في بداية القرن التاسع عشر؟
كان من الصعب على تلك المجتمعات/القبائل مقاومة أطماع جيرانها الذين كانوا في أوج قوتهم الاقتصادية والعلمية والثقافية. لقد استعمر العالم العربي لأنه كان في انحطاط، فالاستعمار نتيجة وليس سببا. وحتى وإن ساهمت الحركة الاستعمارية في إدامة التخلف وترسيخه، فهي ليست مصدرا له بأيّ حال من الأحوال.
تحدث المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي عن “القابلية للاستعمار” وردها إلى نقص الوازع الديني بدل ردها إلى سببها الحقيقي: هيمنة الفكر الديني المتزمت.
أما جمود ما بعد الاستقلالات فيعود أساسا إلى ندرة سياسيين من قامة الحبيب بورقيبة في تونس، الرجل الوحيد في العالم العربي الذي كانت له الشجاعة في مواجهة الأسباب الحقيقية لتأخر بلاده عن أوروبا. لقد ثار على البنى الاجتماعية والسياسية الرثة التي سهلت مجيء الاستعمار. وبدأ بعدم نسيان الأهم وهو الاشتباك الجدي والعقلاني مع الأصولية وقطع الطريق أمام الإخوان المسلمين.
تنشر الكثير من البيانات والمقالات والكتب لتندد بالاعتداءات الوحشية التي يذهب ضحيتها عدد من المواطنين العرب بسبب ديانتهم المسيحية. وإن كان واجبا تثمين كل مبادرة تندّد بالعنف ضد البشر مهما كانت التبريرات وفي أيّ زمان أو مكان، إلا أن التنديد المناسباتي غير كاف ما دامت المجتمعات العربية (ثقافة وسياسة) لا تعترف بالتنوع الديني والفلسفي. تكفي إطلالة سريعة على الدساتير في هذه البلدان ليعرف المرء أن كلها تعتمد الشريعة الإسلامية كأساس للتشريع وتفرض الإسلام كدين وحيد للدولة. وبالتالي لا تعترف بمواطنة لا المسيحي ولا اليهودي ولا الملحد.
تقصي هذه اللامساواة المُدسترة اللامسلمين وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية وذلك يعرّضهم لمصاعب كثيرة تفتح الباب في النهاية واسعا أمام احتقارهم أولا والاعتداء الوحشي عليهم ثانيا.
ما هو واجب المثقف أمام هذا التمييز الرسمي؟ لا ينتظر الإنسان العربي السوي -الذي لم تلوث عقله الأساطير الدينية والحلول الوهمية- من المثقفين التنديد بما يقع وإنما يطالبهم بنقد وتفكيك المنظومة القانونية المعتمدة أساسا على الشريعة الإسلامية والتي تؤسس للتمييز والتحرش الديني بطريقة مضمرة وصريحة. ما جدوى أن يرفض هؤلاء أفعالا لا يملك أغلبهم الشجاعة على رفض الجهاز الأيديولوجي الذي يحرّض عليها ويعطيها الشرعية؟ ألا يعتبر الإسلام المسيحيين واليهود أهل ذمة؟ ألا تظل بهذا فكرة التمييز القاتلة حاضرة في النص المقدس وجاهزة للاستدعاء وقت الحاجة؟ فلا حل لهذه المعضلة سوى العلمانية أي فصل الدين تماما عن الشأن السياسي ويعني ذلك إبعاد الشريعة تماما من مجال التشريع، وعدم تدريس الحقد وتجريم التكفير.. الخ.
فهل هو مثقف من لا يؤمن بالعلمانية؟ وما نفعه أصلا في مرحلة تعاظم فيها هجوم دعاة الدولة اللاهوتية؟
آن الأوان للتوقف عن الجري وراء محاولة إصلاح ذات البين بين الحداثة والأصالة، بين النقل والعقل، بين الدين والسياسة.. حان وقت إنهاء التوسط بين أطراف لا وسيط بينها. حان الوقت لتحريك البحر الجامد فينا كما كان يقول كافكا. لا يوجد منهج يناسب العصر غير منهج التوأمين: الديمقراطية واللائكية. إن الحداثة اعتراف بتطلعات الأفراد المتناقضة
ولئن كان معظم الكتّاب يدعون العقلانية وينتقدون الإسلام السياسي فإن أغلبهم يهادن عصابة حماس وحزب الله وطالبان! كيف نستغرب هذا التخلف المدقع في وقت لا تخلو مكتبة في العالم العربي من كتب تنتقد النصارى وتصف دينهم بالمحرّف وتدعو صراحة إلى أسلمتهم.. وتفرض دراسة الإسلام على جميع الطلبة في المدارس بصرف النظر عمّا إذا كانوا مسلمين أم لا.. ففي شبه البرلمانات العربية قوى دينية رجعية لا تملّ ولا تكلّ من المطالبة بتطبيق الشريعة كاملة ضاربة عرض الحائط بأدنى حقوق المواطنين غير المؤمنين بالشريعة. كيف يسمح للمسلمين العمل الدعوي الذي يهدف إلى أسلمة المسيحيين، وفي المقابل يمنع على المسيحيين ليس حقّ الهداية إلى طريق عيسى بن مريم، بل حتى إظهار إيمانهم بالتثليث إذ لا تقرع أجراس الكنائس خوفا من أن تشكّل استفزازا للمسلمين في ديارهم!
كيف يمكن أن يعيش إنسان غير مسلم في طمأنينة بين أناس ما زالوا يعلّمون أبناءهم ما نقل أبوهريرة عن الرسول “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دماءه وماله..” (صحيح البخاري 2983)؟
كيف يستتبّ الأمن الاجتماعي ولا تكاد تمرّ صلاة جمعة أو مناسبة دينية دون أن يسمع مرتادو المساجد خطبا نارية مناوئة للمسيحيين واليهود وغير المؤمنين بل للعالم أجمع؟ ألا يتعلّم الناس معاداة العقائد الأخرى في مساجد الحكومة ومدارسها وإذاعاتها وفضائياتها؟
التبجّح بالتسامح وبالشريعة السمحاء شيء والواقع الذي يعيشه غير المسلمين في أرض الإسلام شيء آخر إذ لا أحد يستطيع اليوم ستر الإقصاء الذي يتعرض له أتباع السيد عيسى بن مريم في كثير من الدول التي تنتهج الطريقة المحمدية. لم يبق للمسيحيين في الأغلب الأعم سوى خيارين لا ثالث لهما: قبول الذمة السرية صاغرين أو الهجرة خارج الديار مضطرين. “قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ممن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون” (سورة التوبة الآية 29) هكذا تقول كتب التربية الدينية!
فما هو موقف المثقفين من كل ذلك؟
أمام هذا الوضع الغريب عن العالم المعاصر لا حلّ لتحقيق حرية الإنسان سوى الدولة العلمانية التي تضمن الحياد ولا تفرض الإسلام بالقوّة كما هو الحال في كل الدول العربية اليوم. ولا مهمة حقيقية للمثقف العربي في الوقت الراهن غير المطالبة بإلغاء مادة “دين الدولة الإسلام” من شبه دساتير البلاد العربية، لأنها بكل بساطة مادة عنصرية ومضادة لحقوق الإنسان وتمييز رسمي على أساس الدين، لا يجني منها العرب سوى العنف والتخلف والحرب. هناك ما يشبه العجز الداخلي المزمن في مقاربة الحرية، فبدل أن يحاول المثقفون التحرر من هيمنة الفكر الديني لا يهدرون وقت شعوبهم سوى في محاولة عقلنة الإيمان. فلا يمكن بناء مستقبل ما دون أن يتحرر الفرد من كل الطقوس التي لم تعد لها في واقع الحياة أيّ منفعة أو دور في انفتاح الشخصية واتزانها.
لقد آن الأوان للتوقف عن الجري وراء محاولة إصلاح ذات البين بين الحداثة والأصالة، بين النقل والعقل، بين الدين والسياسة.. حان وقت إنهاء التوسط بين أطراف لا وسيط بينها. حان الوقت لتحريك البحر الجامد فينا كما كان يقول كافكا. لا يوجد منهج يناسب العصر غير منهج التوأمين: الديمقراطية واللائكية.
إن الحداثة اعتراف بتطلعات الأفراد المتناقضة والعلمانية تربية لممارسة الحرية والاعتراف بحرية الغير. وسيأتي حتما ذلك اليوم الذي يستجيب فيه الوعي العربي لتغيرات العالم وانقلاباته ويتحرر من معتقل الثيولوجيا ووهم قدسية اللغة العربية، فحيثما عظم الخطب، يكتب الشاعر الألماني هولدرلين، عظم ما ينجي منه.
لقد أصبح تغيير طريقة التغيير ملحّا، فلكي تذهب بعيدا يجب عليك أن تدخر قوى راحلتك، يقول الفرسان في أمثالهم، ويحتم الوضع هنا تغيير الراحلة تماما إذ يمكن التظلل تحت الأشجار الميتة ولكن لا نستطيع أن نجعلها تحمل براعم المستقبل.