المسكوتُ عَنهُ في تُراثِنَا الحِسيِّ

فالتوريةُ المستخدَمَةُ في «سُتِر» تجعلنا أمام قضية جوهرية وهي: من الذي سَتَر – خَبَّأَ هذا الفن عند العرب عن القراء العرب اليوم؟ من الذي يجعل ذلك الجزء من التراث الذي يتولى كثيرونَ مبدأ الدفاع عنه ليلَ نَهارَ، مطموساً فيما يخصُّ الجنس والعشق؟ ومن ناحية أخرى يتناص مع أقدم وأشهر كتاب بشري عن العلاقة الحميمة في العالم وهو كتاب “الكاماسوترا” الهندي، وكأن وليد رحمي يقول بينما الحضارات الأخرى تتفنن في إظهار وإيضاح فن العشق وفن التواصل بين الرجل والمرأة عاطفياً، فعلى النقيض يقوم بعض المثقفين العرب بطمس التراث الحسيِّ وكأن التراثَ العربيَّ لا يعرفُ شَخصياتٍ مثل حوثرة الذي كان يُضرب به المثل في شدة النكاح فيقال “أنكَحُ مِن حَوثَرَة”، وكان يتعلل بشرود بعيره متصيداً النساء، فيسأله الرسول – صلى الله عليه وسلم- “ما فعل بعيرك الشرود؟ فقال: أما منذ قيده الإسلام فلا”، كما ذهب جواد علي في كتابه “تاريخ العرب قبل الإسلام”، والتورية هنا واضحة في السؤال عن البعير، وعلى غراره “ألغز الأيادي” الذي شاع ذكره في المخيال الحسي العربي القديم، حسب الأمثلة العربية.
ويفيض التراث العربي بالكثير والكثير من الكتب المتخصصة في الحديث عن العلاقة الحميمة، منها: “نواضر الأيك”، و”الروض العاطر”، و”رشف الزلال”، و”ديوان أبي حكيمة”، و”نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب”، و”رجوع الشيخ إلى صباه”، وغيرها من الكتب المتخصصة في الحديث فقط عن فنون المعاشرة الجنسية وأصناف الرجال وأصناف النساء، والمحبب من ذلك وتلك، وتفاصيل الأعضاء الجنسية، وأحيانا الحديث عن وصفات أو مركبات أو مقويات، هذا فضلاً عن الحكايات المتناثرة عن وقائع عديدة نجدها في كتاب “الأغاني”، وفي “حكايات ألف ليلة وليلة”، وغيرها.
لكن “الكاماسوترا” الهندي ليس مجردَ كتابٍ عن الحب والعلاقة الحميمة، إنَّهُ أشبه بكتابٍ مقدَّسِ يحوِّلُ الأمرَ إلى ناحية روحية من العبادة، فبقدر ما في “كتاب المتعة” -وهي الترجمة الحرفية لمعنى “الكاماسوترا” الهندي- من فنياتٍ تتعلق بعمليات الجماع والوطء والتواصل الجسدي المباشر، ومن أوضاع جنسية وحديث وتقسيمات عن فنون المداعبة والملاعبة، وفي أحيان أخرى عزائِمُ وطلاسِمُ وحِيلٌ للحصولِ على المتعة من أوجهٍ كثيرة، إلا أن الهدف منه هو السمو فوق هذه المتعة الجسدية الخاصة إلى التوحد مع الكون، متعة تنطلق من المتعة الجسدية ثم تسمو بصاحبها إلى ما وراء الطبيعة، ومن ثم فإنه بعيداً عن تخصصيته في تقنيات الجماع وفنيات الامتاع في “الكاماسوترا” الهندي، فإنَّ الرؤيةَ الفلسفية هي المؤطرة والمحركة للدافع الجنسي لدى من يعتنقون المذهب الفيدي.
في الجانب العربي، قد نتعجبُ من مِقدارِ الحرية التي كان يكتب بها السابقونَ في مثل القضايا الجنسية، ولعلماء ارتبط اسمهم بالفقه والعقيدة مؤلفاتٌ عدة تتحدث – دونِ مَوارَبَة- عن الفعل الجنسيِّ، وعن الاستمتاعِ المباشر بين الرجل والمرأة، صحيح أن بعض هذه الكتب يُحدِّدُ هذِه المتعة في حالة الزواج المتعارف عليها، لكنها لا تخلو من عروج في بعض الأحيان لذكر بعض الحالات التي قد لا نقبلها أخلاقياً، ولنأخذ مثال ما نقله الغزالي عن الإمام الجنيد، إذ يقول “وكان الجنيد يقول: أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت، فالزوجة على التحقيق قوت وسبب لطهارة القلب”، فكيف وصل الحال بنا اليوم إلى قدر من الفزع عند الحديث عن مثل ذلك الأمر؟
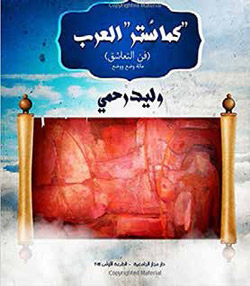
من هذه الرؤية ينطلق المؤلِّفُ فيقولُ في مُقدِّمَةِ كِتابِهِ “ما سُتر كثيرٌ، وما يُستر في كل أوانٍ أكثر. فهل آن الأوان لنعلن عن فرحتنا بأننا عاشقان جمعهما الحب والرغبةُ المشتركةُ في الاحتفاء بالحياة؟ وأن نترشف من كؤوسها الواعدة بالحب والمتعة والسعادة”، ومن منطلق المحبة، ورغم معرفته بأنهُ يقتحمُ غِمارَ المسكوتِ عنه، وغير المتقبل الحديثُ فيهِ من وجهةِ نَظرِ الكثيرين من قرَّاءِ ومثقفي العربية اليوم، إلا أنه يؤكد رغبته في الخوض وكشف السر عن هذا المخبأ والمخفي، يقول “إن ما أقدمه هنا أعتبره شرفاً رفيعاً لا يوازيه إلا شرف ما ستحرزه الأخريات لدى إعادة إنتاجه، وما سيحرزه الآخرون والأخريات من قراءةٍ هدفُها الاستمتاعُ والرغبةُ في تبادل المعرفة والخبرة، وإعلاء شأن الإنسان روحاً وجسداً وفضيلة”.
يفتتحُ المؤلِّفُ كتابِهُ بقصيدة محمود درويش “درس من كاما سوطرا”، والتي تحمل عذوبةً مفرطةً في رهافة تناول العلاقةِ الحميمةِ بينَ عَاشِقَيْن، فعِندَمَا تلتقي تعاليمُ “الكاما سوترا” التي تنصُّ على التدرُّجِ من أجلِ الحصولِ على المتعة، مع رقة وعذوبة كلمات درويش نحصل على أداءٍ راقٍ من الشعورِ والمعنى، يقول:
«ومُسَّ على مَهلٍ يَدَهَا عِندَما تَضعُ الكأسَ فَوقَ الرُّخامِ
كأنَّكَ تَحمِلُ عَنهَا النَّدى
وانتَظِرهَا».
بهذا المعنى الذي يحملُ طيَّاتِ الرِّقَةِ والعذوبةِ والتمهُّلِ في مُطارحةِ الحب يبتدئُ الكاتبُ عالمه، ليردف بعد ذلك بكلمةٍ لابنِ عربي عن السموِّ من خِلالِ العَلاقةِ الجسديةِ وكيف أنها تحفزُ الرَّوحَ، وكُنتُ أتمنَّى أن يتتبع رحمي هذا المبحث بشكلٍ أكثرَ إسهاباً، فمفهومُ السموِّ الصوفيِّ وعلاقةُ الجنسِ بهِ يحتاجُ إلى بحثٍ آخر معمَّقٍ وحده، فبينَمَا يَدعو المسلك الصوفي إلى التجرد والتقشف بما يُقارِبُ مفهوم الرهبانية والزهد الكامل في الحياة، إلا أنه يتخذُ مأخذاً مغايراً في حالة التواصل بين الرجل والمرأة، فهو يَدعو للإكثار، بل حتى في الميراثِ الأكثر تشدداً، فعند ابن القيِّم الجوزية: “وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً: ألَّا يَدَعَ المشي، فإن احتَاجَ إليهِ يوماً قدرَ عليهِ، وينبغي ألَّا يدع الأكل، فإن أمعاءَهُ تضيق، وينبغي ألَّا يدع الجماع، فإن البئر إذا لم تَنزَح ذَهَبَ مَاؤهَا»، فبخلاف المتعارَفِ عليه من حالة الزهد في المأكل والمشرب والممتلكات وعوارض الدنيا، نجدُ الترغيبَ في الإكثارِ مِن الجماع، والتحذيرَ من تركه بالكلية حتى لا تضعف الشهوة والقوة الجنسية، وهذا يدفعنا إلى التساؤلِ “من أين إذن جاءَ اقتِرانُ الجِنسِ بالكَبتِ في الوعي السوسيولوجي للمجتمعاتِ العربية وبنيتها الثقافية؟”، سؤالٌ يستحِقُّ التتبُّعَ والبَحثَ التاريخيَّ في تصوري.
أما فيمَا يخصُّ رِحلَتَنَا مع كتابِ وليد رحمي فإننا نُسجِّلُ رِقَّةَ الكلمات التي يعبِّرُ بِهَا عن مبتغاه، وعن قيامِهِ بأمرين أساسيينِ في بناءِ عملِهِ، الأوَّلُ استلهامُ روحِ “الكاماسوترا” التي تؤكِّدُ مَبدَأَ التدرجَ في اللَّذةِ حتى يصلَ الطرفانِ إلى مُبتغاهِما، وإن كانت قمَّةُ السعادةِ تَتحقَّقُ في حَالةِ وصولِ الطرفين لذروتهِمَا معاً، فإنه في ظلِ غَلبةِ العنف الذكوري في تعامل الرجالِ مع النساء في العالم العربيِّ للكثيرِ من الأسباب المتعلقة بالتقاليد والتراث ومستوى التعليم وسيادَة الخرافة وتكريس الرجعية، فإنَّ التأكيدَ على التدرُّجِ في اللذة، وعن مقدمات العشق، وكيف تسحر حبيبتك بالكلمات كان له تناولٌ مسهَبٌ عنده، فنجده يلتقطُ من هُنا وهُناك، كالتفاتهِ إلى أبي القاسم الشابي في قصيدته الشهيرة “صلواتٌ في هيكلِ الحُبِ”: “يا ابنةَ النورِ، إنني أنا وَحدي مَن رَأى فِيكِ رَوعـَـةَ المعبودِ، فدَعيني أعيشُ في ظِلِّكِ العَـذبِ وفِي قربِ حُسنِكِ المشـهـودِ” مع توسُّعٍ من تَناصَّاتٍ كثيرةٍ تتداخلُ معاً، ترسم لنا صورة من الوجد والغرام والهيام، الذي قد يصل بنا إلى مفهومِ العذرية في الحب، وكأن جوهر ما يريد تأكيده هو سحر الحبيبة بإظهارِ عدم رغبته في الفِعلِ الجنسي حتى تتأكد من محبته لها في ذاتِها لذاتِها المُجرَّدة، والحقيقةُ أيضاً أنَّ من النقاط التي تحتاج إلى بحث في المفهوم العربي “رؤية المرأة العربية للجنس″، وكيف تتلقى فعل الرغبة، وهو أمر ضنينُ الذكر فيه، فغالبية كتب التراث تتناولُ الحديثَ عن الفعل الجنسي من ناحية الرجل، وإذا تناوَلَت الفِعلَ الجِنسيَّ من ناحية المرأةِ بإسهاب فغالباً ما تستشهد بالإماءِ –في وقتٍ كانَ ذَلِكَ فيهِ مباحاً– وهو ما لا يخلقُ لدينا صورةً واضحةً عن كيفيةِ تولُّدِ الرغبةِ أو تقبُّلَ فِعلَ الرغبةِ لَدى المرأةِ العَربية.
في الباب الثاني من كتابِهِ يمضي ناحية الإغواء، والمقدمات المؤدية إلى العشق بمعناه الحسيِّ المباشر هذه المرة، من قُبلةٍ ورَشفِ رِضابٍ، ومُلامَسَةِ جسد، حتى تتهيأ المحبوبة، ونلاحظ أيضاً أن الخِطابَ موجهٌ بالنصيحة للرجل في مبادرتهِ.
ينتقل الكاتب سريعاً إلى نهاية المطافِ في رسمِه لصورة اللقاء الحميم بين عاشقينِ، فإذا ما كانت لحظة التقائهما أشبهُ بالإبحارِ في الموجِ، فإنَّ النِهايةَ أشبهُ بلحظةِ الرسو، وإذا ما كانت البداية قد جاءت من الحنان والتلاقي والمداعبة، فعليها أن تنتهي نهاية رقيقة كما بدأت بداية رقيقة، فالعاشقان عليهما أن يكافئا نفسيهما على ما بذلاه من مجهود وحقَّقَاهُ من متعة معاً، فالقبلات العاشقة والأحضان وتبادل الشراب والفاكهة والمزاح واللمسات اللطيفة هي النهاية التي يجب أن تسود بين لحظات العاشقين، وهو خطأ قد يقع فيه الكثيرون من إنهاءِ التواصل الجسدي بفتور وبانفصالٍ تام، وكأن ما كان هو إفراغُ شهوةٍ دونَ حبٍ يدفعها، ودون متعةٍ روحيةٍ أعلى من متعةِ احتكاك جسدينِ، وهي متعة امتلاء القلب والروح بروحِ المحبوب. بهذه الكيفية ينهي المؤلف حالةَ تواصل العاشقين بالجسد، منتظراً أن يثير كتابه حالةً من الحوار والنقاش حول القضايا التي نعتبرها محرمةً أو الكلام فيها غير مباح، لكن المشكلةَ أن كتابه ممنوع من التداول في غالبية الدول العربية، مما يحرم الكثير من القراء من قدرة التواصل أو التفاعل معه واكتشاف آفاقه الجديدة.




