الهويات العربية المتعارضة

ربما تكمن أهمية الهوية اليوم، في مدونتها الاعتقادية العربية المرتبكة، في تناقض الأسلوب الذي سلكته أو الطريقة التي نهجتها لكي تبلغ هذه المدونة. إنها تكمن في الحقل المعرفي الذي يتصل بالمركزية الأوروبية اتصالا لم يحسم بعد. الحقل المعرفي الذي أسست له يختبر نوعين من الحركة، كل منهما يتجه في اتجاه معاكس للآخر، حركة تحيلنا إلى ما يدعوه هومي بابا بـ”الفضاء الثالث”. لماذا صار هذا الفضاء فضاء ثالثاً؟ لأن الفضاء الأول يتشبث بمفهوم التقدم الذي يدمج حداثة التنوير بحداثية “مودرنيزم” ما أدعوه بـ”الدُرْجَة” (Trendism) أي الموضة التي تتغير مع تغير المركز. وأما الثاني فهو الفضاء الضدي، فضاء الأصالة المعاكسة الذي يتشبث به دعاة النقائية الشعبوية المنزع، أصالة اللاهوت التي ترفض باسم العقيدة الدينية المباطنة لسلطة الفتوى انفتاح الهامش العربي على المركز الغربي.
آية ذلك أن القول بأن الهوية تُصنع صُنعاً ولا تُمْنَح مع الولادة لم يعد بديهيا. الهوية العربية صارت هوية مرتبكة تنوس بين اللغة والتراث والحداثة. والكتاب الذي نحن بصدده يساجل البديهية التي تزعم أن الإقامة ربما كانت في الواحد لا في المتعدد. ولكن الواحد هنا ليس نقداً مباطناً للنقض المعرفي، ليس واحداً تنويري المنزع بل واحد لاهوتي خاضع لسلطة الفتوى الحاسمة والصادرة عن رجال الدين، رغم أن تردد القول أنه لا لاهوت في الإسلام يكاد يصير من كثرة الترداد ترتيلاً.
عنوان الكتاب الصادر عن دار MUTA شقيقة دار المتوسط بميلانو، وهو من فاتحة إصداراتها بالإنكليزية، يمكن ترجمته بـ”الهويات العربية المتعارضة: اللغة، التراث، الحداثة” Conflcting Arab Identities:Language،tradition، and Modernity” وهو من تأليف وائل فاروق الأكاديمي المصري المعروف أستاذ كرسي الأدب المقارن في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو.
وإذا أمكن اختزال منطلق الكتاب ربما انطلاقا من الواقع العربي أو المصري تحديداً يمكن القول إنه بمعنى من المعاني، محاولة مشكلية لإعادة صياغة مفهوم الهوية ليس اعتماداً على المد والجزر، أو الشهيق والزفير، الذي ظهر في استعصاء مفهوم الهوية خلال عصر النهضة، بمحاولة الموازنة بين اللغة والتراث والحداثة، في معادلة ما يدعى بتكافؤ الاضداد (Ambivalence) بل تمرير هذه المعادلة عبر اختزال الجماعات بمخيال الفتوى، تحديداً، المخيال الطائفي الديني، أي المباطن لبرزخ شبه مسدود وتحجيم أبعاد هويتها الأخرى.
ينطلق كتاب وائل فاروق من التساؤل المشروع عن جذور الهوية العربية وكيف تؤثر على صناعة الهوية العربية اليوم. كما يحاول قراءة أعمدة الهوية التي تلعب اللغة فيها دوراً مركزياً ويمكن تمييزها بدراسة النصوص المؤسسة للتراث الإسلامي. بل يحاول الباحث بحذر وتأن أكاديمي متوقع تتبع جذور الثقافة العربية عبر القرون لفهم وقعها وتأثيرها على المقاربة العربية الراهنة.
مآل البحث كما يبين المنحى المشرعن خلسة، المآل الذي اعتمده الباحث هو تبئير الفتوى والأسئلة التي تجيب عنها باعتبارها أساسا ضابطاً للدراسة، والكشف بوضوح عن التراكب أو التفاعل المركب من عناصر متعددة أسست له الحداثة مع اللغة والتراث في بلورة جذور الهوية العربية. وتمكن الإشارة هنا إلى أن التجربة المصرية ربما بالاعتماد على مركزية مشرعنة تطرح في البحث على نحو يفضي بسهولة إلى تعميمها عربياً.
ومسألة الهوية بمنزعها الثقافوي تحيلنا بدورها إلى ما يدعى بالنموذج المعرفي “الباراديم” أو الصيغة المعرفية، أي الميزان الذي يحتكم إليه في عملية الفرز الأكاديمي بين الخطأ والصواب، سواء وضعنا الصيغة المعرفية المعتمدة على محك علم الاجتماع أو نظرية المعرفة أو التحقيق التاريخي.
ولكن لماذا القول إن الباحث بالتزامه البحث عن الحقيقة يشرعن خلسة تبئير الفتوى وهيمنتها اللاهوتية؟ في تقديري أن السبب ربما يكمن في كون التراث المختطف من قبل رجال الدين قد نجح لكونه شعبوياً أصولياً وثقافياً وميثولوجياً، باكتساب لاوعي مباطن يقوم بمهمة القمع.
ومما يعزز هذه القراءة سيطرة النزعة الاستهلاكية المرتبطة بمفهوم سطحي للتقدم، على المجتمعات العربية، وسوء فهم الاستهلاك من منظور تعليمي مفض بالجامعات العربية إلى الاستئصال النسبي للدراسات الإنسانية من برامجها، والتركيز على الاختصاصات العملية دون خلفيتها التنويرية. الاستهلاك المنفلت العقال والمتحول إلى شعبوية مهيمنة يبرز دور الفتوى التي تطرح مفهوم التقدم بلا تعليل خارج منظومة التنزيل. كما أن الطغيان السياسي يعزز بدوره نزعة الانكفاء إلى ملاذ يرتدي جلباب عدم التسييس.
أعود إلى النص الذي نحن بصدده فألاحظ أن تعليل هذه الخلسة ربما يمكن تقريره في مقدمة الكتاب التي أقرأُها باعتبارها مؤشراً يكشف المنحى اللاحق الذي وصل إليه اللاوعي الشعبوي.
يشير المؤلف إلى أنه في منتصف ثلاثينات القرن الفائت بدأ عضو في البرلمان المصري حديثه بالقول “بسم الله الرحمن الرحيم” فاعترضه مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد الممثل لأغلبية ليبرالية قائلاً “إننا هنا نتحدث باسم الأمة وليس باسم الله”. وبعد مائة عام على الحادث، أي في الـ7 من فبراير 2012 تدخل نائب سلفي برفع الأذان، أي الدعوة إلى الصلاة في البرلمان، وذلك بعد أن أعلن غالبية أعضاء البرلمان عن امتثالهم للدين أولاً بإضافة قولهم إلى القسم بالالتزام بالدستور عبارة “إذا لم يتعارض ذلك مع القانون الإلهي”.
وخلافاً للغرب الذي رأى في ما حدث نكوصاً عن مائتي سنة عما وصلت إليه الدولة الحديثة في مصر يرى الباحث أنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار ما حدث نكوصاً، بل هو شكل جديد من المتناقضات التي اثّرت على التجربة العربية إزاء الحداثة منذ تأسيس الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر. وأكثر من ذلك يرى الباحث أنه يمكن اعتبار تطور الحداثة العربية قرين تطور هذه المتناقضات نفسها.
ويعزو المؤلف ما حدث ويحدث إلى أن الدولة الحديثة في العالم العربي تزامنت مع ظهور ما يمكن اعتباره بمثابة “خطابات متداخلة” أي تعايش عناصر مشوهة من التراث مع عناصر مشوهة من الحداثة. وحصيلة ذلك أن الخطاب الحداثي الذي يقترحه دعاته في العالم العربي عاش دائماً التناقض الكامن في كون الحداثة تخاطب مجتمعات المستعمرين الغربيين جغرافياً وتاريخياً وثقافياً.
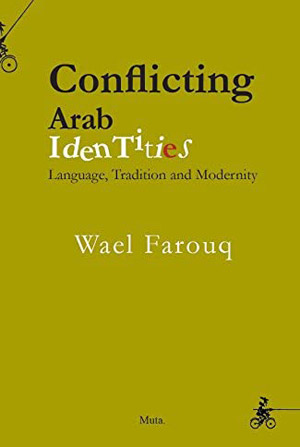
وهكذا يستنتج الباحث أنه بضغط قوي من الخطاب الديني الذي يتهم الحداثيين بالخضوع الثقافي للغرب، لم يستطع الخطاب الحداثي أن يحدث أيّ تغيير حقيقي، فقد كان يناضل باستمرار للاستجابة المطلوبة لإصلاحه. وانتهى الأمر بالخطاب الحداثي إلى انتهاج التقنية نفسها “الميكانيزم” التي اتبعت من قبل التراثيين الدينيين، التقنية التي تدور حول البحث في يوتوبيا الماضي عن شرعنة الوجود في الحاضر.
لا أريد أن أدخل هنا في تحليل مفصل لعملية المماهاة بين سلوك التراثيين الدينيين وسلوك الحداثيين، وأكتفي بالإشارة إلى أن السجال النقدي لا يمكن أن يكون بعيداً عن مؤشرين: الأول هو حضور العقل وكونه ماثلاً (ربما بين آونة وأخرى) في التراث الأدبي الذي يبدأ من المعلقات السابقة على ظهور الإسلام، وبالتالي فإن تاريخه ليس متماهياً مع التاريخي الديني، ويمكن القول إن تاريخه مفارق له. والخطاب في التراث الأدبي العربي يذكرنا بالتعريف التالي لأبي حيان التوحيدي “الكلام على الكلام صعب.. فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه ببعضه، ولهذا شق النحو وما أشبه النحو من المنطق وكذلك النثر والشعر”.. وفضلاً عن أن الخطاب هنا متلبس بالمنطق فإنه خطاب نخبوي، حاله في ذلك حال الثقافة عموما.
وبالنسبة إلى التراث الفلسفي العربي الذي قرئ مجدداً بحيث لا يقتصر على كونه ناقلا للفلسفة اليونانية كما تردد مقولات بعض المستشرقين، فقد تطور من منظور إعادة تسمية الفلسفة الإسلامية في المصادر المعرفية الحديثة، بحيث صارت تدعى “الفلسفة العربية” خلافاً للصورة التي حاول الاستشراق فيها أسلمة الثقافة العربية وعدّها صنيعة لاهوت (أنظر على سبيل المثال لا الحصر بالإنكليزية: دليل كيمبردج للفلسفة العربية، تحرير بيتر أدامسون وريتشارد تيلور، كيمبردج 2005).
وخلافاً للصورة التي حاول الاستشراق فيها أسلمة الثقافة العربية يمكن التذكير بما قاله برنارد لويس في أطروحته حول أصول الإسماعيلية (الترجمة العربية: بيروت يناير 1980 ):
“إن الثورة العباسية أوجدت مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام الاجتماعي والاقتصادي، فقد أنتج انصهار الطبقات الحاكمة غير العربية واندماجها بالدولة العربية السنّية وازدياد التقارب والوحدة بين طبقات الرعية والموالي تقسيما جديداً للطبقات يعتمد على الاقتصاد أكثر مما يعتمد على النسب والعنصر كما كان في القرن الأول تقسيما مكنه وعززه انتقال الخلافة من دولة زراعية عسكرية على إمبراطورية تجارية عالمية”.
ويضيف لويس “إن هذا التغيير بدأ خلال القرن الثاني وقطع شوطاً بعيدا في القرن الثالث “فكان طبيعياً أن ينجم التغيير عن هذا التبدل العظيم في الأحوال الاجتماعية ونظام الطبقات”.
يرى الباحث، وربما كان محقاً، أن نشوء الحداثة وتطورها على يدي ابن رشد قديما، وحامد أبو زيد حديثاً، والمصير الشخصي لهذين العلمين دليل على رسوخ الأصولية الإسلاموية ممثلة بسيطرة الفتوى. ولكن هذه الرؤية التي تنتهي لديه على نحو مخفف بالكلام على تراكب الخطابات وذلك تعبيراً عن تعددية تواكب نشوء الحداثة وتطورها في العالم العربي، هذه الرؤية تستدعي السؤال التالي: لماذا كانت الاستجابة الشعبوية المتقلقلة لجهود الحداثيين العرب تمثل فشلاً للحداثة ودلالة على صعود الأصولية الإسلاموية ممثلة برسوخ اللجوء إلى الفتوى؟ لماذا لم تهطل (trickle down) جهود النخبة الحداثية، بحيث تصل إلى عموم الناس على الرغم من اتساع نطاق التعليم في العالم العربي؟ الجواب على ذلك أن نتائج عمل النخبة الثقافية العربية وبعض الاستشراقية بصيغها المتطورة ظلت جهداً أكاديمياً أعلى لا يصل إلى الناس في الأسفل. دراسة الإنسانيات عموماً مازالت مستبعدة كلياً من الدرس الجامعي العربي. كما أن دراسة العلوم وتطبيقاتها ظلت معزولة عن بطانتها الحداثية. بل صار تعليم المهن مرتبطا تحديداً بظاهرة الاستهلاك دون الفكر المباطن له. الاستهلاك هنا يصبح محرك السلطة الدينية، والطغيان السياسي يفضي إلى اللجوء للطغيان الآخر، الطغيان الفقهي معادله المفهومي.
ولكن يبدو أن الكتاب الذي نحن بصدده يرى تحديداً أن مأزق الفكر العربي يعود إلى جذور أعمق. فالباحث كما يشير، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار عناصر تتعلق بأصل الخطاب العربي الإسلامي نفسه وهويته، وهذه العناصر ذاتية المنزع تكشف عن وجود ميل طبيعي للجوء إلى الماضي في كل حقل من الحقول. ويضرب المؤلف مثالاً على ذلك بالتساؤل عن السبب الذي يجعل المعاجم العربية عاجزة عن “تقديم كلمة جديدة واحدة منذ منتصف القرن الثامن”. ويضيف إضافة أشد تطرفاً بقوله “كل الكلمات التي ظهرت آنذاك اعتبرت غير صافية ولا تنتمي إلى اللغة الفصحى، لغة القرآن والثقافة والوجود”.
أعتقد أن هذا الإمعان في التبسيط يحتاج إلى مجال آخر لتفنيده أو حتى السجال معه. وأما الملاحظات الختامية في الكتاب فإنها تنطلق من سيطرة ظاهرة الفتوى في مصر وتعميم هذه الظاهرة على الوضع العربي عموما. صحيح أن الملاحظات سلبية المنزع أي أنها تفند الظاهرة، إلا أن تفعيلها يوحي باعتبارها مطابقة للواقع العربي.
نخلص إلى القول إن كتاب وائل فاروق يوفر مرجعية نقدية ومعرفية بالغة الأهمية حول الأصولية الشعبوية في الدولة العميقة. ولا شك أن صدوره في لحظة تقلقل تراتبية الخطابات المكونة للهويات العربية وتراكبها وتصادمها يتزامن مع انحسار الفكرة المعتمدة للهوية، وبالتالي ظهور جماعات متعددة الثقافات. وهذا الانحسار هو الذي جعل مفكري ما بعد الحداثة يشيرون إلى أننا لم نعد نعيش في عالم حديث. فالحداثة في زعمهم باتت في حالة احتضار. صحيح أن الهوية الطبقية مازالت عنصراً مهماً يحدد الوضع الاجتماعي للناس ويمنحهم إمكانيات تتصل بالفرص المتاحة لهم في الحياة، إلا أن الهجرات، وأنا أتكلم هنا عن الهجرات العربية، القسري منها والطوعي، شرعت بالاشتغال في صناعة توصيف للهوية ربما كان مغايرا ومختلفاً عما كان شائعا قبل عقود. فإدوارد سعيد يتحدث عن هوية قائمة على فكرة التبني (affiliation) وهي هوية قائمة على الاختيار الشخصي بدلا من الهوية الموروثة (filiation) التي تفرض على المرء فرضا عن طريق التوريث. ونقض فكرة التوريث لدى إدوارد سعيد ربما يتماهى مع تفنيدها لدى المتنبي وهو القائل “ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جَدٍّ همام”.
وفي قصيدة محمود درويش: “طباق لإدوارد سعيد” صورة تصف هذا التحول الافتراضي بوضوح:
” والهويَّةُ؟ قلتُ
فقال: دفاعٌ عن الذات…
إنَّ الهويةَ بنتُ الولادة، لكنها
في النهاية إبداعُ صاحبها، لا
وراثة ماضٍ. أَنا المتعدِّد. في
داخلي خارجي المتجدِّدُ… لكنني
أَنتمي لسؤال الضحيَّة. لو لم
أكن من هناك لدرَّبْتُ قلبي
على أن يُربِّي هناك غزال الِكنايَةِ.
فاحملْ بلادك أَنَّى ذَهَبْتَ…”.
هنا يتكلم محمود درويش الشاعر رافع لواء غزال الكناية، لواء البيان الفردي، ليعيد موضعته مكان التبيين الجماعي. وهذه الصورة التي تنتصر لفكرة التبني القائم على الاختيار بدلا من البنوة البيولوجية الموروثة تجد قرينها المعرفي في كتاب أمين معلوف حول مشكلية الهوية. ترى هل يفسر هذا التحول افتراضي المنزع ما نشهده على صعيد العالم العربي من إشادة بالطبقة الوسطى؟




