سيرة الذات والمكان

يعدُّ أدب اليوميات واحدًا من الأدبيّات المهمّة؛ باعتبارها مجموعة التجارب والخبرات والملاحظات التي يعيشها كاتبها ويقوم بتدوينها هذا من جانب، ولأنها -من جانب آخر- تشكّل وثائق أدبية وتاريخية معًا، وقد حرص الكثير من الكُتَّاب على تسجيل وتوثيق يومياتهم التي تأتي في كثير منها شارحة لنصوصهم وتفسّر غوامضها. وعلى مستوى الشكل تقترب اليوميات من أدب الاعتراف من حيث ارتفاع درجة البوح، وإن كانت تتقاطع من جانب آخر مع الحوليات والمدوّنات التاريخيّة بسبب الاهتمام باليومي والاتكاء على الزمن الكرنولوجي المُتعاقِب في سرد الأحداث. وقد راجَ الإقبال عليها في الفترة الأخيرة لأسباب تتعلّق بالتوثيق للمآسي في ظلّ الحروب والصراعات، التي دفعت بالبشر إلى التنقّل في مسارات وإلى أماكن غير مخطط لها. واليوميات كما يعرفها محمد أحمد السويدي في تصديره للكتاب الذي بين أيدينا بأنها “لوحات فنية مدهشة تكشف عن مشاعر حميمة وخلجات وجدانية فياضة، وخواطر وانطباعات ترصد المرئيات”.
تأتي الأهمية ليوميات الشّاعرة السُّورية خلود شرف “رحلة العودة إلى الجبل: يوميات في ظلال الحرب” الفائزة بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة (الرحلة المعاصرة) في دورتها السابعة عشرة، (الكتاب صادر بنشر مشترك بين المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت، ودار السويدي للنشر والتوزيع والإعلان، 2019). فالكاتبة قبل أن تذهب في رحلة عبر الزمان والمكان لمدينتها (السويداء) التي هجرتها مُضطرة، تغوص في ذاتها سعيًّا لاكتشافها عبر المكان. فهي أشبه برحلة العودة إلى الطفولة؛ فما أن يعود الإنسان إلى مسقط رأسه “حتى يكتشف أن الزمن بمسافاته التي قطعت يعود معك”، كما أن كل شيء يتوقف عند اللحظة التي غادرتها بها “وبقيتْ كأنها صورة فوتوغرافية تستعيدها الآن في أليوم العائلة”.
فعودتها في الأساس مرتبطةٌ باستعادة رُوحيّة لذاتها كما أعلنتْ “الآن وقد عدتُ إلى بلدتي المجيمر في الجبل بعد سنوات من الغياب، أشعر بأنها مربطُ روحي”. وبهذا فإن هدف العودة المتمثّل في استعادة الذّات، وتحريرها من الأوجاع والخسارات والهزائم، يعيد إلى الذهن عودة مصطفى سعيد بطل “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح، فالعودتان جاءتا كترميم للذات من تلك الهزائم التي مُنيت بها الروح في الغربة المكانيّة أو الذاتيّة، أي أشبه بتطهّر للذات من أوجاعها. ومن ثمّ تستعيد الكثير من مشاهد الطفولة المبهجة، كالعودة من المدرسة واستقبال الأم لها، والمؤلِمة كتذكرها إصابتها بحجر في رأسها وهي تراقب أحد الفتية وهو يسرق الكرز، وأيضًا ما ارتبطت بهم من بشر في طفولتها كأمها وجدها، وأشياء حميمة كالشجرة التي غادرت المكان منذ أنْ بدأت رحلتها.
لا تمثّل العودة نوعًا من الحنين للمكان فقط، وإنما هي بمثابة استعادة كاملة للمكان بتاريخه وطقوسه وعاداته وأزيائه وإنسانه ونباتاته أيضًا. فتحضر المدينة بعيون شاعرة تسبغ على كل شيء تراه دلالات جديدة غير مألوفة. فالماضي مفخرة، لكنه نقيض الحاضر الذي صار نميمةً، وكذلك الطيبة والوقت والغروب. أما الحب فيصير خطيئة بأن يُقتل بدم بارد مع أجنته، حتى الهوية صارت شبحًا، واللغة نفسها “تحتار بين الشهيق والزفير محاولة التملُّص من غضب الرجولة الكامن في قساوة الحجر”.
كما يحضر تاريخ المدينة. ففي المقطع المعنون بـ”رحلة إلى روما الصغرى” تغوص بنا في تاريخ المدينة الذي تربَّتِ الحضارةُ الرومانيّة بكرًا في جنباته، وأمجاد الماضي حيث خرج من حوران الكبرى الكثير من الفلاسفة والشعراء، الذين كتبوا باللّغة اليونانيّة، وخرج فيليب العربيّ الذي بنى “شهبا” على شكل صورة مُصغرة عن روما. فتسرد عن تاريخ شهبا الذي يعود إلى العصر الحجري، وآثار المدينة كالبوابات الأربع، والشّوراع الرّومانية المصقولة والمرصوفة، والمسرح الروماني، وأيضًا الحمامات الرومانية والقلعة والمعابد ودور العبادة، ولوحات الفيسفساء الأربع التي تحكي حكايات الآلهة وأساطيرها. لا تتوقف علاقة المدينة بالماضي بل في حاضرها استقبلت المغاربة، الذين كان لديهم القدرة على فكّ السّحر والحسد. ومن ثم تزاوج بين تاريخ المدينة القديم والحديث. وكأن هذا السّحر يربط بين ما شهدته المدينة من حكايات أسطورية حديثة عن جِنيّة القمح التي كانت تخرج للنسوة وهن يحصدن، وأساطير الماضي.
وكذلك قريتها حاضرة بموقعها (على بعد 14 كم جنوبي السويداء) وبتاريخها العريق الممتد إلى حضارة الغساسنة. وحاضرة أيضًا بجغرافيتها (تلالها وبركها، وأنهارها)، وبمعالمها (القناطر، والبيوت، دير الراهب، وقصر الراهب بحيرة) وبإنسانها، وبنباتاتها البرية التي “تشق وجه التراب لتشعر بالحب والندى”، وبزهورها البرية كالأقحوان بلونيه الأبيض والأصفر وشقائق النعمان بكل ألوانها (الأحمر، الأبيض الأزرق السماوي، البنفسجي الفاتح والغامق)، وأشجارها خاصة أشجار الفاكهة بعد انتقال السُّكان من زراعة القمح إلى عريش العنب، وشجر التفاح وشجر التين، وبأزيائها الكرنفالية، فتسهب في وصف مكونات كل ملبس وما يؤطره من زينات، وعلاقة الألوان بالمناسبات الاجتماعية وغيرها من مظاهر خاصّة بالمكان.
إضافة إلى الشخوص الذين ارتبطتْ بهم كالجَدّ الذي تسرد عنه وعن وفاته الدرامية، وعن أمها التي تصفها بأنها “امرأة خميسنية بجمال الملكات”، وأيضًا ألعاب الطفولة كالغميضة وحكايا الطفولة نفسها، وما غرسه الأجداد من خصال كاحترامهم للطبعية. وهي قوانين أشبه بأنساق وأعراف خاصة بالمكان، على نحو الرفق بالحيوان، حيث البقرة كانت تُعامل على أنها الحنونة. كما أن الأشجار عاشت بطمأنينة لم يصبها التجريف والحرق إلا في زمن الحرب.
وأيضًا توثّق لعاداتها وتقاليدها وطقوسها، ومن العادات التي تدخل دائرة الطقسية، عادة قتل الأمهات لبناتهن إذا عشقن، وهي تأكيد على أن الذكورة ليست حكرًا على الرجال فحسب، وإنما هي طبع تأصّل في المرأة لتمارسه على شبيهتها المرأة. وهي بهذا كله، كأنها تقدم لوحة كرنفالية عن المكان بغية التوثيق والتسجيل والحفاظ عليه من الاندثار بما في ذلك الديانات، كالدرزية، التي “تعد طائفة من طوائف سوريا الست عشرة الموازييك”. ولم لا؟ فالمجيمر “أنثى برية شبيهة بزهرة شقّت برأسها التربة في أعلى التلّ تحت السرو وشجرة الكينا”. حالة التأسى والفقد للمكان تتجاوز أماكن الطفولة إلى الحسرة والحزن على الشام بأكلمها، فتخاطبها :كم أشتاق الشام أنثى بكامل أنوثتها، أنثى الإنسانية والوجود. آه يا شام ماذا فعلت بك الحرب! هل أنت بخير؟ كم كانت جميلة عتبات الشقاوة على شوراعك وحواريك؟!
يوميات مفتوحة
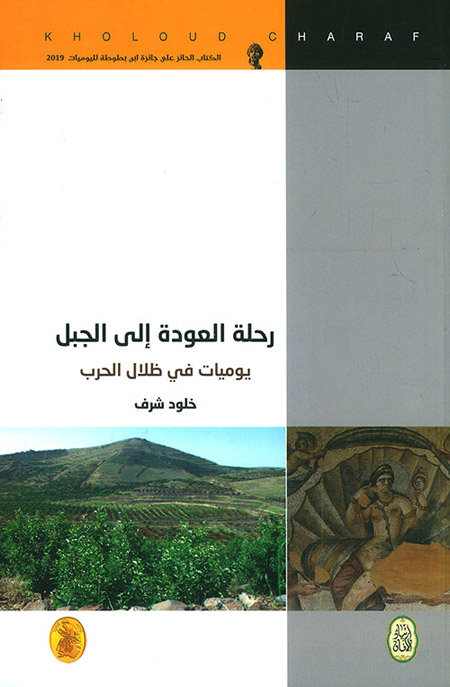
تضعنا المؤلفة في إشكالية خاصة بالتصنيف، فالكتاب المندرج تحت نوع (يوميات)، يتجاوز مفهوم أدب الرحلة واليوميات التقليدية، وفق التقسيم المدرسي؛ ليقدّم تصنيفًا خاصًّا به، لا فقط على مستوى تقنيات الكتابة وأسلوبها المتمثّل للغة تزاوج بين التوثيق والتسجيل وإن كانت بلغة الشعر ومجازاته أحيانًا، لدرجة أنها تقترب كثيرًا من اللغة الموصوفة (المصوّرة) حيث تقدّم لقطات حيّة أشبه بلوحات فنية بعين ساردة عن النبات والأماكن والحيوان وكل شيء، بل كذلك على مستوى البناء والتشكيل.
فبناء هذه النصوص يختلف عن طبيعة اليوميات التي تندرج تحت كتابة الذات لسببين؛ الأول؛ لأن اليوميات دائمًا تلوذ بالزمن الحاضر، وتسجيل الوقائع والأحداث وفق تواريخ الرحلة التي يسير إليها الرحّالة، مسجلاً ما تقع عليه عيناه كرنولوجيا. هنا الكاتبة تتحرّر من الزمن، ولا تقف عند لحظة العودة الآنية، وإنما تعود بالزمن كثيرًا إلى الوراء (ماض بعيد)، أبعد من لحظة استيعابها للأماكن والأشياء، فتؤرخ للمكان، وتقدم لطوبغرافيته، وثقافته، وأيضًا تقترب من زمن (ماض قريب) حيث طفولتها وذكرياتها، فتستحضر ما يدعم هذا الحنين والتوق له. والثاني لأن ثمة وحدات يمكن أن تقرأ على أنها نصوص مستقلة.
في الحقيقة نحن إزاء نص مفتوح يتجاوز مفهوم اليوميات بمعناها التقليدي؛ فالكاتبة هنا تزاوج بين حاضرها المؤلم وقد تركت الحرب آثارها في كل مكان ففيها “سقطت قلوبنا، وسقوف البيت، وسقط سقف الموت”، وبين ماضيها وأمجاد مدينتها المتصل بحضارات عربية كحضارة الغساسنة وحضارات غربية كحضارة الرومان. فبقدر ما هي متحسرة على واقعها بمآسيه وخساراته على المستوى المادي والمعنوي، إلا أنها مشدودة بطرف حنين إلى طفولتها، وبمعنى أدق ماضيها باعتباره نقيضًا لواقعها. وهذه العودة مؤكدة على مستوى أحداث النص ذاته، وأيضًا عبر التناصات مع نصوص أخرى كمقتطف من نص ريلكه الذي يقول “منذ طفولتي، أنجزت جميع وداعاتي، صاغتني الأسفار ببط، غير أني أعود لكي أبدأ من جديد”.
تُحدّد الشاعرة والكاتبة خلود شرف غايتها من الحكي، وهي غاية تتمثّل في العودة إلى استعادة الطفولة، وتأتي هذه الاستعادة بنظرة شاعرية رومانسية حالمة، تصبغ على البشر والحجر والحيوان صورًا وخيالات مبهجة، وفي نفس الوقت حزينة ومؤلمة فها هي تتساءل “فما الضير أن نلوّن هذا العالم الواقع علي هستيرية الحرب، ببعض الحب وقليل من زهور الجنة” ولم لا “ما دام الألم في كل مكان”.
وبهذه المزواجة بين الألم ووصف الجمال، الذي يأتي كنوع من الاحتماء والمقاومة، لبؤس الواقع؛ كي تنجو الروح “مثل سماء زرقاء”، تضعنا المؤلفة في مواجهة نص وصفي بامتياز، فهي تقف أمام كل شيء في المكان لتصفه، النبات والتلال والتربة والحيوان إلخ. وإن كان كما يقول الشاعر نوري الجرّاح -في تقديمه- تأتي صور الجمال “مقرونة بالألم، والتطلعات مجروحة بالإحباط، وذلك جراء ما أصاب عالمها من دمار وما آلت إليه طموحات الجيل الذي تنتمي إليه من خسارات”.
فبين سطور الجمال التي تنثرها وهي تسرد عن “رحلة العودة إلى الجنة” يبرز الشيء وضده، تظهر رائحة زهرة الجنة، التي رائحتها أشبه بالنارنج السوري، وفي نفس الوقت تطل هستريا الحرب. لا شيء على طبيعته؛ فتلال المكان تبوح بالحكايا، تجيد الغناء وتُتْقِنُ التقمُّص في كل سكناتها وحركاتها، والبرد فيها لغة تنخر العظم، إلا أنها تعلّمه “كيف يعشق ليدفأ، صامدًا على ركبتين، كمسامير معدنية”. والسويداء التي يتفاخر الناس بكل ذرة تحمل الماضي على أنه قيم عريقة وبطولات وحضارة، “بينما يأكلون لحم بعضهم البعض بالثرثرة في الصباحات”.
كما أن الدخول إلى السجن يأتي بمثابة الرحلة وإن كان “ليس إلى باطن الأرض، أو حتى إلى عالم مغاير”، بل رحلة “في سبر أعماقها”، ومن ثم كانت النتيجة بعد الخروج بأن شعرتْ “لأول مرة أعرف من أنا “.
حكايات التقمص
تدخل بالقرية دائرة الأسطورة والعجائب، لدرجة أن الولَه بالمكان ينعكس على زائره، فالطقوس تتلبّس به “فيخرج من زمنه ليسقط في زمن جميل، لا يستحضر العذابات والآلام، بل يستنطق لغة الفكر الإنساني الغارق في التأمّل والبحث”. وما يسرد عن تقمُّص الأجيال الحالية لحيوات إنسان من الأجيال الماضية، ينقل الحكايات إلى عوالم مفارقة لواقعها إلى عوالم رحبة، وكأنها بحاجة إلى اختراع أسطورة، وسط هذا الثراء الأسطوري للمكان.
كما تقارن بين واقع المكان، وما كان عليه من قبل، ففي أثناء حديثها على الموسيقى وآلاتها المستخدمة، تذكر الكثير من الآلات وأوصافها كالربابة، التي تصفها بأنها “آلة بوتر واحد، لها ذراع كالكمان، يعزف على الوتر، تسند إلى الأرض أو إلى الفخذ لا إلى الكتف” وغيرها من آلات مثل الشبابة، وهي “آلة نفخية تشبه الناي، لها أربعة ثقوب مصنوعة من المعدن، يعزف عليها بالحفلات الشعبية والأفراح”. لكن الكثير من هذه الآلات انقرض مع حركة التطوّر السّريعة ودخول المدنيّة ومستحدثاتها. وتشدّد على أن الذي يصنع التراث هو المكان، ومن ثمّ تتعحبُ من هذا التكالّب وراء سرقة آثار العالم، التي تفتقِدُ لقيمتها بافتقادها مكان اكتشافها.
وتتوقف عند الاختلافات اللّغوية بين القُرى، فكما تقول إن معظم القرى في جبل العرب تستبدل الألف الثانية في الضمير (أنا) بياء الملكية فتقول (أني) مع تخفيف الألف وخروج النون من الأنف وتثقيل الياء. كما أن اللّغة تتلوّن حسب المواسم، وتعاقُب الفصول. ومن شدة ولائها للهجة تدعم النص بقائمة بالمفردات العامية الرائجة في القرية، وكأنها تصنع لهذه القرية عالمًا مستقلاً بلغته وحضارته وتاريخه وأيضًا بطبيعته وبشره.
ومن الأشياء التي تتوقف عندها في تأسّ، ما خلقته هذه الحرب من أزمات؛ كاستغلال التجار، باحتكارهم البضائع، خاصة إذا عرفوا من اللّكنة أن الشخص غريب. وأيضًا بسرقة الآثار وتهريبها خارج مناطق اكتشافها، حتى أنها تتساءل عن السبب “ما الذي يستفيد منه العالم من وراء هذه السرقات وتهريب الآثار خارج مناطق اكتشافها؟” بل إن للحرب تأثيرها على الحيوانات والأشجار التي تُحْرق، فأهل القرية عادوا إلى تربية الحيوانات كنوع من الاكتفاء الذاتي في مواجهة الجوع. وتنقل تأثيرها على الفنون التي كانت من قبل أشبه بطقوس جماليّة، فتحوّلت إلى سلعة؛ فصار الرقص في زمن الحروب والمآسي وسيلة لكسب العيش، كما تهشّمَت الثقافات التراثية التي تحمل الفكر الجماعي التقليدي لحضارة المناطق.
على الرغم من تقصّيها للأشياء محليًّا إلّا أنها تجنح أحيانًا لتسرد لنا تاريخ نشأة القهوة، في الفصل المسمّى بـ”المشروب الشعبي”، في سهول الحبشة منذ أن اكتشف تأثيرها راعي أغنام في القرن الخامس عشر الميلادي. فتسرد في فصل ممتع وشيّق كلّ ما يرتبط بالقهوة. فتربط بين الخاص حيث جدها وطقسها في صناعتها، والعام حيث عادات العرب في شربها، وكيف إذا امتنع الشخص عن شربها، يشير إلى أن له حاجة، ولا يشربها إلّا إذا أخذ وعدًا بقضائها. أما إذا امتنع الشخص عن شرب القهوة بلا سبب فهو نذير شر وعداء. ومن القهوة تنتقل إلى المَتّة وهي مشروب شعبي وإن كان النساء من يتميزن بشربه غالبًا، وهو طقس يلغي الوقت الدائر في أحاديث من نوع الثرثرة كتسلية. وبالمثل تتحدث عن الرقص في السويداء الذي هو من أجمل الطقوس التي تدور بدوائر محاكاة للوجود.
تستفيض الكاتبة في وصف أهوال ومعاناة الحرب؛ فتحكي عن الحرب التي دمرت ليس البيوت والشوارع والأماكن، وشردت الأطفال فقط، بل دمرت روابط الصداقة، فصار الصديق عدوًا، يرتاب فيه، ويتوجّس منه. كما تصف ما خلقته الحرب من عادات سيئة وجرأة للبعض، كتلك التي سرقتها، دون أن تظهر ردة فعل لاستيائها وشكواها من كيفية العثور على الطعام، أو العودة من جديد إلى البيت! فالحرب أعطت حكمتها بألا يثق الإنسان في أحد. وأن الإنسان إذا ما فقد شيئًا عزيزًا لديه، فإنه لا يمكن أن يستعيده أبدًا.
وفي المقابل تقدّم ما أكسبته الحرب للروح والبدن على السواء، فقد أنضجتها بعد نجاتها، وهو ما يحفّزها لأن تقدّم نصائحها للآخرين، فتعمل على هدم وتقويض كافة الأنساق الثقافية التي كانت سائدة والتي كانت أشبه بتمائم يحتكم إليها البشر كتراثٍ مَنيعٍ يصدّ في الأزمات، فترفض هذا مدعيّة أن قواعد العيش اختلفتْ، فأنتَ لست بحاجة لأن تخبّئ القرش الأبيض كي ينفعك في اليوم الأسود، فكما تقول “لن تجد أسود من هذه الأيام”، ومن ثمّ فالأجمل أن تعيش لحظتك رغم كل شيء.
ترحل عن المكان وإن كان كل شيء في روحها إلا أنّها تُصرّ على أنْ تحمل أشياءه المادية، فتحمل حفنة تراب من شهبا بلون البن المحروق وبذور حبق وحجر من الخفان الخارج من جوف الأرض إلى بولندا.
هذه الرحلة التي كانت أشبه باستعادة للنفس وصلتْ بالكاتبة إلى مرفأ النهاية والطمأنينة فكما تقول “حين تطمئن روحي أغفو”؛ جعلتها تنهي نصّها بمرثية عنونتها بـ”وصيّة رحلتي”، تكتب فيها ما يُشبه رثاء النفس هكذا “الآن سأكتب نعْوَتي وأحمل أشلائي بكيس الصوف الذي حاكته لي أمي في صغري، وأودّع كل مَن يحبني. لا تنسوا وصيتي لا تعاملوني كعدد”. في إشارة إلى الوصول إلى حالة الطمأنينة التي نشدتها طوال رحلتها، ومن ثم كانت النتيجة شبه سلام مع النفس ومع الآخر.




