شكوى الجيل الجديد من الجيل القديم
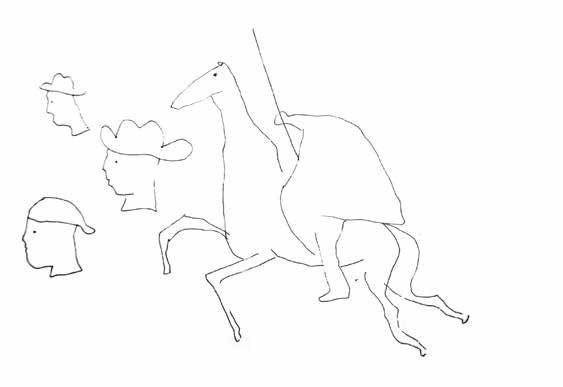
للمثقف في المجتمعات العربية، كما في كل مجتمع آخر وظائف ومواقع عدة وصور مختلفة، ولكُلٌ هذا التنوع وزن، ومكانة خاصة، وبالتالي تأثير يختلف بحسب المجتمع المحيط. بصورة عامة يُنظر إلى هذا الشخص كقدوة أو مثل اعلي يُحتذى به من قبل أفراد المجتمع والقوى المجتمعية الأخرى. تاريخياً، لطالما كانت هنالك علاقة بين تحضر الأمم وشعوبها، وانفتاح مثقفيها على التفكير بطرق غير تقليدية. حاجة المجتمعات لأشخاص مماثلين عظيمة. ولا شك في أننا حالياً، في ظل استنزاف مواردنا وهجرة شبابنا ومثقفينا، بحاجة أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى من يؤدي هذا الدور بفعالية متجددة.
نبيل ممدوح ونازلي تارزي
الحقيقة هي أن الحروب سادت والدمار طال الجميع، الجميع في حالة شتات، أو هو طرف فيها وشاهد عليها، مثقفونا في طليعة الهاربين من الأوطان. وهو ما يجعلنا نتطلع جهة مجتمعات الهجرة واللجوء لنستطلع أحوال شباب في المهجر، ونتساءل في الوقت نفسه لماذا لا نلحظ اهتماماً جدياً وإرادة حقيقة من قبل المثقفين بالعلاقة الثقافية للناشئة العرب في المهاجر الأوروبية بهويتهم، بما يفيد بلورة هذه الهوية في ظل تجاور هويّاتي في مجتمعات متعددة الهويات. الملاحظ أنه لا توجد أيّ محاولة لمد الجسور بين أجيال متعاقبة من المهاجرين تفصل بينها أزمات هوية، نزاعات، تفكك مجتمعي، خلل اقتصادي، حاضر عشوائي، وهو ما يسهم في رسم صورة لمستقبل رمادي. هنالك نظرة فوقية من قبل أجيال الآباء نحو أجيال الأبناء، جهل بتطورات واقع الأجيال الجديدة، وتحولات وعيهم واستعداداتهم للتكيف، نكران للمتغيرات وإعادة استهلاك لأفكار لم تنتج ما يذكر في الماضي، ولا هي بقادرة على أن تنتج ما يذكر مستقبلاً. قلق الهوية الذي تعيشه الأجيال الجديدة المهاجرة، حالياً، لا بد أنها نتاج واقع خاص بهذه الفئة من المهاجرين، ولكنها أيضاً بفعل ثقل الضغط الذي تمارسه أفكار الأجيال المهاجرة الأكبر سنّا، والتي لم تتمكن من الاندماج في التعدد الهوياتي لمجتمعات اللجوء وينسحب هذا التوصيف على قطاع كبير من المثقفين المهاجرين، وهذا ناتج بالضرورة عن تخلي الثقافة العربية المهاجرة عن محاولتها فهم وظيفتها النقدية وتحولها إلى أداة تمكن المثقف المنغلق على تكوينه المعرفي الأول من فرض آرائه الفكرية وتصوراته الضيقة على الجيل الجديد دون اعتبار لحق الجديد في اعتناق تصورات مختلفة وفكر مختلف.
تجربة شخصية (1)
من تجربتي الشخصية مع مثقفي المهجر، كفتاة عراقية شابة كبرت وترعرعت في بريطانيا، واجهت الكثير من المعوقات أثناء محاولتي التشبث بهويتي الثقافية، على رغم انفتاحي على الاختلاف الثقافي البريطاني. المعوقات اختلفت باختلاف المراحل الفكرية والعمرية.
من جهة أخرى، خلال رحلتي البحثية صادفت عدداً من المثقفين العراقيين منهم من كان صاحب ذاكرة معلوماتية وتراثية غنية، وعلى وعي جيد بالقضايا والمشكلات الناجمة عن الاختلاف الثقافي، ومنهم الحكواتي الذي يربط كل حدث بقصة ليست بالقصيرة. تختلف أفكار المثقفين نسبة لاختلاف خلفياتهم علمية كانت أم أيديولوجية أم عائلية، لكنها تشترك، وإن بطريقة غير منظمة، في محاربتها للأفكار الجديدة، أفكار الشباب المستلهمة من فهمها للواقع من مواقع مختلفة، وهي تُحارب بأنواع التجاهل والإهمال، فقط لأنها مختلفة أو لأنها تطرح تساؤلات منطقية وبدهية، ولكنها لا تدخل ضمن المنظور الذي ينطلق منه هذا الجيل العتيد من المثقفين.
انشغال الطبقة المثقفة في المهجر بنزاعاتها الشخصية والأيديولوجية، وإهمالها عواقب هذه النزاعات على وضع الأجيال الجديدة من الناشئين في المهجر، إضافةً إلى انعدام الرغبة، أو حتى الإرادة، لأخذ المبادرة في تضييق المسافة بين أفكار الجيل القديم واستعدادات الجيل الجديد، خلق ما يشبه بالمنطقة العازلة بين الشباب ومجتمعهم المهاجر. أجيال الشباب في المهجر تواجه العديد من التحديات والصعوبات في محاولة اندماجها بالثقافة الأم، وهو ما يجعلني أتساءل عن جذور المشكلة، هل هي ثقافية أم جيلية؟
لا أخلي عاتق الشباب من المسؤولية، فهم مشتتون بين أفكار ذويهم، ومرجعياتهم الأم، من جهة، وبين ولائهم لبلدان المهجر التي ولدوا فيها، ولنزوعهم الطبيعي للارتقاء والتحقق في إطار بيئة جديدة تطرح عليهم تحدياتها، وتستفز عصبهم الشاب، لكنهم أيضاً يبدون عاجزين عن التماسك الطبيعي في ظل هذه المعادلة القاسية.
شباب المهجر يفتقد إلى الحد الأدنى من الدعم والتنظيم، وباستثناء بعض المحاولات الفردية هنا وهناك فإن الوسائل المتاحة محدودة جداً. لكن لا يمكن أن نتناسى أن هذه المشاكل هي في الأساس بعض نتائج عدم تكيف الطبقة المثقفة من الأجيال المهاجرة من الأكبر سناً وتعلقها بمرجعياتها الثقافية على نحو مرضيّ، وخوفها من ضياع الهوية.
من الغريب أن نرى كيف أن بعض الشركات العملاقة، من نفط وأدوية وتكنولوجيا، تلعب اليوم دور المحافظ على الثقافة والتاريخ العراقيين، وهي الشركات نفسها التي استثمرت في خراب العراق، وفعالياتها، تكاد تكون الوحيدة لإحياء التراث العراقي في المتاحف والجامعات والمسارح وتثقيف عامة الناس بها، بينما يقف المثقف العراقي متفرجاً على هذا الاستغلال الموجه لبسط نفوذ هذه الشركات في العراق والمنطقة، هذا إن لم يكن هو أيضاً جزءاً من هذه الصفقة الصامتة في أحيان كثيرة.
تجربة شخصية (2)
هاجرت إلى السويد قادماً من بغداد الحروب قبل إحدى عشرة سنة، أذكر أنني نزلت المطار السويدي وبوصلتي الفكرية ضائعة في خضم النزاعات والدمار وحروب الهوية التي أحرقت الأخضر واليابس في مدينتي. سخرية القدر وحدها جلبتني إلى بريطانيا بعد سنوات، باحثاً عن وطن أصبح معلقاً كصورة ضبابية للذكرى على جدران النسيان، في محاولة لفهم ثقافة لم تبرح في اندثار مستمر. صادفت الكثير من المثقفين بعضهم ممن التقيت به مسبقاً على صفحات الجرائد، ومنهم من يُعلم ويثقف، ومنهم المتفرج. إجاباتهم عن أسئلتي الفضولية لم تشف غليلي، بعضها باهت وسطحي، والبعض الآخر ثقافوي جمعي، والغالبية تتشارك سمة مميزة: معاملة التاريخ من منظور جمالي شعري وأحياناً مقدس. رافضةً أيّ تساؤل أو طرح منطقي مبني على مفاهيم مختلفة، ربما تكون أساسية في بناء المجتمعات الحديثة.
ثقافة تغليب البعد الجمالي على البعد المعرفي، وبشكل خاص في الحقول الاجتماعية، وهو بحد ذاته تجهيل للثقافة وتبسيط للمعقد. أنتجت هذه الثقافة طبقة جديدة من المثقفين تعامل التاريخ والواقع من منحنى وإدراك شعري رومانسي، وتقيّم التاريخ لغوياً، مهملةً التفاصيل ومترعة بلغة التعميم والتجزيم، متناسية أبجديات البحث العلمي الرصين وأدواته، تنتقي ما تريد وتجتزئ ما تريد، والنتيجة مفردات طنانة فارغة من معانيها، ضوضاء لغوية أكثر منها فكرية. أكاد أسمع هذه الضوضاء في مقاهي بغداد ستينات القرن الماضي، صليل الأقداح، رائحة الشاي بالهيل، حجر دومينو يطرق الطاولة بقوة معلناً فوز أحدهم وسط دهشة الفضوليين وتعليقاتهم، دخان سجائر، نقاش فكري هنا، نقاش لغوي هناك. هذا الصنف من المثقفين لا يعرف من الثقافة غير خطب وخطابات ولا يعرف من الكتابة سوى جُمل صبت في قوالب صدئة جاهزة للاستهلاك بنكهة خاصة، حسب هوى المثقف السياسي المتقلب.
لا أقول إن جميع المثقفين المهاجرين من غير الشباب هم من هذه الطينة، فهناك بالتأكيد مثقفون بصفات مختلفة، مرتبطون بالعصر وتطوراته، ولديهم رؤى خلاقة ويؤمنون خصوصا بالقوة الشابة وما تعتنقه من أفكار، وما يأسرها من تطلعات مستقبلية. لكن هذه الفئة من المثقفين شديدة الندرة.
يبقى الرهان على الشباب في الوطن والمهجر، وأهمية التواصل ونقل المهارات المكتسبة في الخارج، فمدن مثل بغداد عظيمة بماضيها لا تموت، أبدية وأزلية البقاء، المدن والحضارات لا تُقيّم ببنيانها وعمرانها، بل تُقاس بمواردها البشرية والعلمية. العقول والمواهب والمهارات ما زالت، وإن كانت بعيدة، بغدادية الوجدان، منتظرة على أحرّ من الجمر الرجوع إلى الوطن لبناء ما خربه سياسيو المصادفة ومدّعو الثقافة.


