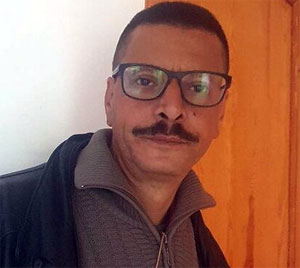للإنسانية شكل إحساس

من سخرية الحياة أننا نتخلّف عن مواعيد هامة بينما معظم أوقاتنا تضيع في أمور غير هامة! حين لا نفهم الحياة بشكلها الصحيح، تقسو علينا وتعاكسنا ونصبح دوما متسابقين مع ممثلها الدائم السيد ”وقت”، في محاكات ومجاراة معه (شد لي، نقطع لك) ولا قضية تربح معه إلا حين يريد فترة راحة فيترك مكانه أحيانا للبديل المؤقت السيد “وقت مثالي” وهذا الوقت المثالي تصادفه فقط في أشياء غير مهمة أحيانا تافهة تفاهة هذه الحياة وكأنه يعرفك جيدا ومطلع على أهوائك يعرف رذائلك كلها وماذا تريد بالضبط هههه، أنا لست متأخرا بطبيعتي كما وصف أحد عرابي الأدب ذلك في مقالته المتأخرين! لكني تخلفت عن مواعيد هامة جدا كان بالإمكان أن تغير شكل ونظام حياتي اليوم.. هي مواعيد أسميها ضياع الفرص! ومن سخرية الحياة أن الفرص مهما قلّت أو كثرت عند أيّ شخص تبقى مفاتيح مهمة لفتح أبواب المراحل وجعل المستقبل أكثر اطمئنانا، لكن بشكل أو بآخر عندما تصل أحيانا في الوقت المناسب وتريد الدخول، لا تجد المفتاح أو تجد قاعة انتظار وطابور مثلك وصل في الوقت المناسب، لأن السيد “وقت مناسب” هو شخصية مهمة وعليه إقبال شكله ذلك المسؤول الكبير المكلف بمهمة وصاحب قرار يغير حياتك فتبقى مدة تدور في نفس المكان لعل وعسى والسيد وقت ينتشي بذلك عندما تتوقف عن الدوران دون راحة تجد سنوات من العمر ضاعت هباء منثورا
لكن ومع ذلك في لحظات تأمل مع النفس ورغم ذلك فحياتك تبقى أفضل ممّن توفرت له عدة فرص واستغلها ونجح بالمفهوم المتعارف عليه… المهم! ولو تعتقد أنك قد تصل في الوقت المناسب حتى لا تنتظر أو تسمع جئت متأخرا وتصادف ربما معيقات التأخر إما مكانا محجوزا دون علم الغاشي والماشي ولمن سيأتي بعدك أو جاء قبلك، أو بند ميزانية غير جاهز لمشروع لم يسطّر بعد لكنه يدخل في المخطط الخماسي، خماسي خماسي شخصية خمس أجزاء علمية أو أوا أو أو أوا أو أو هكذا هي سخرية الحياة وهي مطبات في الطريق تجعلك تنتبه إلى السرعة التي تسير بها نحو الوصول إلى الأفضل، أليس كذلك! أليس كل ما يصبو إليه أيّ إنسان هو تحقيق الأفضل له؟ وهذا في حد ذاته إشكال لأن غالبا الأفضل يصبح غاية فيها منافسة ونحن أصلا لا نعرف ماذا سيحدث خلال دقيقة أو شهر أو عشر سنوات، فبسبب الأفضل الكثير منّا ينسى أنه إنسان، وغايته تبرر الوسيلة فتغيب الإنسانية مع هذه الفكرة، نفقد الصورة الإنسانية بداخلنا لنصبح متهافتين على المادة، حب المادة يقتل إنسانيتنا ويفقدنا الشعور بحب الخير للآخر، “أحب لغيرك ما تحب لنفسك”.
المهم ومع كل هذا وذاك ليست الصورة قاتمة بعد لأن طبيعتنا الأولى هي الخير وإذن إنسانية بطبيعتها، لكن نفتن حين ننشغل في كل الأمور ونريد كل شيء ونأخذ كل الأمور بجدية، لكن حين لا نبالي بها ولا نأخذها محمل جد نستمتع بالوقت ويصبح بجانبنا فنستأنس كذلك بأمور خارج نطاق كل هذه السخرية حين نجعلها بسيطة وسهلة، ونحب الوقت الراهن بما فيه ولنا، أشياء، وأشخاص إلى ما ذلك نقدم الجمال إليها ويعود إلينا بالجمال لأننا فهمنا المهم أحببنا أعز ما عند السيد وقت وهو سيد وقت الراهن وبذلك فهو لن يعاكسنا ويضبط وقتنا على وقته هذا بالضبط ما يجعل الأمور بعدها تتزن ويتزامن وقتنا مع أوقات جميلة أخرى ربما من يدري.. فنضج الإنسان في بعض المواقف هو الذي يعطي للإنسانية لون الحياة، يقترب الإنسان أكثر إلى الله عندما يصبح قادرا على وضع نفسه مكان الآخرين وفهم مشاعرهم الدفينة دون التعبير عليها، والتعاطف معها دون أيّ مرجعية فقط من باب الحب غير المشروط للمحيط وكل من يتقاسمه معه هي أسمى علاقات الإنسان مع الكائنات.
ما يجعل الفرق بيننا هو فقط الإحساس والشعور بالآخر وبعض التعابير! كمّ الإحساس الذي بداخلنا هو وحده الذي يجعلنا في مراتب مختلفة، نكون إنسانيين أكثر حين تتداخل مشاعرنا بالآخر ونشعر به، نحسّ ولو بالقليل مما يشعر به أو ما يعيشه، عندما نشعر بالآخر نرتقي إلى مرتبة إنسان وعندما نعبر عن الصورة بإنسانية نرتقي أكثر بأرواحنا لتصبح نورانية، وعندما نحاول الشعور في صورة أدبية نسمى أدباء! ونصف دواخل آخرين رأوا نفس الصورة أو المشهد وخانهم التعبير، وأحيانا أخرى نكون قادرين على التعبير لكننا لا نستطيع وصف الصورة، لأن كمّ الإحساس بداخلنا تفاقم صعد وارتفع وتضخم فأغلق فوهة الخروج، كتلة مشاعر صعدت وتضخمت فمنعت خروج التعبير وإن حاولنا التعبير يكون غصة هكذا ببساطة شكل الإنسانية داخلنا، هذا هو العالم غير المرئي فينا، أما وربما حين يلتقي الغني بالفقير أحيانا يشعر به ولو أنه لا يعرف معاناته ولكنه يوبخه على فقره، يقول له أنت من أراد ذلك! في ضرب لكل مبادئ التعاملات الاقتصادية ويمحو كل أشكال الأزمات الاجتماعية والسياسية والتاريخية ويحمله مسؤولية فقره دون مراعاة للشعور في حد ذاته، الشعور الإنساني الآني كأنه يلومه على فقره لأنه لم يفعل شيئا مما فعله هو.. عالمه الداخلي يقول ذلك، لم يغامر أو يكتشف أو يحاول أن يجازف، لم يقم بما قام به الغني حتى أصبح غنيا! هل نبحث ماذا فعل ذلك الغني العصامي حتى أصبح غنيا في زمن الأغنياء الجدد! لا يحتاج، قد يكون ربما أقصى ما فعله بعد أن كدّ وجدّ وثابر وغامر وفشل ثم سقط ونهض من جديد لم ييأس ثم واصل وسقط من جديد حتى جاءته مكالمة من أميركا بأن أحد أقاربه توفي وله أملاك كثيرة وهو مليونير وليس لديه أبناء وهو الوريث الوحيد، نعم هكذا ممكن؛ لكن في المقابل لم يقدم للفقير أيّ فكرة مهمة لتجاوز فقره، بل حتى أنه لم يساعده في الخروج من حالته المزرية تلك ولو لدقيقة! لماذا! بينما حين يلتقي الشاعر أو الأديب في طريقه مشهد معاناة إنسانية، فقلبه يدمع قبل عينيه ويخرج ما لديه من تعبير وهو يمد يد المساعدة بما يستطيع، وإن لم يسعفه الحظ في المساعدة يتألم أكثر هكذا ببساطة يكون الكتاب والشعراء دوما مرتبطين أشد الارتباط بالمجتمع الذي يعيشون فيه ويصورون كل المشاهد لتصل إلينا حارة بتعابيرهم القوية، لو كانوا يريدون السياسة أو الاقتصاد لحكموا العالم، لكنهم وصلوا قلوبنا دون ذلك بنقاوة قلوبهم دون خبث، طرقوها دون استئذان سمحنا لهم بالدخول لأن قلوبنا من قلوبهم نظيفة وجدناهم أحباب الإنسانية، كلمات الشعراء والأدباء لها وقع كبير في نفوسنا، لأنها قبل ذلك خرجت من أعماقهم، وشعروا بما كان يشعر به الآخر، المنفلوطي بكى حين رأى الأرملة الرثة ووبخ الزمن في أروع قصيدة وصفت فيها قسوة الحياة، كذلك ومثال نجيب محفوظ وطفل إشارة المرور الذي يبيع الحلوى ووصفه الرائع من حلم طفل بالحلوى إلى طفل يبيع حلمه، وقبلهم فيكتور هوجو، كل هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن للإنسانية عدة أوجه وأجمل وجه فيها هو وجه الإحساس بها! حين نحلم بالحلوى فلن نبيعها، كذلك كل الأحلام، نحلم ونحاول الحصول على ما حلمنا به هذه هي حقيقتنا.