نظرة على أهم الكتب
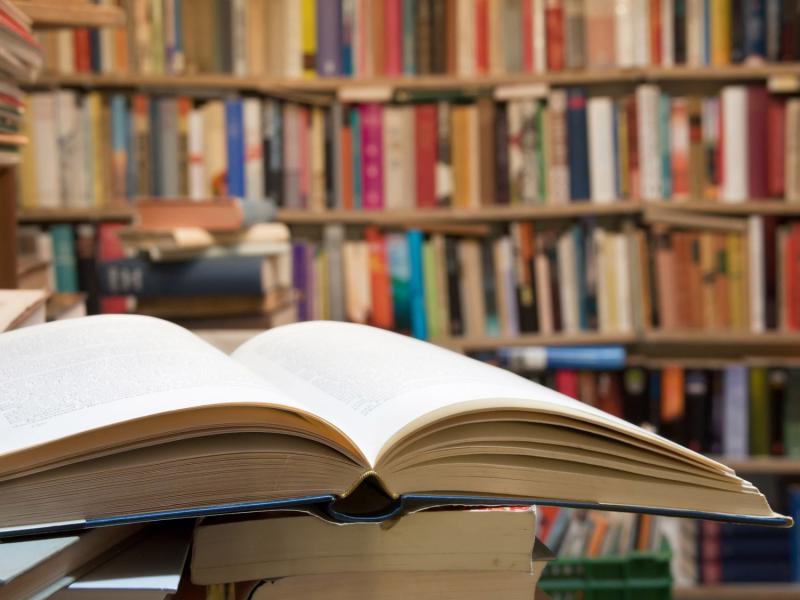
الضيافة في زمن الهجرات المتعاقبة
إن وضع الغريب مقبل على الانتشار. ولكن التنقل الذي يطيب لبعضهم تمجيده يصطدم بالحدود التي تقيمها الدول/الأمم أمام المهاجرين الذين لا يعامَلون كضيوف بل كأعداء، لا سيما في هذه المرحلة التي شهدت تفاقم الحروب وتزايد الهجرات هربا من ساحات المعارك، ما اضطر بعض الأهالي إلى التمرد على القوانين الجائرة التي تفرضها حكوماتهم، ومدّ يد المساعدة لغرباء لا سقف يؤويهم ولا طعام يغذيهم، فأيقظوا بذلك تقليدا أنثروبولوجيا قديما هو الضيافة. بيد أن ذلك لا يكفي، فاستضافة غريب أو إطعامه وإسكانه كلها قطرة ماء في بحر التيه العام. في كتابه “الغريب الذي يأتي”، يعكف عالم الأنتروبولوجيا الفرنسي ميشيل أوجيي على إعادة استقراء مسألة الضيافة، من منظور الأنتروبولوجيا والفلسفة والتاريخ، ليبين قدرتها على إزعاج المخيال الوطني، لأن الغريب الذي يأتي هو في الواقع يطلب منا أن نفكر بشكل مغاير في موقع كل واحد وكل واحدة من العالم.
كيف تنشأ الشعبوية

خطاب الساسة والإعلاميين والمحللين والباحثين يكاد لا يخلو من عبارة “الشعبوية” في الأعوام الأخيرة، ورغم ذلك تبدو العبارة عصية على التفسير والتأويل، بل قد تحمل أحيانا معانيَ تنأى بها عن المراد. في كتاب “عودة الشعبويات”، يقترح مجموعة من الباحثين تحت إشراف برتران بادي ودومونيك فيدال قراءة تاريخية ومعاصرة لهذه الظاهرة، وتحليلا لعودتها بعد سبات، وإذا كان المؤرخون يساعدوننا على معرفة كيف ولماذا تظهر الشعبوية وفق موجات متتالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، فإن مقاربات أخرى سوسيولوجية وسياسية واقتصادية تكمل هذا المسعى، للوقوف على الملامح المشتركة في عدة تجارب متنوعة، وأعراضها – من عبادة الزعيم إلى تقنيات الدعاية الديماغوجية – وممارساتها المتكررة. آخرون يتساءلون ما إذا كانت ثمة سياسة أو سياسات شعبوية متناسقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية، ويضربون أمثلة عن التجارب الشعبوية المعاصرة، من ترامب إلى بوتين، مرورا بشافيز وأردوغان.
الحس النقدي منذ الطفولة
“البيداغوجيات النقدية” عنوان كتاب جماعي صدر تحت إشراف الباحثتين المتخصصتين في علوم التربية لورانس دوكوك وإيرين بيريرا، وهو يشكك في السياسات التربوية الفرنسية الحالية، ويرى أن الحكومات المتعاقبة لا ترى في التربية أكثر من مسار تأهيل شخصي، وأن البلاد نفسها لا تشجع على الأعمال المشتركة ولا تهتم بظروف تدريس المعارف. فقد خيرت تشجيع البيداغوجيات البديلة المستوحاة من رؤية منزوعة البعد السياسي، ومارستها في مدارس الأثرياء وحدها، وفق منطق فرداني. والكتاب يقترح بيداغوجيات انفتاح جماعي، تستثير في المتعلم حاسته النقدية وتدفعه إلى الوعي بعلاقات الهيمنة كالعنصرية والجنس والطبقية وسياسة الميز، لكي يعرف كيف يلغيها، والغاية هي خلق مجتمع لا يكون فيه الفرد هو ذاته برغم الآخرين، بل لوجود الآخرين أيضا. والنموذج الذي يدعو الكتاب إلى الاحتذاء بتجربته هو سيليستان فريني المعلم الفرنسي الذي أرسى قواعد بيداغوجيات نقدية في النصف الأول من القرن العشرين، ثم تبعه ابنه الروحي البرازيلي باولو فرير. هذه التجربة التي تطورت في القارة الأميركية والعالم الأنكلوسكسوني منذ ثمانينات القرن العشرين وتجاهلها الفرنسيون.
نوستالجيا أوروبية
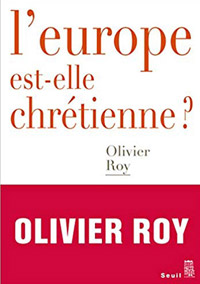
هل أوروبا مسيحية اليوم؟ وكيف؟ هل يمكن أن تستمر كذلك بتبني مواقف نوستالجية، سلطوية، هووية؟ وعن أي مسيحية يتحدث إذن أولئك الذين يضعون “القيم المسيحية” في مواجهة موجتين يتوجسون منهما من حيث القوة والتهديد، أي مجتمع مفرط في العلمانية وإسلام غاز، كعلامتين عن الانهيار الحالي؟ أي معنى، وأي روابط، وأي منطق يمكن تلمسه في الصخب الذي يملأ المنابر الإعلامية والتجمعات الحزبية أحيانا عن حقائق الإرث الأوروبي التي تقدم كثوابت: مسيحية، علمانية، هوية، ثقافة، قيم، معايير، حقوق… في كتابه الجديد “ألا تزال أوروبا مسيحية؟” يحلل أوليفيي روا، المتخصص في الإسلام السياسي، والأستاذ بالمؤسسة الجامعية الأوروبية بفلورنسا، وضع الأوروبيين بوصفهم أيتام ماضيهم المسيحي، الذي لا يمكن إنعاشه بسنّ قوانين، بل ربما بأنبياء.
العالم الرقمي على مقاس جماهيري
“المناطق الجديدة للمنظومة الرقمية” كتاب مبسط عن الثورة الرقمية وأثرها على التراب الفرنسي والأوروبي والعالمي ألفه بيير بكوش، المنسق العلمي لمشروع إسبون (ESPON) الأوروبي، وعضو المجلس العلمي لمؤسسة التوقعات الاقتصادية في حوض المتوسط، ورئيس المجلس العلمي للمعهد الدولي لعلوم المناطق. هدفه الأول بيان أن الرقمي يفرض نفسه بسرعة كمسرح عمليات كانت من قبل ترجع بالنظر إلى مجالات مختلفة: أسري، سياسي، مؤسساتي، مديني، فني، ميدي، اجتماعي، طبي… أي كل مجالات الحياة، العامة والخاصة. أما الهدف الثاني فيتمثل في إبراز أهمية المقاربة الجغرافية للثورة الرقيمة. أولا لأن ذلك يعطي بعدا ملموسا لتلك التحولات متعددة الأشكال. وثانيا لأن المناطق تظل ميدانا يمكن أن يندرج فيه المتقطع والمحدود، فيما العالم الرقمي هو عالم تواصل واكتمال ليس له حدود، من أجل غاية نبيلة كالخلق والابتكار، أو غاية دنيئة كالشمولية والطغيان.
جينالوجيا الليبرالية المتسلطة

جديد غريغورا شامايو، الباحث في مركز البحوث العلمية بليون، كتاب بعنوان “المجتمع المستعصي على الحكم”، ينطلق من سبعينات القرن الماضي حين طغى الحديث عن أزمة الحوكمة” في فرنسا مع ميشيل فوكو، وفي أميركا مع صاموئيل هنتغنتون، قبل أن تصبح ظاهرة شغلت عالم رجال المال والأعمال الذين وجدوا أنفسهم أمام تمرد عمالي كثيف، ومظاهرات إيكولوجية غير مسبوقة، وتنامي تعديلات اجتماعية وبيئية، ما خلق “أزمة ديمقراطية” جعلت الدولة مستعصية على القيادة، وصارت تهدد بتقويض ما هو قائم. بهذه المناسبة تم إعداد فنون تسيير جديدة كحركة مضادة لم يغادرها الغرب، يشرح الكتاب مصادرها وتاريخها الفلسفي، فنتبين كيف شنت الحرب على النقابات وفرضت أولوية قيمة المساهمين، ووضعت عدة أساليب هيمنة لنزع السياسة. وخلافا لما استقر في الأذهان لا تعتري الليبرالية الجديدة فوبيا الدولة بشكل أحادي. والاستراتيجيات التي رسمت للخروج من تلك الأزمة تجنح إلى ليبرالية متسلطة حيث ليبرالية المجتمع تفترض عمودية السلطة، لتغدو “دولة قوية” لأجل “اقتصاد حرّ”.
فلسفة العنف
برغم دروس التاريخ لا تزال بعض الأرواح عديمة القيمة في نظر من يرديها قتيلة دون خوف من العقاب، كما يحدث في أماكن كثيرة من العالم. ما دفع أناسا كثيرين على التسلح والتدرب للدفاع عن النفس. وهو موضوع كتاب “دفاعا عن النفس″ لإلسا دورلان أستاذة الفلسفة بجامعة باريس 8، وتقصت فيه جينالوجيا فلسفية عن الدفاع عن النفس سياسيا. فاستعرضت القانون الأسود لعام 1685 الذي كان يمنع العبيد من حمل السلاح والهراوات، وقانون الاستعمار الفرنسي في الجزائر الذي كان يبيح للمستعمرين حمل السلاح واستعماله ويحظره على الجزائريين، لتؤكد خط الفصل الذي يضع الأجسام “الجديرة بأن يذاد عنها” في مقابل أجساد المنزوعين من السلاح المتروكين بلا دفاع أو حماية. نزع السلاح هذا يطرح مسألة لجوء الفرد إلى العنف دفاعا عن نفسه. وتحت التاريخ الرسمي للدفاع المشروع نجد ممارسات قديمة يكون فيها الدفاع عن طريق الهجوم شرطا للبقاء وضمان مستقبل سياسي. تاريخ العنف هذا يلقي الضوء على مفهوم الذاتية العصرية كما صاغها سياسيو الأمن المعاصرون، وتفترض إعادة قراءة نقدية للفلسفة السياسية حيث يجاور هوبز ولوك فرانز فانون ومالكوم إكس أو جوديث باتلر.
التعذيب بغير نتيجة

يبدو التعذيب في الثقافة الشعبية، كما تنقله الأفلام والروايات، ضرورة قصوى وأخيرة لانتزاع أسرار وإنقاذ أرواح. وهو ما يبرر به عملاء الـ”سي آي إيه” مثلا وكل المستنطِقين حينما يلجوؤن إلى القسوة لإنطاق المظنون فيهم. ولكن الفكرة خاطئة، كما بين شين أومارا، أستاذ علوم الأعصاب في ترينيتي كوليج بدبلن، في كتاب عنوانه “لماذا لا يفعل التعذيب فعله”، فالمخ الواقع تحت الضغط لا يعمل كما يعتقد الجلادون، حسب ما أثبتته نتائج علوم الأعصاب حول ردود الأفعال الدماغية إزاء الخوف والحرارة المرتفعة والحرمان من الأكل والشرب والنوم وكل أدوات التعذيب. ذلك أن عوامل الضغط تلك تعكر الذاكرة والذهن والمزاج إلى حد يُفقد المعلومةَ المتحصل عليها أي صدقية، وأن القدرات الإدراكية للشخص الخاضع للتعذيب تتدنى بشكل يصعب معه نقل ما يعلمه. في هذا الكتاب، يأخذنا أومارا عبر مسالك الألم والعذاب، ويرينا بالتفصيل كيف أن كل الحجج التي تساند التعذيب لا تصمد أمام الاختبار العلمي.
الحيوانية البشرية
ثمة شيء تغير في علاقتنا بالحيوانات، فقد صارت القضية الحيوانية تطرح في كل منبر، حتى غدا الإنسان أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان. ذلك ما ذهب إليه إتيان بمبيني، أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة بوردو، في كتابه “عقدة القردة الثلاثة”، وفي رأيه أننا نكسب كثيرا من صورة الإنسان الجديدة تلك، فهي تأتينا من بيولوجيا التطور التي وضعتنا، في سلم الحيوانات الرئيسية، إلى جانب القردة، وهي تذكرة أيضا بضرورة ترشيد علاقتنا بالحيوانات التي نستغلها، لا سيما أننا نحترم بقدر أكبر من يشبهنا. وفي رأيه أن الحيوانية البشرية تجعل منا أقوياء ذهنيا، لكوننا تخلصنا من الثنائيات والتقسيمات الميتافيزيقية القديمة، وأن ذلك يعكس فكرا تقدميا منفتحا على العلم، سخيا مع الحيوانات، مستنيرا فلسفيا. فهل نستطيع أن نتجنب “عقدة القردة الثلاثة”، تلك الكيفيات الثلاث التي تشير إلى أننا نجهل ما نعيش ونفعل كبشر أحياء؟ وهل نستطيع تصور تقدمية حقيقية تعي كل ما ندين به للحيوانات، دون أن ننكر من نحن؟
الآلة كوسيلة لسحق الإنسان

“إتقان التقنية” كتاب للألماني فريدريخ جورج يونغر وضعه عام 1944 ردّا على أخيه إرنست يونغر الذي مجد في كتابه “العامل” السير المحتوم نحو آلية عامة، وبشّر بقدوم عالم جديد. وخلافا لأخيه، يؤكد فريدريخ على الآثار الوخيمة التي سوف يخلقها تطور التقنية، لأنها في رأيه سوف تتبع منطقها الخاص القائم على بسط نفوذها التنظيمي وتطويره حدّ الجودة. فالمبدأ الذي تقوم عليه ليس اقتصاديا، لأن الاقتصاد يسعى لتحقيق الربح، أما التقنية فهي شرهة، مفسدة، لا تني تتلف الموارد، تتنامى على حساب استنزاف الأرض، تُنضب خصوبة هذا الكوكب لتؤكد قوتها إلى حدّ انقطاع الموارد، وزوال ما يمكن أن يغذي شراهتها. في هذا الكتاب يؤكد يونغر الصغير أن إخضاع الأرض بواسطة التقنية ليس مصدر ثراء، وإنما هو توزيع فقر متنام على جمع متزايد يتم حشده لهذا الغرض، وبذلك تكون البروليتاريا والآلة متصلتين ببعضها بعضا بشكل لا رجوع فيه، ويكون الإنسان حلقة خاضعة للآلية التقنية التي تفرغ الوجود من معناه.
ما بعد اللائكية
المعجزة قد تكون مدنّسة وحديثة، تلك هي الملاحظة المدهشة للفيلسوف الهولندي هنت دي فريس. ففي رأيه أن المعجزة اليوم هي الحياة نفسها، لم تعد مسألة دينية بل صارت ناتجة عن تأمل النظام الطبيعي الذي يصيبنا بالذهول. ولكن التسليم بأن كل شيء من قبيل المعجزات قد يؤدي إلى اعتبار الخوارق أمورا معتادة. عندما تقدم لنا تكنولوجيات الاتصال مزيدا من الأحداث يوما بعد يوما فإننا سوف نجد صعوبة في التمييز بين المكرر والجديد. لذلك، “قد تشترط الميكانيكا تصوفا” كما يقول برغسون، فنمسك عندئذ بأحد المفاتيح لفهم عودة الدينيّ الذي ينتج في جانب منه عن الحاجة إلى تصور الأحداث الخارقة غير كونها مجرد أحداث تتوارد في الزمان. والمؤلف يستحضر فيتغنشتاين وستانلي كافيل لتَصوّر عصر “ما بعد لائكي” يُحلّ الإعجاز موضعا يُتقبَّلُ فيه كأمر عادي، ليس لأثره سبب بالضرورة. يقول الكاتب “قد نعيش فترة ينبغي خلالها تعلم التفكير من جديد، وكذلك العيش، وقبول فكرة أن كل شيء ممكن.”
عن الحقيقة وما بعدها
“ما بعد الحقيقة” ليس فقط مفهوما عابرا يشجب تهافت نظريات المؤامرة أو الـ”فيك نيوز″ التي عششت في البيت الأبيض، بل هو جوهر مرحلتنا” بعبارة الفيلسوف الإيطالي موريسيو فيراريس في كتابه الأخير “ما بعد الحقيقة وألغاز أخرى”، ومثلما كانت الرأسمالية جوهر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والميديا جوهر الأعوام الأخيرة من القرن العشرين. فـ”ما بعد الحقيقة” في رأيه هي لقاء بين نسبية فلاسفة ما بعد الحداثة الذين يؤمنون بأن كل شيء تأويل، وبين الإنترنت الذي يمنح كل شخص إمكانية نشر حقيقته التي تحوز تعريفا مبسطا: أقول الحق. وبذلك يتجاوز مفهومُ “ما بعد الحقيقة” الكذب بفرض “حجة الأقوى” غير عابئ بالوقائع. الجدة لدى فيراريس تتمثل في ربطه الميتافيزيقا الخالصة (عن طريق طرح أسئلة مريبة من نوع: هل هذه الطاولة موجودة خارج إدراكنا إياها؟ وهل صحيح أن الثلج أبيض؟) بنوع من التفكير التكنولوجي.




