هذا القبر صومعة.. هذا المدفون راهب

الآن. في عتمة مليئة بالتوجسات، وغياب مجبول بالبرد، عليّ أن أذكر ما كان. بين زمجرتين للحديد عليّ أن أكسر جدار النسيان والكتمان. بين زمجرتين للحديد، تباعدتا، أم تقاربتا، سيكون لي ناس وأيام وبلاد أكبر من ظلمات الأرض والسماء. هنا، في المكان الضيّق الذي يسمونه منفردة.
طولها يتيح لجسدي أن يتمدد، ويترك لي عرضها فرصة إسناد ظهري وحكّ أصابع قدمي بالجدار المقابل. السقف يسمح لي بالوقوف، وهم لا يسمحون. وماذا أيضاً.. لديّ ثلاث بطانيات صغيرة، تتبادل أدوار الفراش واللحاف والغطاء. صحن وكأس وملعقة من البلاستيك. أهذا كل شيء؟ لا يهم، هذا خارج الموضوع. ما لدي هو ظلام يترك لك أن تغفو على ساعدي روحك. ينتشر مساحات إن اتسعت أفكارك، ويلتصق بجلدك إن ضاقت. ولديّ زاوية بين حائطين، أستطيع أن أحتفظ فيها بكل ما تحضره الذاكرة من أشياء. وتوجد رائحة رطوبة أو رائحتي أو رائحة ثالثة مكونة من رطوبة ومني. وأيضاً.. صوت وقع أقدام السجّان الذي لم يعرفني يوماً، لكنه يكرهني كما لو أن صورتي محفورة في رأسه منذ جززت عنق أبيه، وشخر بين يدي، فقط لأنه منعني من اغتصاب أمه، فلما رأت زوجها يهوي صريعاً، دقت مخالبها في صدري، فقتلتها بدم بارد، ولما كان السجّان صغيراً، حاول أن يضربني بيديه الناعمتين، فلم يبلغ ركبتي، فرحت أقهقه كمارد شرير، ولمّا مللت صراخه، رفسته ووضعت حذائي فوق وجهه، بل وربما تماديت فدست فوق جبينه الصغير، ثم رحلت.
ماذا لدي أيضاً؟ نعم.. صنبور ماء يمد رأسه فوق أجمل أشيائي، شيء يشبه الحفرة، وليس بحفرة. يسمونه هنا (بخشة)، ونقول عنه بطة، وفي الكتب قد تجده في باب “مرحاض”. هذا أروع ما لديّ. ليس فقط لأنه أقرب ألوان كهفي إلى الأبيض، بل لأن ثقباً في شبك الحديد الذي يغطي أعلى بوابة المنفردة، يترك لحزمة رقيقة من الضوء أن تسقط فوقه فأراه أبيض. ودعوني أقول أيضاً، حين تكون قريباً من هذا البياض إلى هذه الدرجة، لن تحتاج إلى كثير حركة كي ترسل خيطاً من ماء النشادر فوق صفحة بياضه، فترسم من سريرك الحجري المرتفع قدر قدم، ضربت حتى الشبع، ما تريد. ثم تأمّل ما يمكن أن تريك إياه الحزمة الرقيقة من التماعات وإضاءات، حتى كأنك في ملهى ليلي، ربما ثمل بعض الشيء، لكن سطوتك في الملهى تجعلك تتمدد وأنت نصف عار فوق الأرائك كأنك هارون الرشيد، ثم انظر وتخيّر. أجمل نساء الأرض يستعرضن أمامك، ما حولهن وما بينهن، فإذا هاجت نفسك، وأردت إحداهن فلن تضطر للحراك أيضاً، فقط أرخ رأسك، واذهب إليها وبها، كيف تشاء، ولا بأس بعد ليلة تضيء الجلد من بعض النظافة، وإن بماء بارد ينز من صنبور، أنت في النهاية، تحبه. أما إذا لم تعجبك أيّ امرأة باعها لك خيالك، فما عليك سوى أن ترفع سروالك لتعود إلى عمل آخر.. وما أكثر الأعمال هنا.
ربما عليّ الاعتراف. لا تسير الأمور دائماً بهذا اليسر. يحدث أحياناً أن ترغب بواحدة منهن، لكن رأسك يأبى الاسترخاء، فتحاول نيلها في صحوك. تمسك، تهتز، تتوتر، فإذا بها تفلت، وإذا بجميع الفتيات يختفين بلمحة بصر. لا يبدو مفهوماً لماذا يكرهن الصحو إلى هذه الدرجة. بيد أنني أنظر إلى الأمر بموضوعية، فمهما كانت جاذبيتك، لا بد وأن يكون هناك فتاة لا تنسجم ومدارك.. القصة قصة شحنات.
النتائج الأسوأ تحصل حين لا تحصل على الفتيات، ولا يختفين، بل يأتي الشاب الذي يكرهني أو أيّ من أخوته الأشقاء اللئام، فيزمجر بحديد الباب، ويدفع بصوته من الباب كفقاعة من القذارة ظلت جرذان المصارف تكورها عصوراً:
ـ لبرّه يا حمااار.
وكما تعلمون. لا نستطيع شيئاً أمام قوانين الفيزياء، فما إن تدخل فقاعته ظلام ملهاي، حتى تُقذف الفتيات خارجه، وأقذف أنا خلفهن في عراء الممر. لكن الشاب لم يخطئ يوماً في تلقفي، مهما كنت لصيقاً بهن. يمسكني كما أمسكت أباه. ولرقة قلبه، يغطي عينيّ بأنشوطة سوداء، يسميها (طميشة)، كي لا يقتلني الشوق إلى الظلام الذي غادرته، وربما أيضاً لأنه لا يريد لبراءتي أن تخدشها مشاهد الجريمة، كما حصل معه في طفولته. ثم يزيدني حناناً فيقودني من رقبتي كي لا أتعثر أو أخطئ الطريق، فقد أخبروه ـولا بدـ أن التعثر والخطأ، صفات ورثتها عن أجدادي.
بيد أن جمال البياض لا ينتهي هنا، وإلا لما أسميته الرائع، فالضوء النحيل الذي لا يفارقه، يجعلني أشرق حتى حين أقرفص فوقه. ليس هذا من علم الماضي، وإنما من علم الظلام، فأكثر الأمور اعتيادية تبدو أشدها معنى حين فقدانها. ما الذي كان سيحصل لو أن الضوء النحيل انقرض. هل عليّ أن أشرح ما حدث حين أخطأ مسؤولو الكهرباء فقطعوا التيار عن المجرّة التي أقبع في قبوها. هل يمكن تخيّل مجرّة بلا نجوم. يومها حبلت نجوم ضباط الفرع سخطاً، ولولا أن تداركت الكهرباء نفسها فأعادت التيار محملة كل إلكترون اعتذاراً وقبلة استسماح، لرأينا أهل وزارة الكهرباء في كهفنا، ولجعلوهم يرون نجوماً من نوع ثالث هذه المرة. غير أن القصة لم تنته، إذ كان الانقطاع قد أحدث عطلاً في كوكبنا، فقضي علينا أن نبقى دهراً نجلس، نحن أصحاب الكهوف السفلية، بلا بياض.. أي .. بلا أيّ لون!
جميعنا كنا في العتمة ذاتها. امتداد لا تعرف أين يبدأ لتعرف أين ينتهي. في البداية، شعرنا بفرحة سوداء، لكنها فرحة. ربما كنا نتمنى أن تكتمل عزلتنا، أن نبلغ انفصالنا الكلي عن أيّ نأمة خارج ذواتنا. الذات التي تكورت جنيناً في رحم أكبر من أن نملأه فنخرج. كنا نحس معاً بالاتساع في ظلام يشمل الكوكب، وكل يشعر بالاكتمال في دائرة تنغلق على سواده الخاص.
هكذا قيّض لنا أن نعيش حال زميلنا الأعمى. وفي حين كان هو يحفظ تاريخاً من التجربة، كنا نحن نحبو في ظلام الولادة. سرعان ما لفّنا الجهل والضعف. راحت دوائر التساؤلات تخنق أنفاسنا: كيف كان للظلمة أن تقسم أجزاءها؟ بأيّ لون رسمت المكان والأشياء؟ ربما كان سؤالاً غبياً، لكنك حين تتحرك في لون واحد، فتصطدم بجدار، وتتعثر بصحن، وتنزلق في حفرة، ستقف مذهولاً أمام حقيقة أن الأشياء موجودة ليس لأنك بينها وتحس بها، تحملها، أو تتجنبها، أو تنام فوقها. إنما لأنها موجودة، وتعرف أكثر منك كيف وأين توجد. بل إنك لا تشعر بوجودك، بحيّزك، إلا حين تصطدم بها. تصبح هي، الأشياء، تحدد وجودك. كلما تهت عنك دلّتك قرقعة الأشياء على جانبيك.
في ضياع كهذا كان يمكن لأذنيك أن تسعدا. صرنا نُهرّب أصواتنا، الوحيدة التي لا خوف عليها من الاصطدام، نهرّبها بين الكهوف. كنا كصراصير الليل، لا نكف عن الأزيز. أصوات بلا تاريخ، تقول الكثير: همهمات، نحنحات، سعال، ولا مفر، كان هناك نحيب وبكاء.
لم نستطع أن نرتقي عن حال الصرصور لنصبح خفافيش مثلاً فترشدنا آذاننا. كان ذلك يتطلب أجيالاً من حياة الكهوف. ولم يكن بمقدورنا، ونحن في حنين للجلد المتيبّس في كعوب أقدام أهالينا، أن نعتب عليهم لاختيارهم النور بدلاً من الظلام.
الهمّ الأكبر الذي خلّف وجعاً في قلوبنا، لم نفهمه، ولم يزُل، كان الحفرة التي لازلنا نذكر أن لونها لم يكن كالذي يملأ عالمنا. ليس حنيناً فحسب، بل مأساة أن نقرفص فوقها، لنُخرج ما اعتاد البشر على إخراجه منذ بدؤوا وجودهم. لا أظن أن أحداً منا فكّر في الأمر، أو حدس أننا سنعاني في هذه الحركة الطبيعية. لا يبدو الأمر صعباً. بعض العناء في الوصول. وضع القدمين في المكان المناسب، بقليل من الحذر والهدوء تستطيع أن تتحسس الأبعاد، وسترشدك الأشياء الصديقة. لكن ما إن تخلع سروالك وتهبط مقرفصاً حتى تغيب الدنيا. ليست الدنيا الغائبة أصلاً، بل تلك المتبقية في سراديب داخلك. حين تقرفص.. هل تعلم أنك تحدق في شيء ما. نحن عرفنا ذلك هنا، وكل منا واجه التجربة وحيداً أمام ماذا.. هل أقول أمام غائطه. أردنا رؤية شيء لنحدق فيه. لو أن خيط الضوء يتسلل فيرينا نملة تتحرك على بعد أميال. النملة سوداء. نحن نريد فقط نقطة ضوء فوق رأسها أو ظهرها، كان ذلك سيعني بهجة كاملة. لم يكن أمام أعيننا شيء، لم يكن هناك أمامٌ لأعيننا. كلما جاهدت لتستحضر شيئاً من تاريخ النور، لا تحظى بغير خيالات سوداء. كانت عيوننا مثلنا، تدور في كهف محجرها، كما ندور. يفاجئها الجدار كما يفاجئنا. في غمرة خيبتنا ننسى ما قرفصنا لأجله. نغمض أعيننا علّنا نحس فرقاً بين ظلام بجفون وظلام من دونها، فنفشل. نركز نظرنا ونحدق كأنما نريد حرق الأردية السوداء التي تلفّنا، أو نكسر زجاج حوض الماء الأسود الذي بَدَوْنا غرقى فيه، فنشعر بأصابع تضغط فوق عيوننا، بهدوء، لكن بقوة وثبات. نعود فنغلق الأجفان خوفاً على العيون من التعب. ليس سهلاً أن تمنع جسدك من التصرف على طبيعته، فقط لأن المنطق لا يتفق وهذا التصرف.
أخيراً، كان يمكنك أن تدرك أن المنطق انتصر. ستسمع حشرجة مخنوقة، وتشمّ أطراف رائحة هزيمة، وصوت ماء ينزف.
يوم انتشلونا من مأساتنا، وأعادوا خيط الضوء النحيل، كدنا نتحول إلى عبيد له. كم مرة غافلته وهو يمتد مستقيماً دافئاً باتجاه البياض فقبّلته. أقتربُ من الثقب وأمدّ شفتي حتى يظهر خيالهما كفراشة سوداء.. وَ.. قبلة. أما القرفصاء فصارت نشوة خالصة. كنت أنثر قبلات متصلة في حضوره، كلما جلست القرفصاء. الجلسة التي تحوّلت من همّ إلى راحة، فصرت تسمع أصوات المياه ضاحكة دون انقطاع. ولعل ذلك ما جعل جرذان المصارف تعبّر عن رفضها، فبدأت تغزو كهوفنا كلما كفانا النوم مشقة التخيل، فحملنا على بساط خياله حيث يشاء ونحب.
بدأت تحرشات الجرذان بعد يوم أو يومين من مناسبة سياسية عظيمة. كنت أعجن عقلي لأخبز فكرة. تلك كانت متعتي المفضلة، رغم ثقتي أن البرد والرطوبة لن يتركاها تنضج كما يجب، لذا أتأملها بعد أن أشكلها آلاف الأشكال، ثم أصرخ في وجهها: “غبيّة”، وأرميها في الحفرة. على الأقل أستمتع بصوت الماء المنسكب فوقها وتحتها، لينزلقا معاً إلى أسفل السافلين.
سمعنا في البداية، صوت حركة عنيفة صادرة عن أحد الكهوف، صوت ارتطام بحائط، ثم بالباب الحديدي. اعتقدت أنه المجنون، فهذه حركاته، وإن يكن من عادته أن يوقظنا على هذه الأصوات باكراً، وقلت: لعله يعتقد أن شهر رمضان قد حل.. فأخذ دور المسحّر.
أزعجتني الضجة التي بعثرت الصور في رأسي. وددت أن أضع وجهي فوق شبك الثقب، وأصرخ فيه أن يتوقف، وهي رغبة يحلو لي ألاّ أخسرها رغم استحالة تنفيذها، فصرخة من هذا القبيل، ستكلفني صرخات من كل قبيل. ربما لهذا أحب هذه الرغبة، فهي تشعرني أنني لازلت قادراً على التفكير بما ليس مسموحاً.
بعد معركة ظننّا أن زميلنا يخوضها مع نفسه، خرجت من كهفه صرخة، أكبر من الحلم. هببنا ننظر من ثقب الشباك. لم نر شيئاً إلا الأبواب السوداء الحزينة، وسرعان ما سمعنا صوت فتح طاقات أبواب الحديد، وصوت صرخات ألم قصيرة متقاطعة. قبل أن أحاول التفسير، فُتحت طاقة بابي، اندفعت قبضة إلى بطني، فأعادتني إلى جلستي.
من مجلسي الأثير، وصلتني الأصوات دون عناء، وفهمت الحكاية، فحين عاد الجميع إلى مواقعهم سالمين بعد صرخة أو اثنتين، بقي واحد يصرخ، مكملاً صرخته الجبارة تلك، ففتح الأشقاء اللئام بابه، معربدين متوعدين، ولمّا رأوا حاله فهموا أن الأمر يستحق إعادة نظر.

لوحة: ريما سلمون
هتف أحدهم فزعاً: ولك يا حمار.. شو عمل فيك هيك..
علّق آخر ضاحكاً:
ـ ولك جردون غلبك..
واستمر يصرخ..
قال ثالث مستعيداً لهجة الوعيد
ـ لا تبعق ولك.. يعني لما شفته ما عرفت تنادي..
فسرّب جوابه بين الألم والخوف:
ـ خفت..
وبسماع صوته علمنا أننا ظلمنا المجنون..
قال أحد اللئام:
ـ خفت!! رح علمك الخوف على أصوله..
وسمعنا صوت العصا تنهش جلده
وكان أحدهم يقول:
ـ خلينا ناخده ونشوف قصته.. بركي الجرح خطير..
سمعنا وقع أقدام.. وزحف جسد.. وشراهة عصا.. وأيضاً تكنيس جرذ.
من يستطيع أن يفهم هذه الجرذان! ما الذي تريده منّا! طعامنا لا يكفينا حتى نترك لها حصة، وكهوفنا أضيق من خيالها، بل وليس لدينا حفر وسراديب ولا حتى صناديق أو أكياس لتختفي فيها أو خلفها. أيّ جنون ركب رأسها حتى تركت عالماً رحباً لتأتي إلى متاعيس الكهوف.
وظلّت على جنونها. اعتدنا أن نسمع كل يوم صوت عراك. ولمّا كان الأول قد ابتلى بالعصيّ لأنه لم ينادهم، لم يعد غريباً أن نسمع من يستنجد باللئام خوفاً من عدوّ أسود، شجاعته أكبر من حجمه بمرات. لكن الاستنجاد باللئام لم يكن يغير شيئاً.. إذ يصرخ أحدهم:
ـ وطي صوتك ولا.. شو في..
ـ جردون!
ـ أي اقتله.. شو مستني..
وينسحب تاركاً المعركة تحتدم. قرقعة صحن وكأس وملعقة، ضربات حائط، وربما صوت قنبلة تصدر عن الباب الحديدي، وأخيراً يعمّ الهدوء، فينقر المحارب بابه ليأتي أحدهم صارخاً:
ـ قتلته؟
ـ إيه..
ثم يفتح طاقة الطعام ويبتعد آمراً: ارميه من الطاقة..
لغبائي، استرقت النظر مرة باتجاه الصوت، ورأيت يد زميلي تمتد ممسكة بذيل أسود كأنه صل ثعبان، وجرذ.. وأيّ جرذ! جرذ بحجم قط.. وأي قط.. كأنه أكبر من الكلب. خرجت عيناي من شباك الثقب، كاد شعر الجرذ يخزها، وعادت قفزاً مملوءة بالقرف.
عدت إلى مكاني وقد غزتني قشعريرة راحت تهزني على دفعات. كانت الفكرة مرعبة. كيف استطاع أن يقتل حيواناً بهذه الضخامة في كهف ضيق دون أي أداة. إنه لا يحتاج أداة ما، بل عدّة صيد كاملة! وماذا لو فاجأني جرذ بهذا الحجم، بل من أيّ حجم كان، هنا، في قعر كهفي. صارت الخيالات تأخذني وترميني. أفكر كيف سأجهّز نفسي للمعركة. لكنني علّلت نفسي بالآمال هرباً من القلق. إذ لا بد أن حظّي أفضل من غيري ولن يهاجمني أيّ جرذ. ثم لا يمكن أن يكون لكل ساكن كهف جرذه الخاص. لولا أن كوابيس أمي مع قرينتها ذكّرتني باحتمال آخر. فالجرذان التي كانت تهاجمنا بدت وكأنها قرائننا. والقرين همّ ما بعده هم. كانت أمي تحكي لي عن قرينتها. كيف تأتيها في الحلم لتصارعها. أمي كانت تعرف قرينتها من بين مئات الأشخاص في حلمها. تقول: “كلما صادفتني صعوبة في حلمي، أتلفت يميناً ويساراً، فقرينتي لا تهاجمني إلا حين تجدني في مصيبة. لهذا كنت أستعد لها. ولم أكن أتردد في مهاجمتها. أعلم أن حياتي معلقة بهذه المصارعة. أتحول إلى وحش مرعب. أنا التي لم تعارك أحداً في حياتها، أصبح أشرس من نمر، وفي كل مرة كنت أصرعها، ثم أستيقظ فرحة بنصري، وتعبة أشد التعب. أتعرف يا ولدي، سمعت قصصاً كثيرة عن مساكين صرعتهم قرائنهم، فركبهم الجنون، أو دخلوا في مرض وغيبوبة بلا نهاية”.
أغمضت عينيّ لأبتعد عن الموضوع، ففُتحت أذناي، شنفتا لقرقعة في أسفل الحفرة. قلتُ: (أتى!..). وكان الصوت يرتفع. العدو يتقدم بزحف ثابت. قفزت معدلاً جلستي، فإذا بي أتحفز كنمر، بل كهرّة. ورأيت الخوف يرقص أمام عيني مبتهجاً بسطوته. هززت رأسي، وهل تصدقون، كشّرت عن أنيابي كأني سأنهش لحم عدوي ذي الشعر الأسود.
أشبه ببطل يدخل المسرح. مدّ الأسود رأسه كتلةَ صوف معتمة، وكان هناك رأسا دبوسين يلمعان كعينين. انطلق جيش من النمل من رأس أنفي وانتشر حتى أقاصيّ. كأنها رجفة الموت. ليس خوفاً.. ربما.. لكنه قرف.. عجب.. رفض. زأرت من مكاني دون أن أخسر هيبتي، فخرج صوتي مواء. لم يتراجع أمام صوت مرتعد كصوتي. أخذ يتقدم صاعداً الأبيض الجميل، وكأنه يدخل بيتاً اعتاده منذ صباه. عدت فصرخت، وما خرج صوتي، وكان جسدي يتراجع معلناً خيانته العظمى. تلفتّ بحثاً عن أيّ شيء أدافع به عن نفسي، فلم أجد سوى قطعة صابون عسكري. قفزت نحوها.. فقفز إليها، أوشك أن يقضم يدي، فسارعت بإمساكه. قلت: انتصرت. لكن جسدي عاد فخذلني، وصار يرتجف تقززاً. ليس هناك ما هو أشد قرفاً من إمساك جرذ، ولو كان خارجاً من ألف عملية تنظيف. يكفي أن تلمس شعره الأسود اللزج، وجسده الذي يعلن عن كل ما بداخله فور إمساكه، حتى تشعر بغثيان ثقيل، فكيف بواحد خارج للتو من مستنقع الخراء. تراخت يدي، فمال برأسه محاولاً قضم إصبعي. قذفه ذعري إلى الباب، وانتهى كل شيء. كان معلقاً بأحد نتوءات الباب الحديدي، صامتاً إلا من عربدة رائحة نتنة راحت تتوغل في الكهف وفي جسدي.
غسلت يدي ووجهي مئات المرات. لم أدر ما أفعل لأتخلص من الإحساس بالنتانة، والأسوأ أن الجرذ ظلّ أمامي متدلياً كجورب الشيطان. عليّ أن أخرجه. لكن كيف؟ لم أحتمل أن يُطلب مني رميه من الطاقة، فأنتزعه من النتوء تاركاً قطع جسده تنزّ بين يدي.
لم أفعل شيئاً من ذلك. حملت بطانيتي العزيزة. تكورت في الزاوية، وغطّيت همّي. أنكرت أن هناك مشكلة، وغصتُ في كهف أكثر عمقاً وعتمة من كهفي. غصت وأوغلت حتى ذهبت الرائحة. رفعت الغطاء. نظرت إلى الجرذ دون انزعاج. نقرت الباب بهدوء. حضر أحدهم. قلت له: افتح الطاقة. ففعل. قلت: قتلت الجرذ، مدّ يدك وخذه. تلمّسَ يميناً ويساراً فوجده. قال: انتظر قليلاً. أغلق الطاقة. ركض فأحضر مفتاح القبر. فتحه، وكانت زمجرة الحديد أخف وقعاً. سألني مندهشاً: الله أكبر.. كيف قتلته؟. هززت كتفي أن (هكذا). انتشل الجرذ من مشجب موته، وركض به. عاد بممسحة. مسح قذارة الجرذ وسألني: ألا ترغب بالاستحمام؟ لم أستغرب سؤاله. كان يتوقع إحساسي بالاشمئزاز. قلت: أجل. قال: اتبعني. تبعته، فأشار إليّ أن أدخل حمام الكهوف. دخلت ورددت الباب. حين أكملت خلع أسمالي، حركت يد الصنبور، فلم يخرج الماء، بل دخل الأشقاء جميعهم، كلّ بعصاه، وراحوا يضربونني، فأتقلب بين عصيهم. أتقي واحدة فتنالني أخرى. ظللت أدور كدجاج يشوى، حتى نال أحدهم خصيتي بضربة أخرجت عيني.
اختفوا جميعاً، لم تبق إلا عيناي. فتحتهما فرأيت ظلام بطانيتي. رفعتها، فرأيت سواد الجرذ. نقرت الباب. أتى أحدهم. فتح الطاقة. حملت الجرذ بكفيّ كأنه طفل صغير.. رميته خارجاً. أغلق الطاقة وهو يتذمر:
ـ قرف يقرفكن.. ما أوسخ شغلتكن..
ما حدث بيني وبين الجرذ لم يكن آخر مشاكلنا مع معشرهم، ولا أهمّها، فآخر غزواتهم كانت أمراً آخر. لم تتركنا الجرذان إلا وقد خلفت وصمات عار في جباهنا الصفراء، وبدّلت عادات كهوفنا السرية.
كان الوقت ما بعد عشاء البطاطا المسلوقة بتخيّلٍ وتبديل جلسة. انطلق صوت من الكهف المجاور، الكهف الذي تلقّى ساكناً جديداً لم نستطع رؤيته حين دخل، إذ توزع الأشقاء اللئام ينقرون على الأبواب كي لا نسترق النظر. الصوت الذي هبّ كفرس فزعة، كان صراخ أنثى. اندفعت إلى الثقب، فرأيت عيون زملائي تطل أيضاً. كانت هناك فرحة في العيون يشوبها خوف. يا أيها العالم.. بيننا أنثى. لم نستطع منع فرحة الاكتشاف، لكن سرعان ما أخذت مكانها لعناتنا على القدر الذي قاد فتاة إلى باطن الأرض. وها هي تتخبط فزعاً أمام جرذ بلا قلب. اشتعلت دماؤنا نخوة. صرنا ندور في ضيّق مكاننا كأننا نبحث عن ثقب لنلج منه. لم نجد إلا الجدران لنضربها. ليس ليهرب الجرذ، بل لنفكّ عقدة النخوة التي كادت تختنق بحثاً عن طريقة لإنقاذ الفتاة. اهتزت جدران الكهوف من ضرباتنا. فاندفع الأشقاء اللئام صارخين مهددين. وعادت الأنثى للصراخ.
هتف أحدهم: لا تصرخ يا كلب.
لم نفهم لِمَ يخاطبها بصيغة مذكر.
صاحت الأنثى:
ـ جردووون
فهتف جميع الأشقاء:
ـ سد حلقك يا شرموط.
وسمعنا صوت زمجرة حديد
ـ لبرّه..
خرجَتْ وما كان باستطاعتنا استراق النظر.
ـ وين الجردون
ـ ها..
لم تكمل
ـ لا تتكلم يا حيوان
وسمعنا صفعة عنيفة، وبكاء أمّ وأخت وابنة وحبيبة وصديقة.. كلهن بكين.. كل اللاتي نعرفهن سمعنا صوت بكائهن قبل أن تعاد جارتي إلى كهفها ويغلق الباب. أردت أن أحطم باب الحديد، أفتح أبواب زملائي، إلا بابها. نمسك أشقاء القذارة، نرميهم أرضاً، وندوسهم.. ندوسهم.. حتى يتحولوا إلى عجين من لحم. حينها سنفتح بابها.. ونقول لها.. مرّي فوقهم.. ابصقي على جباههم وعودي إلى دنياك..
كان القهر قد سمم هواءنا. فرُحنا نتقلب في هزيمتنا الإضافية بحثاً عن نَفَس نظيف، ينسينا ما كان.. بلا جدوى.
لم نفهم لماذا قتلتنا تلك الصفعة، مرّغت رؤوسنا. لم نفهم كيف يمكن لصفعة أن تفعل بنا هذا، نحن الذين نسمع كل يوم صوت العصيّ والسياط تنهش أجسادنا التي تطلق صراخاً وزعيقاً وجعيراً. نحن الذين لم تُترك مساحة من أجسادنا دون ذكرى تظلّ تلحّ علينا كلما حاولنا أن نشبه أنفسنا. كيف تهزمنا صفعة وكلٌّ منا يخرج من كهفه بالصفع واللبط واللكمات، ويُعاد بمثلها. كل ذلك يحدث هنا، في المكان الذي بدت فيه صفعة أشبه بحذاء رُمي في وجه فارس يختال عائداً من انتصاراته. أترانا كنّا ما نزال نخبّئ في سراديب موتنا شموخ فارس لا يُهان!
بين يدي بكائها آخر الليل. رحنا نسعل سعالاً حاداً كي نسألها الغفران، كي نخبرها: نحن معك.. إن لم يكن بقوتنا.. فبضعفنا.
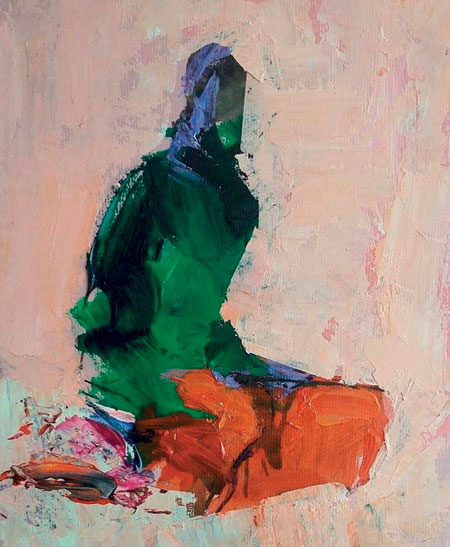
لوحة: أحمد قليج
***
حضور الأنثى، أو معرفتنا بحضورها، غيّر الكثير. شعورا الهزيمة والخطيئة اللذان تمددا بارتياح في صدورنا جعلانا نقف أمام ذواتنا وقفة مصارحة، وما أصعبها من مصارحة في كهوف النسيان. قبلها كان وقتنا يمر برهبته، حزنه، وجعه، وبعالم من التخيلات المريضة، كان يمضي بكل ما فيه، وهذا ما كان يعنينا. حياة الكهوف علمتنا كيف نكذب، وأن نحترف الكذب. الكذب الذي بدأ بين أيدي وأرجل وعصي المحققين.. ولم يتوقف. بدا يسيراً، ولازماً. أن نبتعد عن الحقيقة يعني أن نرتاح من رؤية تحطم أحلامنا وأفكارنا في كل يوم. حتى إن مدت الحقيقة لسانها في وجهنا، سنعلن أنها عدم. ما كان يمكننا الاعتراف بحقيقة تقول إننا مدفونون في كهوف معتمة. إن الدنيا رحلت بعيداً، ولم تترك سوى ظلمتها، ومخلوقات مجبولة بالحقد والكره. إذا تخيلت أنني أركض مزهواً بريح الحب بين أغصان شمس لا تنطفئ، فسأركض وستحرقني الشمس. إذا مضى خيالي إلى أهلي، أصدقائي، حياتي، فلن أدعه وحيداً، سأذهب معه، وأكون بينهم، أو أحضرهم إليّ. إذا تذكرت أغنية لفيروز، لن أقول تذكرت، سأسمع صوتها، وسأطرب. سأقف بوجه أيّ منطق يخبرني أنني واهم. سأعيش حريتي حتى هنا، ليس على سبيل المجاز، بل هو الواقع. وحين أعود متورّماً من مذبح التحقيق زاخراً بكل أصناف الألم، أتمدد على ظهري، أنظر في خيط الضوء، وأقول: كان يمكن للتعذيب أن يكون أقسى. أقول: شيء رائع ألا أحسّ بالألم. أقول: كم كنت قوياً إذ لم أصرخ. وربما: كم كنت شجاعاً عندما كسرت العصا فوق رأس المحقق، وجعلتهم جميعاً يركعون، ثم غادرت الغرفة، صعدت إلى الأرض، وانطلقت في الشوارع، وكانت الجماهير تصفق لانتصار الإرادة، ثم أرحل أبعد في خيالي حين يستلّني النوم من ألمي.. ممتطياً صهوة الأحلام.
حضور الأنثى جعل الحياة أصعب. لم تتوقف خيالاتنا، لكننا بتنا أضعف من أن ننكر الحقيقة. صرنا نشمّ رائحة واقعنا ونختنق بها. الكهف الذي كنا نستطيع نشره عالماً من التاريخ والبشر والعلاقات وحتى الضحكات، عاد قبراً، ومكث كذلك. ألم التعذيب أصبح ألمين. وإحساس الذل كبر، حتى خطاب العيون والأصابع بين القبور، راح يتضاءل حتى اقتصر على التحية.
للحظة كرهت الأنثى. قلت لماذا نتحمل كل هذا الشعور بالذنب، أليست مثلنا؟ كلنا مظلومون هنا، وكلنا معذّبون. لماذا علينا التفكير بها وكأنها من عالم آخر. وكل ذلك بسبب صفعة. وما قيمة الصفعة في جهنم العنف التي نعيشها، بل وما قيمتها أمام التعذيب الذي لا بد وأنها ذاقت منه دون أن نسمع صوتها. قلت وقلت وشيئاً لم يتغير. فتلك الأنثى ذاتها، إذ أعادتنا إلى الواقع جعلت محاولة هروب كهذه كذبة مفضوحة. كانت الحقيقة تقدم نفسها لي بكل ثقة: ربما.. لو أن ما حصل في الجنة لما فكرنا في الأنثى وكأنها مخلوق سحري يأتي من السماء، أما هنا، فالأنثى عنوان كل جميل يأتينا من الماضي. كل ما ينقصنا من عاطفة ولطف ونعومة وجنس وحتى نظافة، وربما ما نحمله من أساطير عن ضعفها أمام ذكورتنا. ولماذا لا نعترف، كنّا نحتاج إلى أن نتذكر أن الحياة فيها من هو أضعف منا.
ما فعله حضور الأنثى أيضاً أننا بتنا نتصرف بخجل في قبورنا، وكأنها لا تكف عن مراقبتنا. توقفت ألعاب خيوط النشادر، ومنعت الخيالات الخليعة عن نفسي في صحوي، لكن الأصعب كان كتمان أصوات أجسادنا. صرنا نخجل من صوت بصاقنا، مخاطنا، ضراطنا، وتبرّزنا. الأصوات المقرفة التي كانت عادية بين حشد من الرجال، باتت مذلة بعد حضورها.
مع هذا.. كان هناك شيء جميل جديد: على حواف قبري نبتت أنثى..
***
الأيام التي تلت ذلك التحول، جلبت معها ما هو أخطر. لا أدري كيف أصبحتُ زاهداً. وليس أيّ نوع من الزهاد، فلم أكن أبتعد فقط عمّا يسمونه غوايات النفس، بل شعرت بحب يفيض في قلبي فيغطّيني ويغطّي كل من قُدّر له الوجود.
بدأ انقلابي حين رحت أراجع تصرفاتي مُذ حشرت في القبر. كان ذلك آخر تأثيرات حضور الأنثى. فتّشت عن أخطائي، فراعني ما اكتشفته.
لعلها لم تكن أخطاء كثيرة. لكن كلّ واحد منها بدا جريمة رهيبة. تذكرت الأيام الأولى لدفني، ساعة وقفت وقفتي الأولى أنظر من الشبك. قبل ذلك لم أكن أجرؤ، وأنا حديث العهد، أن أخالف أمراً قالوه لي أكفاً لوجهي وكلاماً لأذني (ممنوع الوقوف)، وقالوا (إذا رأيناك تنظر من الشبك.. خلعنا عينيك). ترددت كثيراً قبل أن أنظر أوّل مرة، إلى أن وجدت في نفسي الشجاعة، وفي جسدي استعداداً للعقوبة. اقتربت من زاوية الشبك بعد أن جلست ردحاً أنصت لأيّ همسة، ومقلّباً الأمر في رأسي حتى كاد يهترئ.
أول ما نظرت، شهقت. كان مشهداً مرعباً. خيالي مغلق العينين بـ(الطميشة) لم يرسم لي القبور على هذا النحو. كنت أتخيل المكان واسعاً، بل وأن فيه مقاعد وكراسي، إذ لطالما مكث الأشقاء اللئام لساعات هنا، لكني لم أر سوى ممر ضيق، وصفّاً من القبور مقابلاً لقبري.
سمعتُ صوتاً، فسقطت في مكاني، كاتماً أنفاس خوفي، وقلبي. لم أسمع حركة بعد ذلك، فهدأت. عاد الصوت من جديد (بس.. بس). نهضت ببطء، وقبل أن أصل الشبك تراجعت خوف أن يكون الصوت فخاً. ولما عاد على شكل (ولك بس..). غامرتُ ونظرت، فرأيت زميل القبور الأول. رأيت عينين ضاحكتين، هكذا بدتا لي، وبدتا غائرتين في محجرين عميقين على نحو ساخر، أما حول المحجرين فلم تترك العتمة سوى لمعة سواد، عرفت بعد تمعّن أنه شارب ولحية. ابتسمت له فلم يُجب، بل عاد وسرّب صوته: (ولك .. بس). فهمت أنه لم يرني بعد، لذا عليّ الاقتراب. كان اكتشافاً مهماً، فرغم أنه يعني مخاطرة أكبر، لكنه عنى أيضاً أن الأشقاء اللئام لن يروني إذا ما ابتعدت قليلاً عن الشبك.
قرّبت وجهي من الشبك، وهززت رأسي للتحية، ردّ بابتسامة عريضة، فغمرتني سعادة عاشق. انتبهت أنني كنت مشتاقاً لوجه إنساني. وجه يبتسم، يحس، يخاف، ليس محتقناً بالحقد كوجوههم. وجه يشبه وجهي الذي أذكره.
أخذ يحرّك أصابعه وشفتيه، ولعل صوتاً ما كان يصدر عنه ولا أفهمه. أعاد حركاته مرات حتى بدأت أفهم، وصرت أجيب بطريقته. سألني من أيّ البلاد أنا، وإن كنت وحيداً في قضيّتي أم لا، وسألته، منذ متى يسكن هذا القبر، فأشار برقم لم أستطع تصديقه حتى أعاد إشارته أربع مرات. قال إنه هنا منذ ثمانية أشهر وخمسة أيام. شعرت بدمي يهبط إلى قدمي. ما عدت قادراً على الوقوف. قاطعت إشاراته بتلويحة وداع، وجلست على عتبة ضياع رهيب كاد يخلع عقلي. أيمكن أن أبقى هنا كل هذا الزمن. هنا.. وحيداً.. بارداً.. مقفراً.. معذباً.. وكيف؟ لن أستطيع الاحتمال. لكن ماذا سأفعل إن لم أحتمل؟ أليس الجنون أسهل من الإجابة على هذا السؤال: كيف لا يكون لي إلا الصبر وأنا واثق أنني لن أستطيع الاحتمال! هي لحظة اختناق ما قبل الموت، تبقى عمراً في حالة اختناق أخيرة.. لا تنتهي.. تتمنى الموت القريب فلا يأتي، وتتمنى الحياة التي تواصل ابتعادها بصمت..
لم يتركني زميلي. راح يسعل سعالاً منظماً، وما أردت إجابته. شعرت أنني أكرهه. بدا غراباً أو بوم شؤم.. بل شيطاناً. ظل مصرّاً على ندائه، فقلت لعله كان يمزح ويريد أن يتراجع. قفزت إلى الشبك مع هذه الفكرة، فسارع يرمي إشاراته وكأنه يستدرك خطأه بعد عذاب ضمير. أخبرني أن حالته خاصة جداً، لذلك ليس هناك سبب كي أخاف. وأشار أنه قريباً من كهوفنا الصغيرة يوجد كهف أكبر يسمّونه (جماعية) حيث ستكون الحياة أشبه بالجنة بالنسبة إلى حياتنا هنا. وقال إنه خلال فترة إقامته تبدل أغلب سكان الكهوف الصغيرة، وقبل أن يودّعني، على أمل أن ألقاه في الغد بعد الغداء، أفهمني أنه إذا لم تكن قضيتي كبيرة فسيضعونني في الكهف الجماعي فور اعتقالهم مجموعة جديدة، فالقبور ملآنة الآن. وختم كلماته بابتسامته العريضة مرتاحاً لأثر كلماته في عيني.
في ليل ذلك اليوم، كانت جريمتي الأولى، جلست جلسة صلاة، هي الأولى لي منذ كنت طفلاً، ولم أصلّ، فقط دعوت بقلب أسود أن يأتوا بسكان جدد للكهوف، وكي لا أرى سواد قلبي فضّلت أن يكون الجدد من البشر السيئين، لم أحدد أيّ سوء هذا والكهوف نادراً ما تفتح أبوابها لهؤلاء، لكنني ارتحت لجمل الدعاء التي لا تميّز شيئاً.
لا أنكر على نفسي أنني تراجعت عن موقفي بعد ذلك، لكن ما بقي عبئاً ثقيلاً على ضميري أنني لم أتراجع إلا حين أحضروا جدداً، فأدخلوهم حمّام الكهوف، لينقلوهم بعد الغداء إلى الكهف الجماعي مباشرة، فظللنا على حالنا. حينها تراجعت عن دعواتي، ليس لأن قلبي لم يعد أسود، بل لأنني لم أستفد من سواده.
الجريمة الثانية كانت أيام العتمة. تلك الظلمة التي كشفت كثيراً من عيوبنا ونقاط ضعفنا. في ليلة من لياليها، وبين يدي ضجر يطبق فوق الصدر كبرميل قمامة.. ثقلاً ورائحة. لم يكن باستطاعتنا أن نصدر أيّ صوت غير طبيعي، فكيف لنا أن نجزم أن أحداً من اللئام لا يتربص بين قبورنا. في تلك الليلة، جاء الكلاب مهرولين كعادتهم، فتحوا باباً، جرّوا زميلاً، وذهبوا. لن أتحدث عن ذنب نحمله جميعنا كلما سمعنا صوت ركضهم. ترتعد قلوبنا، نسمع زمجرة حديد، ينسحب الدم من عروقنا، وكثيراً ما يصعب التمييز أيّ باب يفتح بابي أم سواه، ربما الخوف هو من يشوّش سمعنا. وعندما يفتح الباب، يشعر كل الذين ظلت أبوابهم مغلقة على رعب انتظارهم بالدم يعود إلى مجاريه، معلناً الفرحة بالنجاة، الفرحة المذنبة التي سنعتذر عنها في قلوبنا، لكننا نعلم أنها ستعود مرة أخرى.
الجريمة كانت حين بدأ صراخ زميلنا يعلو. ما كان باستطاعتي أن أعرفه من صوت صراخه، ففي صراخ العذاب تصبح كل الأصوات متشابهة. وحده الجنس يظهر فارقاً بين صراخ ذكر أو أنثى. تحت سطوة الصراخ، عادة ما كانت أجسادنا تنتفض وكأنها هي التي تتلقى الضرب، إلا أنني في تلك الساعة لم أشاركه عذابه. رحت أستمع إلى الصراخ كصوت، كموسيقى، ولم أنتبه لإحساس أشبه بالطرب إلا بعد أن اكتمل رافعاً في وجهي جريمتي التي لن أغفرها لنفسي ما حييت. أهو السأم.. الأنانية.. الجنون.. لم أعلم أيّ سبب كان وراء لذتي بسماع صراخه. هالني أن أكون بشعاً إلى هذا الحد. رغبت أن أحظى بمرآة ونور لأرى وجهي. كيف يمكن أن يواجهني بعد هكذا سفالة! رأيت نفسي طاغية قديماً يضع معارضيه في ثور ذهبي، ويشويهم تاركاً أصوات عذاباتهم تخرج من منخري الثور لحناً موسيقياً. آمنت ببشاعة صورتي، ورحت أتمتم كرجل دين تائه، ندماً، اعتذاراً، وما نفع شيء. سجلت في دفتر نفسي “أنا قذر”.
أما أكبر ذنوبي، فقد بدّل رغبتي في المرآة إلى خوف منها. كنت أكيداً أنني بت أحمل وجه وحش. لم يكن ذنبي تصرفاً أو رغبة، كان شعوراً قاتماً سفك خضرة الجمال في أعماقي.
كان ذلك يوم اكتشاف وجود صديقي في كهف لا يفصلني عنه سوى كهف آخر. صديقُ عمر، صديق حرية. كان معي تحت الشمس، بين نسائم الهواء. دخّنا معاً، شربنا معاً، هناك حيث يمكن أن تضع يدك على كتف صديقك، أن تضحك معه وتثرثر، بل وأن تختلف معه.
توقعت أول اعتقالي أن يكون قد اعتقل أيضاً، ثم حذفت الفكرة. قلت لا بد أنه نجا. ورغم أنني كثيراً ما كنت أستطيع رؤية الأجساد المنهكة وهي تخرج من كهوفها صاعدة إلى العذاب، لكن قرب كهفه من مدخل الممر منعني من رؤيته، ولعلّي لو رأيته ما كنت لأعرفه. فالأشكال هنا تتبدل. الرأس إما حليق الشعر أو مهمله، والوجه شاحب يغطي اصفراره طحالب وأعشاب برية كان يمكن أن ندعوها شعراً، أما الثياب فضاع لونها وشكلها وعمرها، حتى شابت أجسادنا.
لأكثر من مرة، جاءوا فانتشلوني من وحدة المنفردة التي لا أحنّ إليها إلا حين ينتزعوني منها، كحال الوطن. وعندما أصل إلى حيث عليّ الاتجاه يميناً نحو غرفة التحقيق، كنت أسمع أحياناً صوت سعال عنيف، أعنف من أن يبدو رسالة. لم أهتم لأمره، خاصة وأنني في الطريق إلى التحقيق أحظى بمئات الحواس لكنها جميعاً تسبقني إلى الغرفة، لتتركني وحيداً في الطريق إليها. لم أكترث بذاك السعال إلا عندما لفت انتباهي أحد اللئام وهو يقودني حين صرخ متوعداً، انتبه قبلي إلى أن هناك رسالة. وحين أعادوني سمعت السعال، فخاطرت بابتسامة من تحت ظلمة (الطميشة)، فصار السعال لحناً، وكأنه عواء ذئب حزين، وانتبه الكلب الذي يقود عماي، فرفسني إلى الكهف، وصرخ بصاحب السعال: حاج تنهق يا حمار.
بعد العشاء، وقفت أراقب الممر. حين تأكدت أن الوضع آمن، سعلت سعلتين متقطعتين، وانتظرت الجواب، فجاءني سعال مختلف من الجهة الأخرى، تنحنحت موضحاً أنه الرجل الخطأ، فلم يُعِد المحاولة. مرة أخرى سعلت السعال ذاته، فجاءني الرد من الاتجاه الذي أريد، وسعلنا عدة مرات معاً، كأن سعالنا استحال زقزقة عصافير تلتقي على غصن الحب. دبّ فيّ الحماس لمعرفته، فسألت بصوت مسموع (من؟) وجاءني الجواب قصيدة هبطت راقصة إلى أذني: (أنا محمد..) إنه صديقي.. سوق من المشاعر قام في أعماقي. فرحت، حزنت، خفت، ارتحت، وقفت على رؤوس أصابعي. التصقت شفتاي بالشبك، وكانت ضحكة معجونة بالخوف والاختناق تخرج من صدري. وسمعت ضحكته حدائق من الحب. سألته : (متى؟) وانقطع الحلم.
دخل أحد الأشقاء على عجل..
لم أنم يومها، وكنت أعلم أن صديقي لم ينم. تمنيت ألا ينام بين كهوفنا أحد من الأشقاء اللئام كما يحدث غالباً، وكان أن تحققت أمنيتي. صرت أرتب الكلام الذي سأقوله، سأسأله متى .. كيف.. أين وصل التحقيق معه.. ماذا قال لهم.. فيض من الأسئلة ملأ رأسي متأهباً للانطلاق.
في وقت بين العشاء والفطور، اقتربت من الشبك. صمت القبور في هذا الوقت يصنع عالماً من الرعب، تعززه روائح الرطوبة والعفونة، وزادت عليها رائحة صدأ الشبك.
سعلتُ السعال ذاته بصوت ضعيف، وسرعان ما جاء الرد كلاماً..
ـ صاحي؟
ـ صاحي.. من زمان هون؟
ـ بعد بيوم..
كاد الحزن يتحد برائحة الرطوبة لولا أن أنقذني بضحكته الطيبة
ـ كيفك.. عجبك التعذيب؟
ـ غير شكل
ـ شكلك متغير كتير
ـ من كتر ضرب الكفوف صار وجهي متل الرغيف العجيب.
وفرقعنا معاً ضحكتين أزعجت صمت الكهوف. فهبّ أحد اللئام، ويبدو أنه كان قريباً فاصطاد بنظره صديقي، بينما تراجعت سريعاً.
خلال لحظات غزا جيش اللئام الممر. فتحوا طاقة باب صديقي أولاً، وسمعتهم يسألونه مع من كان يتحدث، فأنكر، وسمعت أحدهم يقول له: (شوي.. وحياتك لأشويك شوي.. ).. ثم فتحوا طاقة باب المجنون.
ـ تعال ولك.. مين كان عم يحكي؟
ـ ما بعرف.
ـ شو اشتقت للفلقة.. احكي ولك.
ـ رقم ستة ورقم تمانة.
عندما لفظ رقمي كهفينا، انكمش قلبي على تجاعيده كورقة في قبضة الخوف، ودمي أصبح مكعبات جليد تتحرك في أوردتي مخلفة وجعاً وبرداً، أما جلدي فتحول إلى خبز يابس. هكذا هو الخوف.. إذ يعلن عن حضوره يغيّر كل شيء، يسحب من الروح ألوانها، ولا يترك إلا الرغبة في الانطفاء، في عدم لا يسبقه سؤال. ماذا نفعل يا إلهي؟ هناك أشياء لا نستطيع أن نعتادها. الذل، الانكسار، الألم، كلما لاحت لنا، اتسعت رغبة الموت فينا، حتى تبدو الحقيقة الوحيدة.
بدؤوا بصديقي. أرعد الحديد القذر، انفتح بابه، وكنت أعلم أن صديقي سيكون واقفاً بشموخ كأنه جبل. لماذا عليه أن يُظهر لهم الجليد والخبز اليابس! سيقودونه إلى المسلخ، وهناك لا يظل جبلاً. الجبال لا تصيح، لا تتألم، لا تبدّل أقدامها المرعوبة تحت جنون العصي، لا تزرقّ ظهورها من انحنائها في قلب (الدولاب) فوق البلاط. لكننا لم نكن نتخلى عن وقفة الشموخ الوحيدة. هنا.. في أحضان كهوفنا. الوقفة التي لن يراها أحد، لن يشعر بقيمتها أحد، إلا.. نحن.
عذابي كان عذابين، وخوفي كان عمراً كاملاً. كل العصي التي انهالت عليه كانت تصيبني بصرخات ألمه، ولحظات انتظار دوري. حين عادوا به يجر أقداماً ضاع شكلها، كنت قد بلغت آخر أنفاس صبري. وقفت بصعوبة كأنّ تعذيبي انتهى للتو. غير أني وقفت قبل أن يفتح الباب، ولا أدري لم ابتسمت للوحشين المتلمظين لصيدهم السهل.
ـ متضحك يا عرصة.. بالله لكسرلك سنونك.
هبطت من زنزانتي المرتفعة عدة سنتمترات عن الممر. غطوا عيني ليريحونني من بشاعة وجوههم، ورموني في المسلخ، حيث لم يبق حقد إلا وأنزلوه بي. واحد رأى فيّ أباه الذي كان يضرب أبناءه حين ينزعج وحين يفرح، ويبصق عليهم كلما رآهم وكأنهم لعنة من الآلهة. الآخر لا يراني إلا ويتذكر كيف رفضته كل بنات الضيعة. أذكّره بشاب أخذ منه حبيبته التي ما أحبّ سواها، وما أحبّته يوماً. الثالث يضربني دون أن ينظر إليّ، فعقله مشغول بأسرته التي لا يعلم ما يفعل ليسكت جوعها. أما الرابع فكان على وشك أن يحقق حلمه في أن يصبح نجماً سينمائياً. الشعر مصفف ولامع دائماً، اللحية مشذبة، والثياب لا تختلف عن ثياب أيّ نجم أميركي، ولا بأس إن كان لا يبدّلها طوال السنة. لم يكن ينقصه سوى أن يتعلم أساليب الضرب. يرى نفسه يتطور بسرعة، لكن ما يؤرّقه أنه عندما أتيحت له فرصة توجيه لكمات مباشرة إلى وجهي بعد جولة تعذيب، لم أسقط أرضاً. لكمني مرات ومرات، ولم أسقط، بينما كان يرى الأبطال تكتفي بلكمة لتصرع خصمها. أليس هذا سبباً كافياً لحقد أكبر.. وتدريب أعنف!
في صباح التعذيب ذاك كرهتُ كل ما أنجبه الكون. كرهت نفسي، كرهت صديقي، وراح رماد كرهي يخرج من كهفي لينتشر في باطن الأرض ويخرج إلى سطحها، يمرّ بالمدينة المستيقظة على الضعف والجبن والجهل، حتى عندما اقترب رماد الكره من أهلي لم يتوقف، تردّد قليلاً، ثم امتد فوقهم على مهل، واندفع يلفّ المجرات جميعاً.
نمتُ على وسادة حذائي، كنت أتمتم.. أكرههم.. أكرههم.. إلا.. أنتِ.
***
لم أكن لأبلغ مرحلة مراجعة جرائمي، لولا أن اكتمل نصابها عندما رقصت الفرحة في قلبي وفي عينيّ إذ سمعت صوت الأنثى لأول مرة، الصوت الذي سأذكره دائماً.. حباً.. وندماً.
بعد كل تلك الجرائم صرت أخشى ألا أجد فارقاً بيني وبين وحوش العتمة الرابضة على أبواب كهوفنا، وكهوف كل البشر. كيف لا أكون مثلهم طالما كنتُ أستطيع أن أغطّي الكون بغيمة كراهية. إن استطعت فتح بوابة السماء لأتمنى للآخرين الدفن هنا، وحوّلت صراخ عذاب زميلي إلى أغنية، وصراخ الأنثى في جوف الكهوف إلى متعة..
غسلت رأسي. نظرت إلى نفسي في لحظة صمت. قلت: هذا القبر أصبح صومعة.. وهذا المدفون صار راهباً. سيتسع قلبي للجميع، سأحزن لأجلهم، سأرى المصائب التي تجبرهم على الخطأ، وسأغفر، لن أكره، لن أحقد.
رأيت أوساخ أفكاري تغادرني، رأيت سواد مشاعري يقطر من أصابعي، وحين تأكدت أنني نظيف من كل لوث، بدأت أغربل حياتي، لأسامح وأغفر لكل من أساؤوا إليّ، كل من ظلمت نفسي وظلمتهم بطردهم من قلبي.
سامحت الكثيرين، لكلّ وجدت عذراً، فأرسلت إليه مع الهواء الرطب سلامي وحبي. ومن لم أستطع مسامحته طلبت له الغفران، وكانوا ثلاثة. أولهم أساتذتي في المدرسة الذين لم يفهموا إلا العنف والعقاب حتى مع أطفال دون العاشرة، وثانيهم أولئك الذين سرقونا من أيامنا ليدفنونا، ثم ليذيقونا من عذابات القبر ما لم يرد بنص، وثالثهم.. أنا.
الأرق الذي صادفني وأنا أرتّب شكلاً جديداً لوجودي كان سؤالاً سهلاً، لم أحظ بجوابه: لمن أدعو.. ممن أسأل الغفران؟ هكذا.. وجدت نفسي أمام عودة جديدة لسؤال قديم.
حين تكون وحيداً، وحيداً إلى حدّ تصبح معه الفكرة والتجربة، الذات والآخر، الخارج والداخل، خيوطاً تنسج دائرة صغيرة اسمها (أنا). حينذاك، إن لم تكن تؤمن أنك صورة لمتعال خارجك، فستحتاج أن تحاكي صورتك في البعيد، أن تحاكي الثابت خارج حركتك، ستحتاج لمرآة كي ترى سعي الوجود في دائرتك، الدائرة التي تحتاج، على الأقل، إلى التأكد من أنها مازالت تعيش دورانها.
جلبت من ذاكرتي حفنة رموز، رأيتها الأجمل. أسميتها آلهة وأنبياء. ورأيت البشر يغلقون باب تاريخ مضى، ويفتحون قلوبهم للضحكة القادمة. لملمت ثمار أفكاري. أشعلتُ سراج دين جديد، وشهدتُ: أنا مؤمن فأنا أحب، كافر إن رضيت نفسي بالكره. وسافرتُ في تأملي.
أوّل من فكّرت فيه، أولئك المتمترسين أمام أبوابنا. رأيتهم بعينين جديدتين. بدوا لي رغم كل عنفهم وصلفهم مساكين. أيّ حقد يمكن أن أحمله على رجل لا يذهب إلى بيته إلا في أوقات الفراغ. قيامه وقعوده في باطن الأرض. حريته غادرته في يوم لا يذكره، وصار السجن قدره، والفقر قدره. قدر يجعله لا يكف عن سؤال الآخرين. بالترهيب مرة، وبالتذلل مرات، فلا يرى في عيون الناس إلا الخوف والكره والتقزز. وبعد كل ذلك.. إذا أراد أن يأكل، سيجلس جلسة طويلة مع زملائه ليتفقوا على جمع ثمن طعام، هو دائماً بلا أيّ لحم، لهذا سيشعر دائماً أن في دمه شوق للّحم، ولن يستطيع منع يده من سرقة الفتات الطافي والمترسب في حسائنا. ورغم سطوته على المكبلين، غير أنه دائم الخوف. لا تسأله لماذا ومن ماذا، فالجميع يراقب الجميع هنا. إحساسه أن حياته غدت مشياً على صراط يلاحقه منذ أصبح قدره خليطا من السجن والفقر والخوف.
تخيلتُ أنني أسأله: ألست من اختار؟ وعرفت أن جوابه، إن كان صراطه يترك فسحة للجواب، سيكون آهات ما اعتاد أن يظهرها إلا على حجر أمّه وهو صغير. وسأرى في عينيه قلق السؤال: أنا اخترت.. فمن أنا؟ أليس فقر أبي.. أنا.. أليس جهل عائلتي .. أنا.. وفشلي والأبواب الموصدة.. أليست هي الأخرى أنا؟ هذا بعض مني فقد اختار.. فهل اخترت أنا؟
ودّعت ضياع السجّان، وأكملت رحلتي بين الناس. كنت أعيد الجميع إلى البداية، حيث نتساوى جميعاً. ها أنا أعود شبيهاً للسجان بعد كل هروبي. صرتُ سجيناً لأن من اختار الواقع لي في البداية جعلني اختار هذا الطريق في النهاية..
الواقع اختار لي وله.. ثم اخترنا.. فكنت سجيناً.. وكان سجاناً..
في الآخر.. عرفت أن طريق الهداية.. قد هداني إلى الضياع..
هذا القبر صومعة.. هذا المدفون راهب.
تشرين الثاني 2001




