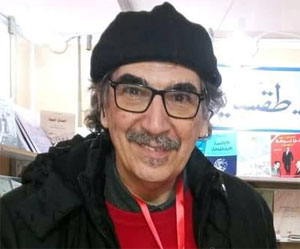وحده أبي يعرف

نعم أبي وحده يعرف. أليس هو أقرب من آدم مني، وآدم هو أول من اغترف من نهر المعرفة. ولأننا لا نغترف من نفس النهر إلا مرة يتيمة لا غير، ولأن النهر تُنهكه رياح الزمن العاتية، وحيث أننا نُلزم غالبا على رمي نرد مغشوش، فأبي هو أقرب العارفين وأسعدهم، واﻷوفر حظا مني ومنك. ولتدعنا من منطق معلم الفلاسفة، ولنقس بمنطق الطير المهاجر أو منطق أشجار اللوز الألفية الشاهدة أزهارُها الذابلة على ما خُط هنا وماذا سوف يُخط، ومن مرّ من هنا ومن سوف يمرّ، فهذا هو الأنسب في حال أبي.
نعم أبي وحده يعرف.. يعرف أسماء الأشياء وكنهها، ويتذكر ملامح الوجوه رغم طمس الزمن لملامحها، بل ويستطيع تفكيك شفراتها ويسمع نداءاتها الأبدية التي ترنو للسلام. وأصوات الموتى…؟ تعرفه ويعرفها، ويتذكر ذبذباتها ويحفظ نبراتها وأصداءها التي تخترق دروب الماضي السحيق.
عاشق بنت العم يعرف لوعة الحب ونوباته، وقساوة الأقدار التي تحول دونه. يعرف أن الحب ما هو إلا إخلاص الحبيبة للمحبوب ولو كان مقادا إلى منصة المشنقة، حيث يسيل اللعاب الأحمر للحبل المفتولِ باﻷيادي المدلسة، وألا تبرح العاشقة مكانها عندما يرحل هنالك، وراء حائط الضباب الجاثم على صدر المدينة التعيسة. رابضة، تنتظر مساءاتها الباردة لتنتحب في صمت، ولتتلقى الرسائل العابرة، المعطرة برائحة الطين المبلل.
أبي وحده يعرف ما العمل حين يتنامى إلى الآذان أزيز رصاص الحرب الأهلية المشتعلة، من وراء الجبال الشرقية للمدينة المكلومة المطعونة، يطلع إلى سطح البيت المكشوفة عورته على الليل المقمر المبتسم، يرقب الموت من وراء الثياب المنشورة على الحبل المفتول بالأيادي المشقوقة. يشعل سيجارة التبغ الأسود الملفوفة في كفن من همّ وغمّ. ينفث دخانه في أعين الجبناء فيغشاهم العياء، وحين تسمعه يسعل، فسيسري الأمان لا محالة في البيت المرتجةِ جدرانه، المتلعثمةِ أبوابُه ونوافذه، ويسود فيه النوم فيملأ مسامه وأعينه الحيرى الشاخصة. فتسكن جوارحه وتهنأ بالسلام.
نعم أبي وحده يعرف.. يعرف هذا وذاك، ورب البيت أعلم بجنباته وما دفن سرا وليلا في أحشائه، وبماذا تتهامس أحجاره.
الضارب في الأرض بحثا عن دريهمات يعرف الرزق وأبوابه الموصدة، الصدئةُ أقفالها والتي لا تفتح إلا بإدماء الأيادي والأقدام.
حين يدلف الباب الغربي لسوق المدينة، حاملا على ساعديه الأثقال وجارا من ورائه الأغلال، يتخذ مكانا قصيا تحت الشمس الحارقة حادة الطباع التي دبغت جلد وجهه، ونحتت خيوط الطالع على جبينه. سرعان ما يحيط به الخطر من كل جانب، يحول بينه وبين رزقه، ويتجسد الشر في إنسان بارد السحنة، منفوخ البطن، يريد إحكام وثاقه بالأحبال الوهمية التي فتلت بالأيادي القاسية، لكن أبي ينتفض ويعصف بالخطر وينفخ في الوجه الجليدي دخانه الحارق، فيذوب وثاقه، ثم يرحل بعدها مع الطيور المهاجرة نحو الجهة الغربية للمدينة الضيقة أبوابها.
ولأن أبي أوصاني، فإنني في يوم من الأيام، تخلفت عن الذهاب إلى الكُتاب، ومشيت في اتجاه القرية التي تفتل فيها الحبال التي يسيل لها اللعاب الأحمر. ورأيت الأهالي المغلوبة، المطموسة أعينها، في حجرات مظلمة تشتغل في حزن وألم. وشاهدت بأمّ عيني الظالم في ذلك اليوم القائظ، وهو منحني الرأس تحت منبع الماء الذي كان يوجد في وسط القرية يغسل شعر رأسه وينتعش بالبرودة. كنت ساعتها قد دخلت القرية عبر حقول أشجار الزيتون المحيطة بها، تسللت بالخفة التي أورثنيها أبي، وبلطف بالغ، وحين أصبحت على مسافة قريبة من منبع الماء، أجهزت على الظالم بحجرة كانت كل ما تركه أبي، فخرّ الظالم مغشيا عليه، ولذت أنا بالفرار.
ركضت بعدها بكل جوارحي، حيث إنني كنت أحيانا لا أشعر بالأرض من تحتي، حتى خيل إليّ أنني طائر سابح، يعبر الحقول والوديان. وطاردني جمعٌ من الأشرار الذين يتفننون بفتل الحبال وشدها، لكنهم لم يتمكنوا مني. وبعد ما يناهز ساعة من الجري، استرحت عند شجرة اللوز الألفية التي تعرف جيدا أبي، فتحادثنا عن الأشياء وأسمائها ثم باحت لي بشيء من أسرارها، وضحكنا على سذاجة الإنسان الذي يعلّق آماله على رمي النرود المغشوشة. ونمت عند ظلها الوافر تحت السماء المبتهجة التي كانت كعادتها تتفنن في حرق النجوم بصخب المحتفلين المنتصرين.
وقبيل الفجر بقليل، وبينما أنا في حالة بين النوم والصحو، رأيت الموكب الجنائزي لأبي، نعش يطير به سرب حمام أبيض، وتنامت من بعيد لأذني تراتيل الشهادة، ثم سمعت بيتنا تصدح أبوابه ونوافذه بسورة يس وسمعت بكاء أمي، فقمت مفزوعا من توي، وركضت بكل جوارحي، لكنني ولبعد المسافة لم أستطع الوصول في الوقت المناسب، فلم أقبل جبين أبي ولم أواريه التراب.
ولأن أبي يعرف، فهو يرسل لي كل فصل خريف من بين الطيور المهاجرة نحو الأفق الغربي للمدينة المهجورة، تلك التي تقتات من دود المعرفة، وتغنّي لي مواويله المفضلة، وأجهش بالبكاء حين أراها لأن فيها شيئًا من أبي!