اليتيم الأبدي
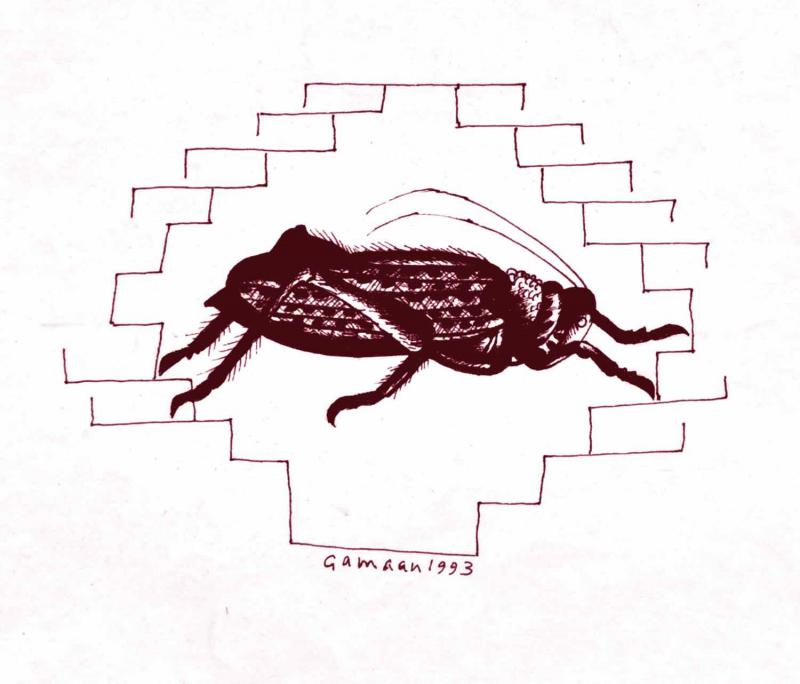
في الثالث والعشرين من شهر أغسطس 1939، أي قبل أسبوع واحد من اندلاع الحرب الكونية الثانية، كتب شاعر أوروبي لم يرغب في الإفصاح عن اسمه، ما يلي “غير أن كل شيء انتهى. ولو كنت شاعرا حقا، فإنه سيتعيّن عليّ أن أمنع الحرب”.
هذه الصرخة المفعمة باليأس والخيبة توحي بمعنيين: المعنى الأول هو أن الشاعر قد يزعم أنه يتمتع بقدرة خارقة لتجنب وقوع كوارث مدمرة. أما المعنى الثاني فهو أن الشاعر الذي يعيش في عالم الكلمات والصور والاستعارات، هو في الحقيقة فرد معزول عن الواقع، وبالتالي هو في النهاية عاجز أن يكون فاعلا في هذا الواقع ليجنّب الناس كارثة حرب، أو أيّ كارثة أخرى.
ولو نحن تأملنا في تاريخ آداب العالم، لعاينا أن للشاعر في كل الثقافات، وكل اللغات، مكانة بارزة تتحقق له من خلال اللغة التي بها يصيغ واقعا قد يكون مخفيا عن الناس الذين يعيش بينهم، وبها يدافع عن قيم تداس، وعن حقوق تصادر. وقد يكون قادرا أيضا على أن يغيّر نظره الناس إلى العالم من حولهم، فلا يكون شعره ترفا جماليا، ولا زينة للمجالس، ولا مديحا لأهل السلطة والنفوذ، بل ابتكارا لما يمكن أن يساعد الناس على فهم وجودهم على وجه الأرض. وربما يكون الشاعر قادرا أيضا من خلال الكلمات على أن يكشف للناس خفايا المستقبل القريب، أو البعيد، وعلى أن يحذّرهم من خطر داهم. وفي الآن نفسه، يبرز لنا التاريخ أن الشاعر مهما علت مكانته، يجد نفسه غالب الأحيان في مواجهة قوى ظالمة وشريرة، سياسية أو دينية تحديدا. وهذه القوى تبذل كل ما في وسعها لإخماد صوته، وتجريده من كل قدراته المعنوية. لذلك قُتل العديد من كبار الشعراء، وعذبوا، وشرّدوا، وحرموا من أبسط حقوقهم، وضربوا بالسوط حتى الموت مثلما كان حال بشار بن برد.
وربما يتمتع الشاعر اليوم، خصوصا في البلدان العريقة في الديمقراطية، بحرية لم يعرفها الشعراء في مختلف العصور السابقة. وخلافا لمن سبقهم، لم يعُد الحكام في هذه البلدان يجرؤون على تسليط العقاب على الشاعر المتمرّد، ولا على إخماد صوته. مع ذلك هو يجد نفسه في مواجهة عالم يضاعف كل يوم من قدراته في تحطيم وتدمير نفسه بنفسه. كما أن هذا العالم يسعى من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة إلى خنق، وتقويض قدرات الإنسان القديمة ليحوله إلى كائن راضخ لهذه الوسائل رضوخا يكاد يكون مطلقا. وكل هذه الوسائل تبدو وكأن هدفها الأساسي هو إقناع الناس بأن الشعر لم يعُد مفيدا ولا نافعا، وأن الشاعر ينتمي إلى سلالة منقرضة ليكون أبطال اليوم نجوم السينما، ونجوم الرياضة، ونجوم الموضة، ونجوم الجريمة المنظمة… وربما لهذا السبب كتب إلياس كانيتي يقول “كلمة شاعر هي من بين الكلمات التي نلاحظ منذ فترة من الزمن أنها مرمية على الأرض هامدة، ومتعبة وخائرة القوى، والتي نحن نتحاشاها، أو نخفيها، وباستعمالها نحن نصبح عرضة للسخرية بعد أن أفرغت من معناها لتصبح بشعة، وجامدة”.
ربما يتمتع الشاعر اليوم، خصوصا في البلدان العريقة في الديمقراطية، بحرية لم يعرفها الشعراء في مختلف العصور السابقة
لكن يبدو أن كانيتي لم يرسم من خلال هذه الفقرة صورة للشاعر الغربي، بل صورة لوضع الشاعر العربي في هذا الزمن الموسوم بتقلبات عنيفة ومتلاحقة. والأدلة والحجج على ذلك كثيرة. فإلى زمن قريب، كان الشاعر العربي يشعر أنه قادر على أن يكون فاعلا في الأحداث الاجتماعية والسياسية والثقافية، وغيرها. ولم يشمل هذا الأمر شعراء ظلوا أوفياء للإرث الشعري القديم مثل أحمد شوقي وبدوي الجبل وسليمان العيسى والجواهري ومعروف الرصافي وسعيد عقل وغيرهم، بل شمل أيضا شعراء ثاروا على هذا الإرث، وعلى أغراضه وأوزانه سعيا منهم إلى أن تكون قصائدهم منفتحة على التجارب الحديثة في الشعر العالمي. لذلك نحن نجد لدى هؤلاء الشعراء المجددين أمثال بدر شاكر السياب وعبدالوهاب البياتي وأدونيس ونازك الملائكة ونزار قباني ومحمود درويش ومحمد الماغوط وصلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطي حجازي وخليل حاوي وغيرهم، ذلك الطموح في أن يحافظ الشاعر على حضوره في الواقع، عاكسا من خلال قصائده نبضات هذا الواقع وتحوّلاته، وتطلع المجتمع إلى الحرية، والعدالة، والتخلّص من ماض بغيض موسوم بالقهر والإذلال. وبالتزامهم بالقضايا الساخنة التي تشغل مجتمعاتهم، سواء كانت هذه القضايا سياسية، أم اجتماعية، أم ثقافية، أم غيرها، تمكّن البعض من هؤلاء الشعراء من اكتساب شهرة واسعة لدى جمهور الشعر في جميع أنحاء العالم العربي. وكانت قصائدهم تحفظ عن ظهر قلب، ويرددها الناس بحماس وإعجاب لأنها تعكس همومهم وأحلامهم وطموحاتهم.
أما اليوم، فالشاعر العربي يُعامل كما لو أنه كائن زائد عن اللزوم. كائن مسكين ومتهور، يزعج راحة الحكام والمحكومين على حد السواء. ولأنه مصرّ على مواصلة “عمله العبثي” الذي هو كتابة الشعر، فإن أعداؤه يزدادون شراسة وعنفا يوما بعد آخر. وأشدّهم عداء له اليوم هم أولئك الذين سمحوا لأنفسهم بأن يكونوا خليفة الله على الأرض. وهؤلاء يستندون إلى القرآن ليعلنوا على رؤوس الملأ أن الشاعر كائن ملعون في الدنيا والآخرة، وأنّ شعره هو في الحقيقة تشويه للغة كتاب الله، ومسخ لها، وتعديا صارخا على حُرمتها، وقداستها. لذا لا بدّ من طرده من مملكة الله، وتشريده ليهيم على وجهه في أودية الغاوين والمنافقين وتجار البلاغة الرخيصة. فإن هو أظهر أي شكل من أشكال العصيان والتمرّد، فإنّ هَدْر دمه يصبح أمرا مشروعا.
ويعلم من يزعمون أنهم خلفاء الله على الأرض أنّ عداءهم للشاعر لن يثير غضبا، ولن يستدرّ ولو ذرّة من مشاعر العطف والرحمة والشفقة في مجتمعات سُلبت منها قدراتها وأحلامها وطموحاتها، وفقدت حسها الإنساني، وقدرتها على صدّ المظالم الأشد انتهاكا لحقوقها البسيطة لتبتلع السكين والهراوة وهي خانعة ومستكينة. لذلك هم يستميتون في استنباط الوسائل، وابتكار الفتاوي لإجبار الشاعر لا فقط على الكفّ عن كتابة الشعر، بل على الانسحاب من الحياة جملة وتفصيلا.
الشاعر العربي يُعامل كما لو أنه كائن زائد عن اللزوم. كائن مسكين ومتهور، يزعج راحة الحكام والمحكومين على حد السواء
ويشعر الشاعر العربي اليوم باليتم. فهو لم يتخلّ فقط عن أوزان الشعر القديم، وعن قواعده، وبناه، بل تنصل أيضا من موروث الشعراء المجددين في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، مظهرا عزمه على فتح آفاق جديدة في الكتابة الشعرية. ومثل أبي نواس الذي سخر من الشاعر الجاهلي الباحث عن آثار الحبيبة في الرمال المتحركة، هو لم يعد يجد لدى جلّ مشاهير الشعراء القدماء أو المحدثين إلاّ القليل من القصائد التي تثيره، وتهزه، وتضيء له الطريق. وبعد أن تعرّف على شعراء من مختلف العصور، ومن مختلف أنحاء العالم، بات يشك في أن العرب كانوا “أمة الشعر”. ولعلهم نسبوا لأنفسهم مثل هذا الشرف لأنهم لم يسعوا إلى التعرف على أشعار الأمم التي سبقتهم مثل اليونان والرومان، كما أشار إلى ذلك الشاعر التونسي الكبير أبوالقاسم الشابي في كتابه “الخيال الشعري عند العرب”. وأثناء سعيه إلى كتابة قصيدة جديدة متحرّرة من كل ما يمتّ للإرث الشعري القديم، أو الحديث، اكتشف الشاعر العربي أنّ الشعراء الأقرب إلى العالم الذي هو بصدد صياغته ليسوا عربا إلاّ في ما ندر، بل هم فرنسيون وأميركيون وبريطانيون وألمان ويابانيون وإسبان وبرتغاليون ومكسيكيون… وفي قصائد هؤلاء هو يرى نفسه وعالمه. أما في قصائد جلّ الشعراء العرب القدماء فلا يرى سوى أشباح باهتة، وظلال لزمن ولّى وانتهى لتصبح صلته به هشّة قابلة للانقطاع في أيّ لحظة.
ويرفض الشاعر العربي اليوم أن تكون قصائده عاكسة لهموم وقضايا مجتمعه. ولأنه منبوذ من هذا المجتمع، فإنه يحب أن يكتب ويعيش متوحدا بذاته، محاولا قدر الإمكان أن يظل بعيدا عن صخب زمن متقلب، لينعم بسكينة روحية تكاد تكون شبيهة بتلك التي سعى إليها المتصوفة والزهّاد القدماء الذين خيروا العيش في العزلة والصمت. ثم أن هذا الشاعر قد يكون أجبر على العيش في منفى قد يكون داخليا، أو خارجيا. لذا فإنّ عالمه الخاص هو الذي يعنيه بالدرجة الأولى. ولأنه لا يريد أن يكون ناطقا باسم مجتمع أو قضية، فإننا لا نجد في قصائده إلاّ صدى باهت لما يحدث خارج عالمه الخاص. بل قد لا نجد أثرا لهذا الصدى. وربما لهذا السبب، تكاد قصائد الشاعر العربي اليوم تخلو من أي صدى للأحداث الكبيرة التي هزت وتهز العديد من البلدان العربية على مدى العقد الأخير.
هل يعني هذا أنّ هناك شاعرا عربيا بمواصفات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الشعر العربي بصدد التشكل في زمن متقلّب، ومضطرب كما البحر في العاصفة؟ قد يكون ذلك صحيحا. لكن علينا أن ننتظر سنوات أخرى لكي تتوضح لنا ملامح هذه الصورة الجديدة للشاعر العربي.
كاتب تونسي




