دفتر يوميات
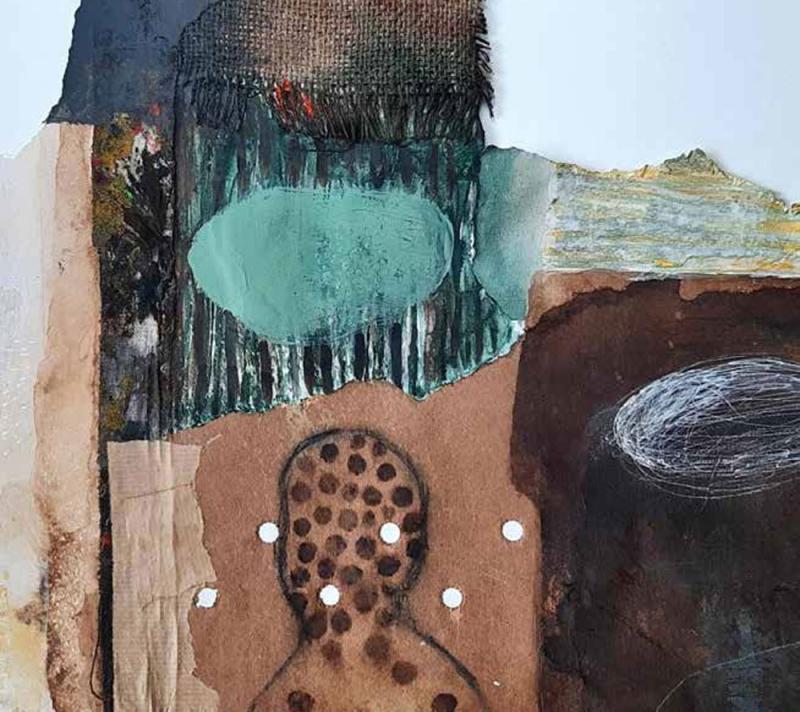
"بَوحٌ أوَّل"
I
كانَ الطِّفلُ الذي كُنتُهُ قد أَكْمَلَ، للتَّوِّ، مسيرة صُعُودٍ مُرْهِقٍ صوبَ رأسِ تلَّة رمليَّة تقعُ على حافَّة شاطيءٍ لا تكفُ موجاتُ بَحْرهِ عن إرسال الأصوات والإشارات والنَّسائم، فيما ثلاثُ طائرات حربيَّة إسرائيليَّة تُحلِّق في السَّماء، على عُلوٍّ مُنخفصٍ، مُرْسِلةً هديرها الصَّاخب في جميع الأرجاء وهي تُلقي أوراقاً مُلوَّنةً تبيَّنَ، فيما بعدُ، أنَّها مناشير مكتوبة بلغةٍ عربيَّة ركيكةٍ تدعو النَّاسَ إلى الاستسلام ورفع الأعلام البيضاء. وعلى الجهة المُقابلة لهذه التَّلَّة، كانَ ثمَّةَ ثلاثُ دبَّاباتٍ تحتلُّ رأسَ تلَّةٍ رمليَّةٍ تَتَوارى خَلْفَ "جُمْيَّزةٍ" و"توتةٍ" تُواريان خَلْفَ أَغْصَانِهِمَا الكثيفة المُثقلةِ بأوراقٍ خضراءَ، وثمارِ تينٍ شآميٍّ أحمرَ وفِرْصَادٍ تميلُ حُمْرتهُ القَانيةُ إلى سَوادٍ، بيتاً صَغِيراً هو بمثابة جزءٍ من طابق أرضيٍّ لبيتٍ رماديٍّ كانَ قيدَ الإنشاءِ، وقد أُريدَ لهُ أنْ يتكوَّن من طابقين أو أكثر، إلاَّ أنَّ إرساءَ جميع أساساته، وتجهيز طابقه الأرضي للسُّكنى لم يَكُونا قد اكْتَمَلا بَعْدُ.
***
يتكوَّنُ الجُزْءُ شِبْه المكتملُ من الطَّابق الأرضي الذي حُوِّلَ على عجلٍ إلى مَسْكنٍ صغيرٍ لأسرةٍ كبيرةٍ تضمُّ أُمَّاً ترمَّلت بفقدِ ربِّ الأسرة قبل نحو عامين، ولمَّا تكن قد تجَاوزت الأربعين من عمرها، وثمانية أولاد وبنتين تتراوحُ أعمارهم ما بين الخمسة وعشرين عاماً وأربعة أعوامٍ ونصف العام، يتكوَّنُ هذا الجُزْءُ من مُدْخَلٍ مستطيل متوسط المساحة ذي باب حديديٍّ ينفتحُ على شُرفة واسعة تُطلُّ من عُلوٍّ يربو على الأربعة أمتارٍ على "شارع النَّصر"، وعلى الجانب الأيمن من هذا المُدخل يَقَعُ سُلَّمٌ حجري يقودُ إلى السَّطح العلوي، وممرٌ قصير يُفضي إلى ممرِّ آخر تتوزَّعُ على جانبيه ثلاث غرفٍ؛ اثنتين للنَّومِ، وواحدة لاستقبال الضُّيوف، وصالة واسعة نسبيَّاً، وحمَّامين تعلوهما سُدَّة ذاتُ باب صغير يقعُ في الجزء العلوي من الحائط الأيسر لمطبخ واسع تمَّت تهيئة بتشكيلات متنوِّعة من المازيكو المائل إلى الحُمره وألواح الرُّخام الأرجوانيِّ. وتنفتحُ إحدى غرف النَّوم، وغرفة الاستقبال، والمطبخ الواسع، والصَّالون العريض الممتدِ باستطالة لافتة والذي هو بمثابة قاعة متعدِّدة الأغراض يجري فيها تناول الطَّعام وإكمال الواجب المدرسي إلى جانب حوائجِ عيشٍ أخرى، على أربع شُرفات تحيطُ بالبيت من الأمام، ومن اليمين واليسار، مُظَلَّلةً بشجيرات فُلٍّ وياسمين تتسلَّق أغصانها المفعمةُ بالزَّهور اليانعة، بيضاءَ وصفراءَ، أعمدة الشَّرفات عبر شَبَكاتٍ من أخشابٍ رفيعةٍ وحبالٍ وأسلاكٍ تتيحُ لها أنْ تتدلَّى على الجدران والشَّبيابك ليتضوَّعَ أريجُ عطرها الشَّآمي في أرجاء الحديقة وأنحاء البيت متمازجاً مع أريج "الحنَّاء" و"الفتنة".
أما الحائطُ الخَلْفِيُّ، المُطلُّ على حَديقةٍ واسعةٍ تَعْمُرها أشجارُ فواكه وحمضيات وأشجارٌ مثمرةٌ أخرى، كالنَّخيل والجوَّافة والسَّفرجل والعنَّاب، وشجيراتُ زهورٍ وورودٍ، وأشتالُ نباتاتٍ، وخضرواتٌ متنوِّعة، فيما تتوسَّطُ حيِّزها الشَّمالي الغَربيِّ بركةُ ماءٍ تأخذ شكلَ نجمة ثُمانيَّة ذات نافورات، فقد تُرِكَ بلا مَحَارة خارجية تَقِيهِ وتُزَيِّنه، فظلَّتْ أسياخٌ حديديةُ مُدَوَّرة تُطلُّ برؤوسها من ثناياهُ، وكأنَّما هي تتهيَّأُ لاستقبال ما سيُدْخلُ على البيت من إضافاتٍ تُكْمِلُ إنشاءَهُ حينَ مَيْسَرة. وعلى بُعدِ بضعة خطواتٍ من بركة الماء، كان ثمَّة "حظيرة" هي أشبهُ ما تكون بكوخٍ خشبيٍّ أو بيتِ حياةٍ صَمَّمتهُ الأمُّ، وأشرفت على تنفيذه، وهيَّأته من الدَّاخل ليضمَّ في رحابه الواسعة "بيوت حياة" هي أعشاسٌ وأقفاصٌ وأقنانٌ وأشكالٌ أخرى تَعدَّدت تصاميمها وتنوَّعت لوازمها وملحقاتها وتباينت مواضعُ وضعها لتُلبِّي حاجات أنواع عديدة من الطيور الدَّاجنة والحيوانات التي جعلت الأمُّ من تربيتها وتنميتها هواية مُحبَّبةً من قبل أنْ تتحوَّل هذه الهواية إلى حاجةٍ عمليَّة ماسَّة، أو إلى مهنة منزليَّة أملاها العَوزُ المُسَيَّجُ بالكرامة والكبرياء، ومتطلباتُ العيشِ الأساسيَّة التي يحول دون تأمينها "ضِيقُ ذاتِ يَدٍ" يُمْعنُ في التَّقلُّص والضِّيق!
أمَّا على الجانب الأيسر من هذا البيت الصَّغير، المُحاط بحديقة تعهَّدتها الأمُّ الفتيَّةُ الصَّارمةُ بعنايةٍ حثيثةٍ وتنسيقٍ جماليٍّ لافت، والمُشْرِفِ من عُلُوٍّ على "شارع النَّصر"، فقد كانَ ثمَّة بيتٌ مكتملُ الإنشاء، مكونٌ من طابقين، ويلي سوره العالي طريقٌ عريضٌ يتجه غرباً باتجاه الشَّاطي، وشرقاً باتجاه حيِّ الشِّجاعيَّة وجبل المُنْطَار، مُروراً، بأجزاء من حيِّ الرِّمال، والأماكن والأحياء الأخرى، كمدرستي "فلسطين" و "اليرموك" وحارتي "التَّفاح" و"الدَّرج"، و"جامع السيد هاشم" و"قبر شمشون"، و"مدرسة الزَّهراء"، و"الجامع العمري الكبير"، و"المدرسة الهاشميَّة" التي تقعُ عَلَى تلَّة الزَّهراء المُحاذية لحيِّ الشجاعيَّة، الأشهر بين أحياء مدينة غزَّة، والذي هُو مِسْقَطُ رأس كاتب هذه السُّطور.
وعلى الجَانب الأيمن من البيت، حيثُ تمتدُّ عرائشُ العنب الأحمر والأسود والأخضر والأبيض متبوعةً، على امتداد السُّور الحجري، بأشجار برتقال يافاوي وكلمنتينا ومندلينا وخشخاش وليمون وزيتون وسفرجلٍ وعِنَّاب، فيمتدُّ شارعٌ صغيرٌ متوسطُ العَرض ينتهي من جهة الغرب بالتَّقاطع مع شارع يتحاذى، لمسافة محدودة، مع "مُعَسْكَرٍ للاجئين الفلسطينيين المسيحيين" ويُمتدُّ باتجاه شمال مدينة غزَّة في مُحاذاة "مُعَسْكر الشَّاطئ للاجئين الفلسطينيين" اللَّذين أنشأتهُما، في خمسينات القرن الماضي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وصولاً إلى بلدة "جباليا" ثمَّ "بيت لاهيا" التي تقعُ على تخوم الأرض الفلسطينيَّة التي تمَّ احتلالها من قبل العصابات الإرهابيَّة الصُّهيونيَّة في حوالي منتصف العام 1948، ليُنشأ عليها كيانٌ احتلالي استيطانيٍّ بات يُسمَّى بـ"دولة إسرائيل"!
وعلى الجهة الموازية لهذا الشَّارع الصَّغير الذي يمتدُّ لمسافة تربو على خمسة دونمات، أقامت الأونروا، على عجلٍ، مدرسةً (ابتدائيَّة) للذُّكور أُطلقت عليها اسم "مدرسة غزة الجديدة" كما أقامت على الجانب المُقابل من "شارع النَّصر" الذي تُطلُّ عليه هذه المدرسة من جهة الشَّرق، مدرسة (إعداديَّة) أُخرى، بالاسم نفسه وللذكور أيضاً، تُطلُّ عليه من جهة الغرب، فيما كانت مدرستان للإناث قد أُقيمتا على حافَّة "مُعسكر الشَّاطيء" لتطلَّا على الشَّارع الموازي لشارع النَّصر من جهة الغرب، وهو الشارع الذي كان قد أُطلق عليه فيما أذكرُ، الآن، اسم "شارع الشِّفاء"، وما ذلك إلا لأنَّهُ يمتدُّ جنوباً حتى يصلُ "مستشفى الشِّفاء" الشَّهير أيضاً، ليتجاوزهُ وصولاُ إلى شارع "عُمر المُختار" حيثُ يقعُ مبنى "المجلس التشريعي" الذي يرتفعُ أمامه، في نهاية ممر عريض يفصل بين اتجاهي الشارع في ما يُشبه حديقة عامَّة، تمثالُ "الجندي المجهول".
كان تمثالُ "الجندي المجهول"، الذي لم يكفَّ كاتب هذه السُّطور طوال سنوات طفولته وفتوَّته عن مجالسة أصدقائه تحت قدميه، قد بُنِيَ في العام 1957 فوق قبر جنديٍّ فلسطينيٍّ مجهول. وخلال حرب حزيران 1967، دمَّرَ جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا النُّصب التِّذكاريِّ الذي أمدَّ أهل غزَّة بأملٍ ينبعُ من مغزى استمراريَّة وجوده ونُبل دلالته. وفي العام 2000، أعادت السُّلطة الوطنية الفلسطينية بناءَهُ، فظلَّ منتصب القامة، مشدود السَّاعد قابضاً على سلاحه الموجَّه صوبَ مُحتلِّي فلسطين من اليهود الذين جيء بهم إليها من أبعد بعيد، إلى أنَّ قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية في كانون الأول (ديسمبر) 2005 فلم يُدَمَّر تماماً، غير أنَّه تعرَّض للقصف، مرَّة ثانية، أو ربَّما للتَّفجير من قبل عناصر حركة إسلامويَّة مُتزمِّتة أيديولوجيَّاً، في حزيران (يونيو) 2007، فنهضت بلدية غزَّة بإعادة بنائه من جديد بوصفه مَعْلماً لا تكتملُ صورة غزَّة إلا بانتصاب قامته العالية وسطَ أجمل ميادينها، وأكثرها بهاءً، وعُلوَّ شأنٍ، وقيمةٍ، ومغزى وجود.
II
كانَ "ربُّ الأسرة"، الشَّيخ الأزهري، والمُفكِّر المُتَنَوِّر، محمد خُلوصي عُمر أحمد بسيسو، المولود في العام 1909 ميلاديَّة في "حارة بسيسو" في "حيِّ الشِّجاعيَّة" في "مدينة غزَّة" الفلسطينيَّة، والحاصل على شهادة "العَالِمِيَّة" الأزهريَّة في اللُّغة والأدب والفقه، والذي يشغل منصب "قاضي غزَّة الشَّرعي"، إلى جانب مناصب أخرى وإسهامات لافتة في الشِّعر والفكرِ والنَّقد الأدبيِّ والنشاط الثقافي والاجتماعيٍّ والنِّضال الوطني، قد انتقلَ، على عجلٍ، إلى جوار ربِّه، في السادس والعشرين من نيسان (أبريل) 1965؛ وكانت قِصَّةُ "رحيل الأب"، هي أوَّلى قصص التَّشابك الخالد ما بين الحياة والموت التي كان على طفلٍ لمَّا يتجاوز الرابعة عشرة من عُمْرِهِ أنْ يُواجهها، وأنْ يكتنزَ تفاصيلها، بدقَّة متناهية، في باطن عقله، وشغاف قلبه، ووشائج ذاكرته، وعُروق وجدانه، ليستعيدها، باكياً أو مُحَفَّزاً أو فخوراً مُعْتزَّاً، كلَّما أحكمت الحاجةُ إلى الأب الذي غابَ، أو الذي آصْطُفِيَ من قبل الوجود لمواصلة الحياة في مجاله الأبدي، قبضةَ خِنَاقها الدَّامي على روحه الغَائمة في وجودٍ تعسُّفيٍّ غائمٍ ومرير، أو في مفترقِ طريقِ خيارٍ يُفْضِي إلى إبداع حياة تتهيَّأُ للإطلال على وجودٍ حُرٍّ، كريمٍ وخلَّاقٍ، صَافٍ ونبيلْ!
بعدَ عَصْرِ اليوم السَّابق لرحيل أبيه المُفاجئ، أي يوم الأحد الموافق 25 نسيان (أبريل) 1965، أبصرتْ عينا الطَّفل، الذي تمكَّنَ، بعد نحو عامين وواحدٍ وخمسين يوماً، من الوصول إلى رأس التَّلة الرَّمليَّة، أبصرتِ الأبَ مُجَالِسَاً، على حافَّة النَّجمة الثُّمانيَّة ذات النَّوافير، صَدِيقَهُ، رجلَ القانون، قُصَيّ العَبَادْلَة الذي كان يَشْغَلُ مَنْصِبَ قاضٍ في المحكمة المركزية لقطاع غزة. كان الصَّديقان الحميمان، القاضي الشَّرعي والقاضي المدني، يجلسانِ، قُبَالةَ بعضهما بعضاً، على مقعدين صغيرين من خشبٍ وقشٍّ، وبينهما طاولةٌ صغيرةٌ تمدَّدت فوقَ سطحها المُغطَّى بشرشفٍ فلسطيني مُطَرَّزٍ طاولةُ نّردٍ قديمةٍ يبدو أنَّ الشَّيخ قد ورثها عن جَدِّه الشيخ لأبيه الشَّيخ، كما ورث عنهما العلم والمعرفة والقضاء الشَّرعي وعِمَادة، أو مشيخة، الطُّرق الصُّوفيَّة في قطاع غزَّة.
ولم يكن للطِّفل الواقف الآنَ على حافَّة الشُّرفة المُطِلَّة على بركة الماءِ مُتكئاً على كوع يده اليُمْنَى المُثَبَّت على سطح درابزينها الواطئ، وحاضناً في باطن كفِّه الأيمن ذقنهُ مُركِّزاً بَصَرُهُ في تحديق لا يَرْمِشُ، أنْ يُبصرَ فحسب، بَلْ كانَ لهُ أنْ يلتقط الصَّوتَ أيضاً، أعاليةً كانت نبراتُ هذا الصَّوت أم خفيضة، فلم تكنْ الشُّرفة التي يقفُ على حافَّتها، الآن، ببعيدة عن بركة الماءِ النَّجميَّة ذات النَّافورات إلا ببضع خُطواتٍ فحسب.
وفيما كانَ يُركِّزُ تحديقَ بَصَرهِ على التقاط أدق تفاصيل وجهي القاضيين المُتجالسين وإشعاع عينيهما، وحركة يديهما وكفَّيهما وأصابعهما وهي تُلقي مُكَعَّبيِّ النَّرد السُّداسيين العاجيين على سطح الطَّاولة الخشبيِّ، أو وهي تُحرِّكُ الأحجار البيضاء والسَّوداء المُستديرة فتغيِّر أماكنها وأشكال اصطفافها، كانَ يُصْغي إلى أصوات قرقعة إلقاء المُكعَّبين وتحريك الأحجار، وإلى "الحوار الخلَّاق" بين الفقيه الشَّرعيِّ ورجل القانون المدنيِّ، وهما يتحاوران، عبر لعبة النَّرد الخالدة، بشأن الحياة والموت، الوجود والعدم، البقاءِ في الدُّنيا الفانيَّة أو الرَّحيل عنها!
مرَّ بمحاذاة البركة النَّجميَّة طفلان، هما شقيقا كاتب هذه السُّطور الأصغرين، هَمَّام وشَديد، وللاسمين، بالطَّبع، دلالاتُهما الكاشفة عن جانب من جوانب رؤية والدهما الشَّيخ الأزهريِّ للعالم، إذْ أراد لأبنائه أنْ يتوافروا على وافرِ الهمَّة، وقوَّة العزم، وبسالة الإقدام، وامتلاك النَّفس عند الغضب، وذلك إلى جانب خصائصَ وسماتٍ أُخرى تحمل أسماءُ أبنائه وبناته الأخرين، الفرديَّة أو المُركَّبة، جوهر دلالاتها: بسَّام، أحمد صخر، سُلَافة، مُحمَّد وضَّاح، عبد الرَّحمن، سَائد، عُمَر، أَسْماء، ثًمَّ همَّامٌ وشَديد، والطَّفلان اللَّذان غادرا الحياة في هيئة ملاكين من أثير بعدَ أنْ تجسَّدا، لوقت قصير، في هيئة مولدين آدميين من رحم أمٍّ: سَهلٌ ووضَّاح.
ببطٍ وتؤدةٍ، مَرَّ الطِّفلانُ بُمحاذاةِ البركة النَّجميَّة وقد دفَعَا عُنقيهما إلى الخلف ليلامسَ آخرُ رأسِ كُلٍّ منهما طَرف كتفيه وأوَّلَ عَمُودهِ الفِقَريِّ، مُفْتَرِضَين، بحذقٍ طفوليٍّ، أنَّ هذا الوضع سيُعزِّز قدرتهما على التَّحكُّم في تحريكِ طبقٍ نجميٍّ طَائرٍ تُمْسِكُ كفُّ واحدهما اليُمْنى بِبَكرة خَيْطِه، فيما هو يُمرِّرُ من بين سبابة كفِّه اليُسرى وإبهامها المزيد من المدى الخيطيِّ ليدفعَ الطَّبقَ، في تتابعٍ مُحْكَم القَدْرِ وقَلَقٍ بَادٍ، نحوَ مزيدٍ من العلوِّ في فضاءاتِ سماءٍ صافية تُظلِّلُ بَحْرَاً خَفِيفَ الموجِ، وتِلَالاً رمليَّة تُفْضِي إلى معسكر لُجوءٍ مُكتظٍّ يقعُ على حافَّة شاطئ رمليِّ مُغَطَّى بزلفٍ، وأَصدافٍ بحريَّة، وطحالبَ لزجةٍ، وعظامِ أسماكٍ!
لَمْ يُبصرْ الطِّفلانِ المُحدِّقانِ بإمعانٍ في طبقيهما الورقيين الطَّائرين، واللَّذين تتسابقُ أصابعهما على إيصالهما إلى أعلى عُلوٍّ مُمكن، لم يُبصرا والدهما وصديقهُ المُتَجَالِسَين على حافَّة بركة ماءٍ نجميَّة ذات نافورات، فَمَرَّا عنهما بخطوات وئيدة حتَّى حَالَ سُورُ الحديقة دونهما ومتابعة الخطوِّ، فأسندا ظهريهما إلى حافَّته الخشنة وأخذا يُتابعان، بانهماكٍ، قيادة طبقيهما الورقيِّين الطَّائرين، ويتأمَّلان، بدهشةٍ طفليَّة، دُنُوِّهما من السَّماء التي تَعْلُو سطحَ البحر، وتبدُّل ألوانهما مع تبدُّل مواضعهما في الفضاء، وتباين درجات انعكاس أشعة شمسٍ الأصيل على سطح ورقهما الصَّقيل الْلَمَّاع!
أمَّا الطِّفلُ الواقفُ على حافَّة الشُّرفة المُطلَّة على تلك البركة مُركِّزاً بصرهُ على وجه أَبيه، فقد كانَ لهُ أنْ يلتقطَ صوتَ الأبِ وهو يُغطِّي مُرور ابنيه الطِّفلين، همَّام وشديد، بمحاذاة البركةِ على نحوٍ خاطفٍ. ومع مُرور الطِّفلين أمامَ بصر أبيهما، مرَّتْ برهةُ صَمْتٍ تأمُّليٍّ تُوِّجَتْ بإطلاق تعليق تساؤليٍّ موجزٍ مسكونٍ بنبرةٍ خفيضةٍ تَمْزجُ بالأَسى الكظيمِ شعوراً غامضاً بدنوِّ الأجل وتطلُّعاً لاهباً إلى متابعة حملِ أمانة الحياة وتمكين الصَّغيرين من الخطو الواثق في مدارات الحياة صوب مستقبلٍ زاهرٍ يرجوهُ لهما: "مش حرام هدول يعيشوا أيتام"! ولم يَكُنْ للطِّفل الواقف على الحافَّة أنْ يتبيَّن ما إذا كانَ والدهُ يُوجِّهُ هذا التَّساؤلَ إلى نفسه، أم إلى صديقه القاضي الذي يُلاعبه النَّردَ، أم إلى سَيِّد الخَلْقِ والكَونِ والقَضَاءِ والقَدَرِ والْعُلوِّ العَالي، أم إليهم أجمعين وقد اجتمعوا في إهابِ بُرهةٍ وجوديَّةٍ كُلِّية تجلَّت في كيانِهِ فأنطقتهُ سؤالاً سكتت عن الإجابة عنه لأجلٍ غيرِ معلوم!

III
فَورَ ارتطام وجدانه بسؤال اليُتْمِ الذي تزامن إطلاقهُ مع نزول قرص الشَّمس إلى أغوار البحر وشروع طائر العتمة في فرد أجنحته السَّوداء، ذهبَ الطِّفلُ إلى غُرفة النَّوم ليجلس على الأرضِ، عند أقدامِ سَريره الصَّغير، ضامَّاً أصابعَ كفِّه اليُمْنَى على شيءٍ يُحِكِمُ قبضته عليه خوفَ تبدُّده، ومُغْلقاً فَمَهُ على شفتين متلاصقتين وفَكَّين مُلْتَحِمَين ولِسَانٍ يحترقُ بجذوةِ سُّؤال صَيَّرَ اللِّسانَ جَمْرةً أحالت كهفَ الفمِ أَتوناً جَمْريَّ اللَّهب!
ولأمدٍ غير قَصير، مكثَ الطِّفلُ الجالسُ، وحيداً مُنْكَفئَ الرَّاس، عند أقدام السَّرير غارساً كوعَ يده اليُمْني في قطن فرشته، يفتحُ قبضة كّفِّه اليُمنى ويُغلقها بحزنٍ غامضٍ وتوترٍ كظيم، فما إنْ تنفتحُ قَبْضَةُ الْكَفِّ حتَّى يتوالى ارتسام كلمات السُّؤال الجَمْري على سطح باطنه: "مش" "حرام" "هدول" "يعيشوا" "أيتام" "؟!"، وما إنْ تنغلقَ حتَّى تكونُ الكلمات جميعها قد تجسَّدت في صِيغةِ سُؤالٍ مُكْتَملِ الأركان: "مش حرام هدول يعيشوا أيتام؟!".
ولعلَّ المدى الذي استغرقه فتحُ قبضة الكفِّ وإغلاقها، في عُزلة تامَّة وبتواتر زمنيٍّ بطيء متطابق البرهات، أنْ يكون هو ما رسَّخَ حضور هذا السُّؤال الوجوديِّ، عبر تشكُّلاتٍ صُوريَّة وتجلِّيات مُتَصَوَّرة وتَخَيُّلاتٍ لا تُحصى، في أعماق وجدانِ طفلٍ لم يَكُنْ قد وصلَ رأسَ التَّلة الرَّمليَّة، بعدُ، ليُدركَ لِلْيُتم من مَعْنىً آخرَ غيرَ السَّلبِ والفَقْدِ المُفْضِيان إلى الارتطامِ بقبح العالم وضراوته عبرَ الولوج في حالٍ من العجزٍ المهيضِ المتواكب مع شُعورٍ مُتفاقمٍ بالهشاشة وقابليَّة الانكسار!
كانَ للعينين أنْ تُبْصرا كلمات السُّؤال وأنْ تكتنزاها في شرائح الذّاكرة الرَّائية على نحو ما ارتسمتْ في المشهد الذي أبصرتاهُ، وفي خطوط باطن الكفِّ التي أمعنتا في تأملها وهما تقطرانِ بدمعٍ تبصران نظيرهُ يقطر من ثنايا الخطو. وكان للأذنين أنْ تلتقطا نبراتِ الصَّوتِ التي اخترقتهما اهتزازاتُ موجاتها كأسياخٍ مُحمَّاة، وأنْ تكتنزاها في شرائح الذَّاكرة السَّامعة، ليتضافرَ نفاذُ إشعاعات الضَّوءِ مع اهتزاز موجات الصّوت في قرعِ عظمَ الجمجة حتَّى يثقباهُ وصولاً إلى مركز استقرارهما الأبديِّ في ألياف الدِّماغ وثنايا خلاياهُ! ولم يكن للطِّفل النَّائم في قلبِ كابوسٍ خانق يتشكَّلُ في أقبيةِ يُتْمِ قَدْ يأتي، أنْ يتفادى توالي نفاذ الإشعاع الضَّوئي السَّاطع إلى عينيه، وتتابع القرعِ الصَّوتي الدَّامي على عظم جمجمته، بل على كيانه بأسره! هكذا لم يكن بمقدوره أنْ يُغْمِضَ عينيه، أو أنْ يُغلق أذنيه، لينام في أتون يُتْمٍ سيأتي!
***
مع إشراقة شمس يوم الاثنين، الموافق 26 نيسان (أبريل) 1965، نَهَضَ الطِّفلُ الذي كان قد ذهبَ فورَ ارتطام وجدانه بسؤال اليُتم في اللَّيلة الفائته إلى سريره مسكوناً بتوقُّع أنْ تَتَجَلِّي الإجابة عن هذا السُّؤال في أي لحظة قادمة، نهضَ من سريره، وشرعَ يَفْرُكُ عينيِّه وهو يمَضى ماشياً، شِبْه نَائمٍ وشَبْهَ يَقِظٍ، صَوب الشُّرفة التي كان يقف عندَ حافَّتها بالأمس، ليتابع الإطلال على تفاصيل المشهد الذي رأى، والإصغاء إلى نبرات الصَّوت الذي سمع؛ وليتمعَّن بعمقٍ في تعدُّد تفاصيل مكونات المشهد وتنوِّعِ تموجات نبرات الصَّوت اللذين كان قد أغمض على أولهما عينيِّه وأغلق أُذنيه على ثانيهما، وأودعهما تحت وسادته، بعدَ أنْ كانَ قد مَدَّد الأوَّل إلى جواره على السَّرير الصَّغير ممسكاً بأطراف أصابعه، ومُحدِّقاً فيه، مستنطقاً تشكُّلاته المُتداخلة واستيهاماته المتكاثرة وتشخُّصاته المتغايرة، لأمدٍ غير قصيرٍ، فيما هو يُتابعُ الإصغاء إلى نبرات الثاني تتصادى في أرجاء الحديقة والبيت وتملأُ كيانهُ وهواءَ الغُرفة بنبوءة موتْ!
لَمْ يَجِد الطِّفلُ ما كانَ يأملُ أنْ يَجِدْ، لم يكنْ ثمَّة من أحدٍ يُجالسُ أحداً ويُلاعبهُ النَّردَ على حافَّة بركةٍ ماءٍ ثُمانيَّة الأضلعِ ذات نافورات، وليس ثمَّة من طفلين يُطيِّرانِ، بحذقٍ ممتعٍ وقلقٍ بادٍ، طائِرَتِيهَما ذَاتيِّ الورق المُلوَّنِ، اللَّامعِ الصَّقيل، في سَماءِ غزَّةَ الزَّرقاء الصَّافية وقتَ الأصيل، ولم يَكُنْ في قلبِ البركةِ التي أُفْرِغت من مائها بغية تجديده نافوراتٌ تضخُ فيها الماءَ من عَلٍّ يأتي من تحتٍ عَميقٍ غير منظور. كانَ الصَّمتُ مُطْبِقَاً وكأنَّماالكونُ كُلُّة قد أُصيبَ بخرسٍ عميم، وكانَ الهواءُ ساكناً بلا نسمات تدلُّ على وجوده، ولَمْ يَكُنْ ثمَّة من قاضٍ شرعيٍّ يُحاورُ قاضٍ مدنيٍّ حولَ أسئلة الحياة والموت، الوجود والعدم، البقاء في الدُّنيا أو الرَّحيل عنها، فيما هُمَا يتبادلانِ وشوشة مُكَعَّبيِّ الحُظوظ والأقدار قبل إلقائهما على سطح طاولة نَردٍ يتقاسمان مساحتها!
وعلى الرَّغم من إمعانه النَّظرَ في كُلِّ ما حوله، وإطالته التَّحديق في الموضع الذي كانَ أبوهُ يُجالسُ صديقه ويُلاعبه النَّردَ فيه، لم يَعْثُرْ الطِّفلُ على ما يُؤكِّدُ لهُ أنَّ ما أبصرته عيناهُ من صُور، وما التقطتهُ أذناهُ من أصواتٍ، وما اشتمَّه أنفهُ من أريجٍ فوَّح في الأرجاء رائحة الجنَّة، كانَ واقعاً قائماً في العالم الخارجيِّ لا محضَ تخيُّلٍ داهَمَهُ وملأَ عليه كيانه منذ الأصيل الفائت حتَّى مطلع الفجر الجديد!
أخذتِ الطِّفلَ هواجسُ كوابيسِ اللَّيل حتَّى تملَّكتهُ وشرعت ترْسُمُ أمام بصره، بتكاثرٍ واكتظاظٍ، صورُ مخلوقاتٍ وحشيَّة غريبة تراءت لهُ كتنويعاتٍ على صُورة "عَزرائيل" قابض الأرواح التي استقتها مخيِّلته من حكايات خرافيَّة سمعها، وقصصٍ مُصَوَّرة قرأها، وتعويذاتٍ وأمثالٍ أصغى إليها، وأنيابَ وأسنانَ وأظلافَ وأرجلِ وأذرع هياكل كينوناتٍ وحشيَّة أخرى اجترحتها مخيَّلته مُذْ طفولته الباكرة، واكتنزت ذاكرته مشاعر الرُّعب التي كانت تجتاحته مترافقةً مع وقائعَ تعقُّبها خطواته الرَّاجفه، أو ظهورها فجأةً أمامه، أو ملاحقتها له وركضها خلفه للإمساك به بغية إيذائه أو خطفه أو قبض روحه، في عتمة الليالي الحالكة وهو عائدٌ إلى البيت عبر طريق موحشٍ يمرُّ بغابة أشجار الكينياء الضَّخمة المتاخمة للبيت المُنفرد الذي كان قيد الإنشاء ولمَّا يكن ثمَّة من بيت آخر سواه قد أقيمَ على حافَّتها الجنوبيَّة الغربية، أو فوق أيِّ من التلال الرَّمليَّة الشَّاسعة المحيطة بها من شرقٍ وشمالٍ وجنوب وغرب!
فجأةً، وفيما هو مأَخُوذٌ بكوابيس اللَّيل التي تحوَّلَّت، مع طلوع الفجر وبدء الشُّروق، إلى شبه كوابيس يقظةٍ في فَجْرٍ يشي غُموضهُ بصُبحٍ غَائم، سَمِعَتْ أُذنا الطَّفل، الضَّاجتين بِوَقعِ أقدامٍ ثقيلة الوطئ وأصواتِ كائناتٍ شبحيَّة غريبةٍ، حفيف أقدامٍ أثيريَّة تَخْطُو فوق عُشبٍ نديٍّ، وأبصرت عيناهُ شبه المفتوحتين على إغماضة كابوسيَّة طالَ أمدها، والمحدِّقتين في أرضِ الحديقة المُغَطَّاة بالعُشْبِ والغَبَش، طَيْفَ كائنٍ نُورانيٍّ يتقدَّم صَوبه، بُخطى وئيدة، عبرَ ممرٍ ضيِّق فُرِشَتْ أرضيَّته بزلف البحر وسيَّجته من الجانب الأيمن شجرة برتقال يافاويٍّ وشجرتي ليمون بَلَدِيٍّ وبَعْلِيٍّ، ومن الجانب الأيسر ثلاثة أشجارُ زيتونٍ شرعت عناقيدُ زهورِها العِطْريَّة البيضاء في التَّشكُّل.
IV
أطلَّ الطَّيفُ النُّورانيِّ طالعاً، في البدء، من قَلْبِ خميلةٍ شكَّلَتْهَا تعريشةُ عِنَبٍ تمدَّدَتْ فوقَ سَطْحَها أَغْصَانٌ مُتشابكةٌ كثيفةُ الورقِ تتدلَّى منها عناقيدٌ ذاتُ حبَّاتٍ لؤلؤيةٍ حَمْراءَ وسَوْداءَ وخَضْراءَ وبَيْضاءَ، وتهدَّلت على جوانبها الأربعةُ، ما عَدَا كُوَّة صغيرة في وسط جانبها الشَّمالي، أغصانٌ طريَّةٌ ذاتُ أوراقٍ خَضْراءَ نَضِرةٍ تُبرقُ بِقْطْرِ النَّدى وتلامسُ أطرافُهَا الأرضَ بِحَنَانٍ خفيٍّ.
وما إنْ أبصرتْ عينا الطَّفل، عبر الغبش، هامة الطَّيفِ العالية التي كانت هالاتها تعلو ثمَّ تعلو ثمَّ تعلو مع كُلِّ خُطْوَةٍ تُقرِّبُ وصولهُ إلى الشُّرفة التي يتَّكئُ على حافَّتها، حتَّى انتصبَ واقفاً، وشرعَ يشدُّ جسدهُ ويُمدِّدهُ مُخَفَّزاً بالرَّغبة في أنْ يُواكبَ عُلوَّ هالاتِ هامةِ الطَّيف إلى أعلى علوٍّ تصلهُ، غيرَ أنَّ أمراً لم يُدْركْ كُنْهَهُ قد حَالَ دونهُ وذلك، فأمسكَ شحمةَ أُذنه اليُمنى بإبهام وسًبَّابة كفِّه اليُمنى وأخذَ يفركُهَا بنعومةٍ فيما هُوَ يُمرِّرُ أصابغً كفَّهُ اليُسرى، جيئةً وذهاباً، على عينيه لإنهاضهما من الخَفَش الذي حال دونهُ والتَّمعنِ في أدقِّ تفاصيل الطَّيف النُّوراني الذي تراءى لهُ أنَّه يخطو صوبهُ فاتحاً ذراعيِّه كأَنَّما يريدُ احتضانهُ لِيُطَيِّفَهُ كي يأخذَهُ، محمولاً على كفِّهِ، صَوبَ أعلى علوٍّ تتوقُ هامتُهُ إليه!
ومَعْ وُصُولهِ إلى حافَّةِ الشُّرفةِ، مدَّ الطَّيفُ يدهُ اليُمنى صوبَ الطِّفلِ الواقف منتصباً كتمثالٍ من رُخَامٍ سًماويٍّ أزرق، وأَخَذَ يُربِّتُ بكفِّه على كتفه، مُكَرراً القَولَ بحُنُوٍّ مُحَفِّز وتشجيع: "عَفَارمْ، عَفَارم، عَفَارم عَليك"، ومُكِمِلاً بابتهاج وغبطة: "شايفك صاحي بدري اليوم، عَفَارم ... تجَهَّز للذَّهاب معي إلى السُّوقِ لجلبِ ما سنبتاعهُ من مُسْتَلزماتِ شَطْحَة اليوم إلى "الشَّيخ عجلين"، سنسبح معاً هذا اليوم يا "نَصْرَ"، سأتابع تعليمك وأخوتك السِّباحة، وستمسكون بي أو سأحملكم على ظهري لنعبرَ البحر صوبَ أبعدِ مدى نستطيعهُ .. ولعلَّ أمُّك قد ابتاعت، أو جَهَّزت لكَ ولإخوتك، مايوهات جديدة .. تهيَّأ لمصاحبتي بعد قليلٍ إلى السُّوق .. تهيَّأ يا "نَصْرَ" .. تَهيَّأ!
وفيما هو يَنْعُمُ بتربيت كفِّ أبيه على كتفِه، ويُصْغي إلى كلماته المُشجِّعة ويبصرُ في عينية بريقَ بهجة قادمةٍ ستعمُّ الأسرة بأسرها، ما عدا الابن الثَّاني "أحمد صخر" الذي كانَ قد التحق بجامعة أسيوط لدراسة الهندسة، والابنين سائد وعمر اللذين كانا مُشتركين في رحلة مدرسيِّة مُقرَّرة من قَبْلُ بمناسبة "عيد شمِّ النَّسيم"، أشرفتْ كوابيس الأصيل واللَّيل التي تحوَّلت إلى شبه كوابيس يقظة في فَجْرٍ قاسٍ وصبحٍ غير شَفُوقٍ على التَّبدُّدِ، وشَرعَ الطِّفلُ في تَصَوُّرِ نفسه مُمْسِكاً برقبة أبيه بكفية وهو مُمدَّدٌ على ظهرهِ فيما الأبُ يُوغلُ سَابحاً في بَحْرٍ مفتوحٍ على أُفقٍ بهيجٍ تبصرهُ عيونُ الأبِ السَّابحِ حاملاً ابنه الصَّغير، وربمَّا غيره من أبنائه، على ظهره، فيمضي نحوَ ذاكَ الأُفق، فتراهُ عُيونهُ يَمْضِي مُبْتَعِدَاً داعياً إيَّاهُ وأبناءَهُ للمضيِّ قُدُماً صوبَ آفاقٍ لا تُحدُّ ولا تتناهى!
صاحَ الطِّفلُ: "تَحْتْ أَمْرَكْ يَابَا"، وهمَّ بمُغادرة الشُّرفة للدُّخول إلى البيت بُغية التَّهيُّؤِ لما أمرهُ أبوه أنْ يَتَهيَّأَ لهُ، غير أنَّ بقاءَ كفِّ أبيه مُربِّتةً على كَتِفة أبقاهُ واقفاً، حيثُ هُوَ، لبرهةٍ استغرقت ثلاثَ تربيتاتٍ ومِسْحَةً واحدةً على الرأس. تراجعَ الأبُ خُطوهً إلى الوارء تلازمت مع استدارة خفيفة جهة اليمين وأعقبتها انحناءةٌ تكفي لقطف وردةٍ جوريَّةٍ أُرجوانيَّةٍ ساطعةِ اللَّون تُجَاور وروداً أرجوانيَّة تتنوَّعُ تَدَرُّجات ألوَانِهَا وتَزْهُو بها غُصُونُ شُجَيراتٍ يانعةٍ تَعْمُر الحَوضَ الملاصق لحائط البيتِ ليَتَضَّوعَ عِطْرُ ورودِهَا في أرجائه أرأئجَ فِرْدوسيَّةً ذاتُ عَبقٍ نفَّاذٍ ورنين ناعم!
***
انحنى الأبُ انحناءةً جعلت يدَهُ اليُسَرى تُمَدِّدُ، مَفْتُوحةَ الكفِّ، ساعدَهُ الأيسرَ أدنى ظَهْره ليشدَّ أزرَ عموده الفِقري، فيما ساعدهُ الأيمنُ يتحرَّكُ جاعلاً من الإبهامَ والسَّبَّابَة والوسطى مِقْبَضاً طريَّاً يَقْصُدُ مِرفَق سّاقِ الوردة ليقطفَها دون نزعها عن ساقها، ودونَ إيلامِ الشُّجيرة أُمِّها. وفيما الأبُ يقطفُ الوردة الدِّمَشقيَّة مُنْحَنِياً كأنَّما يُغَازلها ويُطْري جمالها الخالد وهو يشتمُّ أريجها الفردوسيِّ، أدرك الطِّفلُ أنَّ القدمين اللتين كانتا تخطوان خلفَ الطِّيف النُّوراني الأبيض في الممر الواصل ما بين خميلة العنب وشرفة البيت المُسيَّجة بالياسمين، واللتين تصورتهما مُخيَّلته عائدتين إلى مُهْرَةٍ وُلدتٍ للتَّوِّ في تعريشة العنب، إنَّما تعودان إلى شقيقته، ذات العيون الواسعة والوجه الصّبوح والشَّعر الأسود الطَّويل المُنْسَدلِ حتَّى الخصر، سُلافة التي تكبرهُ بنحوِ ثلاث سنوات، والتي لم تَكُن، في ذلكَ النِّيسَانِ القاسي، قد أكملت الرابعة عشرة من عمرها.
أخذتِ الطِّفلُ مُفاجأةُ رؤية شقيقته سلافة واقفة خلفَ أبيهما، جَامدةً في مكانها، صامتةً، واجمةً، مَشْدُوهةً، مفتوحةَ العينين على وسعهما بلا حراكٍ أو بريق، تتدلَّى يداها على جانبيها فيما كفُّ اليدِ اليُسرى تُمْسِكُ بدفترٍ صغيرٍ تصلُ حافَّتهُ إلى رُكبتها، وكفُّ اليد اليُمنى تُمسك بِقَلمٍ منزوع الغطاءِ بما يشي أنها كانت تكتبُ شيئاً ما في الدَّفتر الذي تَحْمِلهُ وأنَّها لا تزالُ مُهيَّأةً لمتابعة الكتابة في أي لحظةٍ قادمة.
وفيما هو يُقلِّبُ عينيه في حيِّزِ إبصارٍ ضيِّقٍ لا يتعدَّىَ متابعة التئام ثالوث أصابع كفِّ أبيه، بنعومة باديةٍ، عند مرفق ساق الوردة ليقطفها، والإطلال على وِقْفة التَّمثال الرُّخامي القابضةُ كفَّاهُ على دفترٍ وقلم، تَلَقَّى الطِّفلُ إشارةً من عين شقيقته تُفيدُ أنَّها قد خرجت من قلب التِّمثال الرُّخامي وأنَّها، حيَّةٌ، هُنا، فألقى عليها، ببهجة غامرة مسكونة بمحبَّة ودهشة، تحيَّة الصباح: "صباحُ الخير يا لولوص .. صباح الخير".
وفي اللحظة عينها، كانَ الطِّفلُ قد سَمِعَ وقعَ قدمين يخطوان، بتمهُّلٍ حذرٍ، صَوبَ الشُّرفة، فأدار رأسه وهو يُلْقي الكلمة الأخيرة من تحيَّة الصَّباح على شقيقته ليبصرَ القادم؛ إنَّها الأمُّ تُمْسِكُ أَصَابعُ كفَّيها بمقبضي صينيَّةً نُحاسيَّة مُستديرة متوسِّطة الحجم تحملُ عليها غلايةَ نُحَاسيَّة، وفنجانيِّ قهوة، وطبقاً صغيراً تستلقي بضعُ تَمْراتٍ على سطحه، وأربعة أكواب فارغة، وإبريقين زحاجيَّين يحتوي أحدهما ماءً والثَّاني عصيرَ رُمَّان. عبرت الأمُّ بابَ الصَّالون، فأطَلَّت على الشُّرفة لتبصرَ ابنها واقفاً عندَ حافَّتها، وليبصرها هُوَ مارَّة باتجاه درجات السُّلَّم الصَّغير المُفْضِي إلى الحديقة، فتبادلا في اللَّحظة نفسها تحيَّة الصَّباح: "صباح الخَير"، غير أنَّ الأمَّ توقفت عن الخَطْو لتتابع الكلامَ وهي تُوزِّع بصرها بين الصِّينيَّة التي تحملها ووجه ابنها: "شَيفَاكْ هِنَا، ليش صَاحِي بدري؟ إنْتَ نِمْتِ امْنِيح، وَلَّا إيش؟ كُل إخوتك لسَّه نايمين، شَكْلَكْ مِتْنَشِّط أُوْمِشْتَاقْ لَلْبَحَر، يلَّا شِدْ حيلك عشان تروح مع أبوك على السُّوق وتْجِيب لِغْراض عشان انحضِّر حالنا للشَّطحة بِلْكِي شَمِّينا النَّسيم، تعال معي لنشوف أبوك وأختك .. ولَّا روح إنتَ شوفهم عند العريشة وقلهم ييجُوا عند البركة".
لم يكن بمقدور الطِّفل، الذي لجمَ لسَانَهُ وجومٌ تَمَادى في الإمساك بكيانه، أنْ يُعقِّب على ما قالته أُمُّة إلا بكلمتين "هَيهُمْ هِنَا"، فردَّت الأمُّ مُتسائلةً: "وين هنا؟"، فأجابَ مُحاولاً رسم ابتسامة على شفتية: "هِنَا .. هِنَا .. جَمْبْ حُوض الجُوري"، وهُنَا تردَّدَ في الأرجاء صوتُ الأبِ وهو يُلْقي على الأمِّ تحيَّتَهُ الصَّباحيَّة الرَّقيقة: "طابَ صَبَاحُكِ يا أمَّ بسَّام .. طَابَ صَبَاحُكِ .. أسْمَعُ رنينَ رائحةِ الفَجْر في قهوتك .. فتعالي إليَّ، وإليَّ بها، طابت قهوتُك .. وطابَتْ كُلُّ صباحاتك".
"آخْ منَّكَ يا أبو بسَّام .. رُحْتِلَّكْ عَلْعَريشَة مَلَقِتْكَاش .. ليش امْصَحِّي سُلافة من الفَجْر؟ قَهْوتَكْ جَاهزة، وينْ بِتْحُبْ تِشْرَبْهَا؟"، هَكَذا علَّقتْ أُمِّي على ما سمعتهُ محمولاً على صوت أبي، وتساءلتْ، فأجابَ: "قد جاءني وحيُّ الشِّعر، وشرعَ يَهُزُّني، فنهصتُ من نومي لأجد سُلافة يقظةً تدرسُ، فطلبتُ إليها أنْ تتبعَ خطويَ لِتُدًوِّنَ بخطِّها الجميل ما يُمْلِيهِ الوحيُّ على لساني من شِعْرٍ يُلْهبُ ذهني ويقدحُ مُخيلتي، أمَّا القهوةُ فِعِنْدَ حافَّة البركةِ أو حيثُ تشائين".
V
أومأت أُميِّ برأسها إليَّ ففهمتُ أنَّها تُريدني أنْ أسبقها لترتيب الطاولةِ والمقاعدِ القائمة عندَ حافة البركِةِ، فأسرعتُ لفعل ذلك، غير أَنِّي فوجئتُ بأنَّ كُلَّ شيءٍ مُرتَّبٌ تماماً، وأنَّ النَّافورات قد تمَّ تشغيلها لتملأ هذه البركة النَّجميَّة بماءٍ يُضيئُهَا ، فَعُدتُ على عجلٍ لآخذَ الصِّينيَّة من يديِّ أُمي كي أضعها على الطَّاولة، فأومأتْ إليَّ بما يُفيدُ أنَّها ستفعل ذلك بنفسها، فامتثلتُ لأمر إيماءتها ورحتُ أخطو بجوارها، فما إنْ وضعت أُمِّي الصِّينِيَّة على الطَّاولة واستعادت وقفتها بعد انحناءة خفيفة، حتَّى كانَ أبي، حاملاً وردته الجُوريَّة بكفِّه اليُمْنَى، وإلى جواره سُلافةُ، قابضةً بأصابع كفَّيها على قلمٍ ودَفْترٍ، يتقدَّمانِ نحوها، ويُلقيانِ معاً تحيَّةَ الصَّباحِ المُخْتَصَرة: "صباح الخير".
رأيتُ أبي يلفُّ ذراعه اليُسرى حولَ كتفِ أُمِّي، ويمدُّ يدهُ اليُمنى بوردته الجوريَّة المقطوفة للتَّوِّ ليُودعها يدها وهو يُقبِّل جبينها ثلاثَ مرَّاتٍ تفصلُ بين كُلِّ مرَّة ومرَّة كلمة أو بضعُ كلمات من عبارةٍ تابعَ نُطْقَهَا: "بُوركتِ .. بُوركتِ يا أمَّ بسام .. بُوركتِ"، فَأَبْرقت عينا أُمِّي وهي تتلقَّى وردةَ أبي، وأضاءت وجْهَهَا ابتسامةٌ خفيفةٌ وهي تشتمُّ رائحتها الفِردوسيَّة الخلَّابة، وتستجيبُ للتبريكات بتبريكات مماثلةٍ مشفوعة بتضرُّعات ورجاءاتٍ بدا أنها تُدرك أنَّ أبي وسُلافة وأنا نقرأ حركة شفتيها فندرك فحواها، فيما هي تُردِّدُ كلماتها في دخيلة نفسها بصوتٍ مكتومٍ لا يسمعهُ أحدٌ غيرُ اللَّه.
فور جُلُوسنا على المقاعد القَشِّيَّة الصَّغيرة المحيطة بالطَّاولة في ما يُشبهُ الدَّائرة، شرعت أُمِّي في صبِّ عصير الرُّمانِ في الكوبين. وتلبية لإشارة من يدِ أُمِّها، وضعتْ سُلافةُ القلم والدَّفتر الصَّغير في جيب فُستانها، ومدت يدها فتناولت كوباً ناولتتي إيَّاه ثمَّ أمسكت بالكوب الآخر واحتفظت به لنفسها. وفي هذه الأثناء، أخذت أُمي في صبَّ القهوة بتمهُّلٍ حاذقٍ يُؤَمِّنُ انسيابها المتواتر كخيطٍ رقيق لا يشرعُ في الالتفاف على نفسه إلا عندَ ملامسة مركز قاع الفنجان الأبيضِ، وذلك على نحوٍّ يُمكِّنُ الخيطَ، من أوَّله إلى آخره، من تكوينِ مزيجٍ مُتماسك يخلوُ من الفَجَوات التي تُسبِّبها فقاقيعُ جزئيات ثنائي أُكسيد الكربون التي لمَّا تمتزجُ بالسَّائل المَغْليِّ، أو بالسائل "المُعدَّسِ" وفق النَّعت الذي يُفضِّلهُ أبي ليشبِّه الفقاقيع الرَّغوية بحبَّات العدس، حيثُ لِلصَّب المتأني أنْ يدفعَ هذه الفقاقيع إلى الأعلى لتتبدَّى على سطح الفنجان في هيئة رغوةٍ تتشكَّلُ من بقاياها التي تمكَّنت من الوصول إليه لتمنح كُلَّ فنجانٍ قدراً يخصُّه من الرَّائحة، ووجهاً هو بمثابة قناعٍ يُخْفي ما يحتويه من سائل متمازج رائق، أو من تِفْلٍ يَرْسُبُ في قاعه.
وفيما كانت أُمِّي تتابعُ صبَّ القهوة، أخرج أبي من جيبٍ جلبابه الرَّمادي قدَّاحةً فضِّيةً وعُلبةَ سجائرٍ مستطيلةً فستقيَّة اللَّون ووضعهما مُتجاورتين على الطَّاولة تَهَيُّئاً لما ينبغي أنْ يحدث لحظة الشُّروع في احتساء القهوة بعد اكتمال عَمَلِيَّة صَبِّها المُتأني في الفنجانين، أي التَّدخين.
أنهت أُمِّي عمليَّة صبَّ القهوة وَدعت أبي إلى الشَّروع في احتسائها، قائلة: "اتْفَضَّل .. هَيْ قَهِوْتَكْ .. اتْفَضَّل .. صحتين". وفي هذه الأثناء، كانت سُلافةُ تُمْسِكُ بكوب عصير الرُّمان في يدٍ، وتضع كفَّ اليد الأخرى على فتحة جيب الفستان، أمَّا أنا، فقد ضَمَمْتُ يديَّ مُتَداخلتيِّ الأصابع ومتلاصقتيِّ الإبهامين على كوبِ الرُّمانِ الذي ثَبَّتُّهُ على فخذيَّ الأماميينِ المتلاصقين جرَّاء التفاف السَّاق على السَّاق وتلاصق الرُّكبتين، ثمَّ انحنيتُ قليلاً لأُقرِّب وجْهي، بوجومٍ، من الكوبِ، لأتأمَّل ما يحتويه، فوجدتني لا أرى في مرآة سطحه الرُّمانيَّة اللَّونِ، شيئاً سوى تساؤل أبي، الذي رافقتني كلماته مُنْذُ أصيل الأمس، وهي ترتسمُ في تشكُّلاتٍ وخطوطٍ وتمازجاتٍ تكوينيَّة لا حصرَ لها وتحتفظُ بلونٍ وحيدٍ هُو الأخضرُ الزَّيتونيُّ الغامِقُ: "مِشْ حَرامْ هَدُولْ يِعِيشُوا أَيْتَامْ؟".
أمَّا أبي الذي كانَ قد استلَّ من عُلبة سجائره سيجارةً وضعها بين إبهام كفِّه اليُمنى ووسطاها، مُسْنِداً مرفقه إلى طرف الطَّاولة وإبهامه إلى طرف جبينه، فقد بدا مُسْتَغْرقاً في بُرهة تأمُّلٍ أخذته إلى أبعد بعيدٍ، فيما السِّيجارة التي لمَّا تُشْعَلُ، بعدُ، تهتزُّ بين إصبعيه المُهتزَّين في فضاءِ يُلامسُ شعرَ رأسه الأبيض. أدركت أمِّي استغراق أبي في "سَرْحَةٍ بعيدة"، فتوقفت عن تنبيهه لتتيح له ما يكفي من الوقت لاقتناص الطَّائر الذي تلاحقهُ مُخيِّلتهُ محمولةً على أجنحة سرحته البعيدة، فأمسكتْ عن إطلاق تنبيه جديد بشأن القهوة الجاهزة للاحتساءِ، فعمَّ الصَّمتُ المكانَ بأسرة، وتمازجتْ رائحةُ غِواية القهوة مع أرائج أزاهير الحديقة وعطور زهرات أشجارها المُهيَّأة للتَّحوُّل إلى ثمارٍ، أو إلى مُفَارقة الغُصُون!
حينَ أدارَ أبي رأسه نحونا، وشرعَ في تأمُّل وجوهنا مُركِّزاً إشعاع عينيه على حدقات عيوننا، أدركتْ أمِّي، وأحسَّتْ سُلافةُ كما أحسستُ أنا، أنَّهُ قد عادَ من سرحته البعيدة، ليدخل في سرحةٍ قريبة يقرأُ خلالها ما تقولهُ عيونُ مُجالسيه وما ينعكسُ في مراياها من تصوُّرات وأفكارٍ تمورُ في ذهنه الشَّارد! وفجأة، رفعَ أبي رأسه ليُحدِّقَ في العلوِّ كأنَّما يُسَارِرٍهُ ببضعِ كلماتٍ نمَّت عنها حركةُ شفتية وأنهتها زفرةٌ ذاتُ أريج فوَّاحٍ ورنينٍ خافت. مدَّ يدهُ دونَ أنْ يُتْبِعَ حركتها بإطلالةٍ تبصرُ اتجاهها، فالتقطتْ أصابعهُ القدَّاحةُ كأنَّما الذَّاكرة قد أملت حركة اليد صوبَ موضعها على الطَّاولة، ثمَّ ضمَّ أربعة أصابع كفِّة اليُسرى عليها، وفتحَ غِطاءها بوخزة من إبهامه الذي أدار به عجلة الإشعال، فتصاعدَ اللَّهبُ مُجلِّياً تصارع ألوانَ النَّار ومَشْبَعَاً برائحة وقودٍ يحترق، فَأخذَ يتأمَّلُ اللَّهب فيما هو يُقرِّبهُ من طرف السيجارة ليشعلها، فاشتعلت وهو يَمُجَّ منها نفساً عميقاً ويُلْقِي بالقدَّاحةَ على الطَّاولة ليلتقطُ فنجانَ القهوة ويحتسي منه أولى الرَّشفات متبوعةً بمجَّة عميقة من السيجارة وكأنَّما هو يُمارس طقوس التَّهيُّؤ لإنشاد ما شرعَ في إنشاده من شعر وهو يتأمَّل ترمُّدَ رأسِ زهرة سّيجارته ويُراقب مآلات خيوطِ دخانها السَّابحة في فضاء يُلاشيها:
دُخَّانها يُؤنِسني راقصاً مُبتسماً والجوُّ بَاكٍ عَبُوسْ
آناً أراهُ كالوشِاحِ انْطَوى ثُمَّ أراهُ شِبْهِ تاجِ العَروسْ
يَحْمِلُ ما تَعْجَزُ عنْ حَمْلِهِ شُمُّ الرَّواسي من هُمومِ النُّفوسْ
بصوتٍ آسرِ خفيض مُتَنَوِّعِ النَّبرات أنشدَ أبي هذه الأبيات، فَسَارعتْ سُلافة كما سارعتُ أنا، وربَّما في اللحظة نفسها إلى سؤاله بلغةٍ فصيحة أَمْلَى الموقفُ حُضُوَرها: "أهذه الأبيات لكَ يا أبي؟"، فردَّت الأمُّ: "هي لجبران خليل جبران"، وتابعت: "مِنْ كُتُر ما اسمعتها من أبوكو سألته عن اسم شاعرها، وكمان إحْفِظتْهَا"، فَعَقَّب أبي على قولِ أُمِّي موجهاً كلامه لسُلافة ولي: "هل قرأتما شعراً أو نصَّاً في كتاب المحفوظات المدرسيَّة من أشعار جبران خليل جبران ونصوصه؟ فأجابت سلافة" "لا أذكر"، أمَّا أَنا فَلُذتُ بِصَمْتٍ يُشجِّع على التَّذكُّر غير أنِّي عجزتُ عن العثور على جوابٍ فيه ظلُّ يقينٍ، فآثرت السُّكوت، فتابعَ أبي قائلاً: "جبران وما أدراكما مَنْ جبران ومَا قَدْ أبدعَهُ جُبران، عليكما بقراءة كُلِّ ما قَدْ كتب، ففي المكتبة تجدان بعض دواوين شعره ومؤلفاته، فخذا منها ما تشاءان واقرآهُ معاً، أو ليقرأَهُ كلٌ منكما على انفراد، أو كما تشاءان، ولكن تناقشا معاً حول كُلِّ ما تَقْرَآنِ وفَكِّرا فيه وشكِّلا رأياً بشأنه، وعودا إليَّ إنْ وجدتما صعوبة أو رغبتما في الإجابة عن سؤال". وقبل أنْ يُنْهِي نُطْقَ عباراته التوجيهة الآملة، كان أبي قد احتسى آخر رشفة في فنجان قهوته، ونَهَضَ واقفاً، واضعاً يديه متشابكتي الأصابع وراء ظهره، ليشرعَ في الخطو صوب البيت، وهو يأمُرنا: "تهيَّئُوا للشَّطحة .. وتهيَّأ أنتَ يا نصرُ للذَّهاب معي إلى السَّوق .. لا تتأخَّر .. سأذهبُ الآن لأتَتَهَيَّأ ... ".

VI
مع بدء صعودِ أبي سُلَّم الدَّرجات الثلاثة المُفْضِي إلى الشُّرفة المُفضية إلى مدخل البيت، تتبعهُ سُلافةُ حاملةً الدَّفتر والقلم على نحو ما حملتهما أوَّل مرَّة، وأتبعها أنا مُركِّزاً بصري على دفترها، تناهت إلى مسامعنا أنغامٌ موسيقىيَّةٌ تُواكبُ صَوتاً تكادُ عذوبةُ نبراته الفريده أنْ تعبرَ خلايا الجسد لتخاطب الرُّوح. ومع متابعة الخطو داخلَ البيت، أدركَ الجميع أنَّ صوت الموسيقى الشَّجيَّة الحزينة إنَّما يتناهى إلى المسامع من قلب المذياع الكبير الموضوع في الصَّالة متعدِّدة الأغراض فوق طاولة خاصَّة به ولا يُوحدُ بجوارها إلا مقعداً وحيداً مصنوعاً من خشب البامبو مُخصَّصاً لأخي الأكبر "بسَّام" الذي أعاقه شللٌ نصفيٌّ ألمَّ به في بواكير طفولته عن متابعة الخطو. ومع الوصول إلى الباب المُفضي إلى هذه القاعة التي فيها ينام بسَّام، انضمَّ إلى الأنغام الموسيقيَّة الشَّجيَّة الحارقة والإيقاعات المُحفِّزة والصوت الفريد ذي النَّبرات الجارحة، صوتَ أخي بسَّام يُشارك عبد الوهاب الغناءَ ساعياً إلى التَّماهي بصوته ومحاكاة نبراته:
أخي جاوزَ الظَّالمونَ المَدَى فحقَّ الجِهَادُ وحقَّ الفِدَا
أنتركهم يَغْصِبُونَ العُروبةَ مَجْدَ الأُبوَّةِ والسُّؤددا؟
...
ومع إصغائنا إلى هذا التَّساؤل الاستنكاري محمولاً على صوتين متمازجين: صوت "محمد عبد الوهاب" وصوت أخي الأكبر "بسَّام"، كُنَّتُ وسلافةُ ندخُلُ القاعة في ذيلِ جلباب أبينا الذي أَلْقَى على "بسام" تحيَّة الصَّباحِ: "طبتَ صباحاً أيُّها البسام .. طبتَ صباحاً .. أراك قد تفوَّقت على عبد الوهاب في أداء هذه القصيدة الخالدة العصماء"، فتابعناهُ، سلافة وأنا، متعاقبين: "صباحُ الخير أيُّها البسَّام" .. "صباحُ الخير أيُّها البسَّام"، فانتتفضَ بسَّامُ مُعدِّلاً جلسته على المقعد ليتمكَّن من إسناد جَذْعِهِ بيده اليُسرى وهو يرفعُ يده اليمنى مُلَوِّحاً لنا، ومتابعاً الغناء. وقفَ أبي واضعاً كفَّيه فوق بعضهما كأنَّما هو واقف في محراب، ووقفتُ وسلافة بإجلالٍ خاشعٍ حيناً، وبإمالة رؤوس وتحريك قبضات في الهواء أحياناً، نُصغى إلى الشِّعر المُغَنَّى:
أَخِي أيُّها العربيُّ الأبيُّ أرى اليومَ موعِدَنا لا الغَدا
أَخِي أَقْبَلَ الشَّرقُ في أُمَّةٍ تَردُّ الضَّلال وتُحْيِي الهُدَى
صَبَرنا على غدرهم قَادرينَ وكنَّا لهم قَدراً مُرْصَدا
...
ولحظة الشَّروع في مزج الترتيل بالتجويد في غناء البيت الشِّعري التَّالي:
أَخِي قُمْ إِلِى قِبْلَةِ المَشْرِقَيْـنِ لِنَحْمِي الكَنِيسَةَ وَالمَسْجِـدَا
...
انضمَّ أبي إلى عبد الوهاب وبسَّام وتابعَ الغناءَ معهما بلا توقُّف، وكأنَّما هو يُغنِّي القصيدة ويتغنَّى بها في آنٍ معاً، فأيقنتُ وسلافة أننا نُصْغي الآنَ إلى كورالٍ منزليٍّ يقودهُ الموسيقار الخالد محمد عبد الوهاب، فَتَحَفَّز كلانا للانضمام إليه لتعزيز قوَّة صوته وتمكينه من إيصال الرِّسالة التي يحملها إلى أبعد مدى يصلهُ، فتمازجَ صوتانا مع أصوات أعضاء الجوقة الأصليين، وكبرت الجوقةُ وصارت تضمُّ، بحسب الأسبقيَّة: عبد الوهاب، بسَّام، أبي، سلافة، وأنا، وسرعانَ ما انضمَّ إليها، أو جاء لحضور الحفل الكوراليَّ المُذاع على الهواء مُباشرةً، أفرادُ الأسرة جميعاً، حيثُ جاءت الأمُّ تستقصي ما يجري، واستيقظ سائد وعُمر وأسماء وهمَّام وشديد، وشرعَ كُلٌ منهم يُشارك في الغناء وفق مشيئته وأسلوبه وفي التوقيت الذي يُقرِّره، ولكن دائماً بنبرات صوتٍ شبهِ نائم وشبهِ مُستيقظ:
أخِي إنْ جَرى في ثَراها دمِي وأطبقتُ فَوقَ حصَاهَا اليَدَا
ففتِّش على مُهجةٍ حُرَّةٍ أبتْ أنْ يَمرَّ عليها العِدَا
وقبَّل شَهِيداً على أرضِها دعا باسمِهَا اللهَ واسْتَشْهَدا
فِلِسْطينُ يَفْدي حِمَاكِ الشَّبابُ وجَلَّ الفِدائيُّ والمُفْتَدَى
فَلِسْطين تحميك منَّا الصُّدورُ فإمَّا الحَيَاةُ وإمَّا الرَّدى
انتهى الحفلُ الكُوراليُّ الذي فرضهُ صوتُ المذياع الذي لا يُحبُّهُ بسَّامُ إلَّا عالياً، مثلما فرضه تعوُّدُ بسَّامٍ مُشاركة محمد عبد الوهاب، كما يُشارك فريد الأطراش، غِنَاء كُلِّ ما يُغنيان، على الهواء مُباشرة، وسعيهِ، مع كُلِّ أغنية، إلى إخراج أيٍّ منهما من الصُّندوق الذي منه ينبعثُ صوته ليستضيفه ويتبادل معه حديثاً لا ينقطع عن كُلِّ أغنية لحنها وغَنَّاها. وقبل تمكُّن شقيقي الأكبر، الشَّاعر الفنَّان، بسام، من إخراج محمدعبد الوهاب من الصَّندوق لاستضافته، انفضَّ الجمعُ وذهبَ كُلٌ منَّا إلى الاعتناءِ بما ينبغي عليه الاعتناءُ به تحضيراً للشَّطحة المنتظرة!
***
كانت أُمّي قد أعدَّت الحمَّام لأبي ليستمتعً بحمام ساخن ووضوء كاملٍ ومتقنٍ قبل الذَّهاب إلى السُّوق لابتياع الأغراض اللازمة للشَّطحة البحريَّة المنتظرة، ولترتيب أمر إيصالها إلى البيت، بصحبتي، في سيَّارةٍ مُستأجرة، والذَّهاب، من ثمَّ، عند توقيتِ صلاةَ الظُّهر، لإمامة المُصليِّن في المسجد العمري الكبير.
لا يزال صوتُ "بابور الكاز"، الذي تولَّى تسخين القدر الكافي من الماء لاستحمام أبي، يرنُّ في أُذنيَّ، وليس ليَ الآنَ إلَّا أنْ اتيقنَ أنَّ رنينه النَّائحُ الذي أصغيتُ إليه في ذلك اليوم المُسمَّى "شمِّ النَّسيم" لم يُفارق وجدانيَ أبداَ، على مدى العقود الزَّمنية التي كان لي أنْ أكون حياً فيها، وعلى امتداد مسارات الأزمنة التي عبرتها عبر منحنيات الحياة التي لا أعرفُ، ولعلِّي لا أُحبُّ أنْ أعرف على نحوٍ مُسْبَق ويقينيٍّ، متى تتوقَّف هذه المُنحنيات المُضْنِيَة، القاسية والنَّبيلة، عن الحياة!
بعدَ أنْ أبلغته أُمي أنَّ كُلَّ شيء جاهزُ و"على ما يُرام"، دخلَ أبي الحمَّامَ الكبير المُحَازي للمطبخ جهةَ الشَّرق، وأغلق الباب، وتابعت أُمي، في المطبخ وفي غيره من أرجاء البيت، التَّحضير للشَّطحة التي كان أبي قد أبلغها بأمرها في وقتٍ مُتأخِّرٍ من اللَّيلة الفائتة، إذْ إنَّهُ كان قد اتفق، عبر الهاتف على ما قد بدا، مع صديقه وصديق الأسرة السَّيد "أبو ماجد أبو شرار" الذي كانَ يشغلُ منصب قاضي المحكمة المركزية في غزَّة، على إتمامها في الغد الذي يُصادف عطلة رسميَة بمناسبة "شمِّ النَّسيم"، ليلتئم شمل الأسرتين الصديقتين بحميميَّة منقطعة النَّظير في "شطحة مُشتركة" على شاطيء "الشيخ عجلين"، في "شاليه" تعودُ ملكيتهُ إلى صديق مُشترك من عائلة "لُظن".
أمَّا شقيقاي سائد وعمر فقد توجَّها صوبَ غرفة النَّوم للتّأكُّد من أنَّ حقيبتيهما اللتين أعداهما في المساءِ الفائت تحضيراً لمشاركتهما، هذا اليوم، في رحلة مدرسيَّة، تحتويان كُلَّ ما يريدان أو يحتاجان. أدخلَ سائد وعُمر ما أعدته أُمُّهما لكلٍّ منهما من سندويتشات وعصائر وفواكه في جوف الحقيتبتن الصَّغيرتين، وحمل كُلٌّ منهما حقيبته، وذهبا إلى المدرسة معاً للالتحاق بالرِّحلة.
وأمَّا شقيقتي الصَّغيرة أسماء، فقد كانت إلى جوار أُمِّها طوال الوقت تنتطرُ فروغها من مهمات تحضير مستلزمات الرِّحلة في المطبخ، لتولي جٌلَّ عنايتها لأمر اختيار الفستان الذي سترتديه، ولتصفيف شعرها، وللتَّأكُد من أنَّ كل ما يلزمها قد أودع في السِّلال أو في الأكياس التي ستُحملُ، لاحقاً، إلى "الشَّيخ عجلين".
في هذه الأثناء، كان شقيقاي "الرُّوسيان" همَّامٌ وشديدٌ، يَجْلِسَانِ على مقعدين وثيرين في غرفة الضُّيوف، ويتجادلانِ، بطفوليَّة منقطعة النَّظير، بشأنِ مَنْ منهما الذي كانَ الأكثر حَذَقاً في إطلاق طبقه الطَّائر، وفي تطيِّيره في الفضاء البعيد والتَّحكم في حركته بغية الصُّعود به إلى أعلى الأعلى، وتوجيهه ليتابع طيرانه الواثق فوق البحرِ وفي مدارات سماء غزَّة، ثُمَّ تحريكه في اتجاهات شتَّى، ودفعه إلى أعلى عُلوٍّ ليُعانق النُّجوم وهي تبزغُ في السَّماء لحظة دُنُوِّ قُدوم الأصيل، وذلك قبلَ الشًّروع في سحبه للنزولُ في عين الموضِع الذي تمَّ إطلاقهُ منه في حديقة البيت، عند نُزول المساء!
لم يكنْ شقيقايَ الصَّغيرين همَّامٌ الذي يكبر شديد بنحو عامين، وشديدٌ الذي هو آخر عنقود أنا واسطة عقده، يعرفان شيئاً عن الوجعِ الذي ألمَّ بأبيهما أبي، وبُسلافة أُختي واختهما، وبأُمِّهما أُمِّي، حين جاءَ الوحيُّ بنبوءة أنَّهما سيعيشانِ، بعدَ بضعِ ساعاتٍ من الآن، يتيمين، بلا أبٍ يرعاهما، وبرعاية أمِّ ترمَّلتْ على عجلٍ، وستَذُوقُ الأمرَّين والأمرَّ من الأمرَّين من أجل رعايتهما ورعاية الثَّمانية الآخرين من أبنائها وبناتها على نحو لا يُعوِّض غيابَ الآبِ فحسب، بل يؤكِّد عدم غيابه!




