البطل المضاد

يُروَى أنّ لويس فردنان سيلين (1894 – 1961)، يوم تسليمه مخطوط رواية “رحلة في أقاصي الليل” لناشره دونوويل، تنبّأ لها بهذا المصير: “ستكون جائزة الغنكور من نصيبها لا محالة وستكون بمثابة الخبز لقرن كامل من الأدب.”
كلامٌ في غاية التفاؤل نظرا إلى سوداوية الرواية وإلى الصِّبغة المأساوية التي تتسم بها كتابة سيلين. ربّما هذا ما جعل الكاتب الفرنسي المتحذلق فريدريك بيغبيدي يقول سنة 2001، في كتاب “الجرد الأخير قبل التصفية” الذي أحصي فيه خمسين عملا أدبيا الأكثر أهمية في القرن العشرين، والذي تحتل فيه رواية “رحلة في أقاصي الليل” المرتبة السادسة: “أخطأ سيلين في القسم الأول من جملته، وفي القسم الثاني كذلك لأنّ الجميع يعلمون أنّ سيلين طبيب وليس خبّازا”، مُردفا بأكثر جديّة ما يلي: “كتب كثيرة يصعب تفسيرها: تبدو كأنها خرجت من حيث لا ندري، ولكن عندما نقرأها، سرعان ما نتساءل كيف عاش العالم من دونها. تنتمي ‘رحلة في أقاصي الليل’ إلى تلك العائلة محدودة النسل: بداهتها توقع الاضطراب في حياة كلّ قرائها. لغتها الخام تغير طريقتكم في الحديث والكتابة والقراءة والحياة. وحدها الموسيقى رسالة إلى الجهاز العصبي. البقية هراء. لا يمكن لأحد أن ينجو منها. كم أحسد منكم أولئك الذين لم يقرؤوا بعد هذه اللوحة الملحمية حيث القذارة والجيفة: سيقع فضّ بكارتهم ذهنيا. تفهمون قصدي: في البداية ليس الأمر ممتعا، بعد ذلك يستهوينا كثيرا.”
تعلمون إذن ما ينتظركم، حتى أنّه بوسعي أن أذهب بعيدا في المجاز لأقول برفقة دانتي أليغييري، الذي نقش في رائعته “الكوميديا الإلهية” هذه المقولة على باب الجحيم، والذي لولا تشجيعات فرجيل صاحب “الإنياذة” لما كان ولجه: “أنتم يا من تدخلون هنا، تخلوا عن أيّ أمل كان”. فعلى قارئ رائعة لويس فردنان سيلين “رحلة في أقاصي الليل” أن يشحذ عزيمته لكي يتحمل أعباء هذه المغامرة التي تبدأ منذ العنوان حيث للكلمات هنا، عند سيلين، معنى عميق، معنى يفوق المجاز أو الاستعارة أو الصورة الشعرية أو أيّ غواية جمالية أو أسلوبية ففي “رحلة في أقاصي الليل” رحلة حقيقية نسافر خلالها رفقة فردينان بردمو من باريس سنة 1914 إلى جبهة القتال في الحرب العالمية الأولى فالكونغو في أفريقيا ثمّ مدينتي نيويورك وديترويت الأميركيتين، كي يعود من جديد إلى باريس وضواحيها الحزينة حيث يمتهن الطبّ، ثم مدينة تولوز الفرنسية أين ذهب لملاقاة صديقه روبنسون، ليصل به المطاف لإدارة مستشفى أمراض نفسية. خمسون عاما قبل ولادة العولمة، يمكن أن نُقِرَّ بأنَّ “رحلة في أقاصي الليل” أوّلُ رواية تَتحدّثُ عن تقلص كوكب الأرض وعن توحّده. فلقد تغيرت جغرافيا العالم وانطلق تحويله إلى قرية منذ ذلك الحين. يبدو ذلك من خلال المعاينة الدقيقة والتي يمكن وصفها بالمِجْهَريّة أو على الأقل بالطبيّة، التي تكشف تماهي البطل فردينان بردمو والروائي لويس فردنان سيلين وهما اللذان يمتهنان الطب. بإمكاننا، حينئذ، نعت معاينة كهذه تحملها جملة كالتي ستلي بالنبوغ: “لا يُفلتُ المرء من التجارة الأميركية”. كيف لا وقد صدرت الرواية سنة 1932، ولم تكن الولايات المتحدة على مستوى القوة والتطور الذي ستصل إليه عقب الحرب العالمية الثانية.
يجدر في هذا السياق الإقرار بأنّ البطل فردينان بردمو بطل مضاد، أي أنّه ينتمي إلى فئة جديدة من الشخصيات الروائية لا تتمتع بأيّ من خصال البطل الكلاسيكي كالعظمة والقوة والنبل. بل بالعكس، فردينان بردمو بطل رغما عنه، شارك في الحرب العالمية الأولى لأنّ الموسيقى العسكرية أغوته. وفي جبهة القتال، يكتشف البطل المضاد جحيم الحرب وخاصة عبثها. نحن هنا بعيدون كل البعد عن بطولات أشيل، أجاكس، يوليس، إيني أو غيرهم من الأبطال الأسطوريين، أو حتى بعض الأبطال الجدد والذين برزوا منذ ولادة “دون كيشوت” للإسباني سرفنتس، وصولا إلى شخصيات يعرفها سيلين جيدا وهي لكتّاب فرنسيين أمثال فيكتور هيغو (جان فلجان، غفروش، كازيمودو…)، بلزاك (فوتران، رستنياك، الأب غوريو…) وإيميل زولا (لانتيي، ماهو.. إلخ).
ففي إقراره بحبه لأميركا، يُمكِنُ اعتبار بردمو بطلا مضادا، لأنّ “الدوكسا” أو الفكر المتعاقد عليه يفرض على الجميع كره أميركا واعتبارها شيئا هامشيا لا قيمة له مقارنة بأوروبا وبالعالم القديم: “ما كان يمنعهم في النهاية من الفرار معي هو أنهم، بالخصوص، لا يرغبون في أن يسمعوا أو يعرفوا شيئا عن هذه الأميركا التي كنت أنا مولها بها. لكل غيلانه. أما هم فكانت أميركا غولهم الذي يمقتونه أشد المقت… كانوا يسعون أيضا إلى إثارة نفوري منها، إلى أبعد حد..”.
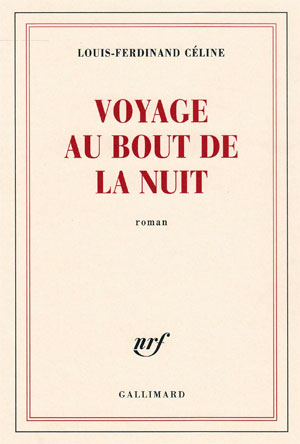
لا أرغبُ في الكشف عن أحداث الرواية، لكن يجب أن أنتهي من تفسير كيف أنّ فردينان بردمو ليس فحسب بطلا مضادا، بل هو أنموذج للبطل المضاد، إذ أنّه بعد لقائه بروبنسون ليون عند قيامه بمهمة استطلاعية أوشك على الهروب والتخلي عن قواعده مما كان سيتسبب حتما في الحكم عليه بالإعدام، لكن شاءت الأقدار أن يُصابَ وأن يكون من أول الحائزين على وسام عسكري راح يتباهى به في المسارح وفي المجتمع المدني الذي تتراوح مواقفه بين تمجيد الحرب والعزوف عنها. يصير إذن البطل المضاد – وهو الذي يتسم بالجبن وربما بالخيانة لأنه يتساءل عن جدوى محاربة الألمان الذين سلبوا فرنسا سنة 1870 مقاطعتي الألزاس واللورين – بطلا رغما عنه، بطلا لا غاية له ولا مهمة، إلاّ ربّما البقاء على قيد الحياة: “هو السنّ الذي ربما يأتي أيضا، ذلك الخائن، ويهددنا بالأسوأ. لم يعد لدينا الكثير من الموسيقى بداخلنا كي نجعل الحياة ترقص، هذا هو. كلُّ الشباب قد ذهبوا إلى الموت في أقاصي العالم داخل صمت الحقيقة. وأين الذهاب خارجا، أسألكم، حين لا يعود في داخلك القدر الكافي من الهذيان؟ الحقيقة، إنها احتضار لا ينتهي. حقيقة هذا العالم هي الموت، يجب الاختيار بين الموت والكذب. وأنا غير قادر بالمرة على قتل نفسي.”
ليسَ من السذاجة أن أتفاعل مع هذا الكلام وأن أتساءل في خضمِّ الحديث عن هُويّة المتحدث. صحيح أنّ الراوي في “رحلة في أقاصي الليل” فردينان بردمو نفسه، أي البطل، وأنّه يستعمل ضمير الأنا، لكن تتميز هذه الرواية بما يسمى في عالم الموسيقى بالبوليفونيا أو تعدد الأصوات، إذ تتكاثر الأصوات الروائية ولا تقتصر على الراوي المعلن أو المعروف أو المتعاقد عليه، بل تعلو الأصوات من كل صوب وجانب لِتُحوِّلَ النص إلى غرفة أصداء لا حدود لها. وهذا ليس بغريب عن كتابة سيلين: “ما من أحد يقاوم الموسيقى في الحقيقة. ما من شيء يمكن فعله مع القلب، نحن نَهَبُهُ عن طيب خاطر. نحن في حاجة إلى الاستماع في قاع كل موسيقى إلى اللحن الذي لا علامات له، المصنوع من أجلنا، لحن الموت.”
مرة أخرى، تبدو هذه الكلمات وكأنها أتت من عالم غريب بعيد، من عالم جديد، كالذي اكتشفه بردمو من خلال التجارب التي عاشها من الحرب إلى الحب، من الوطن الحرّ (باريس-فرنسا) إلى الوطن المَسْبِي (جبهة القتال حيث حلم استرداد الألزاس واللورين)، من العالم القديم (أوروبا وأفريقيا) إلى العالم الجديد (أميركا). هي اكتشافات لا نهاية لها عبّر عنها بهذه الطريقة الفضة: “نستدرك خطانا، نفكر بوضوح أكثر من السابق، نأمل من جديد في حين كنا عزفنا عن كل أمل وحتما نعود إلى ممارسة الشذوذ بالثمن ذاته. في النهاية، إنها اكتشافات في مهبل امرأة لكل الأعمار.”
هذا هو إذن فردينان بردمو: حياته وتجاربه ليست مثاليّة، بالعكس يكاد الشر يَتنقَّلُ معها من مكان إلى آخر، وذلك وفق معنى اسمه. نعم، ليست الأسماء في الأدب اعتباطية، إذ يوجد عِلمٌ قائم الذات يُدْعَى “الأونومستيقا”. فلو اعتنينا بمصدر اسم البطل المضاد فردينان بردمو، لتوصّلنا إلى استنتاجات عجيبة. اسم فردينان ذو أصول جرمانية وهو متكون من كلمتي “فريد” و”نانه” اللتين تعنيان تباعا “السلام” و”الجرأة”، ويُمكنُ ترجمة هذا الاسم بـ”الذي يتجرأ على فرض السلام”. وكان هذا الاسم من أكثر الأسماء شيوعا في إسبانيا والبرتغال زمن العصر الذهبي للملكية، لكن تراجع استعماله في كامل أوروبا خلال القرن العشرين. يُحْتَفَى بالقديس فردينان كل يوم 30 مايو، وهو أصلا الملك فردينان الثالث المولود سنة 1199، والذي اعتلى عرش قشتالة في سن التاسعة عشر والذي شُهر بسبب انتصاره على المسلمين في الأندلس مما مكنه من توسيع نفوذه ومن فرض اللهجة القشتالية لغة رسمية في إسبانيا. توفي الملك سنة 1252 ودفن حسب الطقوس المسيحية.
فردينان اسم يصعب حمله ولا يبدو فردينان بردمو أهلا له، والغريب هو أنه يُدركُ ذلك، فتراه يشحذ عزيمته قائلا: “تشجع يا فردينان، كنتُ أُكرّرُ بيني وبين نفسي، كي أتمالك قواي، لفرط ما طُردتُ من كل مكان، سينتهي بك الأمر حتما إلى أن تجد الشيء الذي يخيفهم إلى هذه الدرجة، جميع هؤلاء الأوغاد، وهو موجود حتما في أقاصي الليل. لهذا السبب هم لا يذهبون أبدا إلى أقاصي الليل.”
أمّا في ما يخص اللقب بردمو، فهو من خلق سيلين، وهو مشتق من عبارة “بردا” ذات الأصول العربية فهي “بردعة” التي تعني “ما يُوضع على ظهر الحِمار أو البغْل ليُرْكَبَ عليه، وهي كالسَّرج للفرس” (قاموس المعاني)، إذ أنّ هذه الكلمة التي دخلت القاموس الفرنسي سنة 1848 عبر اللغة الشعبية – العسكرية تحديدا – تعني أغراض الجنود. يحمل بردمو نفسه إذن كالدابة التي تحمل الأسفار، هذا ربما ما جعل الكاتب والفيلسوف الفرنسي جورج باتاي يكتب في شهر جانفي 1933، أي ثلاثة أشهر بعد صدور الرواية: “يمكن اعتبار هذه الرواية بأنها وصف للعلاقة التي يعيشها رجل مع موته، وهي حاضرة في كل صورة من صور البؤس البشري الذي يتجلى قُدُما في الرواية. تَكمنُ عظمةُ “رحلة في أقاصي الليل” في غياب أيّ دعوة للإحساس بتلك الرحمة الجنونية التي ربطتها الوضاعة المسيحية بالوعي بالبؤس. فلقد مضى زمن لعبة زولا السخيفة التي مكنته من استلال عظمته من مآسي البشر، وهو الذي بقي غريبا عن الفقراء. ما يَعزِلُ “رحلة في أقاصي الليل” ويمنحها معناها البشري، هو تبادل الحياة مع الذين يدفع بهم البؤس خارج الإنسانية، تبادل الحياة والموت، الموت والانحطاط.”
تحاليل باتاي وكلماته تضرب كالعادة في الصميم. ليس من الغريب أن يستغل صاحب رائعة “التجربة الباطنية” (1943) هذه الفرصة للنيل من عصفورين اثنين بحجر واحد: الأخلاق المسيحية المهيمنة والكتابة البورجوازية الكاذبة. هنا تفعيل لفلسفة نيتشة التي أرادت أن تتبع خطا ثوريا يذهب من الرجوع إلى أصول الآداب والفلسفة من خلال التراجيديا الإغريقية، مرورا بالبحث الجنيالوجي عن أصول الأخلاق، وصولا إلى محاولة تجاوز الخير والشر. من المؤكّد أنّ لويس فردنان سيلين قرأ فريديريك نيتشة وأكثر من ذلك، قد قام بتحويل بعض المصطلحات الفلسفية النيتشوية إلى قصص وحكايات. ما من مجال هنا للمقارنة بين الرجلين، لكن يبدو أنّ صاحب “رحلة في أقاصي الليل” قرأ “ولادة التراجيديا” ويبدو ذلك في مواضيع رواياته وكذلك في مراسلاته مع ميلتون هندوس وهو جامعي يهودي – أميركي عاشق لأدبه ومدافع عنه. ففي إحدى رسائل سنة 1947، وهي من أشد السنوات قسوة في حياة الأديب الذي كان منفيّا في الدنمارك بسبب نصوصه المعادية للسامية واتهامه بالتعامل مع المحتل النازي سنوات الاحتلال الألماني لفرنسا، كتب سيلين لصديقه ميلتون هندوس رسالة يمكن اعتبارها فنا شعريا: “الحقيقة وحدها لا تكفي – أنا في حاجة إلى تحويل كل شيء – ما لا يُغَنِّي لا وجود له لدى الروح – سخطا للواقع. أريد أن أموت في الموسيقى، لا في العقل أو في النثر. العلاقة بين الواقع وكتابتي؟ يا إلهي الأمر سهل فالحياة الموضوعية الواقعية ليست ممكنة بالنسبة إليّ، لا تُحتمل – إنها ستثير جنوني، سأصاب بداء الكلب من فرط إحساسي ببشاعتها إذن أحولها وأنا أحلم ماشيا… أظنُّ أنّ هذا تقريبا هو المرض العام للعالم المسمى بالشعر..”.
ألهذا السبب اختار سيلين رباعية شعرية لدعوتنا للدخول في “رحلة في أقاصي الليل”؟
رحلة هي حياتنا
في الشتاء والليل
نبحث عن عُبورنا
في السماء حيث النور القليل.
أغنية الحرس السويسري، 1793.
التاريخ الذي قَدَّمهُ سيلين غريب بعض الشيء، لأننا نعرف أنّ هذه الأبيات من فعل ضباط سويسريين كانوا تابعين لجيش نابليون بونابرت وأنهم أنشدوها أمام بحيرة بيريزينا في روسيا البيضاء أين لقوا مصرعهم خلال حملة 1812 تحديدا. فلماذا اختار سيلين سنة 1793 الموافقة لفترة “الرعب”، وهي من أهم حقبات الثورة الفرنسية، مع العلم أنّ الحرس السويسري كان من جند الملك، لكن وقعت إبادته كاملا في حدائق التويلري سنة 1792؟ تكمن الإجابة حتما في عبارة “أنا في حاجة إلى تحويل كل شيء” التي خطّها سيلين لصديقه ميلتون هندوس، وهي في الحقيقة عبارة استعملها الكاتب في روايته “غينيولز باند” أو “فرقة الدمى المتحركة” الصادرة سنة 1944، حيث يقول: “إمّا التحويل أو هو الموت”.
بإمكاننا فعلا أن نتساءل عن هوية فردينان بردمو، لكن يجب أن نتساءل عن الهوية داخل الرواية ككل، حتى أنّه يمكننا تخيل معادلة كهذه: فردينان x 2 أو فردينان زائد فردينان = رواية “رحلة في أقاصي الليل”، أي أنّ التداخل بين الأسماء والتواريخ والأحداث وكلّ شيء في نهاية الأمر بين مغامرات البطل فردينان بردمو والكاتب لويس فردنان سيلين يَجْعَلُ الرواية فعلا مُمكنا، فعلا موجودا، فعلا حقيقيا. وليس هذا الفعل سهلا، لا من الناحية الروائية ولا التاريخية، فالسيدة التي أهدى إليها سيلين الرواية، أي إليزابيث كرايغ، شأنها شأن الأبيات التي تَلعبُ دور شاهدة البداية، تحمل معنًى عميقا، فهي تفتح أمامنا أفق القراءة والتأويل. لكن كيف نُكران ذلك ولقد أقرّت السيدة والفنانة إليزابيث كرايغ بأنّها تعرفت على نفسها في شخصية “مولي” أكثر من نصف قرن بعد نشر الرواية؟ نعم، فلقد عثر عليها أحباء سيلين في مدينة لوس أنجلس الأميركية سنة 1988 واعترفت عن نفسها وعن فردينان بردمو/أو لويس فردينان سيلين أهمَّ الأشياء، ربّما أهمّها الحب، الجنس، الفن والمنحى التراجيدي التي كانت تتسم به حياة سيلين وبعد ذلك كتابته.
شخصيا، لا أريدُ أن يكون بردمو نفسه سيلين، لا فحسب لأنّ من شأن ذلك أن يطعن في الرواية كما هي أو كما نحلمُ بها، بل خاصة يجب على القارئ الحقيقي أن يذهب قدما في فهم الأمور أي في فهم ما هي عليه من تجديد ذهبَ بالرواية إلى أقاصي ليل الإبداع. فلقد تنبّهَ الرائع تروتسكي، نعم السيد ليف دفيدوفيتش برونشتين، المعروف باسم تروتسكي، إلى هذا منذ أول لحظة، أي منذ صدور الكتاب، لأنّ الثوري العالمي تنبّه إلى عبقرية هذا العمل بالرغم من الاختلافات الأيديولوجية التي تفرض نفسها بين هذين الرجلين، أي بين اليميني سيلين، وهو معاد للسامية، واليهودي اليساري الذي كان أبا للجيش الأحمر وأكثر في تاريخ حلمٍ ما أروعه من حلم في تاريخ البشرية، فحقّا تنبّه تروتسكي إلى الحقيقة المحضة وهي ممكنة عند أولئك الرجال الذين قاموا بكل شيء، من محاولة فهم للعالم إلى ثورة، فحرب، فسفر، فحب، فمراوغة للموت، فكتابة، وهذا ما قاله تروتسكي عن “رحلة في أقاصي الليل”: “أسلوب سيلين يتأقلم مع نظرته للعالم. عَبْرَ هذا الأسلوب الذي يبدو مُهْمَلاً وغير سليم، يَحْيَا، ينبثقُ وينبضُ ثراء الثقافة الفرنسية، التجربة الحسية والفكرية لدولة عظمى في كامل ثرائها وحتّى في أبسط فوارقها. وفي الآن نفسه، يكتب سيلين وكأنه الأول الذي يصطدم باللغة. الفنان يَخُضُّ القاع ويملأُ معجم اللغة الفرنسية.”
في هذا السياق، صدر سنة 1993 كتاب لمجموعة من الباحثين تحت عنوان “دليل لقراءة “رحلة في أقاصي الليل” (منشورات نيزي)، نجدُ فيه مثلا إحصاء كاملا للكلمات الأكثر شيوعا حسب العد التنازلي: “العالم”، “الأشياء”، “الليل”، “الذهاب”، “الناس”، “النهار”، “الأم”، “الهواء”، “الحرب”، “الموت”، “الرجال”، “شهر/شهور”، “أقصى/أقاصي”، “بيت”، “عبور”، “أيام”، “نساء”، “فتاة”، “صباح”، “امرأة”، “رجل”، “قلب”، “طويل”، “سنة”، “كبيرة”، “مريض”. من المفيد أن نذكر أنّ كلمة “يهودي” غائبة عن الرواية وليس هذا الأمر اعتباطيا لأنّ في هذا التغييب حتما تعبير عن مقت وعداء شديدين. كما يتعرض “الدليل” إلى أهمية المعاجم في “رحلة في أقاصي الليل” والتي يمكن جردها كالآتي: الجسد، الغثيان، المرض والطب، الجنس، الطفولة، الجنون، الليل، الحرب، الشجاعة والجبن، القتل، الموت، الفقراء والأغنياء، السفر والمدينة.
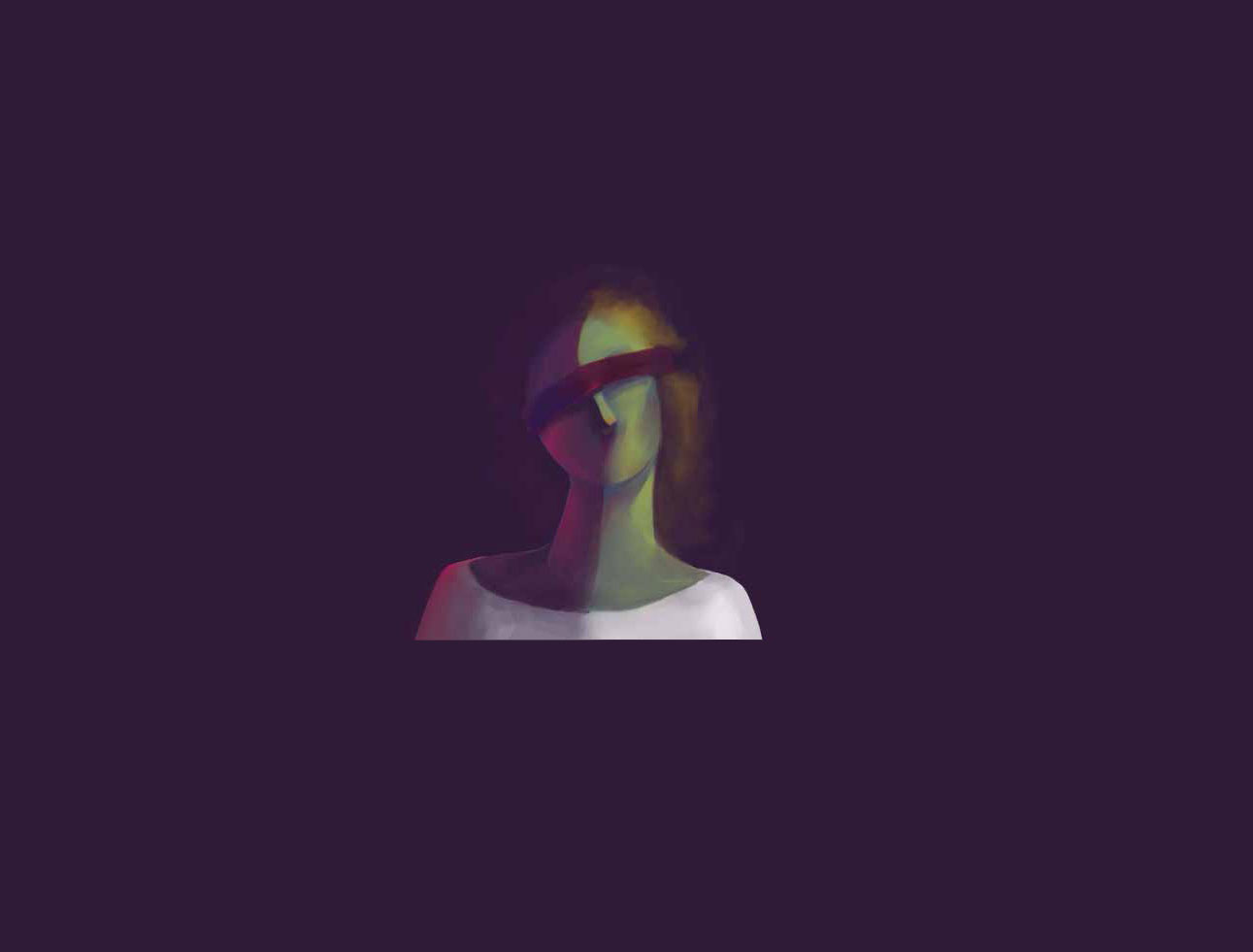
تلك إذن معاجم تبني مواضيع لرواية حديثة، لكن تكمن عبقريّة هذا العمل في لغة سيلين، تحديدا في الشفوية عنده، فتركيبة الجملة في “رحلة في أقاصي الليل”، وبعد ذلك في الروايات الأخرى للطبيب المحارب المسافر المتناقض لويس فردينان سيلين، تتميز بتركيبة شفوية، أي أنّ البناء يُحاكي كلام الناس العاديين، الكادحين، الجنود، الموامس، العرب والزنج، مراعيا بطريقة تُضاهي الإعجاز الاختلافات الكامنة بين مختلف تلك الشرائح. اللغة حية عند سيلين وهي، فضلا عن بردمو، بطل قائم الذات، بطل يكاد يتغلَّبُ على البطل الرئيسي، لأنّ اللّغة هي الأساس، هي الماضي والحاضر والمستقبل، ولا وجود للكتابة وللأدب في منأى عنها. عبّر سيلين عن ذلك من خلال الكتابة، أي دون تنظير، فالكتابة هنا تنظير للكتابة أي تصوير توضيحي لها، بمعنى أنّ الكتابة أنمذجة للكتابة. وهذا تحديدا ما أقرَّ به سيلين في حواره التلفزيوني الشهير مع لويس ألبير زبندن سنة 1957 حيث يقول إنّه لا يهتم إلاّ بالكتّاب ذوي الأسلوب، فحسب رأيه القصص موجودة في كل مكان، في الشارع، في المخافر والإصلاحيات فللجميع قصص، آلاف من القصص، ويقول أيضا إنّ الأسلوب نادر وأنّه من الصعب العثور على أسلوب أو أسلوبين اثنين أو ثلاثة في جيل بأسره. ويذهب سيلين بعيدا قائلا إنّه يوجد آلاف الكتاب وأنهم يزحفون ولا يكتبون وينسخون ما قاله الآخرون من الكتاب الكبار لا غير.
تتضافر إذن كلّ هذه العناصر لتجعل من “رحلة في أقاصي الليل” عملا فذّا ومن سيلين كاتبا جبارا يجدر بنا قراءته والتعامل معه بجدية حقيقية. على حدّ عبارته، تجاوز سيلين الكتابة الروائية وكرّس قلمه لخدمة الأخبار، قاصدا بذلك الحراك التاريخي الذي عاشته فرنسا والعالم بأسره من الحرب العالمية الأولى إلى الحرب الباردة مرورا بفترة ما بين الحربين فالحرب الكبرى. بهذا يُمكنُ اعتبارُ مقولته عن نفسه بأنّه “وضع جلده على الطاولة”، وعيا منه “بأنّ الموت وحده هو الملهم”، اعترافا منه خاصة بأنّ الكتابة أهم من الحياة أو ربما هي في أسوأ الأحوال الحياة. اليوم لا أحد يتذكر غي مازلين الذي حرم سيلين من جائزة الغنكور المرموقة سنة 1932، وربما لا نتذكر كذلك اليوم الكاتب لوسيان ديكاف إلّا لأنَّ سيلين أهداه رواية “الموت سُلفةً” لأنه وقف بجانبه ودافع عنه ليتحصل على الغنكور. لكنّها ليست لعنة وإن كانت كذلك فهي مباركة، فلقد كتب الروائي الكبير جورج برنانوس في الصفحة الأولى من جريدة “لوفيغارو” يوم 13 ديسمبر 1932: “السيد سيلين لم يتحصّل على جائزة الغنكور. فهنيئا للسيد سيلين”. هذا اعتراف من كاتب كبير آخر – علينا أن نُعجّل في ترجمته إلى العربية – بقيمة سيلين وروايته “رحلة في أقاصي الليل”، فلو كان سيلين تحصّل على هذه الجائزة عن روايته الأولى، لكانت قد حلّت به لعنة الاعتراف والشهرة، ولكانت قد جفّفت منابع قريحته.
دعونا الآن من التخمينات ولندخل بكل الثقة الممكنة واللازمة في هذه المغامرة الوجودية، مع العلم أنّ رفيقة سارتر، سيمون دي بوفوار، كتبت سنة 1960 في سيرتها الذاتية “قوة الأشياء” أنّ “رحلة في أقاصي الليل” أهم رواية قرأتها مردفة: “حفظنا عن ظهر قلب مقاطع كاملة منها. كانت فوضويتها قريبة منّا. نحتَ سيلين آلة جديدة: كتابة حيّة كالكلام. وتعلّم منها سارتر كثيرا”. هذا اعتراف آخر في حق سيلين وهو في غاية الأهمية لأنّ سيمون دي بوفوار كانت “القندس المحارب” لسارتر الذي كتب عنه أو تحديدا ضده سيلين سنة 1948 نصا في غاية الحدة تحت عنوان “إلى هائج الجرة” وهو قدح فيه وفي فلسفته الوجودية.
إن كان هنالك أعداء أو كارهون أو قادحون فكريّون وسياسيون للويس فردينان سيلين، فسيمون دي بوفوار وجون بول سارتر يُمَثِّلانَ أشد المتعصبين ضدّه، لكنّهم في الآن ذاته من أكثر المحبّين له أدبيّا. أقول ذلك كي لا يستعمل البعض من المتطرفين والغادرين هذا الكتاب في ترجمته وفي تقديمه هذين كأداة لبثّ الفتنة والكراهية. فلتكن “رحلة في أقاصي الليل” ملحمة من خلالها يتحوَّلُ الموت إلى حياة، والحرب إلى سلم والليل إلى صباح جديد.




