ألمعية المفكّر وحلمية الشاعر
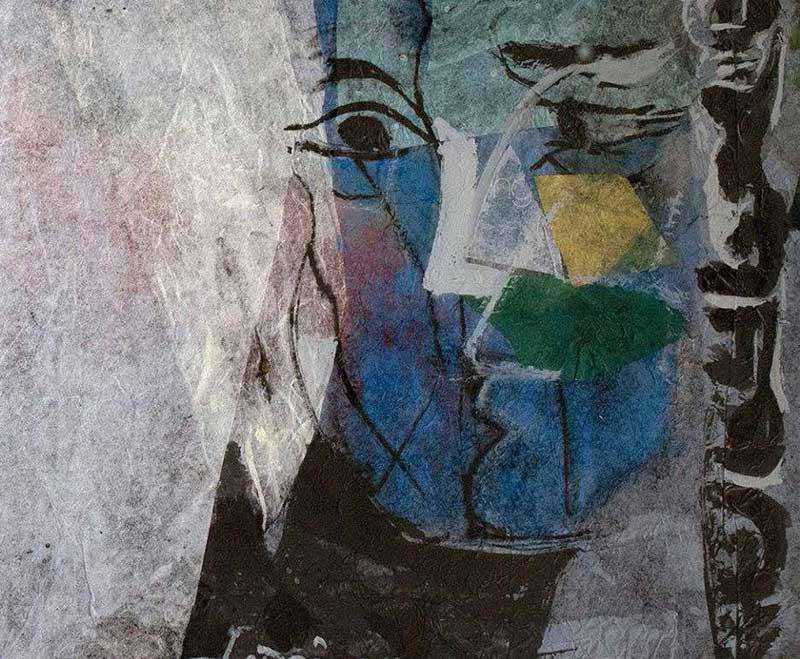
يشيع في ثقافتنا العربية مصطلح المفكّر، ولقب المفكّر، بعشوائية ومجازفة. على أن لنا في هذا قولا من باب البحث والتعيين والتحديد. ينحصر قولنا في ماهية المفكّر أولا وأخيرا، المفكّر في علاقته بمشكلات عصره وواقعه. وآية ذلك، أن المفكّر على خلاف الشاعر لا يستطيع أن يقيم طلاقا بينه وبين الحقيقة أولا، أو بينه وبين مشكلات عالمه ثانيا. فيما الشاعر قد يشتط به الشعر ليغدو بوحا ذاتيا صرفا. أو يتحول الشعر لديه إلى جمالية تخلق الإعجاب لدى المتلقي. لقد أشرنا إلى بعض صفات الفكر الملتزم في معرض حديثنا عن المسألة التي نحن بصدد فضها، إشارة عابرة وعامة، حين ربطنا بين المفكر والحقيقة والمفكر ومشكلات واقعه. غير أن مفهوم المفكر يحتاج إلى تحديد أدق.
ما المفكّر؟ قلنا ما المفكّر، ولم نقل من المفكر. لأن السؤال حين يبدأ بما فإنما القصد تحديد الماهية. أي ما ماهية المفكّر، بحيث يصدق التحديد على كل مفكّر، وعندما يصدق التحديد على كل مفكّر، فمن ليس مندرجا في التحديد سنخرجه من دائرة المفكّر.
المفكر أولا: كل إنسان أنتج قولا في المعرفة بوصفها معرفة بالحقيقة بمعزل عن صدقها أو لا صدقها، حسبه بأنه يعتقد بحقيقتها حتى لو دحضتها التجربة. من هنا نجعل من معيار البحث عن الحقيقة استنادا إلى مناهج البحث معيارا أول للمفكّر.
ولما كانت الحقيقة بحثا عن مشكلة أو مسألة، فإن المفكّر هو الذي يكشف عن المسألة أو المشكلة تحليلا وتركيبا، ويفترض حلا لها، ويسعى لجعل فرضه معرفة عامة وهذا ثاني معيار نقيس عليه المفكّر من غير المفكّر.
وإذا كان المفكّر هو المنتج للمعرفة، وذا علاقة بالحقيقة وكاشفا للمشكلة وحلّها، فالشرط الضروري لتحقيق فعل المفكّر هذا هو الحرية. وهذه صفة ثالثة للمفكّر.
ما علاقة هذا كله بمفهوم المفكّر؟ وبخاصة إذا كانت صفة الحرية صفة ضرورية من صفات المفكّر.
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من أن نعود إلى المفاهيم الثلاثة التي تميز المفكّر: الحقيقة، المشكلة، الحرية.
فالحقيقة قول خطاب مطابق للواقعة، لماهيتها. وحسب المفكّر الاعتقاد بذلك، كما قلنا، لأن الحقيقة التي يسعى لكشفها المفكّر هي حقيقة بالنسبة إليه أولا ثم يجعل منها حقيقة يطلب من الآخرين الاعتقاد بها. فالمفكّر بهذا المعنى ملتزم بمطلب الحقيقة.
أما المشكلة فهي التي تجعل المفكّر يفكر بموضوع ليس معطى مباشرة على أنه موضوع واضح، أو هو موضوع مرتبط بحياة البشر الذين ينتمي إليهم. فليس للمفكر إذن مشكلة خاصة به، ذاتية. وإنما مشكلاته هي مشكلات مجتمعه وأمّته وقد غدت مشكلته الخاصة. فهو إذن ملتزم بالضرورة بعالمه الذي يغص بالمشكلات.
وعندما نحدد المشكلة بارتباطها بهموم البشر الحقيقية، فإننا نميز بين المشكلة الحقيقية والمشكلة الزائفة؛ لأن تمييزاً كهذا يقودنا فيما بعد إلى التمييز بين المفكّر الأصيل والمفكّر الزائف.
المشكلة الحقيقية هي تلك التي تنشأ من تناقضات المعرفة بالعالم. والانتقال من اللاّمعروف إلى المعروف ليس بعد مشكلة، فهذه حركة المعرفة، ولكن عندما تنشأ لدينا معارف مختلفة ومتناقضة حول ما كان غير معروف عندها تنشأ المشكلة.
إذن المشكلة الحقيقية هي واقعة اجتماعية تاريخية قومية… إلخ فنشأت حولها معارف متنوعة ومتناقضة.
فعندما نقول مثلاً التبعية مشكلة حقيقية، فإنما نقصد تلك العلاقة غير المتكافئة بين العرب والغرب والإجابات متنوعة حول أسباب هذه التبعية، كما هي متنوعة الإجابات حول حلها.
فأول شرط لاعتبار المشكلة حقيقية هو أن تكون واقعية وموضوعية وذات علاقة بمصائر البشر.
وعندها يكون المفكّر هو الذي يتناول مشكلات من هذا القبيل. أما المشكلة الزائفة فهي التي ليست ثمرة واقع موضوعي ولا يمكن الإجابة عنها أصلاً. إنها تصوّر لمشكلة.
والأخطر هو تحويل المشكلة الحقيقية إلى مشكلة زائفة، كأن نحوّل المشكلة الفلسطينية التي هي مشكلة شعب طرد من وطنه بفعل حركة عنصرية استعمارية صهيونية، إلى مشكلة حول من هو أحق بفلسطين العرب أم اليهود.
وتظل حرية المفكّر الأكثر تعقيداً. فالقول من حيث المبدأ أن المفكّر حر، تعني أنه حرّ التفكير. ولكن عندما ربطنا تفكيره بالحقيقة والمشكلة الأصلية فإننا، عملياً، قد وضعنا حدوداً لحريته. فهل هذا الوضع سلب لحرية المفكّر.
الجواب لا. لأن الحرية لا تتناقض مع مطلب الحقيقة ومطلب العلم. وإلا صار المفكّر حراً في قول لا علاقة له بالحقيقة وليس هاجسه هاجساً أصيلاً.
من هنا جاء التمييز بين المفكّر الديمقراطي والمفكّر الذاتي ،عند غرامشي ، فالمفكّر الديمقراطي هو الذي يجعل من مشكلات عالمه الحقيقية مشكلات شخصية. وعندها يتكامل مفهوم الالتزام، التزام المفكّر بما هو أصيل من المشكلات، وبما هو هاجس حقيقي، فنحن لا نعتبر أن ذاك المتحرر من مطلب الحقيقة والعلم مفكّراً، سمّه ما شئت، إلا المفكّر.
استنادا إلى تلك الأطاريح الطويلة والضرورية نصل إلى النتيجة التالية: إن المفكّر،عموماً، والمفكّر العربي نتيجةً، هو المرتبط بالضرورة بالحياة الراهنة المليئة بالمشكلات المتعلقة بمصير البشر، المشكلات التي لا تترك لأحد أن يفكر خارجها إن هو حدد مهمته كمفكّر أمّة أو مفكّر إنسانية أو مفكّر قضية . حسبنا أن نورد المشكلات الراهنة للعرب أمام المفكر: التبعية، التأخر، التخلف، الدولة السلطة، التمزق، الهوية، فلسطين، التجزئة، النقد، الحرية الديمقراطية.. الخ.
إن أمّة بحجم هذه المشكلات تحتاج إلى مفكّر ينتج المفاهيم قولاً واحداً، لا إلى مفكّر يزيّف المشكلات، أو يخلق مشكلات لا علاقة لها بمصير مجتمعه وأمّته.
عندها باستطاعتنا أن نقول دون أن نشعر بتأنيب ضمير إن رهطاً ممن يكتبون الآن عن العرب بعقول لا تبحث إلا عما يحقق مصالحها الذاتية بتجميل الواقع الخرب ذاته، ما هم إلا جزء لا يتجزأ من حالة الانحطاط التي يسعى البشر التائقون إلى الحرية لتجاوزها.
وإن الظهور العلني لمثقف مدافعا عن الاستبداد ومبجلا الحاكم المستبد لهو أخطر بكثير من الاستبداد والحاكم المستبد.
وما قيمة المفكّر إذا لم يكن متمردا على عالمه من أجل عالم أفضل، وبخاصة إذا كان الواقع ذاته ينطوي على إمكانية العالم الأفضل.




