ألوان مدينة عصية على المحو
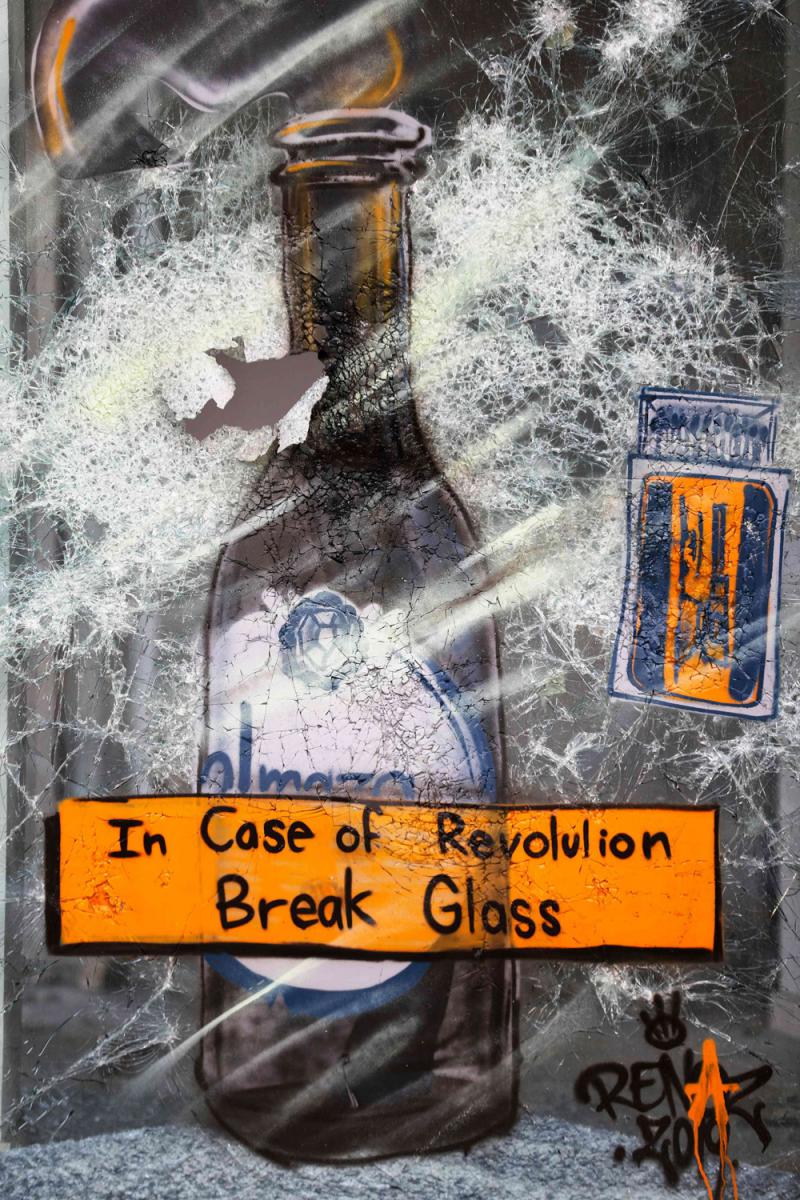
"المدينةُ الملوّنة" وصفُ حليم بركات لبيروت وعنوانُ سيرته فيها، استحضرته وأنا أتابع تسجيلات حريق المرفأ، ثم انفجاره الذي اقتلع الشجر والحجر، وحوّل نصف المدينة إلى شظايا زجاج وطوب ومعدن، طبقات البنّي والأسود والرمادي والأبيض تنهمر من شجرة الفِطْر العملاقة لتكلّل الممرات الضيقة والشوارع الرحبة، وتطمس العمارات الشاهقة والدور القرميدية وتمسح فجوة إعمارها التي انسربت كنيزك ما إن أدرك أوج اشتعاله حتى انطفأ. ثلاثة عقود ما بعد الحرب الأهلية، وعقد ونصف بعد عدوان 2006 الإسرائيلي على بيروت، تتلاحق الصور الملونة بخلفية دماء وأتربة، وغبارٌ مسربِلٌ للوجوه والجدران والحنايا؛ دور عتيقة، مطاعم ومقاه، غاليريهات ومكتبات… ينبت في ذهني صدى كلمات حليم بركات “ترى هي وهم كمدينة؟”.
لم يكن الأسى هو ما تحيل عليه الفاجعة، وإنما الدهشة من قدر لا فكاك منه. في سفرتي الأخيرة لبيروت (أبريل 2013 )، كنت أنقّب بين تفاصيل مواعيد متزاحمة عن طبقات أسماء وعمائر وشوارع، وخرائب مطردة، وترسيمات حدود، أو ما تبقى منها، كانت عصية على الاكتشاف، في مدينة بعمق مدن متناسخة. بدت مدينة جاهزة من جديد، لتكون ما هي عليه، غلاءٌ ورفاه ونعومة وقسوة، وعبق مدفون في الأرجاء، عواطف متناقضة إزاء عناوين تلتبس بذاكرة مثقلة بالألوان والصور.
ملصقات تعلن وعودا شتى، ترتصف جنبا إلى جنب، من ترويج مستحضر تجميلي، إلى إعلان حبور بتسمية زعيم في منصب سياسي، إلى التنويه باستشهاد رمز. تزامَنَ وجودي في بيروت مع مقتل عالم الدين السوري محمد سعيد رمضان البوطي، بدمشق، في عز الانتفاضة السورية، كانت ملصقات نعيه والدعاء له تؤثث الجدران بأحد شوارع حيّ فردان، وغير بعيد عنها، نصب إشهاري كبير لكريم بشرة فاخر يقول “الجمال نادر وصعب” مع وجه امرأة غير مكتمل، وفي منحدر مروري قريب، أسفل أحد الكباري تنتصب لافتة بيضاء خطت عليها عبارة “مبروك دولة الرئيس تمام سلام، لقد عادت الروح لبيروت”… كلمة الروح سحرية تماما مثل الندرة، في المدينة المقترنة بطائر الفينيق، لهذا تسكن المجازات واللوعات والرغائب المسترسلة، الإيمان بوجود كنه خفي، وجوهر عصي على الامّحاء، هو ما يمنح الطاقة لتعميرها وإعادة تعميرها، وربما هو سر تحولها في كل مرة إلى مرتع لشهوة المال والثراء، هي بقعة الأرض الصغيرة والنادرة، التي يتصرف شعبها بطوائفه وأحزابه كعائلة كبيرة.
هكذا أتمثل بيروت بيتا عائليا محدود الأعطاف، يتخطى بأسطورته معالمه الواقعية، في تلك الزيارة ذاتها عشت تجربة البيت عبر حادثة عابرة، كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة والنصف حين توقفت سيارة صديقي بشار شبارو صاحب منشورات ضفاف، بحي اليونيسكو حيث كنت أقيم، أخذني في جولة ببيروت، قبل أن يقترح الذهاب معه في زيارة مجاملة، لم يقل لي مضمونها، مررنا في أزقة ضيقة ومنعرجات، قبل أن نتوقف أمام إقامة في حي “المصيطبة”، لا توحي في شكلها الخارجي بأيّ شيء، لفت انتباهي الازدحام الشديد عند المدخل، وقد انتظم الناس في صف طويل، ترجّلنا وأخذنا دورنا في الصف، عندئذ بادرني بقوله “إننا في دارة الرئيس تمام سلام الذي كلف بتشكيل الحكومة قبل يومين”، هو ابن الزعيم السياسي السني صائب سلام والمنزل الذي يتلقى فيه التهاني هو دارة والده، حين وصلنا الدور سلمت وقدمت تهنئتي. ونحن نغادر قلت لبشار “هل يقدم الجميع، أعني سكان بيروت، تهنئتهم لرئيس الوزراء عند اختياره؟”، وأجاب “من شاء ذلك”، كان المشهد أقرب لحفلة عائلية يتلقى فيها رب البيت التبريكات.

وأنا أتفحص تسجيلات مخلفات انفجار المرفأ كنت أبحث عن تفاصيل ما عرفته من شوارع ودور وأحياء، أتفقد ما حل ببعض الأماكن التي مررت بها يوما أو ولجتها، “المكتبة الشرقية” و”متحف سرسق” بحي الأشرفية، غاليري “صفير زملر” في الكرنتينا، ومركز دراسات الوحدة العربية بشارع الحمرا، مطاعم منطقة الجميزة…، هياكل وخرائب وبقايا أثاث وتجهيزات مكتبية اقتلعت من رتابتها وترتيبها وانطمرت. تجول الكاميرا بين الشقق النافذة على بعضها، المخترقة جميعها، المنفية من حيواتها، والمسكوبة في السواد… استوقفتني صور المتحف وقد تناثرت مقتنياته وتهشمت؛ بقدر الحرص كان الفقد، أيّ ضغينة تلك التي تمادت في التنكيل ببلّورة الألوان؟
تتحول المدن وألوانها بقدر ما استقبلت من غزاة، واحتضنت من حروب وثورات، وقدر بيروت أن ينتهكها غزاة الداخل والخارج، بقدر ما مرت عليها من ثورات وانتفاضات، لهذا لن يكون بالإمكان أن نتعرف على معالم مدينة مأثورة، وإنما هياكل مدن تتناسخ، وأسماء تتبدل، بتقلب الطرز والعمائر والأهواء. وليس غريبا ألا يعثر زائرها على ألبومه الأثير غير الملون، المنحدر من زيارات قديمة، أو من مدونة كاتالوغات وأفلام وأرشيف مجلات وصحف. ستتجلى له في كل مرة صيغة منزاحة وبديلة، تحرسها علامات كبرى ممتدة من رأس بيروت إلى الأشرفية؛ جامعات ومكتبات قديمة ومسارح وغاليرهات، وبالطبع مطاعم وبارات حافظت بنوستالجيا منقرضة على وسوم عتيقة.
أنتمي لجيل استهواه فكر بيروت، وتمرد بيروت، وملاحمها المتعاقبة، فكانت الصداقة ليس مع كتابها ومثقفيها وفنانيها فقط، بل أيضا مع جدرانها وملامحها القديمة والمستحدثة، مع تناقضاتها المؤبدة، وكان الانخراط في ما أنتجت من أسئلة ومفاهيم واختراقات في الأدب والفن والسياسة والقيم، وكان النشر في منابرها صحفا ومجلات ودور نشر، استمرارا لالتزام قديم برمزية لا تنطفئ، أحتفظ برسائل جوابية استلمتها قبل سنوات طويلة من المرحوم بشير الداعوق صاحب دار الطليعة وحماسته لفكرة كتاب عن “المحاكاة والسرد”، أول كتاب لي، ضل مخطوطة وحلما لم يكتمل، إذ لم تكن “دار الطليعة” مجرد دار نشر، بل محفلا ثقافيا وبصمة، ذات وقت…، كان ذلك قبل أن تتعاقب إصداراتي عند دور أخرى هناك. في ما يشبه “نداهة” يوسف إدريس، إلى ألوان عصية على المحو.

قبل سنتين وتحديدا في شهر سبتمبر من سنة 2018 احتضنت “دار نمر للثقافة والفن” ببيروت، معرضا فوتوغرافيا للمصور التشيكي جوزيف كوديلكا بعنوان “بيروت 1991” تناول فيه وسط المدينة الذي هدمته الحرب الأهلية، قبل أن تكنسه جرافات شركة سوليدير. تناولت الصور انتهاك المدينة، ونقلت عبر منظور تركيبي ملامح الخواء الهيكلي والعري والتهشم العميق، في مساحات الكادر تتقاطع التشوهات وتتلاحم، مجسدة استعارة الخراب، لم يكن التكثيف الصوري اختزاليا ولا مرائيا، بقدر ما كان حادا وبليغا، يلتقط الإجهاض المؤقت، المنذور للكتمان، بمصادرات الهياكل المستحدثة، لا يمكن لمن يعيد التأمل في تلك الصور التي نشرت في كتاب “بيروت: الوسط التجاري” (1992، عن دار نشر Cypres)، إلا أن تتداخل في ذهنه مع صور الانفجار الأحدث، في استرسال مفجع ، لقدر مرزئ.
في رواية “بيروت بيروت” لصنع الله إبراهيم تدور الوقائع حول نواة فيلم وثائقي عن الحرب الأهلية، عشرات اللقطات والمقاطع التسجيلية عن المخيمات والفصائل المسلحة والتنظيمات السياسية، وأحداث الاغتيالات والتفجيرات والوقائع الحربية المفصلية… احتاج الفيلم لعتبات لفظية تلملم متنه البصري، وكانت مهمة البطل في الرواية هي كتابة تعليق سردي شارح، فالصور قد تقول كل شيء دون أن تجيب عن الأسئلة المركزية: لماذا وقع ما وقع؟ ومن المسؤول؟ ولفائدة من؟
الأسئلة ذاتها التي تستثار اليوم بعد العصف العاتي الذي أعقب انفجار المرفأ في آلاف التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما لا يحصى من المقالات الصحافية والتحليلات الإعلامية، عن مدينة تكاد تكون وهما لاطّراد هروب صورها وناسها وذاكراتها… في مقطع من الفصل الأخير من الرواية نقرأ ما يلي:

“كانت الأغنية التي كتب كلماتها بديع خيري، منذ أكثر من ستين عاما، تقول:
أهو دا اللي صار وآدي للي كان
ما لكش حق تلوم عليّ.
تلوم عليّ الزاي يا سيدنا،
وخير بلادنا ماهوش بإيدنا.
قوللي عن أشياء تفيدنا،
وبعدها إبقى لوم علي.
بدل ما يشمت فينا حاسد،
إيدك في إيدي نقوم نجاهد.
وإحنا نبقى شعب واحد،
والأيادي تكون قوية
سالت الدموع من عينيّ كالسيل. وفشلت في إيقافها، فتركت لها العنان" (بيروت بيروت، ص 252).




