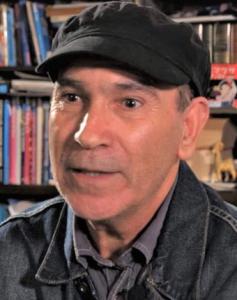أنا أستهلك إذن أنا موجود

ذات يوم ليس ببعيد عبّر المدير العام لأكبر قناة تلفزيونية فرنسية، هي القناة الأولى، أحسن تعبير ومن دون قصد عن تحوّل المواطن الفرنسي إلى مجرد كائن مستهلك في نظر المؤسسات الصناعية والتجارية والإعلامية المروجة لمنتوجاتها “يوجد عدة طرق للحديث عن التلفزيون بقول، ولكن يجب أن نكون واقعيين فالمنظور التجاري هو الأساس. في الأصل مهنة قناتنا هي مساعدة شركة كوكاكولا مثلا في بيع سلعتها. ولكن من أجل أن تصل الرسالة الإشهارية جيّدا، ينبغي أن يكون دماغ المشاهد جاهزا. تهدف برامجنا المتنوعة إلى جعل ذهن هذا المشاهد متاحا بتحضيره بين إعلانين عن طريق الترفيه والاسترخاء. ما نبيعه لشركة كوكاكولا هو زمن الدماغ البشري المحرّر، المتاح”. ذلك هو التطبيق العملي للتعريف الذي قدمه ستيفن بتلر ليكوك للإشهار “يمكن وصف الإشهار بأنه علم اختطاف عقل الإنسان لفترة كافية لاستنزاف المال”. عن طريق محاولة تحويل غير النافع إلى ضروري في وعي ولاوعي المستهلك، يمكن أن نضيف.
يدغدغ الهجوم الإشهاري رغبات الأفراد ليدفعهم إلى الشراء. وقد وجد فيه مجتمع الاستهلاك سلاحه المثالي. ويبدو أن الشركات الكبرى قد نجحت في “إغواء العقل الباطن” ومن هنا كاد مجتمع السوق المهاجم أن يتفوق على المجتمع المدني المنكمش باستمرار في أغلب المجتمعات الغربية.
من تحصيل الحاصل القول بأن مجتمع الاستهلاك غزا كل المحيط الذي يتحرك فيه الأفراد. الإعلانات في كل مكان حتى كادت الحيطان أن تغدو شاشات تدعو من خلالها بشبق شقراوات شبه عاريات إلى اقتناء السلع الجديدة والخدمات والتخفيضات ليل نهار، وتتحول المرأة جراء التكرار من ذات إلى موضوع في ذهن متابعي الموضة. وليس هذا فحسب بل تهاجم الإعلانات الهواتف الخاصة عن طريق الإنترنت فيجد أصحابها أنفسهم مستهدفين بنوعية خاصة من السلع والخدمات مختارة خصيصا لهم جُمعت أوتوماتيكيا أو خوارزميا انطلاقا مما خلفوه من آثار رغبات افتراضية أثناء بحثهم وتجوالهم على الشبكة العنكبوتية.
استنفرت كل الوسائل من أجل تحفيز الناس على الشراء والاستهلاك وإيهامهم بأنهم سيجدون سعادتهم في السوبرماركت. فهل “الحياة الطيّبة” كما كان يقول قدماء فلاسفة اليونان هي في الوفرة؟ ألا تطرح هذه الوفرة على الإنسان اليوم مشكلة وجودية؟ كيف يجب أن تكون حياته؟ هل يجب عليه ملء خزاناته بمنتجات متنوعة ومختلفة وتغيير ديكور منزله باستمرار واقتناء آخر جهاز تلفزيون أو موبايل أو لوحة إلكترونية؟
على أي حال، تلك هي الدعوة الموجهة لوعي المواطن ولاوعيه عبر خطاب إشهاري مركّز لا يرمي إلى بيع السلعة فقط بل الفكرة أيضا: في القناة الثانية الفرنسية يمكن للمتفرج أن يشاهد ويسمع هذه الأيام إعلانا غريبا يروّج لنوعية من الملابس الداخلية يقول: قبل أن تفكر في تغيير العالم، فكّر في تغيير سروالك التحتي الداخلي أولا! بمعنى لا داعي للتفكير، اهتمامك بنفسك ولباسك أولى!
آلة دعائية لا تهدأ ترسل وابلا من الخطابات المدروسة لتغرس بين أضلع المواطن- المستهلك حمى الاستهلاك وإقناعه بأنه ضرورة حيوية لا مفر منها وأنه الطريق الأقصر لبلوغ السعادة.
صناعة الإحباط المربح
ولكن مهما كان مستوى دخل الفرد، فلا يمكنه تلبية كل رغباته الاستهلاكية، فهناك دائما شيء آخر جديد أو سلعة يرغب فيها ويوّد اكتسابها ولكن ظروفه وإمكانياته المالية لا تسمح بذلك فورا فتبقى الرغبة حية معلقة قد تُحقّق وقد لا تتحقق أبدا. وهذا يمكن أنّ يولد إحباطا. وحتما سيكون هذا الإحباط شديدا حينما يكون دخل فرد أو أسرة ما ضعيفا أو في وضع من عدم الاستقرار.
يزداد الكثير من المحبطين تناسبا مع ازدياد السلع الجديدة المسيلة للعاب المراهقين وحتى الكهول وخاصة الإلكترونية منها. وتدلّ الكثير من الإحصائيات الأوروبية على أن عدد المستبعدين من المجتمع الاستهلاكي هو في ازدياد مطرد نظرا لاستفحال ظاهرة البطالة جراء الأزمة الاقتصادية التي تضرب بقوة جل البلدان الأوروبية. ويمكن ملاحظة ذلك في مواسم التخفيضات، حيث يتهافت الناس على السلع بشكل يكاد يكون جنونيا. وقد وصل الأمر في فرنسا منذ شهور إلى اشتباكات بالأيدي والأرجل بين الزبائن، نساء ورجالا، من أجل الفوز بعلبة شوكولاطة “نوتيلا” بسعر زهيد. وتقدم مشاهد الفيديو على يوتوب منظرا بائسا كله صراخ ودفع وعنف يدل على حالة جوع ومرض بالاستهلاك. وكان ذلك ضمن حملة دعائية قامت بها إحدى العلامات التجارية الفرنسية التي اضطرت إلى إيقافها في يومها الأول تجنبا للمعارك الدامية التي قد تحدث داخل مراكزها التجارية.
ولا يجب أن يكون المرء متخصصا في علم النفس ليعرف أن هذا الحرمان المتراكم سيولد حتما الحسد والغيرة ومختلف التشنّجات في المجتمع. فعدم التمكّن من المشاركة في وليمة الاستهلاك ليس استبعادا اجتماعيا فحسب بل يعتبر كموت اجتماعي. فهذا النمط الاستهلاكوي سيهدد “العيش المشترك” والمحيط البيئي معا إذا لم يعاد التفكير بطريقة أخرى في علاقة الإنسان بالأشياء والمواد السلعية. فنوعية العلاقة بالأشياء هي التي تحدّد علاقة الناس ببعضهم وبالطبيعة. يقارن الناس بعضهم ببعض وتستحوذ عليهم الرغبة في محاكاة من يستهلك أكثر. فالمقارنة الاجتماعية كثيرا ما تقود الفرد إلى مقارنة نفسه بأقرانه والحاجة إلى تكوين صورة ذاتية إيجابية تضاهي من يقارن بهم نفسه ومن المستحسن أن تكون أرقى. ولكن فهو من جهة يريد أن يشبههم ومن جهة أخرى يريد أن يكون متميزا. وهو دور تؤديه نوعية وأثمان البضائع التي تَمكّن من اقتنائها. وإن لم يتمكن الشخص من توفيرها، فهذا يمكن أن يفضي إلى إحباط إذ كثيرا ما لا يعترف الفرد في هكذا حالات بمبدأ الواقع. فالرغبة في محاكاة الآخر مستفحلة بسبب التباري الذي يخلقه الخطاب الدعائي والحرب النفسية التجارية التي تخلق أفرادا مشترين لكل جديد ويتحولون دون أن يدروا إلى لافتات إعلانية متنقلة تحرك في نفوس الآخرين رغبة التشبّه بهم ومن ثم السير في طريقهم الاستهلاكي واتباع ملتهم كما تقول عبارة ابن خلدون.

وعلى العموم، فمجتمع الاستهلاك هذا الذي يتميّز بالرخاء والبذخ هو عنيف أيضا، رمزيا وماديا. يفرض منطقه على الناس بطرق عديدة ويغيّر حتى من نظرتهم للسعادة كما يستبعد الكثير منهم ويغدون على الهامش حاقدين ينتظرون أول فرصة للثأر من المجتمع الاستهلاكي فيندسون بين صفوف المتظاهرين السياسيين كما يحدث في باريس هذه الأيام ليهجموا على المتاجر وينهبوا السلع التي طالما أسالت لعابهم. وهو رد فعل انتقامي ضد الاستهلاك التفاخري الاستعراضي الذي يبتغي بعض الأفراد من خلاله إظهار طبقتهم الاجتماعية وتفوقهم على الآخرين.
ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وجد إنسان الجموع المشترية عالما افتراضيا يمارس فيه تفاخره وبات يراقب ما أنجز غيره من بطولات شرائية على الشاشة الزرقاء ويستعرض مظهره ومقتنياته الحقيقية والوهمية لجذب الانتباه والتباهي واصطياد “الإعجابات”. وتكفي إطلالة سريعة على ذلك العالم الافتراضي لنعرف أن المظهر قد تفوق على الجوهر بالضربة القاضية.
وربما تلعب هذه الحياة الافتراضية المفبركة دورا إيجابيا ما في اتزان شخصية هذا الفرد إذ دونها سيعيش حياة مملة سخيفة وسط تسونامي السلع المتجددة بجنون التي تحاصره من كل جانب. ولا يغدو التمثيل هروبا من الواقع فحسب بل تعويضا له مثلما الشراء التعويضي بديلا عن الحب والجنس. “إذا كان الرجل والمرأة سعيدين، فلا يستهلكان”، يكتب ميشال بيكيمال في “رسول الليبرالية”، “فالإحباط هو مصدر الرغبة في الاستهلاك. ولذلك فمن الضروري تقديم نماذج من الجمال والثروة يستحيل الوصول إليها وهكذا يضعهم الإحباط في طريق التبضّع والمشتريات”.
من الصراع الطبقي إلى صراع العلامات التجارية
يبدو أن التراتبية الاجتماعية باتت مقترنة بالنزعة الاستهلاكية فغدت تتمظهر أساسا في نوعية المواد والسلع المستهلكة أو المرغوب في استهلاكها. كلما كان سعر حذاء الشخص الرياضي أو أيفونه أغلى كلما اعتبر أن مرتبته الاجتماعية أرقى وهكذا. كل فرد في المجتمع الاستهلاكي تحركه الغيرة والتنافس مع من هم أعلى منه في السلم الاجتماعي ولا يقارن نفسه سوى بهم ولا يعير اهتماما لمن هم أدنى منه.
وهي الحالة التي وصفها وتوقعها المفكر الفرنسي غي ديبور في كتابه “مجتمع الاستعراض” الصادر سنة 1967 والذي حاول فيه تحليل ونقد ثقافة الاستهلاك الطاغية التي يفرضها النظام الرأسمالي وخُدّامه والمستفيدون منه كشركات الإعلان والدعاية والتلفزيون وحتى نجوم السينما.. فالاستعراض حسبه هو اللحظة التي تحقّق فيها السلعة احتلالها الكلي للحياة الاجتماعية، فهو ليس مجموعة من الصور بل علاقة اجتماعية تتوسط فيها الصور.
وهو الكتاب الذي أصبح بمعية “الإنسان ذو البعد الواحد” لهربرت ماركوز في السنة الموالية إنجيل انتفاضة الطلاب في باريس وأغلب العواصم الغربية (1968).
لقد نشأ مجتمع الاستهلاك أو بالأحرى بداية الانتباه الإعلامي والسوسيولوجي والفلسفي للظاهرة في نهاية خمسينات القرن الماضي ومنذ ذلك الوقت والنقاش دائر: هل سيخلق هذا المجتمع الاستهلاكي الرفاهية أو ينبغي تجاوزه بما أنه مرادف للسقوط في عبودية الأشياء؟
وكالعادة كما في كل أوروبا كان الصراع في فرنسا بين البراغماتيين المدافعين عن العصرنة والإنسانويين المتشائمين والمرتابين من الحداثة. هؤلاء الذين لم يتوقفوا عن نقد حضارة البضائع التافهة، التبذير، الإعلانات المُبلّدة، الاغتراب، سلطة السلع والمادية المهينة. في السبعينات من القرن العشرين كان انتقاد مجتمع الاستهلاك في أوجه وكانت مجلات اليسار تنشر ملفات دورية تحلل فيها عواقب ثقافة الاستهلاك المتصاعدة وتطالب بتجاوزها. أما صحف اليمين ومثقفوه فكانوا يعتبرون أن التمتع بالوفرة هو عامل مهم من عوامل اتزان شخصية الفرد وازدهارها وأن النقد الموجه لحضارة الاستهلاك والتأسف على التأحيد الاستهلاكي وتكييف الذوق ما هي سوى الدليل على رومانسية توجه أنظارها نحو الماضي.
ويمكن ذكر مفكري الاغتراب ومنهم الفلاسفة ليوتار، غولدمان، نافيل لوفور وغورز.. وهم من قراء مخطوطات 1844 والذين وظفوا مفهوم الاغتراب لدى ماركس الشاب توظيفا جديدا بنقله إلى دائرة الاستهلاك، فغدا الاغتراب معهم ليس حرمان المنتج من ثمار عمله وإنما حرمانه من رغباته الخاصة.
يبيّن المفكر الفرنسي جان بودريار في كتابه “مجتمع الاستهلاك”، أن هذا الأخير هو عامل يهيكل العلاقات الاجتماعية. فالاستهلاك أصبح وسمة اجتماعية إذ يشتري الفرد غالبا وفقا للموضة الآنية، ووفق الرمز الهندامي المهيمن، كي يكون “أنيقا، في قلب الموضة، وليس مبتذلا قديم الطراز″. يقوم مجتمع الاستهلاك بتأحيد الأفراد، ويهدم كل شكل من أشكال الفردية. حينما يريد الفرد أن يكون كل الناس سوف لن يكون أحدا، يغرق وجوده في مظهره، يفقد ذاتيته. يتحول “السمارتفون” إلى امتداد لكينونته إذ لا يفارقه أبدا، فهو يحمله في يده متبخترا كأنه حبله السري.
ولئن كان بديهيا أن كل إنسان بحاجة إلى إرضاء حاجاته ورغباته، فإن ما هو إشكالي هو حينما يتحول البحث عن إرضاء الرغبات قبل البحث عن الحاجات إذ يشتري الأفراد مثلا أحدث ما طرح في السوق من الأيفونات بينما أيفونهم القديم لا يزال جديدا يفي بالغرض! وهنا يتحول الأمر إلى استعباد واغتراب حيث يجد الناس أنفسهم متعلقين تعلقا مرضيا بالسلع والخدمات بل يصبحون عبيدا لها. وهذا هو منطق مجتمع الاستهلاك الذي يجدد ويخلق منتوجات جديدة مبتكرة لنفي صفة الموضة عن القديمة أو تتفيهها. فالمستهلك المثالي بالنسبة للشركات التجارية والصناعية هو ذلك الزبون المحبط دوما. ولذلك فالإشهار يهدف إلى تأجيج عدم الرضا لديه وخلق رغبات جديدة كي لا ينقطع عن الشراء وتكديس المشتريات. وهو ما عبّر عنه المفكر الفرنسي إدغار موران قائلا “نخلق مستهلكا من أجل سلعة، لا سلعة من أجل مستهلك”.
سلعنة الوجود

أصبح المستهلك شخصية اجتماعية تمثل التطلعات الشرهة العمياء والوهمية، إذ تحول البحث الفردي المحموم عن اللذة إلى عائق أمام كل انشغال بالشأن العام كما أصبحت الرغبة موجهة نحو صور الإشهار. وقد تفطّن الفيلسوف الألماني لودفيغ فويرباخ منذ القرن التاسع إلى الظاهرة حينما كتب في جوهر المسيحية (1841) أن لا شك أن “عصرنا يفضّل الصورة على الشيء، النسخة على الأصل، التمثيل على الواقع، المظهر على الوجود، وما هو مقدس بالنسبة له، ليس سوى الوهم، أما ما هو مدنّس، فهو الحقيقة. وبالأحرى، فإن ما هو مقدّس يكبر في عينيه بقدر ما تتناقص الحقيقة ويتزايد الوهم، بحيث أن أعلى درجات الوهم تصبح بالنسبة له أعلى درجات المقدّس′.
انتشرت المحاكاة بين الناس، فكلما استهلك الفرد أكثر، كلما أصبح آخر وبعيدا عن ذاته. إن فبركة احتياجات كاذبة للناس عن طريق إثارة الرغبات توحد أساليب حياتهم وممارساتهم، وهكذا يتم تعويم الفرد في الحشد. ينتقد عالم الاجتماع والفيلسوف الأميركي هربرت ماركوز طغيان هذه الحاجات الزائفة في كتابه الشهير “الإنسان ذو البعد الواحد”، فالفرد يبني هويته الاجتماعية حسب ماركوز انطلاقا من وحول علاقته الرمزية مع هذه السلع. وليس هذا فحسب فقد تمكن التيار المسيطر من إدماج القوى المعارضة بحثّها هي أيضا على الاستهلاك. وأصبح شعار المرحلة متعويا لدى الأغلبية: “ليس لدينا سوى حياة واحدة، نحن هنا لنستمتع، أن نكون في تلذّذ دائم”.
ونتيجة لذلك، فهذه الحرية الشكلية في الاستهلاك تستعمل في الحقيقة كأداة هيمنة من طرف الطبقة الحاكمة والشركات والسوق التي لا تستطيع البقاء سوى بابتداع حاجات زائفة تشجع الأفراد المهيمن عليهم والمستلبين على الإفراط في الاستهلاك.
أما جان بودريار فيرى أن التراكم والوفرة السلعية يبدوان كأنهما تحسّن في حين أن الكمية قد عوضت النوعية فقط. وتتيح الوفرة خيارات أكثر وتوهما بالحرية والمساواة ولكن أي مساواة وحرية يقول بودريار حينما لا تترك هيمنة المال والغلاء للزبون متوسط الدخل سوى خمس علامات تجارية فرعية رديئة؟ لا عدالة ممكنة ولا حرية حينما يكون المال هو السيد، يقول ألبير كامو، فمجتمع يرتكز على المال لا يمكنه التظاهر بالعظمة أو العدالة.
لا أساس لتلك الفكرة المكررة دائما وخاصة على الصفحات الإشهارية القائلة بأن الاستهلاك يجلب السعادة، فالعكس هو الصحيح كما تبيّن دراسات وتحقيقات كثيرة. فنظرا لتعدّد السلع الرهيب، فقد يجد الزبون في مجتمع الاستهلاك نفسه أمام خيارات كثيرة ولكن سيشعر بالمرارة أمام عجزه الشرائي لا يسمح له دائما باقتناء ما يعرض أمام عينيه من جديد في كل لحظة.
نحو ثقافة السوق
ولئن كانت ظاهرة تسويق وسلعنة الثقافة من القضايا الإشكالية الرئيسة في السياسة الثقافية في أوروبا، فهي تكاد أن تصبح أمرا عاديا لا يثير انتباه الأغلبية ما دام كل شيء يجب أن يخضع لمنطق السوق وأربابه. وهي سياسة مدعومة حتى من قبل الاتحاد الأوروبي الذي بدأ منذ سنوات يستعمل في أدبياته وملتقياته عبارة “الصناعات الثقافية” و”المنتجات الثقافية”.. دون أدنى تردد، محملا الثقافة منطق الصناعة! وقد أصبحت تلك العبارات مألوفة. فهل يمكن الحكم على الثقافة من خلال مردودها الاقتصادي فقط؟ هل نحكم على فنان انطلاقا من ثمن لوحاته في السوق؟ وهل نسبة تردد الجمهور على معرض من المعارض هي التي تحدد قيمته؟ وهل مبيعات كتاب هي المفتاح النقدي للحكم عليه؟ في فرنسا تعتاش أغلب دور النشر مثلا على مبيعات كتب ذات محتوى أقل ما يقال عنه أنه تافه يجذب هواة الفضائح والخوارق والتطوير الذاتي. حكايات المشاهير واعترافات نجمات ونجوم الرياضة والتلفزيون والمساجين.. إلخ. ولولا بعض مداخيل المبيعات الخارقة للعادة في هذا المجال التي تنقذ الوضع لما استطاع الناشرون البقاء ولحرم القراء الحقيقيون من التمتع بكتب الأدب والفلسفة الجادة.
وكذلك الشأن في ميدان السينما التي أصبحت تبحث عن الوجوه المعروفة والكتابة خصيصا لها، إذ المهم هو جذب المتفرجين وبيع التذاكر وضمان الأرباح. ولم تعد المتاحف الكبرى تتردّد في كراء لوحات ومنحوتات العظماء وتوسع متاجر بيع صور الأعمال الفنية والشوكولاطة طلبا للمردودية. وحتى جامعة السوربون وظفت مدير متحف “مريامون” في بلجيكا، فرانسوا ميريس، صاحب كتاب “المتحف الهجين” لإلقاء دروس في “علم اقتصاد الثقافة”.
أثرت هيمنة السوق والمردودية على محتوى الثقافة حتى أصبحت منتوجا يهدف إلى تلبية طلب هو نفسه خلقه جو المنطق السائد الملوّث والكذبة الديمقراطوية التي تقول بـ”ضرورة جذب إعجاب أكبر قدر ممكن من الناس″. واستبدلت الحرية وفق هذه المقاربة المحاسبية بالتسيير.
تقول بعض المصادر إن أب الاتحاد الأوروبي جان موني قد تأسف وندم كثيرا في آخر حياته على أنه لم يبدأ بالثقافة في توحيد أوروبا بعد أن لاحظ بأمّ عينيه ما آلت إليه الثقافة في القارة التي عشق وعمل كل ما في وسعه لتوحيدها.
ما العمل؟
من البديهي أن نقد مجتمع السلع لا يعني رغبة في العودة إلى مجتمع الندرة وإنما يحاول المفكرون النقديون إنقاذ ما يمكن إنقاذه، التقليل من آثار الانحرافات التي يعرفها عام بعد عام. من بينها تبذير الموارد، اعتداء صارخ على البيئة، هجوم الإسمنت على المساحات الخضراء في المدن، الامتثالية، التنميط، تسبيق الملكية على الكينونة..
ولا أحد يأمل في تحويل المتبضّع اللاعقلاني المتباهي المقولب إلى سقراط متفلسف: “سر السعادة ليس في البحث دائما عن الكثير وإنما هو تطوير القدرة على التمتع بالقليل”.