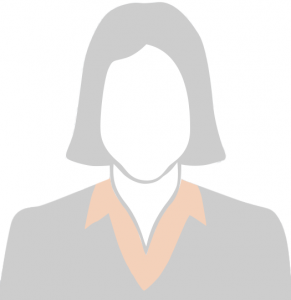ابتسامة خفية

قميص ماركس
عرفته كما عرفه معاصروه، أقصد كل من ارتاد الجامعة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وهو وإن تعددت أسماؤه فهو دائما الشخص نفسه: ماركس، أو صاحب القميص الأحمر، بل إن خصومه السياسيين والأيديولوجيين كالإسلاميين والوطنيين على سبيل المثال أطلقوا عليه ودون تحفظ اسم الأحمر.
هو كالأمير؛ يعرفه جميع الطلاب، بينما هو يعرف القليل القليل منهم وإن كانوا جميعا رفاقا في نظرته الحالمة وابتسامته التي يهديها لكل من يقابله، مبادرا بالتحية بصوته الأبح الذي منحه درجة أخرى وملوحا بيده.
أنا شخصيا – بنواياي الريفية الساذجة وقميصي الذي يفوح برائحة الشيح، حسبته أوروبيا ــ قاوري – كما نقول عندنا -، شعره الأشقر المنسدل على كتفيه، وشفاهه الحمراء الرقيقة كما لو كان فتاة مدللة ثم قميصه الأحمر، لم أصدق أنه جزائري مائة بالمائة أقصد أبا عن جد ومن زمن بعيد. وهكذا خاب ظني الريفي المتمرن على الوجوه السمراء والشوارب الكثة في أن يكون قادما من يوغسلافيا مثلا أو من الاتحاد السوفياتي أو رومانيا ولمَ لا ألمانيا الشرقية؟ لأن حدود العالم آنذاك كانت تمتد بين الشرق والغرب، وعلى المرء أن يغير قميصه إذا تجاوز حدود كل منطقة. طبعا تغير كل شيء اليوم، حتى أنه يمكنك أن تجوس كل الديار دون أن تتحرك من كرسيك الذي ليس مريحا بالضرورة.. هل ذكرت ما يخدش الحياء لا قدر الله؟
فيما أذكر كان يدرس الاقتصاد مع أن وجهه وجه شاعر خارج من عصور الرومانسية الذهبية، بيني وبين نفسي كنت أسميه بايرون فيما بعض رفاقه يطلقون عليه اسم الباشا أسوة بالأفلام المصرية.
كانت قامته الطويلة هي أول ما يستفز العين ويحرضها، إذ منذ النظرة الأولى تدعوك للتساؤل: من يكون هذا الفهد؟ لذلك تجد فئة محدودة من الطلاب الذين لا هم لهم سوى تأمين المنحة والشهادة والعودة إلى ذويهم، يسمونه اليوبارد، ربما كنت أعجب بهذه التسمية الأنيقة، ولكني لم أجرؤ يوما على التصريح بذلك. وما لي، ولكل المشاغل الأخرى غير المجدية؟ يكفيني أن أنال وظيفة بسيطة في منطقة قريبة من سكني لأنتزع قدمي فقط من الوحل وأتمكن من السير، طبعا لم يكن من السهل التخلص من ذلك الطين الذي غمر حتى الروح، ومازالت بعض طبقاته عالقة إلى يومنا هذا.
ما كنت أحسده عليه وهذا ليس سرا، بل إنه إحساس يتقاسمه أغلب الطلاب على اختلاف تخصصاتهم، هو أنه كالضوء يجلب الفراشات الملونة ليصرعها. عادة تجده يتأبط ذراع فاتنة جديدة في حملة من الحملات التطوعية أو في خطبة من خطبه الكثيرة حول الاستغلال والاقتصاد السياسي وحق الفقراء في الحياة الكريمة. وفي الغد ترى الفتاة نفسها منزوية في عتمة المدرج تبكي تحت خصلات شعرها المنسدلة بدلال.
امتيازات كثيرة توجته نجم الجامعة بامتياز، ناهيك عن وسامته الموروثة ولكنته الفرنسية الراقية وقامته المديدة، صدقا هو أقرب إلى نجم سينمائي منه إلى طالب جامعي، أضيف هنا لكونه طالبا محنكا فهو طالب السنة الرابعة على الدوام، عندما دخلت الجامعة كان هو في السنة الرابعة وتخرجت منها وتركته في السنة نفسها، مرة يضطر لإيقاف السنة في بدايتها ومرة في وسطها، بحجج لا تنتهي أبرزها حملات التطوع والتوعية والمشاركة في المؤتمرات الشبانية في إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.. وطبعا كل شيء مدفوع الحساب سلفا، ثمة تضحية أخرى لعلها الأعظم في حياته كلها، هو وقوفه ضد عائلته الإقطاعية وتأييده للتأميم وانحيازه إلى جانب الفقراء، قلة من تستطيع حسم موقفها بهذه الشجاعة ودون أيّ اعتبار لتلك الروابط الدموية الموغلة في التعقيد، لذلك كان لا بد من مكافأة توازي حجم القربان الذي قدمه. ومن ثم فتح صفحة بيضاء لا أثر فيها لأيّ عصب فيه ذكرى امتصاص عرق الفقراء، كنوع من تبرئة الذمة والكفر بالماضي المشين، وهكذا فلكل مبدأ كفارته وقرابينه.

تركته في الجامعة وتخرجت وعينت أستاذا للفيزياء بثانوية في شرق البلد.. وانتميت فيها إلى النظام الداخلي، وبعد مدة حصلت على سكن ونقلت أمي وأبي وأخواتي الثلاث وأخي الأصغر، وللمرة الأولى تصير أحذيتنا غير معبأة بذلك الكم الهائل من الطين، وفيما فرحت البنات وأخي الأصغر ثار أبي على الوضع: الشقة التي لا فناء لها، والنوافذ مسفوحة الأسرار نحو الشوارع المعتقة الهواء، واللباس القصير الصارخ بالوقاحة، والضوضاء والطماطم المعلبة. فحمل صرة ثيابه وعاد ليشم رائحة التراب التي كالعنبر، واقتفت أمي أثر عطره ممزقة الفؤاد.
تزوجت من زميلة لي وأنجبت أطفالا، ثم انتقلت إلى الصحراء لتأدية واجب الخدمة الوطنية اعترافا بما قدمه الوطن لشبابه، وكنا حينها في منتصف الثمانينات، ثم عدت لأواصل حياة السلحفاة تلك.
نسيت ماركس وخيوط أحلامه الرومنسية المفتولة من الحرير والذهب، وانغمست كلية بين أوراق الطلاب وغبار الطباشير، وارتعاشات البكالوريا، وطلبات الأطفال وصراخهم اللامتناهي، وأنا أرقب قاماتهم تتمدد نحو الأفق مثل شجيرات السرو كحلم مضرب بخضرة ليلية غامقة، غرقت تماما فيما نسميه الحياة هذا الاستثناء المذهل، حتى أهلي صاروا ضيوفا بعد أن مات أبي وأمي والبنات تزوجن وتخرج الأخ، ثمة تفاصيل كثيرة بين فجوات الأحداث.
لم يكن زمنا يسيرا على كل حال، إذا عددناه بالأيام والسنوات والشقاء، أما إذا عددناه بمقياس السعادة، فأقول الصدق بأنها محض لحظات عبرت الخاطر، وحين استفقت من غفوتي وجدتني أتخطى عتبات الأربعين عن جدارة: انحناءة خجولة بين الكتفين، فضة لامعة فوق الجبين،أخدود صغير عند ملتقى الشفتين وغيرها.. وغيرها، وحده الزمن أستاذ الأساتذة سيعلمنا.
أمي رحمها الله كانت دائما تقول بأن الجبال وحدها هي التي لا تلتقي، هذا صحيح ولكني في تلك الحياة السابقة ما كنت لأصدق كثيرا من كلام امرأة، لم تعرف غير بياض الأفق وزرقة السماء أحيانا وخضرة الحقول وثغاء الشياه على مدار الحول، أيّ ثروة سأجنيها من هذه المعارف الحمقاء؟.. لقد كنت عاريا من كل شيء حتى من الحكمة. لذلك أقول بأن أمي كانت شجرة للحكمة دون أن تتيقظ حواسي لأشم عبيرها المتضوع، كما تبوح اليوم شجيرة الليمون بسرها تكفيرا عن خطيئتي نحو تلك الذكرى، ذكرى أمي.
لا أدري إن كان القدر هو من قاد خطاي، أم أنها الصدفة أم عزمي، ولكني انتقلت إلى العاصمة التي لم أعتب بابها المشرع على البحر منذ زمن بعيد، أعني منذ استحالت رقعة ضيقة للدم والرصاص، ولكني عدت إليها اليوم لشغل مع ابن خالي، لا أدري لم ذكرتني بأمي في وحدتها وضعفها ورقة ثيابها، هل هناك وجه شبه بين أمي والعاصمة؟.. لقد كانت أمي يتيمة منذ طفولتها فنهب أبي جمالها وأخوالي ميراثها وثروتها ونهبنا نحن أبناءها حليبها وجسدها، فيما استفردت البنات بحليها المنقوش بريشة الأجداد، بينما احتفظت هي بروحها الشفافة على الدوام، وحين ماتت، ماتت كما يموت أحباب الله فقيرة الجسد عامرة الروح.
وجوه عابرة طافحة بالصحة وجوه أجنبية وجوه شاحبة، يا إلهي يمكننا تمييز الرتب في الشارع، كأنما نحن في الجنة والنار، وجوه مستبشرة ووجوه مكفهرة، من هذه الآلهة التي عبثت بالوجوه والأرزاق؟ طاولات السجائر والكاوكاو والسلع الصينية المكدسة وصراخ الباعة الصغار: “كسي روحك يا الزوالي، استر روحك يا لعريان”. كدت أفقد روحي لأخرج من سوق الحراش، وأتجاوز الطاولات المتزاحمة والأثواب المعلقة والسلع المكدسة من كل صنف من الإبر والدبابيس إلى الأفرشة والأواني. همست في نفسي لا شك أنها مقلدة كلها كما هي عندنا. وحين خرجت إلى قلب العاصمة بعد زحمة وانتظار وتجاوز متحايلا بسيارتي ذات الترقيم الحديث نسبيا: 2005.. رأيت المعارض العملاقة والبازرات والألبسة الأنيقة والسيدات الجميلات والأكلات اللذيذة الجاهزة: مسكينة أنت يا زوجتي تعودين من شقاء الطباشير لشقاء القدر. أحرام أن تجدي مائدة عامرة بهذين الراتبين الهزيلين؟.. الأبناء في الجامعة ومنهم من يجلس على كرسي الانتظار أملا في وظيفة. انس النكد اليوم على الأقل أنظر أين أصبح الشطار والأذكياء؟.. هاهي الحياة تضحك لغيرك على الدوام، تغمز بعينيها الساحرتين وتنساك من تلويحة يدها.
دلفت نحو محل فاخر للأثاث وعلى الرغم من اجتهادي في ارتداء بذلة أنيقة وحلاقتي الجيدة، وتسريحتي الجميلة وابتسامتي، إلا أني لم أستطع منع نفسي من الإحساس بالضآلة أولا أمام الباب الزجاجي ذي القفل الأوتوماتيكي، وثانيا أمام الباعة الشبان من فتيات لامعات الثغور وشبان مديدي القامة، أهؤلاء منا ونحن منهم.. سبحان الله!
كل شيء كان يفوح برائحة الترف والنقاء: غرف للعرسان، طاولات من مختلف الأشكال وأنواع الأخشاب موائد صغيرة مستديرة، كراس بنية اللون، عسلية بلون الشوكولا السوداء، مزهريات فاخرة، مطارح مريحة.. يعجز اللسان عن الوصف وتجهد العين من النظر فيما يصمت العبد الضعيف ويبتلع ريقه، ويحمد ربه أن سيدة البيت بقيت هناك في بيتها بعيدا عن هنا وإلا أصابتها السكتة فجأة.
في آخر المحل الواسع الذي يتسع لإقامة تجمع سكني بأكمله، كانت هناك طاولة صغيرة وكرسي من الخيزران وثمة رجل وسيم بلحية قصيرة، أزعر، وشعر يكاد الشيب يحتل سواده تماما، وعلى محياه سمات النعمة ووقارها، كان وحيدا فوق الكرسي تندلق حبات مسبحته بهدوء وبمحاذاته يستريح فنجان أنيق من القهوة. أقول لنفسي: يبدو مألوفا، أضحك. وهل أتيح لك أن تعرف مثل هذا الصنف الذي خرج من الفردوس لتوه؟
إلا أن الوجه يصر على ألفته مع العين: من يكون؟.. أين رأيته؟.. هذه السحنة الجميلة ليست غريبة عني، ولكن الذاكرة مثقوبة ومتعبة من الترداد.
بعد انقضاء يومين عدت إلى المحل ثانية رفقة ابن خالي، وحين طلبت أن ندخل ضحك مني..
– ماذا تريد أن تشتري من هنا؟
– لا شيء، ولكني أرغب في تمتيع العين وغسلها.
–لا تلعق شفاهك يا ابن عمتي، فلم نخلق لهذا.
–من ذلك الرجل الوحيد هناك؟
–الحاج سليم مالك المحلات، ألا تعرف؟.. وكيف لا تعرف محلات الباشا؟
كانت اللافتة المعلقة على جبين الباب الواسع في الأعلى عند المدخل تعلن بقوة، بلون أحمر مشع، عن محلات الباشا، أقصد محلات الحاج ماركس.