التاكسيستي
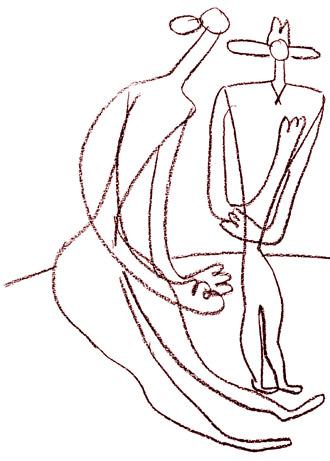
ركنت سيارتها في أحد الأزقة الهادئة بالمدينة، أطفأت المحرك، أخرجت هاتفها النقال، أرسلت رسالة نصية “أني بره نراجي فيك.. سيارة بيضا”، انتظرت. كان الزقاق مغلقا بخيمة واسعة، بها فتحتان جانبيتان تطلان على الرصيف، تنتصب أمام بيت العزاء. لم تسمع نحيبا أو حتى أنين بكاء.. لكنها سمعت رنين الملاعق وهي تحك أواني الألومنيوم فقط، رائحة “البصلة” غازلت أنفها، مذكرة إياها أنها لم تتناول غداءها بعد.
سيدة ترتدي جلبابا أسود ووشاحا أبيض، وقفت وسط الشارع تجول بعينيها، فما كان من آمال إلا أن أطلقت صرخة فزعة من منبه سيارتها، خفضت السيدة رأسها لتدقق في قائد السيارة، ابتسمت، اتجهت نحوها، فتحت الباب.. “أنت التاكسيستي”، ارتسمت بسمة جانبية خجولة على وجه آمال.. وأجابت “هي أني.. اركبي”.
أمسكت آمال المقود بحرفية وصرامة، ليس كما تمسك قلمها وهي تخط تقريرا صحافياً، ولا كما تثبت يديها على آلة التصوير وهي تلتقط جنون سماء طرابلس أثناء الغروب حين تختلط ألوانها وتسيح بين سحابات الصيف وسعف نخيلها السامق.
“أنتِ التاكسيستي”.. عاودت الابتسام بمرارة بينما تنقر كلمة “تاكسيستي” أذنها دون توقف.
في زمن الحرب تتساوى كل المهن، أن تحرك المقود، أو القلم، أو آلة التصوير.. أن تنهض باكرا لوحيدها، تُلبسه، تُناوله إفطاره، تقوده صحبة صغار آخرين إلى المدرسة، أن تقف في طوابير الخبز، الغاز، المصرف، أن تضغط زر الكهرباء فيستمر الظلام لا مباليا، أن ترتعد بردا تحت البطاطين، تحتضن ابنها وتفرك أطرافه المثلّجة، أن تتفقد الصيدليات للحصول على دواء الضغط لأمها المسنة، أن تنهب الطرق المزدحمة والأزقة المحفورة، أن تدفع بسيارتها كالدابة وسط برك المياه وهي تدعو “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء”.
أن تواجه تبادلا عشوائيا لإطلاق النار، أو دخانا كثيفا لقذيفة، فتتعامل معهما بحرفية، تدير المقود بسرعة فائقة وتمتطي ظهر الرصيف وتعود، أو أن تحتضن بذراع واحدة كتف الكرسي المجاور تلتفت نحو الخلف بعد أن تغير ذراع تحكم السرعة إلى الوراء، وتدوس على الوقود وترجع بمركبتها في مسار مستقيم بسرعة مخلفة غباراً أمامها.
أن تدفع مركبتها طواعية كما تُساق الشاة نحو البوابات وهي تتمتم “وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون”، ألَّا ترفع عينيها إلى تلك الوجوه الملثمة بالأسود، والأفواه المسدودة بالقماش إلا من لعاب ظاهر على سطحها. أن تشعر بقلب وجل باقتراب البندقية منها وهي تتأرجح في رقابهم، أو تصوب في اتجاهها، أو تنطلق منها رصاصات محمومة مجنونة ضائعة في سماء هادئة فتُردي صمتها.
“أوراق السيارة”!
تفتح الدرج الأمامي، تخرج الأوراق، تمدها.. لا يقرأ، قد يتصفحها مقلوبة وهو يتراجع قليلا إلى الوراء، يعاود الاقتراب وبندقيته التي يتكئ عليها، يخفض رأسه يتفحصها وركابها، يضرب سقف السيارة ويقول “بري”.
“يعطيهم ما يرفعهم كلهم.. يرزينا فيهم”، تنطلق الدعوة غالبا من الكرسي الخلفي أما آمال فيغوص صوتها وتكتفي بالتمتمة.. دعاء أو دعوة سيان.
على الرغم من أصولها الجبلية وبشرتها الناصعة وعينيها العسليتين، إلا أنها تشعر بانتماء عميق لهذه المدينة، التي سكنت أكثر أحيائها شعبية، في بيت خفيض بشارع مترب، تطل نوافذه مباشرة على “زنقة الباز″. وإن حملت آمال لقبا باسم تلك القرية الجبلية، لكن قلبها ينبض بعشق طرابلس، تهتز طربا للمالوف الأندلسي “أليف.. أليف يا سلطاني والهجران كواني/ باء بُليت بنظرة/ تاء.. تيه عني الزهرة/ ثاء.. ثلاثة في حضرة/ جيم.. جار عني سلطاني والهجران كواني..”، وتهز جسدها الممتلئ رقصا على الأصوات الطفيلية للزمزامات، تعشق أغاني سلام قدري ومحمد رشيد ومحمد حسن.
“أحلى مدينة طرابلس.. أحلى مدينة مغرومين بحبك جينا طرابلس″.
حين التقت به في مبنى الصحيفة التي يترأس تحريرها، كانت خريجة حديثة في قسم اللغة العربية بكلية التربية، تعشق الأبجدية، تتعامل معها بنفحاتها وتعاريجها وانحناءتها ونقاطها، بقافها وكافها وضادها ويائها، بجنونها وقلقها وانقباضها، بقواعدها الصارمة، بأوزانها وأحمالها وقوافيها.. حفظت الشعر والمعلقات والقصائد، لكنها سرعان ما ضاقت بموازين الخليل، فلجأت كأبناء جيلها إلى الشعر الحر، تحفظ شعر السياب والملائكة والبياتي وصدقي عبدالقادر، “بلدي وما بلدي/ سوى حقق الطيوب/ ومواقع الإقدام للشمس اللعوب/ أيام كانت طفلة الدنيا الطروب/ فالحب والأشعار في بلدي دروب/ والياسمين يكاد من وله يذوب، ولا يتوب”. وعلي الرقيعي.. “وعلى صورته وسّدت رأسي/ وتمسحت بخديه وقبلت عيونه/ وتضرعت طويلا للسماء كي تصونه”.
ولم يكن سواه، محمود، من أمسك بيدها، سحب مزلاجا حديديا صدئا، دفع بها إلى عالم الصحافة، علمها كيف تدخل الأزقة وتتفادى الطرق المعبدة حتى لا تطالها يد السلطة والسلطان. أخذها للأزقة المتربة حيث الوجوه التعبة والحزينة والغائرة والجائعة، والأزقة المعبدة حيث الملامح الدقيقة والبارزة والثغور الوردية اليانعة. علمها أن السخرية في عالم الصحافة حربة في وجه اصحاب السلطة، تجرحهم وتُذهب هيبتهم، تكشف نفاقهم. كان عموده الأسبوعي يرفع من مبيعات الصحيفة. على الرغم من سنوات السجن السياسي الرطبة التي لطخت حقبة من عمره، ظل على عهده معارضا بالقلم، حتى جاء ذلك اليوم الذي منعوه فيه من الكتابة، بارت الصحيفة، انخفضت مبيعاتها. ازدادت سخرية محمود كما ازدادت شعبيته، وتحت الضغط، أفرج عن قلمه ورفع عنه قرار المنع من النيابة العامة، فعادت إليه حبيبته وقرر الزواج من آمال.
أحبته وأحبها، قرأت له وقرأ لها، علمها أصول العمل الصحافي، فزينت تقاريرها ومتابعاتها الصحافية صحفا عدة، لكن محمود ظل في سخريته، يدخل الأزقة، يدور حول المنعطفات، يلتقط هموم الناس، يكشف فساد المسؤول بلكنة طرابلسية ساخرة.
شهد محمود بزوغ الثورة، لكنه لم يشهد آثارها، مات وهو مبتسم متيقن أن الديمقراطية والعدالة والحرية أقرب إليه من روحه التي فرّت وهو يستعد للمشاركة في أحداث الثورة، مضى معتقدا أنه خلف لابنه حياة أفضل، وأن آمال ستحلق في عالم الصحافة بنسقه، تكشف الفساد وتسخر من المسؤولين، وترفل في الطرقات المعبدة إذ لن تكون هناك أزقة متربة.
لكن الثورة خلّفت الحرب كما تخلّف النار الرماد.. أتت على آمال وابنها وعائلتها ومدينتها وبلادها.. الحرب التي أحرقت القمح فجاع أهلها، أطفأت النور فبردوا، أفسدت الذمم فأفلسوا.
“أنتِ التاكسيستي؟”.
“أيوه هي أني”.
كل المهن تتساوى في زمن الحرب…المهم العد نقدا.
تنهب سيارتها الأزقة، تبتعد عن الطرقات الرئيسة، تقف عند البوابات الوهمية، تزاحم في طوابير الوقود، تنتظر دورها حتى يسقط رأسها على المقود بعد أن يلتصق جفناها تعبا، ثم تنتفض من زعقة منبه سيارة خلفها.
تيقنت آمال أنه في زمن الحرب تهجر الأصابع الكتابة وترتمي الأوراق منتحرة تحت عجلات السيارات. وكما علمها محمود أن القلم لا سلطان عليه، يتحكم بها ويؤدي بها إلى المنزلقات، تعلمت هي أن تتحكم في مقود السيارة وتختصر الطرقات وتحتمي بالزحام وتتفادى العتمة.
“أنا التاكسيستي، تفضلي”.
تدوس على الوقود وتنطلق مختصرة الطرقات في مدينة الميليشيات.


