الجمال العنصري

أزمة الهوية والانتماء مسألة اجتماعية وثقافية وسياسية وصراع بين دول العالم الثالث والإمبريالية الغربية ممثَّلة بالإدارة الأميركية التي تدعو إلى الاعتزاز بالهوية العرقية البيضاء وقهر الهويات الأخرى. وهذا الصراع بين العالم الثالث والإمبريالية والرجعية يستدعي تحرره؛ ليحقق دوره التقدمي والتمسك بهويته وذاتيته والاعتزاز بها والوصول إلى الأمان الرامز إلى الاستقرار والانسجام مع الذات.
بطلة رواية “جارية” للكاتبة البحرينية “منيرة سوار” (2014)، لا تحب لونها؛ لأنها سوداء، وتسعى وراء رجل أبيض “هيثم”، ترغب فيه ولا يرغب فيها، وترفض رجلاً آخر أسود “عبيد”، يرغب فيها ولا ترغب فيه. ولا شك في أن معاناة “جارية” من زنوجتها بوصفها أنثى لا يمكن أن تشابه بحال من الأحوال معاناة ابن خالتها “عبيد”؛ لأن الأنثى تتأثر بمعايير الجمال بصورة أكبر.
تفتتح “جارية” صالون تجميل يصطبغ باللون الأبيض من خلال جدران ناصعة البياض وأرضية بورسلين بلون أبيض مطفي، وأريكة جلدية بيضاء، وتتخذ من الاحتراف في عالم التجميل وسيلة لمغالبة التحديات والتخفيف من سطوة اللون الأسود في حياتها، فهو “العالم الذي نستطيع من خلاله رسم وجوهنا وذواتنا من جديد” (ص 58).
تعيش “جارية” حالة استلاب ثقافي يهيمن على تفكيرها وأخيلتها ويسيطر على حياتها، وتمعن في نكران ذاتها، والانكفاء عليها رفضاً واحتقاراً، إلى حد يصل إلى المازوشية؛ فهي في قطيعة تامة مع المرآة التي لن ترى فيها إلا وجهاً أسود؛ أي في قطيعة رمزية مع وجهها وذاتها. لكنها تصطدم باستحالة الهرب من قدرها في هويتها السوداء، فملامح وجهها مرسومة على وجوه أهلها، والسواد الذي يغلف تلك الوجوه لا ينفك يذكّرها بسوادها. إنها تنفر من لونها الأسود الذي يجافي الجمال المعياري. فمقياس الجمال العالمي يرتبط بالبشرة البيضاء والشعر الأشقر والعيون الفاتحة. وسرعان ما يظهر توترها كلما دخلت إلى الصالون زبونة شقراء تجسد الجمال الأنموذجي الذي تشيعه الثقافة العالمية وتروّج له وسائل الإعلام.
لأني أسود
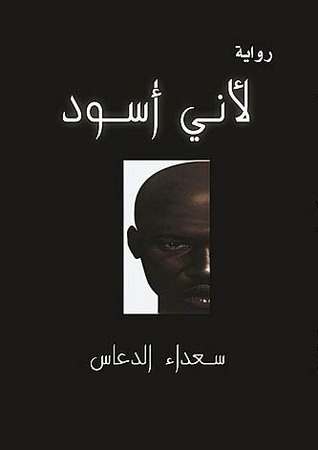
تطرح الكاتبة الكويتية “سعداء الدعاس” في رواية “لأني أسود” (2010) سؤال الهوية، بدءاً من العنوان الذي يأتي إجابة على أسئلة كثيرة تلح الكاتبة عليها منذ الصفحات الأولى؛ لتشكل “أزمة الهوية” بؤرة ازدلاف فكرية وفنية عند الأبطال الذين يواجهون مشكلة الاختلاف اللوني والاغتراب عن المجتمع. فيستعرض السرد انكساراتهم عبر صفحات مذكراتهم، مبرزاً الحاجة إلى البوح في معايشة أزمة هوية الزنوجة عندما يمنعهم الكبرياء عن الإفصاح. فالسارد الممثل “جمال” الذي ولد لأم أميركية سوداء اسمها “جوان”، وأب كويتي أسود اسمه “فوزي”، وليد التماثل اللوني لأبوين يعانيان تركة التمييز اللوني. فيخاطب الآخر الأبيض بنبرة انكسار “أنت تجهل معنى أن تكون أسود.. معنى أن يكون لونك مصدراً لإهانتك! معنى أن تحمل هوية لونية منذ ميلادك حتى الممات. هوية تتقن تعريتك.. تحدد انتماءك قبل أن تصرح به.. هل تقبل أن تعرف بـ’العبد’؟!” (ص ص3 – 4). لا شكّ في أن رفض هُوية السواد يقوم على أساس اقترانه في المخيال الاجتماعي بصورة القبح والوحشية والبدائية والعبودية، في حين يرتبط بياض البشرة بالجمال والذكاء والحضارة والمدنية؛ من خلال انتشار الثقافة البيضاء بين السود، وتأثيرها في حياتهم. لقد نجح النظام الثقافي السائد في عملية الاستعمار العقلي للأفارقة السود، فاستوعبوا المثل العليا للقوة البيضاء المهيمنة، إلى حد الاقتناع بأن قبولهم من قبل الآخرين ومن قبل أنفسهم لا يمكن أن يكون إلا من خلال التنصل من عرقهم.
مع تقدّم السرد تبرز محاولة جمال إعادة الاعتبار لسواده، والنظر إليه بعين الرضا والحب، فيقول “أرغب بمعنى مختلف عن ذلك الذي يتوقعه الآخر من شاب أسود.. حين كنت في السنة الأولى في المعهد المسرحي، كان أمامي خياران، إما أن أكون ممثلاً يعتليه الآخرون ليكون حصانهم عند دور الفارس، أو أن أعتليهم أنا وأكون الفارس، فقررت أن أكون أنا الفارس” (ص 61). فهويته السوداء بحاجة إلى اعترافه بها أولاً، ومن ثم تستعيد هذه الهوية مكانتها وقيمتها في المجتمع شيئاً فشيئاً. إذن لا بد له من مغالبة الآخر كي ينتزع اعترافه به بوصفه آخر أسود. فبدلاً من أن يرجو من الآخرين ألا يعيروا انتباهاً لبشرته أو ينتهي به الأمر على نحو عدائي مطلق يحاول أن يستظهر قيماً إيجابية لسواده. من هنا يبدأ القارئ بتلمّس بعض الومضات التي تلوّح إلى إمكانية التعامل مع اللون الأسود بوصفه معلماً جمالياً. إلا أن هذا الحل يبدو أكثر ارتباطاً بجنس الذكور؛ ففي الوقت الذي يقع فيه سواد الرجل موقع المقبولية، بل قد يكون عنصراً جاذباً ولافتاً، نجد سواد المرأة يشكل عبئاً ثقيلاً على أنوثتها؛ إذ ترنو البطلة “جوان” إلى الفنان الأميركي دينزل واشنطن مأخوذة بسواده، كما يظهر المقطع الآتي “التصقت جوان بشاشة التلفزيون.. مدت يدها تلامس السطح المصقول.. دققت النظر في وجه واشنطن.. تمنت تقبيله.. أرادت الاستمتاع بسواد يماثلها لم تمنحه الفرصة من قبل؛ سواد سعت لكبحه تحت زيف الأصباغ وكريمات التمليس” (ص ص 32 – 33). إنّ التزمّت الفكري حول مفهوم الجمال الراسخ في الأذهان يحتاج إلى تراكم جهود كبيرة لنقضه. فهو يقتضي حشد أنساق ثقافية جديدة تعمل على إزاحة ما ترسخ في الأذهان حول الجمال، على وفق المعايير البيضاء العنصرية التي تحيل على استمرار معاناة المرأة السوداء.
أكثر العيون زرقة
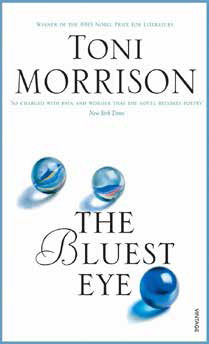
تقارب توني موريسون في رواية “أكثر العيون زرقة” (Morrison, Toni: The Bluest Eye, 1970) مفهوم الجمال ومعاييره، وعلاقته بالهوية؛ إذ تقع الطفلة السوداء “بيكولا” ضحية النزوع إلى المستوى المثالي للجمال. فالرواية تظهر فيضاً من المشاعر السلبية التي تجتاح البطلة السوداء إزاء شكلها وجمالها منذ الصفحات الأولى، بما يظهر الوعي المبكر للطفلة. ففي المونولوج الآتي تطغى هواجس الجمال والمرغوبية والجاذبية على براءة الأطفال “كان من المفترض أن تدخل الدمية سروراً هائلاً إلى قلبي، لكنها أحدثت العكس تماماً.. لم تكن لديّ إلا رغبة واحدة هي أن أمزقها تمزيقاً، وأن أتبين مما صنعت، وأن أكتشف الجاذبية، وأن أعثر على الجمال” (ص 20). تنفر الطفلة الصغيرة بيكولا من لونها الأسود، الذي يقع على النقيض مما تقرّه السلطة الاجتماعية في توجيهها الحركة الجمالية وصناعة الإنسان الأنموذج. بدليل اعتقاد بيكولا أنّ قبحها لا يتعلق بها بصورة خاصة، فأفراد أسرتها كلهم “التقطوا القبح بأيديهم، وألقوه على أنفسهم كالوشاح، وانطلقوا به في الدنيا” (ص 39). اللون هو جوهر شعور البطلة السوداء بالنقص والاشمئزاز الذاتي؛ إذ تعتقد أن الجمال وقيمة الذات يرتبطان بالبياض وما يتعلق به من صفات؛ الأمر الذي يمنعها من بناء صورة ذاتية إيجابية.
فالرواية تناقش العلاقة الوثيقة بين المظهر الشكلي والشعور بالقيمة؛ إذ تعتقد بيكولا أن عدم توافق شكلها مع معايير الجمال البيضاء يمنع الناس من إظهار أيّ شعور بالعاطفة تجاهها. فهي تنعت بالفتاة القبيحة من قبل ما لا يقل عن خمس شخصيات في الرواية، بما في ذلك هي نفسها، وهذا القبح أصبح موضع السخرية والتندر في الصف. وبما أن الجمال يرتبط بالقيمة وينعكس على المعاملة الحسنة والاهتمام الدافئ، تشطح البطلة شطحة كبيرة في خواطرها ويأسر كيانها خاطر عذب؛ إذ يخطر ببالها أنه “إذا كانت عيناها هاتان مختلفتين؛ أي إذا كانتا جميلتين فإنها ستكون مختلفة.. لقد كانت أسنانها جيدة، على الأقل لم يكن أنفها كبيراً وأفطس. لو أنها بدت مختلفة وجميلة، فلربما سيكون ‘تشوللي’ مختلفاً، والسيدة ‘بريدلوف’ كذلك”. (ص 46). فالبطلة إذن تجاري الآخرين في إدانة ذاتها، على الرغم من أنها تتمتع بقدر من الجمال. إنها تتبنى نظراتهم الفوقية وشعورهم بالاشمئزاز والقرف والغثيان إزاءها، لقد وصلت إلى درجة الاحتقار الذاتي العرقي بالكامل لمغايرتها المفهوم الأبيض المثالي للجمال المنتشر في أميركا. وبذلك تكرس مقولة مفادها “المرأة السوداء هي نقيض الجمال الأميركي. هي الآخر الذي لا يمكنه أبداً إرضاء نظرة المجتمع”. (Davis, Cynthia A.: Self, Society and Myth in Tony Morrison’ Fiction) لقد عمدت القوى الاستعمارية على ترسيخ نفور الأسود من لونه وغرس كراهيته لعرقه وثقافته؛ وبالتالي إلى كراهية أخيه الأسود والانقلاب عليه والتماس اللون الأبيض أيقونة الجمال والسعادة والتحضر.
تنصاع بيكولا وراء أحلامها وتستسلم لها استسلاماً أعمى وتعيش حالة الاستلاب الثقافي للجمال المعياري بمعانيها كلها؛ إذ تذهب إلى ساحر يدعى “سوبهيد”، وتطلب منه أن يمنحها عينين زرقاوين، ثمّ تقوم باستجواب صورتها عن نفسها بعد أن تعود من عنده بعينين زرقاوين، يجنح فيهما سرد “موريسون” إلى الغرائبية المبرر لها في خدمة السرد الواقعي:
– “هل أنت غاضبة مني؟ لأن عيني ليستا على قدر كاف من الزرقة؟ لأنهما ليستا العينين الأكثر زرقة؟
– لا، لأنك تتصرفين بشكل سخيف.
– لا تذهبي، لا تهجريني. هل ستعودين إذا ما حصلت عليهما؟”. (ص ص203 – 204).
ما تبحث عنه بيكولا حقاً هو العاطفة، فهي تخشى أن ينصرف عنها الآخرون إن لم يكن لديها عينان زرقاوان. فالمقطع السابق يوضح كيف أن “محاولة تحقيق معايير الجمال البيضاء لن تجدي نفعاً مع بيكولا. إذا كانت العينان الزرقاوان؛ أي الأنموذج الأبيض للجمال، لا تجعلان منها فتاةً محبوبة، فهذا يعني أن الحصول عليهما ليس هو الحل لشفاء الهوية الأميركية الأفريقية”. (Gomes, Ruas Machado Rosana: Identity, Race and Gender in Toni Morrison’s The Bluest Eye). فالطفلة السوداء الصغيرة ما تزال تصبو إلى الجمال الأميركي الذي تبثه السينما وتعمل على أسطرته، وينتشر في الثقافة الجماهيرية، على الرغم من امتلاكها ما كانت تطلبه من زرقة في العيون.
يشير السرد إلى أن الجمال المعياري لا يمكن بلوغه فهو غير قابل للتحقق؛ لأنّه لا يقف عند حدّ معين. ويبرهن أن السعي وراء هذا الجمال بوصفه هاجساً ملحّاً ووضعه على رأس الأمنيات والقيم المرغوبة في الحياة يمثل الخضوع للأبيض، وسيخلق دائماً كراهية الذات وازدراءها؛ إذ تنتهي البطلة نهاية عبثية تحيل على تفكك الشخصية تفككاً لا رجعة فيه، فقد “كان الضرر الذي حاق بها شاملاً. أمضت أيام جنونها، ماضية جيئة وذهاباً.. كانت تمضي بذراعيها، وقد ثنت مرفقيها، ووضعت يديها على كتفيها، مثل طائر منهمك في جهد دائب للطيران، يائس على نحو غريب” (ص ص 204 – 205). لقد كانت البطلة على استعداد لدفع ثمن الانتماء إلى فئة منبوذة ترمى بالسخط، لكن الثمن كان غالياً، أكبر من أن تحتمله طفلة. إنها جميلة وأقل سمرة من غيرها من الزنوج. وفي سعيها نحو المثال الأبيض كانت تسعى إلى “هولوكوست” بيضاء من دون أن تدري؛ إذ وصلت إلى حافة الجنون. ويبرز دور الراوي العليم في استظهار مفهوم الجمال الجسدي بوصفه واحداً من الأفكار المدمرة في تاريخ الفكر الإنساني؛ فهو ينقل بصورة مباشرة الآثار النفسية المدمرة للأفكار الغربية من الجمال، وكيف يمكن لهذه الأفكار أن تغير النظام الطبيعي لثقافة كاملة. وهذه الحال تنسحب بشكل مجازي على كثير من الفتيات السوداوات الأخريات المأزومات في المجتمع.
عبور
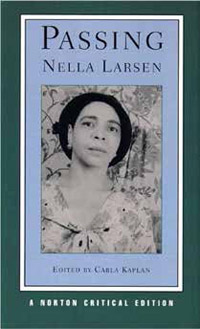
تدور رواية “عبور” للكاتبة الأميركية نيلا لارسن (Larsen, Nella: passing, 1929) ، حول شخصيتين هجينتين عرقياً، هما “آيرين ردفيلد”، الشخصية المحورية في الرواية، وهي امرأة أفريقية الأصل ذات بشرة فاتحة بعض الشيء. وصديقتها “كلير كندري” وهي امرأة جميلة ذات بشرة فاتحة وشعر أشقر، أفريقية الأصل أيضاً، من أب أسود وأم بيضاء، تعيش في مجتمع أبيض، متزوجة برجل أبيض، وتتصرف في العلن بوصفها امرأة بيضاء.
يظهر السرد أهمية الجمال في حياة الشخصية وتقييمها الآخر بناءً على شكله، بعرض وجهة نظر زوج “كلير” الجمالية “ضحك الرجل ضحكة مكتومة فتغضنت عيناه.. وأوضح: حسناً، في البدء، عندما تزوجنا كانت بيضاء مثل.. مثل.. زنبقة. لكن يبدو لي أن بشرتها آخذة في الدكنة تدريجياً. أخبرتها أنها إن لم تتنبه لنفسها، سوف تصحو يوماً وتجد نفسها قد تحولت إلى زنجية” (ص 67). يربط زوج كلير “جان بيلو” بين الجمال والعرق؛ فتقييم الجمال مشحون بمعايير اجتماعية وسياسية. كلما ازدادت بشرة المرأة بياضاً تشبهت بالوردة البيضاء الجميلة، وكلما جنحت بشرتها نحو السواد ابتعدت عن مصاف الجمال. وكلمة “زنجية” في هذا المقطع جاءت نافرة ذات دلالة سلبية محضة مرتبطة بالقبح الفج. هذه النظرة العنصرية لم تأتِ من فراغ، فهي تعبر عن ذوق عام غرسته آلة الإعلام الأميركية في الأنساق الثقافية الجماهيرية، وحمله البيض في عقولهم وقلوبهم، وآمن به السود أنفسهم، وتبنوه عن قناعة مطلقة. فالجمال المعياري إذن موجه، ومتداخل مع المخيال الفردي والجمعي الذي يرفده بعناصر التشكيل.
تقدم رواية “عبور” رؤية جمالية جديدة على وفق ما يظهر تقديم الساردة الممثلة “آيرين” ملامح شخصية “كلير” الشكلية، ومعالمها الجمالية. يظهر ذلك في المونولوج الآتي “بدت البشرة عاجية لها بريق ناعم خاص. كما كانت العينان بديعتين، إنهما داكنتان، أحياناً سوداوان كلياً، تكتنفهما رموش سوداء طويلة، عينان خلابتان، فيهما شيء سري دفين. آه! بالتأكيد! كانتا عينين زنجيتين غامضتين!” (ص 45). هذا التداخل الغريب هو جوهر جمال كلير، وهذا النوع من الغرابة يمثل إشكالية في السرد إلى حد ما؛ فهو يتخذ طابعاً خاصاً مميزاً يشكل تحدياً للنظام الدلالي السائد، ولمعايير الجمال البيضاء المستخدمة لدعم العنصرية. لكنه لا ينقلب عليها، بل يضعها قاعدة ارتكاز واضحة؛ لتقدّم بذلك الكاتبة نيلا لارسن أنموذجاً جمالياً توفيقياً.
ضروب الشبه

تقوم روايتا “جارية” و”لأني أسود” بمناقشة مفهوم الجمال ومعاييره الثقافية السائدة المرتبطة بالبشرة البيضاء وبالشعر الأشقر وبالعيون الفاتحة؛ فالبطلة جارية افتتحت صالون تجميل لإيمانها بدور مستحضرات التجميل في تحسين الوجوه، بل وتغييرها. وهي تجد في كل زبونة شقراء تعبيراً عن “الفئة التي ولدت من دون أخطاء، وكل ما فيها يصرخ بالجمال والروعة” (ص 70). ولا يختلف الأمر كثيراً عند “جوان” في رواية “لأني أسود”؛ إذ تجد الجمال في البشرة البيضاء التي لا تحتاج إلى تبييض، وفي الشعر المسدل الذي لا يحتاج إلى تصفيف، وغير ذلك من فوارق بين الأنثى البيضاء والأخرى السوداء. إن أصداء القضية ذاتها تتردد عند نيلا لارسن في رواية “عبور”، من خلال البطلة “آيرين ردفيلد” التي تغبط صديقتها “كلير كندري” على بياضها الأخاذ، وشعرها الأشقر. فحين يسألها أحد أصدقائها الزنوج عن اسم صديقتها الجميلة الشقراء، تقول في سرها “وقد كانت كذلك بالفعل. كلير، جميلة وذهبية، مثل يوم مشمس” (ص 137). الأمر ذاته يعلن عن وجوده عند توني موريسون في رواية “أكثر العيون زرقة”، التي تلفت الانتباه من خلال الطفلة السوداء “بيكولا”، إلى التأثير السلبي للنظام الثقافي الغربي المهيمن على السود؛ إذ يبرز الصراع النفسي للبطلة بين واقع الحال والمستوى المثالي للجمال. “فقد أجمع الكبار والبنات الأكبر سناً والمتاجر والمجلات والصحف ولافتات واجهات العرض، والعالم كله، على أن الدمية ذات الشعر الأشقر والبشرة الوردية هي ما تعده كل بنت كنزاً” (ص 20).
تبرز العلاقة الوثيقة بين اللون والجمال والقيمة الاجتماعية؛ ليظهر السرد اللون الأبيض بوصفه لون الرفعة والشهرة. فعلى سبيل المثال إن البطلة “جارية” تسبغ اللون الأبيض المجازي على الأميركية “أوبرا وينفري” التي استطاعت أن تصبح إحدى أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم، على الرغم من سوادها، في مجتمع يقدس الجمال الأبيض ويتشبّع بمعاييره “أضع مجلة (أوبرا) فوق بقية المجلات وكأني أبرهن بذلك على احترامي الكامل لما أصبحت عليه على الرغم من سواد بشرتها” (ص 34). كذلك الأمر فإن علاقة اللون والمظهر بالقيمة لا تقف عند حد معين في رواية “أكثر العيون زرقة”، بل تنسحب على ارتباط اللون بالقيم والمثل العليا، إلى درجة تقديم صورة الخالق في حلة بيضاء؛ ليظهر السرد أقصى درجات التطرف العنصري “الرب رجل أبيض، عجوز، لطيف، له شعر أبيض مسترسل، ولحية بيضاء ممتدة، وعينان زرقاوان صغيرتان تبدوان حزينتين عندما يموت الناس، وقاسيتين عندما يكون الناس سيئين” (ص 134). أما الشيطان فهو رمز الشر والقبح وأمير الظلام. إنه “القوي الأسود، الذي يحجب الشمس، ويتأهب لكسر العالم” (ص 134). فاللون الأبيض إذن هو رمز النقاء والصلاح، واللون الأسود هو رمز الشر والخطيئة. وبذلك يميل السرد إلى إبراز الجمال بمعانيه وقيمه كلها مرتبطاً باللون الأبيض في الرواية، أما القبح فيلصقه باللون الأسود. وفي ذلك كله تفوح رائحة صراع الحضارات النتنة، لا نسائم حوار الحضارات العليل. إن تلك الأوصاف خليقة أن تشجع العنصرية وتلهب نيرانها.
يقدّم السرد في رواية “لأني أسود” أسرة البطلة “جوان” بوصفها أنموذج القبح الأميركي على حد تعبير البطلة، ويقدم عائلة صديقتها “ميليسيا” بوصفها الأيقونة الزائفة للعائلة الأميركية التي تطابق كلياً من الخارج، الصورة البيضاء التي يرغبون في ترويجها للعالم؛ إذ يحفل مكتب “ميليسيا” الأنيقة النظيفة بالصور العائلية الرائعة، كما في إعلانات شركة “كوداك” تماماً. تسرّ جوان لنفسها بنبرة حزن “كيف أجرؤ على توثيق علاقتي بميليسيا؟.. هي صورة عن الجمال الأميركي، وأنا صورة عن قبحه” (ص 35)، ثم تظهر المفارقة في صورة منزل ميليسيا الصغير المتهالك، وممره النتن؛ إذ “تضطر (ميليسيا) أن تسد فتحات أنفها الصغير عند اجتيازه، كآخر طقوس الأناقة التي تمارسها منذ أولى ساعات الصباح إلى أن تعود إلى شقة لا تقل عفناً ونتانة عن ذلك الممر المفعم بالأجواء (الهيبية)” (ص 39). كذلك الأمر فإن موريسون تقدم أسرة بيكولا بوصفها نقيض العائلة الأميركية المثالية البيضاء، من حيث التوافق مع معايير الجمال والسعادة؛ فبطلة الرواية بيكولا تعتقد أنّ قبحها لا يتعلق بها بصورة خاصة، بل “جاء من اقتناع أفراد الأسرة كلها بأنهم قبيحون جداً،… لقد رأوه مؤكداً يطل عليهم من لوحات الإعلانات كلها، من كل فيلم، وكل نظرة” (ص 39). ويبرز السرد في الرواية صورة الأسرة المثالية والجمال المثالي من خلال “جين” وأسرتها، فهي شقراء مثل والدها وأمها وأختها الصغيرة أيضاً، ويحظون باحترام الجميع ويعيشون بسعادة لافتة لا حد لها. في إشارة مواربة من الكاتبة إلى الأنموذج الزائف للعائلة الأميركية التي تحتضن قيم المجتمع المهيمن وتطابق كلياً الصورة البيضاء التي يرغبون في ترويجها للعالم.
ضروب الاختلاف
تظهر رواية “لأني أسود” مغايرة للنسق الثقافي، في محاولة تنصّل البطل “جمال” من الصورة النمطية الانتقاصية التي رسمتها له المواضعات الاجتماعية والثقافية، فيسعى جاهداً إلى قلب معايير التفوق، ووضع ذاته موضع الفخار؛ فيسعى إلى هدم التمثيلات الجاهزة حول الزنوج، وبناء تمثيلات جديدة تسعى إلى رفع الحرج عن الملونين داخل مجتمعاتنا “بعد سنوات الجهاد تلك أصبحت أحقهم بالبعثة الدراسية.. ولأني اكتشفت أن السوق الفني يصر على حكر لون بشرتي بأدوار الشر والعبودية، قررت أن أصبح مخرجاً، أن أكون الفارس لا الحصان” (ص 62). في المقابل تعبّر “كلير” في رواية “عبور” عن رغبة الانسلاخ عن الصورة النمطية الانتقاصية المرسومة للسود والقيم التي ألصقها الأميركيون بالهوية السوداء من خلال التنكر لذاتها والمضي نحو انتماء مصطنع، بادعائها أنها امرأة بيضاء الأصل.
صحيح أن الكاتبتين منيرة سوار وتوني موريسون لم تعمدا إلى ربط السواد بالجمال؛ أي لم تقترحا حلاً جمالياً يهدف إلى الاقتناع باللون الأسود، بوصفه حلاً بديلاً يمكن له منافسة اللون الأبيض، لكننا نلحظ اختلاف الرؤية السردية لكل منهما إزاء مشكلة السواد. فالاقتراح الذي تقدمه “سوار” في رواية “جارية” يكمن في تجاهل تأثيرات اللون الأبيض برموزه وإسقاطاته وإجراء بعض التغييرات اللونية حولها، الهادفة إلى كسر سطوة اللون الأبيض؛ إذ تخرج البطلة من سيطرة هذا اللون في صالونها “بدأت أشعر بالضجر من دوراني بين اللونين الأبيض والأسود، فاشتريت هذه اللوحة التجريدية التي يغلب عليها اللون الأحمر” (ص 181). أما توني موريسون فلا يبدو أنها ترى بأن ربط السواد بالجمال هو أفضل طريقة لتقدير التقاليد الأميركية الأفريقية. فهي تطرح حلاً بديلاً يتمثل بالفخر العرقي والاتصال بجذور الأميركيين الأفارقة. ويمكن تحقيق ذلك بنجاح أكبر من خلال مواكبة التقاليد، مثل الموسيقى (موسيقى البلوز، وموسيقى الجاز على سبيل المثال)؛ إذ يُلحظ ذلك في الرواية من خلال شخصية “كلوديا” التي “تستقي من التقاليد السوداء باستمرار من خلال الاستماع إلى موسيقى البلوز مع والدتها، وبذلك تمكنت من البقاء والنمو بحال جيدة في الرواية (Identity, Race and Gender in Toni Morrison’s The ) Bluest Eye). وفي رواية “لأني أسود” يعيد السرد الاعتبار لسواد الرجل بوصفه قيمة جمالية؛ إذ يظهر انبهار البطلة جوان بالممثل العالمي الأسود دينزل واشنطن “تفحصت الصورة في مخيلتها.. توقفت عند سواده الأخاذ.. ركنت رأسها على زجاج الحافلة وراحت تحلم” (ص 33). كما تقدم الكاتبة نيلا لارسن اقتراحاً مختلفاً بوقوفها على منابع الجمال في كلا النمطين: الأبيض والأسود، والنظر إلى التآلف الحاصل بالجمع بينهما “عينان سوداوان تتموضعان في الوجه العاجي، تحت الشعر الأشقر الفاتح… لقد كان جمال كلير كندري أمراً محسوماً عصياً على الاعتراض، بفضل هاتين العينين اللتين أعطتهما إياها جدتها، ثم بعد ذلك أمها وأبوها” (ص ص 45 – 46). فالبطلة “كندري” تجمع بين معايير الجمال البيضاء وبعض عناصر الهوية السوداء التي تتضافر معها بصورة لافتة من دون أن تنقلب عليها.




