الحبيب السايح: الصحراء جنّة الكلمات

يطرح الروائي الجزائري الحبيب السائح في هذا اللقاء مع مجلة “الجديد”، العديد من المواضيع منها خاصة هاجس الكتابة عن اليهود الذي أفرد له عمل روائي صدر العام الماضي “أنا وحاييم”، حاول أن يلتقط فيه التفاصيل والوقائع والعلاقات القائمة بين يهود الجزائر والمسلمين، وكيف كانت العلاقة بينهما خاصة أثناء الحرب التحريرية، وينظر أيضا في هذا اللقاء في مكانة المتن الروائي الجزائري ضمن متون عربية ودور الجوائز وإسهامها في التعريف بالكاتب وغيرها من المواضيع.
الحبيب السائح كاتب جزائري من مواليد منطقة سيدي عيسى ولاية معسكر. نشأ في مدينة سعيدة، تخرّج من جامعة وهران (ليسانس آداب ودراسات ما بعد التخرّج). اشتغل بالتّدريس وساهم في الصحافة الجزائرية والعربية. غادر الجزائر سنة 1994 متّجها نحو تونس حيث أقام بها نصف سنة قبل أن يشدّ الرّحال نحو المغرب الأقصى ثم عاد بعد ذلك إلى الجزائر ليتفرّغ منذ سنوات للإبداع الأدبي قصة ورواية.
من أعماله القصصية: القرار/ الصعود نحو الأسفل / البهية تتزيّن لجلادها / الموت بالتّقسيط. وفي الرواية له: زمن النمرود / ذاك الحنين / تماسخت / تلك المحبّة / الحنين / الموت في وهران / كولونيل الزبربر / أنا وحاييم. وترجمت لـه إلى الفرنسية: ذاك الحنين وتماسخت.
الجديد: كيف تعيد قراءة مسارك الروائي؟ كيف كانت البدايات، كيف تجلت؟ ما الذي أوقفك على درب الكتابة المضني؟
الحبيب السايح: أعترف أنه سكنني، ولا أدري منذ متى ولا كيف هاجس أن أصبح يوما صحافيا أو كاتبا أو ممثلا، حيث مثلت في مسرح الهواة عندما كنت في العشرينات من عمري. انضممت إلى جريدة الجمهورية لإعداد ملحق “النادي الأدبي” (مع المرحوم بلقاسم بن عبدالله). ثم كتبت أولى قصصي القصيرة وفزت بجائزة القصة والشعر التي كانت تنظمها وزارة التعليم العالي في السبعينات. وقد كان الحدث حافزا كبيرا لي على مواصلة الكتابة القصصية، والتي وجدت بعد فترة، أن فضاءها لم يعد يسمح لي بأن أكتب ما هو أوسع مما يسمح به؛ وهو فضاء، في الحقيقة، صارم جدا منه تدربت على صياغة الجملة السردية. وقد لا أكون الوحيد، من جيلي، الذي خرج من فضاء القصة القصيرة إلى فضاء الرواية. بل أؤكد أننا (جيلي) كتبنا القصة القصيرة قبل انتقالنا إلى كتابة الرواية. وكان هذا، في تقديري، مرتكزا صلبا كنا سنبني عليه نصوصنا الروائية.
ثم، إن ما قد يكون أوقفني على درب الكتاب، كما تقول، المضني فعلا، هو قراءاتي منذ المراهقة التي كانت، بلا إنكار لذلك، تدْخل في حوار مع ما كنت أحفظه من القرآن، ولاحقا مع كنت سأقرأه من النثر العربي ومن الشعر ومن التراث الإسلامي في مجمله، العقلاني منه خاصة. مما شكل لديّ ذائقة لغوية ذات خليط باهر سيطعّم بما كنت سأطالعه باللغة الفرنسية. فأنت ترى أن هناك عوامل كثيرة قد تجتمع لك في مسارك لتوجهك نحو غاية كنت ترغب في الوصول إليها. وها أنا اليوم، بقدر ما تكلفني إياه كتابة الرواية من شقاء عصبي وتعب جسدي، أشعر بغبطة لا تنقطع لأني أعيش أحد أحلامي الثلاثة.
التجربة، المخاض
الجديد: هناك سمة تكاد تكون ملازمة لتجربتك الروائية هي هذه العناية المفرطة باللغة ونحتها وصقلها وتقديمها للقارئ في نص باذخ يحتفي باللغة.. كيف تشرح هذا النزوع وهذا الاقتراب؟
الحبيب السايح: لعل في الإجابة أعلاه بعض العناصر التي تشرح الأمر. أحب، فحسب، أن أضيف أني مسكون بلغة القرآن، في بلاغتها وفي جملتها النحوية، ولكن أيضا ـ وهذا هو الباهر لي ـ نظْمها وإيقاعها. وإذا أضفت إلى ذلك الشعر العربي في استعاراته ثم ألف ليلة وليلة في توليد الحكاية وسردها، والرواية الكلاسيكية الروسية والأميركية والفرنسية في بنائها وزخمها وسعة فضائها والرواية العربية مع روادها الذين تعلمنا منهم التواضع والاختلاف وأخيرا رواية أميركا اللاتينية التي كانت “الصعقة” التي لم تترك أي كاتب عربي لم تهز كيانه، سيحصل لديك، بالتأكيد، ما يضعك أمام خيار واحد ووحيد: أن تكون أنت في لغتك وفي تراكيبك كما في انتقاء موضوعاتك وهي مجتمعةً تشكل بصمتك. فمن هنا ما يضني. ومن هنا ما يشقي. ولكن بالرغم من ذلك ما يمنح قلبك غبطة متجددة. ويوفر لك حرمة لدى قرائك.

الجديد: أنت روائي مهجوس بالصحراء كيف كتبتها، وما علمتك الصحراء؟ كيف يمكن أن تفهم من يقول إن الرواية هي بنت المدينة، هل يمكن أن نقول إن هناك كتابة للصحراء؟
الحبيب السايح: أحب في البدء أن أحدثك عن علاقتي بالصحراء. هنالك، في الجنوب الغربي الجزائري، في حاضرة أدْرارْ، شاءت لي العناية أنْ حررت سمعي وبصري وبقية حواسي لأدخل جنة الأصوات والكلمات والألوان والأنوار فأسمع صمت الأمكنة الناطق بظل الإنسان الذي مرّ، الذي يمرّ، وأقف على بقايا أثره في الطوب والماء وفي الخضرة والورق كما في الخيط النوراني الرابط بين الأرض والسماء؛ فاكتشفت أن فضاء صحراء أدْرارْ لا يشبهه فضاء صحراء أخرى.
تلك كانت علاقتي الجسدية والروحية بصحراء أدرارْ، المكْرمة القصوى التي حبتني إياها العناية. فانخزل لي كونٌ شاسع من العلامات التاريخية والأنتروبولوجية والإتنية والمعمارية والثقافية والفلكلورية والروحية متعددة الأبعاد المتوجهة بضياء المحبة. محبة لا تمنحك إياها غير صحراء أدْرارْ.
وكنت، لذلك، وقفت يوما، في صمت واحة تيميمون، نحو قصر أولاد سعيد. ويوما آخر في سكون حْمادة آولف نحو قصر أقبلي. ويوما ثالثا على عرْق عين بودة المباركة. فسألْتُني كل مرة: بأيّ لغة أواجه هذا الفضاء الفاتن؟ كيف أعيد تخييل أدرارْ الأخرى المتحركة في الذاكرة والوجدان والبصر عبر متاهات القصور والقصبات ودهاليزها ومجاري فگاراتها تحت الأرض وسواقيها إلى بساتين النخيل الشاهد من خلف الطوب، وهذا الوهج المتخلل لكل شيء، وهذا السرّ الذي يتابعك حيثما حللت إن أنت استدرت لتكتشفه ألْفيتَه تحول سرابا!
ذلك كله، كان يستدعي لغة فائقة الدلالة: لغة المخطوطة؛ المخطوطة التي، في أدرارْ، لا تزال لها مهابة من القدسية؛ لغة القرآن في نظمه، والسيَر، والسرود الشفهية المحملة بالأسطوري المشحونة بالخرافي؛ لغة رجل الرمل بلكنتها الآسرة، لغة الكتاب المقدس بما ترنّمه يوما نشيد الإنشاد. وفوق هذه اللغات كلها لغة الرواية التي تنتهي إليها كل لغة.
كانت التجربة القصوى، بالنسبة إليّ، في صحراء أدْرارْ، أن أجيب عمّا يلي: إن كان فضاء الصحراء بهذه الشساعة والسر والصمت، والخوف أيضا، والسحر، والحب، فكيف ينبغي لعالم رواية، فيها، أن ينشأ، أن يكتب على درجة ذاك الفضاء نفسها؟
ثمة، كان سيكون البدء لسرد يتأسس على إيقاع فضاء أدرارْ كلها؛ لا نقلا عنه ولا تبديلا له، بل إضافة له ليصبح المكتوب هو الفوقي، الجميل، الباقي، الدال على الحياة، البديل عن الزائل.
تلك كانت الضريبة القاسية التي تطلّبتها ضرورات ميلاد نص جديد متماه مع المحكيّ المحلي بحمولاته كلها مفارق له في قدرة استيعابه العلامات وفي أسلوب نقلها إلى لغة الرواية، متقاطع، في ذلك، مع المخطوطة مضيف إليها رونق البلاغة الجديدة وصرامة النحو والصرف.
لذلك، تحتّم الاستناد إلى خيارات بنائية وقاموسية وبلاغية تعكس طبيعة التيمة: المحبة في أبعادها الإنسانية، ما فوق التقسيم الديني، والصوفية في إشراق أنوارها على كائنات الصحراء كلها: البشر والطير والشجر والحشرات والماء والرمل والشمس والقمر.
فكل كتابة لي لاحقة، منذ 1994، كانت ستكون بنفحة من تلك اللغة التي علّمتني صحراء أْدرارْ إياها. وكان كل نص جديد سيروح هو السرير المائي المتجدد، الذي أحس روحي يتهدهد عليه، كما في البدء، كما في روايتي “تلك المحبة”.
هوسي بالصحراء ليس إلا انشغالا بهذا الفضاء البديع الملغز والساحر. دخلت أدرار أحمل خوفي ورعبي وهواجس موتي. فبدّلتني أدرار ذلك كله أمنا وسكينة وأملا، لذلك، وكاعتراف مني بذاك الجميل الذي أهدتنيه إياه العناية وبالحضن الإنساني الذي قابلني به أهل أدرار، منذ أن نزلت بينهم، كتبت لها “تلك المحبة”. أعتبر “تلك المحبة” أول نص سردي عن أدرار بحواضرها الثلاث: توات، گورارة وتيكلت، وهو لا يصف صحراءها في قفرها وجدبها ولكن في حياة إنسانها وفي ارتباطه بقدسية الماء وبالنبات كما في علاقته مع الله ومع الكون الذي يبدو لك متحركا في بعد آخر، غير الذي تراه في المدن. فإن أول ما شدني، من ذلك، هو شعوري بأن الله أقرب إليك من كل شيء تراه عينك، من هنا علمتني صحراء أدرار أشياء، لا تعلمك إيّاه جغرافيا أخرى، فهي الصبر والتأمل والمحبة.
صحيح أن الرواية، في جوهرها، إنتاج المدينة. وهندستها هي هندسة المدينة في معمارها وفي حركيّتها وفي علاقاتها البشرية. وأدرار المدينة، الآن، هي جزء من تمنطيط المدينة القديمة الباقية إلى اليوم، مثلها مثل تيمي.
أعتقد أن هناك كتابة عن الصحراء، وهي قد تكون كتابة ناقلة عنها للغير بطاقة بريدية. وهي كتابة عابرة. وأن هناك كتابة في الصحراء ومن الصحراء. وهذه كتابة بدأت تؤسس شيئا فشيئا في أدرار، التي لم تعرف السرد القصصي أو الروائي إلا منذ فترة قصيرة جدا.
أنا وحاييم
الجديد: في تجربتك الأخيرة تعايش اليهودي مع المسلم؟ ما هي حدود هذا التعايش.. كيف لمسته؟ ما الذي يمكن أن يجمع حسبك بين هذين المتنافرين؟ هل برأيك يمكن للرواية أن تضع مفهوما جديدا أو تبني علاقة جديدة تاريخية بين اليهودي والمسلم في ظل ما يعرف الآن من صراع وجوّ مشحون وفي الكثير من الأحيان دموي بين الاثنين؟
الحبيب السايح: في رواية “أنا وحاييم” سعيت إلى إظهار العلاقة التي يمكن أن تربط إنسانا إلى إنسان آخر من وطن واحد على ديانتين مختلفتين. وكم كان ذلك، بالنسبة إليّ، مثيرا! فبحسب ردود أفعال القراء بدا أن “أنا وحاييم” بلّغت الرسالة التي عملتُ وأردت لها أن تصل.
لم تكن هناك حدود تعايش فاصلة، إتنيا ودينيا بين المسلمين وبين اليهود في الجزائر، قبل الاحتلال وقبل قانون “كريميو” (1870). فأنت إذ تعود إلى تلك الفترة وحتى عشية حرب التحرير لا تجد هناك فرقا واضحا بين الطائفتين في الجيرة وفي اللغة واللباس والغناء؛ خاصة عند اليهود الجزائريين أصلا. إنما الذي كان سيحدث الشرخ هو قانون “كريميو” وهو أيضا الحركة الصهيونية التي نشطت في الجزائر غداة نهاية الحرب العالمية الثانية وخلال حرب التحرير لتهجير اليهود الجزائريين إلى فلسطين التي كانت احتلت في 1948. وبرغم ذلك، وكما تناولته رواية “أنا وحاييم” بقي في الجزائر يهود من أصول جزائرية أو يهود من الأقدام السوداء شاركوا في حرب التحرير. فمنهم من استشهد ومنهم من نفي أو سجن بعد الاستقلال لمعارضته انقلاب 1965، مثلهم مثل بقية الجزائريين. هذا ما تقوله، أيضا، رواية “أنا وحاييم”.
ما يمكن أن يجمع بين يهودي وبين مسلم هو الإنسانية، لأننا جميعا أبناء آدم، كما تقوله الرواية نفسها. الإنسانية التي تقاوم الميز على أساس الدين أو العرق وتناهض الاحتلال وتتبنى تقرير مصير الشعوب. فما يباعد اليوم بين اليهود وبين المسلمين ليس هو الدين بل هو احتلال فلسطين وتسليط القمع غير المسبوق على شعبها الصامد وممارسة الأبارتايد بحقه.
هناك توجه واضح في الأعوام الأخيرة من الروائيين العرب نحو إثارة موضوع العلاقة التاريخية أو القائمة اليوم بين اليهود وبين غيرهم في البلدان العربية وفي فلسطين المحتلة. وهي علاقة تكذب وتفند الأطروحات الصهيونية حول استحالة التعايش بين اليهود وبين العرب مسلمين ومسيحيين وغيرهما في البلدان العربية نفسها، وما يجري اليوم بشأن فلسطين ليس صراعا دينيا، حتى ولو كان الإسرائيلي يتأسس على أيديولوجية دينية وحتى لو كانت بعض المنظمات الفلسطينية تتأسس هي أيضا على أساس ديني، بل هو صراع تحرري وسياسي حول الأرض تندمج فيه من الجانب الفلسطيني كل الأطياف العلمانية منها وغيرها.
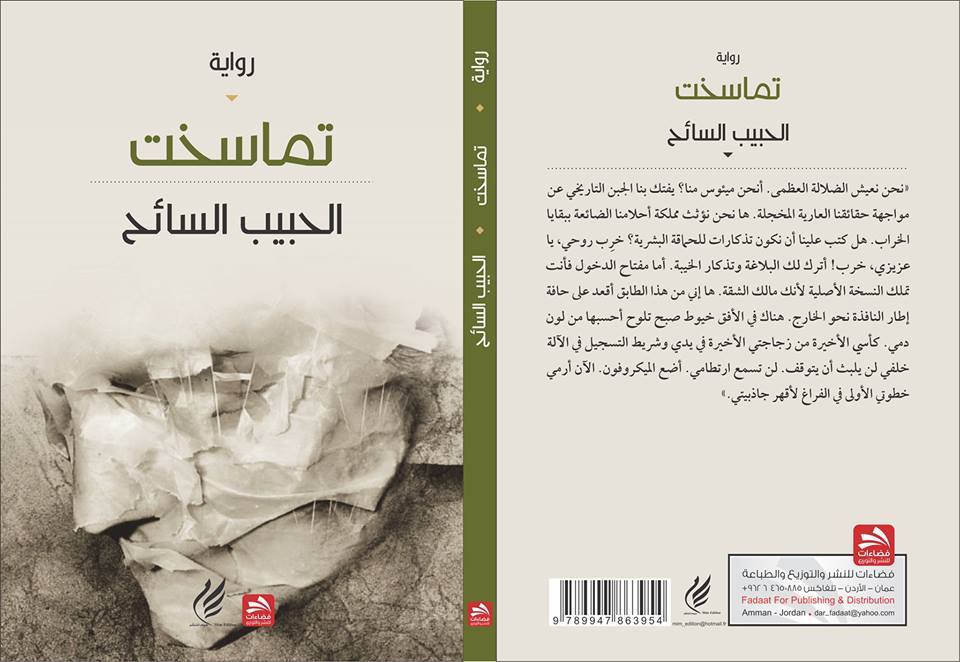
الجزائر مسرح الكتابة العنيفة
الجديد: حدث ما حدث في الجزائر من موت وعنف وإرهاب وجاء على نخب وكتاب وإعلاميين وكنت من الكتّاب الذين فككوا هذه الأحداث العنيفة التراجيدية خاصة في روايتك “كولونيل الزبربر”.. نحن الآن على مسافة من تلك الحقبة الأليمة.. كيف تراها الآن من موقعك كروائي تناولها ومنحها عددا من الأعمال.. كيف تقرأ ما كتب عنها هل أحاطت بها وشخّصتها ووضعتها في مكانها التاريخي؟
الحبيب السايح: في رواية “كولونيل الزبربر” كما من قبلها في رواية “تماسخت” ورواية “مذنبون لون دمهم في كفّي”، عملت، بعد أخذ مسافة، حتى لا أقع في الاستعجالية، على أن أنظر إلى تلك الوقائع بعين الشاهد الذي يتذكر ما حدث؛ لأني كنت أعيش، كباقي الجزائريين، في خضمّها؛ وعلى أن أنقل ما ترتب عليها من آلام عميقة وخسائر فادحة، من غير أن أدين. فقد سجلت شهادات، فحسب، ضمّنتها أسئلة طرحتها على الضمير الإنساني تتعلق باغتصاب حق الإنسان في الحياة وانتهاك كرامته وتدنيس حرمته. وأنا اليوم أشعر بنوع من التحرر من مسؤوليتي ككاتب شاهد على ما وقع، لأني هزمت ترددي وكنست كل حساباتي عما يعتبره بعض الكتاب “خسارة وربحا” في التقدير حين يتعلق الأمر بموقف سياسي أو إنساني أو أخلاقي. فإني كنت أمام ضميري عاريا. ولأني أعرف أن تاريخ الشعوب الحالي تكتبه الرواية. غير أنه لا بد من ذكر أن تلك المرحلة التراجيدية لم يكن من السهل مقاربتها روائيا؛ نظرا إلى طابعها المركب والمعقد وسيرورتها الدموية باهظة الثمن. ومن ثَم، وفي ندرة الكتابات السوسيولوجية وقلة التحقيقات الصحافية وغياب الدراسات الجامعية التي أنجزت عنها وكذا سرية أرشيفاتها، لا يتسع المجال بدرجة الزاوية التي تستطيع الرواية الجزائرية من خلالها أن تنظر إلى ما حدث بشكل حيادي وأن تتناول آثاره النفسية خاصة على جيل بأكمله.
الثورة والقلق
الجديد: العديد من الكتاب في الجزائر ما زالوا ينهلون من الثورة وتوابعها، لم يخرجوا بعد من عباءتها حتى أن هناك من يقول إنها استنزفت الخيال ورمت به في الملل والتكرار. هل تعتقد أن تيمة الثورة ما زالت منبعا لا ينضب مع كل ما حدث في واقع الجزائر من تحولات وانقلابات وغيرها؟
الحبيب السايح: بصدق، لا أعتقد ذلك. فحرب التحرير فعل ملحمي عظيم راسخ في الوجدان ومعتمل في الذاكرة الجماعية. وهو أحد روابط الضمير الجمعي. لذا فهي، فعلا، منبع استُمدّت منه أعمال أدبية وفنية (سينما، تلفزيون، مسرح وتشكيل). وهذا غيض من فيض، كما يقال. لأن الكتابة، روائيا، الآن عن حرب التحرير تقتضي كثيرا من المعرفة والبحث ومن الشجاعة خاصة لتناول المسكوت عنه والمحظور وما لم يقله المؤرخ وما رسّخه السياسي خدمة له ولنظامه. الكتابة عن ثورة حرب التحرير فعل يضعك في مواجهة مباشرة مع العتمة التاريخية. وحينها أنت ستكون مخيرا بين أن تذهب في عمقها تحمل في يدك ما ينير المسلك وبين أن تكتفي باليقينيات المعلقة على بابها. هنا يكون الفرق بين كاتب وآخر. كاتب مكتفٍ بتلك اليقينيات واصف. وكاتب مسكون بالقلق مُسائل.

متون الرواية
الجديد: كيف تجد متون النص الروائي الراهن في الجزائر خاصة وفي العالم العربي خاصة؟ ما هي علامات التقارب بينهما.. لماذا لا يحضر النص الروائي الجزائري إلا فيما ندر؟
الحبيب السايح: تلك المتون، بحسب ما أطالعه، نابعة من كثير من الأسئلة التاريخية المعلقة ومن الهموم الوجودية ذات الصلة بالتحولات الجارية في الجزائر، منها على الخصوص ما خلفته المحنة الوطنية من رضوض نفسية في الأجساد والروح والذاكرة. وهي متون توسع، كل يوم، من انتشارها أفقيا. واستطاعت أن تحتل لها مساحة مهمة في خاطرة السرد العربي المعاصر. وذلك بالنظر إلى تقهقر الرقابة الرسمية، بحيث أصبحت في الجزائر، رقابة بعدية، وإلى خرق الإنترنت جدار حدود البريد التقليدي، الذي غالبا ما شكل حاجزا رقابيا على النصوص الجزائرية المرسلة إلى الخارج للنشر (خاصة لبنان). إني أتحدث هنا عن تجربة شخصية عشتها.
أما عن التقارب فإنه، برغم الخصوصيات التاريخية والثقافية والاجتماعية لكل بلد عربي، يبدو اليوم واضحا جدا؛ ذلك لما جرى ويجري في العالم العربي من تحولات سياسية عميقة منذ عشرين سنة، فإنه يكفي أن تطّلع، مثلا على عينة من الروايات الصادرة، في الأعوام الأخيرة خاصة، لتتبين الاهتمام المشترك، غالبا، بالتاريخ وبالعلاقة مع الآخر وبالحريات وبالهويات.
وأما حضور الرواية الجزائرية، كنص فارق ومتميز، فإنه أصبح اليوم قائما وبشكل لافت في دور النشر العربية الكبرى أيضا وفي المكتبات. وهو يكسب له مزيدا من القراء في العالم العربي.
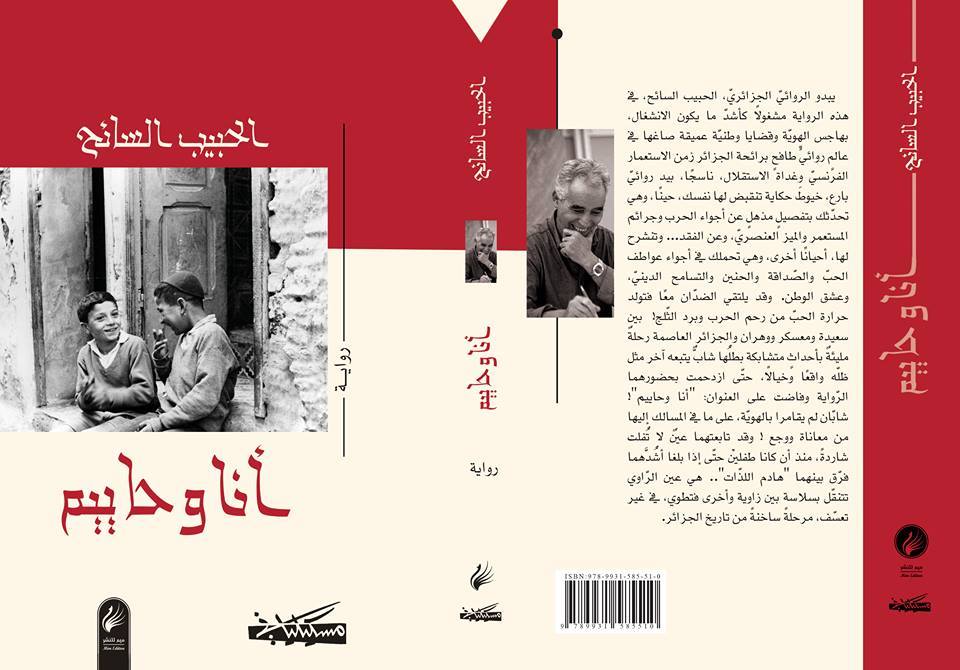
غياب النقد
الجديد: لماذا لا يواكب النقد هذه المتون.. هل تراه غائبا أم مغيبا أم مترفعا على الخوض في تفكيك النصوص الروائية الراهنة؟
الحبيب السايح: أعتقد أن الانبهار بالمناهج النقدية “التقنية”، كالبنيوية، غرّب المهتمين بالدراسات الأدبية عن النص الأدبي بصفته قيمة جمالية وأخلاقية وإنسانية. الأمر الذي أحدث هوة زمنية كبيرة بين المهتم أو الناقد أو الدارس وبين النص الروائي الذي يصدر بشكل دوري ومتواتر ويتطور ويخرج بذلك عن المعايير التي في منظومة الناقد. هذا يدعو إلى مراجعة للنفس وإلى تحيين المعارف وترهينها لتكون في انسجام مع ما يطرحه النص الروائي الجديد. ففي الجزائر، يمكن لك أن تجرّد النصوص الروائية ذات القيمة الصادرة خلال عام وتتابع حظوتها من المتابعة الإعلامية والنقدية فلا تجد إلا نادرا خبرا ثقافيا عنها هنا ومقالة متابعة يتيمة هناك. وهذا أمر محزن جدا. ولأكون واضحا أمثل لك: رواية “أنا وحاييم” (2018، عن مسكيلياني وميم) نفدت خلال عام طبعتها العربية وكذا (لا ريب) طبعتها الجزائرية. ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر. وفازت بجائزة كاتارا؛ من غير أن تحظى بمقالات نقدية في الجزائر (إلا ما كتبه عنها الناقدان والدارسان. د. آمنة بلعلى. و.د. لونيس بن علي. و.أ. عطاءالله نصر الدين. والروائي الصديق واسيني الأعرج!). إني، هنا لا أتحدث عن الرسائل الجامعية والأطروحات التي أنجزت حولها، وهي معتبرة، لأن هذا لا يندرج ضمن النقد وإنما البحث.
الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية
الجديد: كيف ترى التنوع الثقافي في الجزائر. كتاب الرواية باللغة الفرنسية مثلا، هل يمتلكون خصوصية ما تحفر في عمق المجتمع الجزائري الثري، هل تراهم غرباء عن مجتمعاتهم مثلما يعتقد الكثير لكونهم يتنفسون بلغة المستعمر بكل محمولاتها الثقافية والحضارية. ثم كيف تقيم أولئك الكتاب الذين انتقلوا من الكتابة باللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. كيف تصنفهم نقديا؟
الحبيب السايح: قبل أن يظهر جيلي، كانت الرواية المكتوبة بالفرنسية في الجزائر هي السائدة والرائدة. واليوم يتأكد أن المشهد تغيّر كليّة لصالح الرواية المكتوبة باللغة العربية، لأسباب قد لا يكون هذا مجالها. ولكن من الموضوعية القول إن جيلي يحمل إرثين: إرث الكتّاب الجزائريين باللغة الفرنسية المؤسسين للرواية الجزائرية (كاتب ياسين ومحمد ديب) في مواجهة رواية الأقدام السوداء. وإرث مؤسسيْ الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية (عبدالحميد بن هدوقة والطاهر وطار). فالكتابة بلغة المستعمر كانت كتابة مواجِهة لآلة هذا المستعمر الأدبية والأيديولوجية. وهي التي كانت ستثري السرد اللاحق بالعربية. وكانت روايات جيل الكتّاب باللغة الفرنسية المرافق لجيلي ذات صلة وثيقة جدا بالمجتمع الجزائري لأنها اشتغلت على خصوصيته وتاريخه وهويته. أما بعض الكتّاب الجزائريين الذين صاروا يكتبون بلغتين (عربية وفرنسية) ـ حتى لا أقول انتقلوا إلى اللغة الفرنسية ـ فإني أحترم خيارهم.
الجوائز الأدبية
الجديد: هل يمكن أن تساهم الجوائز في ترقية النصوص الروائية؟ وهل تراها نافعة للكاتب في ظل تهافت من هب ودب على الكتابة. لماذا تتهم الجوائز بأنها خرّبت عالم الرواية وبأن همّ الروائي الآن هي الفوز بأيّ جائزة مع التخلي عن صرامة الكتابة وروحها؟
الحبيب السايح: بالتأكيد! إن الجوائز العربية ذات القيمة الاعتبارية والمالية أيضا تسهم بشكل كبير في انتشار الكاتب أفقيا وفي توسيع مساحة مقروئيته، كما في لفت أنظار المهتمين إليه. لعله الأمر الذي صار يغري الكثير من “المتهافتين”، كما تقول. ولكن، ومهما يكن من أمر اللجان المشرفة على تلك الجوائز من أخذ ورد بخصوص تحكيمها الذائقة الفردية غالبا وفي الخط الذي ترسمه هيئة الجائزة لنفسها، فإن نتائج تلك الجوائز تسفر غالبا عن نصوص تستحق؛ وهي بذلك تقصي غيرها من “النصوص” المتطفلة.
وعلى كل، فإني أعتقد، وهذا ما أصبحت تدركه بلا شك هيئات تلك الجوائز، أن الكتابة لجائزةٍ ما هو خيانة لشرف الكتابة. الجائزة، في تقديري، هي آخر ما يفكر فيه الكاتب الذي يحترم نفسه؛ لأن همه هو التعبير عما يؤرقه من أسئلة الإنسان الوجودية والظلم والحرية والانعتاق.
التطور المهدد للتقاليد
الجديد: كيف تقرأ ما يحدث اليوم في العالم من تطور مذهل في مسار التواصل والحضور. الفايسبوك مثلا، هل تراه وسيلة تعويض نافعة للتعبير الحر. أين تقف عند الانتشار الواسع للنصوص في هذا الفضاء؟ هل يمكنه برأيك أن يزيل الكتاب من منصة الحضور الملموس، وأنت كيف تتعامل مع الأمر؟
الحبيب السايح: أولا كل قراءة لتطور وسائط التواصل المذهل، فعلا، هي مهددة، كل لحظة، بالتجاوز؛ نظرا إلى الوتيرة السريعة جدا التي يتغير بها. إنه تطور مرتبط أشد الارتباط بالصناعة الإلكترونية الاستهلاكية التي تشهد منافسة شرسة من أجل السيطرة على إنسان هذا العصر وإخضاعه آليا لنظامها و”غذائها” واحتلال ذهنه وتكييف ردود أفعاله بما لا يترك له مجالا آخر للاتصال غيرها. إنه عصر الإنسان الآلي، الذي يتنازل كل يوم، عن حيز جديد من مساحة حريته ومن إنسانيته ومن التحديق إلى خارج ما تغمره به هذه الوسائط من الأخبار والصور الموجهة والمهيمنة.
ثانيا هناك، خطر حقيقي لا يتهدد الكتاب الورقي فحسب ولكنه يعصف بتقاليد القراءة التي توارثتها البشرية جيلا بعد جيل، والتي بفعلها ارتقى الإنسان إلى مراتب عليا من الأخلاق ومن التعايش ومن معرفة الآخر غيره؛ برغم ما خلّفته وتخلّفه الحروب خاصة. لذلك تدعو الضرورة إلى أن تعمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة على إيجاد وسائل وإجراءات للحفاظ على استمرارية فعل القراءة من الكتاب الأصلي أولا. إنه من مسؤوليات الدول العربية وواجباتها أن تدعم نشر الكتاب الورقي وتوزيعه، وأن تسنّ قوانين لفعل القراءة في أطوار التعليم كلها. إضافة إلى الفعاليات الموازية الموجهة للجمهور الواسع ضمن المراكز الثقافية ودور المطالعة العمومية والمعارض.
ثالثا شخصيا، لا أحس بمتعة القراءة إلا مع الكتاب الورقي فهو يُحدث لديك شعورا حميميا لأنك تلمسه بصفته حقيقة لها جسد ورائحة وروح هي الكلمات بالحبر، وليس بصفته شيئا افتراضيا إن انقطع التيار أو فرغت البطارية أو تعطل الجهاز فقدت الصلة به. إني لا أقرأ ما هو إلكتروني إلا لضرورة قصوى. وغالبا ما أسحب ما أقرأه ورقيا.
صدمة الحراك
الجديد: كيف وجدت الحراك الذي يسكن شوارع الجزائر اليوم، هل فاجأك؟ لماذا برأيك تجاوز الحراك النخب ولم يسمع لهم صوت متقدم في فهم وتحليل ما يحدث، كيف ترى الأفق والمسار والمستقبل؟
الحبيب السايح: منذ الـ22 من فيفري، وإلى اليوم، لا أزال تحت وقع الصدمة، وليس المفاجأة فحسب! ولغتي تكاد تعجز عن تلقُّف ما يجري في صوره وفي تمثلاته. إنه لا بد لها من مسافة زمنية كي تستوعب الدلالات الجديدة لهذا التحول الهائل. وهو شأن أصاب النخب كلها. وهو يفرض عليها التأمل. ومن هنا ضرورة انخراطها في السير نحو الأفق الذي رسمه الحراك لبناء مستقبل جزائر المواطنة والحرية والعدالة.

كلام الصورة: العلاقة بين العرب واليهود أصبحت موضوعا روائيا عربياً




