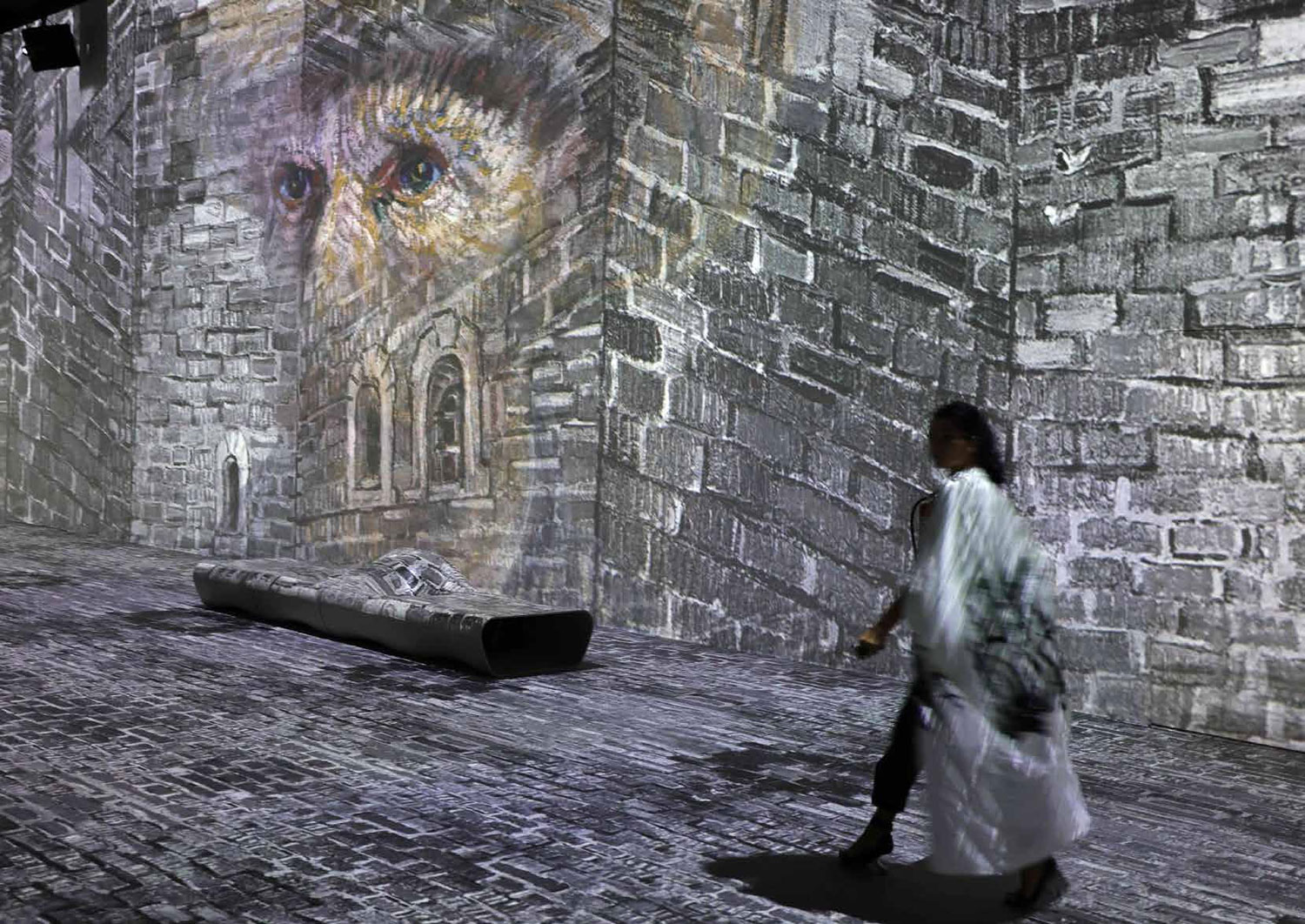الخوف كنْزُنا الباقي

” عندما خلَقت الآلهة البشر، فَرضَت عليهم الموت، واستأثَرتْ هي بالحياة“
(ملحمة جلجامش)
لو قدّر لي أن أرصد بذور الخوف الأولى في حياتي فسأقول إنها وجدت في قلب تلك القرية النائية في إحدى الجبال الرفيعة، جنوب السعودية،. لم يكن الخوف، آنذاك، مما نجهل فقط، بل ممّا نعرف ونسمع من أقاصيص وحكايات بعضها يرويها الآباء لكي لا يصبح الصغار فريسة سهلة للأنداد المتربّصين، وبعضها تنسجها الجدات والأمهات، ونحن نتقلّب بين أيديهن طلباً للنوم.
ما أن كبرنا قليلاً حتى جرى طرْدنا من دفء علّيّة الأم، وإيقاع يديها على ظهورنا إلى فسحة رحبة متعددة الأغراض في المنزل، يتحول في المساء إلى صالة نوم للأولاد الأشقياء، وربما في أيام أخرى مجلساً فسيحاً للضيوف حين يطرقون باب المنزل زائرين الوالد بحثاً عن لقمة طيبة، أو لمناقشات عارمة حول نزاعات أهالي القرية التي لا تهدأ.
الليل كان قلب الخوف، ومخزن قصص الرعب التي تسرّبت من أحاديث الآباء حول الجن الذين ينتظرون الصغار عند منعطفات القرية، والذئاب الثاوية في الأودية التي تهاجم فرائسها في الليل، والضّباع التي تتجول بحثاً عن طعام، كل هذه الكائنات يتوجب العيش معها واقعاً أو استيهاماً في ليالي القرية الكالحة التي لم يدخلها ضوء الكهرباء بعد، فيما تزيدها الرياح المسائية القارصة رُعباً.
تلك المخافات بقيت راسخة في أعماقي، وهي تعاودني على هيئة أحلام أو خيالات حتى اليوم، وهي تزداد حضوراً كلما تقدم بي العمر. والفرق يكمن ربما في أن حضور الخوف في أيام الطفولة كان كابوسياً بل ومحفّزاً لامتطاء أيّ لحظة تخرجني من عالم القرية وأشباحها، ومن وصاية الأب، ومن الوقت الراكد إلى الفضاء المطلق، فضاء المدينة والأحلام والرغبات في أوسع تجلياته، فضاء الحرية القصوى الذي سأنخرط فيه بكل ما أوتيت من قوة.
ربما كان ذلك هو الخوف الأبسط، الخوف الطفولي من كل قوة تسيطر عليك مادية أو خيالية، ورغم انغراس ذلك الخوف بأنيابه في روحك وذاكرتك، فلم تكن من حيلة سوى ردمه بين أحلامك الليلية، وربما أمكن علاجه بقراءة المعوّذات سراً كتميمة تحميك من غضب الخارج، أو الانغماس في نوم الإخوة الآمنين حول فراشك.
ولكن هل تبدد الخوف من طريقي؟ وحين تنفّست الصعداء وأنا أغادر قريتي فهل منحتني المدينة الأمان المنشود؟ بعض الباحثين الثّقاة يعتقد أن المدن العربية ما زالت قرىً كبيرة لأن بنائها الاجتماعي القائم اليوم لم ينجب مدناً حديثة على غرار المدن الكبرى، وأقول إن التباينات الحضارية ستبقى ماثلة ولا يمكن ردمها بالمزيد من العمارات الفارهة وحشد التقنيات المتقدمة.
فيما بعد، وحين اجتزت مرحلة الصبا عبوراً إلى جنّة الشباب، كان الخوف يتشظّى، وأصبحت موزعاً بين خوفين عصيبين: “الخوف من” و”الخوف على”. لست عالم سيكولوجيا لأتقصّى ما يفعله الخوفان بالإنسان، لكنني أعرف أن هذه المخافات يمكنها إحباط دوافع المرء وطموحاته، فهناك الخوف من وطأة قوانين المدينة وسلطاتها، ومن أناسها متعددي الألوان والمشارب والثقافات، وهناك الاصطدام بالأسئلة الكبرى حول الدين.. حول الوعي، حول التغيير الاجتماعي والثقافي الذي يعصف بالوطن، وكيف يتوجب على المرء بناء موقف ذاتي وهو يعبر تلك التقاطعات الحادّة. عشت وجيلي زمناً ونحن نقارع كل السلطات التي نعيش في ظلّها لكي تبقي لنا حيّزنا في اللغة لنكتب قصيدة أو قصة أو رأيا ما. كانت المفردات الغزيرة التي يتمتع بها أقراننا في دولنا العربية الشقيقة شبه محرّمة علينا، وعلينا أن نهيئ بدائلها. كانت الحرب على الحداثة وتاريخها وأفقها ولغتها معلنة وكانت منابر المساجد مكاناً جامعاً للإطاحة بكل أدب جديد، وكان هذا يبعث على الخوف والمقاومة معاً، وأتذكر أن صحفاً محلية حُجبت عن الصدور بسبب نشرها قصائد.
الخوف باقٍ لأنه يرتطم بالحقيقة الكبرى الباقية وهي: الموت. هذا معنىً أنثروبولوجي راسخ، ولكن إلى متى سيُصعّد الإنسان من خوفه ليصبح حجاباً حديدياً أمام المستقبل؟
لعل أعظم وأشقّ لحظة واجهها الإنسان منذ قرن هي “لحظة كورونا”، فقد تساوى أمام رعب ذلك الفايروس القاتل وبطشه كل الأمم الغنية والفقيرة على السواء، وكان على كل كائن بشري أن يحصد نصيبه من الخوف وأن يحسد الحيوانات لأنها كانت في مأمن من تلك العقوبة الجماعية. فكرت في اللجوء مجدداً إلى قريتي النائية هرباً من مدينتي المغلقة، لكن الميديا طغَت وتمكّنت من تسويق الخوف ليصل إلى كل الدساكر النائية في العالم وحتى بطون الأودية ومنابت الشجر.
كلنا كنا ننتظر ولادة دولة الحداثة والتقنية والعلوم لكي تكبّل مخاوفنا، ولكن ها هي تتكاثر وتسيطر على عقولنا ومستقبلنا وممتلكاتنا، وربما أصبحت بعض المنصات التقنية سلطات كاسحة، فهل قلّل ذلك من نسب الخوف في حياتنا؟
بكل أسى فإن أعناقنا في قبضة هذا الكون التقني الشرس، وعلينا أن نخاف أكثر!