الخوف من الخوف

مخاوف البشر غرائب وأسرار، وهي مما لا يحصيها العدّ، ومن بين كافة العواطف والانفعالات التي تعتمل في نفس الإنسان، أغزرها، وأكثرها تعكيراً لصفو الحياة هو الخوف. وأقول نفس الإنسان لأن النفس، أو الروح، إن شئنا الدقة، هي التي تنفعل، فتخاف، وغالباً ما يطاوعها العقل، أو يقف عاجزاً، مكتوف اليدين. فالعقل قد يعقلن الذعر، فيخفّف منه، أو قد ينساق هو الآخر مع الخوف في لعبته، فيتحوّل الخائف ساعتها إلى أضحوكة للآخرين.
لأن الخوف عبارة عن انفعالٍ شخصي محض، فلا يمكن تجسيده، أو الدلالة عليه، في مطرحٍ واحدٍ، ونقول عندها: هو ذا الخوف؛ عدوّكم الأكبر، فاجتنبوه. ففي النفس الخائفة لا خوف أقوى أو أقلّ، بل هنالك الخوف وحسب. وهي، أيْ المخاوف، كمثل ينابيع الأرض، تتجدّد كلّما نُبِشَ عنها. وكما تجرّ الحكايات حكايات أخرى، تجرّ المخاوف مخاوف أخرى. نظنّ أننا قد نجونا من أحدها، فلا نعرف كيف صرنا فريسة لغيرها، فهي مما يزيد، ولا ينقص. وكلما ازداد الانسان في العمر ازدادت مخاوفه، أو بشكلٍ أدقّ ازدادت كوابيسه؛ الهيجان اللامرئي لأسوأ مخاوفه.
والآن، أثمة في هذه الدنيا ما يخيف البشر أكثر من البشر أنفسهم ؟ والجواب: كلّا. فمن بين الذين شاركونا الجلوس ذات يوم على مقاعد الدراسة، ونحن صغار، أو من بين الذين نجد أنفسنا، مضطرين للعيش بجوارهم، أو على مسافة قريبة أو بعيدة عنهم، بحكم الوظيفة – العمل، أو الجيرة، أو القرابة، أو النصيب، نصيبنا في الدنيا هكذا، أو حين تتسلح العقائد بعد أن تتحوّل إلى أيديولوجيات مقيتة، بالسكاكين والرصاص والأحقاد، ولاسيما في أوقات الحروب الأهلية، فمن بين حَمَلة هذا النوع المسلّح من العقائد، أو ممن عددنا قبلاً من البشر، يوجد: قتلة، وحاقدون، ووشاة، وخونة، وأنذال، ومغتصبون، إلى آخر ما هنالك من أوصاف كريهة، ومشينة، تخصّ السيّئين.
يوجد: بشرٌ خُلِقوا وقد نُزِع الخوف من قلوبهم، أقصد الرحمة، فمن هؤلاء يطلع السفّحاون، والدكتاتوريون. وهم ومَن شابههم يتوجّب على الدوام الحذر منهم، والخوف إلى حدود الهرب، من مخططاتهم الأثيمة التي تقتات على مخاوف ونقاط الضعف التي تكون في العادة، في البسطاء من بني البشر.
ثم هنالك ما يخيف ويجمّد الدم في العروق في الموجودات الأخرى التي نتشارك معها العيش فوق ظهر هذا الكون، من حيوان، ونبات، وجماد. وقد لعب وعي الخوف، أو الخوف الواعي وهو من العواطف الإنسانية المشروعة، ومكوّن أساسي من مكوّنات طبيعتنا البشرية، دوراً رئيسيّاً في حفظ جنسنا البشري من الانقراض. فالخوف الذي ألجأ أسلافنا إلى الكهوف وأغصان الأشجار، هو الذي أعانهم مع الأيام على التلاؤم مع جميع الأجواء والبقاع الجغرافية التي صدف أن وُجدوا فيها.
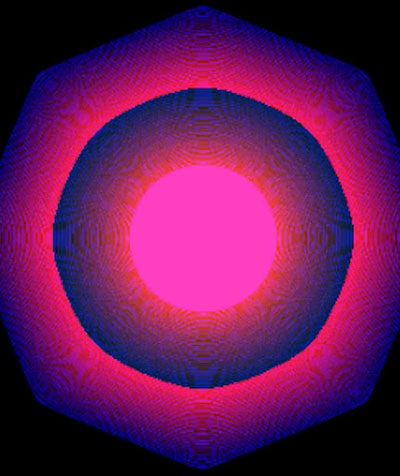
وبعض المخاوف من الكائنات المرعبة حقاً، الحيوانات الضارية، أو الجمادات الجليلة، الجبال الشاهقة، والمغاور السحيقة، والأمواج العاتية وغير ذلك من مخاوف، حتى من البشر أنفسهم، كلّها فيها الحقيقيّ، وفيها الزائف. وفي المحصلة النهائية، فالخوف من هذه الأشياء لا خوف منه، وبالإمكان تفاديه، الاحتيال عليه، كأن نغيّر عاداتنا في العيش.
ماذا؟ أأخاف المرور في الزقاق الفلانيّ لوجود قاطع طريق وغد، يفرض خوّة على كلّ مارّ؟ إذاً، سأغيّر الزقاق، حتى لو اضطررت إلى لفّة طويلة في الطريق الموصل إلى بيتي. أأخاف من أفلام الرعب، أو من تسلّق المرتفعات؟ إذاً، فلا داعي بتاتاً لمشاهدة الأولى، ولا إلى تسلق الثانية؟ تماماً بتلك البساطة يمكن لهذه الوصفة الفولاذية؛ أن تعيننا في الابتعاد عن الخوف، أن نغلق الباب أمام هذا النوع من المخاوف، نغلقه ونستريح.
ثم هنالك نوعٌ آخر من المخاوف هو من صنع أوهامنا ووساوسنا؛ مخاوف تفرّخ مخاوف جديدة. الشجرة التي تخفي الغابة، وهذه أصعبها، لأن أصلها الفعليّ لا يوجد في أيّ خارجٍ حقيقيّ، بل داخل النفوس، وبالتالي فهي لا تزول إلّا مع الموت. والأمر هنا يتعلّق على الأرجح بالجينات، أو الأمراض التي قد تطرأ على الانسان، ولاسيما مع تقدّمه في السنّ، بفعل الجفاف الذي قد يصيب الأوردة الدموية المغذّية للدماغ. فترى الإنسان العاقل، شديد الشجاعة، كان، يصير في الأيام الأخيرة من حياته، وقد تستغرق تلك الأيام الأخيرة سنين عديدة، يرى أشباحاً في غرفة نومه، فيعود، وهو في الثمانين أو التسعين من عمره، كما الأطفال، بل وأخوف من الأطفال، فلا يعود يجرؤ، هو كبير العائلة، على النوم في غرفته بمفرده، يحتاج إلى أيدينا وأجسادنا الحانية، تقاسمه مخاوفه.
ولا يسعنا بإزاء مثل هذا النوع من المخاوف إلّا الرثاء، للأثر اللعين الذي يتركه مرور الزمن على بني البشر، وصورتهم الزاهية في أعين الآخرين. فلتلك المخاوف علاقة بتكويننا البيولوجي، والبيئة التي عشنا فيها، والتربية التي تلقّيناها، وباختصار أكبر، فالكلمة الأخيرة بخصوص مسبّبات تلك المخاوف، ولماذا هذا التنوّع المذهل فيما قد يخيف، ولماذا يخاف فلانٌ من هذا الشيء، ولا يخاف منه علّان، وما إذا كانت تلك المخاوف مما يمكن علاجه أم لا، كلّها أمور ينبغي أن تُترك الكلمة الأخيرة فيها للعلم.
ثم هنالك الخوف بما هو مفردة من مفردات اللغة. فلدينا كمٌّ وافرٌ من الاستخدام المجازيّ لتلك المفردة، أو مرادفاتها “خشية”، “هيبة”، “رهاب”، “فزع”.. إلخ. وهذا النوع من المخاوف نوع أجوف، اخترعه البشر، ليرشّوا الملح على مغامراتهم أو أفعالهم الحياتية، وليجمّلوا لغاتهم، ويزيدوا رصيدها من المحسّنات البديعيّة. ولنأخذ، على سبيل الدعابة، الجملة التالية:
” أخاف أن أتأخر عن موعدي”.
أين الخوف هنا ؟ لن نعرف شيئاً عن هذا النوع المخنّث من الخوف قبل أن نمضي مع النصّ الذي وردت فيه هذه الجملة الانشائية إلى نهايته. فقد يكون الموعد غراميّا، وبالتالي، فالتأخر قد يؤديّ إلى ارتباك في العلاقة، أو انفكاكها. وبالأخصّ إذا تكرّر، من دون أعذار واضحة. وربما كان الخوف هنا متعلّقاً بمقابلة عمل، أخشى أن أفقده، فأقطع عندها في ربع ساعة ما يأخذ في العادة ساعة مشي، فالفرص الثمينة لا تتكرّر.
وربما كانت الجملة تخصّ نزالاً مع أحدهم، وجّهتَ له، أو وجّه لي، إهانة بالغة، وأخاف إن تأخرتَ عن العراك معه، العراك الذي سيكون على مرأى من الآخرين، وبتشجيع من حساباتهم الخبيثة، أن أدعى “خوّيفاً”، أو أيّاً من المرادفات العديدة لكلّ من يتملكه الخوف: “جبان”، “رعديد”، “متخاذل”، “نعجة”، وفي الإنكليزية يُطلقون على أمثال هؤلاء الأشخاص، الذين يجمّدهم الخوف في أمكنتهم كلمة:
” دجاجة!”.
وفي العربية قد نطلق عليهم تسمية:
” نعجة!”.
لماذا نسمّي الخوّيف أو الجبان: نعجة، أو دجاجة؟ لا يمكننا أن نصل إلى نتيجة مرضية بهذا الخصوص إلاّ بضربٍ من التخمين. فمساءلة اللغات عن أسرارها في اختيار محسّناتها البديعية ضربٌ من العبث، لا يحلّ المشكلة، بل يزيدها تعقيداً.
ثم هنالك النزال نفسه، الخشية من أن تكون نتيجته الموت، وعند الكثيرين، بل عند أكثر بني البشر، الخوف من الموت مرادفٌ للخوف من الله والقصاص يوم الحساب. أن نصير في قلب التراب، قبل أن تتاح لنا فرصة التطهّر من آثامنا العديدة، الآثام التي ارتكبناها ولكن لا يعرف سوانا أننا ارتكبناها. وهذه أيضاً؛ “آثامنا”، الناجمة ربما عن ارتكاب محظورٍ مّا (تابو)، لا نعرف كيف ولماذا اقترفناه، لكننا اقترفناه وانتهى الأمر، وسنمضي حياتنا بعد أن ارتكبناه، ونحن خائفون من أن ينكشف للآخرين، صدفة، أو بعد كأسٍ أو كأسين من العرق المثلّث، فتهوي صورتنا في عيون الآخرين إلى الحضيض. فها أن حَبّة خوف، قد تكون غير مرئية في زمن، ثم تتحوّل في زمنٍ لاحقٍ، مع اشتداد الوعي، ومحكمة العقل، إلى عنقود مخاوف.

وأما بخصوص مخاوفي الشخصية، القديمة أو الراهنة، فلو جرى تخييري لما قمت بفضحها. وما يجعلني أكتب عنها الآن أنها ليست من العيار الثقيل. وسأبدأ بالقديمة، الأزلية، منها. وأقساها بالنسبة إليّ: رهاب الأماكن المرتفعة؟ نعم، فأنا أستمتع، والأدق أنني كنت أستمتع فيما مضى بتسلق الأماكن المرتفعة، فصعود الجبال واحد من هواياتي المفضّلة، بالرغم من أن الجبال التي تسلّقتُها في حياتي المديدة تُعدّ على أصابع اليد الواحدة، وبالكاد، يمكن أن تُدعى جبالاً، والحديث هنا يخصّ الهضاب المحيطة بعيني: الفيجة والخضرا، قرب دمشق، أو إن ابتعدتُ أكثر، فقد أتحدث عن جبال الزبداني وسرغايا، التي حاولنا تسلّقها مراراً، في المراهقة، في مساعينا الدؤوبة للهرب إلى لبنان .
كيف أخشى الأماكن المرتفعة، ومع ذلك لا أخشى تسلّقها؟ السرّ هنا يكمن في المنظور. ينبغي أن يتحدّد المنظور قبل أيّ حديث. ففي عملية الصعود لا أرى إلاّ ما يتوجّب رؤيته. وعلى هذا، فإلى الآن، قد أقبل أيّ دعوةً إلى التنزّه فوق قمة جبلٍ من الجبال، شريطة أن تكون مستوية، وأكون كمن يتسكع في شوارع المدينة. وباختصارٍ أكثر، فأنا لا أرى مشكلة في النظر من تحت إلى فوق: رؤية الأشياء تصغر كلما اقتربنا منها. قد يصيبني بعض الدوار، ففي النهاية أنا بشريّ. ولكن لا يسقط قلبي في الأشياء، ولا يضيع بين أحشائي، وتصبح عملية استخراجه مؤلمة للغاية، إلّا إذا اضطرتني ظروفٌ قاهرة لأن أنظر من فوق إلى تحت، من القمة إلى الأسفل؛ الوديان العميقة، القيعان، أكتاف الجبال، الأشجار، البشر وقد صاروا ذباباً، كلّ هذه الأشياء، منظوراً لها من فوق الجبل، أو من نافذة الطائرة، من الدرجة الأخيرة في السلّم، إلى الدرجة الأولى فيه، أتمنى لو يجري إعفائي منها .
هل انتهيت؟ وهل لمخاوف الانسان من انتهاء؟ نعم، أخاف أفلام الرعب، ولا أقبل دعوة لحضور أحدها، حتى ولو وعِدتُ بأموال طائلة، رغم حاجتي الماسّة لتلك الأموال. وحفيدتي تستهجن خوفي من هذا النوع من الأفلام، الذي تعشقه هي إلى حدّ الهوس. تستفسرني عندما تراني أهمّ بمغادرة الصالون، بعد أن تُشغِّلَ في السهرة واحداً من تلك الأفلام:
” كيف تخاف منها وهي تمثيل بتمثيل؟”.
حسناً، أعترف أنها، بقولها هذا، تفهم لعبة الفنّ أكثر منّي، وأنها قادرة أكثر مني على خلق تغريبٍ بريختيّ، أو مسافة ملحمية، بينها وبين ما تشاهده، أو تقرأه، لا تترك للحيل الفنية أن تخدعها. وأنا أفنيت عمري في تمثيل العوالم، تجسيدها من خلال فنّ القصة، اللعب بالكلمات، ومع ذلك فلا أستطيع حتى الساعة، أن أقيم أيّ فارق بين الحقيقة والتخييل، فما تزال بعض الأفلام الهندية، مثل فيلم “سانغام”، تبكيني حديثاً، كما أبكتني قديماً .
ثم، هنالك القطط، (السنانير، لا أعرف لماذا استغنت لغتنا العربية الحديثة عن هذه المفردة الجميلة) ليس كلّها بل المنزليّة منها فقط. إذ لم يسبق أن كانت لي متاعب مع القطط الشاردة. فهذه قد أشفق عليها، وأوزع بقايا الطعام بينها وبين حاوية القمامة، الكلّ له نصيب من أعطياتي، ثم إنّ معنا الجهات الأربع لنفرّ إليها، أنا وهي، إن وقعت المواجهة بيننا. وحدها؛ القطط التي تعيش مع البشر في منازلهم، (وهنا قد أثير ضدّي منظمات حقوق الحيوان) بظهورها المقوسّة، والإمكانية الدائمة لديها للانتقال المباغت من الوِدّ الخنوع إلى وحشيّة الفطرة الأولى، هو ما يبقيها في المرتبة الثالثة من قائمة مخاوفي، بعد رهاب الأماكن المرتفعة، وأفلام الرعب. فهذ النوع من “السنانير” جاهز دوماً، لأن يشطب ملايين السنين من العيش المشترك مع بني البشر، لأقلّ هفوة، إن غضبت فستخمش أقرب يدٍ لها، حتى ولو كانت يد رضيع، أو عندما يحلو لها في الكثيرٍ من الأحيان، كنوعٍ من إضفاء قيمة زائدة على وجودها في المنزل، أن تلعب دور الكلب؛ الحارسة الأمينة للبيت ولساكنيه، في مواجهة الضيوف الغرباء!
ومع ذلك، فأين العيب في المخاوف التي ذكرتُها حتى الآن؟ بل أيّ مثلبة قد تشوّه سمعة الفيل إن أُخِذَ عليه خشيته من الفئران، إن كانت تلك الخشية حقيقيّة، وليست من نسج خيال صانعي مسلسل “توم وجيري”؟ ومن يجسر على الوقوف وجهاً لوجه أمام فيلٍ هائج؟ الأسود، ملوك الغابة، لا تقوى على ذلك الفعل المتهوّر، شريطة أن يتمّ إخراج الفئران من المعادلة:
” أن توضع بين قوسين!”.
صحيح ؟ فإذا استبعدنا الرعب الذي تسببه الفئران للفيلة، وإذا استبعدنا كونها الطبق المفضّل للسنانير، والجوارح، والأفاعي، فمن أجل أيّ غرضٍ جليلٍ وُجِدت تلك المخلوقات، التي يمكن من منظورٍ فيليٍّ خالص أن يستمرّ وجود الكون، بل وأن يكون “أحسن العوالم الممكنة”، إذا جاز لنا هنا استعارة مفردات الفيلسوف الألماني لاينتس، بمعزلٍ عن الفئران؟
هل أواصل أكثر، لعبة التلهّي بمفردات اللغة، أنيط بالكلمات الجليلة مهمة تعداد مخاوفي إلى نهايتها؟ مستحيل، لأنها ستحوّلني إلى أضحوكة، سيرة تلوكها الألسن، في اللحظات التي يتلذّذ فيها الناس أيّما تلذّذ بتعداد، مخاوف، نواقص الآخرين. لماذا ينبغي عَلَيّ أن أتوغّل أكثر في هذا الحقل الشائك؟ ولماذا قد أعطي للآخرين أسلحةً أعرف سلفاً أنها يمكن عند أيّ زَعَل، أو خلاف مستحكم، أو طلاق، لا سمح الله، أن ترتدّ إلى نحري؟
” أنظروا فلاناً من الناس: يتصرّف ويكتب عن الحرب وأهوالها كما لو أنه عنتر زمانه، رغم أنه على أرض الواقع يخشى القطط المنزلية، القطط التي قد يدفع بعض البشر في بعضها أثماناً باهظة”.
والآن، فكلّ ما قلته منذ قليل عن مخاوفي كان من قبيل الدعابة، لتكملة الحجم المطلوب لهذه المادّة، وإلّا فمخاوفي الحقيقية في هذه الأيام تحديداً، تقع في مكانٍ آخر: فالمخاوف التي لا تنيّمني الليل تكمن في المستقبل، في الآتي من الأيام. فبعد أن عشنا في العقد الماضي أهوال الحرب في سوريا، فتدمّرت بيوتنا وغدونا متسولّين لأيّ منفىً يقبل بنا، ثم إننا أمضينا أول عامين من هذا العقد الجديد في أهوال كورونا اللعين، فما المرعب الذي قد تتمخضّ عنه الحرب في أوكرانيا، إنْ طال أمدها، أو استعصت على إمكانية حلٍّ مقبولٍ من أطراف النزاع كافّةً؟
الحربُ، ومن بعدها الوباء، فهل نحن من بعد الوباء، على موعدٍ مع القنبلة النووية؟ هذا هو ما يخيفني في هذه الأيام، وليُشطب كلُّ ما سبق أن قيل في عن الجبال والسنانير وأفلام الرعب.





