السمّ والترياق
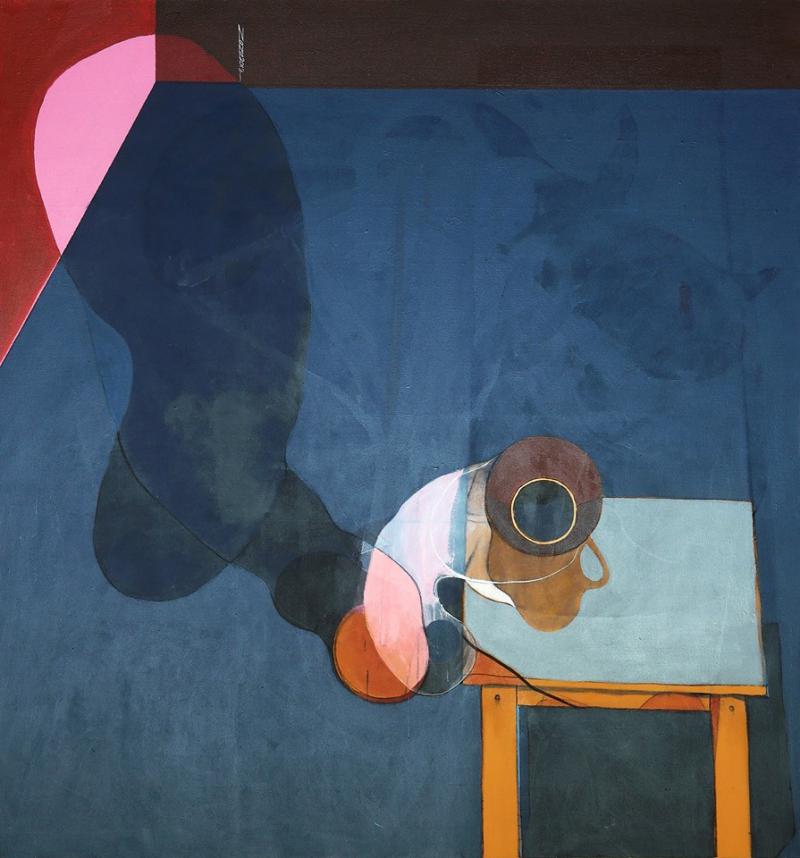
كرّس جاك دريدا جل أعماله لمفهوم الكتابة، ليس بمعنى الحرفة بل بمعنى الخط والحرف، أي ما هو مسجّل مقابل ما هو منطوق. وقد هدَفَ، في كتابه الشهير “علم الكتابة”، إلى سبر أغوار التوتر الذي يسببه “علم الكتابة” في المجال المعرفي الغربي، والذي أسهمت الحداثة في جعله توتراً عالمياً، فموقف الفلاسفة وعلماء اللغة والأنثروبولوچيا الحذر والمتناقض إزاء قيمة الكتابة يكشف، في رأي دريدا، عن مجموعة من المسلمات الميتافيزيقية الهشة، وعن ضروب من التواطؤ تبغي تدعيم المركزية العرقية الغربية.
في سياق التفكيك الذي طرحه دريدا رصد، في هذا الكتاب، كذلك، الميل إلى تهميش الكتابة على مدار تاريخ الفكر الغربي من أفلاطون إلى ليفي شتراوس. وقد صاحب هذا التهميش تمييز آخر في الفكر الغربي بين الكتابة الأبجدية، بوصفها الأرقى، وأنواع أخرى من الكتابة التصويرية أو الرمزية. وهذا النزوع الذي ينطلق من أولوية الكلام على الكتابة يقوم، في نظر دريدا، على ربط الدلالة بالكلام (الصوت)، واختزال الوجود إلى الحضور، “ففي الوقت الذي يكون الكلام مشحوناً بالحضور يحتل الحضور في الكتابة مكانة ثانوية”، وهو ما أدى إلى تكريس مركزية “اللوغوس”، بل والمركزية العرقية الأوروبية. وأطلق دريدا على هذا النزوع ميتافيزيقا الصوت بسيادة الكلام على حساب الكتابة، وجاء بفكرة مناقضة لهذا الموروث الميتافيزيقي وهي أن الكلام مشتق من الكتابة بدلاً من أن تكون الكتابة مشتقاً طفيلياً من الكلام. وقد اقترح وجود نموذج بدئي للكتابة تفرضه الضرورة، فالكتابة تقليد قديم يعبر عنه بصور حسية مرئية وصورية، ولا يمكن أن تخلو الطبيعة من ممارسة كتابة من نوع ما.
وكان فلاسفة الإغريق القدامى قد عبّروا عن كرههم للكتابة بسبب خشيتهم من قوتها في تدمير الحقيقة الفلسفية التي يرون أنها حقيقة نفسية خالصة وشفافة، ولا يُعبَّر عنها إلاّ بالحديث الذاتي أو الحديث المباشر مع الآخرين، ولما كانت الكتابة لا تذعن لهذا التصور فهي تجسد الحقيقة بصورة مرئية، إذ ظهر وكأنها تختزلها إلى مرتبة أقل سموّاً مما هي عليه في النفس. وذهب هؤلاء الفلاسفة إلى أنّ تدوين “الحقيقة” بالكتابة هو تدنيس لها. وكان سقراط يرفض رفضاً باتاً أن تدوّن فلسفته، لأن الحقيقة فيها لا يمكن أن يحتويها جلد حيوان أو حجر جامد بدل النفس الزكية الطاهرة، وجاراه أفلاطون في اعتبارها بمثابة دواء له من الضرر على الذاكرة أكثر مما له من الفائدة لأنه يقود إلى النسيان (عبدالله إبراهيم، “علم الكتابة”. جريدة الرياض، العدد 14647، 31 يوليو 2008).
إن المفهوم التحديثي للكتابة الذي سنه دريدا، كما يقول خاليد القاسمي، “لا يجعلها وعاء للكلام فحسب، ولكن للغة برمتها، وهي سابقة عليهما، فتكون اللغة نفسها تولدا ينتج عن النص، وبهذا تدخل الكتابة في محاورة مع اللغة، فتظهر سابقة على اللغة ومتجاوزة لها، فهي تستوعب اللغة، وتأتي كخلفية لها بدلا من كونها إفصاحا ثانوياً متأخراً، وهذا هو البعد الخلاق الذي يريد دريدا منحه للغة”. لكن ما الذي تكونه هذه الكتابة السابقة على اللغة، وما هي خصائصها؟
يشير رامان سيلدن إلى ثلاثة خصائص أساسية تميز الكتابة في ضوء مفهومها الدريدي الجديد، والمتوافق مع مفهوم اللغة الجديد نفسه -عند دريدا- القائم على الاختلاف ولانهائية الدلالة، وهي:
أولاها قابلية العلامة المكتوبة للتكرار في غياب منتجها الذي أنتجها في سياق معين، وكذا في غياب مخاطب محدد توجه إليه هذه الإشارة. وثانيتها أن العلامة المكتوبة يمكن أن تخرج عن إطار سياقها الفعلي، وتستنبت في سياق مختلف لا يراعي بالضرورة قصدية منتجها الأول. وثالثتها أن العلامة المكتوبة تقبل الإبعاد، فهي تنفصل عن غيرها من العلامات في سلسلة بعينها، وكذلك لا يمكنها أن تشير إلا إلى شيء ليس حاضرا فيها.
من هذا المنطلق، يمكن القول إن الكتابة بهذا المفهوم، هي كتابة الاختلافات بوصفها أثراً، أي الكتابة معلومة الوجود والسابقة على اللغة، ومجهولة الماهية، وهي ما يسميها دريدا الكتابة الأصلية، التي تتضمن الكلام والكتابة العادية معاً.
إن موقع الكتابة الأصلية يصعب تحديده، وهي ليست جزءاً من نظام اللغة، بل هي شرط لكل نظام لغوي يحكمه الاختلاف والإرجاء بين دواله ومدلولاته. يقول دريدا “إن الكتابة الأصلية بوصفها حركة للإرجاء وقضية مركبة أصلية، لا تقبل التبسيط، وهي تفتح في إمكانية واحدة، السبيل للتحديد الزمني والعلاقة مع الآخر ومع اللغة، كما لا يمكنها بوصفها شرطاً لكل نظام لغوي أن تكون جزءاً من النظام اللغوي نفسه، ولا يمكنها أن تصبح موضوعاً يعالج داخل مجال هذا النظام (وهو ما لا يعني أن لها مكاناً واقعياً في مجال آخر، أو موقعاً آخر مخصصاً لها)”.
ويسترسل دريدا في جدله مع إشكالية الكتابة، دون أن يقلب السلم الهرمي: كلام/كتابة، فهو بطرحه للتصور الجديد للكتابة الأصلية يبين قدر العنف الذي مارسته هذه الكتابة على اللغة. فكتابة الاختلاف بوصفها عودةً أزليةً أسطوريةً، مزقت أوصال اللغة، وضيعت حلمها في تمثيل الحقيقة. يقول دريدا “إن تفكيك هذا التراث لا يعني قلبه، لا يعني تبرئة الكتابة، بل يعني أننا نبين لماذا يطرأ عنف الكتابة على لغة بريئة. هناك عنف أصلي للكتابة لأن اللغة، بمعنى ما هي أولا كتابة. لقد كان التعدّي موجوداً بشكل دائم. إن اتجاه الخط المستقيم يظهر بوصفه تأثيراً أسطورياً للعودة”.

لقد أتى دريدا بالكتابة المزدوجة الذي يحرّض نصفها الأول على قلب الهيمنة الثقافية التي يطابق بينها وبين الميتافيزيقا وسلاسلها الهرمية، في حين أن نصفها الثاني يتيح تفجّر الكتابة في صميم الكلمة بحيث يؤدي هذا التفجر إلى تمزيق النسق المعهود. فالكتابة هنا تقف ضد النطق وتمثل عدمية الصوت، وليس للكينونة إلا أن تتولد من الكتابة، وهي حالة الولوج إلى لغة “الاختلاف”، والانبثاق من الصمت، أو أنها انفجار سكون. ومن ثم “فالمرجع بالنسبة إلى الحقيقة مقرر سلفاً بالمعنى، لكن المعنى متعلق بالكتابة البدئية بوصفه اختلافاً متواصلاً للدلالات، ولهذا فإن ‘الغراماتولوجيا’ (علم الكتابة) ترى أنه ليس هناك شيء قبل اللغة أو بعدها، فمفاهيم الحقيقة والعقلانية ما هي إلا من نتائج المجاز والاستعارة”.
في ضوء ما سبق، يصبح لدينا نوعان من الكتابة “الأولى: كتابة تتكئ على ‘التمركز المنطقي’ وهي التي تسمي الكلمة كأداة صوتية/أبجذية خطية، وهدفها توصيل الكلمة المنطوقة. وثانيتهما هي الكتابة المعتمدة على ‘النحوية’ أو كتابة ما بعد البنيوية، وهي ما يؤسس العملية الأولى التي تنتج اللغة” (خاليد القاسمي “مفهوم الكتابة الأصلية في تفكيك(ية) جاك دريدا”، مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي).
وتكمن منطلقات معارضة دريدا للبنيويّة في إعلاء عالم اللغة فرديناند دي سوسير شأن الكلام، واعتبار الكتابة ملحقاً له. وتتوضّح هذه المعارضة في قراءة دريدا لجان جاك روسو، حيث شرح بشكل عميق ومفصّل العلاقة بين الكتابة والكلام؛ يقول عن روسو إنّ الكتابة بالنسبة إليه “ليست سوى تمثيل للكلام”، ويعلّق “من الغريب أن يولي المرء اهتماماً أكبر لتحديد الصورة بدلاً من الشيء نفسه”. وفي السياق ذاته قال إنّ البنيويين أغفلوا أنّ الكتابة هي علامة منبثقة من علامة، لذا هي تحتلّ مكان الكلام. وحصيلة النّقاش الفلسفيّ عند دريدا تكمن في مبدأ الحضور، فالبنيويّون أنزلوا مرتبة الكتابة لأنّهم خافوا من قوّتها التي بمقدورها أن تدمّر الحضور الشفّاف والبريء الذي لا يتحقّق إلّا عبر الحديث المباشر مع الآخر أي عبر الكلام. ورأى أنّه لا يمكن العودة بعد الآن إلى التمركز حول “اللّوغوس”، لأن الصّوت قد استبدل بالكتابة، فموسى (النبي) ألقى لوحي الوصايا الذي خطّهما يهوه بيده، واستبدلهما بكتابة منبثقة من استرجاع “الذّاكرة” لا يعرف مدى أمانته للأصل. لذلك ظلّ دريدا يحفر في طبقات النّصوص علّه يصل إلى الصّوت الأوّل، صوت يهوه ليسأله عن سبب هذا التشتّت والبعثرة، عن لعنته التي جعلت الكتابة “السمّ والترياق” في آنٍ معاً (أنطونيوس نادر، “ألق الكتابة ولعنة يهوه: قراءة في تفكيكيّة جاك دريدا، مجلة معنى الإلكترونية، 20 يوليو 2019).
إن إعطاء الأولوية لما يُكتب ويُدوَّن يفيد أمرين، حسب علي حرب، أولهما أنه لا انفكاك للمعنى عن العلامة وللمدلول عن الدال، أو للمفهوم عن الأسلوب. ومن هنا قول دريدا “لا شيء يوجد خارج النص”، ولا يعني ذلك نفي الوقائع أو التعامي عن الحقائق، كما حسب الخائفون على الحقيقة الموضوعية والمذعورون من منهج التفكيك، وإنما يعني أن النص يسهم في تشكيل الموضوع، وأن الحقيقة لا تسبق النص عليها، وإنما هي مرجعه بقدر ما هي ثمرته، وأثر من آثاره. إنه يعني أن النص الذي يُحيل الى الواقع أو الحدث، إنما يخلق واقعه ويفرض نفسه بقدر ما يترك أثره ويشكل مجاله.
وثانيهما، الذي يفيده تشكيل علم الكتابة والأثر، هو أنه لا تطابق بين المعنى والعلامة، أو بين المقول والمكتوب أو بين المفهوم والموجود، ما يجعل من المتعذّر القبض على حقيقة الشيء واكتناه ماهية الحدث. فالمعنى يستعصي على الحصر، والمفهوم هو صيرورته الدائمة، ذلك أن النص، بما هو أثر، ليس وحيد الدلالة أو الوجهة، وإنما هو منسوج من الالتباس والتوتّر أو التعارض، بحيث يقبل غير تفسير أو تأويل، بقدر ما يكون غير مطابق لما يطرحه أو يدّعيه. بكلام آخر، إن الاعتراف بأن للنص أثره ووقائعتيه، بمعزل عن مؤلفه، يعني أنه أقل أو أكثر أو غير ما يقوله، ما يجعل المعنى رهن قارئه الذي يقرأ في النص ما لا يرد على ذهن مؤلفه.
وهذا يقودنا الى الإرجاء بوجهيه المكاني والزماني. مفاد الوجه الأول أن المعنى، كونه يلابس النص ولا يعرف إلا من خلال أثره، لا سبيل الى التحقق منه أو التثبّت من هويته، وإنما هو يختلف عن نفسه باختلاف القراء للأثر، أي هو نتاج بقدر ما هو نسبة لا تنفك تتغير بين الكلمة والشيء أو بين الكلمة والكلمة أو بين الأشياء. وهكذا كل قراءة تنتج معناها وتخلق حقيقتها بقدر ما تقوم بصرف اللفظ ونسخ المعنى أو تحويل المفهوم على سبيل الزحزحة والإحالة، الأمر الذي يضاعف النص عبر القراءات المتباينة والمتلاحقة وبصورة تتسع معها دوائر تأثيره وتتعاظم مفاعيله.
أما الوجه الثاني للإرجاء فهو استحالة القطع والجزم في الحكم على الأشياء، ما دام النص متعدّد المعنى، والأثر ملتبس الدلالة أو مزدوج الإحالة. ولذا لا وجود لقول فصل أو لكلمة نهائية في أيّ موضوع أو أمر أو شأن، فالمعنى مؤجل أو مُرجأ، لأنه لا قوام له بذاته بمعزل عن النص الذي ينتج الفروق والاختلافات بقدر ما هو مساحة للتباين والتعارض. ولذا لا سبيل إلى اختزال النص والأثر، كما لا سبيل إلى الوقوف على مراد المؤلف، فنحن نقرأ لا لكي نبحث عمّا أراد المؤلف قوله، وإنما لكي نكشف ما لم يقله، أو ما كان يمتنع عليه القول.




