الفن المعاصر والكتابة بالبصري
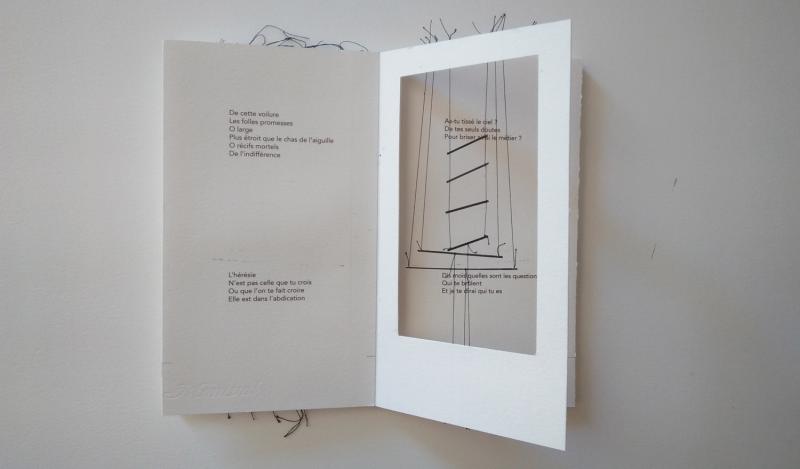
لعل مما يلفت الانتباه في دراسة الأعمال الفنية، بوصفها كتابة بالبصري، في ضوء ما تستمده من رمزيات متصلة بسياقات تاريخية متبدّلَة، أن قدرا معتبرا من مؤرخي الفن نحوا إلى اعتبار الأسلوب الفني منطويا على طابع ثقافي “لا زمني”، أو مجرد من “لحظيته”، وإن كان يرتبط بالحواضن الاجتماعية والسياسية والفكرية؛ ففي مقالة كتبها المؤرخ الأميركي ميير شابيرو، قبل سنوات، بعنوان “مفهوم الأسلوب”، يقترح تعريفا للأسلوب الفني بما هو “تجسيد للصلة بين مجموعة اجتماعية وفنان بعينه”، كما يقدم تاريخا لهذا المفهوم مسترسلا من الدلالة المتصلة بالحقبة التاريخية والعصر، إلى المعنى المرتبط باليد والمهارة، ويبين كيف تؤدي ثوابت الكتابة بالبصري وظيفة أساسية في خلق المشاعر القومية، التي تمتد من الأحاسيس ذات الجوهر العنصري إلى تلك المولدة للثورات.
في هذا السياق تحديدا يمكن أن نرى أعمال الغرافيتي، التلقائية، والمؤقتة، بوصفها النموذج النقيض، في حيز الكتابة بالبصري، لمفهوم الأسلوب الاستشرافي المتصل بالمنحوتات والتجهيزات المثبتة في الفضاءات المدينية، بقصد البقاء والخلود؛ إنه فن التظاهرات والانتفاضات والاحتجاج، وهو فن اللحظة، الذي يبقى مقترنا بها، ويتحول إلى شاهد أو ذكرى، إن لم يتم محوه أو طلاؤه باعتباره تجسيدا لزيغ تعبيري، مدفوع بحماس التظاهر. فيمثُل الفرق بينه وبين النصب المخلد لفكرة قومية أو عقائدية في افتقاده إلى روح الاستمرارية المتعالية على السياقات، إنه مقترن بعدد المتظاهرين ممن يسكن وعيهم وخيالهم الرغبة في تمثيل الغائبين وإسماع صوتهم للسلطة وإزعاجها في أفق تقويض استبدادها، حيث إما أن تتنازل السلطة “فيتحول الرمزي إلى فعلي” بتعبير جون بورغر، وإما أن “تختار السلطة اللجوء إلى العنف فتضمن أن يتحوّل الحدث الرمزيّ إلى حدث تاريخيّ، حدثٍ سوف يُحفَظ في الذّاكرة، وتُستخلَص دروسه”. والظاهر أنه لا يمكن النظر إلى الأنصبة المتمركزة حول أفكار العدل والحق والثورة والحرية بوصفها كيانات جمالية خارج الأيديولوجيا، وإلا لما كان ثمة تاريخ للنحت بهذا الرصيد الممتد، منذ الأسطوريات القديمة إلى العقائديات السياسية الحديثة والمعاصرة، مرورا بتاريخ الأديان،… ومنذ هيمنة القدسي إلى تسلط الأنظمة الشمولية على الكتابة بالبصري، وتحويلها إلى مادة للبروبغاندا السياسية وتعميم رمزيات الحضور في المجتمع والمدينة.
ولا يعزب عن النظر، في هذا المقام، أن خروج اللوحة من الكاتدرائية إلى المتحف، لا يمكن تمثله في انفصال عن خروج الرؤية من حضيرة المعتقد إلى جماليات البصري، إنه الانتقال الضارب في عمق المجتمع الحديث والعلماني، حيث أعيد إسكان النحت والتصوير والعمارة في مجال دنيوي، بصرف النظر عن الذرائعية الدينية، من هذا المنطلق أضحت مؤسسات المتاحف مآلا، لا تقتصر وظيفته على استقبال الأعمال المصادرة من مجال القدسي، وإنما بالنظر إلى كونه نطاقا لعقيدة مستحدثة ترى الفن بوصفه شأنا مدنيا، وتاريخيا، وإنسانيا، لا يمكن أن يتجلى إلا في حيز من الملكية الجماعية الساعية لتحصين الذاكرة والأثر. كما لا ينفصل ولع اقتناء اللوحات والمنحوتات، والبروز التدريجي للمجموعات الفنية الخاصة عن تفاقم النزعة الفردانية في المجتمع الحديث والمعاصر، ونهمها إلى امتلاك ما هو جماعي، بوصفه وسيلة لتوسيع مصادر الثروة، كما لا ينفصل ذلك التحول من مؤسسة “المتحف العمومي” إلى المقتنيات الفنية للأفراد والشركات والبنوك عن فكرة الحجب والمصادرة، وانتزاع الوظيفة الفنية، لحساب هاجس تضخيم القيمة، في اتصالها بالأسلوب وبصمة الكتابة البصرية؛ من هنا ستنشأ أسواق الفن داخل حاضنة لصناعة الثروة يلتبس فيها الحقيقي بالزائف، والنفيس بالمتمحّل، والأصلي بالنسخة، والمقيم بالعابر.
الأثر المنظور والوساطة والمعنى

بناء على هذه الافتراضات نعتقد أن الفن المعاصر في السياق العربي ينطلق من قاعدة فكرية تراهن على توزع حقل القيم وتشظيها في تعامل الجمهور مع الكتابة بالبصري، فمن جهة ثمة رهان على العمل ذي العمق المفهومي والرمزي، المنبني أساسا على سنن حجاجي، رافض ومُفكِّك، ومن ثم قد يبدو منفّرا وعدوانيا تجاه العالم، انتقاديا للحاضنة الثقافية التي تبلورت فيها صيغه ومقولاته ورهاناته، في مقابل وضع مستقر لسياق التلقي يقسم المشاهدين بين من لهم إيمان بجدوى الرسالة الاحتجاجية للفن ونزوعه التمردي، المتصل بغرابته وخروجه عن مضمار القيمة المأثورة، وبين الجمهور الواسع ممن لا يستسيغ التسليم بوجود أي قيمة في الاختراقات الأسلوبية للفن المفهومي، والمأخوذ بالمعايير التقليدية للتحفة.
المحصلة أن الدخول إلى عوالم التفسير والتبيين والدفاع يقتضي إيمانا بصيغة تشكيلية معينة، وكفرا بصيغ عدة داخل أساليب الكتابة بالبصري في الفن المعاصر، لاسيما في مظاهره العربية المتباينة، لعل من أهمها تمرد التعبير الفني عن قاعدة التمثيل الأخاذ إلى التشكيل الصادم، ومن التناسب إلى التنابذ، والوجود في وضع يتخطى التخييل الصوري لعدد من العواطف والأفكار إلى صياغة مجازية لا تخلو من موقف عقائدي، والتنقل الدائم بين الإيمان بالمنطلق الجغرافي وباللغة والمعتقد الخاصين، إلى اعتبارهما تفصيلا ضمن مجال إنساني واسع يتبادل التأثير والصور المعبرة عن المحن والمآلات والاختلالات المشتركة. وبديهي، من ثم، أن يحفل التعبير الفني العربي المعاصر، بتقاطعات شتى، تخلق سلسلة من المجاورات، بين تجارب متباعدة من الخليج إلى المحيط حيث يمكن أن نضع منير الفاطمي بجوار منى حاطوم بجوار شيرين نشأت وقادر عطية وصفاء الرواص وسمر دياب وآخرين.
على هذا النحو تتجلى صناعة اسم (فنان/مؤلف) واقتراح رؤية في هذا الحقل المخصوص من جماليات التعبير البصري العربي، خارج قدرات الفنان نفسه، ثمة مئات الآلاف من الاقتراحات الفنية المبنية على مفاهيم احتجاجية ومناهضة لعالم اليوم، وما توترات عبر أصقاعه من معتقدات ورؤى بصدد الحروب والصراعات الناشئة عن اختلافات الهوية و الدين ومنسوب الثروة، ومن ثم بالنظر إلى مقولات “السلطة” و”السوق” والقمع المجتمعي للحرية الفردية وللجسد، وما لانهاية له من الموضوعات، حيث نجد تعبيرات عديدة عنها لا تلقى القبول بل تعتبر مجرد هذيان تشكيلي، كما قد تعبر عن اختراقات تمثيلية في سياقات مغايرة.
والشيء الأكيد أن الأمر يعود في مضمره إلى ثوابت ثقافة ورؤية مجتمع فني ضيق وانحيازات معارض، ورهانات قيمين فنيين، وتأويلات نقاد وخبراء فن، ونخبة تنفق بعضا من رصيدها المالي في إنشاء إقامات وشراء أعمال فنية. إنها الصعوبة التي جعلت عددا لا حصر له من الفنانين العرب يتطلعون باستمرار إلى عرض تجاربهم ضمن بلدان أوروبية وأميركية، وذلك بالنظر إلى كمّ الوسطاء الراسخين في مهن العرض والاختيار والتسويق والترويج الإعلامي وإقناع الجمهور بقيمة تلك الأعمال، التي تبقى محتاجة دوما لمن يدافع عنها، والانتصار لها في مواجهة أعمال مختلفة، وافتراض قيمة لها تؤهلها لأن تكون في مصاف “المنجزات”، وحين أستعمل في هذا السياق مفردات: “الدفاع” و”الاختيار” و”الترويج” و”افتراض القيمة” فلأن عددا من الأعمال التي تنتمي لراهن الفن العربي المعاصر، تبدو نابعة من نوازع وصيغ وقوالب متماثلة في التعبير عن الصدمة والرفض، وتشابهها الرمزي والتخييلي يضعها دوما في دائرة الشك، وعدم التسليم بالجدوى، فنادرة هي الأعمال القادرة على اختراق التخمة الرمزية والمفهومية، معطى يجعل كل تلك المفردات وما يتصل بها في معجم الوساطة أساسية في التداول.
والشيء الأكيد أن الوساطة التي قد تبدأ باقتناع المؤسسات الداعمة، وأروقة العرض، ولا تنتهي بالصحافة والنقد الفني، لا تزال ضامرة في السياق العربي، إن لم تكن منعدمة في بعض البلدان، ومن ثم فإن مبررات “اللجوء الفني” هي وليدة هذه القناعة التي ترى أن الفنان العربي المعاصر لا يمكن أن يتحقق دون البحث عن “مناصرين” و”متبنين” و”مراهنين” على قيمته الافتراضية، وهي من الندرة بحيث تجعل الهجرة مرادفة للإنجاز، مع ما يرافقها من سعي دؤوب من قبل الجيل الجديد، إلى اكتساب مهارات لغوية وتواصلية وثقافية تيسر مهمة إقناعه لمؤسسات الوساطة الغربية، فمن المداخل الرئيسة لصياغة التحقق، داخل الفن المعاصر، قدرة الفنان/المؤلف على الإقناع المعنوي، وتقديم خطاب كتابي/بصري متجانس. إذ لا يمكن أن نتحدث عن عمق في غياب القدرة على بيان حدوده، واستيضاح تجلياته، وإخراجه إلى السطح. وهي المهمة التي ليست موكولة إلى الآخرين، نقادا كانوا أو قيمي معارض، أو صحفيين، حتى لو تعلق الأمر بفنانين فطريين. غياب القدرة عن التبيين هي مرادف لافتقاد العمق نفسه؛ إذ لا يمكن أن ننجز لوحات ومنحوتات وتجهيزات مفعمة دلالة بالصدفة، ولا يمكن تشكيل خطاب بصري مقنع وشديد الرمزية دونما إدراك لخطورة المنجز، أو بغير قصد، فمعاناة الفنان المعاصر مع الأداة والشكل والإطار هي في الجوهر معاناة مع “الكتابة” أيضا، التي لا تشكل معنى أصيلا وفريدا وحقيقيا عبر اللعب بالكلمات.
التركيب الفني ومفارقة الضرورة

لا جرم إذن، أن يكون الانطلاق من قاعدة اللون والمادة والكتلة والمساحة في صيغ “معاصرة”، غير منفصل عن جوهر الوعي بالأزمة “المفترضة” للوسيلة، وهو وعي لا يمكن أن يكون بغير جوهر ثقافي، يتمثل محدودية الصيغ السائدة والمتراسلة من نقطة كونها تحد من طاقة التعبير الحر، ومن ثم يتطلع إلى تخطيها، وتجاوز ما يرتبط بها من رهانات. ذلك على الأقل ما يجب استيعابه في واقع عربي لم ينجز حداثته الثقافية بشكل متوازن بين الأجناس التعبيرية المختلفة، من الشعر إلى الرواية إلى السينما إلى المسرح والتشكيل… حيث برزت على الدوام تفاوتات موحية، بأعطاب راسخة في منظومة الثقافة جامعة.
وفي مقطع شديد الدلالة أورده محمد بنيس ضمن مقال صدر قبل أزيد من أربعة عقود حمل عنوان “من قضايا تجربتنا التشكيلية”، يقول ما يلي “أغلبية فنانينا التشكيليين، باستثناء مجموعة محدودة تعد على رؤوس الأصابع، تهمل الجانب الثقافي من حسابها الذاتي. وقد نشعر بإحراج عندما نريد فتح نقاش مع بعض الفنانين المغاربة، ونكتشف خواءهم الثقافي. وهذه الخاصية تلعب دورا… في خلق مأساوية فنوننا التشكيلية، إن بعض الفنانين الشباب يحملون القماش والفرشاة والألوان دون أن يتساءلوا عن نوعية الكتاب الذي سيقودهم في جحيمهم” (ص 89). ورد هذا المقال ضمن العدد السابع (الصادر في ربيع 1977) من مجلة “الثقافة الجديدة”، الذي شكل مع العدد 6 – 7 من مجلة “أنفاس”، أولى الأدبيات النقدية والنظرية عن واقع الحركة التشكيلية في المغرب، والحال أن هذا العدد ذاته يضم “كتابات” لكل من الفنانين: محمد شبعة ومحمد المليحي وفريد بلكاهية ومحمد القاسمي، جنبا إلى جنب مع كتابات نقدية لعبدالكبير الخطيبي وأدمون عمران المالح وطوني مارياني وآخرين.. عن التجربة التشكيلية المغربية وأعطابها ومطامحها الفنية والجمالية.
وربما كانت مقالات هذه المجموعة، تمثل تلك القلة التي استثناها محمد بنيس، في مقاله الواصف لحالة صادمة، ما لبثت أن تفاقمت، بالموازاة مع (ويا للمفارقة) اتساع قاعدة الممارسة الفنية بالمغرب، بحيث برز للوجود تدريجيا فنانون بغير أهلية فكرية، وبملامح “عَـيٍّ” خطابي، قد ينحصر في مظهر أول في الاتكال على المهارة والمعرفة التقنية، وقد يمتد إلى الاكتفاء بتفاصيل سطحية من تاريخ الفن، لتبرير الاختيار والسعي إلى تفسير العمل البصري. والحال أن تعقيد المنجز يتعارض مع التبسيط المعرفي وما يستند إليه من تحليل، فيبدو أشبه ما يكون بارتجال فني يخلو من أيّ رؤية.
ويمكن ربط “الإعاقة النظرية” المناقضة لمعنى “الكتابة بالبصري، في هذا السياق، بالمشهد الثقافي، وما تخلله في مرحلة ما بعد السبعينات من القرن الماضي من تفتت طاغ، أفضى إلى انعزالية مرضية لمبدعي الأجناس التعبيرية المختلفة بعضهم عن بعض، بحيث بات نادرا أن تجمع قضايا جمالية موحدة، وأسئلة ذات جوهر فكري، مبدعين من شتى الاختيارات التعبيرية اللفظية والبصرية، (في التصوير والنحت والرواية والمسرح والسينما والشعر…) إلا ضمن هوامش بالغة الضمور.
من هنا ينبغي إنعام النظر في طبيعة تطور الوعي الفني، وانخراطه في الأسئلة العامة التي شغلت الثقافة، من إعادة إنتاج النموذج المدرسي الغربي، إلى الوعي بالتراث والحداثة والآخر والأسلوب… وهي كلها مفاهيم تسكن جوهر الممارسة الثقافية في شتى تجلياتها. إنها المعرفة التي تورط الباحث في واقع الفن العربي المعاصر ضمن مآزق غياب الخطاب الجمالي الموازي لتخمة الإقامات الفنية والمعارض، وموجات البيع، والتزكية لأعمال وتجارب تشكيلية سرعان ما تنطفئ، وتمّحي من الذاكرة؛ ليس لأنها لم تكن جذابة وأصيلة حقا، وإنما لأنها انطوت، في العمق، على هشاشة فكرية قاتلة.
من الأسلوب إلى هندسة الفكرة

ولعل من السمات المميزة اليوم للمقصود بالفن المعاصر تلك التي تقرنه بتخطي المهارة إلى امتلاك خيال بصري يصطنع للفكرة مقابلا صوريا، خالبا وإشكاليا وصادما في آن. لا يهم أن يكون الفنان حاذقا في صناعة “الشيء” المعروض، الذي يمثل الكشف المفهومي والمعنوي، البليغ والمدهش، فالأهم هو هندسة الفكرة، والقدرة على تمثّل صيغتها الحسية. الأمر هنا شبيه بما يمتلكه المهندس المعماري (الاستثنائي) من بصيرة جمالية يوكل تنفيذها إلى فريق من المساعدين والرسامين والتقنيين، ممن يبدون أكثر امتلاكا لحرفية الإنجاز التطبيقي على الورق للعمل المفكر فيه. ويمكن تخيل عدد لانهائي من الأسماء المغمورة لحرفيين لن يكون بمقدورهم يوما أن يوقعوا أعمالا ولو أنهم سهروا على تنفيذها، من الأشكال البدائية إلى الصيغ المقدمة للعرض. مثلما أن عددا كبيرا من الكتاب يمتهنون حرفة صياغة النصوص للمشاهير ممن لا يمتلكون القدرة على الكتابة لكن لديهم مسارات حياتية وتجربة، تغريان الناشرين بتحويلها إلى كتب.
في أحد مباحث كتاب “ما الجمالية؟” يتحدث الباحث الفرنسي مارك جيمينيز عن الجوهر النهضوي للفن الذي يباعد بينه وبين المثول بما هو تفكير في صياغة الأعمال المتقنة ذات الكنه الاستعمالي، بما في ذلك اللوحات المقترنة بالغاية التزيينية للصالونات الفارهة، في هذا السياق يرى أن “التصوير والنحت ليستا ممارستين تستندان فقط إلى الخبرة، وإلى مهنة، وإلى مهارة الحرفي، وإنما تتحولان إلى نشاط ثقافي يضع قيد العمل عددا من الملكات والمؤهلات، التي تسمح للفنان بتخطي رتبته كحرفي بسيط، لكي يوافق صورة النهضوي ذي النزعة الإنسانية” (ص 49).
في الفن المعاصر الذي يتهم عادة بالافتقاد للشرعية، (بتعبير مارك جيمينيز نفسه)، بالنظر إلى “استساغة السهولة، وإنتاج أيّ شيء كان، مع تفضيل الصيت الإعلامي على الإنجاز الفني”، ستبدو عملية الاتكال المسترسل على قاعدة الحرفيين بمثابة تزييف للحقيقة الإبداعية، كما أن ضحالة الحصيلة الثقافية لعدد كبير من الفنانين اليوم مقارنة بنظرائهم قبل خمسة عقود مثلا، يضع محل تساؤل جدوى المراهنة على مضمون ثقافي يضطلع بوظيفة نهضوية لمنحوتات وتنصيبات وشرائط فيديو هي من خالص علم التقنيين، وليست لها تلك النضارة الرؤيوية التي تسند فكرة العمل، فتبدو ضحلة وضعيفة وعامية في مجملها، ومنذورة للعبور المؤقت.
يتمثل المأزق هنا، أساسا، في عدم التمييز بين العجز عن التنفيذ، والزهد في تضييع الوقت في عمل تقني، قد ينجزه الآخرون، وبين الاتكال على فرادة الفكرة التي قد تتطابق مع عشرات الأشياء الجاهزة، وبين القدرة على تشكيلها بصيغ مختلفة، لا يمثل المنجز الجاهز إلا احتمالا من احتمالاتها. وبناء على هذا الافتراض يبدو الاتكال الكامل على التطابق بين الجهد الذهني الخاص وتمثيله الحسي بما هو هروب من وضع العجز إلى التحقق عبر الآخرين؛ أذكر في هذا السياق كيف لفت انتباهي أحد الفنانين المغاربة ونحن نتأمل منحوتة معاصرة، في معرض لأعمال فنان شهير، إلى الطابع الحرفي الدقيق للمنحوتة الذي لا يتماثل مع أعمال سابقة لصاحبها، وقبل سنوات كان قد تسبب إنتاج عدد كبير من النظائر للتحفة الواحدة، بالاعتماد على الحرفيين، إلى تهاوي أثمنة أعمال عدد من الفنانين، بعد تداولها بشكل موسع، في حقل مبني أساسا على الندرة.
***
إن مفهوم الفردية المتصل بالكتابة لم يعد ممكنا في ظل الانتقال اليوم من عمل يدوي لفنان بارع، إلى مؤسسة المشغل التي تنطوي على فريق من المساعدين، وبانتشار التقنية المذللة لحرفية استثنائية. إنه تحول يوازي الانتقال من النفيس والفريد إلى المتاح والمكرر، ومن الثابت إلى المؤقت، فعشرات التنصيبات اليوم، مصنوعة لمؤسسات ومتاحف بوصفها تعبيرات دالة على حساسية ما، وقيمتها مستمدة من تأويلات الفنان المعاصر نفسه، الذي تحول مجهوده إلى التواصل والشرح وإنفاذ الأثر، أكثر من الاستغراق في إنشاء الصيغ التشكيلية من فراغ. الكتابة بالبصري هنا أقرب إلى هندسة الأثر المرئي، وتأويله، ومنحه مساحة دلالية متغايرة “ما بعد” الإنجاز، وإكسابه عتبات متباينة بتباين مسارات العرض والتواصل مع المشاهد، قد يكون جزء مهم في مضمون الكتابة هذا ذو عمق مجازي، وغير متصل باليد، (يد الفنان)، وإنما بتخطيطاته الذهنية والأسلوبية، المصحوبة في كل مرة بقدرة على التبيين على نحو مرتجل، ذلك ربما هو ما يمنح مفهوم الكتابة بالبصري في الفن المعاصر كنها مفارقا، يباعد بينها وبين الاستعمال المأثور في باقي الأجناس.




