القنطورس

القنطورس، الوحش الخرافي الإغريقي هو تعريب كلمة Centaurus، كائن نصفه إنسان ونصفه حصان. أعيد إحياؤه في بريطانيا العصر الفيكتوري ونُصِّب على جدران Kew gardens، التي يقال إنها أضخم وأهم حديقة من نوعها في العالم. الحديقة تقع في لندن وسط العاصمة.
هذه الأوراق كتبت في أواخر سبعينات القرن الماضي، وهي محاولة للتماهي مع هذا الوحش الخرافي. وربما من الأصح القول أنها إذ تجمع بين البصر والبصيرة، تمثل رؤية للوضع الثقافي البريطاني الذي يختزل بكوزموبوليتيته أمشاجاً من مختلف الآداب والفنون العالمية. وقد تصلح هذه الامشاج توطئة لترجمتي لقصائد من الشعراء البريطانيين: أدريان هنري، روجر ماغو، وبرايان باتن، وهي قصائد صارت توصف من قبل ناشرها دار بنغوين بأنها كلاسيكية حديثة. (نشرت الترجمة في مجلة “الجديد” العدد 72، كانون الثاني2021).
هكذا لن يجد القارىء هنا دراسة تقييمية لمراجعة نقدية. هذه مكانها آخر. إنها سيرة غير ذاتية إذا صح التعبير، سيرة تعبر عن الذات والموضوع متضافرين. القنطورس يمثل شعرية التحول من الخرافي إلى الطبيعي، ومن الطبيعي إلى الخرافي، وهو تحول أدعوه هنا بشعرية الحقيقة: شعرية الشطح المادي.
يحمحم قنطورس فارع في زقاق لولبي من أزقة “سوهو”. إنه ليس كقنطورس الأساطير. في الأسطورة يمثل القنطورس مخلوقا نصفه جواد ونصفه إنسان، يصاب بجرح بليغ فيتوسل إلى “زيوس” رب الأرباب أن يخلصه من خلوده الجريح فيحوله “زيوس” إلى “برومثيوس” سارق النار الجليلة من السماء. ولكن قنطورس الفارع المحمحم في زقاق لندني لا يمتلك من صورة قنطورس الأسطورة قدرته الفائقة على العدو والسير والخب. وبدلا من أن يقبس من السماء النار الأزلية التي لا تنطفئ، يستلّ من الجحيم النار الجنسية التي تستعر ثم تخمد لتستعر. يلتحم بجنيته الإلهية، مدنية التألق، مرنانة الصوت، ومسدلة الشعر. يقترب من لافتة صغيرة معلقة لصق جرس كهربائي: (موديل شابة. اضغط الجرس واصعد الدرج). الصيف إفريقي قائظ والزقاق لندني مزدحم. لغة الجنسولوجيا تسحق كل اللغات. الجنسولوجيا كما هو معروف فرع من فروع العلم الذي يدور حول مسائل الجنس. ولكن العلم هنا ليس طبيا ولا تفوح منه الرائحة المخبرية. وعلى رفوف ما يطلقون عليه بالأحرف الكبيرة للافتات النيون المضاءة اسم الـsex shop أي حانوت الجنس، تتكدس مئات الكتب والمجلات وموسوعات الحب جنبا إلى جنب مع مئات المستحضرات التي لا ترى في الإنسان حدا يتجاوز المفهوم البيولوجي للذكورة والأنوثة. ومثل هذه الحوانيت تنتشر كالفطور انتشارا مروحيا مركزه ساحة البيكاديللي، وتتخللها دور عرض الأفلام الزرقاء المكشوفة أو نوادي التعري أو الشذوذ أو المسارح أو الحانات. عالم غابي كثيف يحتله القنطورس الفارع الباحث عن المتعة، المكرس أبدا في بالوعة “سوهو” الذهبية، قارئ المجلة الإيروطيقية، وعاشق أفلام “الحلق العميق” و”التاغو الأخير في باريس” و”إيمانويل”. قد يكون القنطورس بروليتاريا وقد يكون بورجوازيا، مدمنا للمخدرات أو مدمنا لأحلام النوم وأحلام اليقظة. ولكنه متفرج باستمرار. قد يكون منخرطا في حزب العمال أو حزب المحافظين ولكنه مفعم بالريبة والشك تجاه السلطة. وإذا لم يكن فوضويا يضع على صدره شعار “أنا عدو الدولة” فإنه يمكن أن يردد مع “بالينورس” بطل كتاب “القبر المتململ” The Unquiet Grave للناقد الإنكليزي سيريل كونولي Cyril Connolly “من الأفضل أن أكون أشنة بحرية نامية على صخرة من أن أكون قرنفلة على صدر رئيس الجمهورية. أن يتجنب المرء بداية الأشياء هو الأمر القمين بتجنيبه نهايتها.. كل صداقة تنتهي بخصام هو في حقيقته تعبير عن تناقض إرادات. وكل حادثة لا بد أن تصل إلى نقطة تتحول معها إلى زواج فتتبدل أو هي ترفضه فتذبل وتتلاشى. إن الصداقات التي تستمر هي تلك التي يحترم فيها كل صديق كبرياء الآخر إلى الحد الذي لا يريد معه شيئا منه. وهكذا فإن إنسانا تتملكه إرادة التحكم لا يمكن أن يكون لديه أصدقاء. إنه كالطفل الذي يحمل ساطورا. إنه يجربه في قطع الزهور أولا ثم الأشجار ثم الأثاث المنزلي وأخيرا يحطمه على حجر صلد”.
القنطورس إذن متفرج نشيط. وقد يتحول من متفرج نشيط إلى مراقب منفعل في إحدى حلقات الخطابة في “هايد بارك”. وإذا كان من المصابين بالشذوذ الجنسي فإنه لا بد أن يكون مهندما إلى حد المبالغة. قد يرتدي بذلة بيضاء ناصعة ويقف صامتا يراقب ذلك الزنجي المتحمس والحامل لافتة إحدى الكنائس ويستند إلى منصة خشبية متحركة في (هايد بارك) منبر الخطابة الذي يعلن أنه لا تحد فيه حرية التعبير إلا بالشروط التي تحقق النظام. يصيح الزنجي وهو يلوح بقبضة مهددة “الشذوذ الجنسي عمل من أعمال أكل لحوم البشر cannibalism إن معناه أن يلتهم الأخ لحم أخيه”. يكتفي القنطورس المجلبب بالبياض من قمة الرأس حتى أخمص القدم بالابتسام ابتسامة كلبية متهكمة. وحين يصل الخطيب إلى القول بأن الشذوذ “قذارة مادية قدر ما هو قذارة روحية”. يسارع إلى الدخول معه في حوار منطقي حول القذارة والنظافة.
يهتف دون تردد “من منا النظيف ومن منا القذر؟ أنا أغتسل مرتين في اليوم فكم مرة تغتسل أنت؟.. رائحة إبط من تلك التي تفوح الآن؟…”.
وفي حلقة خطابة أخرى تتسع باستمرار، يصيح هندي في جمهور من المتحلقين الهنود والزنوج والأجانب، يتخلله قنطورس هنا وآخر هناك.
“لقد بدأنا قردة في الغابة. بدأنا قردة نتأرجح من جذوع أشجار الغابات الكثة. أليس كذلك يا إخوتي؟..”.
يردد إخوته “بلى!”
يستأنف الخطيب قائلا “وكنا عراة غير مكتسين. كنا لا نخجل من عوراتنا ونمارس الجنس كما نلتهم الطعام ونشرب الماء. أليس كذلك يا إخوتي؟..”.
يردد إخوته “بلى.. بلى!”.
ويقول “وجاء بناة الإمبراطورية الإنكليزية العظام فأنزلوا كل قرد على حدة عن غصنه المتأرجح وألبسوه وأطعموه وأرسلوه إلى المدرسة ثم اختاروا عددا من النجباء أرسلوهم إلى عاصمة الإمبراطورية”.
ويقول “وعندما أصبح النجباء طلبة جامعيين كانت الفتيات الجميلات قد أصبحن غصة في حلوقهم فكان واحدهم يقول لنفسه: فلأذهبن إلى سوهو. وفي بالوعة سوهو الذهبية كان يتسلل إلى نوادي الستريب تيز فيدفع النقود ليشاهد الفتيات الجميلات وهن ينزعن ملابسهن قطعة قطعة. تصوروا يا إخوتي أنه يدفع النقود ليشاهد عريا كان قد أرغم على الاعتقاد فيما كان يعيش سعيدا بعريه في الغابة أنه تخلف وعار، وأن من مستلزمات التمدن أن يضع عليه الملابس ويحزم رقبته بربطة عنق. كان الاستمتاع بالعري مجانيا في الغابة أما الآن فجلالة الرجل الأبيض يقبض من رجالنا المال مقابل مشاهدة فتياته وهن يخلعن ثيابهن عائدات القهقرى من المدنية إلى البربرية. تصوروا..”

وفي حلقة أخرى يقول خطيب كهل يقف تحت لافتة إصلاحية “في البدء خلق الله الإنسان. كل ما كان يحتاج إليه موجود في الأرض، الكل شركاء. لم يكن هناك أغنياء. ولذلك لم يكن هناك فقراء. ولكن مع مضي الزمن تسللت أفعى مريشة وهمست “خذ ما يزيد على حاجتك لا بد أن يكون هناك فقراء حتى يحصل البعض على المزيد. أن يعطي الأثرياء معناه أن يؤخذ من الفقراء”.
ويهدد شاب يافع تحت لافتة الفوضويين “إذا لم نضع للدولة حدا فستلتهم الدولة كل شيء”.
تقاطعه امرأة تقارب الأربعين “لماذا لا تعترف أنك لا تريد الدولة كأساس. كيف يمكن أن نلقي بكل هذا التراث العظيم من النظام في سلة المهملات؟..”.
يصيح الشاب “هذا الشكل من العلاقة مع التراث هو يا سيدتي من أشكال النيكروفيليا.. هل تعلمين ما هي النيكروفيليا؟ سأقول لك. النيكروفيليا هي مضاجعة الموتى”.
لا يصفق أحد ولا يصفر أحد. الضجيج يصخب في حلقة أخرى ثمة يهود بريطانيون وبريطانيون عاديون يستمعون إلى صهيوني، وثمة بضعة أعراب من الخليجيين. يقول “هذه الأكداس المكدسة من جنيهات النفط. أتعلمون أين تذهب هذه الأكداس من أموال أعراب النفط؟.. إنها تصب في بلاليع المومسات وبين أقدام الراقصات..”
يهتف خليجي مقاطعا “غيور! أنت غيور!..”.
“ومن الذي لا يغار!”
وهكذا تعود الجنسولوجيا لتستقطب النقار. من السياسة إلى الجنس. من الاقتصاد إلى الجنس. وقد دخلت النقار الممثلة الفضائحية ليندا لوفلاس Linda Lovelace التي اشتهرت في فيلمها “الحلق العميق”.. فقد بدأ في إحدى دور السينما بلندن عرض فيلمها الجديد “ليندا لوفلاس للرئاسة..”.. تحت شعار:
“Blow the trumpet، beat the drums – elect a President who really comes”.
“انفخوا البوق
اقرعوا الطبول
انتخبوا رئيسة تجيء فعلا”.
واللغم في هذا الشعار أو المنشور هو الجنسانية أو الجنسي – السياسي يكمن في معنى العبارة الأخيرة. فالمجيء هنا معناه الوصول إلى الذروة الجنسية وليس الوصول إلى السدة الرئاسية.
وقد علق ديريك مالكولم الناقد السينمائي لصحيفة الغارديان على هذه الفكاهة السوداء فيقول إنها تمثل ضربة مسددة لما تتمتع به الديمقراطية من احترام. فالفيلم يعلن الإعلان الفضائحي التالي “هذا الفيلم قصد به إغاظة الجميع بصرف النظر عن العرق أو اللون أو المعتقد..”. وبعد لحظات يسأل أحدهم “لماذا يضعون اللحم على المذبح في حفل زفاف بولندي؟..”
ويكون الجواب “من أجل إبعاد الذباب عن العروس”.
وبعيدا عن هذه الفكاهة السوداء أو قل البذاءة السوداء يلوح “التانغو الأخير في باريس” أقل صخبا. فمارلون براندو الذي يعرض فيلمه الذي تشاركه بطولته ماريا شنايدر في أبرز دار لندنية للعرض تضم عدة صالات تعرض إحداها الفيلم الفضائحي “إيمانويل”، يقوم بدور بالغ الرفاهة والغنائية. وحتى في المشاهد التي لا تخلو من فجاجة تبدو الفجاجة مبررة ضمن السياق العام. ولم تمارس الرقابة البريطانية أيّ تدخل في الفيلم. وبالطبع فإن هذا ينسجم والتطور الذي طرأ على مختلف أوجه الحياة الفنية والأدبية في بريطانيا منذ سنوات. خذ على سبيل المثال العرض المسرحي الموسيقي “أوه كلكوتا”، إنه مستمر منذ سنوات بنجاح كبير.. وقد نقل إلى مسرح “الدتشس” وهو مسرح صغير على أساس أن يستمر عرضه لسنوات أخرى. اشترك في كتابة هذا العرض عدد من أبرز كتاب المسرح والمثقفين نذكر منهم يوجين يونيسكو وجو أورتون والناقد المسرحي الشهير كينيث تينان. وقد أثار منذ عروضه الأولى نقاشات كثيرة يحسن بنا أن ننقل منها ذلك النقاش الذي جرى بين أحد المتفرجين المحافظين وبين كينيث تينان باعتبار أنه يكشف عن موقفين عقلين متباينين من مسألة الأدب والفن المكشوف أو “الجنسولوجيا السياسية”:
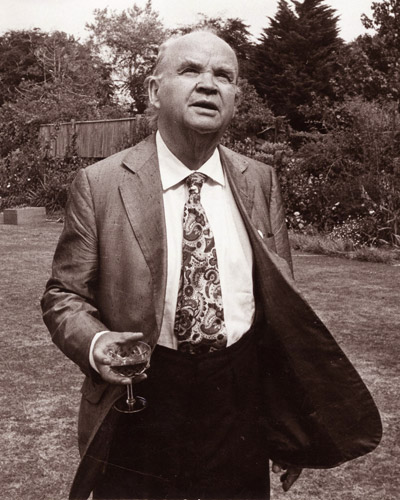
– محافظ ذكي: المزيد من الجنس على المسرح؟ ألا يوجد ما يكفي منه الآن..؟
* كينيث تينان: يعتمد هذا على أيّ نوع من الجنس تقصد. بالنسبة إلى ذوقك أو ذوقي قد يكون هناك القدر الكافي من الجنس ثقيل الأنفاس والمثير للتعرق والرمزي أحيانا على المسرح. ولكن ماذا عن الجنس باعتباره لعبا، لهوا ليليا، تمضية للوقت في مدينة؟
– محافظ: الجنس مسألة شخصية وخاصة بكل تأكيد.
* تينان: إنه كذلك بالنسبة إلى أولئك الذين يريدونه على هذا النحو ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلى أولئك الذين لا يريدونه على هذا النحو. دعني أشرح كيف تم إعداد “أوه كلكتا”. لقد دعوت عددا من الكتاب الذين أحترمهم لكتابة أحلامهم الجنسية أو ملاحظاتهم عن الجنس كتابة درامية. لم يرغمهم أحد على الإسهام في الكتابة كما أن أحدا ليس مرغما على رؤية العرض. كل ما أرجوه هو أن النتيجة ستكون التفوق على نوادي التعري في الذكاء والفن. لماذا ينبغي أن ينفرد الكتاب الرديئون بأفضل الموضوعات؟
– محافظ: ألاحظ أنكم لم تشيروا إلى أسماء كتاب الفصول كل على حدة.. هل يعود السبب إلى أن المؤلفين يشعرون بالخجل؟
* تينان: ليس تماما. الأمر يعود جزئيا إلى أنني لا أريدهم أن يشعروا بأن خصوصياتهم قد اقتحمت (بعض الأحلام شخصية جدا). وإنما لأنني أريد أن يحكم على العرض ككل. كنت أخشى أنني إذا ما حددت أسماء المؤلفين إزاء الفصول فإن التركيز النقدي سينصرف إلى الكتاب المعروفين على حساب الكتاب الأقل شهرة. أما الآن فأعتقد أننا قدمنا للجمهور لعبة باهرة للتخمين.
– محافظ: دعنا نعود إلى مسألة العري على المسرح. البعض يظن أنه يمكن أن يبرر. البعض الآخر لا يظن ذلك. ولكنّ الكثيرين من المعسكرين لا يعتقدون أنه عري بذيء.
* تينان: الأمر يعتمد على الكيفية التي تستخدم فيها العري. إذا ما استخدم من أجل أن يرمز إلى شيء آخر: ثورة الطلبة، الحرية الروحية… إلخ.. فإنه يأتي عندئذ تحت عنوان: العري الذي يمتلك دافعاً خلفيا هو أبعد ما يكون عن أن يكون مهيجاً أو مثيراً. لكن إذا كان الهدف إيصال المتعة الحسية فإن من المثير للدهشة إذا لم يكن العري أداة فعالة.
– محافظ: أعتقد أن العري يشجع مرض التلصص Voyeurism وخيالات جلد عميرة، وهذه فعاليات متوحدة ومعادية اجتماعيا.
* تينان: حسنا.. لا يمكننا أن نسهم جميعاً طيلة الوقت. وسيكون هناك دائما من تمثل لهم هذه الخيالات. وسيكون هناك دائماً من تمثل لهم هذه الخيالات مخارج ضرورية. وعلى أيّ حال لماذا يجب تقييد المتعة الجنسية بحدود التماس الفيزيولوجي بين شخصين في الخفاء؟ أنا لا أقترح أن تحتل الخيالات والأوهام محل الجنس العادي بيد أنها قادرة دون ريب على إغنائه وإنعاشه.
– محافظ: ولكن هل هذه مهمة كتاب الدرجة الأولى؟
* تينان: ربما لا يكون التأليف من تنويعات على الجنس هو الأعظم أو الأشد مهابة من بين الموضوعات التي يمكن أن يقوم بها كتاب الدرجة الأولى. ولكن لم يقل أحد بذلك. إن عملا فنياً رئيسياً يمكن أن يؤثر تأثيراً رئيسياً على حساسيات المرء. وبالمقارنة فإن “أوه كلكوتا” هي مجرد رسالة.. رسالة دون خجل. إن استقصاء السعادة عن طريق الجنس هو موضوعنا الرئيسي. ولكن هناك نقاط قد تنير أو حتى تثير قلق الجمهور بقدر ما تبهجه. وبالمناسبة لا يسيئني البتة إذا ما اتهمنا بأننا ندغدغ الجمهور. القاموس يقول أن فعل دغدغ يعني “الكركرة” أو الإثارة المبهجة. وهذا يبدو لي أمراً مناسباً جداً أن نفعله للآخرين.
المحافظ: لقد عرَّف أحدهم البورنوغرافيا بأنها “الكتابة الجنسية التي تخفق في أن تكون أدباً” هل تدعو بهذا المعنى إلى أن تكون البورنوغرافيا على المسرح؟
تينان: أنا لا أقبل بهذا التعريف. البورنوغرافيا هي الكتابة التي تستهدف بالدرجة الأولى أن تسبب الإثارة الجنسية. ويمكن أن يتحقق ذلك بطريقة فجة أو بطريقة لطيفة. في الحالة الأولى يكون الأدب رديئاً. أما في الحالة الثانية فهو أدب جيد. من المؤكد أنني أؤيد تقديم بورنوغرافيا جيدة على المسرح.
محافظ: ولكن مادة البورنوغرافيا مقيدة بحدود. كم هناك من الطرق لممارسة الجنس؟
تينان: عدد كبير، وكما قال احدهم فإن الدود فقط يمارس الجنس بطريقة محدودة.
محافظ: إن أهم حجة تؤخذ على البورنوغرافيا هي أن أثرها محدود وقصير الأجل. يمكنك أن تقرأ “هاملت” مرات ومرات وأن تحصل من قراءتك على شيء جديد في كل مرة ولكن الأمر ليس كذلك في ما يتصل بالبورنوغرافيا التي يقصد منها أن تحقق رد فعل واحد.. رد الفعل نفسه في كل مرة.
تينان: هذه النقطة صائبة لكنني أوضحت أن البورنوغرافيا فن ثانوي وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إلى أي حد يمكن تطوير هذا الفن على أيدي الكتاب الجيدين. إن “أوه كلكوتا” هي خطوة في هذا الاتجاه. التجارب ستستمر. إن لدى كل منا الكثير ليتعلمه.
– محافظ: شكل غير ضروري من التربية كما أرى.
* تينان: أو نعم.. ولكنه مبهج. إنه مبهج نفس ذلك النوع من البهجة المتأتية من فندق من الدرجة الأولى. إنه مبهج إلى حد يكفي لأن يجعلنا ننسى الموت لمدة ساعة أو ساعتين.
هذا النوع من النقاش ليس نادراً إنه يعكس تطوراً كبيراً في موقف الرقابة الشعبية من موضوع الحد الفاصل بين الأدب والإباحية.
إلى أيّ حد يمكن للأدب أو الفن المسرحي أن يمضي؟ في الفصل الأول من “أوه كلكوتا” يظهر على المسرح عاملان من عمال مناجم الفحم في ويلز (إحدى مقاطعات بريطانيا). إنهما صديقان حميمان، ويشتركان في حب غوندالين الفتاة الجميلة التي تسكن في حيهما.
وبعد خلاف بين من الذي سيتزوج من الفتاة تتزوج غوندالين من أحدهما، فيقبل الآخر بالأمر الواقع، ويقرر أن يستمر على صداقة الرجل الذي فاز بالفتاة. وفي إحدى الأمسيات يتأخر الزوج عن العودة إلى البيت فيطلب إلى صديقه إخبار الزوجة بذلك. يدخل الصديق إلى البيت ويحاول إغراء الزوجة ويعرض عليها مبلغاً كبيراً من المال مقابل خلع بعض ملابسها، ثم يدفع لها مبلغاً آخر لقاء خلع المزيد، فتتحدث الزوجة إلى نفسها في مونولوغ مفاده أنه لا خسارة في تلبية طلب الرجل ما دامت لن تفعل شيئاً. وعلى أيّ حال فهي ستسدد فاتورة الكهرباء وتشتري إبريقاً جديدا للشاي.. إلخ. وبعد أن يدفع الرجل لها أجره كله ويحصل عليها مقابل ذلك يسارع إلى التسلل خارج الدار بينما يعود الزوج وهو يسأل عما إذا كان صديقه الذي أرسل معه أجره الأسبوعي قد سلمها هذا الأجر كما طلب منه.

بهذه الفكاهة السوداء يبدأ العرض المسرحي. وهو يكتسب مع تعاقب الفصول تأثيراً تراكمياً تغلب عليه روح الدعابة التهكمية.
إلا أن اللوحات الراقصة تمنح العرض حيوية غير عادية. وإذا لم تكن “أوه كلكوتا” مسرحية بالمعنى المتعارف عليه فإنها تظل من أذكى العروض المسرحية الموسيقية التي تتجنب باستمرار الأسلوب التقليدي في التوجيه. وعلى أيّ حال فإن من مظاهر النفاق الشائعة أن العديد من المثقفين غالباً ما يعكس مواقف سلبية من المسرحية. ومع ذلك فإن هؤلاء المثقفين من زوار لندن يشكلون جزءاً لا بأس به من الجمهور الذي جعل المسرحية تستمر في العرض طيلة السنوات الست الماضية. أما لماذا أطلق على العرض اسم “أوه كلكوتا” فإن السبب في ذلك هو عدم رغبة المؤلفين تسميته بـ”أوه مدارس”. وينبغي أن يدرك المتفرج ذلك وخصوصاً وأنه يفترض أن هذه هي المرة العاشرة أو العشرين التي يحضر فيها المسرحية كما يخاطبه المساهمون فيها من الممثلين في استعراضهم العاري الذي يعلن لحظة الاختتام. ومع لحظة الاختتام يكون العرض قد أبّن المؤسسات الرئيسية في المجتمع ومنها الزواج الذي أصبح دعابة حقيقية. وقد نشرت الصحيفة الأسبوعية الشهيرة “النيوستيتسمان” رسماً كاريكاتيريا بدا فيه مشهد جماعي راقص من هذا العرض المسرحي المتخفف من الملابس دون أيّ حدود وقد طرح فيه أحد الممثلين السؤال الدراماتيكي التالي على زميلته:
هل تقبلين بي زوجاً يا حبيبتي؟
في الخمسينات كان هذا السؤال يصاغ بقدر أقل من الفكاهة السوداء. لم يكن التهكم حصيلة المفارقة بين البوح وبين الإباحية، بل كان – كما يصوغه الشاعر غريغوري كورسو – تعبيراً عن رغبة في تجنب الطقس الملكي الشعائري النفاقي الرسمي للزواج:
“هل أتزوج؟ هل أكون آدمياً
هل أذهل الفتاة الجارة
ببذلتي المحلية وقلنسوتي الفاوستسية؟
………..
………..
أغازلها الليل بطوله، والكواكب في السماء
عندما تقدمني على والديها
وقد قومت ظهري، ومشطت شعري أخيراً
وربطة عنقي تخنقني
هل أجلس وركبتاي متلاصقتان على مقعدهما
مقعد الاستجواب العنيف
ولا أَسأل أين غرفة الحمام
ماذا أفعل إذن لأشعر كأني غير ما أنا
شاب يخال فلاش غوردون نوع صابون
آه، ما أفظع أن يجلس شاب
أمام عائلة وتفكر العائلة:
لم نره قط من قبل! ويريد ابنتنا ماري لو!
يسألان بعد الشاي والكعك البيتي ماذا تشتغل؟
هل أقول لهما؟
هل يميلان إليّ والحالة تلك؟
يقولان حسنا تزوج، إننا نفقد ابنة
لكننا نكسب ابناً
وهل أسال إذّاك أين غرفة الحمّام؟”.
وفي الستينات كان الحب الأول هو الذي يستحق كل شيء. وكان الزواج الثاني أو الثالث هو الزواج الأفضل. كان القنطورس متمرداً يختار الشذوذ الجنسي حيناً أو حياة الجنس الجماعي حينا آخر، أو في الحالات التي يكون قد تزوج فيها زواج ربطة عنق مهندمة وثوب زفاف فاقع البياض. يعلن إعلاناً مهذباً في صحيفة محلية عن رغبة زوجين يقدران القيم الاجتماعية في ممارسة الطقس العلني لتبادل الزوجات بين زوجين من الطراز نفسه. هذه هي بعض بؤر المفارقات يقوم عليها العرض المسرحي “أوه كلكوتا” ولكن المفارقة الرئيسية التي يحتفي بها العرض هي التي تعلن عن اكتشاف الخبر السعيد التالي “الاقتصاد هو الجنس”، والخبر السعيد الآخر “الجنس هو الاقتصاد”.
وهكذا يطرح العرض المسرحي مسالة الجنسولوجيا السياسية دفعة واحدة. ليس الإنسان حيوانا عاقلا. ليس إنساناً مفكراً. إنه كائن جنسي مستتر يكشف الاقتصاد كشفا مدهشاً عن قابلياته الفيزيولوجية النشيطة. أما القنطورس من الطراز الآخر، القنطورس الذي لا يحمحم في بالوعة “سوهو” الذهبية، القنطورس المتوحد الذي يدفعه حياؤه ووحدته إلى تجربة الكومبيوتر من أجل الحصول على فتاته حسب خصائص تتكشف من الاستمارة التي يقوم بملء كافة جداولها وخاناتها بمعلومات شخصية عن نفسه يقوم الكومبيوتر بمطابقتها مع معلومات شخصية مماثلة عن فتاته فإن عنفه الجنسي يكون من النوع المضمر المستتر. وإذا كان صحيحاً كما يرى كولن ولسون في كتابه “موسوعة القتل” إنه في كل دقيقة يقطعها عقربا ساعتك ترتكب جريمة قتل في مكان ما من العالم، إذ تحدث في نيويورك جريمة قتل واحدة في اليوم، وفي باريس تقترف جريمتا قتل يومياً، بينما تبدو لندن أشد امتثالاً للقانون إذ ترتكب فيها جريمة قتل واحدة كل أسبوعين، فإن من المؤكد أن هذا الكشف المحافظ لمعدل الجريمة إنما يتصل اتصالا وثيقاً بما يسمى جريمة القتل الجنسي. وقد لاحظت في زيارتي الحالية إلى لندن أن الحدائق الكبرى (الباركات) ومنها “هامستد هيث” على سبيل المجال قد أصبحت لدى حلول الظلام مسرحاً لكمائن الاغتصاب الجنسي. ولهذا فثمة من يحذِّر الفتاة المهذبة دائما بأن تكون على حذر وأن تستسلم بدلا من أن تنتهي باغتصاب مصحوب بحادث خنق بجوربين من النايلون أو بسروال داخلي من قماش فاقع الألوان.
وإذا كانت هذه الصورة شديدة القتامة فإن الصورة الأقل قتامة ربما تمكن ملاحظتها في ما يسمّى “مكتب المواطن” وهو مكتب خاص بحل المشاكل الخاصة وفي طليعتها مشاكل الحب والجنس والزواج والمساكنة. وقد أطلعتني الباحثة الاجتماعية بولين بيترز بعد أن شاهدنا معاً فيلم “التانغو الأخير في باريس” الذي يمثل فيه مارلون براندو دور الهارب من ماض زوجي إلى حاضر عشقي أيروطيقي على ثلاثة نماذج من المشكلات التي تعرض على “مكتب المواطن” قالت إن جون الذي تزوّج في ظروف صعبة يكتب الآن ما يلي:
لا مانع لدي لو أننا تزوجنا بسبب كونها حاملاً. فهذا السبب وجيه لو أنه كان السبب. إنها تتناول حبوب منع الحمل، وسيكون من الحمق إنجاب طفل في غرفة واحدة. حياتنا العاطفية جيدة ولكنها لا تستحق هذا العناء لا أستطيع أن أقسم ولكن أعتقد أنها سعيدة. طموحها منزل وأولاد وآمل أن يتحقق ذلك. وهذا سيحدث لأنني لن أتركها الآن. أعلم أنني لن أفعل. لا أستطيع المجازفة بذلك. لا أستطيع عندما تكون حساسة إلى هذا الحد. ثم إنني استلطفها كما ترين!”
وقالت إن جيرمي يكتب:
“بالطبع أنا أردت الزواج منها. كان الأمر عظيما خلال السنوات الثلاث الأولى. ولم أكف آنذاك عن التفكير فيما إذا كنا سعداء فعلاً أم لم نكن. وعندما أقود السيارة أحياناً أنظر إلى صفوف المنازل التي يركب واحدها الآخر وأفكر: يا جحيم.. إن في كل منها بائساً امتصت منه زوجته كل رغبة في الصراع.”
وقالت إن هنري النموذج الثالث يكتب:
لسنوات هددت أنا وإليانور كل منا بالطلاق. وتأخر التنفيذ إلى حين يكبر الأطفال. كبر الأطفال الآن، ولكني لا أستطيع أن أرى ذلك يحدث الآن لأنني لا أستطيع أن أنفق على بيتين في وقت واحد. يمكنني أن أنتقل إلى غرفة وأعتقد أنني كبير السن الآن لأفعل ذلك. وعلى أيّ حال فالطلاق معناه أن تقف على المنبر لتعترف أن حياتك كانت خراباً لفترة واحد وعشرين عاماً. هذا مذل. ولكن حتى لو أمكنني مجابهة ذلك.. أتدرين أنني لا أعتقد أن لديّ مسوّغات كافية. أن يكون المرء غير سعيد وألا يستلطف زوجته ليسا مسوغين كافيين، أليس كذلك؟
إن هذه الصورة التي تفتقر إلى الحسم تذكّر بإحدى مقالات غراهام غرين التي أرّخ فيها لسيرته الذاتية. ويخبرنا كولن ويلسون أن عنوان هذا المقال “المسدس في الدرج الجانبي”، وقد شرح فيه هذا الوضع النفسي بوضوح عظيم. وبيّن كيف كان يلعب لعبة الروليت الروسية بمسدس يمتلكه شقيقه، وذلك بعد أن أفلح علاج التحليل النفسي في شفائه وجعله يشعر بالاهتمام تجاه الآخرين.. ولكن مع الإحساس الكامل بالسأم من الحياة.
“أعتقد أن السأم كان أعمق من الحب بكثير. وكان دائماً مظهراً من مظاهر الطفولة. وخلال سنوات لم أكن لأشعر بأيّ اهتمام جمالي، بأي شيء مرئي على الإطلاق. فعندما كنت أحدق بمنظر أكد لي الآخرون أنه جميل، لم أكن لأشعر بشيء. لقد كنت مصلوباً على خشبة السأم”.
وأخذ المسدس ووضع رصاصة في طاحونته ثم سدد إلى رأسه وضغط على الزناد. وعندما هبطت مطرقة الزناد، شعر بانفراج دارة التوتر.
***

إن انفراج دارة التوتر هذا الذي كان يرجئ الحسم باستمرار في الصور الثلاث التي ألمحت إليها الباحثة الاجتماعية بولين بيترز ويمكن للمرء أن يكتشف في هذا التحليل بعض الثغرات، ولكن من الذي يدّعي أن للحقيقة وجهها الوحيد.
عندما خرجت من إحدى الحانات الصغيرة في سوهو كانت كلمات مارغا ماتزال تطن في أذني. مارغا تخلط بين العربي وبين الأعرابي.
مارغا النادلة ترى أن كل عربي أعرابي، وأن كل أعرابي ثري. وما دمت عربيا فأنت ثري. وما دمت ثرياً لا يمكن أن تسأم. ولكن ماذا عن السأمان العربي الفقير الذي يخجل من الإعلان عن سأمه قدر خجله من الإعلان عن فقره؟
الفتيات يتظاهرن بعدم الاكتراث. يقفزن من زقاق لولبي إلى زقاق لولبي آخر في بالوعة سوهو الذهبية. القنطورس يحمحم. إنه متفرج ولديه جنيّته الإلهية، معدنية التألق، مرنانة الصوت، ومسدلة الشعر. وقبل لحظات كان يقول: مارغا، النادلة الألمانية الأصل مفاخرا:
“في سوهو لا يأخذ الحب مظهراً رسمياً أو مظهراً طبياً كما في هامبورغ مثلا. أنا أعرف هامبورغ. إن مركزها الإيروطيقي أشبه بالسجن. إنه مريح جداً لكنه سجن. إنه ليس المكان الذي يريده الذكر. الذكر لا يحب الجنس المفتعل، الجنس المنظم تنظيم العيادات الطبية. مركز هامبورغ أشبه شيء بمحطة البنزين. إنه مكشوف أكثر مما ينبغي”.
وعلى مقربة من سوهو لا يأخذ الاقتصاد، كالحب، مظهراً رسمياً أو مظهراً طبياً. إن أحد مراكزه الرئيسية المتعددة محلات ماركس أند سبنسر التي تدفع لإسرائيل جعالة سنوية تقدر بالملايين من الجنيهات. وقد كانت جمعيتها العمومية تجتمع في فندق الدوشيستر الشهير الذي ابتاعه العرب مؤخراً، ولكنها أعلنت أنها ستكفّ عن استعمال ردهة الفندق لهذا الغرض ما دام الفندق قد آلت ملكيته إلى العرب، ومع ذلك فالعرب هم الزبائن الدائمون المتسامحون الذين يتدافعون بالمناكب في جميع فروع محلات ماركس آند سبنسر. العرب متسامحون رغم لوائح مقاطعة إسرائيل، وقد نشرت إحدى الصحف اليومية هنا خبراً مفاده أن أحد الأثرياء اتجه إلى محل للأحذية وهو يحمل صورة إعلان يصف نوعاً من الأحذية النسائية بأنه Very sexy أي حذاء يتسم بجاذبية جنسية فائقة، وطلب شراء كل ما في المحل من هذا النوع من الأحذية. وتساءلت الصحيفة بتهكم: يريد أن يفتتح محلاً للأحذية، أم يشبع نهم نسائه النهمات؟
تزمين نص مستعاد
مرَّ نصف قرن على كتابة هذا النص السيري المنزع والواصل بين الذات والموضوع. وفي هذا المستوى أقرأه الآن نموذجاً مرجعياً، باراديم، للنقد الثقافي. الكاتب في هذه الحالة، شأن المتصوف المادي، يتلاشى بوصفه أنا، ويبقى النص سرداً واقعياً لمركزية الآخر. وهذه السردية تظل قرين الشطح المادي. ليس في السردية هنا هذيان أو تخليط أو هلوسة. بل ثمة حاجة إلى قراءة مكملة، إلى تزمين. في ثمانينات القرن الماضي كان المحافظون يرددون بصمت أنه لا مبادىء ولا عقائد ولا نظريات في الاقتصاد. ولكن الثاتشرية سرعان ما حولت البعد الصامت إلى بعد صائت. اختارت مارغريت ثاتشر مُنظراً عقائدياً لحزب يكره التنظير والمنظرين اسمه ملتون فريدمان. والمفارقة الأولى التي ترتبط بهذا الاسم أنه أميركي وليس بريطانيا. أما المفارقة الثانية فتكمن في أنه العدو اللدود لأي تدخل للدولة في الاقتصاد. اخترع فريدمان الحائز على نوبل مذهب النقد أو المال الحرّ “المونيتيريزم”. وفي كتابه: “حرية الاختيار” شرح للعقيدة الاقتصادية التي تعيدنا إلى مرحلة بداية الرأسمالية في الولايات المتحدة: لا وجود للدولة في أي قطاع للخدمات ولا وجود لها في أي إطار من أطر الاقتصاد. إذا انهار مرفق اقتصادي فالدولة ينبغي أن لا تساعده على البقاء. التدخل عنده معرقل للدورة الاقتصادية الطبيعية. الوجود في ظاهره وباطنه هنا صار مماثلا للاستهلاك.




