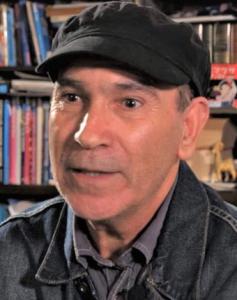المثقفون ليسوا ملائكة

كان الموسيقار الألماني ريتشار فاغنر من المعادين الكبار للسامية وقد كتب نصوصا أقل ما يقال عنها إنها تفوح كراهية ضد اليهود إذ اعتبرهم في أحد نصوصه تلك كطبيعة مشوهة وكان ذلك أحد أسباب خصومته مع صديقه الفيلسوف نيتشه. وقد حاول نظام هتلر أن يستعمل ذلك في ترويجه للفكر النازي وقد استغل زوجة ابن الموسيقار التي كانت تجمعها صداقة بهتلر ذاته. وحاول هذا الأخير بكل الوسائل أن يجعل من فاغنر أبا شرعيا للأيديولوجية النازية وقد صرح يوما بأن ليس لها من سلف آخر سوى فاغنر. وقد قال المخرج الأميركي ودي آلان في خرجة من خرجاته الظريفة: حينما أكثّر من الاستماع إلى موسيقى فاغنر، تتملكني رغبة في احتلال بولونيا.
وهم ليسوا جهلة أو برابرة حاقدين على العقل والثقافة، هؤلاء الذين نشاهدهم في تلك الأفلام القديمة الشهيرة وهم يحرقون أطنان الكتب في شوارع برلين سنة 1933، بل هم طلبة فضلوا تطهير مكتباتهم الجامعية من الأعمال التي كانوا يرون أنها ليست جرمانية بالقدر الكافي وقد شارك في تلك الأفعال المخلة بالعقل الكثير من أساتذة جامعاتهم. وقبل أن ينتشر بين الجماهير الألمانية الواسعة وينتصر سياسيا، انتصر فكر هتلر في انتخابات الجمعيات الطلابية مثلما حدث مع الفكر الإسلاموي تماما، إذ اكتسحت منظمات “الإخوان الأشبال” مجمل التمثيل الطلابي في كل من مصر والجزائر قبل أن يفوز “الأصوليون الأكابر” في الانتخابات العامة ثم يتحولون إلى إرهابيين.
ولئن اختار كثير من المثقفين الألمان المنفى في الثلاثينات مع صعود الحزب القومي الاشتراكي، فالأغلبية فضلت البقاء وخدمة النظام التوتاليتاري الهتلري بطريقة أو بأخرى. ومن بين الذين اختاروا الانضمام إلى أيديولوجية العار نجد أسماء شهيرة مثل كارل شميت وارنست يونغر وغيرهما. أما الأساتذة على اختلاف اختصاصاتهم ومع الأسف حتى أساتذة الفلسفة واصلوا، وكأن شيئا لم يكن، التدريس والنشر تحت مظلة هتلر، ما عدا الذين كانوا من أصول يهودية أو من اليسار الراديكالي أو من دعاة السلام والذين فروا خوفا من بطش النازية. أما العلماء الألمان فأغلبهم قد نزل إلى سفه لم يسبق له مثيل، فكانوا رواد العلم النازي، علم التجارب العنصرية، علم الموت.
ولكن ما يبقى محيرا فعلا هو حالة مارتن هيدغر ذلك الذي يعتبره الكثيرون أهم فيلسوف في القرن العشرين! لقد عيّن صاحب “الكينونة والزمان” سنة 1933 عميدا لجامعة فريبورغ وانضم في نفس الفترة إلى صفوف الحزب النازي. يقول مواطنه الفيلسوف يورغن هبرماس لجريدة لوموند الفرنسية (08 /11 /2014) إنه قرأ في “الكراسات السوداء” ما كان كافيا لإدانة هيدغر، ولم يكن ذلك مفاجأة بالنسبة له إذ لم يكن يخفى على قراء اللغة الألمانية تلك الحمولة النازية في لغة هيدغر. ويضيف هابرماس أن الرجل كان نازيا ولكن ما يبعث على الأسى يقول إنه لم يتنكر لماضيه بشكل صريح وعلى الملأ رغم إلحاح تلميذه هربرت ماركوز بعد نهاية الحرب. ومع ذلك ورغم صدور “كراساته السوداء” سنة 2014 التي يشير إليها هابرماس والتي تفضح وجهه الحقيقي، لا يزال يجد في فرنسا على وجه الخصوص من يدافع عنه ويحاول تبرئة ذمته! وربما نجد تفسيرا للاحتفاء الدائم بهيدغر في فرنسا في ذلك الوصول المحزن الذي حظي به فكره في البلد بعد 1945، استقبال محبك جيدا من طرف هيدغر وساذج من طرف القراء الفرنسيين، كما يقول هابرماس نفسه.
ولم يكن موقف معظم المثقفين في كل من فرنسا وبريطانيا بعيدا عن إخوانهم الألمان في مسألة الاستعمار الممارس من طرف بلديهما، فكما كان معظم المفكرين الألمان غير معنيين بمناهضة النازية، كان المفكرون الفرنسيون والبريطانيون في معظمهم غير مستهجنين للاستعمار وغير مكترثين لوضع المستعمَرين في أفريقيا وآسيا. وربما يكون المفكر الشهير أليكسي دو طوكفييل أكثرهم شراسة في الأمر فحينما وصل إلى الجزائر سنة 1841 كتب دون لف ولا دوران “لقد سمعت أحيانا في فرنسا أناسا أحترمهم يقولون بأنه من السيء أن يتم حرق المحاصيل، وأن يقع تفريغ مطامير القمح وأن يلقى القبض على الرجال غير المسلحين، وأيضا على النساء والأطفال. وأنا لا أوافق هؤلاء السادة على مثل هذا الكلام، وأرى أن مثل هذه الأعمال المؤسفة ضرورية لشعب يرغب في شنّ حرب ضد العرب بهدف جبرهم على الرضوخ له”.
وليس هذا فحسب بل يضيف المفكر محرضا على التخريب واللصوصية قائلا “أعتقد أن واجب الحرب يسمح لنا بأن نخرّب البلد وأن نفعل ذلك، إما بتدمير المحاصيل الزراعية وقت الحصاد والجني، وإما بالقيام في كل الأوقات بهجمات يكون الهدف الأساسي منها إلقاء القبض على الرجال والاستيلاء على قطعان الغنم والدواب”. لقد كان صاحب “الديمقراطية في أميركا” ذائع الصيت والمبرمج في كل مراحل التعليم الفرنسية صديقا للكاتب العنصري أرتور غوبينو وحتما يشتركان في ذلك الشعور المتعالي بالانتماء إلى عالم المدافعين عن النظام الاجتماعي التراتبي والذي ليس للديمقراطية فيه من مزية واحدة هي كونها تثبيت حكم النخبة التي تستفيد من عمل الشعب.
أما مواطنه صاحب “البؤساء”، فيكتور هوغو، فلم تأخذه رأفة ولا رحمة تجاه البؤساء الجزائريين تحت الاحتلال بل كان من المتحمسين لاحتلال بلده للجزائر سنة 1882، تلك الجزائر التي تحمل اسمه اليوم الكثير من شوارع مدنها! هو المعجب بالجنرال السفاح بيجو “أعتقد، يقول لصديقه، أن غزونا الجديد أمر عظيم ومفيد. إنها الحضارة تدوس على البربرية. إنه شعب مستنير يتجه نحو شعب يعيش في عتمة الليل. نحن إغريق العالم، وعلينا أن ننشر النور في العالم”. وعلى رغم المجازر التي ارتكبها صديقه بيجو وعصابته في الجزائر، لم ينبس من يصنف من بين الإنسانيين الكبار ببنت شفة، وواصل تبرير وتمجيد الاستعمار إلى آخر يوم من حياته. لقد كتب سنة 1862 كلمات بائسة في حق الأفارقة: “ليس لأفريقيا تاريخ، بل مجموعة من الأساطير الغامضة.. في القرن التاسع عشر حوّل الرجل الأبيض الأسود إلى إنسان وفي القرن العشرين ستحول أوروبا أفريقيا إلى عالم”.
وتستمر تلك السلبية وعدم الاكتراث إزاء الأنظمة التوتاليتارية في شرق أوروبا وآسيا خصوصا وحتى في أفريقيا إذ لم تعارض النخب الغربية تلك النظم فحسب بل انبهرت بتلك التجارب وصار الكثير من المثقفين المحسوبين على التنوير من المدافعين عنها جهارا نهارا دون أدنى اعتبار للشرور التي كانت ترتكب فيها باسم التقدم والعدالة الاجتماعية ومناهضة الإمبريالية وغيرها من اليافطات التضليلية.. وقد أصبحت الماوية والكاسترية (نسبة إلى فيدال كاسترو) موضة في فرنسا وأوروبا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وقد بدأ انبهار المثقفين بشعارات الإخاء والمبادئ الإنسانية والتقدمية ومخططات ستالين الخماسية في الثلاثينات ولم يسلم من ذلك حتى جورج برنارد شو. أما برتولت بريخت وبابلو نيرودا ولويس آراغون فقد كانوا يرون في ستالين أنه “شمس الشعوب” وفي الشيوعية السوفييتية التجسيد للعقلانية الإنسانية.
وكان جان بول سارتر مثالا لضلال المثقفين الذين تواطؤا مع مختلف أشكال العنف المسمى ثوريا في القرن العشرين. لقد ساند صاحب “الوجودية مذهب إنساني” أنظمة ومجموعات إرهابية لم تكن تعير أدنى اهتمام للإنسان، من الاتحاد السوفييتي والدول الشرقية الدائرة في فلكه ومرورا بصين ماو ووصولا حتى إلى تبرير جرائم عصابة بادن بادن وقد ذهب حتى إلى التقليل من ضحايا الثورة الثقافية التي قام بها سفاح بكين ونشر 18 مقالة مؤيدة لفيدال كاسترو وثورته. لقد ناصر حتى الدكتاتور الكوري الشمالي كيم إيل سونغ!
فمن حق هذا المواطن العربي وخاصة إن كان ليبيا أن يتساءل عن السبب الذي جعل أدباء من كل حدب عربي وصوب يأتون إلى الجماهيرية العظمى ذات عام لمناقشة أدب القائد معمر القذافي وليحللوا مجموعة قصصية ساذجة شكلا ومضمونا وتحت يافطة مأجورة “القذافي كاتبا ومبدعا”؟ كيف يمكن أن يشارك ناقد أدبي في وليمة دعائية يبذر من أجلها النظام الليبي
لقد كانت الشيوعية بكل أشكالها أفيون بعض المثقفين في الغرب والشرق. في الاتحاد السوفييتي لم يكن كل المثقفين أندري سخاروف أو ألكسندر سولجنيتسين أو غيرهما من المنشقين المقاومين، لقد كان المئات من الأساتذة والعلماء والصحافيين والسينمائيين وغيرهم من منتجي الثقافة والعلم من المساندين الأوفياء لدكتاتورية الحزب الشيوعي السوفييتي ورجاله. وقد وهب مبدعون كبار فنهم وضمائرهم إلى جهاز بيروقراطي وبوليسي قتل وهجّر الملايين، وكان غوركي ومايكوفسكي من هؤلاء. وليس هذا فحسب، ففي الوقت الذي وصل فيه القمع والـتأميم القاتل أوجه سنة 1931، كتب غوركي مقاله الشهير في أكثر من 5000 كلمة ضد المثقفين الغربيين الذين يتجرؤون على الاحتجاج على ما يحدث في بلده العظيم، وكان تحت عنوان “رد على مثقف” وفي الحقيقة هو عبارة عن ترديد ولو بطريقة أجمل وأذكى لشعارات اللجنة المركزية لحزب السوفييت.
وإذا عدنا إلى الصين وثورة ماو الثقافية التي دمرت جزءا كبيرا من الشعب الصيني وخاصة في الأرياف، فسنجد أن معظم من استعملوا كرأس حربة في فرض الرعب على الناس كانوا من الشبيبة المثقفة، طلبة ثانويات وجامعات. وقد امتد ذلك المرض حتى إلى الشبيبة المثقفة في الغرب وباتت تساند الشمولية الماوية في أهم المراكز الجامعية والمدارس العليا بباريس ويمكن ذكر بعض من هم اليوم من الأسماء المعروفة كالكاتب فيليب سولير، والباحثة والمحللة النفسانية جوليا كريستيفا، وسيرج جولي مدير جريدة ليبيراسيون السابق وأحد مؤسسيها مع الفيلسوف جان بول سارتر.
ولن نبالغ إذا قلنا إن من أطلقوا على أنفسهم في فرنسا اسم “الفلاسفة الجدد” قد ولدوا من رحم تلك الموجة الماوية التي هزت فرنسا وأوروبا ابتداء من سنة 1956، وهي الموجة التي خلفت الموضة الموالية للستالينية التي امتدت من 1945 إلى 1956 في فرنسا. ولم يعد سرا أن كلا من الفيلسوف أندري غلوكسمان، برنار أونري ليفي، ألان فيلكنكروت، باسكال بروكنر وبلوندين كريغل وغيرهم كانوا من الثوريين المعجبين بالماوية الصاعدة التي كانت تكتسح مناطق كثيرة في العالم آنذاك. وهم اليوم في أغلبهم إلى المحافظين الأميركيين الجدد أقرب، ومن المنحازين إلى النظام في إسرائيل متجاهلين حقوق الشعب الفلسطيني.
وحتى وإن بدا الفيلسوف الفرنسي روبير ميزراحي، اليهودي الأصل بعيدا عن هؤلاء من الناحية الفكرية، فنحن معه أمام رجل طلّق النزاهة ثلاثا وسقط سقوطا حرا في مانوية مضحكة كئيبة في تناوله للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فدفاعه عن دولة إسرائيل هو دفاع مطلق وحق اليهود في إقامة دولتهم على أرض فلسطين لا نقاش فيه ولا يحق لأحد أن يتساءل في هذا الأمر الواقع وإلا عدّ من المعادين والحاقدين على اليهود.
أما في عالمنا العربي فلا يختلف أمر المثقفين عن غيرهم في بقاع الأرض الأخرى ونظرا للوضع غير الديمقراطي الحاصل كان المواطن العربي ينتظر دائما من المثقفين عدم الوقوف مع الحكام المستبدين بشكل صريح، إذ ذاك تشجيع لهم على المضي في غيّهم. ولذلك فمن حق هذا المواطن العربي وخاصة إن كان ليبيا أن يتساءل عن السبب الذي جعل أدباء من كل حدب عربي وصوب يأتون إلى الجماهيرية العظمى ذات عام لمناقشة أدب القائد معمر القذافي وليحللوا مجموعة قصصية ساذجة شكلا ومضمونا وتحت يافطة مأجورة “القذافي كاتبا ومبدعا”؟ كيف يمكن أن يشارك ناقد أدبي في وليمة دعائية يبذر من أجلها النظام الليبي ملايين الدولارات من أموال الشعب الليبي؟ كيف يتظاهر القوم بدراسة نصوص قصصية منسوبة للقائد كتبها له غيره؟ وحتى وإن كانت نصوصا خارقة للعادة، فهل يستحق صاحبها كل ذلك التطبيل وهو المستعبد لشعب بكامله؟ ومن العجيب المضحك أن تقدم جائزة تحت مسمى “جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان” ويزمر لها الكثير من المتزلفين وهم يعلمون أن ذلك السيد كان يعبث بحقوق الإنسان في ليبيا ويعتدي على البشر حتى خارج ليبيا ويعترف بجرمه ويدفع ملايين الدولارات لأهل ضحاياه.
فهل تستحق مجموعة القذافي القصصية “القرية القرية، الأرض الأرض، وانتحار رائد الفضاء” كل ذلك الكم النقدي أم أن الأمر مجرد تملق وتكسب؟ إبراهيم الكوني درس المكان الأسطوري في تلك القصص! والروائي المبدع والباحث المدقق واسيني الأعرج تناول “المدينة والمثال في مجموعة معمر القذافي القصصية”! ومن الجزائر يكتب ناقد محترم آخر، نورالدين السد، بحثا حول “الأبعاد الدلالية في الخطاب القصصي للقائد الأديب معمر القذافي”! ومن أرض الروائي الثائر كاتب ياسين أيضا يتحدث الشاعر عزالدين ميهوبي، وهو اليوم وزير للثقافة في نظام بوتفليقة، عن “البعد الإنساني في إبداعات معمر القذافي”! أما الدكتور عثمان بدري أستاذ النقد الأدبي الحديث بجامعة الجزائر فلا يتحرج أبدا ويعنون بكل جرأة “الدلالة المفارقة للمكان في الخطاب الأدبي للقائد، المبدع، معمر القذافي”.
تلك عينة من قائمة طويلة تتضمن أدباء من معظم البلدان العربية، كلهم وجدوا في معمر القذافي الأديب والمبدع. فهل يمكن أن يكون أديبا من يجد صعوبة حتى في الكلام بالدارجة الليبية؟ كيف استطاع الروائي الليبي إبراهيم الكوني أن يبقى صديقا وفيا لمجنون طرابلس مدة 40 عاما؟ ولن أتساءل حتى عن الأسباب التي جعلت جابر عصفور يقبل جائزة معمر القذافي العالمية للآداب بقيمة 150 ألف دولار، فللرجل سوابق ولواحق. ويعرف الناس أن الجائزة عادت إليه بعدما رفضها الكاتب الإسباني غويتسولو مصرحا بأن الأمر لا ينسجم مع أخلاقه وأنه لا يهادن الدكتاتوريات. ولن يصدم البتة من يعرف سوابق الرجل بتلك السهولة التي وقع فيها السيد المفكر المحترم جابر عصفور في مصيدة آل مبارك. كيف يعقل أن يقبل ناقد في قامة عصفور تولي وزارة الثقافة في حكومة أقل ما يقال عنها إنها كانت ضد حركة الشارع المصري المطالب بالتغيير والديمقراطية؟ كيف يمكن لإنسان عادي أن يتوزّر في تلك الظروف؟ فما بالك إن كان الرجل من البشر المثقفين الذين يدّعون الحداثة والتقدم؟
ألم يؤيد الروائي الجزائري الشهير رشيد بوجدرة، المتبجح بالاشتراكية وحقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين تلك الزيارة المشؤومة التي قام بها وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبدالقادر مساهل إلى دمشق لزيارة بشار الأسد؟
لو لم أكن أعرف جنون عظمته لكنت استغربت من شطحات الرجل الغريبة بين الفينة والأخرى، ولكن أن يصل الروائي الجزائري رشيد بوجدرة- ذلك الذي يدعي الوقوف بجانب العدالة الاجتماعية ومحاربة الظلم ومناصرة اليسار منذ عقود- إلى الانضمام إلى منطق الأسد قاهر شعبه فهذا ما لم أكن أتصوره على الإطلاق. لم يخطر ببالي أن يتفكك صاحب “التفكك” بهذه الطريقة الحزينة ويبلغ هذا المستوى من اللا مبالاة وقصر النظر، إذ عاكس تماما ما يقوله مثل شعبي جزائري “سكران ويعرف باب داره” بمعنى يمكن أن يكون الإنسان ثملا ولكن لا يمكن أن ينسى عنوانه. ولكن يبدو أن السيد رشيد بوجدرة قد نسي عناوينه السابقة كلها وكل مبادئه وراح يصطف وراء نظام الظالم بشار بدعوى محاربة الإرهاب الإسلاموي. ففي الوقت الذي استنكر فيه كل المثقفين الجزائريين الأحرار والرأي العام بصفة عامة تلك العلاقة المشبوهة التي تجمع بين النظامين في الجزائر ودمشق، وندد بالزيارات المتبادلة بينهما، لا يتردد الروائي رشيد بوجدرة في نشر مقال على موقع “كل شيء عن الجزائر” في نهاية شهر أفريل 2016، يشيد فيه، من دون حياء، بتلك الزيارة المشؤومة والتي اعتبرها دلالة على جرأة الدبلوماسية الجزائرية بصفة خاصة والدولة بصفة عامة. فالمسألة مسألة جرأة وحسب،إذ لا دولة عربية تملك الجرأة على القيام بمثل ما قام به النظام الجزائري والذي هو على عكس كل الأنظمة العربية الأخرى، يقول بوجدرة، لا يهاب من الغول الأميركي ولا من الصقر السعودي. ويذهب الكاتب إلى اعتبار الزيارة الجزائرية إلى دمشق والتهاني الموجهة عبرها من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى أخيه بشار الأسد بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال سوريا عبارة عن تحد حقيقي إلى كل الناهبين المفترسين في العالم كله.
ولكن لماذا لا يرد المثقفون الجزائريون الأحرار على تخاريف الرجل السياسية والأدبية والفكرية المتكررة منذ سنوات؟ أعتقد أن ذلك يعود لسببين اثنين:
يعتبر البعض منهم أن الرجل انتهى إبداعيا وكل ما يقوله مجرد تسجيل حضور، ولذلك لا يتعبون أنفسهم في الرد على أوهام لا تستحق، في نظرهم، أدنى تعليق. ولا يريد آخرون توريط أنفسهم في سجال مع رجل سليط اللسان ولا يتوانى في قذفهم واتهامهم بأمور قد لا تخطر على بال أحد كما سبق أن فعل مع الكثيرين، فقليل من الكتاب الجزائريين والعرب والأجانب من سلم من نقده اللاذع المجاني وجنون عظمته.