المرأة والفكر
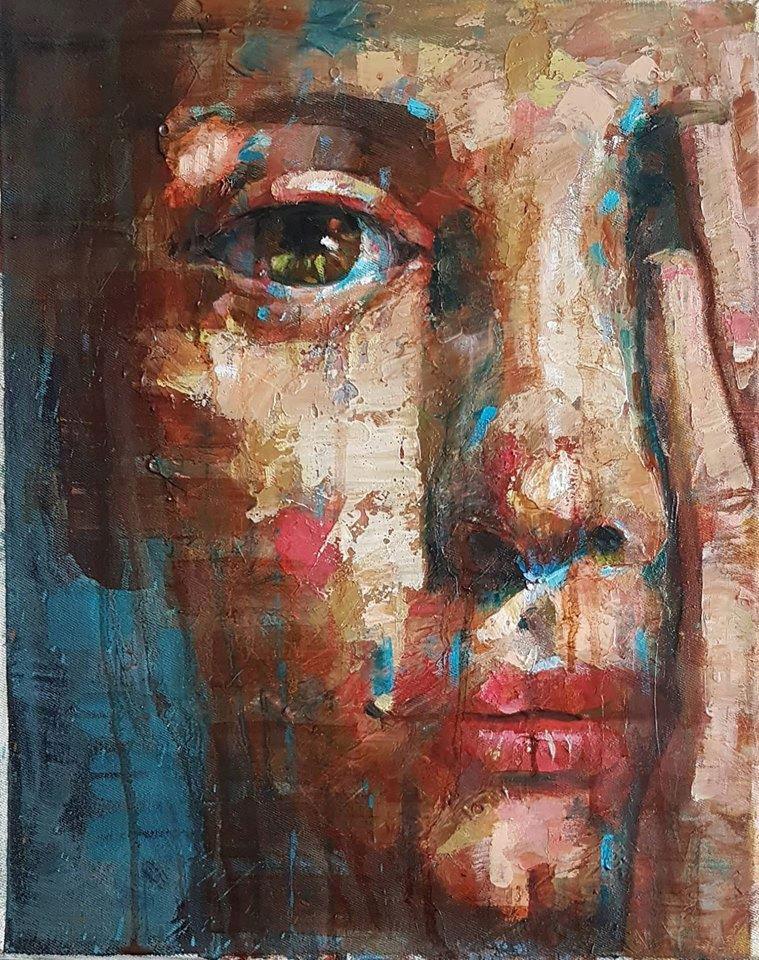
“نقطة الانطلاق لا قيمة لها بدءًا؛ إلا بفضل قدرتها على محاكاة نقطة الوصول”. (جيل دولوز)
إن البحث عن المرأة الناقدة وصاحبة الفكر الحر أمر يعد صعبا في ثقافة تحاول تكريس سردياتها التي ترفض التغير والتحول رغم التحولات العالمية في مجال الحقوق، وبطبيعة الحال فإن الذي يبحث في مشاكله انطلاقا من واقعه الثقافي العربي بوصفه وليد منظومة ثقافية مختلفة عن الغرب فإنه يمنح العربي أفق للإضافة والتجديد بدل أن يناقش الأمر من زاوية غربية. فالثقافة العربية ثقافة تجسد منظومة عربية إسلامية تيولوجية لها معاييرها الموروثة التي تحتاج إلى مقاربات نقدية من داخلها؛ لكن لا على أساس مفكري الهوية الدوغمائية بل على صعيد القراءة التي تستثمر المنجزات المعاصرة وخصوصا في مجال الحقوق وما تقدمة من ممكنات تجعلنا قادرين أن تكون لنا إضافتنا المقترنة بخصوصيتنا الثقافية. إما محاولة الاندماج في معايير الغرب وتكرارها يجعلنا مجرد شراح ومقلدين للآخر وهذا يعني أن تكون لنا آلياتنا في الانطلاق من واقعنا الذي يمنحنا خصوصية في مقاربته نقديا.
يقتضي البحث عن تلك الحقائق منهجا يقوم على مخالفة لا تهادن بل تعمل على تفكيك المكونات؛ لأن التمركز هو نوع من التعلق الهوَسي بتصوّر مزدوج عن الذات والآخر، تصوّر يقوم على التمايز والتراتب والتعالي، يتشكّل عبر الزمن بناء على ترادف متواصل ومتماثل لمرويات تلوح فيها بوضوح صورة رغبوية انتقيت بدقة لمواجهة ضغوط كثيرة. وينبغي نقد الطرق البارعة للسرود التي تنتظم حول حبكة دينية أو ثقافية أو عرقية مخصوصة، فتخضع الأفكار والتصورات لتلك الحبكة التي تظل يقظة في إثراء تمجيدي للذات، وخفض تبخيسي للآخر، ويصعب تخطّي ثقافة المطابقة دون نقدها، ويصعب تحقيق الاختلاف دون الحوار.
إلا أن تلك السرود لا تخلو من التدخلات المظفورة بين المعرفة والقوة من أجل السيطرة على المعنى وإن اعتمدت العنف الرمزي والتي بتحليلها لعلها تهدينا إلى تلك الحلقة المفقودة الجامعة بين صور الذات المهيمنة وصورة الأخر المقصيّة، فإن تناولنا يتخذ الطابع الحواري القائم على كشف التمركز الذي يحيلنا إلى تلك الأطياف التي تحيا حياتها داخل العقول على سبيل القيم والسلوك الاعتقادي والتي رسخت في اللاشعور غير القابل إلى المراجعة وكأنه يقين صارم لا يقيل النظر والمناقشة على سبيل التشخيص والتعليل، وهي تمثل نزوعا يعبّر عن القوة الميالة إلى الهيمنة والنفوذ، وبالتالي المصلحة الذاتية من خلال عدم التردد في مساءلة أفكارنا إذا أردنا أن يكون ما نفكر فيه مؤسسا بشكل متين. وهذا يتحقق من خلال جعل الاحكام المسبقة محل النقد والنظر، إذ من الناحية الفلسفية يعتبر حكما مسبقا كل رأي معتمد دون تحليل مادام مفترضا بوصفه صادقا أو صحيحا قبل الحكم عليه أي غير خاضع لتقويم نقدي.
هنا تأتي ضرورة تطوير آليات الحوار والتبادل حتى تمكننا من إعادة النظر في آليات الفهم وتفكيك الأوهام القارة والتي تحول دون اندماجنا السوي بالحضارة التي أصبحت فيها المصائر متشابكة بعيدا عن مناداة الهوية والتهويمات وقيم البداوة وأخلاقيات الاستمتاع والإمتاع والمؤانسة التي تحط من قيم الإنسان وتحوله إلى كائن مستهلك. هذه كلها مجتمعة تصنع المحن الذاتية وتؤدي إلى الإقصاء المتبادل والذي يقودنا إلى تدمير علاقتنا بالتراث والآخر والحاضر وبعده الوجودي الذي يتعرض اليوم إلى الانهيارات والصدمات والتحولات، ورغم هذا مازال فكرنا -بثنائياته الضدية وأفكاره الأحادية- سجين عوالمه المستحيلة المتناقضة مع الواقع والتي تمثل الآخر التراث أو السلطة الاجتماعية التي تكون هويتنا على أنه ذلك “الآخر” الذي يصبح “تعرّفه المخطئ” علينا جزءا من هويتنا. فالتمثيل المخطئ الذي يعكسه يؤدي بنا إلى تمثيل أنفسنا خطأ لأنفسنا، ويصبح هذا التمثيل المخطئ حجر الزاوية في هويتنا.
وهذا التمثيل المخطئ يشير له علي زيعور ويبدو أن الدراسات التراثية العربية في المرأة -الغزالي، إخوان الصفا، الفقهيات، والقطاع الجنسي عموماً- لا تعنى بالمرأة مدلولا واعيا، أو “الأنا ” الواعي، في الإنسان؛ إنها تعني ما نسقطه على الشيطان في مدلولاته التي تكشف عن اللاوعي والمكبوت والظلّي والمعتم، وكل هذا بحاجه إلى زحزحة عن تمركزاته وانجراحاته ونهاياته التي لا تزيدنا إلا ضعفا على ضعف، لهذا نريد هنا أن نمارس القراءة على سبيل النقد والتجديد في قواعد الرؤية والمعاملة بعيدا عن عقائد التمايز والإقصاء على أساس التجييش والتخوين، والتعبئة التي لا تحل ما نعانيه من عزلة اختيارية عن العالم المعاصر الذي يعيش صيرورة هائلة والذي يتشكل ويتغذى أفقه من خلال اتساع معناه بقدر ما يتشكل ويغتني من الطفرات المعرفية والتحولات الحضارية والاجتماعية، في حين أننا مازلنا نعيش ضمن العوالم المستحيلة المتناقضة مع الحياة ومجرياتها، وهو كذلك عالم تحكمه رؤية قروسطية متخلفة تتخللها نظرة ما ورائية سحرية أسطورية إلى الوجود ومازال المرء ينتمي إلى ما قبل الأزمنة الحديثة يعيش وفق المعايير القديمة ويتصرف بطريقة لا تبعد كثيرا عن ردود أفعال في وقت تتعدد الدلالات وتتصاعد الإمكانات، ويبقى عالمنا ينتظر من ينقذه لا على سبيل القطيعة ولا على سبيل المماهاة مع ما هو قائم، لأن المماهاة مستحيلة، كما أن الانقطاعات جهل وعبث. وإنما يتعلق الأمر بتوظيف الأصول والتراثات لخلق عالم جديد أو على الأقل المساهمة في تشكيل العالم المعاصر.
تلك المماهاة التي تودي إلى تقبل ما يشكله الآخر عنا مما يدفعنا إلى التواطؤ ضد أنفسنا من خلال تقابلات ثنائية مرتبة سلّميا. علوي سفلي، الأساطير، الخرافات، الكتب، الأنظمة الفلسفية. عندما يتعلق الأمر بالترتيب، ينظم قانون ما يمكن التفكير فيه عن طريق تقابلات ثنائية، يستحيل التوفيق بينها؛ أو جدلية، يمكن تلطيفها. وكل التقابلات هي في الحقيقة أزواج كما في رجل-امرأة. ماذا يعني هذا؟ هل كون الكلمة مركزية تخضع الفكر، كل المفاهيم، الشيفرات، القيم، لنظام ذي طرفين، هل له علاقة بالتقابل رجل-امرأة؟
كما يظهر في هذا التقابل: طبيعة/تاريخ طبيعة/فن، طبيعة/عقل، عاطفة/فعل( )؛ لأنه ما من شكّ أنّ التحولات التي شهدتها المجتمعات العربية، إن كان ذلك على مستوى نمط العيش أو أشكال التواصل أو نمط المعرفة القائم على استثمار ما أفرزته الحداثة من قيم، قد أجبرت الإصلاحيين على النظر في منزلة الأنثى ومن ثمة طرحت قضية التعليم وقضية العمل وحق المرأة في الخروج وغيرها من القضايا، حيث تم إقصاء المرأة حتى على المستوى اللغوي إذ يشير نصر حامد أبوزيد إلى “هناك تميز بين العربي وغير العربي على مستوى بنية اللغة إذ يلاحظ أن إطلاق اسم العجم ‘الأعاجم’ على غير العربي -بما يحيل إليه من دلالة عدم القدرة على النطق التي تعد صفة من صفات الحيوانات ‘العجماوات’- هو من قبيل التصنيف القيمي الذي يعطي العرب مكانة التفوق، وكأن من يتحدثون بلغة غيرها هم بمثابة العجماوات التي لا تبين ولا تنطق. وعلى مستوى دلالتها يتبع تميز آخر بين ‘المذكر’ و’المؤنث’ في الأسماء العربية، وهو تميز يجعل من الاسم العربي المؤنث مساويا للاسم الأعجمي من حيث القيمة التصنيفية. بالإضافة إلى ‘تاء التأنيث’ التي تميز المذكر والمؤنث على مستوى البنية الصرفية، يمنع ‘التنوين’ عن اسم العلم والمؤنث كما يمنع اسم العلم الأعجمي سواء بسواء’.
وهنا يصل إلى تصور يقول فيه “إذا كانت اللغة تتعامل مع المرأة من منظور طائفي عنصري يساوي بينها وبين الأعاجم، فإنها إنما تعكس مستوى وعي الجماعة التي أبدعت تلك اللغة”.
من أجل خلق تكيف بيننا وبين العصر تكيف استراتيجية تقصد إلى توفير الشعور بالتوكيد الذاتي داخل عالم الأقوياء الذين يهاجمون ويفتشون عن توسيع المدى لحياتهم، والتي توفر المعافاة بتوازن وايجابية مع الدار العالمية للفكر والإنسان.
نعم إنها محاولة لإحداث معالجة نفسية اجتماعية تراعي ما يعانيه الفرد من انجراحات وتهويمات مسيطرة هي رهينة الخطابات الهاجعة العرفية واللاهوتية والاجتماعية التي لا بد من الحوار معها تأويلا وتحويلا من أجل المعافاة، والذي يعمل على تفكيك التلازم بين النحو والبلاغة وما ينتجاه من صور وإزاحات، فهذا التوتر بين البلاغة والنحو هو المسؤول عن نسبية الحقيقة التي يمكن أن تدلي بها اللغة وبالتالي العمل على نقد تلك الصور الكامنة النمطية والتي تشكل منظومة من الإقصاء الذكوري الذي يعمل على تهميش الأنثى وإلحاقها بالأنا الذكورية من البلاغة والصور الإقصائية التي تحاول الخوص في تلك الصور النمطية وتحاول كشف العمى الثقافي الذي يحيل إلى مواضعات كثيرة متداخلة.
أولا: مساءلة التمثلات والصور النمطية الإقصائية

ضمن هذا العالم المستحيل خلق الرجل مخيالا يقوم على الرغبة والإقصاء، تلك الإقصائية التي تمتد عميقا في المخيال الذكوري المتعلقة باللغة وآليات التمثيل شعرا ونثرا عقيدة وطريقة وكما يقول عبدالله الغذامي “علاقة المرأة باللغة كمنجز تعبيري بواسطة الحكي والكتابة، فإننا هنا نقف على الحكايات المأثورة التي تتعامل مع المؤنث وتجعل التأنيث مركز الحبكة التي تتحول إلى معتقدات أو صورة نمطية ثابتة وهو ما سميناه بالجبروت الرمزي”. (عبدالله الغذامي- ثقافة الوهم، ص5 )، ومن أجل تفكيك هذه السردية، نجد أنفسنا إزاء الثنائيات الآتية:
- صورة الجسد المقصي/الأنثى
في هذه الثنائية نحن أمام محور للحكاية السردية، وهي تضع تصنيفا للجسد وهو تصنيف حط من قدر الجسد بفعل ذلك الجبروت الذي شكل رأسمال الذكوري باعتباره منذ الخطاب الأورفي القديم الذي أقصى الجسد وتمركز حول الروح، أقصى الأنثى وتمركز على الذكورة، كما صوره أفلاطون في الحب الأفلاطوني مما حول المرأة رمز الغواية في أقوى تعبير “باندورا” أول كائن أنثى مارست الغواية استدراجا “لايبيميتيوس” أخت “بروميتيوس” لتكون أول كائن أنثى حل بعالمنا لغرض تنفيذ مؤامرة انتقامية، “إنها كائن جزافي بامتياز! جاءت إلى عالمنا بأجندة تدميرية حاملة في جيدها كافة أنواع الشرور.” (إدريس هاني، تأنيث الأنثى، مجلة الوعي المعاصر، ص101).
بهذه اللغة يتم رسم ملامح ذلك المخيال الإقصائي الذي يجعل من الأنثى بمثابة مخزن المتضادات يرمي فيها الذكر كل نواقصه ومخاوفه ولكشف تغلغل السلطة ونشاطها في اللغة والتعابير والمصطلحات بوصف اللغة تجسيدا لأسلوب النظر والعمل والشعور تمنح مقوماتها الاستثنائية من خزان اللساني والرمزي الذي تمثله اللغة، فلا بد من “أن نعي كيفية تشكل هذه الذات نصيا وهي الوليدة لنتاج مفاهيمي ثابت وخاص تخضع فيه لعقل مستزرع، لكن هذا المنحى يساعدنا عبر النبش في أصول الأصول التي شكلت الخطاب الأنثوي إبداعيا، وإنسانيا، وفكريا، بعد عقود من ممكن المتعلم”.(سالمة الموشي، الحريم الثقافي بين الثابت والمتحول، 2004، ص21).
كل هذه التصورات النمطية تتناسى أن المرأة ليست وجودا ماهويا جامدا إنها بعد وجودي وهوية تتجدد وتتشكل مع الزمان والمكان؛ إلا أن التصورات النمطية تحاول المضي في اختلاق تصوراتها عن الأنثى وقيمها، خاصة آلية النبذ اللاشعوري، فالذكر قبل أن يقوم على وأد الأنثى في التراب يقوم بقتلها في أعماقه بوصفها آخر، وبقيت تلك الصورة التخيلية حاضرة في عمق هذه الثقافة إذ ثمة نظرة قارة تعكس خضوع الظواهر البشرية والثقافية والدينية لتفسير مركزي غير خاضع للتغير، بل أن يستبطن أنساقا هاجعة داخل الأنا الجمعية “لمنظومة تحكمت تاريخيا واجتماعيا ومعرفيا في تشكّل حالة الثبات التي اعتمدت سلطة امتثال وفق وعي ممنهج استمد مشروعه الوجودي من النسق الواحد الذي لا يتعدد باعتبار الذات الأنثوية فكرة ثابتة… تظهر فيها الأنثى بوصفها آخر ومخزن التضاد الذي يعيد إحياءه دائما عبر السجالات الحياتية التي تعكس موقفا نكوصيا لا يساهم بمغادرة تلك الارتهانات التي تعكس أفكارا راسخة قائمة على أنقاض الجنسي مفعمة بقيم سامية لأن الآخر/الأنثى منفعل مقابل الأنا الذكورية الفاعلة” (سالمة الموشي، الحريم الثقافي بين الثابت والمتحول، 2004، ص102).
هذه الثنائية الضدية بحاجة إلى إعادة التفكير بها وبالقبليات التي تحركها لكي نتغير ونغير بالفكر الحي والمتجدد متجاوزين قيمنا الإنسانية المستهلكة ونجترح قيما جديدة قادرة على جعلنا نتجاوز عوائقنا التي تلغم صيغ الاندماج السوي بالعصر ورهاناته منفتحين على الأفق الجديد الذي يتسع من تغذية معناه معرفة وتحويلا ثقافيا وحضاريا تتضاعف به إمكانياتنا وتتجدد أنماط الرؤية وقواعد المعاملة.
- المرأة بوصفها جسدا: صورة الجسد الشهوانية المتخيلة
من مقومات هذه السردية؛ أنها تقوم على رؤية نمطية تنطلق من موجهات تخيلية تمثل زاوية النظر إلى المرأة، فإلى جانب الإقصاء الجسدي بشكل عام والأنثوي بشكل خاص ثمة نظرة أخرى للأنثى وهي المرتبطة بالرغبة بوصفها انعكاسا لرغبة ذكورية ذات جانب واحد قائمه على تفخيم الأنا الذكورية، الأمر الذي يقود إلى خفض قيمة الآخر/الأنثى ونحن هنا إأمام تصوير تخيلي ذكوري يتم فيه تكوين بلاغة ذكورية يتحول بمقتضاها الجسد الأنثوي ومن بعده الأنطولوجي إلى جسد متخيل، تمتلكه الذاكرة الإنسانية بما فيها من إطار تخيّلي يتخذ من اللغة محور التعبير والتصوير المفارق للواقع؛ إلا أنه يعبّر عن الرغبة المكبوتة، وهذا ما يظهر عبر قدرة المخيلة على إنعاش تلك الرغبات الممنوعة والمسكوت عنها؛ لتعيش فيه باستمرار استيهاماتها الشهوانية والجمالية. إنه جسد من خلق مخيّلة الواصف الناحت له.
وهذا ما انعكس في النصوص الشعرية والفقهية والصوفية التي تغدو الأنثى فيها محل إمتاع للرجل، وهذا الضرب من الأداء البلاغي يعكس سمة نسقية ومظهرا ثقافيا ينعكس في ملامح الجسد وعلاماته الحسية “إنه جسد من خلق مخيلة الواصف، يمنحه من توقعاته وحساسيته كل ما ينقصه من الاكتمال والتعالي. هو صورة لأنه يتم تجريده في الكثير من الأحيان من خصائصه الظاهرية وعزله عن محيطه لإعادة تركيبه في مخيلة اللغة وفق منظور يسلب منه طابعه الوجودي” ( فريزا هي عن صورة والجسد والمقدس في الإسلام، 2000، ص146).
فهذه الخطابات تنطلق من استراتيجيات ثقافية والتي هي بمثابة المنطلق لما يتشكل من تمثل عن الآخر (الأنثى)؛ بالإضافة إلى إن تلك التمثلات الخطابية تمنحنا نوعت من المتعة؛ إذ “تقوم الخطابات بتنظيم رؤيتنا للعالم، فنحن نعيش الخطابات ونتنفس الخطابات ونعمل دون وعي كحلقات في العديد من سلاسل السلطة” (هانس باراتس، مابعد الحداثة، مجلة نزوى)، فالجسد في تلك النصوص من خلال اللغة والخطاب والمقارنة التركيبية يكف عن أن يكون جسدا واقعيا ليغدو جسدا ثقافيا بالدرجة الأولى لأن التعامل معه يكون انطلاقا من مخزونه الفكري وذاكرة اللغة وقيمها وأخلاقها، وأيضا من خلال الممكنات البلاغية إذ يتحول الجسد في هذه اللعبة التأملية إلى مشهد للمتعة والتأمل الجمالي. فتلك النصوص التي تتعامل مع الجسد كبعد جمالي إمتاعي تكشف عن صورة تخيلية زائفة تظهر الأنثى وكأنها بعد لذة الرغبة المكبوتة ناسيا البعد الروحي، فالروح هي مادة الجسد التي تنظم الحالة الشعورية والمعنوية والجسد يمثل وعاء الروح والحاضن المادي المعرفي والتراكم الحياتي بعيدا عن الإقصاء حول الوهم وإقصاء الآخر.
فالبطانة الشعورية-العقائدية، وهي تشكّل متنوع من تجارب الماضي أي دون النمط الأورفي (نسبةً إلى الفيثاغورية) تقصي الجسد لمصلحة الروح أو النص الجمالي الذي يعكس الرغبة والذي يعطي الجسد دور المركزية ويتناسى الروح. فالجسد بكليّته يقوم على الجزئيات المتمثلة بالأعضاء التي يمتلك كل منها إيقاعا له مدلوله، فالفم له دلالة القبلة والعينان لهما دلالة المحاكاة والأنامل لها دلالة اللمس، (وتعطَّلَتْ لغـةُ الكـلامِ وخاطبَـتْ عَيْنَـيَّ فِي لُغَـة الـهَوى عينـاكِ)؛ إلا أن هذا الفصل الذكوري للجسد الأنثوي وإخضاعه لرغباته الذكورية بقصد الإعلاء من شأن الأخيرة أي الذكورة يعكس بعدا سلطويا اجتماعيا تهيمن عليه قيم الذكورة وأيضا يعكس بعدا نفسيا “فالأنوثة هي الجانب اللاواعي من الرجل، فيما الذكورة هي الجانب اللاوعي من المرأة. إنها لعبة حضور وغياب في منتهى المخاتلة والتعقيد، على أن الوعي ليس هو الشخصية كلها، إن وعينا تصبغه ثقافتنا وموروثنا وبيئتنا ” (إدريس هاني، تأنيث الأنثى، مجلة الوعي المعاصر، ص105).
تلك التصورات تبقى وسيلة زائفة للتعرف بهويتنا؛ لأنها شبيه “المرحلة المرآتية ” في تصور لاكان إذ نصطدم بالصورة “المرآتية” التي يعكسها العالم باتجاهنا؛ ولكن تلك الصورة، تماما كتلك التي تعكسها مرآة حقيقية، مشوهة وتؤدي إلى “تعرف مخطئ”، ولكن هذا “التعرف المخطئ ” يظل يشكل أساس ما نعتقد أنه هويتنا.
ففي نظر لاكان نحن بحاجة إلى تجاوب واعتراف الآخرين و”الآخر” لنتوصل إلى ما نعيشه كهويتنا. أي أن “ذاتيتنا” تُدرَك في تفاعلها مع “الآخرين”، أي مع الأفراد الذين يشبهوننا بشكل أو بآخر ولكن أيضا يختلفون عنا بشكل واضح؛ فنحن نصبح أنفسَنا عن طريق نظرات أخرى ـمنظورات أخرى- عن أنفسنا. وأخيرا، بما أننا تركنا كل ما هو قبل أوديبي خلفنا ودخلنا عالم اللغة وأخضعنا أنفسنا له، يمكن أن نقول إن الهوية بناء لغوي: نحن مبنيون في اللغة، أو من اللغة، لكن تلك اللغة ليست لغتنا ولا تستطيع التعبير عما نريد قوله حتى ولو استطعنا، مثلا، أن نعرف محتويات لاشعورنا (هانس باراتس، مابعد الحداثة….مجلة نزوى)، فهذا الكلام يكشف أن كل تلك النصوص وما تراكمه من صور نمطية بحق الأنثى تبقى مجرد صورة تعكس “التعرف المخطئ” ومن ثم لا بد من الاعتراف بهذا الوضع المحرج عبر نقد ما ينتجه من صور مشوهة وإعادة النظر بكل السردية من أجل خلق حالة من الاعتراف بحق المختلف، من تفكيك تلك التمثلات التخيلية التي نقيمها عن الجسد الأنثوي؛ “لقد كتب الكثير عن العلاقات الاجتماعية في المشرق العربي وشوهت النماذج المقدمة في ألف ليلة وليلة مثلاً صورة المرأة الشرقية المتزنة، فمشكلة التاريخ أنه كتب من وجهة نظر الحكام لا المحكومين فجاء معبراً عن مصالح الطبقات الحاكمة ضد الأغلبية من الكادحين” (جوليت منسي، المرأة في العالم العربي، 1981، ص20).
ثانيا: المرأة ناقدة ومفكرة

بعد أن تناولنا العوائق التي تحول دون ظهور خطاب فلسفي ناقد في التراث العربي، نحاول، الآن الوقوف عند تجارب مهمة يمكن أن تكون تصورات عن المرأة الناقدة والمفكرة، فهذا التحديث النقدي يميل إلى الاختلاف مع التصور السائد عن المرأة يمثله كل من المرنيسي، والسعداوي، إذ أن هاجسهما الوحيد هو تحرير المرأة إلى جانب حركة كبيرة في هذا المجال حاولنا تأكيدها من خلال هذان الخطابان البارزان:
- خطاب السعداوي
بالسعي الحثيث إلى تشكيل علم للجنس يهدف إلى تحرير المرأة والرجل من هيمنة قرون من التقاليد والاضطهاد والتشويه والتجاهل لحقيقة الجنس -كما تصوره هي- تشير إلى أن المعروف بيولوجيا وفيزيولوجيا أنه ليس هناك من هو ذكر خالص مائة بالمائة ومن هو أنثى مائه بالمائة، بل إن الأعضاء الجنسية والهرمونات الجنسية في كلا الجنسين تتداخل (السعداوي، الأنثى من الأصل ،1974، ص 79).
جاء هذا في إطار سعيها لقول حقيقة الجنس فتربط السعداوي بين بيولوجيا التناسل وطب الجنسانية، إنها لا تمل من الاستشهاد بالبيولوجيا، لتؤكد على أن الأنثى هي الأصل. في عالم النبات حيث تستمر المدقة (العضو الأنثوي) في الحياة خلافا للسدادة (العضو الذكري)، إلى عالم الحيوان حيث تحمي الدجاجة فراخها.
إن نوال السعداوي تجد في البيولوجيا ملاذها لتؤكد على القدرة اللامحدودة عند الأنثى على الإخصاب، وكذلك ميزة الإنجاب التي تزود الأنثى بقدرة لا محدودة أو لانهائية على أن المرأة بيولوجيا أرقي جنسيا وأكثر قدرة على الإثارة والمتعة من الذكر. بل إنها تندفع باستمرار إلى حقل طب الجنسانية، الحقل الذي يهدف إلى معرفة علمية لحقيقة الجنس، معرفة ظلت محكومة بإرادة عدم معرفة عنيدة. وباندفاعها تدفع القارئ إلى متاهات طبية تتعلق بحقيقة الأنثى الجنسية وذلك في إطار سعيها إلى التأكيد على أن “الأنثى هي الأصل”.
والسعداوي تذهب إلى أكثر من ذلك فهي تستنجد بالتاريخ لتأكيد صحة فرضياتها العلموية، إذ هي تؤكد على هذه الجدلية: تاريخ الأقوام البدائية حيث كانت الأمومة موضع اعتزاز وقداسة ومكانة متميزة للمرأة وتاريخ مصر الفرعونية حيث لم تعرف المرأة المصرية الحجاب وكانت تختلط بالرجال.

إن السعداوي تطرح السؤال بالشكل التالي: لماذا نظر إلى الجنس على أنه إثم. وإذا كان الجواب ذا مرجعية ثقافية فإن السعداوي لا تفلح في قراءة المرجعية الثقافة بالرغم من إصرارها على أن قضية المرأة في النهاية قضية سياسية؟ (تركي الربيعو، الخطاب النسوي المعاصر قراءة في خطاب نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي، 12-1-2015).
- خطاب فاطمة المرنيسي الحريمي والقدسي والسياسي
ما يميز المرنيسي هو تأويلها للمقروء التراثي، التأويل الذي يجعله معاصرا لنفسه ومعاصرا لنا في آن. وهي تتقدم في هذا المجال الوعر خطوات كبيرة إن لم نقل مفارز، وهي بذلك تدير ظهرها لـ”بيولوجيا التناسل” التي تعيرها السعداوي اهتماما كبيرا. المرنيسي على وعي تام بأن الجنس في حالة تبعية تاريخية للجنسانية (الجنسانية في مصطلح فوكو هي الصياغة العلموية للجنس وما يكتنفها من جاهزيات المعرفة والسلطة) ولذلك فهي تتجه مباشرة إلى حقل السلطة/المعرفة علها تقرأ ما لم يقرأ بعد وهذا ما تفعله. وفي تعاملها مع النص التراثي كشبكة من علاقات معرفية وسلطوية بأن تقوم بإخضاع النص التراثي لعملية تشريحية دقيقة وعميقة تحوله بالفعل إلى موضوع للذات، إلى مادة للقراءة.
إنها تستخلص معنى النص من ذات النص نفسه أي من خلال العلاقات القائمة بين أجزائه وهي توظف لهذا المجال دون أن تصرّح بتلك المكتسبات المنهجية التي وفرتها الثورة في مجال العلوم الإنسانية، فهي تمزج المعالجة البنيوية والتحليل التاريخي للنص التراثي دون أن تغفل البعد الأيديولوجي مع بداية عقد الثمانينات من هذا القرن. إن فعل القراءة هذا التي تقترحه المرنيسي وتمارسه، ليس محايدا، إنه رد فعل واع على عملية التجهيل المستمرة من جهة وعلى الجهل بالماضي من جهة ثانية (تركي الربيعو، الخطاب النسوي المعاصر قراءة في خطاب نوال السعداوي وفاطمة المرنيسي، 12-1-2015).




