تبصُّراتٌ في الشّعريّة والشّعر
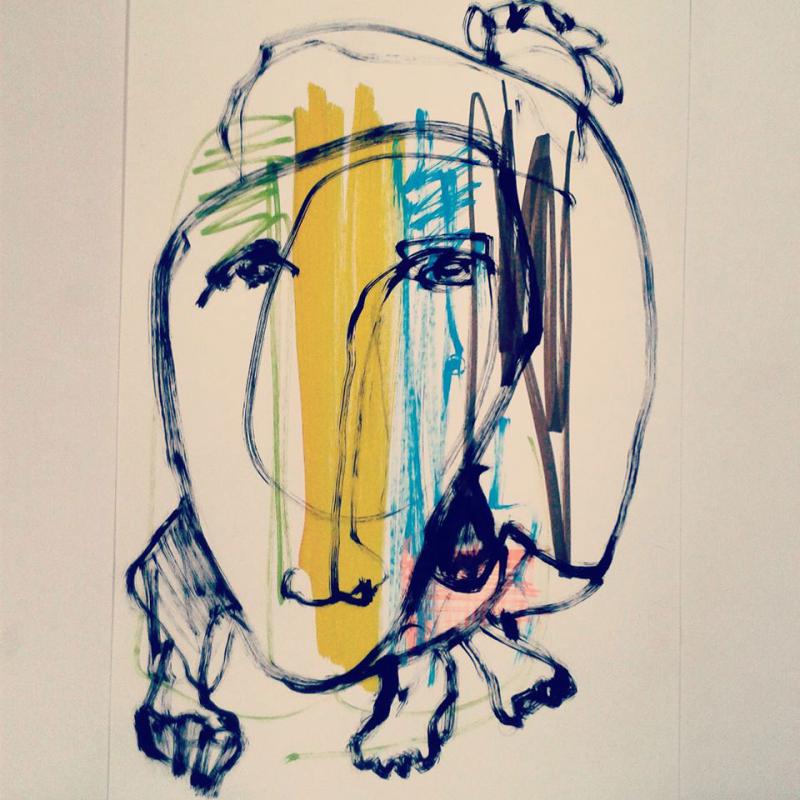
(I)
الرُّؤيوي والجمالي وجوهر الشّعريّة
لا يصدُر الشّعرُ، بأعمق معانيه وأوسعها وفي اكتنازه مفهُوم “الشّعريّة” في ثرائه وغناهُ، إلّا عن إنسانٍ إنسانٍ، وثمة منظومة مُتكاملة طوّرها الإنسانُ الشّاعرُ واعتنقها، وجلّاها، إبداعيّاً ووُجُوديّاُ، في نُصُوصٍ أدبيّةٍ، وأعمالٍ فنيّةٍ، جميلةٍ، مُتقنة الصّوغ، ومُحكمة التّشكيل والتّكوين والسّبك.
وليس لما يُعارضُ هذه الرُّؤية، أو يُناقضُها بإطلاقٍ، أو يسخرُ منها، أو يُبخّسُها، أو يفتقرُ إليها، من نُصُوصٍ أدبيّةٍ، وأعمالٍ فنّيّةٍ، أن ينطوي على أيّ قدرٍ من الشّعريّة، ليكُون عملاً أدبيّاً، أو فنّيّاً، جميلاً؛ أي عملاً إبداعيّاً مُفعماً بالشّعريّة في أعمق معانيها الرُّؤيوية والجماليّة المُتواشجة، لأنّ مُبدعهُ قد أحسن الإصغاء إلى نداءات الوُجُود الإنسانيّ الجدير بالوُجُود، فالتقطها، برهافةٍ مُتلهّفةٍ، وشوقٍ، ودهشةٍ، وأسكنها وجدانهُ الإنسانيّ الكُلّيّ الّذي عنهُ ينبثقُ كُلُّ إبداعٍ حقيقيٍّ ليس لهُ أن يكُون إلّا جميلاً، ونبيلاً، في تواشُجٍ حميميٍّ مُتّصلٍ ومفتُوحٍ، طيلة الوقت، على تجليّة خفاء الوجُود عبر بناء “بُيُوت الحياة” وابتكار “أشكال الجمال”!.
وقد يتمُّ التّعبيرُ عن القبيح، بل وعن شديد القُبح من المنظُور الرُّؤيويّ الإنسانيّ، بنصٍّ أدبيٍّ أو عملٍ فنّيّ، قد يبدُو، من الوجهة الجماليّة الشّكليّة، جميلاً، غير أنّ لمثل هذا النّص، أو العمل، أن يُوصف بكونه تجسيداً “جميلاً” للقُبح؛ أي كُسوةً، أو زيّاً، أو وعاءً خارحيّا مُصنّعاً لاحتواء القُبح البشريّ وبثّه، عبر خدع جماليّةٍ شكليّةٍ مُبهرةٍ وبلا رأفةٍ، في النّاس. إنّه ليجلُدُ بسياطه التّخييليّة اللّاهبة “عقل العالمُ” ساعياً إلى “غسل الأدمغة”، و”تخريب الضّمائر” و”امتهان إنسانيّة الإنسان”؛ وهُنا ينفصلُ الشّكلُ عن المضمُون ولا يلتقيا، جوهريّاً، أبداً! ولنا في آداب الصُّهيُونيّة العُنصُريّة، وفي فُنُونها، الّتي تبدُو جميلةً، بل ومُبهرةً في أغلب الأحيان، أمثلةٌ ساطعةُ الدّلالة على ذلك.
وقد يجري التّعبيرُ عن الجميل، بل عن المُفعم بأسمى آيات الجمال من المنظُور الإنسانيّ السّامي، بنصٍّ يبدُو، من الوجهة الجماليّة الشّكليّة، قبيحاً، فيتكرّرُ الأمرُ نفسُهُ، ولكن على نحوٍ مُعاكس تماماً، إذ سيتبدّى النّصُّ الأدبيُّ، أو العملُ الفنّيُّ، السّاعي إلى التّعبير عن الرُّؤيويّ الإنسانيّ النّبيل عاجزاً عن التّناغُم، جماليّاً، مع هذا النّبيل، أو الجليل، الذي يسعى إلى إظهاره من خفاءٍ، وبثّه في النّاس، فينتهي به الأمرُ إلى بثّ القُبح، شكلاً ومضمُوناً؛ فما للتّعبير عن المضمون الرُّؤيوي الإنسانيّ النّبيل الجليل، بشكلٍ أدبيٍّ، أو فنّيٍّ، قبيحٍ، إلّا أن يُعزّز القُبح الّذي ينتمي، شكليّاً، إليه، فيُرسّخ وُجودهُ، مضمُونيّاً!
ولنا في شيءٍ من آداب الشُّعُوب المقهُورة، وفُنُونها، وتعبيراتها الشّعبيّة المُتناقضة، بل وفي خواطر الأفراد السّاعين للتّعبير التّلقائيّ عن “أحوالهم المُتغايرة”، أدلّةٌ كثيرةٌ على هذا الّذي ندعُو إلى تركه، والكفّ عن ترويجه الّذي لا يُروّحُ شيئاً سوى “القبح” الكفيل، وحدهُ، بتجريد القضايا العادلة من عدالتها.
(II)
غايةُ الشّعر
غايةُ الشّعر، مُذ بدء البدء مع كُلّ بدءٍ جديدٍ، غايةٌ وُجُوديّةٌ إنسانيّةٌ كُلّيّةٌ تمُورُ بغاياتٍ تفصيليّة تُجلّيها رُؤى الشُّعُراء المبثُوثةُ في القصائد، وهي الوجهُ الكُلّيُّ الآخرُ للقيمة الجماليّة الرؤيويّة المُتواشجة الّتي بها يكتملُ “عيارُ الشّعر” موصُولاً بالنّصّ الشّعريّ المُتجلّي في ذاته، أو بالقصيدة المُتجلّية في ذاتها، كوُجُودٍ جماليٍّ – رُؤيويٍّ – إبداعيّ، أو ككينُونةٍ إبداعيّةٍ وُجُوديّةٍ مُلتحمةٍ ذات قيمةٍ معرفيّة جماليّةٍ مُتواشجةٍ، وذات تناغُمٍ دلاليٍّ، وتماسُكٍ بنائيٍّ، وانصهارٍ تمازُجيٍّ بين شتّى العناصر والمُكوّنات والبُنى، وذات تساوقٍ كُلّيّ بين المضمُون الدّلاليّ والشّكل الجمالي يكفُلُ تحقُّقُهُ، رُؤيويّاً وجماليّاً، تحقُّق وُجُود واحدُهُما، وُجُوداً حيويّاً، في أصلاب آخره، وفي شتّى تمظهُراته.
“مقاومة التّلاشي” هي خُلاصة ما يُريدهُ الشّاعرُ من الشّعر، وجوهرُ غاياته، إذ للقصيدة المتحقّقة، أن تهب الشّاعر”وجوداً ثانياً”: وجودا بها، ووُجوداً فيها، ووُجوداً معها؛ فالحالةُ الوجدانيّةُ الّتي أنتجت القصيدة تزولُ، والشّاعرُ الّذي تفاعل مع اللّغة الشّاعرة في كتابتها بأصابع وجدانه الكُلّيّ يفنى، “بينما القصيدة تبقى، وتستمر في تخليق معانيها، مُنتقلةً، في صيرورة الحياة وانبثاقات، من “حال هُنا الآن إلى حال هُنالك الآن” لاكتنازها مُمكنات حُضُور وُجُوديٍّ دائمٍ تنقُلُها القراءةُ المفتُوحةُ على مدارات الوُجُود والأزمنة من “مُمكناتٍ مُجرّدةٍ”، إلى “وقائع فعليّةٍ قائمةٍ”؛ فلا يكونُ “الشّعرُ”، في هذا الضّوء، إلّا “حاجةٌ وجُوديّةٌ للشّاعر، وللقارئ أيضاً”.
(III)
الشّعرُ والنّثرُ والنّظمُ
لا يصدُر الشّعرُ، بأعمق معانيه وأوسعها وفي اكتنازه مفهُوم “الشّعريّة” في ثرائه وغناهُ، إلّا عن إنسانٍ إنسانٍ
ليس ثمّة من “نقيضٍ حقيقيٍّ للنّثر” إلّا “النّظم” المُكتفي بذاته شكلاً ووعاءً، والمُلتقط مضمُونهُ ومُحتواهُ من خارجٍ يفصلهُما عنهُ؛ أمّا “الشّعرُ” فهُو قابلٌ للوُجُود في “النّثر” بقدر وجُوده في ذاته، فالنّثُرُ هُو، في البدء والمُنتهى، الرّحمُ الّذي في رحابه وُجدت قطرةُ ماء الشّعرُ الأُولى مصحُوبةً بجذوة ناره الأُولى، وهُو الرّحمُ الّذي، عبر رفد مشيمته لهُ بما يُكوّنهُ، اكتمل جوهرُ الشّعر، ونما وربا، وهُو، إلى ذلك، أوّلُ بيتٍ سكنهُ الشّعرُ قبل أن يشرع، بعد أن وُلد وسكن “بيت الوُجُود” وصار رأس سُلالةٍ يقطُنُ الوُجودُ الكُلّيُّ وجدان أفرادها فيما هُم يقطُنُون رحابهُ، في بناء “بُيُوت حياةٍ” تخصُّهُ، ليسكُنها وأُفرادُ سلالته المتمايزُون، لحظةً في إثر لحظةٍ، ويوماً في إثر يومٍ، وجيلاً في إثر جيلٍ، وعلى مدى الأزمنة!
وفي هذا الضّوء، نقرأُ ما رمى إليه ابنُ طباطبا العلويُّ حين عكف على صوغ معيارٍ جوهريٍّ يُميّزُ به الشّعر “الحسن”؛ أي الشّعر “الجميل” الّذي به تخرُجُ “القصائدُ” عن أن تكون محض “نظمٍ ووزنٍ وقافيةٍ”، بتكلُّمُه، ابتداءً وبجلاءٍ، عن “الأشعار الّتي خرجت خُرُوج النّثر سُهُولةً وانتظاماً”؛ إذ بهذا المُفتتح، وعلى نحوٍ مُضمرٍ ببراعةٍ وذكاءٍ، لم يجعل ابن طباطبا من الشّعر والنّثر نقيضين مُطلقين، كما قد تُصوّر وكُرّس في أزمنةٍ سبقت زمنه، بل إنّهُ أكّد وُجُود الشّعريّة في كليهما، وذهب إلى ما هُو أبعدُ حين جعل “منثُور الكلام” منبعاً للشّعريّةُ الّتي يُرادُ سكبُها في الشّعر المُتجلّي في “قصائد” مسبُوكةٍ!
وحين أكّد ابنُ طباطبا أنّ “الأخذ من منثُور الكلام وجعله شعراً أخفى وأحسن”؛ وحين جعل من إمكانيّة “حلّ معقُود الكلام” المسبوك في قصائد، دليلاً على تشابُك جماليّات الصّوغ الشّعريّة الجماليّة بين الشّعر والنّثر، فإنّ في هذا ما يُفصحُ، في قراءتنا لما قد كتب من خُلاصاتٍ بدت مُضمرةً، أنّهُ ينفي تناقُض الشّعر والنّثر، ويستبعدُ وُجُود أدنى تبادُليّةٍ جوهريّةٍ بين الشّعر والنّظم!
ولعلّ في هذا ما يفتحُ بصائرنا على إمعان التّأمُّل، في حرص ابن طباطبا، ونُقاد، وفلاسفة جمالٍ، أفذاذٍ من العرب وغير العرب، على التّمييز المُستمرّ بين “النّظم” و”الشّعر” من جهةٍ أُولى، وعلى إزاحة التّناقُض الّذي “جُعل جوهريّاً” بين “النّثر” و”الشّعر”، ليجعلوهُ تغايُراً رؤيوياً جماليّاً، بينهما، وعلى نحوٍ لا يُجرّدُ أيّاً منهُما من الشّعريّة بأوسع مُمكناتها، وأعمقها، وأغزرها، وإنّما يذهبُ إلى تأكيد التّناقُض بين كليهما من جهةٍ، وبين “النّظم” من الجهة المُقابلة!
وإلى ذلك، فإنّ للسّعيّ إلى بلورة منظُومة معياريّةٍ، رُؤيويّةٍ وجماليّةٍ، مُتكاملةٍ، تشملُ الشّعر كُلّهُ، بجميع تجلّياته الشّعريّة النّصّيّة القائمة مُنذُ بدء البدء حتّى اللّحظة، وتلك المُمكنة الوُجُود بعد لحظة واحدةٍ من انبثاق وُجُودٍ ما، وعلى مدى الأزمنة، سواءٌ أكانت هذه التّجلّيات منظُومةً على الأنحاء الّتي عرفناها، أو على نحوٍ نظميٍّ قابلٍ للوُجُود، أو غير منظُومةٍ على أيّ نحوٍ؛ أي تجلّت كينُونتُها في إهاب شعرٍ نثريٍّ أو نثرٍ شعريٍّ، فإنّنا سنكُونُ في حاجةٍ ليس إلى إعادة تعرُّف منابع الشّعريّة فحسبُ، بل إلى معرفة مصادرها الأساسيّة القائمة، أساساً ورُبّما دائماً وأبداً، خارج النّظم، وذلك بقدر ما سيكونُ علينا إعادة تعرُّف ما يُضفيه النّظمُ على النّصّ الشّعريّ المنظُوم من قيمٍ رؤيويّةٍ وجماليّةٍ، وما يأخُذهُ منهُ من أيٍّ منهُما.
وإنّي لأحسبُ، أنّهُ سيكُونُ لنا، إن نحنُ ذهبنا إلى إدراك ذلك فأدركناهُ، باتّساعٍ وعُمقٍ، وعن كثبٍ يتأسّسُ على استلهامٍ تبصُّريٍّ في ما قد كتبهُ سابقُونا، وما يكتُبُهُ مُجايلُونا، من الشُّعراء، والنُّقاد، والفلاسفة، وعُلماءُ الجمال، ومُنظّرو الأدب والفنّ، أن نُحدّد ماهيّة القيم الّتي يتكفّلُ النّظمُ، في تمايُزه عن الإيقاع وإن تضمّن صيغاً خارجيّةً من صيغه الكثيرة مُمكنة الوجُود، بتجريد الشّعر منها، أو الّتي يُكسبُها إيّاهُ، وأن نُدرك، بدقّةٍ ومن غير إرباكٍ وخلطٍ، المجال المعرفيّ أو الجماليّ، الّذي تنتمي إليه القيمُ الّتي يُجرّدُ النّظمُ الشّعر منها، وتلك الّتي قد يُكسبُهُ إيّاها، بحيثُ نكُونُ مُؤهّلين لإمعان التّبصُّر، من جديدٍ، في مُضمراتٍ فرضيّاتٍ متنوّعةٍ اكتنزها كتابُ ابن طباطبا “عيارُ الشّعر”، كما اكتنزتها كُتُبٌ تأسيسيّةٌ أُخرى وضعها قُدماءُ النُّقاد وفلاسفةُ الجمال الرّوادُ على مدى أطوار الثّقافة العربيّة الإسلاميّة الّتي كفّت عن تجديد نفسها، تجديداً جوهريّاً، مُنذُ ما يربُو على ألفيّةٍ كاملةٍ من الزّمان!
وما فرضيّةُ تمايُز النّظم عن الشّعر النّثري وقصائده، وعن النّثر الشّعريّ ونُصُوصه، كفرضيّةٍ يُؤصّلُها تمايُزُ “طبيعته النّظميّة” الشّكليّة، تمايُزاً جوهريّاً، عن جوهر “طبيعتهما الشّعريّة الرُّؤيويّة الجماليّة المُتواشجة” النّابعة، أصلاً، عن صيغةٍ من صيغ التّأمُّل التّخيُّليّ، أو التّفكير الشّعريّ، إلّا واحدةً من هاته الفرضيّات الّتي تُوجبُ، ضمن ما تُوجبُ، إمعان التّبصُّر في كُلّ ما قد قيل من قبلُ حول التّفكير الشّعريّ المُبدع، والتّفكير غير الشّعريّ أيّاً ما كانت مُحفّزاتُهُ، ومهما تبدّلت طبيعتُهُ، أو تباينت غاياتُه، وذلك من منظُورٍ معرفيٍّ واسعٍ وعميقٍ يري أنّ منبع الأوّل ومجالهُ الحيويّ، إنّما هُو “الوجدانُ الإنسانيُّ الكُلّيُّ” الّذي في رحابه تمُورُ ملكاتٌ تخيُّليّة، وقُدراتٌ عقليّةُ، وطاقاتٌ نفسيّةٌ، ومهاراتٌ لُغويّةٌ وأُسلُوبيّةٌ، وقُوىً إبداعيّةٌ إنسانيّةٌ ظاهرةٌ وخفيّةٌ، تتعدّدُ أنماطُ صيرورتها التّفاعُليّة، وتتغايرُ أشكالُ العلاقات القائمة فيما بينها، لتتكفّلُ بتحفيز الإبداع، وإطلاق صيرورته، وإنتاج تجلّياته النّصّية المفتُوحة على تنوّع جماليٍّ لا ينتهي ولا يتناهى، ولا يكُفُّ عن اقتراح ما يذهبُ بالإبداع بعيداً عن التّقيُّد بتقليدٍ قالبيٍّ مُكرّسٍ، أو بسياقٍ مُغلٍّ، أُريدت لهُ السّيادةُ الآبدةُ ليُؤبّد، بحُضُوره المُستمرّ، حُضُور مُكرّسيه، والمُروّجين لهُ، والمُسترخين على حوائط التّقليد والاجترار!
(IV)
الشّعرُ والوعيُّ ومُكتنزاتُ الرّؤى
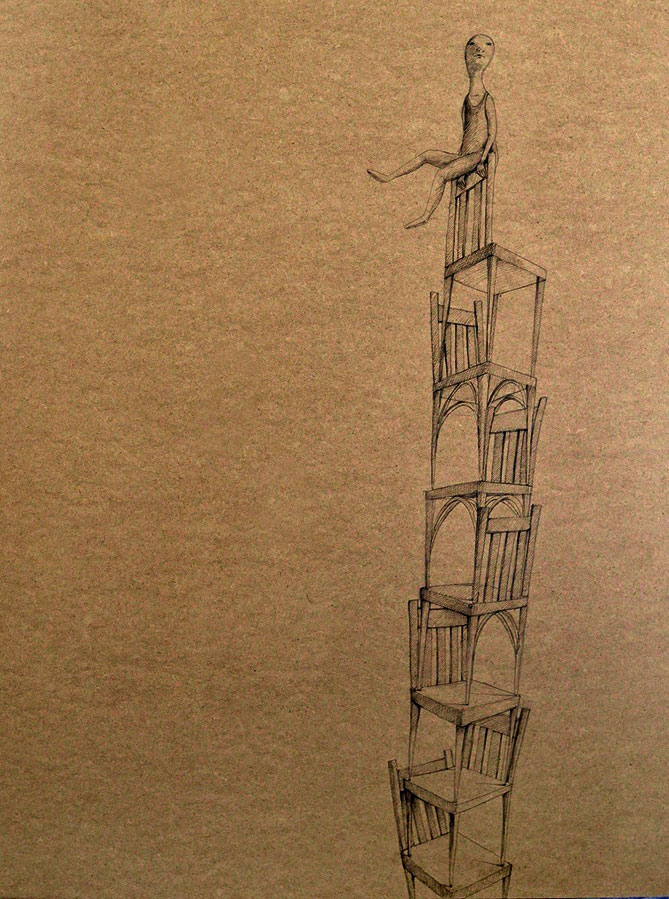
الرؤيةُ شرطُ حياةٍ ووُجُودٍ، وليس لإنسانٍ أن يحيا، وأن يُوجد في الوجُود، دُون التّوافُر على رُؤيةٍ تفتحُ آفاق الرُّؤى المُتجدّدة على صيرورة حياةٍ، وانبثاقات وُجُودٍ! وما من شيءٍ يمنحُ الحياة معناها، ويُجلّي وُجُود الوُجُود، إلّا الشّعرُ، هذا المُفعمُ بالدّهشة المعرفيّة، والتّخيُّل السّاحر الخلّاق، والتّساؤُل الاستبطانيّ المفتُوح، والشُّعُور المبهج بتدفُّقات النُبل الإنسانيّ، والجمال، والجلال!
لا ينبثقُ الشّعرُ عن “حالة لاوعيٍ”، وليس لما يُنتجُهُ من معرفةٍ أن يُوضع في مرتبةٍ ثانيةٍ من مراتب المعرفة، طالما أنها تتجلّي في إهابٍ يقولُ إنّها مُعرفةٌ “أكثرُ كثافةً وأعمقُ غوراً”! وما تمرُّدُ اللّغة الشّاعرة، واستلامها قياد صوغ القصائد، إلّا تأكيد لحقيقة أنّ الشّعر لا يُولدُ من “رحم اللّاوعيّ” أبداً، وإنّما من كُلّ “أصلاب الوجدان الكُلّيٍّ” للشّاعر الشّاعر، ومن أدقّ وشائجه؛ فاللُّغةُ الشّاعرةُ الّتي هي، في البدء والمُنتهى، ماءُ هذا الوجدان ونارُهُ، ومُكتنزُ كُلّ ما يمورُ فيه من ملكاتٍ، وقُدُراتٍ، ومهاراتٍ، وتجارب، وخبراتٍ، ومعارف، ومن مُكوّناتٍ جليّةٍ يعيها العقلُ طيلة الوقت أو متى شاء أن يعيها، ومن أخرى غامضةٍ، أو مُرمّزةٍ، فلا يعيها إلّا في حالاتٍ بعينها فيما الوجدانُ يعرفُ بوُجُودها فيه، ولعلّهُ يُدركُها، بجلاءٍ، متى شاء؛ هذه اللُّغةُ تُفكّر مع الشّاعر الإنسان، وتكتُبُ معه، بل إنّها لتُملي عليه أّن يستبقي، ويحذف، ويُعدّل، ويُعيد البلورة والصّوغ، حتّى تُرضي وجدانهُ الكُلّيّ، فترضى هي، برضاهُ، فتبتهجُ بإيناع ثمرات عذابه الخلّاق، وببهجته لحظة ميلاد النّصّ الشّعريّ – القصيدة!
لئن كان هيغل قد خلُص إلى أنّ “الفنّ هُو ما يكشفُ للوعيّ الحقيقة بشكلٍ ملمُوسٍ”، فقد خلُص أنطونيو داماسيو إلى أنّ “كُلّ معرفةٍ تتضمّنُ عاطفةً… وأنّ كُلّ شُعُورٍ جماليٍّ ينطوي على معرفة”. وإن أفصح أدرنُو عمّا مُؤدّاه أنّ الفُنُون والآداب وسائطُ تتخذُها المُعاناةُ للتّعبير عن نفسها، وأنّها “وسيلةٌ لمنح صوتٍ لبُؤس العالم… (ومُواجهة) المأساة الإنسانيّة”، فثمّة نُقادٌ وفلاسفةٌ ومُبدعُون اعتقدوا أنّ الآداب والفُنُون “هي أضمنُ طريقةٍ للهُروب من العالم” فيما اعتقد آخرون منهُم أنّها “أضمنُ طريقةٍ للتّوحُّد معه”.
ومع كُلّ هذا وذاك من الأقوال والخلاصات، فإنّ للآداب والفُنُون أن تقُول، بحسب اعتقاد الأعمّ الأغلب من النُّقاد والفلاسفة والمُبدعين المُدركين حقيقة حقيقتها، أنّها تضُفُرُ كُلّ ذلك في تداخُلٍ وتفاعلٍ يرقيان إلى نوعٍ من التّمازُج والانصهار، فيأخُذان كُلّ قولٍ أو خُلاصةٍ صوب ما هُو أعمقُ وأبعد من المعاني والمدلولات والرّؤي، إذ عبرها، ودائماً حين توافُرها على ما يُكسبها جوهر هُويّتها كآدابٍ وفُنونٍ تُواشجُ الرُّؤى الإنسانيّة الخلّاقة بجماليّات الإبداع، يكتشفُ المُبدعُ الإنسانُ، كما القارئُ الإنسانُ، ذاتهُ والحياة والعالم، ويتعرّفانها جميعا، فيما يبدُو لهُما أنّها تأخُذهُما بعيداً عن واقع الذّات والحياة والعالم، أو تهربهُما منهُ، لتقذف بهما في مدارات وُجود خفيٍّ جلّتها لهُما، وأضاءت لهُما سُبُل الجوس الأخاذ في رحابها الّتي سيبدُو، على مدى بُرهات الاستغراق في القراءة، أنّها رحابٌ تُفارقُ ثالوث ذلك الواقع، غير أنّ لتفعيل آليّات القراءة، أو المُشاهدة، التّفاعُليّة وتعليق الأحكام أثناء القراءة، أو المُشاهدة، ومن ثمّ إمعانُ التّبصُّر الوجدانيّ العقليٍّ في ما قد أُكملت قراءاتُهُ، أو تمّت مُشاهدتهُ، باستلام رسائله، وتبلوُر خُلاصاته، أن يُمكّنا القارئ/المُشاهد، كما المبدع الّذي صار قارئاً/مُشاهداً عُقب ميلاد العمل الأدبيّ، أو الفنّيّ، وإطلاقه للعيش الحيويّ بين النّاس، من إعادة اكتشاف ذلك الثّالُوث الواقعيّ: “الذّات، والحياة، والعالم”، بعُمقٍ معرفيٍّ وُجُوديٍّ أثرى وأغنى.
وما من منبعٍ أساسيٍّ لهذا العُمق المعرفيّ الوُجُوديّ، الأثرى والأغنى، إلّا العمل الأدبيّ، أو الفنّيّ، نفسهُ، لكونه قائماً، في الأصل الدّافعيّ والمنبع والغاية، على إضاءة الواقع بالخيال، والخيال بالواقع، وعلى كشف مُمكنات هذا بمُمكنات ذاك، ولكونه مُنشغلاً، طيلة الوقت، باكتشاف العلاقات الخفيّة المُضمرة والقابلة، كمُمكناتٍ مُجرّدة، للوجُود الفعليّ والتّجلّي، بين مُكوّنات ثالُوث الواقع الكُلّيّ: الذات، والحياة، والعالم (الكون المعلُوم وشتّى الأكوان المجهولة)، وذلك عبر التّبصُّر الشّعريّ العميق في علاقاتها الظّاهرة الجليّة والخفيّة المُتخيّلة؛ وكأنّي بالخيال الشّعريّ المُفكّر، مسباراً لا يُدانيه، في الفاعليّة الخلّاقة، مسبارٌ لاكتشاف حقيقة ثالُوث الواقع، وللكشف عن مكنُوناته العميقة، وللتّنبُّؤ الاستشرافيّ بمُمكناته عبر حُسن الإصغاء إلى نداءات الوُجُود الإنسانيّ وأشواقه، وتجلية شيءٍ ممّا خفي من أغواره العميقة ومداراته الشّاسعات.
(V)
الشّعريّةُ واللُّغةُ الشّاعرةُ
لا يبقى حيّاً من النُّصُوص الشّعريّة، والقصائد إلّا تلك المكتُوبةُ بأصابع الوجدان الإنسانيّ الكُلّيّ، وبمداد الوُجُود الخفيّ ممزُوجاً، عبر انصهار رؤى الشّاعر في لهيب لُغته الشّاعرة
اللُّغةُ لآلئُ صامتةٌ حين يُلامسُها الشّعرُ يُوقظُها فتُنطقُهُ شعريّتها، ومعاً يمضيان لفتح أصداف الوُجُود الهامسة بأشواق الإنسان، وأحلام حياته، ورُؤى كينُونته، ومُمكنات مُستقبله! وما الشّعريّةُ المكنُوزة في اللُّغة، إلّا تلك المكنُوزةُ في الوجدان الإنسانيّ الكُلّيّ الّذي تقطُنُهُ اللُّغةُ الشّاعرةُ وفي رحابه تمُورُ كُلُّ أجناس الآداب والفُنُون السّاعية، بتفاعُلٍ ثريّ، إلى تجلية الوجُود عبر ابتكار الجمال!
***
لا يبقى حيّاً من النُّصُوص الشّعريّة، والقصائد إلّا تلك المكتُوبةُ بأصابع الوجدان الإنسانيّ الكُلّيّ، وبمداد الوُجُود الخفيّ ممزُوجاً، عبر انصهار رؤى الشّاعر في لهيب لُغته الشّاعرة، بأمواه الشّعريّة الدّافقة في أنهُر الحياة الّتي تُجلّي، عبر صيرورتها، ما خفي من وُجُود الوُجُود الّذي يقطُنُهُ الشّاعرُ ولُغتُهُ إذ يُجلّيانه في القصائد، وإذ لا يكُفّان عن دقّ أبواب مداراته الشّاسعة، فيستضيفُهما مُرحّباً، ليُؤثّثا لهُ، ومعهُ، بيتاً شعريّاً كونيّاً، يستضيفانه فيه، ويُواصلان سعيهُما الشّعريّ لجلاء خفائه، وتوسيع مداراته، وتجلية وُجُوده المفتُوح على أبديّة الآبديّة واللّاتناهي!
***
واللّغةُ، قبل ذلك وأثناءهُ وبعدهُ، مقطُونةٌ بالوجُود الخفيّ ونداءاته الغامضة الّتي لا يجعلُ من الإنسان الإنسان شاعراً إلّا حُسنُ إصغائه إليها، وفضّه، برهافةٍ شاعريّةٍ وتوقٍ وُجُوديٍّ، ألغازها، وأحجية أسرارها، وخفاياها، وتجليتها جميعاً، وبتفاعُلٍ حيويٍّ مع اللُّغة المائرة في وجدانه، في نُصُوصه وقصائده المُتوهجة بالجمال الرّائي، وبالجماليّات الشّعريّة الّتي لا يُمكنُ للوجود الحقّ أن يختار ما يُؤثّثُ به بيته، الّذي هُو اللُّغةُ الشّاعرةُ: شريكتُهُ في تأثيث هذا البيت، سواها.
هكذا لا يجعلُ الشّاعرُ المُصغي، برهافةٍ، إلى همس الوجُود الخفيّ ونداءاته الغامضة، من هذا الوجُود بيتاً له فحسبُ، بل يجعلُ من “ذاته الشّاعرة المُبدعة” بيتاً تمُوجُ أرجاؤهُ مُتشابكةُ المدارات بهمس هذا الوُجُود، ونبر نداءاته، وأشواقه؛ فلا تكُونُ اللّغةُ بيتاً اختارهُ الوجُودُ بنفسه لنفسه بيتاً ليقطُنُهُ بمُفرده، بل بيتاً اختارهُ لهُ، ومعه، الشّاعرُ الشّاعرُ المسكُونُ بلُغته الشّاعرة، ليقطُنُهُ وإيّاها بصُحبته؛
وما هذا الشّاعرُ الشّاعرُ إلّا الإنسانُ الإنسانُ “الّذي يحيا شعريّاً على الأرض” فيُحيي الحياة، ولا يُبقي نفسهُ “ضيفاً على الحياة والوجود”، بل يستضيفُهُما، معاً، في بيت لُغته الشّاعرة المائرة في أصلاب وجدانه الكُلّيّ وفي سماوات رحابه وأُروضها، وذلك وفق قراءتي، أو تأويلى، لمقُولات هايدغر، ولا سيّما منها المقولة التّأسيسيّة الّتي تًكثّفُ تبصُّراته الفلسفيّة والجماليّة، بل والميتافيزيقيّة اللّاهُوتيّة، جميعاً “اللُّغةُ بيتُ الوُجُود”.
(VI)
الشّعريّة والإنسانُ والوُجُود
مُذ لحظة وُجُوده على الأرض، وبطبيعة فطرته الغارسة في جسده ورُوحه، وفي أعماق وجدانه الكُلّيّ المُلتحم وُجُودُهُ بهما مُلتحمين، بُذُور “تكليف وُجُوديٍّ” مفتُوحٍ على الأزمنة، سعى “الكائنُ البشريُّ”، إلى إدراك “معنى وُجُوده كائناً بشريّاً في الوجُود”، فما كان لهُ من سبيلٍ لإدراك هّذا المعنى إلاّ سبيل إدراك “معنى الوجُود في ذاته ولذاته، وما كان لهُ من سبيلٍ لإدراك معنى الوجُود في ذاته ولذاته إلّا سبيل تنمية بُذور ذاك “التّكليف الوُجُوديّ” المغُرُوسة في أصلاب فطرته ككائنٍ بشريٍّ موجُودٍ الآن، ورُبّما للتّوّ، فوق الأرض وفي رحاب الوُجُود، وهي البُذُورُ الكامنةُ في الوجدان والمُؤهّلةُ، إن شُرع في تعهُّدُها بالرّعاية والنّماء فأينعت، للشُّرُوع في تجلية كلا المعنيين وإظهارهما، وئيداً وئيداً، من خفاءٍ، في خارجٍ هُو المدار الوجُوديُّ الحيويُّ لوجُود الكائن البشريّ السّاعي إلى إدراك معنى وُجُوده، والّذي هُو “الحياةُ الحُرّة على الأرض”!
وما كان لكائنٍ بشريٍّ أن يشرع في السّعيّ لالتقاط بذُور ذلك التّكليف الوجُوديّ بمعزلٍ عن تمكُّنه من التقاط بذرة جميع البُذُور الّتي هي “لُبُّ وجدانه وجوهرُهُ”. وما هذه البذرةُ إلّا “مُبتدأُ إنسانيّته” الّتي سيشرعُ، إن تمكّن من التقاطها من أعمق أعماق وجدانه الكُلّيّ، عبر شكلٍ من أشكال التّبصُّر الشّعريّ المُفعم بإبصار “عين الرّأس” كُلّ ما تقعُ عليه من مُكوّنات الطّبيعة الأرضيّة الكُلّيّة، وبإبصار “عين المُخيّلة”، المُجنّحة بالحُدُوس والرّؤى، كُلّ ما يكمُنُ في الوجدان ويُخفيه الوجُودُ الخفيُّ عن إبصار العين وشتّى الحواس؛ سيشرعُ في الانفتاح على صيرورة كينُونته “إنساناً”، وسيبدأُ، من فوره، في “العيش شعريّاً على الأرض”، ساعياً إلى إدراك “جوهر إنسانييّه” عبر أدائه ما تلتقطُهُ رهافةُ إصغائه مصحُوبةً بمُخيّلته المجنحة وبانفتاحُ بصره وبصيرته على وُسعهما، من مُكوّنات “التّكليف الوُجُوديّ”، ومن نداءات الوُجُود، وأنواره.
وسيكُونُ لنداءات الوُجُود وأنواره، فور اكتنازهما من قبل مُلتقطهما في وجدانه الكُلّيّ، وعبر مُداومته الاستهداء بهما وهُو يُتابعُ سعيهُ للوفاء بما تُوجباهُ عليه من سعيٍّ وُجُوديٍّ مفتُوحٍ، أن تُخرجاهُ من سدائم العدم المُعتم إلى مدارات الوجُود الإنسانيّ المُنير: من “الواقع الغرائبيّ المُشوّه”؛ ومن “الواقع الغريب المشحون بالسّواد والتّوحش”؛ ومن “الواقع العاري القاسي والمُعذّب”؛ الواقع (الّذي يبدو للوهم) أحياناً أكثر غرائبيّةً من الخيال”؛ “الواقع الرّديء جرّاء استشراء الاستبداد والفساد”؛ “الواقع المُحبط (إنسانيّاً)”؛الواقع المُتخم بـ”تحولات زلزالية متسارعة” وبـ”تجارب كونية تمتحن مصائر الجنس البشري”؛ أي، بإيجازٍ مُكثّفٍ، من كُلّ قبضات “البشريّة الغرائزيّة الجشعة المُتوحّشة”، ومن كُلّ أغلالها وغوائلها، هاته الّتي تُملي مصالحُها البشريّةُ، غير الإنسانيّة أبداً، أن تستبقيه في كنفها “حيواناً” أو “كائناً بشريّاً”، وفي أحسن الأحوال “مشروع إنسانٍ” ستظلُّ “تُؤجّلُ وُجُودهُ” بكبحها إمكانيّة تحقُّقه “إنساناً”، حتّى يتمكّن، بحُسن إصغائه إلى مُكتنزات وجدانه العامرة بنداءات الوُجُود، من التقاط بذرة إنسانيّته الكامنة في أعمق أعماق هذا الوجدان.
وهكذا نُدركُ، بجلاءٍ ساطعٍ، أن لا أحد “يعيشُ شعريّاً على الأرض” إلّا الإنسانُ الإنسانُ، كما نُدركُ، وبجلاءٍ ساطعٍ أيضاً، أنّ المُبدع الحقيقيّ، مُؤنّثاً ومُذكّراً، هُو هذا الإنسانُ الإنسانُ، بل هُو هذا الإنسانُ الإنسانُ وقد أدرك درجةً أعلى من درجات ارتقاء إنسانيّة على سُلّم كمالها المُحتمل، وهي الدّرجةُ الّتي تمكّن لحظة وُصُوله الشّعريّ إليها من تعرُّف مكامن “جوهر إنسانيّته الصّافي”؛ هذا الّذي ستتعهّدُ أعمالُهُ الإبداعيّةُ الشّعريّةُ بشتّى تجلّياتها، المادّيّة والصّوتيّة والنّصّية، بتجلية وُجُوده في كُلّ حيثٍ وحينٍ، ومهما بلغت ضراوةُ الواقع البشريّ، ومهما أوغل البشرُ في فحش جشعٍ ينأى بهم عن مُجرّد التّفكير في السّعي لالتقاط بذرة إنسانيّتهم!
فما المُبدعُ الشّاعرُ الإنسانُ، هذا المُعاصرُ الّذي “يحيا شعريّاً على الأرض” الآن، وهذا المُستقبليُّ الّذي سيحيا، شعريّاً، عليها في كُلّ آنٍ، إلّا ذاك “الشّاعرُ البدئيُّ” الّذي التقطت أصابعُ وجدانه بذرة إنسانيّته، فشرع يُصغي إلى نداءات الوُجُود، ويلتقطُ تكليفاته، ويُجلّي، عبر إبداعه، وُجُودهُ. إنّهُ، إذن، ومن حيثُ الجوهر، الإنسانُ الوُجُوديُّ المُبدعُ بإطلاقٍ، إنّهُ ذاك الّي نقر على جدار كهفٍ خطّاً، والّذي أطلق من حنجرته، مُخاطباً الطبيعة والوُجُود الكُلّيّ، صوتاً، والّذي رافقت مُخيّلتُه أجنحة الطُّيُور فرحلت معها وتجاوزتها وُصُولا إلى ما بعد أعالي السّماوات، وذاك الّذي حرّكت حاجتُهُ الحياتيّةُ الوُجُوديّةُ، فرديّةً وجمعيّةً، أصابع كفّه، فظلّ يُحرّكُها حتّى لانت فابتكرت أوّل شكلٍ مُبتكرٍ ليقول “فكرةً” وليكون “بيت حياةٍ” لهّذه الفكرة المُجسّدة في وشائج كينُونته، وذاك الّذي عبّر عن فكرةٍ بجعلها رسماً، ومن ثمّ حرفاً قادهُ إلى إبداع مزيدٍ من الحُروف الّتي تضافرت فابتكرت اللُّغات الّتي صارت “بُيُوت حياةٍ ووجُود” لا تحيا، بدورها، إلّا شعريّاً في وجدان الشّاعر الإنسان، ومن ثمّ على الأرض، وفي شتّى مدارات الوجُود.
فما “الشّاعرُ” إذن، إلّا كُلُّ أُولئك، وهُو غيرهُم وغيرهُم ممن سكنتهُم الشّعريّةُ فكوّنت وجدانهُم، بدءاً من أوّل ساحرٍ، وأوّل عرّافٍ، وأوّل شامانٍ، وأوّل رامزٍ، وأوّل مُتخيّل، وأوّل صانع أقنعةٍ في “مكانٍ سرّيٍّ” ينبُضُ بأشواق الحياة في “قلب عُزلةٍ” عميقةٍ تقطُنُ “قلب غابةٍ” مُعتمةٍ يتوهّجُ بالضّوء! غير أنّ ما يُميّزُ الشّاعر والمُوسيقيّ، بالمعنى الاصطلاحيّ المُحدّد الّذي أفردهُ الوعيُّ الإنسانيُّ اللُّغويُّ والجمالّيُّ المعرفيّ لكلٍ منهُما، عن سواهُما من المُبدعين المأخُوذين باعتناق الشّعريّة الوُجُوديّة والمُتوسّلين في إبداعهم التّشكيليّ مواد الطّبيعة المادّيّة، إنما هُو سُكنى اللُّغة وأصوات الوجُود رحاب وجدانهما الكُلّيّ بلا افتراقٍ عن الوجُود الّذي يقطُنُهُ طيلة الوقت إذ يقطُنُ بيتهُ اللُّغويّ المُؤثّث من قبله، ومن قبل اللُّغة، ومن قبلهما، بمشيئةٍ مُلتحمةٍ، وحميميّةٍ، وبتوقٍ مُتبادلٍ، وسعيٍّ دائبٍ إلى تعزيز وُجُود الإنسان الإنسان عبر تحفيز سعيه اللّاهب إلى إدراك كماله الإنسانيّ الوُجُوديّ المُمكن، لكونه سعياً ليس لأيّ سعيٍّ سواهُ أن يتكفّلُ بإنهاض الحياة وتحفيز صيرورتها المُجلّية صيرورة الوجُود الإنسانيّ الحقّ، والمُفصحة عن معناها المُفصح، بدوره، عن معنى الوجُود الكُلّيّ، وعن مغزى وُجود الشّاعر الإنسان المُبدع “بُيُوتها” فيها، وفي رحاب ما قد جلّاهُ من مدارات الوجُود الخفيّ الّذي تُومئُ تلك البيُوت، طيلة الوقت، إليه.
ولعلّنا نخلُصُ، في ضوء ما سبق وفي تشابُكٍ مع خُلاصاته التّبصُّريّة، إلى حقيقةٍ تقُولُ إنّ الأُسطُورةُ أو سواها من أشكال الإبداع الإنسانيّ الشّعريّ التّعبيريّ السّابقة عليها، بدءاً من المرحلة الأرواحيّة وأقنعتها، حتّى هذه اللّحظة الوُجُوديّة، إنّما غُرست بُذورُها الأُولى في وجدان “الكائن البشريّ” الّذي عثر، في هذا الوجدان، على بذرة إنسانيّته، فصار، مُذ عُثُوره عليها، وشُرُوعه في تعهُّدها بالرّعاية الواجبة بإرادة الوجُود، وبمشيئته شوقه الإنسانيّ المكنُوز في جوهر وجدانه، إنساناً شرع في “العيش شعريّاً على الأرض”، وفق الخُلاصة الوُجُوديّة الّتي التقطها خيالُ “هُولدرلين” وصفاءُ شعريّته، من أثير الوُجُود الّذي أحسن الإصغاء للأصوات المحمُولة عليه، فاحسن صوغ دلالاتها الشّعريّة الباثّة مدلُولاتها في قصيدةٍ حملها أثيرُ وُجُودٍ كان خفيّاً فجلّتهُ، ليلتقطها هايدغرُ، فيقرأُها برُوح الشّاعر الفيلسُوف الإنسان التّي تسكُنُهُ، مُصغياً، بصفاءٍ ورهافةٍ، إلى أصوات الوجُود المكنُوزة فيها، ومُلتقطاً نداءها الّذي يدعُوهُ إلى الشُّروع في تأويلها؛ فما لبث أن استجاب للنّداء، فأقدم بابتهاجٍ وُجُوديٍّ، وبعُمقٍ فلسفيٍّ وصفاء بصيرةٍ، على تأويلها تأويلاً جماليّاً، رُؤُياويّا، ورُؤيوياً، يظلُّ، بدوره، مفتُوحاً على مزيدٍ من الإصغاء، والتّأويل، والتّبصُّر، والاكتشاف، والكشف.
وبهذا المعنى، تنتفي، في تصوُّري، المقولةُ المُتداولةُ الّتي تزعُمُ ميلاد الشّعر من رحم الأُسطُورةـ أو أنّ الأسطُورة هي الرّحمُ الّذي فيه غُرست بذرةُ الشّعر لينمُو، ويتكوّنُ، ويُولد. وإنّي لأحسبُ أنّهُ لا يبقى صائباً للأخذ به، حتّى اللّحظة، سوى القول المُؤصّل الّذي يُفصحُ عن حقيقة أنّ الأسطُورة نفسها، كتجلٍّ شعريٍّ لُغويٍّ أوّلٍ، قد وُلدت في رحم “الشّعريّة” الّتي هي وحدها رحمُ ميلاد الشّعر وسواهُ من تجلّيات الشّعريّة الإبداعيّة النّصّيّة اللُّغويّة الأدبيّة، أو الصّوتيّة، أو الحركيّة، أو الصُّوريّة، أو التّشكيليّة المادّيّة الّتي تتوسّلُ مُكوّناتٍ تشكيلٍ، وأساليب تعبيرٍ، مُنوّعة، ومُتغايرة، لهذه الشّعريّة الّتي يقطُنُ “الشّعرُ”، مصحُوباً بـ”المُوسيقى”، قلب قلبها مسكُوناً، كما المُوسيقى، بلُبّ جوهرها.
ولهذه الخُلاصة أن تعني، ضمن ما تعنيه أو ضمن تدعُو إلى التّبصُّر، من جديدٍ، فيه، أنّ للنّصّ الشّعريّ المُعاصر، كما للمُستقبليّ، أن يختار لنفسه أيّ ثُوب من أثواب القصيدة المفتُوحة على تشكُّلاتٍ لا تتناهى، أو أن يجترح لنفسه زيّاً منسُوجاً من خُيُوطٍ شعريّةٍ أُسطُوريّةٍ، أو ملحميّةٍ، أو مسرحيّةٍ، أو من خُيُوطٍ شعريّةٍ يُفرزُها غيرُ ذلك من أجناس الأدب المفتُوح بعضُها على بعضٍ بتفاعُلٍ ثريٍّ لا يُفقدُ أيّ جنسٍ منها خُصُوصيّته المحكُومة بجماليّات قوانينه الدّاخليّة، فنكُونُ إزاء نُصُوصٍ شعريّة وقصائد تتزيّا بما نعرفُ من بُنى كُلّيةٍ وأشكالٍ أدبيّةٍ جماليّة، أو تذُهُبُ، ودائماً وفق مشيئتها الرُّؤيويّة، أو الرُّؤياويّة، الجماليّة المُتواشجة، إلى نسج ثُوبٍ مُميّزٍ تنسُجُه بنفسها لنفسها في استجابةٍ لشبكة علاقات مُكوّناتها، فتنفردُ به، وتزهُو بارتدائه جماليّات نسجٍ وصوغٍ وتكوينٍ تُساوقُ الأخُيلة التّصورات والأفكار والرُّؤى النّاجمة عن التّفكير الشّعريّ الّذي انبثقت بصُحبتها، أساساً، عنهُ، لتُقاسمها قول مدلُولات النّصّ، أو القصيدة، كدالٍّ كُلّيٍّ مُلتحمٍ، فيما هي تُومئُ إلى ما يكتنزهُ من مغازٍ، ومعانٍ، ورسائل، ونداءات وُجُود.
إنّ الحياة بمعزلٍ عن الشّعريّة الإنسانيّة بطبيعتها موتٌ، وإنّ الوجُود بمعزلٍ عن هذه الشّعريّة عدمٌ، وإنّ العقل والعلم المُنعزلين عنها، وعن التّفكير الشّعريّ الإنسانيّ والرُّؤى الاستشرافيّة النّابعة من موران الوُجُود الحقّ في أصلابه، لا يعدوان كونهما “انحطاطاً بشريّاً” يُراودُ “عدماً مُراوغاً”، جرى تصويرُهُما من قبل سدنة معابدهما من “مُتوحّشي البشر” على أنّهُما “تطوُّرٌ حضاريٌّ” و”إنارةُ وُجُودٍ”!.
(VII)
الشّعرُ ونقدُ الشّعر

ليس للدّراسة اللُّغوية السّطحيّة الصّرف للشّعر أن تُنتج نقداً شعريّاً، معياريّاً ومنهجيّاً، يُمكّنُنا من استيعاب الشّعر، وفهمه، والتّلذُّذ به، والتقاط رسائله، واستشعار تحفيزاته، واستبقاء مُتعته المُتجدّدة مع مُداومة قراءاته، أو الاستماع إليه. وليس لمثل هذا النّوع من الدّراسة، مهما تفرّع، أن يُسهم في تمييّز جيد الشّعر عن رديئه، أو عمّا تُسميّه أسئلةُ “الجديد” بـ”الكتابات الخرقاء”. ولهذا القول، إن أُخذ به عبر إدراكٍ حصيفٍ لمفهوم “اللّغة” في عُمقه واتّساعه وشُمُوله، أن يُوجب تمييز “نقد الشّعر” ليس عن الدّراسة اللُّغوية اللّفظيّة السّطحيّة الصّرف المُستهدية بما بعُلوم اللّغة العربيّة المعهُودة توارُثاً: نحواً، وصرفاً، واشتقاقاً، وبلاغة، وبيانأً، وبديعاً، وعروضاً، فحسبُ، وإنّما عن كُلّ “دراسةٍ” تستهدي بنظريّةٍ أدبيّةٍ وحيدةٍ، وبمنهجٍ نقديٍّ مُفردٍ، في دراسة الشّعر ونقده.
وما لهذا التّمييز أن يكون إلّا في صالح اللُّغة والشّعر في آنٍ معاً، لكونه يتأسّسُ، ابتداءً، على فهمٍ عميقٍ لمفهُوميهما، وعلى وعيٍ مُؤصّلٍ يُدركُ ما هُو مُدركٌ في تجليّاتٍ شعريّةٍ مُتحقّقةٍ من مُمكناتهما الإبداعيّة ومن آليات تفاعُلهما الجماليّ الرّؤيويّ المُتواشج، ولكونه ينفتحُ، مع هذا الابتداء وأثناءهُ وبعدهُ، على سعي لإدراك ما لم يُدرك بعدُ من هذه ومن تلك، ولاسيّما حين يتفاعلُ الشّعرُ واللّغةُ الشّاعرةُ في وجدان الشّاعر المُبدع المسكُون بهما ليُنشئا في رحابه نصّاً شعريّاً جديداً قد يأتي مسكُوناً بمُمكناتٍ إبداعيّةٍ وآليّاتٍ تفاعُلٍ ليست معهُودةً، ولا موروثةً، وربّما لم تكُن موجُودةً، أصلاً، إلّا كإمكانيّةٍ جماليّةٍ رؤيويّةٍ مُجرّدةٍ، منحها النّصُ الشّعريُّ الجديدُ وُجُوداً فعليّاً إذ جسّد وُجُودها فيه، فأوجدها في الوجُود مع ما جلّتهُ من خفائه، وجلّاها.
وإلى ذلك، ستبقى الدّراسةُ اللُّغويّةُ المُعمّقةُ المُستهديّةُ بمفهُوم اللّغة العميق بشُمُوليّته وبشتّى أبعاده المعرفيّة والوُجُوديّة، ولاسيّما الرّؤيويّة الجماليّة والفكريّة الفنّيّة منها، رافداً ضروريّاً من روافد “نقد الشّعر” الّتي لا يكتسبُ أيٌّ منها فاعليّتهُ النّقديّة إلّا باندماجه التّفاعُليّ الزّاخر مع مُكوّنات منظُومةٍ منهجيّةٍ مُتكاملةٍ من المنظُورات والآليّات والإجراءات المنهجيّة الّتي “يُملي” النّصُّ الشّعريُّ، أو القصيدةُ، إعمالُها على نحوٍ يكفُلُ إجادة استقباله، واستيعابهُ، وفهمهُ، والتقاط جماليّاته، ومُلامسة رُوحه، وبُلُوغ أعُلى ذُرى المُتعة الجماليّة النّاجمة عنهُ، بقدر نُجُومها عن قراءاته التّفاعُليّة، وعن نقده المُستجيب لكيفيّات إنشائه المُتبدّية في العلاقات القائمة، والمُمكنة، بين عناصره، ومُكوّناته، وأمشاج بُناهُ المُنتجة كينُونتهُ الجماليّة المعرفيّة الكُلّيّة المُلتحمة.
ونحنُ إذ نقولُ، مُستلهمين تجاربنا النّقديّة المُباشرة في نقد الشّعر، ومُتابعين تبصُّرات شُعراء عديدين في تجاربهم الإبداعيّة، وخُلاصاتٍ جماليّةً أصّلها نُقادٌ مرمُوقُون، وفلاسفةٌ جماليُّون، وعُلماءُ جمالٍ ونفسٍ، وغيرهُم: إنّ النّصّ الشّعريّ والقصيدة يُمليان منظُوراتٍ وآليّاتٍ وإجراءاتٍ منهجيّةٍ لا يلتقطُها منهُما إلا ناقدٌ حصيفٌ ولماحٌ لكونه لم يُسلم زمام نقده الشّعر لمنهجٍ نقديٍّ وحيدٍ اعتنقهُ فصار “تابعاً” لهُ، فإنّما نُنهضُ هذا القول على حقيقة أنّهُما، أيّ النّصّ الشّعريّ والقصيدة، يُوجّهان النّاقد إلى بلورة منهج نقديٍّ تكامُليّ يخصُّهُما، ويلائمهُما، في تصوره، أكثر من سواهُ. وكأني بهما يبُثّان إشاراتٍ لمحيّةٍ تُرشدُ النّاقد إلى اعتماد هذا المنظُور النّقديّ وترك ذاك، وإلى إعمال هذه الآليّة النّقديّة وترك تلك، وإلى تفعيل هذه السّلسلة من الإجراءات النّقديّة وترك سواها. وقد يكُونُ هذا المنهجُ مُؤسّسا على أخذٍ وتركٍ لمنظوراتٍ وآليّاتٍ وإجراءاتٍ تضمّنتها مناهجُ نقديّةٌ معرُوفةٌ ومُتداولةٌ، وغالباً هُو ما يكُونُ كذلك، غير أنّ لنُصُوصٍ شعريّةٍ وقصائد فريدةٍ ومُتميّزةٍ، جديدةٍ وحداثيّةٍ، أن تُملي على النّاقد بلورة منهجٍ نقديٍّ سيبدو، مثلها، فريداً ومُتميّزاً.
هكذا، إذن، يكونُ للنّاقد أن يُنشئ النّصّ النّقديّ المعرفيّ المُوازي للنّصّ الشّعريّ، أو للقصيدة، المُوازيين، مُوازاةً جماليّةً، الواقع الاجتماعيّ الخارجيّ (البشريّ والإنسانيّ بوسع معانيه) والوجدانيّ الدّاخليّ اللّذين عن الرُّؤية الشّاعريّة إليهُما نشآ، فيكُونُ للقارئ المُتفاعل أن يُبلور لنفسه، مُستلهماً كلا النّصّين ومُتفاعلاً معهُما، نصّاً ثالثاً يخُصُّهُ، وذلك على نحوٍ يفتحُ إمكانيّة تعدُّد النُّصُوص على ما لا يتناهى من الولادات الّتي تتكوّنُ أجنّتُها في رحم النّصّ الشّعريّ الأصل الّذي سيكونُ كُلُّ نصٍّ نقديٍّ رصينٍ وازاهُ، بمثابة وشيجةٍ من وشائج مُشيمة ذاك الرّحم الّتي تُغذي الأجنّة المتكاثرة بقدر تكاثًر القراءات التّفاعُليّة الخلّاقة.
ومع حُضُور الشّاعر المُبدع حُضُوراً، رُؤُيويّا، أو رُؤياويّاً، جماليّاً، في النّصّ الشّعريّ الّذي كتبتهُ أصابعُ وجدانه الكُلّيّ، نكُونُ إزاء الرُّباعيّة الإبداعيّة الخالدة، أو رُباعيّة العمليّة الإبداعيّة الّتي لم يُوجدها، ولن يُوجدها، أمرٌ سوى وُجُود الشّاعر المُبدع وانبثاق مُحفّزاتٍ وجدانيّةٍ أخذتهُ إلى كتابة النّصّ الّذي كان لوجُوده أن يُوجد النّاقد والمُتلقّي، كقارئين، كُلٌّ بطريقته، للنّصّ الشّعريّ الأصل، الّذي لولاهُ لما وجد أحدٌ من أطراف تلك الرّباعية الإبداعيّة، ذلك أنّ الشّاعر نفسهُ لا يُوجدُ، ولا يكونُ شاعراً، إلّا في النّصّ الشّعريّ الّذي يُبدعهُ مُجلّياً فيه، وجدانيّاً وجماليّاً، ذاتهُ القائمة والمنشُودة، وتجربته الحياتيّة الوجُوديّة، ورُؤيتهُ للعالم الّتي تنسحبُ على الواقع القائم والواقع المنشُود، وعلى الحياة والنّاس والوجُود، وعلى كُلّ أمرٍ وشيءٍ أكان غامضاً أم جليّاً.
وسيكُونُ لنا، مع نُهُوض النّاقد، عبر هذا النّهج النّقديّ النّصّيّ التّكامُليّ والحُرّ في آنٍ معاً، بتجلية الرّباعيّة الإبداعيّة عبر تحقُّق حُضُورها موّاراً في نصّه النّقديّ النّاهض على تعرُّف مكوّنات العمليّة الإبداعيّة وآليّاتها الّتي أنتجت النّصّ الشّعريّ المنقُود، وذلك على نحو يُمكّنهُ، كناقدٍ رصينٍ، حصيفٍ ولمّاحٍ، وموسُوعي المعرفة، من “عيش الحالة الوجدانيّة الشّعريّة” التّي في رحمها تخلّق النّصُّ الشّعريُّ وولد مكتُوباً بأصابع وجدان الشّاعر، ومن تفكيك هذا النّصّ، وإعادة تركيبه، واكتشاف جماليّاته، وتأويله جماليّاً ودلاليّاً في تواشُجٍ صميميٍّ، سيكونُ لنا مع نُهُوض النّاقد بهذا الّذي أوردناهُ للتّو، أن نُوازي الرّباعيّة الإبداعيّة برباعيّةٍ وُجُوديّةٍ كُلّيّةٍ هي الّتي أوجبت وجُود “الشّعر” الّذي هُو، في جوهره، “جوهرُ وجدان الوجُود الإنسانيّ”.
وما أقطابُ هذه الرّباعيّه، في التّصوُّر الّذي أحسبُهُ مُؤصّلاً بما يكُفي، إلاّ “الأرضُ” بكامل حُضُورها الطّبيعي وبكُلّ مكنُوناتها ومُكوّناتها وكائناتها، وإلّا “الحياةُ” في صيرُورتها وبكُلّ حالاتها وأحوالها، وإلّا “الواقعُ البشريُّ” بكُلّ تناقُضاته وصراعاته وأفراحه وأتراحه ومهازله ومآسيه، وإلّا “الوجُودُ الكُلّيُّ” جليّاً وغامضاً، وبكُلّ مداراته الجليّة والخفيّة، وبنداءاته وأشواقه الّتي لا يُحسنُ الإصغاء إليها، ولا يُحسنُ تلمُّسها والتقاط لُبّ جوهرها، إلّا شاعرٌ إنسانٌ “يحيا شعريّاً على الأرض”، فيُحسنُ الإصغاء والتّلمس وينهضُ، برهافةٍ شعريّةٍ مُجنّحةٍ، بتجلية ما خفي من وُجُودٍ حيويٍّ غيّبتهُ عن وعيّ مُتوحّشي البشر حُلكة نُفُوسهم وسوداويّة غرائزهم، وأخفتهُ عن أنظار الإنسانيين من النّاس من غير الشُّعراء، أنوارُ الوجُود ذاتُ السُّطُوع المخفي، وذلك في انتظار لحظة نداء شاعرٍ سيُناديه الوجُودُ نفسُهُ ليُجلّي وُجُودها على الأرض، وفي حياة النّاس، وفي “الواقع البشريّ”، وفي أثير الوجُود، عبر النّصّ الشّعريّ الّذي اختار الوُجُودُ نفسُهُ شاعرهُ، وعلى أصابع وجدانه الكُلّيّ أملاهُ!
وإنّي لأحسبُ أنّ في ما قد توخّت هذه المُقاربةُ أن تُضيئهُ وهي تُحاورُ، على نحوٍ جليٍّ، أو مُضمرٍ، إجابات من أجاب من الشُّعراء، عن سُؤال “الجديد” عن راهن العلاقة بين “الشّعر والنّقد العربيّين”، أن يُفصح عن أبرز مُكوّنات استجابة نقديّةٍ مُقترحةٍ من قبلي، وربّما تكُونُ في حاجةٍ إلى مزيدٍ من التّعميق المعرفي والتّأصيل الجماليّ، لما أبدوهُ، إلماحاً، من تبصُّراتٍ، وتصوُّراتٍ، وأفكارٍ، وآراء، ولما قدّمُوهُ من توصيفاتٍ تشخيصيّةٍ، ومن وصفات علاج تُمليها “تشوُّهاتٌ” تملأُ وجه هذه العلاقة ببُثُورٍ تُشوّههُا، وتُنافي طبيعتها الواجبة الوجُود، فتُفكّكُها، وتجعلُها غير ذات مغزى وجدوي، وتجعلُ تركها والاستغناء عُنها من قبل الشُّعراء حاجةً تُمليها الحاجةُ الوُجُوديّةُ إلى مُواصلة كتابة شِعْرٍ هُو الشِّعْرُ فِي أجْمَلِ تِجَلِّيَاتِهِ المُؤَهَّلَةِ لاسِتَضَافَةِ الْحَيَاةِ والإنْسَانِ والْوجُودِ، وتَجْلِيِةِ فِي إِهَابِ وِجْدانِهِ الَّذي هُو وجْدانُ الْوجُودِ الْكُلِّيِّ الْقَائِم عَلَى هَذَا الثَّالُوثِ الْخَالِد!




