تمثّلات اليهودي في الرّواية العربيّة

في أحد مباحث كتاب الدكتور صلاح صالح “سرد الآخر“، أفرد مبحثًا مهمًّا تناول فيه ظاهرة “سرد اليهود العرب“، أشار المؤلف إشارة بالغة الأهمية -في وقت صدور الكتاب- وإن كانت تحتاج إلى مراجعة الآن؛ متعلقة بوضعية الدراسات التي تناولت صورة اليهود في الرواية العربية، يقول المؤلف ما نصه “يبرز أمران لافتان لدى تأمّل الشغل الفني على اليهود والشخصية اليهودية في الرواية العربية: يتعلق الأول بحالة شاملة من الانصراف عن تناول اليهود عمومًا، واليهود العرب خصوصًا، وكأنهم غير موجودين، وكأنهم لم يكونوا في زمن غير بعيد عن زمننا جزءًا من النسيج الاجتماعي -المتنافر أو غير المتنافر- في مناطق ومدن عربية عديدة، في اليمن والمغرب ومصر وسورية والعراق” ويستكمل ملاحظاته قائلا “ويتعلق الأمر الثاني بأن الأعمال الروائية الفنية والروائية العربية التي تناولتهم، قد تناولتهم خارج الأطر الاجتماعية الموجودة -أو التي كانت موجودة- في بعض الدواخل العربية، واقتصرت على تناول العدو الصهيوني، ذي الملمح الواحد، والبعد الواحد” (سرد الآخر، ص198).
قد يبدو هذا الاستنتاج بعيدًا عن الحقيقة لو أهملنا تاريخ نشر الكتاب الذي صدر عام 2003، فاستنتاجه يشير إلى حالة من الانصراف عن تناول اليهود عمومًا واليهود العرب خصوصًا كما يقول المؤلف. لكن المتأمّل للنتاجات الروائيّة يكتشف أن ثمة اهتمامًا بالغ الحدّ بالشخصية اليهودية (وصل إلى التدليل المفرط في التناول) سواء من روايات تتصل اتّصالاً وثيقًا بقضية الصّراع على الأرض والهُوية، كما مثّلت الرّواية الفلسطينيّة في كثير منها، أو أعمال عربية تناولت شخصية اليهودي من منظور الآخر، على اختلاف استحضار هذا الآخر.
ربما ثمّة تطورات في الاستدعاء وحضور الشخصية اليهودية في الرواية العربية، إلا أنه وفي الأخير تشهد الفترة الأخيرة نقلة مهمة على مستوى نمط الحضور، وأيضًا على مستوى الاهتمام النقدي الزائد. كما أن الطموح الذي أملناه في عنوان المبحث “سرد اليهود العرب” لم يترجم بصورة حقيقية ودالّة داخل المتن؛ إذْ اكتفى المؤلف بنموذج روائي واحد، استشهد به على التداعيات أو التمثّلات لصورة اليهود في الرواية العربيّة، وهو غير كافٍ في ظل حضور كمّي كبير من الروايات التي تطرقت لهذه الإشكالية.
بصفة عامة، يعود مرجع هذا الاهتمام إلى الطبيعة الإشكالية للشخصية اليهودية، التي تتعدد إشكالياتها، أولا لعلاقتها بذاتها وبمقدراتها الشخصية، وهو ما يدفعها إلى تحديد نمط معين من التعامل، وثانيا، لعلاقتها بجماعة اليهود وقبول تصرفاتها أو إدانتها، ومن جهة ثالثة علاقتها بالآخر، والآخر هنا رديف للعربيّ المسلم، وما تمثّله طبيعة العلاقة الصراعية المتوارثة من التاريخ، من ثنائيات تتراوح بين القطيعة والاعتراف، أو الاندماج والانفصال.
لكن ثمّة عامل آخر أسهم في سعي الكُتّاب إلى استدعاء الشخصية اليهودية، يتمثّل في المتغيّرات السياسية، وما أعقبها من تحولات في قبول الآخر، بعد تلك القطيعة التي أحدثتها حرب 1948، وما تشكّل من صورة في مجملها اعتبرت اليهودي مغتصبا للأرض، وسافكا للدماء، ومُدنسا للهُوية. وما تلا هذه الفترة من علوّ صوت القومية العربية بعد ثورة 1952، وهو ما أحدث نقلة نوعية في الصراع، حيث عمدت القوميات العربية على اختلاف أيديولوجياتها (ناصرية/بعثية/..) إلى إقصاء الآخر(اليهودي)، وقد اتخذ إجراءات فعلية، عبر محاولات تهجير قصرية، في بلدان عربية كثيرة كما حدث في مصر والعراق، ثم في سوريا بعد نكسة 1967، حيث تم سلبهم الهوية وحقوق المواطنة.
أهمّ نقلة في الصراع جاءت عقب نصر 1973، خاصة بعد الجلوس على طاولة المفاوضات، فأخذت الصورة تحتوي على النقيضين، ما بين الإفراط في القطيعة، كما جسدتها قصيدة أمل دنقل “لا تصالح”، والبدء في مدّ يد الصُّلح التي حذّرنا منها أمل نفسه ولو “الدم.. حتى بدم!” -وهو ما لم يتحقّق مع الأسف- تحت شعارات السّلام والتعايش وغيرها، وصولاً إلى مفاوضات أوسلو الشهيرة عام 1993، التي كانت بداية جديدة استكمالاً لبداية السادات برحلته إلى الكنيست الإسرائيلي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1977، وما تلاها من اتفاقية السلام في كامب ديفيد 1979. كانت الرواية حاضرة في كلّ هذا فلم تغفل الحروب والصراعات والمواءمات، وفي كثير منها عبرت عنها واستلهمتها، دون أن تنسى جرح الماضي كما عبر إحسان عبدالقدوس من أن “الرصاصة لا تزال في جيبي”، وإن كان قد جرت مياه كثيرة في النهر.
لعل أهم تحوّل حقيقي في علاقة الروائي بالآخر اليهودي، يتمثّل لي في احتلال اسم اليهود صدارة عناوين الروايات، على نحو روايات: يوميات يهودي في دمشق (إبراهيم الجبين، دار خطوات، 2007)، وأيّام الشتات (كمال رحيم، وكالة سفنكس للآداب والفنون، 2008)، واليهودي الحالي (على المقري، دار الساقي، 2009)، مصابيح أورشاليم: رواية عن إدوارد سعيد (علي بدر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2009)، والسيدة من تل أبيب (ربعي المدهون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2010)، وفي قلبي أنثى عبرية (خولة حمدي، دار كيان، 2013)، اليهودي الأخير (عبد الجبار ناصر، الدار المصرية اللبنانية، 2015)، واليهودي والفتاة العربية: “قصة الحب الخالدة” (عبد الوهاب آل مرعي، العبيكان، 2016)، ويهود الإسكندرية (مصطفى نصر، الدار المصرية اللبنانية، 2016)، وحمّام اليهودي (علاء مشذوب، دار سطور، 2017) وآخر يهود الإسكندرية (معتز فتيحة، دار اكتب، 2017) ماذا عن السيدة اليهودية راحيل؟ (سليم بركات، 2019)، واليهودي الأخير في تمنطيط (أمين الزاوي)، وغيرها من أسماء روايات أبرزت اسم اليهودي على عتبتها الخارجية عكس ما كان من قبل حيث تظهر الشخصية داخل المتن الروائي ضمن مجموعة من الشخصيات، أو تبرز في صورة المجاز على نحو ما جعل ممدوح عدوان عنوان روايته هكذا “أعدائي” (2000)، في إشارة إلى تحميلهم جرائمهم التي -مع الأسف- سعى الكثير من الكُتّاب في الفترة الأخيرة إلى تغافل هذه الجرائم، بل وتبريرها ومن ثم التعاطف معهم، وإلصاق صفة الطيب لليهود (الإنساني) على عكس ما راج عنه في الكلاسيكيات العالمية، كما فعل شكسبير في تاجر البندقية، بجعله مرابيا ومقامرًا، وتشارلز ديكنز في “أوليفر تويست” جعل من شخصية اليهودي “فاجن” ذلك المُسنّ ذي الشعر الأحمر، عديم الضمير، وقد ألصق به كل صفات الشر، فهو “بخيلٌ يقوم بتدريب الصبية لسرقة الأبرياء، ويجني المال من وراء ذلك”. ومن هنا ظهرت صورة اليهودي المثالي تلك الصورة التي عملت الرواية اليهودية على ترويجها.

الجانب الثاني من الاهتمام بصورة اليهودي، تمثّل في المتابعات النقدية التي عنيت باستجلاء هذه الصورة داخل المتون الروائية العربية. فثمة اهتمام نقدي بهذه الصّورة وتتبعها في كثير من المرويات، منها ما هو أكاديمي، على نحو ما فعل عادل الأسطة، حيث أنجز رسالة الدكتوراه في موضوع “اليهود في الأدب الفلسطيني”، ثم أتبع هذا بكتابه “اليهود في الرواية العربية” (رام الله، الرقمية للنشر، 2012)، وأيضًا دراسة الدكتور رشاد الشامي “الشخصية اليهودية في أدب إحسان عبدالقدوس” (القاهرة، 1992) وهناك دراسة حسين أبوالنجا بعنوان “اليهود في الرواية الفلسطينية” (الجزائر، منشورات رابطة إبداع الثقافية، 2002). وكتاب “الشخصية اليهودية: دراسة أدبية مقارنة”(دار العين، 2010)، للدكتور محمد جلاء إدريس، حيث يقدّم دراسة مقارنة بين رواية “إيفانهو” لـ”سير ولتر سكوت”، ورواية “أحمد وداود” للروائي المصري فتحي غانم.
إضافة إلى دراسات مُتفرّقة شغلت فصولاً في كتب، على نحو ما جاء في كتاب الدكتور صلاح صالح “سرد الآخر: الأنا والآخر عبر اللغة السردية” (المركز الثقافي العربي، بيروت، 2003)، فقصر الفصل الخامس على “سرد اليهود العرب” تناول فيه بالدراسة تحليل رواية “حمَّام النسوان” لفيصل خرتش.
وبالمثل أوقفت الدكتورة ماجدة حمّود ضمن كتابها “إشكالية الأنا والآخر (نماذج روائية عربية)” (الكويت، عالم المعرفة، مارس 2013)؛ ثلاث دراسات لتناول الظاهرة، الأولى بعنوان: الأنا والآخر الصهيوني في رواية سحر خليفة “ربيع حار”، والثانية عن “سؤال الهوية في مرآة الآخر لدى عبدالرحمن منيف في ثلاثية “أرض السواد” والثالثة بعنوان” إشكالية لقاء الأنا والآخر اليهودي في رواية على المقري “اليهودي الحالي”، وهناك دراسة رائدة لفيصل درّاج نشرت في مجلة الكرمل (ع 53، 1997) بعنوان”صور اليهودي الغائمة في مرايا غسان كنفاني”.
هذه مجرّد أمثلة على الاهتمام النقدي باستجلاء صورة اليهود في الرواية العربية، وإن كانت هذه الدراسات توقفت في بعضها على الرواية الفلسطينية على وجه الخصوص، كما فعل عادل الأسطة وحسين أبوالنجا، أو أوقفت الدراسة كلّها على روائي واحد كما فعل رشاد الشامي، حيث أوقف دراسته على الأديب إحسان عبدالقدوس دون غيره، أو على نحو استجلاء الصورة عبر روايات منفردة كلٍّ على حدة. وهو ما لم يقدّم صورة دقيقة للشخصية اليهودية تعكس مسار التحولات التي مرّت بها، في ظل التحوّلات السياسيّة التي كان لها دورها المهم في هذه الصور المتعدّدة، وتنوعاتها من الريبة والقلق إلى الاطمئنان له واعتباره صديقًا وعاشقًا في كثير من المرويات. وهو ما تسعى هذه الدراسة في أحد محاورها الأساسية لإبرازه.
فالصّورة المبدئية التي راجت لليهود كما تجلّت في الثقافة العربية، هي صورة نمطية ترددت في أشعار الشعراء على نحو ما صوّر أبو نواس بأن اليهودي يضمر الغدر والشر للآخر، كما أنه مُراب وبالنسبة إلى المرأة اليهودية فهي قوّادة تقود الرجال إلى أحابيلها وشراكها، على نحو ما تردد في قصيدة أبي نواس الشهيرة:
- فلما حكى الزنار أن ليس مُسْـلمًا ظننا به خيرًا فظن بنا شـــرًا
- فقلنا على دين المسيح بن مريـــم؟ فأعرض مزورًا وقال لنا هـجرًا
- ولكن يهودي يحبك ظاهــرًا ويضمر في المكنون منه لك الغدرا
الغريب أن هذه الصورة لم تختلف عمّا راج عن اليهودي في المرويات الغربية، فكما يقول هاني الراهب إنه حتى بداية القرن التاسع عشر كان اليهودي يصوّر في القصص الإنكليزية، إما على صورة شايلوك أو اليهودي التائه” (الشخصية اليهودية في الرواية الإنكليزية، ص 5).
في حكايات ألف ليلة وليلة، ألصقتْ لهم الليالي الكثير من الصفات التي اشتهر بها اليهود في العادة، كالتجارة وامتلاك الأموال، وامتهان الطب، كما نرى في قصة “الخيّاط والأحدب واليهودي”. فالصورة كما تراءت في الحكاية، تجسّده على أنه الملاذ، فقد أسرع لإنقاذ الخياط بمجرد أن رأى ربع الدينار. فالطبيب اليهودي في القصة لجأ إليه الخيّاط وزوجته، بعد أن تعثرا في جثة الأحدب. وتظهر صورة أخرى لليهودي من خلال شخصية عذرة اليهودي في حكاية “على الزيبق المصري”، فهو “ساحر مصري يعزم في الجوّ، فيخرج له قصره العظيم ويعلِّق فيه حلة ابنته متحديًّا الشطار فيمن يستطيع أن يصل إليه” ويمارس أدوار الشر، حيث يسحر المسلمين المتعرضين له حيوانات، وتكون نهايته على يد ابنته بعد أن تُسْلِم لأنها أحبت علي الزيبق.
وإن كانت سهير القلماوي تشدّد على أن شهرة اليهود في حب المال واتصالهم بالمعاملات المالية لا تحتل مكانًا لائقًا بشيوعها في الكتاب (تقصد ألف ليلة وليلة). كما أن عداوتهم للمسلمين غير موجودة، وبصفة عامة تقول إن أثر اليهود في الليالي لم يكن عن طريق الأشخاص، وإنما كان عن طريق تسرّب طائفة من أخبار بني إسرائيل عن صفات العالم الآخر أو من أخبارهم عن الزهاد والصالحين (سهير القلماوي، ألف ليلة وليلة، ص 163).
في المخيلة الشعبية رسمت السينما صورة لليهود، هي أقرب للصورة التي قدّمها شكسبير في “تاجر البندقية” لشخصية المرابي شايلوك، وهي صورة واقعية نوعًا ما، حتى لو كانت متأثرة بالعداء التاريخي بين المسيحيين واليهود فقط، كما مزجت الصُّورة بين الشّخصيّة البخيلة أو الحريصة والداعرة كما قُدِّمَتْ في كثير من الأفلام العربية، التي جاءت في فترة معينة، تجسيدًا للصراع العربي الصهيوني.
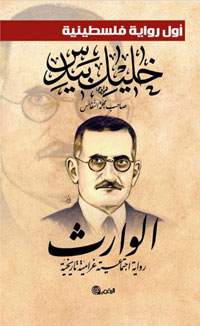
من هذا فيلم “السفارة في العمارة” (إنتاج 2005)، ليوسف معاطي وعمرو عرفة، وعادل إمام، فبسبب الآخر (السفارة رمزًا للكيان اليهودي) يضطر المهندس شريف خيري العائد من الخليج إلى عرض شقته للبيع، كما أن الأنا (المهندس شريف خيري) هنا تتعرض للإكراهات بسبب هذا الآخر (السفارة)، جراء عمليات الحماية الزائدة لمقر السفير، فتنتهك خصوصيته، كما يُمارس عليه الآخر ضغوطًا تصل إلى الابتزاز بشريط الفيديو المصوّر له، حتى يتنازل عن قضية طرد السفارة بدعوى الضرر، ويقبل في أول الأمر لكن استشهاد إيّاد ابن صديقه، يجعله يرفض سياسة التهديد، ويخرج في مظاهرات غير عابئ بأي شيء، غير صورة الطفل إياد بعد اشتعال الانتفاضة.
وإن كان قبل ثورة 1952 كما يقول الناقد السينمائي أحمد الحضري في كتابه “تاريخ السينما في مصر” أن صورة اليهود كانت أقرب إلى الواقعية، وحافظت على سماتها في الموروث الشعبي المصري، مثل البخل والكلام بطريقة معينة، لكنها وفق قوله لم تتطرق إلى حياة اليهود الأسرية على نحو ما ظهر في أفلام “مزراحي وشالوم”، و”فاطمة وماريكا وراشيل” (1949)، ثم “حسن ومرقص وكوهين” (1954).
على مستوى المدونة الروائية العربية: لو تساءلنا كيف تمثّلت صورة اليهودي؟ وهل ابتعدت عن الصورة النمطية المتوارثة عن اليهود في المخيال الشعبي؟ وهل ثمّة تغيرات في نمط الصورة وتلقيها، وأيضًا ما مستوى حضورها في المدونة السردية؟ ومن ثم نتوقف هنا عند بعض المرويات العربية، على اختلاف بيئاتها (دون أن نقصرها على الروايات الفلسطينية)، لنرصد كيف تجلّتْ صورة اليهودي في الرواية العربيّة، وما هي التحولات التي أصابت هذه الصورة وإلى أيّ مدى وصلت؟
يقول عادل الأسطة إن بواكير الرواية الفلسطينية باستثناء رواية خليل بيدس “الوارث” (1920)، قد خلت من ذكر الشخصيات اليهودية وقد استمر الأمر لفترة طويلة، فقبل عام 1948 صدرت روايات عديدة لم يكن للكتابة عن اليهود فيها حضور لافت، وبعد العام 1948 ظل الأمر كذلك باستثناء روايات قليلة مثل روايتي ناصر الدين النشاشيبي “حفنة رمال” و”حبّات البرتقال”، وهي روايات كتبت تحت تأثير اللحظة التاريخية وما شهدته في خمسنات وستينات القرن الـ20″. (اليهود في أول رواية فلسطينية، جريدة الأيام، 10-02-2013).
بداية أودّ أن أشير إلى ملحوظة استوقفتني، ألا وهي أن كثيرًا من الروايات راحت تبحث في التاريخ عن التعايش بين اليهود والعرب، وأن الكثير من اليهود أنصفوا من ظلم وإكراهات المسلمين على يد رجال مسلمين، على نحو واقعة الطبيب ناجي بعد أن سلبه الضابط سوادي مبلغ العشرة آلاف دينار بحجة أنه يجمع تبرعات ويرسلها إلى إسرائيل، وعندما فشل في استرداد المبلغ ذهب إلى بغداد واشتكاه إلى وزير الداخلية آنذاك الزعيم الركن أحمد محمد يحيى، الذي ما أن سمع شكواه حتى انتفض صائحًا “أولستَ مواطنًا عراقيًّا أبًا عن جدّ؟ كلنا أخوة وإن اختلفت الأديان لكن الرب واحد. الشرطة في خدمة الشعب، وليس نهبه” (ص، 49).
فعلى المقري في “اليهودي الحالي” يذهب قديمًا إلى منتصف القرن السابع عشر، وبالمثل عبدالجبار ناصر في “اليهودي الأخير”، دارت أحداث روايته في عشرينات القرن الماضي وعلاء المشذوب في “حمام اليهودي” يذهب إلى ستينات القرن الماضي أيضًا. والنبش في المدونة التاريخية من أجل استجلاء مواطن التعايش والتسامح بين العقائد المختلفة، كأنه يمهد لحالة التطبيع التي بدأت تمهّد لها الحكومات العربية، وثانيا لتقول إن الصراع سياسي وليس عقائديًّا، ومن ثم لمَ الخصام، خاصة أن شواهد التاريخ، أكدت على وقوف اليهود مع المسلمين في كثير من المعارك، على نحو مع حدث في معاركهم ضد الصليبيين، أو ضد المغول من قبل.
بل ساعد اليهود المسلمين العرب أثناء الفتح الإسلامي للأندلس، كما أن المسلمين واليهود تعرّضوا لمحاكم التفتيش في الأندلس. وهو ما يفعله بطل الأسواني في دفاعه عن رفضه فكرة نبذ الآخر فيلقي محاضرة لويندي عن علاقة العرب باليهود وكيف عاشوا تحت الحكم العربي قرونًا دون مشاكل أو اضطهاد، بل كانوا على حد تعبيره “محل ثقة العرب” فالصراع كما لخصه ناجي “صراع سياسي وليس دينيًّا”(ص، 279 ). كما يضرب لها مثالاً على المساواة التي عانها المسلمون واليهود من محاكم التفتيش عندما سقطت الأندلس في أيدي المسيحيين الإسبان (ص 279).
الجوار والألفة واليهودي

قدّم نجيب محفوظ في رواياته “زقاق المدق” (1947)، صورة لليهودي وفق ما تراءى له من يهود عاشوا في مصر (ضمن أقليات أخرى كالأرمن واليونانيين) قبل رحلة التهجير التي طالتهم بعد الثورة. وقد جاء حضور اليهود في الرواية عن طريق شخصية حميدة، التي أبرزت تأثير اليهوديات على الفتيات صويحباتها من عاملات المشغل؛ فهن فتيات خرجن عن تقاليدهن الموروثة بسبب ظروفهن الخاصة البائسة، وأيضًا بسبب ظروف الحرب عامة، فاشتغلن بالمحال العامة “مقتديات باليهوديات” (زقاق المدق، ص 45)، بل إن تأثير اليهوديات على هؤلاء الفتيات تجاوز تقليدهن في العمل، إلى التغيير الذي حلّ عليهن من تقليد اليهوديات، في العناية بالمظهر وتكلُّف الرشاقة، ومنهن من يرطنّ بكلمات، ولا يتورّعن عن تأبُّط الأذرع والتخبّط في الشوارع الغرامية، وبمعنى أكثر فقد كان تأثيرهن كبيرًا “تعلّمَن شيئًا واقتحمن الحياة” (زقاق المدق، ص 45).
حالة الإعجاب باليهوديات لم تتوقف عند هذا التأثير، وإنما في وصفهن وهي تتحدّث لأمها ذات يوم بأن “حياة اليهوديات هي الحياة حقًّا”، وهو ما كان لهذا الكلام وقعه العكسي على الأم، وقالت في انزعاج “إنك من نبع أبالسة ودمي برئ منك” (ص 45). فمحفوظ على الرغم من سعيه ألّا يقع تحت تأثير الصُّورة الذهنيّة المرسومة لليهود، فإنه جعل وعي شخصياته يستجيب لهذه الصورة بما تحمله من حمولات سلبيّة. فالأم بمجرد ما رأت إعجاب ابنتها باليهوديات العاملات في المشغل، على الفور، قرنتْ بينها وبين الأبالسة، ففكرة قبول الآخر/اليهودي على الرغم من المعايشة المكانية وعلاقات الجوار غير واردة، وهذا نتاج السياسة التعبويّة في لصق كل الصفات الشائنة باليهود.
يحضر “في زقاق المدق” أيضًا السمسار اليهودي في الوكالة حيث تجارة السيد سليم علوان أحد أثرياء الحارة. وهنا يقدّم لنا محفوظ صورة التاجر اليهودي الذي لا يؤتمن فالسيد سليم يجلس حذرًا منتبهًا لكلامه “مستجمعًا يقظته، مستحضرًا حذره” كما أن التاجر يبدو رقيق الحديث لطيفه، وإن كان حسب تعبيره شيطانا مفيدا، ومن ثم “يحسبه الجاهل صديقًا ودودًا” وإن كان هو في الحقيقة “نمر يتوثّب، يتمسكن ويتمسكن حتى يتمكّن، والويل لمن يتمكّن منه” (زقاق المدق، ص 72).
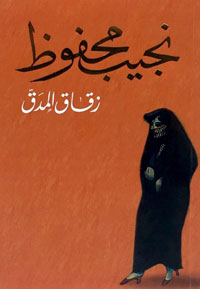
تلا هذا الحضور القليل والمقتضب لشخصية اليهودي في رواية “زقاق المدق”؛ حضور واسع عبر شخصية سعاد وهبي، التي يفرد لها محفوظ فصلاً مُستقلاً في رواية “المرايا” (1971)، ويجعلها بؤرة الحدث بين طلاب الجامعة والأساتذة، وأيضًا مصدر نفوذ عندما يريد عميد الكلية بسبب تأثيراتها السّلبيّة على الطلبة فصلها، وتعود بحكم اتصالاتها التي وصلت إلى وزير التعليم، حسبما سرّبت الإشاعات.
سعاد وهبي طالبة جامعية رافقتهم في مراحل الدراسة، تنتمي إلى حيّ الظاهر بالقاهرة، لكن المواصفات التي يقدّمها بها الراوي تجعل منها غانية فكما يقول “ولدت وترعرعت في جوٍّ من الحرية الجنسيّة المطلقة!” وهناك مَنْ يزيد “وأسرتها منحلة، الأب والأم والأخوات” وتارة “هي امرأة لا عذراء مجربة للسهر والسّكر والعربدة!”. في الحقيقة الصورة التي رسمها محفوظ لسعاد وهبي، باعتبارها تمثّلا للشخصية اليهودية الموجودة في حي الظاهر، لم تنفصل عن الصورة الكلية في الموروث الشعبي للفتاة اليهودية، وهي التي عملت الدراما والسينما على تكريسها في عقلية المشاهد.
فسعاد رمز للإغواء، وفي الوقت ذاته رمز للانفتاح والتحّرر الذي يقابله الاحتشام والانغلاق وتجنُّب المخالطة من جانب الفتيات المصريات اللاتي كنّ يدرسن في عام 1930، حيث كان “يغلب عليهن طابع الحريم، يحتشمن في الثياب ويتجنبن الزينة ويجلسن في الصّف الأوّل من قاعة المحاضرات وحدهن كأنّهن بحجرة الحريم بالترام، لا نتبادل تحيّة ولا كلمة وإذا دعت ضرورة إلى طرح سؤال أو استعادة كرّاسة تمّ ذلك في حذر وحياة”.
أما سعاد وهبي فكأنها “نجم هبط من الفضاء”، كانت أجمل الفتيات وأطولهن وأحظاهن بنضج الجسد الأنثوي. ولم تقنع بذلك فلوّنتْ بخفة الوجنتيْن والشفتيْن، وضيّقت الفستان حتى نطق، وتبخترت في مشيتها إذا مشت…”، ثمّ يستمر في وصفها قائلاً “كانت بخلاف زميلاتها غاية في الجرأة، تواجهنا بثقة لا حدّ لها، ولا تخفي إعجابها بنفسها، وتناقش الأساتذة بصوت يسمعه الجميع، وبالجملة تحدت الزمان والمكان” (المرايا، ص 133).
وفي نفس الرواية يكشف عن تأثير اليهود على شخصية عيد منصور الذي كان يعيش مع أبيه وخادم عجوز لا رابع لهم. فهو كما يصفه بأنه “الصديق بلا صداقة” كان وما زال بلا قلب. أبوه تاجر عمارات، عمل مع اليهود طويلاً واكتسب الكثير من أساليبهم ومهاراتهم” (المرايا ص 257)، وبحكم عمل الأب مع اليهود تأثّر بهم فكان “بخيلاً، دقيقًا، فظًا، جامد المشاعر”. وهذه الصفات انعكست على تربية ابنه فربَّاه “تربية شديدة لا رحمة فيها ولا مهادنة”، مُصمّمًا على إخراجه على نمطه “فنشأ عمليًا صارمًا ذا عقل نفعي، وبلا قلب” كما اتخذ القرش معبودًا ومقياسًا للرجولة والتفوق حتى أنه لم “يتسع قلبه إلا لذلك المعبود الأوحد” رفع شعار “أنا أعزب وسأظل أعزب وبلا وريث فيجب أن أتمتع بحياتي”. لا يعرف للحياة غاية أخرى غير جمع المال، مجرّدا من الوطنية حتى أنه يقول “لولا الإنكليز، لولا اليهود، ما كان لهذه البلد حياة!” (ص 259).
وبصورة تكشف لنا تأثيرات السياسة وما تحدثه من أزمات نفسية، يُقدّم لنا شخصية الدكتور صادق عبدالحميد، ويصفه بأنه دكتور “باطني ممتاز، وأديب وفنان وفيلسوف وسياسي أيضًا” ذهب إلى إنكلترا في بعثة قصيرة في عهد طَلَبِ العلم، وحصل فيها على الدكتوراه، بعد نكسة 5 يونيه 1967، ذهل واختل توازنه، ومضى يتخبّط بين الصالونات والمقاهي كأن القيامة قامت. كان أثر النكسة عليه شديدًا فعندما التقاه الراوي في بيت رضا حمادة بمصر الجديدة، وبعد أن استرد الثقة أخذ ينظر إلى الهزيمة باعتبارها “تجربة مريرة نزلت بنا لنعيد تشخيص أنفسنا”.
كان يرى أن الأهم هو المحافظة على الثوّرة، فهي الضمان لاسترداد الأرض، لكن رأيه الصادم تمثّل في قوله “إننا مُطاردون، يُطاردنا التخلُّف وهو عدونا الحقيقي لا إسرائيل وليست إسرائيل عدوّا لنا، إلا لأنها تهددنا بتجميد التخلف” ويتابع “أتحدى إسرائيل أن تفعل بنا مثلما فعلناه بأنفسنا”.(ص 162). الصورة البارزة لموقفه أنه لا يعادي إسرائيل، لكن الحقيقة أنه اتخذ من الرمز الذي يمثل الفزاعة لكل عربي، نموذجًا للمقارنة، وهو ما يؤكد على حميّته ووطنيته، فهو يوجه النقد إلى الذات، دون أن نبحث عن كبش فداء، لأزماتنا!
الحبُّ ونبذ والعنف

يضع إحسان عبدالقدوس شخصية المرأة اليهودية محورًا رئيسيًّا لروايته “لا تتركوني هنا وحدي” (روز اليوسف، 1979). في التمهيد الذي صدّر به الرواية يشير إلى أنّ استحضار المجتمع اليهودي في رواياته قديم، فقد سبق أن كتب “ربما كانت ثالث أو رابع قصة” فكما يقول “قد عشت هذا المجتمع منذ كنت أعيش صباي وشبابي في حي العباسيّة الملاصق لحي الظاهر الذي كان يضمُّ أغلبية من السّكّان اليهود وكان لي من بينهم أصدقاء وصديقات كثيرون… ثمّ عشتُ مرحلة من صباي في حارة اليهود عندما كنت طالبًا في المدرسة الثانوية، وكنت أيام الإجازة أعمل في محل تجارة بدل وبلاطي، وكان يلازمني في العمل موظف يهودي اسمه ساسون، كان يصحبني كثيرًا لزيارة عائلته في بيته بحارة اليهود”.
تبدو علاقة إحسان عبدالقدوس باليهود علاقة شخصية ومنقسمة إلى جزأين الأول يتأتى بحكم معايشته لهم ومن ثمّ خالطهم، فنرى حالة من التعاطف مع اليهود، والثاني يتمثّل في الرفض القاطع لتلك الممارسات الصهيونية، ومن ثم كان في معسكر الرافضين لاتفاقية السلام. ورغم هذا الصرّاع بين التعاطف والكراهية إلا أنه في كتاباته عنهم ترك مسافة، وإن كان مال في بعض منها إلى التعاطف معهم، والتأسي لفراقهم أثناء هجرتهم من مصر.
في مقالته القصصية “أين ذهبت صديقتي اليهودية” (وإن كان هو يشير إلى أنها قصة)، نُشرت ضمن كتاب بعنوان “الهزيمة كان اسمها فاطمة” يتحدث عن الشخصيات المُلهمة له في كتابة الكثير من قصصه، ولا أحد يعرفها، ومن هذه الشخصيات شخصية جلاديس، وهي شخصية يهودية ارتبط بها بحكم سكنها بالقرب منه، يقول عنها “لا أحد ممن قرؤوا لي قصصًا يعرف مثلاً جلاديس أو يعرف مدى تأثيرها على نبضات فكري التي أوحت إليّ بأكثر من قصة…”، ويعرّفها هكذا “جلاديس فتاة يهودية كانت تقيم قريبًا منا في حيّ العباسية، منذ أن كنت صبيًّا، وكان كل ما يجمعني بها، هو ما يجمع أولاد وبنات الأحياء المتقاربة… وكنت منذ صباي أهوى القراءة… كنت لا أقرأ الفرنسية، وجلاديس تجيد الفرنسية… وعندما اكتشفتْ هواياتي الأدبيّة، بدأت تترجم لي كثيرًا من القصص الفرنسيّة التي تقرؤها، وهي التي عرّفتني بالكاتب الفرنسي جي دي موباسان…” ويستمر “هذا الاهتمام الأدبي المتبادل أطال في عمر صداقتنا… جلاديس وأنا.. كانت أقرب إلى الصداقة الأسرية، فالأسرتان أيضًا كانتا متعارفتين… وطول عمر هذه الصداقة لم أكن أشعر أبدًا بأنها يهودية… لم يكن يخطر ببالي أن أقيسها بمقياس ديانتها..”.
المقالة عبارة عن تفاصيل عن علاقته بجلاديس وموقع أسرتها في الحي، وعن التكوين الاجتماعي لأسرتها الذي يختلف بالطبع عن أُسَر الحي، وهو ما كان ينعكس عليه، فعندما يزورها كان يشعر “بأنه غريب”، وعن المواجهات التي كانت تتمّ بين فتوات حيّ الحسينيّة على سُكّان حيّ الظاهر الذي يقطن فيه اليهود. كما يسرد عن علاقته بفلسطين التي زارها عام 1945، وعن علاقته بجلاديس التي لم يكن تتطرق لأبعاد صراع بين يهود ومسلمين قط. بعد الحرب تختفي جلاديس وعندما يسأل عنها يعرف أنها سافرت إلى إسرائيل، ويكتشف أنها ليست الوحيدة التي هربت إلى إسرائيل وإنما هي وثلاثة أصدقاء.
ظلت حكاية جلاديس في ذاكرته حتى كتبها في قصة “بعيدًا عن الأرض” (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980) وإن كان غيّر اسمها في القصة إلى “ماريا هوبر” وجعلها أميركية يهودية وفي هذه القصة التي يقول إحسان نفسه، إنه كتبها في الخمسينات، ولها هدف سياسي يثبت بها أنه “ليس هناك عداء طبيعى بين الأديان، ولكن المنظمات السياسية هي التي تستغل تعدُّد الأديان لتثير الخلاف، وتصل من وراء إثارته إلى تحقيق مطامعها”.
وقد وضّح من خلالها تأثير مراكز القوى الصهيونية داخل أميركا، وكيف استطاع الصهاينة أن يستولوا على ماريا ويرسلوها إلى فلسطين لتصبح مجندة في جيش الهاجاناه إلى أن تلتقي مع عربي مصري على ظهر المركب، وانجذب كل منهما إلى الآخر، ولكن الحرب تَحول بين الحب، فهي تقرّر أن تعود إلى فلسطين لتحارب، وهو قرّر أن يعود إلى مصر ليحارب، وبعد انتهاء الحرب التقاه مرّة ثانية في نيويورك وعندما يسألها لماذا تركت إسرائيل تقول “لأنها لا تريد أن تقتلك” (ص، 16).
هكذا نسج إحسان عبدالقدوس عبر قصّة الحبّ بين اليهودية والمصري، نقطة التقاء لنبذ العنف، فهي هربت لأنّها لا تريد أن تقتله. في المقالة السيرية يحكي أنه بعد مرور الزّمن التقي جلاديس في إحدى إجازاته في جزيرة ماديرا، وكانت إجابة السؤال العكسي بمثابة اعتراف من قبل جلاديس بأنّ اليهود غير مقبولين، فسألها لماذا لا تعودين، فأجابت بسؤال “وهل يقبلونني في مصر؟!”. وعندما تمادى في سؤاله كان جوابها القاطع “لأنني يهوديّة” (ص، 8).
بطلة رواية “لا تتركوني وحيدة هنا” زينب يهودية مسلمة، ومع أن زينب كانت تبالغ في اتّباع تقاليد الإسلام إلا أن الشخصية اليهودية ظلت هي الطابع المسيطر عليها. في الأصل كان اسمها لوسيان هنيدي، وكانت متزوّجة من زكي راؤول، وأنجبت منه ابنها إيزاك وابنتها ياسمين، العائلة يهودية من سلالة يهودية ومن سلالة يهود منذ أيام سيدنا موسى.
منذ مدخل الرواية والرّاوي يحرص على أن يقدّم شخصية زينب، كنموذج للمرأة المثيرة، فهي “امرأة جميلة ومثيرة ولبقة وخفيفة الدم ولكنها صعبة،.. لا تعطي نفسها بسهولة”(ص، 17). ومع جمالها وطموحها كانت ذكية أيضًا، وإن كان ذكاؤها خاب باختيارها زكي زوجًا له، فلم ترَ فيه غير الوسامة والاستسلام. تأتي زينب على نقيض زوجها تمامًا، فإذا كان هو طموحه كيهودي توقف بالزواج منها، فإن طموحها يهودي أصيل “لا يمكن أن يكتفي بالحب، ولا يمكن أن يشبع بليال في أحضان حبيبها، الذي تزوجته إنها تريد أكثر … تريد الحياة بأوسع جنباتها” (ص 13). وهو ما يعكس جانبًا من صفات الشخصية اليهودية؛ يتمثل في الطمع وحب الحياة والمال.
كانت قبل إسلامها تعيش كما يعيش اليهود، كانت كل الحياة كما تحس بها هي حياة اليهود… وكل أمل يتحرك في خلجاتها هو أمل يهودي.. تعيش كما يعيش اليهود وتسعى كما يسعى اليهود، وتصل إلى ما يصل إليه اليهود… هي نقيض لأختها ليزا التي كانت متشددة في ديانتها وتصوم كل اثنين وخميس لأنهما “اليومان اللذان تتلّي فيهما التوراة داخل الكنيس”. وكانت لوسي تفعل أشياء مثيرة تؤكد تطرفها وكراهيتها للطقوس الدينية، فذات مرة سرقت شال الصلاة، الذي كان يعتز به الأب، كما كانت تكره يوم السبت “راحت تعمل في محلة ستافرو تقلم أظافر الرجال”.
في الحقيقة قدم عبدالقدوس معالم كاملة عن اليهود، عاداتهم وطقوسهم، وكذلك عن طرائق تفكيرهم، وهو ما جعلنا في مواضع ندين هذه الشخصيات خاصة صفات التسلّق والانتهازية. وعبر هذه الصفات راحت زينب تتملق المجتمع الإسلامي وفي الوقت ذاته تتنصل من يهوديتها، كي ترفل في النعيم، وفي ذات الوقت نتعاطف مع مأساتها بعد أن هجرها جميع أبنائها، وحالة الصراع بين الذهاب إلى إسرائيل والقتال ضدّ العرب.
اليهودي الطيّب

ثمّة تحولات كثيرة جرت على صورة اليهودي وفق التمثُّلات الشعبية المتوارثة، وما استجدّ على الواقع الحالي ومتغيراته الأيديولوجية، وضرورات السياسة المُلزمة. هذا التحوّل لم يقتصر على الرواية الفلسطينية التي كانت أبرز صورة لليهودي فيها، تتمثل في كونه الغاصب للأرض والمغتصب للوطن، أو حتى تلك الصورة التي رسمها محمود درويش في قصيدته “سيناريو جاهز”، بأنهما “عدوان سقطا من السماء في حفرة فماذا هما فاعلان”، كما تجلّت في قصص غسان كنفاني، وبخاصة رواية “ماذا تبقّى لكم” (1966) حيث يلتقي حامد بالجندي الإسرائيلي في الصحراء، وينتهي الأمر بقتل حامد للجندي. وهي صورة واضحة في رواية على المقري “اليهودي الحالي (دار الساقي 2009) حيث يكشف عن حالة العداء بين يهود اليمن مع المسلمين، التي وصلت بين الطرفين إلى المضايقة والإلحاح في السؤال “متى سترحلون من بلاد العرب؟” أو إعلان الكراهية “ارحلوا من بلادنا. وإلا سنرمي بكم في البحر” (الرواية، ص48).
هذه الصورة بما تجسّده من تمثّل حقيقي للصراع على الأرض، تتبدّل مع مرور الوقت؛ فالوقت كما يقول درويش “رَمْلٌ ورغوةُ صابونةٍ” إلى صورة مغايرة تمامًا، كانت نتيجة المتغيرات السياسية والثقافية التي لعبت الدور الأكبر في تدشين الصورة الحديثة للآخر.
فهذا العدوّ تتحوّل صداقته إلى أمنية، ويا حبذا لو كانت امرأة شابة، كما تمنّى وليد دهمان في رحلة عودته من لندن إلى غزة عن طريق مطار اللدّ (السيدة من تل أبيب، 2010). ثم تأخذ الصورة أشكالاً جديدة من المسميات من قبيل التعايش والتعاطف، والتغاضي عن إرث الصراع، واعتبار اليهودي صديقًا أو حبيبًا كما في “ربيع حار” لسحر خليفة. فهي لا تنظر له على أنه عدو. فالتعايش الذي تمّ بين الطفل أحمد وميرا يجعل نظرته تتجاوز العداء.
ورغم التفاؤل الذي سعت إليه الراوية إلا أن هذه النظرة في الأخير تستجيب للسياق التاريخي، والعدوان الصهيوني. فبات عنوان الرواية “ربيع حار” كما تقول الدكتورة ماجدة حمود “مُجسِّدًا لهذا الخلل، ليوحي بانقلاب الطبيعة، حين اشتعلت المواجهات بين العرب والصهاينة، فإذا كانت الكلمة الأولى تحمل وعدًا بالجمال والتجدّد في حياة العربي الفلسطيني، حين يتوهم إمكانية نشوء علاقة الحب بينه وبين الآخر الصهيوني، لكن الكلمة الثانية تحمل معنىً سلبيًّا، تصف الربيع بأنه ‘حارٌّ’ مما يبدّد الحلم الربيعي الجميل، ويوحي بتجاوزه إلى صيف حار، وبذلك يضيع الجمال؛ ليفسح الطريق أمام الكراهية والقهر” (الأنا والآخر، ص105)، ومن ثمّ هيّأت للطفل أحمد كل الظروف لينشأ بعيدًا عن سياسة الكراهية للآخر، يسعى للتقرب من الطفلة ميرا، بل يتدبر الحيل كي يجذبها، فيستخدم لغتها في العدّ: آحاد، اشنايم، شالوش.. إلخ.
وبمرور الوقت يتحوّل اليهودي إلى شخص أليف يُقابلك بالترحاب كشخصية رومة العرسي في رواية ربعي المدهون “كونشرتو الهولوكوست والنكبة”، فرومة وهي تستقبل وليد دهمان وزوجته جولي وقد “سبقتها إلينا ابتسامة تخلت عن تردد سابق ورحبت بنا، أهلا، اتفدلو.” (ص 58)، بل “حدث تآلف بين جولي ورومة سرًّا وعلانية منذ لحظة اتفدلوا حتى مأسلامة”. فتساوت تل أبيب مع غزة، فحسب تعبير الشيخ إبراهيم “ما هي كلها بلاد” (ص، 122).
ويحثّ “باقي هناك” حسنية على إقامة علاقات مع الجيران اليهود في الحي بقوله “قلوبنا بتساع كل البشر، لا تحبيهم ولا تناسبيهم، بس خلي علاقتك معهم عادية”. يواصل ربعي المدهون في تقديم صورة مختلفة لهذا التعايش والتآلف بين اليهود والعرب. فعندما عادت جولي ووليد الدهمان أقاما في بيت (جميل ولودا) في عكا، البيت عمارة من ثلاثة طوابق تضم ست شقق، يسكن خمسا منها يهود.
أوّل صور التآلف أن جولي لم تستيقظ فزعة كما يحدث له هو عندما يقلقه نومه ويعيد عليه مأساة عاشها في شكل كابوس. كما أنها بدت مرتاحة لأحاديث جميل عن العلاقات الودية بين الجيران ووصفهم بالعاديين. فمن وجهة نظر جميل أن لجنة سكان العمارة “ليست الحكومة، أو الكنيست الإسرائيلي المتخصص في سن قوانين تعذيب الفلسطينيين. بل إن جميلاً ما أن يغادر البناية، المحكومة بديمقراطية الجوار، وعادية الناس العاديين، حتى يفقد نصف حقوقه في المواطنة” (ص، 65).
وبالمثل أم وليد دهمان ترى أن البقاء في الأرض حتى لو صار هناك “في إسرائيل” أفضل من التغريب في المعسكرات، فتدافع أمام العمة على محمود أو “باقي هناك” كما صارو ا يصفونه “فش فلسطيني في الدنيا يصير إسرائيلي يا بنت العم، ون صار، ما بيكون بإيده ولا بكيفه ولا بخاطره، محمود صار إسرائيلي غصبن عنّه يا حاجة غصبن عنه صار، وابصراحة بقول لك إياها ع روس الأشهاد. منيح اللي محمود بقي هناك. منيح اللي ما هاجر زينا واتبهدل البهدلة في لبلاد يا حاجة ، حتى مع اليهود، أشرف وأرحم ميت مرّة من البهدلة والشرشحة في المخيمات” (ص، 117).
عندما فرَّ محمود دهمان إلى إسرائيل وصفته العائلة بالمجنون، لكن رويدًا رويدًا، بدأ أبوه الشيخ إبراهيم مسرورًا بأن “ابنه البكر تزوّج بامرأة أخرى رملاوية، وأسّس فرعًا إسرائيليا لعائلة دهمان، تاركًا الأب يتكفل بفرعه الغزاوي الصغير” (ص، 121)، لدرجة أنه قال أمام تجمع عائلي “مدينا رجلينا في لبلاد وصار إلنا فيها فرع مش بس محمود اللي بقي هناك كمان أولاد ابني وبناته اللي رح يخلفهم رح يبقوا هناك” فعلى حد قول الشيخ إبراهيم “ما هي كلها بلاد”.
حالة التعايش والتعاطف التي أبرزتها المرويات العربية على اختلاف بيئاتها، انتهت إلى اعتبار الشخصية اليهودية شخصية طيبة، وقد برزت بصورة لافتة عبر شخصية يعقوب شكر الله، بطل رواية “حمام اليهودي” (دار سطور، 2017) لعلاء مشذوب، فالرجل تعايش مع أهل كربلاء، المدينة ذات النسيج الاجتماعي والديني المختلف، وأخذ يُساهم معهم في الليلة الأربعينية، كما أن زوجته وجد فيها الجيران نموذجًا مختلفًا عن اليهود.
وبالمثل الطبيب ناجي في رواية عبدالجبّار ناصر”اليهودي الأخير” يُساعد الفقراء، وهو محبوب من الجميع، وهو ما يؤلِّب عليه الأطباء، فيوغرون صدر الضابط سداوي عليه. وما أن يحدث الانقلاب، حتى يظهر حب الناس له، فيخشى عليه الجميع من فرهود آخر، يتعرض فيه للتنكيل كما حدث لخطيبته تمّام من قبل، فيذهب إليه جميعة البصران، الذي أطلق الرصاص على منزله من قبل، ليكفّر عن غلطته، فيقول له “جئت للبقاء معك والدفاع عنك” (اليهودي الأخير ص، 127)
كما أن ريم زوجة يعقوب شكر الله، ترى أن “هذه المدينة التي منحتنا الأمان والحب، لا يمكن أن نخذلها أبدًا” (الحمام اليهودي، ص 226). بل حزنت عند رحيل أم أكبر صادقي ورجتها أن تبقى شهرا، والأخيرة وهي المسلمة الشيعيّة، مما وجدته من حُسن معاملة من قبل ريم وهي يهودية أثناء فترة الإقامة في شهر المحرم وصفر، تعترف لها بـ”أنها اكتشفت أن المسلمين يصنعون حواجز نفسية واجتماعية مع اليهود، ولكنها وجدت العكس ذلك، فهم على نفس المستوى من الاحترام مع الآخرين دون تمييز في عرق أو دين أو طائفة مما جعلها تحب كربلاء وتتمسك بها” (ص، 82)، وهو ما يكشف أن اليهود استطاعوا أن يحسنِّوا من صورهم عبر التودُّد والمعاملة الحسَنة للآخر المختلِف معهم.
ففي ذات الرواية نجد موقف ريم زوجة التاجر مع أم أموري، وهي المستخدمة التي جلبتها لها زوجة جودي لتساعدها في أعمال البيت، فتعاملها معاملة حسنة، لدرجة أنّ الرّاوي يتأثّر من هذه المُعاملة ويشيد بها قائلاً إنها “لم تعرف اللّحم إلّا في بيتهم، ولا الدفء أيضا”. لا يتوقف الأمر على الزوجة فالزوج نفسه (يعقوب شكر الله) عندما تطلب والدة أموري من ريم أن تتحدث مع زوجها كي يجد عملاً لابنها الذي صار شابًا ويرغب في الزواج. يقبل على الفور وعندما يرى منظره بملابسه المتهرئة وشعره الأشعث الطويل، يطلب من جودي أن يأخذه لدكان الأقمشة ليقص له قطعتي قماش، ويذهب به للخياط كي يُفصّلهما له ويشتري له نعالاً (كذا) جديدًا، ويهتم بأمره كما أنه لم ينس أن يضع في يد “أموري عانة كمصرف جيب” (ص، 117) وعندما يعود كان قد تغيّر شكله تمامًا.
لا تقدّم رواية خولة حمدي “في قلبي أنثى عبرية” (دار كيان، 2013) صورة من التعايش في جربة بتونس، الذي وصل إلى التسامح والتكيّف بين الفتاة ريما المُسلمة أسرة جاكوب اليهودية بعد وفاة عائلتها فحسب، وهو نفس ما فعله كمال رحيم في روايته “أيّام الشّتات”، فبطله جلال المسلم يتربى في كنف أسرة أمه اليهودية بعد وفاة أبيه. وعندما ينتقل إلى باريس أيضًا يعيش وسط مجتمع خليط من هويات مختلفة، عرب وأفارقة، إضافة إلى اليهود المصريين من أصدقاء جده ممّن رحلوا تباعًا من مصر متخذين من فرنسا موطنًا لهم.
كما تبرز رواية “في قلبي أنثى عبرية” صفاتٍ جديدةً للشخصية اليهودية. فجاكوب إضافة إلى حُسْن معاملته لريما التي تعلّق بها منذ أنْ قدمتْ إليه مع أمها التي عملت مديرة منزل بسبب حاجتها للمال، وهي في الخامسة من عمرها، صار مرتبطًا بها ويقضي معظم وقته معها، فهي وحدها “لا تزال تستحوذ على القسم الأكبر من اهتمامه، لأنها تبقى في نظره الشخص الأقرب إلى قلبه ومحرك مشاعره” (في قلبي أنثى عبرية: ص، 26).
فجاكوب أو يعقوب كما تناديه ريما يتّسم بصفة الأمانة، وهي الصفة التي كانت منتفية من قبل في معظم المرويات التي عكست صورة اليهودي الخائن، ومدبر المكائد، والكاذب أيضًا كما تصفهم فاطمة معارف، الدليل لوليد الدهمان وجولي في “كونشرتو الهولوكوست والنكبة”، بالكذب وتزوير التاريخ. فعلى حدّ قولها “بنعطي السّياح معلومات صحيحة ابّلاش… أحسن ما يشتروا كذب الإسرائيليين اليهود ابمصاري” (ص 51). وهو ما يتكرر في رواية مني الشيمي، فتربط بين اليهودي والكذب كما جاء في حوار أسحور ويوشع، فيقول أسحور ليوشع “قل الحقيقة ولا تكن يهوديًّا” (ص 115).
فجاكوب ما زال أمينًا على وصية الأم التي طلبت منه قبل وفاتها بـ”الحفاظ على دينها، وعدم محاولة التأثير عليها” (ص، 19)، وتصف الرواية جاكوب بأنه لم يدخّر وسعًا في احترام الوصيّة، بل كان يذهب معها إلى المسجد وينتظرها حتى تخرج. بل لم يفكّر في حرمانها مما كانت تفعله معها أمها.
في رواية “اليهودي الأخير” لعبدالجبّار ناصر، يصف حمود الخوذي، اليهود في أوّل لقاء بينه وبين الطبيب ناجي بعد وصوله قادمًا من بغداد متجهًا إلى البصرة، بأنهم “أفضل زبائنه في النهار” ويبرر رأيه “لأنهم لا يغضبون بسرعة، وإن عرفوا بجدالهم حول الأجرة، ولكن حيت يتكّرر ركوبهم معه ينتهي الجدال، وأن علاقاته بهم قوية” (اليهودي الأخير، ص 30).
وتظهر الطيبة في موقف ندى مع حسّان وأحمد في “قلبي أنثى عبرية” بعدما أُصيب أحمد أثناء تنفيذ عملية فدائية ردًّا على عملية عناقيد الغضب التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006، فقدّمتْ المساعدة لهما، وأحضرتْ أخاها الكاهن وقام بعلاجه. وهو الأمر الذي جعل حسان يندهش من هذا الفعل، بعدما عرف أنها يهودية، من نجمة داود التي طلت من سلسلتها الفضيّة. وإن كان الأمر كله تعتبره ندى واجبًا لا تحتاج إلي شكر من أجله (ص، 61). وما أن يدخل أحمد معها في حوار فلسفي عن سبب مساعدتهم، يأتي الجوّاب ليقدّم لنا صورة من الصور التي تتردد الآن في أجواء السياسية عن قبول الآخر والمعايشة، وحرية المعتقد، فتقول له ندى جواباً عن سبب مساعدتها:
“وما شأن ديانتي بالعمل الإنساني؟ ألا يحثّك دينك على الرأفة وتقديم يد المساعدة إلى من يحتاجها، مهما كان انتماؤه وعقيدته؟ أليست تلك رسالة جميع الأديان السماوية؟” (ص، 62).
يخفض أحمد رأسه خجلاً بعد أن انهزم في معركة النقاش، وهو ما يجعله يعتذر، وعندها يأخذ ردّ الفعل منحىً آخرَ، فيتشكك في المسلّمات الراسخة في ذهنه، وراح يعيد التفكير في أنه لم يعرف عن اليهود ولم يتقرب من اليهود العرب، في إشارة ضمنية إلى إدانة الصورة المتوارثة بأنهم يضمرون العداء للمسلمين (ص، 63)، بتلك الصورة التي كرّسها عنوان رواية ممدوح عدوان “أعدائي”. ربما المؤلفة استطاعت أن تُسلّحَ بطلتها بهذا المنطق من كونها نشأت في عائلة تختلط فيها كل الديانات: اليهودية والمسيحية والإسلام. فهي من أم يهودية وأب مسلم. وزوج أمّ مسيحي أرمني بعد طلاق الأم من أبيها.
التعاطف وصل إلى التنازل عن الحق، على نحو ما فعلت شخصية “باقي هناك” في رواية “كونشرتو الهولوكوست والنكبة” لربعي المدهون، فعندما أحرقت له جارته اليهودية أفيفا منزله، تنازل عن الشكوى وقال “نحلها حلّ عرب”، في حين الطرف الثاني لم يكن عربًا، بل قال في أسى “غفيرت أفيفا وحيدة وغلبانة وما حدّش بيعتب عليها، اللي شافته في حياتها ما شافه بشر، اللي شافته جننها وأفقدها أعصابها شئلوهيم يعمود لتسيداه ؟ (ص، 142).
في رواية فيصل خرتش “حمام النسوان” (1999) يقدّم صورة من التآلف والتعايش بين الآخر (اليهودي) والأنا (الذات العربية) التي وصلت إلى حماية اليهود بعد أن تصدعت اللحمة السورية من جرّاء قيام دولة إسرائيل، فراح الشباب في حي “القلّة” يظهر غضبته على العائلات اليهودية، لكن تبرز بعض العائلات وتقف في وجه هذه الغضبة كعائلات الطحان وآل القناع والقصاص، وأخذوا يصرخون في وجه الشباب “يهودنا غير اليهود الذين هجموا على فلسطين (…) إنهم مثلنا ونحن وهم أهل”. وبالفعل تم تهريب زلفي شقيق المغنية سلافة. وفي رواية “قصر شمعايا” (2010) لعلي الكردي، يُنْكر الأب الطبيب اليهودي الذي رفض أن يهاجر إلى إسرائيل، ابنه الذي هاجر إلى إسرائيل وصار طيارًا، وعندما تسقط طائرته، ويؤسر يتنكر له الأب، ولا يعترف به.
كل هذه التحولات على صعيد المشهد السياسي تقود وليد إلى تمني المستحيلات أن “يخرج الفلسطينيون والإسرائيليون من ساحة الحرب إلى العيش المشترك، ونتمشى في أوتستراد طويل لا عداء فيه ولا معابر، لا اغتيالات ولا انتحاريين، لا مجندين ولا مقاومين. لا صهيونية ولا حركة تحرر وطني فلسطينية، لا انتفاضة ولا مستوطنات. لا شارون ولا عرفات، لا أبومازن ولا شاؤول موفاز، لا شيوخ ولا مستوطنين. لا أباتشي ولا إف -16، ولا انتحاريين. بل مسافران عاديان (عابران في فضاء عابر)” (السيدة من تل أبيب: ربعي المدهون، ص 96).
قابلت التحولات السياسية والمتغيرات الإقليمية تنازلات أكبر، فصارت الجنسيّة الإسرائيلية “مواطنة وحقوق” كما ادّعت جنين لخطيبها الثالث الأميركي من أصل سوري عندما طالبها بالتنازل عن الجنسيّة، بل وصلت إلى أبشع صورها من تذلّل وتقديم نفسها كأجير بثمن في مرحلة سابقة كما في “السيدة من تل أبيب”، فنصرالدين دهمان، هو واحد ممّن اشترت إسرائيل سنوات أعمارهم وسواعدهم التي لوحتها شمس الظهيرة، إلى أن ارتفعت على كتفيه حيطان شقق في مستوطنات يهودية، ونبتت على كفيّه أشجار التفاح وكروم العنب عمل في المستوطنات اليهودية، إلى التنازل عن الأجر تمامًا كما فعل كيهات في رواية سليم بركات “ماذا عن السيدة راحيل؟!” فقد تبرّع بالعمل مجانًا لدى السيدة راحيل، يوم السبت، كنوع من المساعدة، بعدما اكتشف من صديقيه العربييْن أن اليهود لا يعملون في يوم السبت.
ومع هذه الصفات التي خالفت التمثّلات الأولى لصورة اليهودي في مرويات البواكير، أو تلك التي صدرت إبّان شدّة تأجّج الصّراع العربي-الإسرائيلي، إلا أن ثمّة تمريرات تشير إلى بعض الصفات القديمة، كالغدر واللؤم، والديوثة. في رواية “مصائر كونشرتو الهولوكوست والنكبة” نجد أن جنين الدهمان أثناء قراءتها للملف الذي يعدُّه زوجها باسم عن الأوضاع في عكا، تطّلع على حادثة قصة آلاء الحيفاوية. وهذه القصة تكشف عن صفة الغدر التي يتسمُّ بها اليهودي فآلاء صدّقتْ أنّها مواطنة من الدرجة الأولى في إسرائيل، اقتنعت بأن الشرطة ستؤمّن حمايتها من تهديدات والديها وأبناء عمومتها، وكل من أوكل من أقاربها، صيانة شرفها، فتقدمت آلاء بشكوى رسمية للضابط أفيغدور السمين، كما ينادونه في مركز شرطة حيفا، ونامت على عماها . لكن “أفيغدور السمين ترك آلاء لغسالة شرب العائلة” (ص، 84).
قاد هذا الواقع بما فيه من تعايش وإعجاب، إلى علاقات جنسيّة كاملة برضى الطرفين، دون أن يكون الابتزاز (كما كان سابقًا) واردًا، على نحو ما شاهدنا ناجي عبدالصمد في رواية “شيكاجو” لعلاء الأسواني مع ويندي موظفة البورصة، التي التقاها مصادفة في بار، وتطورت العلاقة بينهما إلى حبّ وفراش، ونفس الشيء نراه في “السيدة من تل أبيب” لربعي المدهون حيث علاقة العربي نورالدين، وهو ابن زعيم عربي كبير، مع دانا أهوفا الممثلة اليهودية، التي كان يرى مجرد تسريب خبر للصحافة عن علاقتهما، من شأنه أن يشعل حربًا سادسة. فتنهار من فرط كلام الحب الذي يبثّه نورالدين “مستسلمة بين ذراعي نورالدين، وغاب جسدينا في بحر من لذة سبحنا فيه ما تبقى من الليل، ولم نخرج إلى شواطئه إلا قرابة الفجر” (ص 63) وبعد اختفاء نورالدين بعد رسالته الغامضة تقرّر العود إلى إسرائيل.
الانتهازية
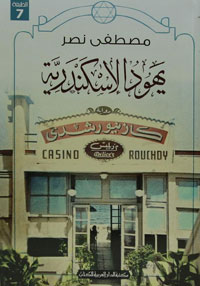
عرفت الشخصية اليهودية وفقًا للأدبيات العربيّة وأيضًا الغربيّة، بأنها شخصية انتهازية، صيّادة للفرص، لا تتورّع في أن تنتهز الفرصة لصالحها، خاصّة إذا كان الأمر متعلِّقًا بمال أو منفعة خاصّة. في رواية “يهود الإسكندرية” (2017) لمصطفى نصر، يقدّم لنا صورة عن هذه الانتهازية تتمثّل في شخصية عامير بيك، فما أن يعلم عامير بيك باشتداد المرض على الوالي سعيد، حتى يهرع إلى استدعاء دوف؛ وهو شيخ صرافي مصر، والمسؤول المالي عن أملاك سعيد، كما أنه الرئيس الفعلي ليهود مصر، لا أحد يستطيع أن يتصرف في أمور تخص سائر اليهود دون الرجوع إليه، فكان الاستدعاء “خشية أن يموت الوالي فجأة دون أن ينالوا منه امتيازات” (ص، 10). فدوف يرى أن الوالي سعيد “هو المناسب لليهود”. ومن ثمّ ينتهز هؤلاء فرصة مرض الوالي الذي فشل الأطباء في علاجه، باقتراح “أن هناك ممرضًا عنده الحل” وما أن سمع الطبيب بأن ثمة حلاً في الأفق، صاح “أين هو؟ آتني به” (ص، 13).
المثير حقًّا، أنَّه عندما صاح عامير بيك بأنه “يعرف ممرضًا يحلّ المشكلة” لم يكن في ذهنه أحد، وإنما كان قوله بمثابة حيلة يستطيع من خلالها الدخول إلى الوالي بعد تعنت الكتخدا الذي رفض وأصرّ على عدم دخول الثلاثة (دوف، عامير بيك، زاكن) إلى الوالي المريض. وبالفعل بعد خروجه من قصر القبّاري، كانت قد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة. وبينما ثلاثتهم غارقون في صمتهم صاح عامير بيك “حتمًا سأجد ممرضًا يهوديًّا يؤدّي الغرض” (ص، 17). كان في تقديرهم أن من يجدونه سيكون فدائيًّا من أجل اليهود. ويلجأون لفرج حلّاق الصحة، الذي تأتي المعجزة علي يديه، وتكون مكافأته أبعدية في منطقة الطابية، التي تصبح بداية لتكوين مجتمع يهودي في هذه المنطقة (جيتو).
ومن الصور التي تعكس الطبيعية الانتهازية، ما نراه من تحريض الحاخام الأكبر موشي لمظلوم في ذات الرواية “يهود الإسكندرية” على استغلال علاقة حسن بدوي باشا صاحب مصنع الورق في الطابية بضرورة الاستفادة من علاقته بالملك فؤاد لصالح اليهود بحكم علاقة الصداقة التي تجمع بين الباشا والملك. كما أن مظلومًا نفسه اليهودي الذي لا يهتم بالدين، عندما يُقْصى حسن بدوي باشا من كل مناصبه السياسية والحكومية بعد غضبة الإنكليز عليه، وبينما الاثنان في أحقر بار، يقترح عليه مظلوم الحل في “أن تحصل على مكافأة من الملك نظير ما قدمت له” ويبرّر له مظلوم هذا الحل، قائلاً إن “الشعور لن يدوم، فسوف يَنساك ويبحث عن خليل جديد”، ثم يفسر له قصده صراحة “استغل الموقف الآن، اضرب على الحديد وهو ساخن، اطلب منه أرضًا كبيرة جدًّا لتقيم عليها مشاريعك التجارية”. يعجب حسن بدوي باشا من تفكيره ويضحك “حقيقة أنت يهودي، كل تفكيركم في المشاريع التجارية” (ص، 271).
المرأة اللعوب
قدمت الرواية العربيّة صورة تكاد تكون موحّدة عن المرأة اليهودية، فحصرتها في المرأة اللعوب، التي لا همَّ لها إلا تحقيق مصالحها حتى ولو اضّطرت لبيع جسدها. وهذه الصُّورة النمطيّة مع الأسف لم تتردد فقط في المرويات التي غلب الخيال عليها، وإنما وردتْ أيضًا في كتابات الذات، فيصف عبد الحميد جودة السحّار في سيرته “هذه حياتي” (مكتبة مصر، د. ت) المرأة اليهودية “باللعوب” فهي عنده مهووسة بالجنس وأبوها رجل قوّاد. لا أعرف مصدر هذه النظرة المتدنية التي قدمها السحار لليهود، خاصة أنه نشأ في حارة صلاح بالحسينية وهي قريبة من حي الظاهر الذي عاش فيه اليهود في هذه الفترة.
لكن مصدر هذه الصورة في الرواية العربية، ربما جاء من تأثير الرواية الفلسطينية. ففي رواية “الوارث” لخليل بيدس (1920) هناك شخصية أستير فهي تقيم أكثر من علاقة في الوقت نفسه، وفي رواية “لا تتركوني هنا وحدي” توجد شخصية لوسي التي أخذت من يهوديتها الوصولية وتضطر للدخول إلى الإسلام كي تقترن بشوكت بيك؛ لترفل في نعيمه وطبقته الثرية التي تريد أن تدخلها فكان هو السلّم لها لهذه الطبقة.
وبالمثل علاقة ياسيمن بخديجة صديقتها ثم علاقتهما بنساء البترول وتجارة العشق، التي حولتها إلى باريس فكما يقول الراوي “وفي المساء كانتا تلتقيان بالعشيقات من نساء البترول . إن عددهن في باريس أكثر من عددهن في مصر، وهن هنا أكثر انطلاقا.. إنهن في باريس يعشن كالمجنونات مبهورات بمجرد الكلمة الفرنسية وهن هنا يرين أكثر.. ويتعبن ياسمين وخديجة أكثر… ولكنهن يدفعن أكثر… (ص، 191). تعود ياسمين في باريس يهودية. ويتكرّر هذا النموذج في صورة نائلة زوجة مرجان في رواية “يهود الإسكندرية” فنائلة تضطر لمعاشرة الرجال من أجل المال وعجز زوجها، فقد أصيب بالبخل من ناحية المال وأيضًا من ناحية الجنس.
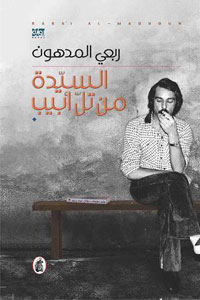
في رواية “السيدة من تل أبيب” تبدو دانا أهوفا الممثلة اليهودية، عاشقة لكن تكشف في حواراتها مع وليد الدهمان الفلسطيني العائد إلى غزة بعد 38 عامًا من الغياب، عن امرأة لعوب، متعددة العلاقات، فتارة مع الأوكراني اليهودي بوريس، الذي تعرفتْ عليه في منزل صديقتها سارة في لندن، كانت لحظة التعارف لحظة الاشتباك فمنذ هذه اللحظة، لم يترك أحدهما الآخر، كما تقول دانا “نتحرك معًا، ونأكل معًا، ونجلس معًا، ونبتسم معًا، كأننا فالس لا يؤدّيه أحد بمفرده” (ص، 84)، حتى أنّها بعد انتهاء علاقتها معه تقول “عشقته منذ تلك الليلة التي تذوقت فيها طعمًا للحب، تذهب معه الروح إلى نهايات لا ترغب في العودة منها، بينما الجسد يرتعش في انتظار عودتها كي يتعرف على نفسه من جديد” (ص، 85). لكنه لا يتكيّف مع الوضع في تل أبيب ويعود إلى أوكرانيا من جديد.
وهناك علاقتها مع لاعب كرة السلة إيهود الذي تعتبره مجرد “لحاف آخر أتباهى به، وأغطي به علاقتي المحرَّمة بنورالدين” (ص، 185). ثم في تطور لاحق تقيم علاقة مع وليد الدهمان لكن القدر لا يكتب لهما اللقاء، فبعد الاتفاق وتحديد الموعد، يقرأ عن سقوطها من شرفة نافذة إحدى الشقق، في إشارة إلى انتقام نورالدين، أو تصفية من الأجهزة الأمنية التي كانت تتعقبها وتترصد مكالماتها كما قالت لها صديقتها وحذرتها.
صورة الرّجل القوّاد لا تختلف عن صورة المرأة اللعوب، فالصورتان حاضرتان وإن كانتا بنسب متفاوتة في الروايات المتأخّرة، ففي رواية “يهود الإسكندرية” لمصطفى نصر، يقدّم لنا المؤلف زكوان،على أنه من أغنياء اليهود، إلا أنه لا ينال الاحترام الذي يبديه اليهود لعامير بيك ودوف، ويبرّر هذا لتاريخ زاكون المشين، الذي ارتبط بالقوادة “فقد بدأ حياته قوّادًا، جمع العديد من النساء.. يهوديات ومسيحيات ومسلمات، وقدمهن إلى الأجانب الذين يعيشون في الإسكندرية دون زوجاتهم” (ص، 121). كما أن تأسيسه لفرقة مسرحيّة في اللبان كان ستارًا لإدارة شبكة دعارة وقد “اتضح أنه حوّل المومسات اللاتي كن يعملن معه في شبكة الدعارة إلى ممثلات” (ص، 121).
اليهودي معشوقًا
تبدّلت صورة المرأة اليهودية الغانية في المرويات الحديثة، بصورة المرأة اليهودية الحبيبة أو المعشوقة، والتي يسعى المحبّ للتقرّب إليها، حتى تلك الصُّورة التي كانت تجسّد النفور من اليهودي إذا طلب علاقة أو صداقة غابت تمامًا؛ فالمرأة البدينة (في رواية يهود الإسكندرية) التي كانت في البار مع حسن بدوي باشا بعد إقصائه من مناصبه مع مساعده مظلوم اليهودي، فما أن تسمع المرأة كلمة يهودي، حتى تسأله بغضب: أنت يهودي؟ (ص 271) ودون انتظار للإجابة تفرُّ هاربة، وكأنها تفرّ من عدوى. كل هذا اختفى وصارت العلاقات مفتوحة، بل لا غضاضة فيها، وقد تصل إلى حبّ وهيام.
في رواية “شيكاجو” لعلاء الأسواني، هناك ويندي وحب ناجي عبدالصمد لها. وأحمد وندى في رواية “في قلبي أنثى عبرية” و”فاطمة وسالم” في “اليهودي الحالي” وإن كانت في رواية اليهودي الحالي الفتاة العاشقة مسلمة والمعشوق هو اليهودي، على عكس الصورة السائدة بأن المعشوقة هي الفتاة اليهودية، وهو تطور لافت، وهو ما يتكرر أيضًا في رواية “آخر يهود الإسكندرية” لمعتز فتيحة، حيث ترتبط سارة المسلمة ذات الأصول الأرستقراطية بيوسف الذي ينتمي لأسرة يهودية في مدينة الإسكندرية. وثمة تطور آخر ماثل في تحوُّل ندى إلى الإسلام بسبب إعجابها بأحمد، كما رأينا في رواية “في قلبي أنثى عبرية” وهو ما حدث من قبل مع لوسي في رواية إحسان عبدالقدوس “لا تتركوني وحيدة هنا” بعدما أحبت شوكت بيك.
ففي “اليهودي الحالي” علاقة حبّ طرفها مسلمة (فاطمة) ويهودي (سالم)، بدأت العلاقة بتعليم فاطمة لسالم العربية ثم نمت هذه العلاقة عبر الرسائل المتبادلة بين الطرفين (ص، 54) وقد وصل مداها إلى الرسالة الصدمة التي أعلنت فيها فاطمة رغبتها في الزواج من سالم اليهودي، مع أن الذاكرة تختزن حادثتيْن مفجعتيْن، إلا أنها استمرت وأرسلت رسالتها “اعلم عفاك الله أنني وهبتُ لك نفسي، حرّة عاقلة، لتصبح زوجي إذا تجاوبت معي وأبلغتني بقولك… أهب نفسي التي خلقها الله إلى أحد خلق الله، إليك أيّها اليهودي الحالي. أهبك متعتي وبدني وأخطب قُربك، متعتك وبدنك. فإذا قبلت قربي وراقك بدني، فلا تتأخّر عن نداء رغبتي، وتدبر أمر سفرنا من بلدة يضيق أهلها بلقائنا، ويحرِّمون زواجنا. وليكن مسيرنا إلى أبعد مكان يحط فيه الرحال. أنتظر منك الجواب خلال أيام عبر ما شئت من وصل أو اتصال. وفي الختام دمت في محبة وسلام» (الرواية ص ص75، 76).
تنتهي القصة بإقصاء للطرفين، وهو ما آل بهما إلى الشتات، خاصة بعد موت فاطمة من الحقد والكراهية، وضياع الابن بعد رَفْضِ الكثيرين الاعتناء به خوفًا؛ فاليهود رفضوا مساعدته لأنه تمرد على مواضعاتهم وتزوّج مسلمة، والمسلمون نأووا عن إلقاء “نظرة رحمة واحدة عليّ”؛ بعدما رأوا زنارايه المتدليين.
وفي رواية “ماذا عن السيدة راحيل؟” لسليم بركات، نرى كِيهات الفتى الكردي يسعى للتقرب من راحيل من أجل أختها لينا. وفي رواية ربعي المدهون “السيدة من تل أبيب”، يقدّم صورة من صور العشق بين الممثلة الشابة دانا أهوفا وابن زعيم عربي انتهت بطفل رغم الحذر، واختفاء الأب. يدفع هذا العشق المحرم إلى إلقاء دانا من نافذة غرفتها، دون أن نعرف من القاتل؟ هل العاشق الولهان؟ أم أجهزة الاستخبارات التي كانت تتعقبها كما أخبرتها صديقتها.
يقدّم لنا علاء الأسواني في روايته “شيكاجو” (دار الشروق، 2007) نموذجًا لحالة التماهي مع الكيان الصهيوني تحت مسمى الحبّ، كما في علاقة ناجي عبدالصمد الذي أُرسل إلى بعثة إلى جامعة شيكاجو، بعد رفض الأمن تعيينه في الجامعة بسبب التقارير الأمنية. يتهمه رئيس البعثة المصرية وعين الأمن على الطلاب أحمد عبدالحفيظ دنّانة بأنه شيوعي، ويرى عبدالصمد أنها ليست تهمة. ومع هذا التاريخ النضالي، نراه لا يُمانع في استمرار علاقته بويندي شور، موظفة البورصة في شيكاجو “فتاة في العشرينات، شقراء وممتلئة” التقي بها مصادفة أثناء لقائه بالدكتور كرم دوس في البار، جاءت وقد اقتحمت مائدتهما كي تسأل: هل أنتما عربيان؟ وما أن انسحب الدكتور كرم حتى أخذتْ تشعر بالراحة وقالت “هيّا حدثني عن مصر” (ص، 216) وبعدها يتحوّل إلى مائدتها وطلب منها أن تقبل كأس جين تونيك، لكن تشترط للقبول أن يحكي لها عن مصر. وبعد هذا اللقاء الذي حكت له عن شعورها بالوحدة، وقصة حب واحدة حقيقية، طلبت منه أن تحدثه في الهاتف. ومن هذا اللقاء الأول بدأت لقاءاتهما التي أخذت منحىً سريعًا وصل بها إلى أن تذهب إلى بيته وهناك بدأ التعرف على جسدها، وبعدها تعرف على عادات الطعام اليهودية، فأعدت له حساء الدجاج على الطريقة اليهودية” (ص، 278).
اعترفتْ له بعد أول لقاء جنسي جمع بينهما في شقته في سكن الجامعة بأنها يهودية. وبينما هي تهمُّ بالخروج من باب الشَّقة سألها متى أراك مرة أخرى. هنا توقفت لحظات وقالت له: الأمر يتوقف عليك. وعندما طالبها بالتفسير: لا أفهم” قالت ببساطة: أنا يهودية! وعندما كرّر الكلمة مرّة أخرى، ظنت أنه أصابه الذهول، فقالت له: هل أصابك الخبر بالذهول؟ فأجاب بيقين: لا أبدًا. (شيكاجو: ص 238).
التوتر في هذه العلاقة لا يأتي من جانب عبدالصمد وفق ميراث يضع الآخر في موضع الريبة، وإنما التوتر والحذر من جانب ويندي، فهي ترى في عجب “أنه العربي الوحيد الذي لا يحلم بإبادة اليهود!”، كما أن الغضب من هذه العلاقة يتأتي من المجتمع اليهودي، ولا يقتصر الأمر على هنري الحبيب السابق لويندي، وإنما تجاوز الأمر هذا إلى مجتمع اليهود في الجامعة، بالضحك عليه أثناء مروره، وكذلك بدأ طلاب الصف الثاني يتحرشون به، حتى وصلت إلى عنصرية بغيضة بالسخرية منه ومن بلده “بأن الهيستولوجي غير مفيدة في تربية الجِمال” (ص، 284).
اليهودي البخيل
صورة اليهودي البخيل صارت نادرة في الرواية العربية، على عكس ما قدمت السينما المصرية (في فيلم “آخر شقاوة” جسَّد الفنان استيفان روستي شخصية الجار اليهودي البخيل كوهين) وكذلك في الدراما (رأفت الهجان “شخصية سوسو ليفي” قام بأداء الدور نبيل بدر) من الاستثناءات تأتي رواية مني الشيمي “وطن الجيب الخلفي” حيث تقدم، إلى جانب الممارسات والإكراهات التي أدّت إلى تشتت الجالية اليهودية، عبر شخصية مشولام المتزوج من العبدة المصرية تاموت، نموذجًا للشخصية اليهودية بكل صفاتها السيئة، التي غابت عن المرويات العربية في الفترة الأخيرة، فهو بخيل، فرّت منه زوجته بيلا وبالمثل دفع بخله ابنه “زكوة” للهجرة إلى تحفنحيس (تل دفنة بالإسماعيلية) وفضَّلَ العمل في إيقاد النار لطرق نحاس الأسلحة على البقاء في الجزيرة، لم يُعد يمنِّي نفسه بالتمتع بثروة أبيه ما دام بقي حيًا، وأرجَأ أحلامَه حتى يموت! ويعتبر ابنيه””بلطاي” و”يهويشما” عبدين.
وعندما تساومه بأن “عنانيا” سيدفع له صكّ عبوديتها، يرفض تصرخ في وجهه قائلة “سآخذ “بلطاي” و”يهويشما” معي، البقاء معك فَجّر قسوتي، المعذَّب لا يقدر على إسعاد مَن حوله، لكنك لا تهتمّ سوى بالمال، سنتركك وحيدًا، مُت الآن، لقد أوشكتَ على بلوغ الستين”، لكن لا يعبأ بقولها بل يقول “إنه سيعيش أربعين عامًا أخرى، فهو يرى أن المال يطيل العمر”، كما يكشف عن سياسته، بأنه يسلّف “نصفَ سكان الجزيرة، لن ينتهي دَيْنهم، الفائدة المركّبة سِحر المرابين! لا أحد يُقبِل على دفع دَينِه، يتخاذل فيتراكم القسط فوق القسط، وتعلو الفائدة، لا يهم، سأظل حيًّا حتى أُحصّل أموالي غيرَ منقوصة، وستظلين عبدة تحت رِجلي” (ص، 93).
وهناك شخصية المرابي مناحم الذي اقترض منه أسحور مبلغًا لكي يقدّمه مهرًا لمفطحية؛ فقد كتب “عقد الربا كما طلب بالضبط، الأرباح خمسة في المئة عن المبلغ سنويًا، إذا تأخّر القسط يضاف إلى أصل الديْن، ويعاد جدولة المبلغ وأرباحه من جديد!” بل يظهر أسحور بالغدر بعدما يقرر بأنه سيربح فهو عدل عن الزواج الذي يعني كما قال إنك صرت وتدا مدقوقًا في الأرض، وهو يرفض أن يكون وتدا في أرض ليست أرضي، وعندما يهرب لن يجد مناحم اللئيم من يطالبه بسداد الدين” (ص، 115)،
على نفس المنوال يرسم مصطفى نصر في رواية “يهود الإسكندرية” شخصية زاكن كنموذج لليهودي البخيل فهو يجمع المال بل هو متحلّل أخلاقيًّا. وبالمثل مرجان حارس قبر جون فهو نموذج صارخ للبخل، فهو “لا تميته إلا قيامة وفعل رباني كبير، .. متمسك بالدنيا، يستمد قوته من ارتباطه بالدين اليهودي وبضريح جون” (ص 385)، كان شحيحًا في كل شيء، حتى مع زوجته فمع قدرته إلا أنه كان يبخل على نفسه ويتعامل معها بحذر، فيستعين بالكتب الصفراء لكي يحمي جسده من مقاربة النساء، ويعوِّض ما فقد منه. وعندما تسأله زوجته عمّا يفعل يقول “لو تعلمين أكثر ما يضرُّ الرجل؛ كثرة معاشرة النساء”.
من جرّاء بخله المادي والجنسي اضطرت زوجته نائلة إلى مُعاشرة الآخرين طلبًا للمال والجنس. فالراوي يصف معاناة نائلة، وكيف حلتها هكذا “احتملته نائلة، ووجدت أن الحل هو التصرف في المشكلتين بطريقتها. هي في حاجة إلى المال الذي يخفيه عنها، والرِّجال لن يعطوها المال إلا إذا أخذوا منها ما يريدون، وهى في حاجة إلى هذا أيضا؛ بعد أن حرمها مورجان منه. فسعت لنيل الاثنين معا: المال والجنس” ( ص، 387). الغريب أن تصرّفها لم يزعجه، حيث سرعان ما انشغل بالبحث في ملابسها ليعرف ماذا أخذت، وماذا أخفت عنه. وهي صورة أخرى تقرنه بالرجل الديوث الذي يبيع الزوجة مقابل المال. كما رأينا في زكي في رواية “لا تتركوني هنا وحيدة” فقد قبل المال الذي قدمه له شوكت بيك مقابل التنازل له عن لوسي. ونفس الشيء حدث مع شولام في “وطن الجيب الخلفي” وهو يقبل بالتنازل عن تاموت مقابل العقد السري.
اليهودي المقهور
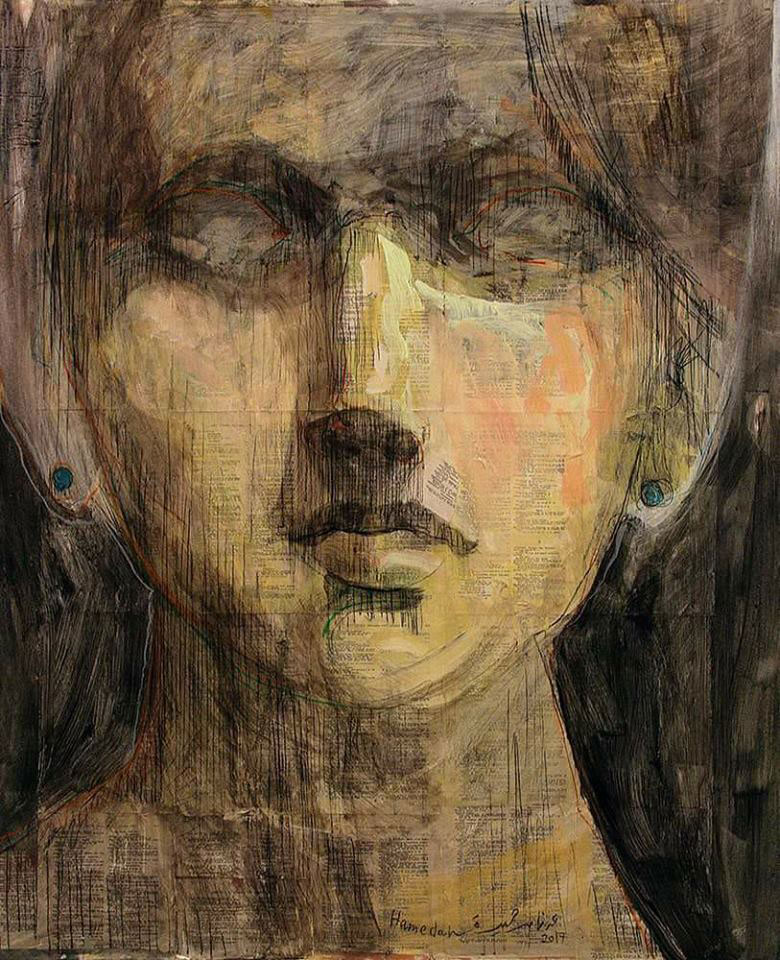
لعبت المرويات العربية على إظهار صورة جديدة تمثّلت في إظهار اليهودي بوصفه مقهورًا وليس قاهرًا، وهذا نتيجة للتحولات السياسية التي كان لها أكبر الأثر، في قبول الآخر أولاً على طاولة المفاوضات، وهو كان مقدمة لسلسلة من التنازلات لم تبدأ بالتفاوض، ولا تنتهي بالتنازل. فعلي المقري يظهر لنا في “اليهودي الحالي” الكثير من الإكراهات والممارسات ضد اليهودي، باعتبار المسلم هو الأقوى؛ فاليهودي -وفقًا للقوانين التي فرضها الطرف الأقوى- لا يستطيع أن يبني أكثر من طابق، فأسعد يقول لابنته عندما هدَّ السَّيْل منزلهم ولجوئهم إلى منزل النَّقَاش اليهودي “نحن لا نستطيع بناء بيوت على أساس متين، لأنهم لا يسمحون لنا بأن نبني أكثر من طابقٍ، أو طابقين، على الأكثر، وعلى شرط ألا تنافس بيوتهم أو تفوقها. فماذا نفعل؟” (ص، 58). كما أن اليهودي لا يركب الخيل، أما الحمير “فركوبها مشروط بألا يمرَّ أمام مُسلمٍ راكبًا فعليه أن ينزلَ حتى يتخطاه”.
كما ثمة إكراه يُحرِّم على اليهود بيع الخمور لغير أتباع ملّتهم. وعندما تجاوز اليهود هذه المواضعات انقضّ عدد من المسلمين على الحيّ اليهودي “وقاموا بكسر كلِّ جرار الأنبذة والخمور في البيوت” وكانت الحجة “بأن اليهود أفسدوا المسلمين ببيعهم الخمور والأنبذة، بخاصة الشباب منهم” (ص، 70).
وفي رواية “وطن الجيب الخلفي” تقدّم مني الشيمي مجتمعًا من اليهود يعيش في هذه البقعة النائية، بعاداته وطقوسه وأفراحه وأتراحه، لكن الشيء الذي تسعى لإبرازه هو ما تعرّض له اليهود من قهر وتنكيل بسبب مواقفهم، وتبدل السياسات التي كانت وبالاً عليهم. كما تجترّ عبر الشخصيات المآسي التي تعرّض لها اليهود، وشتاتهم في الأرض. لكنها وهي ترسم وقائع الحياة اليومية لليهود على الجزيرة لا تتورّع في أن تكشف عن الكثير من صفاتهم، وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما جاء عبر حكايات أم يوشع عن المآسي التي عايشها اليهود، والتي لا تقف عند استعداد كهنة خنوم للانقضاض على اليهود في الجزيرة، بل تستعرض للتفاوت الطبقي؛ فهبات “يهوه قاصرة على الكهنة، والتجار الذين يولّدون أموالهم عبر التسليف وأرباحه” (ص، 30) أما الخدم فلا يطولون شيئا سوى شراء مستلزمات المعبد من السوق.
فاليهود في مصر كما ذكر توم الذي يعمل فيلما عن الآراميين مع صديقه ناصر ” كانوا مجرد جاليات عسكرية، ولاؤهم لمن يدفع، هل خانوا بسماتيك عندما حاربوا معه؟ ظلوا على إخلاصهم، لكن الوضع زمن الاحتلال الفارسي اختلف كُليةً، الفُرس أصبحوا أصحاب البلاد الفعليين”. وهذا لا يمنع من تسرب الخوف لهم بعد طرد المصريين للفرس، فكما يتوقعون “سيبيد المصريون اليهود”.
ومن الإكراهات ما حدث لمفطحية بعد أن عبرت قلعة الحصن، مارّة بدرب المصريين انهالت عليها شقفة من إحدى الطاقات وهي تحاول أن تمشي بالخيلاء نفسها التي يعرفونها. كانت الشقفة قد أخطأتها ودقت الجدار، وبينما هي تعبّر عن غضبها عن الفعل بقولها: من اللبوة التي ألقت هذه الشقفة؟!. وما أن ألقت سبابها حتى انهالت الشقفات من باقي الطاقات، ثم انهمرت عليها الشتائم:
- “لا تعبري مِن هنا يا نجسة، لا نريد أيًا منكن بيننا”
- وقالت أخرى:
- "كم مرةً نمتِ مع “أسحورك” يا فاجرة؟" (ص 136)

عادات وطقوس المجتمع اليهودي
بل تأتي صورة اليهود على أنهم سلبيون، فعندما هجم الفرس على المصريين، وقد طفت الجثث على سطح المياه، وهو ما أثار غضب شباب المصريين الذين اجتمعوا، أما اليهود فظلوا قابعين في بيوتهم لأن أيًا منهم لم يُبدِ تعاطفًا يُذكَر، بل خرج مَن يعمل منهم في الحصن كأن شيئًا لم يكن متوجهًا إلى نوبة حراستِه المعتادة، وخرجَ عمّال المحاجر إلى الوديان والجبال، وظلت نساؤهم يتمتعن بالنسيم الآتي من الناحية الشمالية، وهُنّ جالسات يفلِّينَ شَعرَ الصبية من القمل!
وسليم بركات يفعل نفس الشيء في “ماذا عن السيدة راحيل؟” قدّم لنا الروائي صورة من الإكراهات التي مورست على اليهود القاطنين في الحي، بعد هزيمة 1967، وهو الأمر الذي دفع بالكثيرين من اليهود إلى الهجرة من سوريا إلى بلدان أخرى كتركيا ولبنان ومنها إلى الولايات المتحدة. وفي “حمام اليهودي” لعلاء مشذوب، صورة أخرى من الإكراهات مورست على التاجر يعقوب شكر الله، فالرجل الذي رفض أن يهرب من بغداد إلى إسرائيل أو أميركا، كما فعل الكثيرون بعد تأجّج الصّراع في فلسطين، يذهب إلى كربلاء، بما تحمله المدينة من طابع إسلامي مميز، ويهيئ له المكان رغم خصوصيته الدينيّة التعايش وسط المسلمين على اختلاف طوائفهم، ويعمل بينهم في تجارة القماش، لكن ما أن فكر في عمل حمام كمشروع تجاري بعد أن راقته الفكرة، ظهر التعصُّب، ورُفِض المشروع بحجة أنه يهودي نجس، هم يقبلون أن يشتروا القماش منه، “لكن لا يمكن أن يغتسل عنده أو يأكل عنده” (حمام اليهودي، ص 105).
نفس هذه الإكراهات يُعاني منها ناجي بطل رواية عبدالجبار ناصر “اليهودي الأخير”، فيطلب منه المتصرِّف أن يهاجر من العراق، على نحو ما فعل الكثيرون من اليهود بعد إعلان دولة إسرائيل عام 1948، حتى تأججت المشاعر الوطنيّة وترددت الشعارات المعادية لليهود، إلا أن يرفض ويتمسّك بالبقاء حتى أنه يصرخ “ماذا يريدون مني. الهجرة. إلى أين؟ لا أعرف وطنًا آخر غير هذه الأرض التي عاش فيها آبائي وأجدادي على امتداد القرون؟ يودون أن أكون مغتربًا منفيًّا؟ أنا الآن كذلك” (ص، 41).
فأهل المدينة لم يشعروه يومًا بأنه من دين آخر، أو حتى أن له تعاطفًا مع اليهود الذين اغتصبوا أراضي الفلسطينيين وأقاموا دولة إسرائيل التي لا تعترف بها الحكومة العراقية. كان الإكراه من قبل “رجال السلطة الذين يذكّرونه بيهوديته بغرض الضغط والابتزاز” (ص، 43) ومنهم الضابط سوادي، الذي اقتحم منزله ذات مرة بتهمة وجود بلاغ عن أجهزة اتصال بإسرائيل، ومع أنه لم يعثر على الأجهزة إلا أنه صادر مبلغ عشرة آلاف دينار كانت أمانة لديه.
لكن أنكى هذه الإكراهات هو ما تمثّل في فقده حبيبته وخطيبته تمام، ذات العشرين عامًا، بعد قدوم وليّ العهد عبدالإله إلى بغداد بحماية الإنكليز عام 1941، وتصادف احتفال اليهود بعيد الشعانين، فزعم أنصار حكومة الانقلاب المنهارة أن اليهود يحتفلون بهزيمة الجيش العراقي “فهجم الغوغاء على دور اليهود ومحالهم التجارية، فقتل عدد كبير من الأبرياء ونُهبت ممتلكاتهم، وكانت بين القتلى العذراء الحبيبة تمّام، التي كانت “خرجت من البيت في تلك الظهيرة بحثا عن أخيها الصغير” (ص، 64)، وقد وصفت بأحداث الفرهود. وإن كان الطبيب ناجي يوازي بين المأساة التي حدثت لخطيبته وعرب فلسطين الأبرياء، ومن ثمّ يدين القتلة الذين هم “متطرفون، ولكنهم يهود” فتند عنه تنهيدة أسى “ما أقسى التعصب الأعمى، وما أغباه!” (ص، 65).

وعندما ازداد الخوف نصحه حمّود بأن يقتني سلاحًا، لكنه خشي أن رجال الشرطة المرتشين لن تغلبهم الحيلة في الإيقاع به، أما خشيته الحقيقية في أن يعمد إلى اغتياله بعض الجهلة المتعصبين ممن يدعون التدين وهم لا يحفظون حتى سورة الفاتحة”. ينتهي مآل الطبيب وهو في طريقه إلى الهرب بعدما ضاقت به السبل.
في رواية “عزازيل” (دار الشروق، 2010) ليوسف زيدان، يقدم صورة من صور القهر التي تعرّض لها يهود الإسكندرية، ولكن هذه المرة ليس من المسلمين، وإنما على يد المسيحيين، تجسيدًا للصراع التاريخيّ المأزوم بين الطائفتين، فعندما وطئت أقدامه هيبا الإسكندرية يسمع الكراهية التي يصبها البابا لليهود، كما أن اليهود “كانوا يحظون بكراهية الفريقيْن؛ المسيحيين والوثنيين”(ص، 74). فيصف الراوي يهود الإسكندرية “بالمساكين الأتقياء” الذين “طردهم المسيحيون القساة القلوب”. أما بطريركهم فوصفته أوكتافيا بالمهووس “المتكبر الذي يُطارد كل ما هو غير مسيحي بكل قسوة وبلا شفقة ولا رحمة!” إنهم “يطاردوننا في كل مكان، ويطردون إخوانهم اليهود” كما وصفت أوكتافيا لهيبا، وكانت نقطة فراق بينهما، عندما عرفت أنه راهب مسيحي. وأيضًا “يهدمون المعابد على رؤوس الناس، ويصفونهم بالوثنيين الأنجاس” (ص، 152).
بل ثمة أمنية جاءت على لسان أحد رجال الدين مفادها أنه “سيأتي اليوم الذي لن نسمح فيه للوثنيين، ولا لليهود بالمبيت. لا في الإسكندرية، ولا في المدن الكبيرة كلها.. غدًا سوف يسكنون جميعا خارج كل الأسوار، وتكون المدن كلها لشعب الرب!” (ص، 153). فالبابا كيرُلس معروف بكراهيته لليهود، فكما سخر فلاح من كلام البابا بدعوته للحب، وإشارته إلى حب إخوانكم. فيقول ساخرًا “طبعًا كيرلس يحبهم، لدرجة موتهم وطردهم خارج الأسوار” (ص، 70).
كما أن خطاب البابا كيرُلس مفعمٌ بالنبذ والتحقير، وتأجيج الكراهية في القلوب ضد اليهود، وهو ما كان له أثره لما حدث لهيباتيا. ففي عظته الأسبوعية، وكان على هيئته الحزن، وبعد أن تلا الصلاة والناس خلف يرددون، وفجأة صار صوته ناريًّا وهو يقول لهم في تحريض مقيت “يا أبناء الله، يا أحباء يسوع الحي، إن مدينتكم هذه هي مدينة الربّ العظمى، فيها استقر مرقس الرسول، وعلى أرضها عاش الآباء، وسالت دماء الشهداء، وقامت دعائم الديانة. ولقد طهرناها من اليهود المطرودين. أعاننا الربُّ على طردهم، وتطهير مدينته منهم. ولكن أذيال الوثنيين الأنجاس، ما زالت تثير غبار الفتن في ديارنا. إنهم يعيثون حولنا فسادًا وهرطقة. يخوضون في أسرار كنيستنا مستهزئين، ويسخرون مما لا يعرفون، …” إلى آخر هذا الخطاب التحريضي الذي ينتهي نهاية دموية بالفيلسوفة هيباتيا ابنة ثيرون وقد صارت جثة هامدة، ألقوها فوق كومة كبيرة من قطع الخشب، ثم أشعلوا النار. فعلا اللهب وتطاير الشرر. وسكتت صرخات هيباتيا.
التعاطف
لا ينكر المتابع لمدوّنة السرد العربي أن الرواية العربية -وهي تتناول موضوعها- قطعت شوطًا بعيدًا عن تمثلات البدايات التي راوحت بين التعاطف مع اليهود باعتبارهم أناسا يتواجدون في ذات المكان، وتربّت الشخصيات معها دون الاعتبار لديانتها، وبين التحفظ باعتبار إسرائيل العدو، إلى نماذج جديدة لم تر في التعامل مع الإسرائيليين أيّ غضاضة، على نحو ما فعل بطل رواية “ماذا عن السيدة راحيل؟” لسليم بركات “كيهات” الذي راح يتذرع بوسائل كثيرة كي يعمل لدى السيدة راحيل تقربًا لابنتها.

ونفس الشيء فعلته فاطمة مع سالم في رواية “اليهودي الحالي”، فهي التي ذهبت إلى بيت النقّاش اليهودي، في مسعى لإقناع الأب بسبب تعليمها لابنه سالم قائلة “أنا أعرف أنه يهودي، لكم دينكم، ولنا ديننا. لا توجد مشكلة. كلنا من آدم وآدم من تراب اللغة ليس فيها دين فقط، فيها تاريخ وشعر وعلوم، أقول لك، والله، توجد كتب كثيرة في رفوف بيتنا، لو قرأها المسلمون سيحبون اليهود، ولو قرأها اليهود سيحبون المسلمين” (ص ص 15، 16).
وبالمثل لم يجفل ناجي عبدالصمد من ويندي عندما أخبرته أنها يهودية. وعندما كرر الكلمة مرة أخرى، ظنت أنه أصابه الذهول، فقالت له: هل أصابك الخبر بالذهول؟ فأجاب بيقين “لا أبدًا”. (شيكاجو: ص 238). وإزاء هذا الموقف من جانب ناجي قالت له ويندي بزهو “إنه العربي الوحيد الذي لا يحلم بإبادة اليهود!”.
تبدّد الحذر من قبل اليهودي وتسرّب لدى العربي، فدانا في”السيدة من تل أبيب” تفاخر بيهودية صديقها الأوكراني، مع أن الأم ترى أن بوريس الأوكراني “ليست يهوديته خالصة”، في حين على المقابل وليد الدهمان “ظل متوجسًا من أن يظهر جنسيته الفلسطينية أمام دانا عندما سألته من أنت؟ بل طافت تهويمات عجيبة بأن يصيح أحد الركاب “في الطائرة فلسطيني”، وبعد تردد وتكرار السؤال منها يجيب “أنا فلسطيني أحمل الجنسية البريطانية” (ص 93).
عودٌ على بدء
في نهاية رواية “القارئ” للألماني برنهارد شيلنك (تر. تامر فتحي، روافد للنشر والتوزيع، 2016)، يذهب محامي “هانا” بعد أن أوصته قبل انتحارها، إلى الناجية الوحيدة، كي تتبرع لها بما لديها من مدخرات في علبة الشاي الصفيح، لكن الناجية تسخر منه وتستنكر قائلة “وأن أمنح السيدة شميتز الغفران؟” وبعد حوار عن علاقته بها، في محاولة لإظهار بشاعتها. تسأله:
- هل لديك اقتراح بما يمكن عمله بالمال؟ إن استخدامه في شيء ما له علاقة بالهولوكست سيبدو بالفعل لي طلبًا للغفران، وهذا شيء لا أودّه ولا أهتم بمنحه” (القارئ، ص210)
يكشف هذا المشهد، طبيعة اليهودي الذي لا ينسى ولا يغفر، ومن ثمّ فمهما اجتهد الجميع لمحاولة إرضاء الآخر (اليهودي) والتذكير بحالات الاندماج والانصهار في النسيج الاجتماعي للشعوب العربية، إلا أن الحقيقة أن الآخر (اليهود) لن يقبل (العرب) باعتبارهم (آخر) بالنسبة إليه، فكيهات الذي اجتهد لخدمة راحيل في “ماذا عن السيدة راحيل؟” يفاجأ في نهاية الرواية بعدما عمل ما عمل أيام السبت، حتى صار كالخادم الذليل، أنها هربت دون أن تخبره، ربما ثمة سببا لهروبها كما يقول قائل: حيث كانت إكراهات السلطة لتهجير اليهود من القامشلي بعد النكسة. هذه صورة حاضرة عن اليهود، لكن المرويات تجاهلتها لأسباب معلومة ولا تحتاج إلى تفصيل.
الغريب أن ما تنكره (عمدًا) المرويات العربية تعكسه (بل تتفاخر به) المرويات التي كتبها الآخر (الصهيوني) عن العرب (الأنا) باعتبارهم (آخر) أو مضادًا للذات العربية، ففي رواية “العاشق” للكاتب أب يهوشواع، فالعرب وفق ما جاء في الرواية هم موزعّون بين فدائي مصيره القتل، وجاسوس يجهد لمحو الصورة المريبة التي يأخذها اليهود عنه، وهو يحاول الاندماج في المجتمع الإسرائيلي لكن لا ينجح في ذلك، وبذلك يكون مصدر أرق بالنسبة إلى الإسرائيليين كما يقول أمين دراوشة في كتابه “الأنا والآخر في الرواية الإسرائيلية”.
بل دومًا يظهر الإسرائيلي في صورة المتعالي على الآخر يعامله بدونية، معتمدًا على اعتقاده في نظرية العرق الأنقى. فالعجوز كاتسمان في رواية “ابتسامة الجدي” لديفيد جروسمان، يرى أنه يجب على الفلسطينيين أن يشكروا الاحتلال على إنسانيته ورحمته لأنه “يساعد الشعب الجاهل الذي لا يعرف مصلحته”، فالجندي الإسرائيلي يرى هؤلاء عدوًا، جاء هنا لمحاربة الإقطاع كما وصفها إميل حبيبي في “الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل” (1974). الغريب أن مثل هذه الصورة لم نرها في الروايات العربية، فدائمًا اليهودي ينصهر في المجتمع المحيط به، بل إذا خرج منه يشعر بالشتات والضياع، على نحو ما صوّر كمال رحيم في رواية “الشتات” فالجد والخال بعد ثورة 1952، وهجرة اليهود من مصر، يضطرا إلى السّفر إلى فرنسا كمحطة إلى الهجرة إلى إسرائيل، يتبدّل الحال بعد الأعمال، ويعملون في أعمال متواضعة دنيئة هناك، وهم الذين عاشوا في مصر حياة كريمة، وعملوا أيضًا في مهن مربحة كالتجارة والصياغة والساعات.

كما لا ننسى في ظل هذا الصراع نشأت شخصية منقسمة على ذاتها بين الهُنا والهناك، أو بين الانتماء إلى الوطن الذي عاشت فيه أو العودة إلى وطن الآباء والأجداد. وقد اتفقت الروايات جميعًا على أن اليهود الذين تواجدوا في المجتمعات العربية عاشوا في حالة سماحة، بما رفعته هذه البلدان من شعار “السماحة مع الآخر”، وباعتبارهم جزءًا أصيلاً من هذه الأوطان، تأمل إخاد بطل رواية الجبين “يوميات يهودي في دمشق”، وهو حائر بين الهُنا والهناك، وبعد هجرته إلى أميركا يعود مرة ثانية إلى الهنا. كما أشارت الروايات إلى التأثير الخطير في العلاقة بين الذات العربية والآخر، بفعل الأحداث السياسية وعلوّ نبرة القومية العربية، التي كان لها أكبر الأثر في رحلة الشتات، دون أن نقلل من دور الحركات الصهيونية واحتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948 في تأجيج الصراع وانعكاس هذه التوترات على اليهود في البلاد العربية.
تغيرات الصورة النمطية لليهود لم تكن وليدة اليوم أو نتاج هذه السياقات السياسية وتبدّل الأيديولوجيات فقط، وإنما ثمة جذورا له، وقد تمّ تمريرها عبر مرويات، أو على لسان شخصيات، فمثلا غسان كنفاني في روايته “عائد إلى حيفا” (1969)، فكما يقول فيصل دراج “إن كنفاني جعل من الصهيوني مرجعًا للفلسطيني وأستاذًا له، طالما أن الأستاذ يعترف بنجاحه وبقدرته على هزيمة من لم يكن أستاذًا مثله” (صور اليهودي الغائمة في مرايا غسان كنفاني، ص 25).
لعبت الكثير من الروايات على الأمل في رأب صَدْع قطيعة الماضي، مدفوعة بميراث من الاندماج والتعايش بين الشعوب، قبل أن تطل موجة من الكراهية أو الرغبة في إقصاء الآخر. الشيء الذي يذكر أن هذه الروايات تجنبت الصّراع الدامي بكل إخفاقاته (النكبة، والتشرد والهزائم)، وأيضًا ما خلفته يد الاحتلال من مجازر واستلاب للهُوية قبل الأرض، بل سعت لتكريس صورة اليهودي الإنساني، في مقابل إدانة كاملة لهجرات اليهود وممارسات التنكيل بهم لإرغامهم على الهجرة. فإبراهيم عبدالمجيد في روايته “طيور العنبر” (دار الشروق، 2000) يكاد يدين سياسات عبدالناصر التي كانت سببًا وراء هجرة اليهود من الإسكندرية، فاليهود لديه “ليسوا جالية وإنما هم مواطنون مصريون”. وهو ما يدعو للعجب وكأنّ الكُتّاب في تمثلاتهم لحقيقة العلاقة بين الأنا (الذات العربية) والآخر (اليهودي) يتبنوّن شعار الاندماج الذي كان من قبل مجرد “حلم لو يتحقق يوما” وها هو يطرق أبواب الأدب عبر نوافذ السياسة غاضين الطرف عن أسباب القطيعة التي جاءت أيضًا من نوافذ السياسة ودهاليزها!




