ثورة الدولة الإسلامية
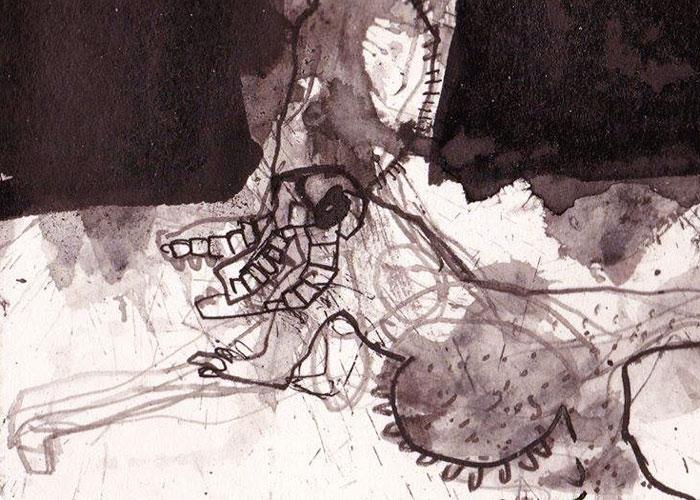
وها أن عالم الأنثروبولوجيا الأميركي الفرنسي سكوت أتران يفنّد تلك التحاليل لكونها تتناول المسألة من منظور غربي، لا يرى في الدولة الإسلامية سوى نموذج مضاد لنموذج الحضارة الغربية، والحال أنها ثورة على وضع جيوسياسي فرضته الهيمنة الغربية كما جاء في كتابه الصادر في بداية شهر مايو 2016 “الدولة الإسلامية ثورة”.
والرّجل لا ينطق من فراغ، بل ينطلق في حكمه من دراسات ميدانية في قلب تنظيم داعش وأحياء باريس ولندن وبرشلونة رفقة فريق كامل من أخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع وحتى تصوير الأعصاب بالأشعة المغناطيسية، بوصفه متخصصا في الإرهاب ومدير بحوث في المركز القومي للأبحاث الاجتماعية بباريس، ومدرسا بجامعتي أوكسفورد وميشيغان. وهو إلى ذلك مرجع دعته منظمة الأمم المتحدة منذ بضعة أشهر وكذلك الرئيس أوباما لفهم ظاهرة الدولة الإسلامية وسبل التصدّي لأنشطتها الدعوية.
قد يبدو نعت ما تقوم به الدولة الإسلامية من أعمال قتل وتدمير وسبي واغتصاب واسترقاق بـ”الثورة” صادما، ولكن الكاتب يرى أن تلك حال الثورات المعاصرة، كالثورة الفرنسية والثورة البلشفية اللتين ارتكبتا مجازر فظيعة لإزالة الوضع القائم وإرساء قيم جديدة. فبالرغم من عناصر النكوص المرتبطة بالبحث عن طريق إلى المستقبل في تجاويف ماضٍ أسطوري، تبدو الدولة الإسلامية حديثة من جهة تنظيمها الإداري المحكم وإمساكها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، ومن جهة منهجها الرامي إلى توحيد الأفراد في حرب شاملة -أيديولوجية، اقتصادية، ثقافية، عسكرية- لإنقاذ البشرية. وجديدها الذي جاءت به هو فكرة “الخلافة” لإلغاء مفهوم الدولة/الأمة. يقول أتران “مفهوم الأمة عند الأميركان يستند إلى جملة من الأفكار والمبادئ والقيم تقوم مقام الهوية، أما في فرنسا فالهوية متصلة بالأرض وروابط الدم التاريخية. لذلك أعتبر الدولة الإسلامية دولة ثورية، لأن إعادة النظر في الدولة/الأمة ثورة. الجهاديون يخلقون حركة خاصة بهم، مع بنى أخلاقية ودينية وميتافيزيقية تختلف تماما عن بنانا.” وعلى غرار أيّ ثورة، تطمح الدولة الإسلامية إلى الكونية والشمولية، فهي الوجه الآخر للعولمة، لها نفس الجمهور، ونفس الهدف، ولكنها تقدِّم بديلا للهيمنة الغربية. وقد لاحظ أتران في العالم السنّي هذا المطمح الثوري المتمثل في الحنين إلى الخلافة، فالعرب، كما يقول، وإن كانوا واعين بأن قرون الخلافة العثمانية الأربعة أوهتهم إلى الانحطاط والتخلف، لا يزالون يحنّون إلى زمن الخلافة في عصورها الأولى، حينما كانت سيطرتها تمتد من فارس إلى الأندلس، وهو بعد أسطوري يغذّي حميّة الشباب، ويعطي لانخراطهم معنى، وعنصر سياسي وروحي بالغ الأهمية في الحرب غير المتماثلة التي تخوضها الدولة الإسلامية ضدّ قوات التحالف.
يؤكد سكوت أتران على ضرورة فهم الظاهرة للتسلح بالوسائل الكفيلة بمواجهتها، بدءا بطبيعتها الحق، فالحديث عن الإرهاب أو النيهيلية أو غسل الأدمغة -الكذبة التي ابتدعها الأميركان في الحرب الكورية حسب قوله- ووصْفها بكونها حركة طائفية كل ذلك لا معنى له في نظره، لأنه لا يساعدنا على أن نفهم كيف نجح ذلك التنظيم في السيطرة على مئات الآلاف من الكيلومترات في أقل من سنتين، وكيف استطاع أن يستقطب أناسا ممّا يقارب مئة بلد من شتى القارات، وكيف توصل إلى إثارة العنف عبر العالم.
وفي رأيه أن الدولة الإسلامية هي حركة سياسية ودينية وأخلاقية لها وزن جيوسياسي لا يستهان بحجمه، وقوتها تكمن في ما تتمتع به من طاقة استقطاب كبرى، وإن كانت، بخلاف أغلب الحركات الثورية الاجتماعية، تحمل رؤية كارثية تبدأ بتدمير العالم لإنقاذه من ذنوبه وخطاياه.
فمن بين الأخطاء التي يقع فيها المحللون، في اعتقاده، النظر إليها كمجرد وجه للإرهاب والتطرف العنيف والإلحاح على أنّ عنفها ليس سوى عمل لاأخلاقي ورفض ذكرها بالاسم الذي أطلقته على نفسها بغرض إزالة الشرعية عنها. وهذا ليس عديم الجدوى فقط، بل هو أيضا يحجب عنا قدرتها على الحشد والتجنيد، مثلما يحجب طابعها الثوري، ويخفي بالتالي التهديد الحقيقي الذي تمثله. فالدولة الإسلامية تمنح أفق مجتمع طوباوي، يزعم إنقاذ البشرية عبر أعمال عنف من شأنها أن تكسر أغلال النظام العالمي للدول/الأمم الذي فرضه الأوروبيون المنتصرون عقب الحرب العالمية الأولى. والتحالف الغربي المعادي للدولة الإسلامية، بما في ذلك روسيا، إنما يحاول إنقاذ ذلك النظام أو إصلاحه، والحال أن ذلك هو ما تعتبره الدولة الإسلامية وأطراف عديدة في الشرق الأوسط السبب الأول لمحَنها ومصائبها. وليس أدلّ على ذلك من أنّ الشبان في الشرق الأوسط، لا سيما أولئك الذين التحقوا بصفوف تنظيم الدولة، يقولون إن الغرب فرض علينا أفكاره، كالقومية والاشتراكية والشيوعية والليبرالية، لأنّنا كنا ضعفاء، ولكنها فشلت كلها.

لوحة: عادل داؤود
الشيء نفسه بخصوص الحرب، فالدولة الإسلامية ليست دولة ذات قواعد عسكرية ومؤسسات مادية، كاليابان سابقا أو ألمانيا النازية، ولكنها قوية بإيمان رجالها بأيديولوجيتهم واستعدادهم للموت لأجلها، وآخر الأخبار تثبت أن رقعتها الجغرافية تنحسر، وقواتها تتلقى الضربات الموجعة، غير أن ذلك لا يعني زوالها، ففي عام 2008 تدخلت أميركا للقضاء على جماعات الزرقاوي وقتلت نسبة كبيرة من قادتها حتى قيل إنه لم يبق من تلك الجماعات الإرهابية سوى 10 بالمئة، غير أن تلك البقية الباقية استطاعت أن تلملم شتاتها وتعود بقوة في شكل داعش وتبسط سيطرتها على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.
والرأي عنده أن تُنقَل الحرب إلى الميدان الأيديولوجي، وتتوجه إلى المكوّنَين الأساسيين اللذين ترتكز عليهما الدولة الإسلامية: أولا، المتطوعون والداخلون في الإسلام وهم الأكثر التزاما وتشددا في الغالب. وثانيا، الرهانات المحلية التي تزعم الدولة إيجاد حلول لها بخلق طائفة موحدة من العرب السنّة، تعطي إشارة غزو العالم بعد نشر الإسلام السلفي، أي إسلام الأصول.
وأمام فشل الإجراءات الأمنية والعسكرية، ينصح الكاتب بتفكيك فكرة “الخلافة” بوصفها أسطورة أساسية في التعبئة، والتركيز على المسائل النفسية والاجتماعية التي تساهم في تنامي تلك الظاهرة على المستوى الوطني. وخلافا للأعضاء المؤسسين لتنظيم القاعدة، يتألف المنجذبون إلى الجهاد في أغلب الأوقات من شبان يبحثون عن معنى لوجودهم في مرحلة ما من حياتهم، وهم في العادة مهاجرون وطلبة ومهمّشون غادروا بيت الأسرة وسعوا في البحث عن أسرة جديدة وأصدقاء جدد أو عن رفاق سفر. أغلبهم لم يتلق تربية دينية تقليدية وانتمى إلى الإسلام بالوراثة أو اعتنق في نهاية مراهقته الأفكار السلفية الراديكالية الجهادية، وعادة ما يكون أولئك الشبان مفتونين بقضية ذات معنى، وبالصداقة، والمغامرة والمجد. وبدل التظاهر بـ”غسل الأدمغة” في الاتجاه المعاكس، ينصح المؤلف بنسيان “السرديات المضادة” والتركيز على “الالتزامات المضادة” مع الشبيبة. فقد لاحظ أن 80 بالمئة ممّن يلتحقون بصفوف داعش أو القاعدة إنما يفعلون ذلك عبر الأصدقاء والشلل ومن النادر أن يأتوه فرادى. وبدل محاولة عزل شبكات الأصدقاء ومجموعات المساندة، يوصي بمساعدة أولئك الشبان على درب التزام شخصي عبر تطوير تعبير منافس لطوباوية الدولة الإسلامية، يتولاه مناضلون شبان لابتكار وسائل ملموسة من أجل إحلال السلام.
مثلما ينصح بالتخلي عن فكرة الدولة/الأمة في الشرق الأوسط، وترك المبادرة للسنّة كي يتخيّلوا وطنهم، ويحافظوا على بارقة أمل لا تلوّح بها الدولة الإسلامية وحدها. وإذا كانت النقطة الأولى معقولة وقابلة للتنفيذ إذا ما تظافرت جهود المتخصصين وأصحاب القرار، فإن النقطة الثانية خطيرة، لأنها توحي بالترويج لفكرة إعادة رسم حدود “سايكس-بيكو” الجغرافية لعدد من بلدان الشرق الأوسط، وفي طليعتها العراق وسوريا، على أساس طائفي، يحلّ فيه المعتقد محلّ المواطنة، وتصير الأقليات منبوذة، وربما مدفوعة دفعا للبحث لها عن وطن بديل في المهاجر الغربية.
والخلاصة أن هذا الكتاب ينبّه إلى ما يجعل الدولة الإسلامية جذابة، فهو المفتاح لفهم الخطر الذي تمثله، والسبيل المنشودة للقضاء عليها. يقول سكوت أتران “لن نهزم الدولة الإسلامية بإجراءات أمنية وعسكرية، ولا بفتح مراكز لثني المتطرفين عن تطرفهم، وإنما باقتحام شلل الأصدقاء للوقوف على الأدواء التي تقود أولئك الشبان إلى التشدد والانحراف، وفهمهم”.




