جذور التفاوت الاجتماعي والاقتصادي

بعد نجاح كتابه “رأس المال في القرن الواحد والعشرين”، الذي ترجم إلى نحو أربعين لغة، وبيع منه أكثر من مليونين ونصف مليون نسخة، نشر الفرنسي توما بيكيتي، مدير البحوث في المدرسة العليا للدراسات في العلوم الاجتماعية والأستاذ المحاضر بمدرسة الاقتصاد بباريس، كتابا جديدا بعنوان “رأس المال والأيديولوجيا” لفت الانتباه من جهة حجمه (1232 ص)، ومن جهة محتواه الذي أثار ولا يزال يثير جدلا واسعا. هنا محاولة لتلمّس ما يحويه هذا الكتاب الذي يتناول سردية كبرى للتاريخ الإنساني، اقتفى فيها مؤلفها خيطا رابطا هو التفاوت كبناء أيديولوجي، ويخلص إلى ضرورة تجاوز الرأسمالية.
تحتاج كل المجتمعات البشرية إلى تبرير التفاوت الذي ينظمها، وتوفر أسبابه لمنع انهيار البناء السياسي والمجتمعي، ولو أنعمنا النظر في أيديولوجيات الماضي، لوجدنا أنها لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها الراهنة. في “رأس المال”، كان بيكيتي قد بين كيف أدت الحربان العالميتان إلى انحسار كبير للتفاوت الموروث عن القرن التاسع عشر، وكيف عاد التفاوت بشكل خطير منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكن الكتاب، باعتراف صاحبه، شابه عيبان. أولهما أنه تركز على الغرب وحده، وثانيهما أنه لم يلامس مسألة الأيديولوجيات السياسية التي قامت على التفاوت إلا أهون مسّ. لذلك انطلق في هذا الكتاب من معطيات مقارنة بالغة السعة والعمق، وسعى إلى تتبع المسار الاقتصادي والاجتماعي والفكري والسياسي الذي عرفته الأنظمة التي أقرت الاسترقاق والتفاوت، أي تلك التي تقسّم النشاط الإنساني إلى ثلاث وظائف توافق المجالات الثلاث أي الديني والحربي والاقتصادي، وفقا للنظرية التي وضعها الفرنسي جورج دوميزيل، منذ الأنظمة الهندو أوروبية إلى الأنظمة ما بعد الكولونيالية والرأسمالية المعاصرة، مرورا بالمجتمعات المالكة والكولونيالية والشيوعية والاشتراكية الديمقراطية.
استنادا إلى دروس التاريخ في شموليته، يعتقد بيكيتي أن في الإمكان أن نقطع مع تلك الحتمية التي كانت سببا في الانحرافات الهووية الحالية، لوضع اشتراكية تشاركية للقرن الواحد والعشرين، ورسم خطوط أفق مساواة جديد ذي بعد كوني، وصياغة أيديولوجيا جديدة للمساواة والملكية الاجتماعية والتربية وتقاسم المعارف والسلطات.
فكيف تم المرور من أيديولوجيا تأسست على السلم التراتبي الطبيعي إلى التفاوت المعاصر الذي عادة ما يقال إنه قائم على الجدارة والاستحقاق؟
لقد عاشت عدة مجتمعات، شأن أوروبا تحت النظام القديم، والهند ما قبل المرحلة الاستعمارية، والصين الإمبريالية، وفق نظام ثلاثيّ قائم على التفاوت، حيث تتقاسم السطلةَ مجموعتان، طبقة المحاربين التي تضمن احترام القانون والنظام، وطبقة كهنوتية وثقافية تضمن وظائف الإنتاج من غذاء وكساء. وكانت الصعوبة التي تواجه تلك البنية تتمثل في إيجاد توازن بين طبقتين مهيمنتين تملك كل منهما الشرعية، ما يضطرها إلى القبول بالحد من نفوذها، كحال الكشاترية في الهند، أولئك المحاربون الذين يمنحون البراهمان مكانة مميزة لضمان نمط مقنع من الاستقرار والنمو يدفع الطبقة الشغيلة إلى قبول الهيمنة. كذلك المجتمعات الأوروبية التي أوجدت تراتبية تقسم الفئات إلى ثلاث طبقات، طبقة العبّاد (oratores) وطبقة المحاربين (bellatores) وطبقة العمال (laboratores)، رغم أن تاريخ تلك المجتمعات حافل بالصدامات والاستثناءات. ومع بزوغ عصر الحداثة، لا سيما زمن الثورة الفرنسية، حلت مجتمعات المالكين محل المجتمعات الثالثية، وتغيرت الأيديولوجيا، فناب عن التأكيد على أن الاستقرار ينشأ من تكامل الأدوار في تناسق تراتبي، تأكيد آخر على أن حق الملكية صار مفتوحا للجميع، وأن المهمة الأساسية للدولة المركزية هي حماية ذلك الحق. بيد أن تقديس هذا الحق خلال القرن التاسع عشر آل إلى تفاوت مفرط لفائدة بعض المتنفذين، وشكل ظاهرة دعمها التوسع الكولونيالي والتنافس الشرس بين مختلف الدول الأوروبية. وكان من أثر تلك الدينامية أن دمرت المجتمعات الأوربية نفسها بنفسها ما بين عامي 1914 و1945. تلك الأيديولوجيا التي يسميها الكاتب “ملكوية”، لم تصمد طويلا أمام الهزات والأزمات، فتركت المجال لمرحلة جديدة من المساواة، استفادت من صعود الضرائب التدريجية منذ 1920 وبروز سياسات اجتماعية ديمقراطية أكثر مساواة، كما حصل في الولايات المتحدة في عهد الرئيس روزفلت، فضلا عن إرساء الشيوعية في دول شرق أو
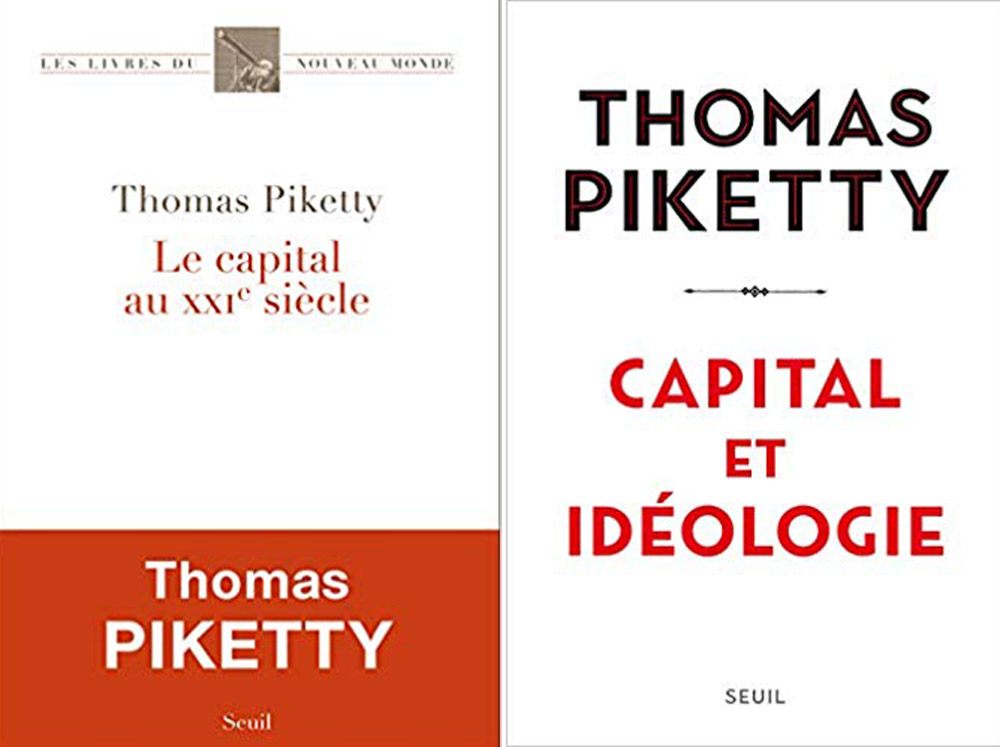
روبا. تلا ذلك منعرج جديد خلال الثمانينات تمثل في سياسة الملكوية الجديدة التي رأت النور في الولايات المتحدة وبريطانيا، وسارت على هديها عدة دول أخرى.
وفي رأي بيكيتي أن انهيار فترة المساواة منذ مطلع الثمانينات مرده إلى الاعتماد المفرط على دولة الرفاه، ما أدى إلى انتكاس المقاولين وأصحاب الشركات الخاصة، ثم إلى سقوط المنظومة الشيوعية الذي أغلق الباب أمام التفكير الجدي في إقامة مجتمع مساواة، حيث عمّ الشعور بأن قيام مجتمعات عادلة لم يعد من الممكنات. حتى محاولات ريغن وثاتشر لجعل التفاوت مطية لتنشيط النمو لم تأت أكلها، فقد تراجع النمو بصفة ملحوظة، وتفاقم اللجوء إلى الدَّين حتى انفجار أزمة 2008.
ثم إن التفاوت الذي يتغير تبعا للمراحل والأماكن، لا يأتي اعتباطا بل يستند إلى ما يسميه الكاتب “ذريعة صندوق باندورا” حيث يجيب المستفيدون من التفاوت غيرهم من الباحثين عن حلول لإقرار المساواة بأن مسعاهم الراديكالي سيؤدي إلى الفوضى. ويضرب مثلا على ذلك بطغمة عسكرية تستولي على السلطة، فتتحالف مع من يمسك بالثقافة المكتوبة والثقافة الدينية، وتقترح نمطا من الاستقرار، فمن النادر عندئذ أن يجازف بعضهم لتغيير الواقع خوفا من العودة إلى الفوضى. ولكن القرن الثامن عشر، ثم القرن التاسع عشر شهدا من امتلكوا الجرأة على نقد الأوضاع القائمة واقتراح تجارب جديدة آلت في النهاية إلى تقديس الملكية. فالتاريخ في نظر بيكيتي ليس فقط صراع طبقات كما كتب ماركس وإنغلز، بل هو تدرب مطّرد على العدل، يمر حتما بصراع أيديولوجيات، لأن الموقع الاجتماعي، أيّا ما تكن أهميته، لا يكفي وحده لصنع نظرية عن الملكية والحدود والضرائب والتربية. نفس الذريعة كانت حاضرة في مجادلات الثورة الفرنسية، حيث تمت المطالبة بإلغاء الامتيازات، ولكن أيّ امتيازات؟ فالعمال الفلاحيون كانوا لا يزالون خاضعين للنبلاء، يعملون تحت إمرتهم دون مقابل، رغم إلغاء الرق في أوروبا. أي أن الثورة لم تلغ التفاوت، بل أعادت صياغته في لغة جديدة تقوم على تقديس الملكية.
لقد انطلق بيكيتي من فكرة أن تاريخ العالم هو تاريخ التفاوت (بصيغة الجمع) وحلل جذوره الفلسفية والسياسية، فسعى إلى تفكيك تلك المبررات الأيديولوجية عبر استقراء العصور القديمة وإفرازاتها، ولكنه لم يستند إلا قليلا لآراء من خاض في هذه المواضيع قبله، فباستثناء توكفيل وحنا أرندت وماركس، قلّ أن عزز موقفه بمقولة لأحد الفلاسفة. حتى قراءته للثورة الفرنسية جاءت مطابقة للسردية الماركسية التقليدية. والجديد هنا هو ما يقترحه استنادا إلى تجارب الماضي، وربطه بين التاريخ وتلك المقترحات لخلق ما أسماه الاشتراكية التشاركية للحد من التفاوت، متمثلا في لاوعيه ما قاله روسو “من الموجود إلى الممكن، تبدو العاقبة في نظري جيدة.” ويبقى السؤال: كيف؟
يقول بيكيتي “إن ما يعنيني ليس معرفة ما إذا كان التغيير سيتم عبر انتخابات أو عقب مسار ثوري ضخم، وإنما مناقشة الطريقة التي يمكن أن ننظم بها المجتمع منذ صبيحة الغد”. ويسوق مثالا عن الشيوعيين الروس الذين ثاروا عام 1917 دون التفكير بجدية في سبل إقامة العدل، فدكتاتورية البروليتاريا لا تصنع برنامج عمل. ذلك أنه يفضل صياغة مشروع اشتراكية تشاركية واجتماعية فيدرالية تقوم على التشاور والمداولة، كتقاسم حق التصويت بين الأجراء والمساهمين في رأس مال المؤسسة، كما هي الحال في السويد وألمانيا، أو وضع سقف لأصوات كبار المساهمين. يمكن أيضا وضع منظومة جباية سنوية متدرجة على الدخل والوراثة، وكذلك أداء سنوي على الملكية لا تتجاوز نسبتها 0.1 لذوي الدخل المحدود، ومن 50 إلى 90 بالمئة للملكيات التي تقدر بعدة مليارات. ويعتقد بيكيتي أن ذلك ممكن، مستشهدا ببعض المبادرات المماثلة في أوروبا والولايات المتحدة خلال القرن العشرين. ويؤكد أنه يطرح أفكارا، انطلاقا من تجارب معيشة، معلومة أو منسية، وسبيلا للمضي قدما، لتجاوز الرأسمالية والملكية الخاصة.

والخلاصة أن التفاوت قديم قدم الحضارات، وأن الأنظمة على اختلافها حاولت تلطيفه دون القضاء عليه لأنها تخضع في كل مرحلة لتلك القاعدة الثلاثية القديمة، التي لا نزال نجد آثارها في عصرنا الحاضر، حيث تسعى عدة مجموعات إلى البحث عن شرعية للحكم أو الهيمنة على المجتمع، فأصحاب الشهائد يطالبون باحترامهم، اعتبارا لسعة ثقافتهم، ويضيقون ذرعا بمن لا يقرؤون كتبهم ولا يصغون إليهم. والشرعية الحربية هي أيضا لم تزُل تماما، وإن تحولت في جانب منها إلى شرعية ريعية، على غرار ترامب وبرلسكوني ممن يعادون المثقفين ويقيمون شرعيتهم على مهارتهم المزعومة في عقد الصفقات. ويلتقي أصحاب هذه الشرعية مع دعاة الشرعية الأولى في استفادتهم من النظام الاقتصادي الحالي. بل إن اليسار البراهماني واليمين الريعي يمكن أن يتحالفا، كما حصل في فرنسا حول ماكرون.
لقد قلب بيكيتي الدبتك الماركسي شعب/غوغاء بجعل الهيكلية الفوقية أي المؤسسات ونظم الحكم عاملا رئيسيا في منظومة التفاوت. وهو موقف يجعل القارئ يقبل على الكتاب من هذه الزاوية، أي من زاوية موقف أيديولوجي وسياسي، وهو ما لا ينكره بيكيتي إذ عرض في القسم الأخير من مؤلفه مقترحات سياسية راديكالية لتجاوز التفاوت، وتجاوز الرأسمالية في الوقت ذاته.
بقي أن نقول إن ما يعاب على بيكيتي أنه قال منذ البداية إن كتابه هذا يصحح ما شاب كتابه الأول من تركيز على الغرب وحده، وإن مقاربته هذه سوف تكون عالمية الطرح، ولكن توسّعه هذا لم يشمل سوى المجتمعات الهندية والصينية، إلى جانب المجتمعات الغربية الرأسمالية بطبيعة الحال، داعيا إلى الحد من التفاوت في تلك البلدان، بيد أنه غفل عن تفاوت صارخ أشد وأعمق، ونعني به ذلك الذي يميز البلدان الغنية عن البلدان الفقيرة، والشعوب الأوروبية عن الشعوب الإفريقية. ذلك التفاوت الذي أقامه الغرب وأمعن فيه عن طريق سياسات هيمنة شاملة على مقدرات تلك الشعوب، ولا يزال يفرضها من خلال شركاته العملاقة، ومؤسساته التي تزعم الحياد كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي.




