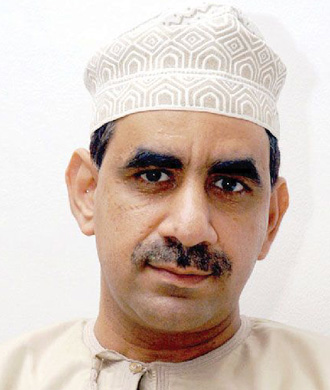حربٌ من أجل استقلال الذات

كأنّما أصبحت حياتنا الخاصة في صراع من أجل الاستقلال. أتذكر هنا مقالا لأمبرتو إيكو تساءل فيه عن سبب حرص بعض المجرمين على ظهور وجوههم للتلفزيون، بدل الخجل من ذلك. وقد عقّب بأن المتهم أو المجرم أراد أن يستغلّ تلك اللحظة لكي يراه العالم، ظنا منه أن ما اقترف يستحق أن يعرف وعلى أكبر نطاق ممكن. فلم يعد يشعر بالخجل من أحد، والسبب أنه، بلا شك، سيجد ضمن هذا الحشد الذي سيراه معجبين به ومفتخرين بإمكاناته.. وكلنا نتذكر وجه ذلك السفاح الذي قتل المصلّين في “مسجد النور” بكريستن شيرش في نيوزيلندا وكيف كان يظهر بوقاحه، وكأنه طهّر العالم.
مدوّن آخر قام بخطوة مهمة في حياته، أشبه بعملية جراحية صعبة، إذ جرّب أن يحرم نفسه شهرا كاملا من الهاتف الذكي.. ألا يحمل معه هاتفا ذكيا. كان الموضوع مثيرا في بدايته ولكنه يمر بنفق طويل من المصاعب ومحطات ضياع استعان فيها بخبرته الحياتية لتخطّيها، قبل أن يعرف أن له حياة وخبرة لم يكن يلتفت إليها بسبب إكراهات هذا الهاتف الذكي الصغير، الذي كان – ودون شعور – يحمل حياته كاملة ويوجّهها الوجهةَ التي يريد.. ففي البداية عانى من صعوبة في إيجاد حيّز له في محيط الحياة. فلم يستطع أن يتعرّف حتى على الوقت، فقد نسي أن يأخذ معه ساعة يد. فالهاتف الذكي هو الذي كان يتكفل بكل ذلك. ولكنْ بمرور الوقت اكتشف أمورا كثيرة لم يكن يشعر بها إطلاقا بسبب الهاتف الذكي، الذي كان قد أودعه كل حياته تقريبا. ولكنْ بانصرام الأيام شعر بأنه يمتلك نفسه وقراراته دون تدخّل قوة هذا الهاتف؛ وبدأ بعد ذلك يحمل معه الهاتف ولكنْ في أوقات محددة. ثم تمكن، في نهاية المطاف، من السيطرة عليه وتحويله إلى آلة طيّعة، بعد أن كان العكس هو الصحيح، أي أنه كان هو آلية طيعة أو عبدا ضعيفا لنزوات هاتفه الذكي.
في حقيقة الأمر – أو هذا ما كان يُفترَض – لم يكن الهاتف سوى وسيلة ساخنة للتواصل مع الآخرين، لكنْ ما جدوى الآخرين وأنت بعيدٌ عن نفسك؟
نرى في وسائل التواصل الساخنة، وخاصة “فيسبوك”، أمورا قد تبدو عجيبة، من قبيل أن تجد أشخاصا يحرصون على إطْلاع “أصدقائهم” (الافتراضيين) على كل خطوة من خطوات حياتهم والحرص على استلام تعليقات منهم أو إشارات. هناك من يسافر ويبدأ في كل خطوة في سفره بإرسال الصور، أولا بأول، فلا تعرف إن كان بالحق مستمتعا أم شقيا.. يُجشّم نفسه عبء الحرص على إرسال كل خطوة من رحلته للآخرين كي “يشاركوه”. وحتى وجبات الطعام، الجلسات التي يُفترَض أنها حميمية وخاصة ودافئة مع عائلته أو أصدقائه، يحرص على أن ينشرها أمام الملأ. إنه لا يضيع الوقت دون أن يجمع عددا وافرا من اللايكات والتعليقات. لو لم يفعل ذلك لذهب اليوم في رأيه سدًى، وكأنه لم يقم بجولة في ذلك النهار، سيفتقده الآخرون. لن يعرفوا عنه كيف قضى ذلك اليوم. كثيرون كذلك حريصون على أن ينشروا كل تفاصيل يومهم أو رواية وكتاب بدأوا في قراءته. هنا سنقف أمام عنوان الكتاب أولا، فتنهال التعليقات واللايكات المشجّعة. ثم سيمضي الوقت مع إيراد فقرات من هذا الكتاب، الذي لن ينتهي دون مشاركة عبر الأثير من حشد وجمهور من البشر، لا أحد يعرف الوضعية التي كانوا فيها لحظة المشاركة. وربما لم ير صاحب الصفحة أو التعليق وجوههم الحية من قبل.
ولكنْ ثمة أمور مهمّة لم نترك لها وقتا للتأمل، وهي أن وسائط التواصل هذه ليست عيونا تعويضية، لسبب بسيط وواضح، هو أن الجمهور البعيد هنا ليس سوى طرف ثالث. فصاحب العلاقة هو الطرف الأول، والوسيط أو الصفحة هي الطرف الثاني، بينما الجمهور البعيد هو الطرف الثالث. ولكي أوضّح هذه الفكرة دعوني أورد بعض الأمثلة. فمثلا، حين قرأت رواية “بقايا اليوم” لكارو إيشي جيرو، الفائز بجائزة نوبل، في صفحات وصفه الساحر للريف البريطاني، شعرت بقوة الكلمات. ولكنّي حين شاهدت الفيلم تحولت إلى طرف ثالث. فلم تستطيع كاميرا الفيلم أن تنقل إليّ الشعور الذي صوّره الكاتب مباشرة بكلماته. لقد صورتْ ذلك تصويرا خاطفا، بينما الكاتب خصّ كل نأمة أو مشهد بوقفة من الوصف والتأمل. كان في الحقيقة ينقل مشاعره كاملة بصدق شديد ويبثّ الكلمات تفاصيل من وجدانه جعلني أرى عبر الكلمات ما لم أستطع ملامسته عبر صورة الكاميرا. وهكذا بالضبط تفعل الصورة. فذلك الشخص الذي يصور وجبة طعامه ثم يرسلها عبر فيسبوك مثلا، هو من يتذوق وحده الوجبة، هو الوسيط الأول المباشر، بينما أنا البعيد – الطرف الثالث – لن ينالني من نصيب من تلك الوجبة سوى صورتها / صورها الباردة. لا يوجد من يصف لي تفاصيل شعوره. رغم أن الأفلام تحاول، عبر الحوار وأداء الممثل، أن تنقل لنا مشاعر الشخصيات، ومن أجل ذلك يبذل فريق عمل كامل جهودا لإيصال المشاهد إلى هذه الحالة؛ كما حدث مع فيلم “المواطن كين”، الذي أنتج في الأربعينات.
إن الفيلم الناجح في الحقيقة يكتسب نجاحه من مدى قدرته على أن يضع جمهوره في قلب الحقيقة، بنبضها الحار، لذلك أُوجدت الجوائز. فأفضل ممثل هو الذي استطاع أن ينقل لنا بمهارة تصرفات المطرب فريدي ميكروري، كما فعل الممثل المصري رامي مالك، أو انفعالات عيدي أمين، كما فعل الممثل الأميركي فوريست ويتاكر. ولكن الصورة الخاصة في “فيسبوك” لا يمكنها أن تفعل ذلك. في هذه الحالة نعود إلى “انتهاك الخصوصية”، التي يسعى الفرد إلى اقترافها في حق نفسه.
والناجحُ من يستطيع أن ينتصر في “حرب الاستقلال” بأقلّ الخسائر الممكنة.