حق وجود الجسد
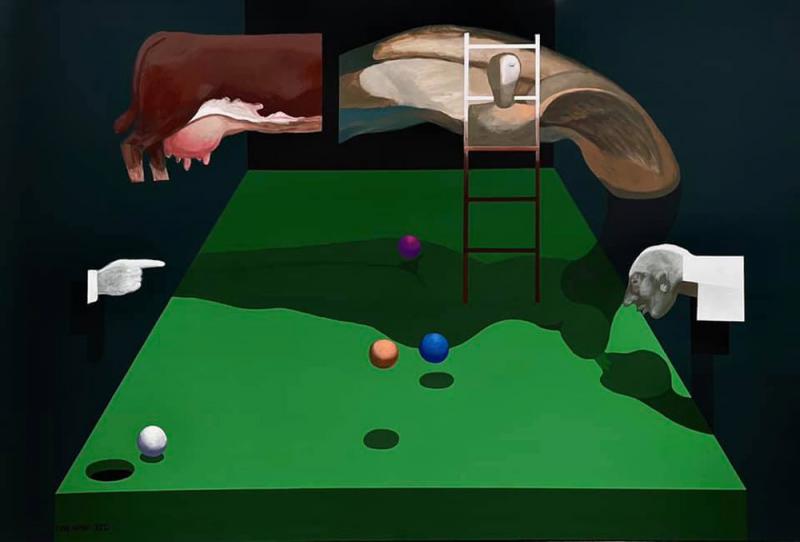
التخيّل فعل إنضاج وتكميل للصور المنشأة من التهويم الافتراضي، ليس بصيغة المرجعية الفلوبيرية (مدام بوفاري، هي أنا، أي صيغة الارتداد التوفيقي، بالبحث عن مرجعية)، بل بصيغة التطلع التكميلي لبناء الصورة النهائية المتكاملة للشيء الذي افترضناه أو افترضنا وجوده بدءاً. وهذا يعني أننا نبدأ التخيل في العقل من أجل النفاذ إلى كنه الأشياء لغرض تكوين افتراضات بناء الصورة الأولى التي تقودنا إلى يقين التكوين النهائي للشيء (أي شيء، بما فيها صور الأفكار) بالتخيل وعن طريقه.
لقد تساءل هوسرل في بدء تأسيسه للظاهراتية: إلى أي مدى يؤثر العقل في ما ندرك؟ وطبعاً هذا التساؤل يكاد يناقض أو يفضح حقيقة انحياز العقل (كأداة ومستودع للتخيّل) في افتراضه (إذا تعلمنا كيف نقرأ رسالة دون تحيّز أو تعصب)، فنحن إذن نحضّر أنفسنا للبدء بقراءة الكون، دون تحيّز أو تعصب، وهذا هو مدخل الفلسفة وواقع الحال يقول إن العقل متحيز في بناء صوره التخيلية/المتخيلة، بسبب عدم تمكنه من التخلص من أثر عقدة ذنب التصورات الدوغمائية المنسوبة إلى نصف الإنسان الجسدي (جسده المضاد للروح أو العقل) والتي لا يملك ولن يملك منها فكاكاً يوماً بالقطع، لأنها جزء من تكوينه الطبيعي، وبالتالي هي جزء من تكوينه التكاملي، وبالتالي يجب أن تؤخذ بحساب البنية التكاملية للعقل أولاً، ولكيان الإنسان الظاهر وبحساب ما ينتجه من بنى متخيلة لافتراضات الأشياء وعلاقاتها وتعالقاتها التي تنتجها فرضياته الأولية أو المبدئية.
واستناداً إلى علم الظواهر، فإن مقولة “لا تقل لي ما هو، بل قل لي ما ترى”، فإن العقل في تكوينه لمدركاته، وبالتالي لوعيه، يعمل على تجميع صوره المتخيلة لطريقة تفسير العالم ونظام الأشياء المحيطة به، والتي تعمل على تعطيل وعيه أو حشره في زاوية التعطل عن الإدراك، وهذه الحالة هي التي تمنعه من نقل ما يرى بخياله (الذهني) من صور الخروج من مأزقه، أو بالأصح هو ما يمنع العقل من إتمامها لكي يصل إلى حالة الخروج المنشودة.
وهذا لا يعني أن وعي العقل يمر بحالات من التعطل أو العجز، بل هذا يعني أن الجزء المكمل لنشاط العقل، نشاط الجسد، بحواسه و”تلقفات مدركاته الحسية” ينشط بطريقة أعلى مطالباً بحصته من “الصفاء” و”الوعي” الحسيين من أجل إكمال دورة نشاطه وإداء دوره في عملية تحريك وإكمال دورة الإنسان ككينونة مكتملة بذاتها.
إن عملية فصل ذات الإنسان وإخراجه كفرد من وحدته الكينونية (بشطره إلى جزأين غير متكافئين: روح وجسد)، ومنح الأهمية والخصوصية والاحترام للروح على حساب الجسد وتحويله إلى كائن متراخٍ وغير قادر على جمع ذاته والسيطرة عليها، ضمن وحدة ذاتية موحدة ومنسجمة وترهيبه بالعقاب من انغماسه في تلبية حاجاته الحسية وشهواته الجسدية، لأنها تُصوّر على أنها طارئة/نجسة أو مقحمة على جسده، بسبب عملية نبذ الجسد، من قبل رؤية الثنائية التي جاءت بها الفلسفة الإغريقية ووجدت، الديانات، (والمسيحية البولصية على وجه الخصوص)، فيها ضالتها، كوسيلة ترهيب وتعنيف وتطهير، وبالتالي وسيلة سيطرة على رعاياها.
ولكن من أي وعي ومدركات قامت فكرة الفصل بين الجسد وذات الإنسان (بمركزها العقلي)؟ وأي ضوابط رؤيوية تلك التي ربطت الجسد بالرذيلة، وكأن الجسد مفصول عن العقل، أو كأنه يتلقى أوامره فعلاً من غرائزه، كما يتصور رجال الإكليروس، من دون تلقي أوامر من الدماغ، تستند لعمليات تخيلية لشكل اللذة ومساراتها عبر أجهزة ثابتة في الجسد، وترتبط بسلسة ارتباطات عصبية تنقل لها الأوامر والمتخيلات من العقل (برمزه العضوي، الدماغ)؟
إن الجسد، بجزئه الحسي، ليس جزءاً مقحماً أو طارئاً على ذات الإنسان، بل هو شكل تمظهره الذي يعرف به، كذات وكينونة وجود، من خلاله وعبر تجسده المظهري، والذي يغيب الإنسان، كذات، بغيابه أو اختفائه أو موته. كما أنه، بهيئة تسييره من قبل العقل، يمثل هوية الإنسان التي تُعرف به كذات قائمة، وتقع عليه مسؤولية تجسيد وجود الكائن، بل وحتى تلقّي العقوبة عنه، في حال إذا ما فكر العقل أو النفس (الذات الداخلية) بارتكاب خطأ أو ذنب يستحق العقاب عليه من قبل قانون المجموع الاجتماعي الذي يعيش داخل منظومته التجمعية الاجتماعية.
******

لا أحد يشك أن الإنسان كائن معذب ومرمي به في عالم من الفوضى غير الخلاقة، ولأنه توفر على العقل والوعي بمصيره القاتم، أخذ على عاتقه مسؤولية خلع نوع من النظام على الفوضى التي قذف فيها، بلا سبب ظاهر أو قادر على إقناعه. وإحساس الإنسان هذا وتقديره، كمصير، قديم ويعود إلى مراحل الفلسفة الأولى (كوعي تام ومنظم)، وكان الاغريق أول من أدرك هذا فاقترحوا عالم الأفكار كبديل للعالم المشوش وغير المنظم، أو الذي تعوزه بداهة الصفاء، ليكون صالحاً لإقامة حياة مقبولة ومقنعة. أما الوجودي هيدجر المحب للشعر، فقد رأى أن الشعر والروح هما البديل لهذا العالم المضطرب.
وبالتأكيد فإن كلا الاقتراحين لم يكونا مناسبين لتأسيس حياة رضية ومقبولة، لأن الإنسان ينطوي على نزعة التطور بالفطرة، وأيضاً على شهوة التغيير، التي يخلّف عدم إشباعها حالة من التوتر والسأم والتعبير عن الاحتجاج.
وعلينا أن نتذكر هنا الأمر الأكثر أهمية، وهو العامل الأكثر تحريضاً ودفعاً باتجاه السأم، وهو أن الحياة عدائية وتعمل على كبت الإنسان ومعاداته، وهذا ما جعله يشعر باليأس، دون وعي كامل، بالنسبة إلى الإنسان غير الفيلسوف، وبوعي وتصميم كاملين باتجاه أسئلة الوجود (الفلسفة الوجودية)، لانطوائها على أسلوب التعبير عن الضيق والاحتجاج… وربما رمي عدائية الحياة بحجر الغضب أيضا.
نحن، كبشر عاديين وفلاسفة، وبعد هذا الكم من قرون الجهد الفلسفي، صرنا نعرف أن الحياة لن تكون خطوطاً مستقيمة وأسطحاً نظيفة، كما تمنى سارتر، وهذا ليس نوعاً من اليأس أو التسليم بسبب الضعف، إنما هو نوع من القراءة المتصابرة لحقيقة المعاينة للحياة: ثمة ما يمنع الإنسان من العيش في دائرة حقوقه، ككيان له حقوقه المكتسبة بحكم الوجود، وجوده هو هنا في هذه الحياة وعلى أرض عالم لا يبالي به، وهو عاجز عن ضبطه أو السيطرة على سر حركته غير المنضبطة، لأسباب عبثية؛ وعندما لجأ الإنسان إلى الفلسفة من أجل تفسيرها وضبطها وجد نفسه موزعاً بين عدة إشكالات، وخاصة فيما يخص التفسير والفهم، وهي التي وضعته في متاهة جديدة من التفسيرات قصيرة النفس والمتضاربة حتى مع أسس الإنسان، كذات وكيان قائم بذاته، لفرط حيرته وحاجته للوصول بنفسه إلى حالة من الاستقرار والصفاء، ولذا لجأ إلى تقسيم كل شيء حوله إلى وحدات، وكل حسب (طقسه النفسي “عقده” النفسية ومناخه الفكري “درجة نضوج وعيه”)، والغريب أنه أوصل هذه التقسيمات إلى كينونته الذاتية التي شطرها إلى جزأين متضادين، روح وجسد، الأمر الذي أوقعه في حيرة أكبر، وفي حالة عجز عن الفهم جديدة ومضافة.
ليس من أحد ينكر أن ثمة ما هو غامض في تركيبة الإنسان، وهو ما دفعه للظن أن ثمة شيئا كبيرا وسريا يسكن جسده، وهو المسؤول عن توجيهه وصلاحه، وهو ما دعاه بالروح. وبتراكم سنوات البحث وتعدد الرؤى حول هذه الروح، لجأ الكثير من الفلاسفة ومنظرو الأديان، إلى شطر الذات الإنسانية إلى قسمين، قسم خير ومتسام، وهو الروح غير المرئية، والقسم الثاني هو الدنس والشهواني والذي تسيطر عليه لوثة النزوع إلى الملذات الحسية، وهو الجسد. والغريب أن الكثير من الفلاسفة ومعظم الأديان قد اتفقت على رؤية أن الإنسان عندما يموت فإنما هو يخسر روحه، وهذه الروح تتحرر من دناءة الجسد، في لحظة الموت، لتصعد إلى السماء أو الملكوت الأعلى.. لتتطهر من رجس الجسد. ولكن جميع الحيوانات والحشرات، بل وحتى الجراثيم المجهرية، تتعرض لصيغة الموت ذاتها، (وتفقد الشيء ذاته في حالة الموت، وهو الروح كما تسميها الأدبيات الدينية، وفعل الوظائف الحيوية التي تحرك الجسد أو تمنحه صفة الحياة، كما سأدعوه أنا، وربما دعاه غيري كذلك من الفلاسفة والعلماء من قبل) سواء بتدخل سبب خارجي في فعل الموت أو إحداثه، أو الموت بسبب المرض أو الشيخوخة، فلِمَ تندثر أرواح الحيوانات والحشرات ولا تصعد إلى الملكوت الأعلى، أو ملكوت خاص بها على الأقل؟ وهذه التساؤلات ليس غرضها التشكيك (لأن الفلسفة قد تجاوزت هذا الأسلوب المباشر منذ عقود) وإنما غرضها العرض والمحاججة العقلية فقط.
من جانب آخر فإن لحظة الموت، ولأشخاص عديدين، قد خالطها بعض الظواهر الغريبة، التي تدلل أن ثمة جانبا روحانيا يخالط لحظة موت بعض الأشخاص، وأغلبها يبدو بشكل اتصال بعض الأفراد بعالم أطياف أو أرواح خارجية، كنوع من التهيئة لموتهم، وقد تسبق هذه التهيئة عند البعض، يوم أو لحظة موته بأيام وأسابيع، ولكن بشكل مدغم ولا يثير الانتباه؛ وكما يورد الفيلسوف الوجودي ألفريد نورث وايتهيد، في كتابه الرمزية: ما أن سجّي ولين بيت، رئيس الوزراء، على فراش الموت، حتى سُمع وهو يدمدم “أيّ أطياف نحن، وأيّ أطياف نتبع”، وجدير بالذكر أن أمثال هذه الحوادث قد رصدت هي وأمثالها، ولكن بالمقابل، فإن أغلب الناس يموتون كالأبقار، كما يقول أرنست همنغواي، فهل يمكننا أن نقبل تلك الحوادث كدليل على أن ما يفقده الجسد في لحظة الموت هو الروح؟ ولكن لم لا تكشف الروح عن نفسها إلا في تلك اللحظات التي لا قيمة لها؟ أين كانت وأصحابها يعانون سنوات ضياعهم ويعيشون وحدتهم وشعور عجزهم التام، في كون خالٍ ومعتم وتعوز أيامه مظاهر الحياة الحقيقية، بل وأيّ مظهر من مظاهر ربتة الروح على كتفه؟
لقد حملت فكرة شطر الذات إلى جزأين أكبر معضلة للإنسان، ألا وهي تذويب حق وجود الذات المستقل، وقد جاء هذا نتيجة لبحث الأديان عن عامل (كبير) يدعم مصداقية فرضيتها في الارتباط المباشر بالذات الإلهية كلية القدرة والهيمنة، ولم يتحقق لها هذا بغير مسخ الإنسان وتقزيم قدراته ونزع إيمانه بذاته ومصادرته، وبالتالي تهميش (جزئه المادي) جسده، لصالح إعلاء قيمة روحه (الجزء غير المرئي، أو الذي لا يدلل على وجوده غير فعل الجسد وحيويته) المؤهلة، لسبب لا يراه الإنسان، للارتباط بالإله.
والنظرة المتفحصة لهذا تظهر لنا أن مُنظريّ الأديان يتناسون أو لا يأبهون لجانب أن الإنسان مُلقى به في وجود أعمى، غليظ، لا يحبه ولا يأبه لآلامه، ويأتي البعض ليصادر (حق الوجود للذات)، بحسب ألدوس هكسلي، وليترك الإنسان وحيداً معوزاً في حياة بائسة، تمعن جميع أدواتها في قهره وتحطيمه، وكأنه دخيل ومقتحم مرفوض لهذا العالم وغير مرغوب فيه، وأيضاً يجب التخلص منه بأسرع وبأبشع طريقة، بل وبما يبدو بصورة الانتقام، تخلصاً من عبئه وسوئه. لم إذن جيء به، ولأي هدف، مادام هو من الوضاعة، التي لا يستحق معها مكافئة له على شقائه في الحياة أكثر من موت وضيع كموت الحمير والأبقار والجراثيم الناقلة والمسببة للأمراض الفتاكة؟
******
لنسلم أن الإنسان وجد ناقصاً في تكوينه، ولنسلم أن عليه أن يمضي حياته في البحث عن فرص كماله، وهذه الافتراضات تسلم بصحتها جميع المؤسسات، وأولها المؤسسة الكهنوتية (في حياة كل مجتمع)، ومن يحتج عليها ويرفض التسليم بها هم صفوة الفلاسفة، غير المستسلمين فقط، بمعنى هم الصفوة التي ترفض فرضية الثنائية الساذجة (وخاصة في جزئها الذي يشطر ذات الإنسان إلى جزأين)، والتي تؤمن بأن الإنسان هو ما وجدنا أنفسنا عليه ككل موحد، وإنه غير مكلف بعمل محدد أو مهمة يؤديها، وكل ما ينتج عنه هو ثمرة عقله واختياره في نزوعه للحرية والكمال. ولكن، وعبر تجربتنا الحياتية، نجد أن “نظام فوضى الحياة” مبني على سلسلة من “قوانين” التثبيط والإحباط، وبالتالي التفشيل المقصودة والغادرة، والتي نهايتها أو ذروتها الموت الرذيل، الذي يبدو للإنسان الناضج العقل والذي يمتلك تفكيراً سليماً، ليس سوى مدة لسان سخرية بمنتهى القسوة والوحشية غير المبررة، بوجهه وامتهاناً جهده في الحياة.
الإنسان، وبعد تحرره من عبودية الخوف الفطري، تمرد على واقعه وقرر العمل، ومما لا شك فيه إنه أنجز وحقق لنفسه الكثير من احتياجاته بهذا العمل، إلا أن هذا الإنجاز، حرره من عبودية الخوف الفطري ليرمي به إلى عبودية الخوف من تراكم منجزه وما رافقه من قوانين مصادرة لحريته من جهة، والمصادرة لوحدة واستقلالية كينونته الذاتية، من جهة ثانية، بعد أن أحاله منجزه إلى عبد للخوف من قسوة منجزه عليه، بعد تحوله إلى ذات أو سلطة متسلطة ومستبدة وقاهرة، وسلمته لضياع جديد أكبر من ضياعه الفطري الذي هرب منه، حتى صار يصرخ مع ت. س. اليوت “أين الحياة التي ضيعناها في العيش؟”، وهذا ما أحال اندفاعه الأول إلى خيبة، وعمّقَ شعوره بالتعاسة وإنه قد خدع وغرر به بلا سبب، وإنه فقد أهم ما كان يطمح إلى امتلاكه: استقلالية وحرية ذاته التي تمثل شخصه المستقل وكيانه الذي تعبث الحياة بإيمانه به وتهدد بإسقاطه باستمرار بلا سبب مقبول؛ وهذا ما أسلمه لحالة من النفور اليائس، والتي لخصها صموئيل بكيت بمقولته الشهيرة “لا شيء يمكن عمله”، وسأزيد عليها مكملاً لمغزاها: في حياة تأبى إلا أن تكون سيئة.
فهل الحياة سيئة فعلاً؟ والإجابة الفلسفية على هذا السؤال، هي إجابة السؤال المضاد: وهل هي ليست سيئة؟ ومن يقول إنها ليست سيئة فعليه أن يثبت ذلك، أما من ناحيتي فسأثبت له أنها بمنتهى السوء لأنها أجبرت المليارات من البشر على العمل في مؤسسات الضرائب والتسجيل العقاري وتسجيل السيارات وإصدار الهويات الشخصية وعقود الزواج… إلخ، ليموت الجميع، في النهاية، ويتركون تلك التفاهات في سجلات أكثر تفاهة… وكل يشعر أنه لم يكن في الحياة لأداء مثل هذه الأعمال التافهة، بل كان يعيش لما هو أسمى وأكبر وأهم…. ما هو؟ أن أكون أنا ذاتي وسيدها الأوحد… وأن أتمتع بحريتي التي لا يحدها شيء أو عمل تافه.
وعند هذه النقطة بالذات، أرى أنه يتعين علينا أن نكون واضحين مع أنفسنا تمام الوضوح، ونقبل ما ذكرنا به الروائي ألدوس هكسلي “إن الذي رآه آدم صبيحة اليوم الأول، من خلقه، هو المعجزة، ثم تدريجياً الوجود العاري”؛ والوجود العاري هنا تعني أننا مطوّح بنا وحيدين، إلا من ذواتنا، وبلا سند، وعلينا الخروج بها، وعبرها إلى الجهة الثانية، التي نتوقع أن تكون أرض نجاتنا، نجاتنا ممّ؟ من عبثية الحياة وتفاهتها. أيتحقق هذا الخروج بالموت؟ كلا بالقطع، بل بالمزيد من الحياة: الحياة الثابتة.
وربما يضعنا هذا أمام المشكلة الأكثر تعقيداً بتناقضها وهي تأرجح الإنسان بين نقيضي إحساسه إنه حيوان ذو هدف، وشعوره أنه كائن محتقر وملقى به في حياة لا تأبه له وتدفعه إلى مصير تافه: الموت والتحول إلى جيفة يهرب من نتانتها الآخرون. لمَ كنت هنا إذن ومن دفع بي إلى هذا المصير غير اللائق؟
******
لقد تخبط الإنسان كثيراً وهو يبحث عن تفسير مقنع لوجوده، وقد أهدر في هذا البحث وقتاً طويلاً جداً، قبل أن يهتدي للبحث العقلي (الفلسفي)؛ إلا أن هذا البحث وجهده المضني، يكاد يكون لم يقدم شيئاً، بسبب تعسفه، في مراحل كثيرة من مسيرته، ضد الإنسان ذاته. بمعنى أن الفلاسفة ذاتهم تخبطوا في بحوثهم وطرق معالجتهم لمجموع الأسئلة التي واجهتهم، وأيضاً بمجموع الرؤى و”الحلول” التي اقترحوها، والتي تخبط بعضها بتقديم مقترحات زادت من المشاكل تفخيماً وتعقيداً، ولعل أولها وأكثرها أثراً هي عملية شطر ذات الإنسان إلى جزأين، كما أسلفنا.
إن ذات الإنسان تتكون من مجموع الوظائف الحيوية اللاإرادية، والتي تمثل وجوده الحيوي الرئيس، ومجموع الوظائف الإرادية التي تمثل أثر وجوده الحيوي وحياته في محيطه الإنساني والمادي، وهي مجموع وسائل إدامة حياته وبقائه حياً، كتناول الطعام وشرب الماء، والسعي لتوفير وسائل الراحة والاستجمام، وأيضاً الحاجة للملبس والسكن، وأخيراً حاجة الجنس، كمتعة وكوسيلة للتكاثر وحفظ النوع، ومجموع هذه الوظائف وأثرها، إرادية وغير إرادية – كفعل – في الحياة، تمثل كينونة الإنسان، الذات، وفعلها الإرادي المستقل، يمثل وجوده وأثره في الوجود، ولأجله وجد.
وقد زاد هذه المشكلة تعقيداً، تنحية الذات الجسدية (الجسد) بكل مظاهرها ووسائل تعبيرها عن نفسها (الحواس والشهوات “الغرائز”) من خارطة وسائل البحث الفلسفي، وتركيز البحث على العقل (اعتبره بعض الفلاسفة هو الروح ذاتها)، باعتبار أن الجسد يمثل الجزء الحيواني أو المادي (ضد الروحي) من كينونة الإنسان، وعليه فيجب إهماله، فلسفياً، وتحقيره دينياً، دون الالتفات إلى قضية أنه يمثل الجزء الظاهر من ذات الإنسان والملموس من كيانه، أو ما يمثل كيانه الظاهر وكينونته التي تمثل وجوده الذي يزول بزوالها.
إن وسائل تعبير الجسد عن أفعاله الإرادية، كما دعوناها آنفاً (حس، شعور، نوازع، هواجس، حدس، غرائز، شهوات…) هي ما وجد الجسد بها وعبّر من خلالها عن نفسه، أما أن تأتي النظم الأخلاقية والإكليروسية لتعبر عن نفسها وعن (سلطاتها) عبره، فهذا لا يعني تحوله إلى مطية خانعة، والدليل بقاء نوازع الإنسان وشهواته قائمة، برغم جميع جهود الرفض والمنع والتقنين التي تعرضت لها، من قبل السلطات الاجتماعية والقانونية والقيمية والدينية، وقد قاومت محاولات القمع، بل وحتى التنظيم، وبعناد ليقول الجسد، بشهواته وملذاته، عبرها: أنا جزء من كيان هذا الفرد الذي يظهر عبري وأمثله، ومن المستحيل محوي أو حتى تقنين متطلباتي، ولعل القائم من حياة البشرية، وخاصة في ظل حضارة الاستهلاك الحالية، خير دليل على ما نقول، وإن من بين الفلاسفة ذاتهم أعدادا كبيرة ممن لم يكتفوا بإشباع احتياجات أجسادهم، بل تفننوا حتى في إشباع الشاذ منها أيضا.
ووفقاً لمبدأ اللذة، والذي تحول إلى رؤية ومنهج فلسفي، في مرحلة من مراحل الفلسفة، فإن تحريم اللذة، باحتقار الجسد ونبذه، قد أثبت أنه عمل جائر وغير منسجم مع طبيعة الإنسان ونظام تكوينه الفسيولوجي والسيكولوجي، لأن نظام قهر الجسد قد أثبت عبثيته حتى في حياة المتصوفة والرهبان، لأنه يورث الكثير من الأمراض العضوية والنفسية. وأرجو أن لا يفهم كلامي هذا على أنه دعوة للإباحية أو شيء من هذا القبيل، إنما هو فقط إشارة إلى حق الجسد في تلبية حاجات دوامه واستقراره وتوازنه، لينشأ ويستمر بصورته الطبيعية التي وجد عليها.
هذا من جهة التوضيح فقط، أما من جهة رؤيتنا لهدف البحث، فإن الجسد هو الكيان الحقيقي لقيام ذات الإنسان المنظورة (على الأقل إلى حين إثبات وجود الروح ككيان ثان يتخلل الجسد) وعليه فإن علينا إعادة الجسد إلى وضعه الطبيعي وإشراكه، كفاعل، إلى جانب العقل واللغة في أدوات البحث الفلسفي، أي عبر الأدوات التي ترتبط به، كالاستشعار الحسي والإدراك الحسي – النفسي وإعادة ربط مصير الإنسان، في نهايته القصوى، بالأرض بصفتها موضع قدميه (المادي والروحي) الأوحد، وأيضاً إنماء روح الفردية في الإنسان ضد شعور الخطيئة والخطأ المحبط، الذي بني على عقيدة تحقير الجسد ونبذه، كموضع للخطيئة وبيت للشيطان ونزعاته ونزواته وأحابيله.
إذن للجسد وعيه الخاص، عبر شعوره أو تأثره بحواسه، انسجاماً مع رؤية سارتر (ليس هناك ذات سامية، إنما هناك شعور)، وعليه فإن الجسد يمارس دوره عبر (وعيه الخاص) أو عبر أدواته الخاصة التي تخضع لتوجيه العقل بطريقة من الطرق، أو عبر كيانيته وتفاعليته الحسية والشعورية، بطريقة غير مباشرة، على اعتبار، وفي حدود الحواس، إن شعوراً يتبع حالة تفاعل وإشباع حاسة من الحواس بالضرورة، في حالة تلبية متطلب حسي يطلبه الجسد في دورة حياته، أو دورة حياة الكائن الذي يمثله.
والغريب أن يهمل الإنسان، فيلسوفاً وغيره، حقيقة أن العقل (كجزء من عضو الدماغ) هو جزء وعضو في منظومة الجسد، وعليه فلمَ نترك الجسد الذي بين أيدينا ونعرفه، لنهرب إلى مجهول الميتافيزيقيا، التي نهوم حولها دون دليل قاطع، أو حتى منظور استشعاريّ على موجوداتها ووجودها؟
وعليه، وضد رؤية، الفيلسوف ألفريد نورث وايتهيد، نقول الجسد ليس ذاتاً عارضة، تحت أي حساب، إنما هو، وبما يحتويه من عناصر، الذات الأصيلة التي يجب أن نتعامل عبرها مع العالم والوجود، ككينونة وهوية للإنسان، وكذلك يجب أن تكون وسيلة البحث الفلسفي للذات الإنسانية، متضمنة العقل وإدراكاته.
****

“ضع السيارة بعيداً، حين تفشل الحياة”، بيت الشعر هذا للشاعر أودن، ورغم أنه عبّر فيه عن حالة شعورية، في لحظة زمنية محددة في ظرفها السيكولوجي، إلا أنها تعبر عن حالة الفراغ التي يصلها الإنسان عندما يصل حالة يأس العجز عن الوصول إلى إجابات قاطعة، أو إدراكات مباشرة ومهيمنة تبلغ حد الإقناع على أسئلته وحيرته.. وهو يبحث لنفسه عن مخرج من ضيقه، فشله، شعوره بالعجز، شعوره باللاهدفية، شعوره بالتفاهة، وشعوره أنه مخدوع وملقى به في مكان لا يحتاجه ولا يهتم لأمره، وإلى حد أن يترك (السيارة… وقدميه بعيداً) ليصرخ معلناً، بل ضاجاً بفشله وفشل الحياة كلها، وأن لا طريق “لا من أمام ولا من خلف ولا من حول” كما قال هنري باربوس في روايته الجحيم.. فهل الحياة فاشلة أو تفشل فعلاً؟ نعم، إذا عُطل الإنسان وطاقاته بسبب سوء الفهم أو عدم الفهم، أو بسبب لؤم مصالح المؤسسات الطبقية، أو بسبب عجز الفلسفة عن الوصول بها إلى مكان مضيء، على أقل تقدير.
هل عشنا ونعيش مراحل فشل للحياة؟
لقد فشلت الفلسفة، وبعدها فشل العلم، رغم ضخامة منجزه عن الإجابة على أسئلة الإنسان الوجودية فسقطت الحياة… في الفشل.
فشلت الحياة ومازالت تفشل، إلى حد أن نضع (السيارة) وأقدامنا بعيداً وأن نقول أن ثمة خطأ في مكان ما… ويجب أن نحدده. وفشلت الفلسفة عن تحديده، وأيضاً فشل العلم بطريقته الخاصة، وربما (العلمية) إذ “برهن العلم للإنسان أنه مجرد صدفة حياتية يعيش في كوكب من الدرجة الرابعة، ويخبره التأريخ أن السقوط قادم لا محالة، وأن حضارتنا لن تنجو من المصير الكئيب الذي أصاب مئات الحضارات السابقة.. ويأتي الأدب ليقول له إن الاختلال العصبي هو مصير إنساننا الذي يعيش في هذا العصر، وإن الهزيمة لا مفر منها، بشكل أو بآخر، وأخيراً يأتي علم النفس ليسخر منه، ويؤكد له أن الثقافة سطحية، يكمن في داخلها إنسان بدائي، يتحين الفرصة للانقضاض والسيطرة” كما يقول كولن ولسن، في كتابه “الوجودية الجديدة” فهل هذا كل شيء؟ لماذا؟
المشكلة في الفلسفة وانقساماتها، بحسب وجهات رؤى وتوجهات أمزجة المتفلسفين (أقصد بالمتفلسفين من اتخذوا الفلسفة وسيلة لتحقيق غرض مصلحي، كالشهرة أو المصلحة المادية). ورغم أن هذا القول يبدو متسرعاً أو مجحفاً، لعدم دقته وإخلاصه لجهد الفلسفة المتراكم، إلا أنه لا يجانب الحقيقة أيضاً، لأن قسما من الفلسفات المعاصرة وضعها أصحابها طمعاً في التميز وحب الظهور، تحت شعار خالف تعرف، أو بدوافع أيديولوجية سلطوية دفعت إليها ومولتها السلطات السياسية والمخابراتية، لأغراض وأهداف سياسية صرفة.
ثمة الكثير الذي فرض على الفلسفة؛ كل من عجز عن إيجاد إجابة مباشرة على أسئلتها، لجأ إلى التجريد وتعقيد ما وجد منجزاً من قبله، بإغراقه بتفسيرات وقراءات لا تخدم بشيء سوى تفخيم اسم صاحبها، ليقال عنه إنه فيلسوف عميق.. عميق بماذا وهو عجز عن الإجابة على أسئلة الفلسفة بلغة مفهومة ويسهل تلقيها وتداولها؟ من قال إن الفلسفة شبكة من الأنفاق المعتمة التي تدور حول نفسها، لتصل في النهاية إلى جدار خرساني أصم؟
قسمت الفلسفة ذات الإنسان إلى جسد وروح، ونسجت حول كل منهما شبكة من الافتراضات والمفاهيم المعقدة والمتداخلة، هل ساعد هذا في فهم الإنسان لنفسه؟ مازال الإنسان يضج صارخاً شاكياً، يوماً بعد يوم، وجيلاً بعد جيل، وحقبة بعد حقبة، من عدم فهمه لنفسه ولا لعلاقته مع العلم والحياة من حوله: لا أملك سوى جسدي المهدد هذا، الذي لا يمكنه الصمود أمام عضة كلبة أو طعنة مدية أو إصابة طلق ناري بحجم أظفر إصبعي.. المرض يهدد بافتراسي في أي لحظة… وفي نهاية نفق الحياة موتي محقق ولا راد له، وفي أغلب الأحيان يأتي عقب مرض ممض يستهلكني بطريقة منفرة.. إن كان لي روح وهي أفضل من جسدي، وهي المؤهلة للارتقاء والتعامل مع الذات الكريمة التي خلقت أو تدير الكون، فلمَ لا تساهم في إنقاذي من عبء ولوثة المرض، أو على الأقل، لمَ لا تفر هاربة لتنقذني (من أنا من دونها؟) من الألم، أو تنقذ نفسها… (من هي من دوني، إن كنت أنا من دونها محض جسد، يتحول بعد إزهاقها مني – كجسد – إلى مجرد جيفة متعفنة)؟
حواس الجسد وغرائزه وشهواته هي أدواته الأصيلة التي وجدت معه، وليست عادات أو وسائل مكتسبة، وعليه فإنها جزء منه ويجب أن تشارك ذات الإنسان في تفسير العالم والحياة، عبرها ومن خلالها..، بمعنى أن تقف مع العقل وتشاركه بتلقفاتها للمدركات، وأيضاً في تحليلها، وفق ردود أفعال تلقيها.
الإنسان كذات (كينونة تتمثل في الجسد) ليس وعياً سلبياً، وإن لم يكن وعياً إيجابياً، كما افترضت الأديان والفلسفات، (إلى حد ما قبل سبينوزا والفلسفة الوجودية، فيما بعد)، فهو وعي طبيعي خام، لا بد من أن يؤدي دوره في بناء فكرة التصنيف لصورة الوعي العام، وبالتالي دوره في بناء التصور النهائي لوجود الإنسان ودوره في الوجود، وبطريقة تكاملية، وليس تكميلية، وهذا ما سنحاول محايثته أو بحثه في ورقة أخرى.




