روجر ألن: حِكايتي العربية

روجر ألن من أهم المستعربين الأميركيين المعاصرين. أرتبط اسمه بترجمات ناجحة لعدد من الروايات العربية من بينها روايات نجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وحنان الشيخ وأحمد توفيق، فضلا عن إسهامه في إثراء المكتبة ألنقدية الأميركية بكتب ودراسات عن الأدب العربي الحديث، والكتابة السردية على نحو خاص. كما عرفناه أستاذا جامعيا مرموقا في جامعة ب. بفيلاديلفيا في ولاية بنسيلفانيا حيث اشتغل لنصف قرن تقريبا على التعريف بالأدب وألنقد العربيين، وفي خدمة اللغة والثقافة العربيتين أيضا.
وبعد مشوار حافل، أحيل على المعاش مؤخرا. ولا شك أنه يستعيد اليوم ببعض الرضا عن ألنفس مسارا من العطاء والحضور والأداء الفكري والجامعي منذ أن التقى الدكتور مصطفى بدوي في جامعة أكسفورد، وتحققت له الدهشة باللغة العربية وآدابها وثقافتها الغنية وعالمها الواسع، ثم بدايات مسار الدكتوراه بدراسته لكتاب “حديث عيسى بن هشام” لمحمد المويلحي، وصولا إلى التحاقه بالعمل الجامعي في بنسيلفانيا حيث دَرّسَ ووجّه وأشرف على مسارات العديد من الدارسين والباحثين المستعربين خلال سنوات عطائه الغزيز محاضراً ومدرّسا ومشرفاً.
روجر ألن هو الشخص ذاته الذي تعرفت إليه وأنا في المغرب إلى أن التحقت بجامعة بنسيلفانيا كأستاذ وطالب في القسم نفسه الذي كان يرأسه ويحاضر فيه. بشوش، مرح، يتّسم بالجدّية المفرطة للبريطاني. لكنه خدوم ومتعاون ومحب للآخرين.
هذا الحوار نسافر معه عبر تجربته المديدة ميمّمين شطر جانب من مساره الأدبي والعلمي، ورؤيته الفكرية وألنقدية وإسهامه الكبير في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.
الجديد: هل تسمح لي أن أبدأ هذا الحوار بالسؤال عن خلفيتك العائلية؟
روجر ألن: ولدت في مدينة صغيرة في “ديفون” (ولاية في جنوب إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية)، لكنّني قضّيتُ سنوات الشباب في مدينة “بريستول”، وكانت عائلتا أبي وأمي تسكنان فيها منذ وقت طويل. أنا الابن الوحيد لوالديّ، وكنت هناك طالبا في المدرسة الابتدائية وفي الثانوية أيضا، وتخصّصتُ في اللغات اللاتينية والإغريقية العتيقة، وكان أملي (وآمال مدرسيّ وعائلتي على العموم) أن أستمر في هذه الدراسات كأول عضو في العائلة كان سيدرس في الجامعة، ويجتاز المرحلة الجامعية.
الجديد: أعرف أنك عازف للبيانو والأرغن، هلاّ حدّثتنا عن ذلك؟
روجر ألن: بدأت الدراسة الجدية للبيانو في سنة 1954، وذلك بعد فترةٍ قضيتُها في المستشفى (بسبب مرض شلل الأطفال الذي أصبتُ به لمدة ثلاثة أشهر، ولكن دون آثار مستمرة، ولله الشكر!) علماً أن بيتنا كان ملآنا بالموسيقى من قبل لأن أمي كانت راقصة باليه ومدرّسة لهذا الفن. وبعد سنتين من بدايتي دراسة البيانو، اقترح مدرسي أن أضيف الأرغن إلى البيانو فدرست الأرغن كذلك وعزفت الآلة كثيرا أثناء فترة الدراسة في كنائس كليات جامعة أكسفورد، وأصبحت فيما بعد مدير الموسيقى والكورال في الكاتدرائية في القاهرة (أثناء بحوثي هناك في سنوات 1966 و1970 و1971 و1975)، وكذلك بعد وصولي إلى فيلادلفيا صرتُ مدير الكورال وعازف الأرغن في الكنيسة الأسقفية (القديسة مريم) على حرم جامعة بنسيلفانيا من 1974 إلى 2000.
الجديد: كيف انتقلت من بريطانيا الى أميركا؟
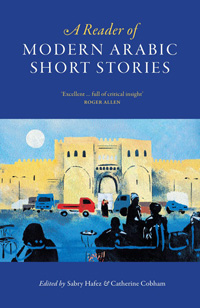
روجر ألن: كانت مناقشة أطروحتي لنيل شهادة الدكتوراه في أكسفورد في سنة 1968 فرصة، وكان الأستاذان المشهوران جدا، ألبيرت حوراني وبيير كاكيا مشتركَيْن فيها. وبعد نهاية المناقشة (وبنجاح، والحمد لله!)، ركبتُ سيارة ألبيرت حوراني في العودة إلى كليّتي. وأثناء السفر أخبرني عن منصب جديد أعلن عنه في جامعة بنسيلفانيا واقترح عليّ أن أكاتب المسؤولين هناك بخصوصه، وأن أقدّم أوراقي. وهكذا، أجبتُ عن اقتراحه وأرسلت أوراقي إلى المسؤولين في فيلادلفيا. وبعد بضعة أسابيع استلمت تليغراما يخبرني بأنني حصلت على المنصب وأن مدير المركز لدراسة الشرق الأوسط في فيلادلفيا سيزور أكسفورد بعد بضعة أسابيع! فقابلت الأستاذ توماس نعاف، مدير المركز، للمرة الأولى في بيت الأستاذ ريشارد فالزر الذي دعانا كلنا إلى بيته للعشاء في ضواحي أكسفورد. بعد ذلك بأسابيع قليلة فقط، عبرتُ المحيط الأطلنطي منتصف شهر أغسطس سنة 1968 (بعد الحصول على الدكتوراه بأقل من شهر) ووصلت إلى “مدينة الحب الأخوي” وأنا لا أعرف الكثير أو القليل عن المدينة أو المجتمع الأميركي أو النظام الجامعي في أميركا. ومن المعلوم أنه كان عليّ أن أتعلم الكثير وبسرعة وفي أكثر من مجال (ومن المهم جدا أن أشير هنا إلى أن هذه الفترة كانت تضجُّ بمظاهرات عنيفة بسبب الحرب في فيتنام، فكان الجو العام في حرم كل كلية وجامعة أميركية مختلفا تماما عمّا كان عليه في الجامعات الإنجليزية التي تخرجت منها!).
الجديد: وكيف كان اختيارك للعربية لغةً وتخصصا؟
روجر ألن: كما أشرتُ من قبل، في البداية كنت أركزّ على الدراسات الـ”كلاسيكية”، اللغتان اللاتينية والإغريقية. وحصلت على منحة من الحكومة البريطانية للقيام بهذه الدراسات في جامعة أكسفورد سنة 1961. ولكن بعد بضعة أشهر فقط مللت تلك الدراسات وبدأت البحث عن بديل لها. والحق يقال، اخترت اللغة العربية دون أيّ معرفة سابقة بها وبثقافتها وبتاريخها، وذلك كنوع من أفق التجريب فقط (وهذا في صيف 1962)، ولكن في خريف 1963 وصل إلى جامعة أكسفورد الدكتور محمد مصطفى بدوي فبدوت مبتهجا جدّا باختياري!
الجديد: وكيف كان سفرك في هذه اللغة بكل خلفياتها اللسانية والثقافية والحضارية؟
روجر ألن: كما أشرت إليه من قبل، بدأتُ دراساتي للغة في سنة 1962. وكانت من المقتضيات للحصول على البكالوريوس في الدراسات العربية قراءة عدة نصوص مهمة من تراث العرب والإسلام ومنها القرآن وصحيح البخاري ومقدمة ابن خلدون وبعض المعلقات ومختارات من الشعر العباسي ورسائل الجاحظ. ولكن كانت أمثلة من النصوص الأدبية الحديثة غائبة تماما إلا لمن اختار من الطلاب “موضوعاً خاصاً” للامتحانات النهائية، ألا وهو “الأدب الحديث”. (وكان من بين النصوص المختارة للقراءة آثار جبران والمنفلوطي وشوقي). وبعد وصول الدكتور بدوي إلى الجامعة، كنت أول طالب اختار هذا المنهج ليس للحصول على شهادة البكالوريوس فحسب بل للحصول على الدكتوراه. فقضيت ثلاث سنوات في القيام بالبحوث في أكسفورد وفي القاهرة (1966 – 1967) وأنا أركز نشاطاتي على عمل محمد المويلحي المشهور جدا “حديث عيسى بن هشام” الذي كتبت دراسة تحليلية له وترجمت الجزء الأول منه إلى اللغة الإنجليزية. وفي سنة 1968 حصلتُ على أول دكتوراه في الأدب العربي الحديث في تاريخ جامعة أكسفورد (لأن الموضوع نفسه كان جديدا تماما). وإثر حصولي على الشهادة هاجرت إلى أميركا فقد بدا المستقبل مفتوحا أمامي وإنْ كانت تلك الفترة لم تزل غامضة إلى حد بعيد.
الجديد: هل لي أن أعرف كيف تتلقى شخصيا المعجم العربي، وهو معجم له تاريخ من الاستعمالات، خصوصا الاستعمال الديني؟ ونحن نعرف أن اللغة العربية لدى العربي تكتسي طابعا مقدسا باعتبارها لغة القرآن والحديث النبوي.
روجر ألن: من المعلوم أن نزول القرآن كان له تأثير واسع النطاق على اللغة العربية، وفي الوقت نفسه كان المرحلة البدائية في حركة جمع وبحث وتطور تراث تعليمي وأدبي وثقافي، والتي كان لها تأثير عظيم ليس على العالم العربي والإسلامي فحسب بل على كل الثقافات العالمية (والغربية الأوروبية أثناء العصور الوسطى عن طريق الأندلس بوجه الخصوص). وكان من مقتضيات الوضع عند النزول البحث في أصول اللغة، ولهذا السبب العودة إلى العصر السابق للنزول الذي كان مصدر أمثلة الإبداع العربي (الشفهي منه خاصة، والشعر الجاهلي وسجع الكهان) التي وفّرتْ للمهتمين بتفسير “مُشكل” القرآن ذخيرةً نفيسةً للغة في مراحلها القَبْل إسلامية (وهنا أفضل أن أجتنب استعمال مصطلح “الجاهلية” الذي أعتقد أنه غير مناسب في أيّ محاولة تريد أن تصف تلك الفترة بدقة). وفي عصرنا هذا، ساعدنا كثيرا التطور المرموق في البحوث في علم اللغويات (النظرية منها والتطبيقية) في قيام المهتمين بعدة بحوث في المستويات الكثيرة للغة العربية (بين القطبين التقليديين، الفصحى والدارجة – العامية) ومنها في دراسة التراث السردي للعرب في صيغة السير الشعبية الكثيرة وطرائق أدائها في المجتمعات العربية المختلفة (من المحيط إلى الخليج).

وفي جامعة بنسيلفانيا، كنت قد شاركت في مشروع يُعدُّ قواميس للغات العربية الدارجة (العراقية منها منشور عند مطبعة جورج تاون، والمغربية والمصرية في مرحلة الإعداد).
وبالإضافة إلى ذلك كنا قد بدأنا مشروعاً آخر لإعداد قاموس تاريخي للغة العربية، ولكن من الواضح أن مشروعاً من هذا النوع يتطلب وقتا طويلا واشتراك الكثير من الزملاء المهتمين بتاريخ تطور هذه اللغة المهمة غاية الأهمية عبر القرون.
الجديد: لماذا اخترت الاشتغال على الذاكرة السردية وليس على الشعر باعتباره جنساً أساسيا مميّزاً للهوية العربية؟ كيف كانت محددات هذا الاختيار؟
روجر ألن: أشرت من قبل إلى النصوص التي كان علينا قراءتها وإعدادها للامتحانات النهائية في جامعة أكسفورد. فمنها ما جذب اهتمامي أكثر من الأخرى، كانت المقامات وما يمكن أن نسميه “بالمقامة الحديثة”، ألا وهي “حديث عيسى بن هشام” للمويلحي الذي أصبح فيما بعد موضوع أطروحتي للدكتوراه.
وأثناء فترة البحث التي قضيتها في القاهرة في سنتي 1966 – 1967، بدأت قراءة بعض النصوص السردية المعاصرة من جيل الستينات، الروايات والقصص القصيرة بالخصوص، ترجمت بعضها إلى الإنجليزية “كمشروع معاصر” إلى جانب اهتمامي بالمشروع الأصعب بكثير، وهو ترجمة أثر المويلحي بسجعه وتعقداته الأسلوبية الأخرى إلى الإنجليزية كذلك.
وإن اهتممتُ إلى حد ما أثناء حياتي الأكاديمية بالتراث الشعري للعرب (كتبت عنه بالتفصيل في كتابي “تراث العرب الأدبي” وكان من الواجب عليّ طبعا أن أدرّس أمثلة للشعر العربي لأجيال الطلاب). الحق يقال إنني بقيتُ أفضّل دائما التركيز على الأجناس السردية (ولأني أدرّسها أيضا في برنامج الأدب المقارن في الجامعة، يمكن أن أضيف: وفي أيّ لغة وأيّ ثقافة عالمية).
الجديد: ترجمت العديد من الأعمال العربية من المشرق والمغرب العربيين. وبعد كل هذا التراكم، وبعد صحبتك الطويلة للنصوص العربية المختلفة، كيف يمكنك اليوم تثمين المتن العربي ورسم أهم ملامحه التي يمكنها تشكيل نواة صلبة ما لهويته؟
روجر ألن: في أواسط السبعينات من القرن الماضي أعددت سلسلة محاضرات عن “الرواية العربية” التي ألقيتها للمرة الأولى في جامعة مانشستر الإنجليزية. وأصبحت هذه المحاضرات أساس كتابي “الرواية العربية” الذي نشرته في طبعة أولى سنة 1982 وطبعة ثانية سنة 1995 (وتُرجمت الطبعتان إلى العربية). وأشير هنا إلى هذه التفاصيل لأنني أعتقد أنّ التطورات في الأنواع العربية السردية بلغت الآن إلى مستويات الامتياز والتنوع (في نفس الوقت) حتى أصبح من المستحيل أن يفكر أيّ متخصص مثلي في القيام بمثل هذا المشروع مرةً ثالثة. ومن الممكن في هذا السياق أن نبدأ باتّساع الحركات الإبداعية (ودور النشر) في الخليج العربي مثلا (والروايات المنشورة التي فازت بجوائز أدبية عالمية) كذلك الشأن في بعض المناطق العربية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك هناك ازدياد واضح وملموس في اللجوء إلى بعض الأجناس التحتية، التاريخية منها مثلا، وفي كتابات الكاتبات (النسوية منها وغير النسوية) وعلى وجه الخصوص، ازدهار عدة تجارب في إبداع أشكال جديدة للرواية (والسيرة الذاتية كذلك) وأساليبها.. الخ.
وإذا كانت للرواية العربية هذه الصفات العامة والمستمرة في تطوراتها، فمن أكثر العوامل المثيرة للاهتمام والعجب الآن في هذا الميدان وجود خصوصيات فنية في كل منطقة تحتية عربية توفّر للقارئ صورة حية للعالم العربي بكل تنوعاته الثقافية والاجتماعية والسياسية.
الجديد: ضمن اهتماماتك المتعددة بالكاتب العربي المصري الكبير نجيب محفوظ (جائزة نوبل للآداب 1988) الذي أثّر تأثيراً بالغا في الأدب الحديث، إذ ترجمت نصوصه الإبداعية، واشتغلت عليها نقدا ودراسة، مثلما اقتربت منه ككاتب وإنسان. كيف يمكنك استعادته اليوم بعد رحيله؟
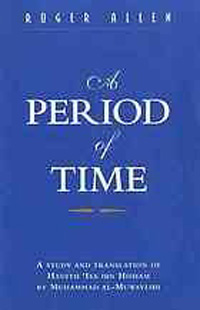
روجر ألن: بعد موت نجيب محفوظ – رحمه الله – أخبرني مسؤولو مطبعة الجامعة الأميركية في القاهرة بأنهم يرغبون في إكمال مشروع قاموا به منذ وقت طويل، وهو ترجمة كل آثار الفائز العربي الوحيد بجائزة نوبل إلى اللغة الإنجليزية. وكنت آنذاك أترجم إلى الإنجليزية روايته “خان الخليلي” والأرجح أنها أول رواياته “الحديثة” (1945؟). وفي سنة 2006 طلبوا مني أن أقوم بترجمة رواية أخرى، “الباقي من الزمن ساعة” (1982). وأذكر هذه التفاصيل الشخصية هنا لأني أدركت فورا أثناء عملية ترجمة الرواية الثانية مدى التطورات والتغيرات التي قام بها محفوظ طوال حياته الإبداعية. وفي هذا السياق يمكن القول – على الأقل في رأيي المتواضع – إن محفوظ أكمل وأنهى برواياته المنشورة في الأربعينات (فعلا حتى نشره “الثلاثية” المشهورة في 1956 و1957، والتي أكملها قبل ثورة 1952) الفترة الابتدائية للرواية العربية (والتي بدأت في القرن التاسع عشر). وكان فوزه بجائزة نوبل إشارة تتويجية لدوره التأسيسي المهم غاية الأهمية. وفي الستينات وحتى موته اشترك محفوظ في كثير من التجارب السردية (بادئا من “أولاد حارتنا” سنة 1959) مع زملائه الكثيرين، المصريين وغير المصريين، في عملية واسعة النطاق لاكتشاف مواضيع ونواح فنية وأساليب جديدة للتعبير عن واقع مصر والعالم العربي عامة في العصر ما بعد الكولونيالي، وبعد نكسة 1967. ومن المعلوم أيضا أنه ساعد كثيرا من الكتاب المصريين من الجيل الجديد في هذه الأبحاث الخلاقة وتبناهم، وعلى وجه الخصوص كل من جمال الغيطاني ويوسف القعيد.
الجديد: انشغلت من الناحية الأدبية بتجربتنا الروائية العربية. ولا شك أنك لاحظت تفاعلها مع تقنيات الكتابة السردية الغربية، خصوصا منها الأميركية والبريطانية والروسية والفرنسية. ولَعلّك لمستَ عن كثب أنواعا من الابتكارات التقنية والجمالية التي استحدثها الروائيون العرب أنفسهم، وبالأخص تلك التي استلهموها من التراث السردي العربي القديم (ألف ليلة وليلة، المقامات والرحلات على سبيل المثال لا الحصر).
روجر ألن: حتى وإنْ كانت بدايات جنس الرواية داخل الثقافات الأوروبية، لكان من المهم في الوقت نفسه الإشارة إلى الدور المركزي لآثار سردية مهمة أخرى في مسارات هذا التطور، إما على هوامش القارة الأوروبية أو حتى خارجها تماما (“دون كيخوتي” مثلا وتأثير المؤلفات السردية العربية الأندلسية المباشر عليه، وكذا “ألف ليلة وليلة” التي لعبت دورا مهما في توسيع فكرة السرد وأنواعه المختلفة وشعبيتها المتزايدة أثناء مراحل تطور الرواية البدائية). أما الآن فأصبحت الرواية نوعا أدبيا عالميا، الإفريقي منها والآسيوي والأميركي – اللاتيني.. إلخ. إلى جانب التراث الأوروبي والأميركي. وطبعاً، لكل تراث روائي عالمي صفاته العامة وصفاته الخاصة المحلية المختلفة. ففي سياق أيّ بحث في هذا الموضوع بالضبط، أفضّل تعديل الرأي التقليدي الذي يتركز على الأصول الغربية لجنس الرواية، وذلك لسببين: أولا التأثير الواضح لعدة مصادر غير أوروبية في عملية تطوير نوع أدبي معقد مثل الرواية، وثانيا الاختلافات المرموقة في طرق تطور الرواية في الثقافات العالمية المختلفة التي تزدهر الرواية فيها الآن.
الجديد: تبقى “ألف ليلة وليلة” أو “الحكايات العربية” كما تسمى عند الغربيين، أفضل وأهم تعبير عن تجذر الحضور السردي والحكائي في الذاكرة الثقافية العربية. كيف قرأتَ هذا النص وتفاعلتَ معه؟ وكيف تنظر إلى الطرائق التي تمثّل بها القراء الغربيون هذا النص العظيم؟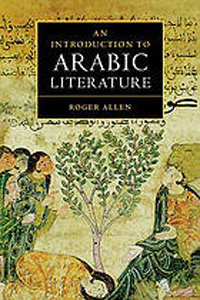
روجر ألن: بدأت الإجابة على هذا السؤال من قبل. وهنا يجب علينا أن نواجه مشكلة أساسية فيما يخص هذه المصادر العربية السردية. وأساس المشكلة هو في الإهمال حتى التام لها عند النقاد والأخصائيين” في الأدب العربي أثناء القرون السابقة للعصر الحديث (بسبب المواقف المعروفة بالنسبة إلى المستويات اللغوية غير الفصحى). من أهم التطورات في هذا الميدان في العصر الحديث التغير في هذه المواقف وتطور البحوث في علم اللغويات، النظرية منها والتطبيقية، والـ”فولكلور” واهتمام المهتمين بهذا الموضوع بالبعد الشفهي لتراث السير الشعبية العربية عامة (وبكل تنوعاتها) وبأدوار الحكواتيين و”الحَلايْقيّة” (صناع الفرجة في الساحات العامة)، وجمهور المستمعين في تلقي أدائها.
وفي كتابي “تراث العرب الأدبي” أو “مقدمة للأدب العربي” (مطبعة جامعة كمبردج)، حاولت أن أجيب عن هذا الوضع بإدماج فصل كامل عن الأجناس السردية الشعبية في بحثي عن تراث العرب الحكائي، ليس لأنها مهمة في حد ذاتها فحسب بل لأن هذا التراث السردي الشعبي قد توفّر ولا يزال يوفّر لمؤلفي الروايات والقصص (والمسرح أيضا) أمثلة عديدة لشخصيات وأساليب وحبكات قد أدمجها كثيرون (وكثيرات) منهم داخل كتاباتهم المعاصرة.
الجديد: ضمن ترجمتك لعدة روايات عربية، أوليت بعضا من اهتمامك للنص الروائي المغاربي، وأشير بالخصوص إلى ترجمتك للكوني وحميش والتوفيق ونجمي، ودون شك، هناك سمات مشتركة على مستوى التخيل الروائي المغاربي والمشرقي، لكني أعتقد أن هناك جملة من العناصر التي تميز النص المغاربي نظرا لوجود خصوصيات تاريخية وثقافية واجتماعية أيضا. ويهمني بهذا الصدد أن أعرف طبيعة ائتلاف التجربتين المغاربية والمشرقية واختلافهما في نظرك.
روجر ألن: لقد قررت أن أركز اهتمامي في ميدانَيْ البحث والترجمة على مؤلفات الكتاب المغاربة قبل أكثر من عقدين وكان السبب الرئيسي علاقاتي الأكاديمية الزائدة بالزملاء الأوروبيين (وبوجه الخصوص مشروع اسمه “ذاكرة المتوسط” حيث اجتمع المشتركون فيه في مدينة طليطلة الأندلسية وقاموا بترجمة عدة أمثلة للسير الذاتية العربية إلى لغات أوروبا الكثيرة والمختلفة. فأدركتُ، وأنا أشترك معهم في هذه المبادرات وفي مناقشات عديدة في أغراض البحث والتدريس والترجمة، أن الأخصائيين في الجامعات والمعاهد الغربية الأوروبيين منهم والأميركيين، وعن وعي أو عن غير وعي، ولأسباب أغلبها عملية (يعني تمويلية)، أنهم في واقع الأمر قد قسّموا إنتاج العرب الأدبي في العصر الحديث حسب أنماط الاستعمار وحسب وجود (أو عدم وجود) معاهد أجنبية في عواصم البلدان العربية (ومن المعلوم أن القاهرة هي الأهمّ في هذا الميدان دون منافس). فبعد سنوات عديدة ركزت فيها اهتمامي (مثل زملاء كثيرين) على مصر وأدب كتابها، قررت أن “أنقل” اهتمامي إلى المغرب وانضممتُ بذلك إلى فرقة زملائي الفرنسيين والإسبان الذين ركّزوا في بحوثهم على إنتاج المغرب الأدبي منذ وقت طويل.

ومما لاحظت، إثر وصولي إلى البلاد (وكانت الظاهرة الأكثر وضوحا) السيطرة المستمرة للغة والثقافة الفرنسية في الميدان العام وفي عالم الأدب خاصة. فإذا لم تكن هذه الظاهرة مفاجأة تامة بالنسبة إليّ، كان مداها مثيراً للاهتمام والعجب. فمن النتائج الإيجابية لهذا الوضع الثقافي مستوى التعليم العالي الذي يتمتع به كثير من الكتاب المغاربة ومعرفتهم واهتمامهم بالحركات الأدبية المبدعة على المستوى العالمي وفي المناطق العربية الأخرى (وهنا يختلفون عن إخوتهم المصريين الذين لا يهتم أكثرهم بمنشورات الكتّاب في المناطق العربية الأخرى بالمستوى نفسِه).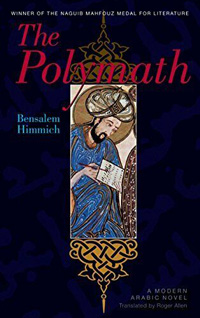
وفي اهتمامي بالثقافة المغاربية خاصة، لاحظت كذلك فرقاً ملحوظاً في مواقف الناس من التاريخ ودوره المركزي في تأسيس الهوية الشخصية والوطنية. وأشرت أعلاه إلى الحضور المستمر لآثار الاستعمار الفرنسي في البلاد – الإيجابية منها والسلبية – ولكن المغربي يتمكن من النظر إلى الوراء تاريخيا (وكذلك في الروايات التاريخية العديدة) دون أن يأخذ في الاعتبار حضور الدولة العثمانية التي سيطرت لمدة قرون على أغلب المناطق العربية الأخرى. وكما يكتب عنه أحمد التوفيق في “جارات أبي موسى” مثلا، كانت العلاقات الثقافية والتجارية بين المغرب وبلدان البحر المتوسط متينة جدا طوال القرون الوسطى. فإذا أضفنا هذه الحقائق التاريخية وتأثيرها المستمر إلى وضع البلاد الجغرافي والعلاقات الحميمة المستمرة بإسبانيا وفرنسا، فإنه من المتوقع وجود هوية مغربية شخصية ووطنية تعبّر عن أحوالها واهتماماتها ومشاكلها في الصيغ الأدبية المختلفة التي تتوفر لكتّابها المبدعين.
الجديد: دعني أتسلّل قليلا إلى مختبرك كمترجم للرواية، كيف تترجم؟ ربما كنتُ أعرف كيف تشتغل بحكم الصداقة وروح الأخوة اللتين تجمعاننا، لكن يهمني أن تشرح للقارئ أسرار طقوسك الخاصة في الترجمة.
روجر ألن: منذ تقاعدي في سنة 2011 ركزت نشاطاتي على الترجمة وليس على البحوث والنقد. ومنذ بداية حياتي كأستاذ جامعي قمت بمشاريع الترجمة حتى أستعملها في عملية تدريس الأدب العربي للطلاب الأميركيين الذين لم يدرسوا اللغة إلى حد الكفاية ولكن لم أترجم أثر أيّ كاتب عربي لم أكن على معرفة شخصية به أو بلغته (باستثناء محمد المويلحي طبعا الذي مات سنة 1930 وعلى أيّ حال كنت على الاتصال بحفيده).
أما الترجمة نفسها فالمرحلة الأولى طبعا هي اختيار النص؛ وفي أكثر الأوضاع أقوم شخصياً باختيار نصوص أعجبتني. وأعتقد أن القارئ الإنجليزي أو الأميركي سيستمتع بقراءتها وسيفيد منها. وفي هذا السياق أتصرف مثل أغلب المترجمين من العربية إلى الإنجليزية. وعلى المستوى الأكثر عمليا أقوم بالمشروع حسب عدة عوامل: هل النص المترجم جزء من مشروع أوسع مثل “ذاكرة المتوسط” المشار إليه أعلاه أو المكتبة العربية (جامعة نيويورك في أبو ظبي) التي كنت قد أكملتُ لها مؤخراً طبعة جديدة لأثر محمد المويلحي “فترة من الزمن”. وفي مثل هذه الأوضاع من المعلوم والمنتظر أنه هناك مبادئ ومقتضيات متعلقة بنوع الترجمة والتحرير والنشر. ولكن في أكثر المناسبات أقرأ نصا يعجبني وأتصل بالمؤلف لطلب موافقته على الترجمة. وتسرّني الإشارة إلى أن كل كاتب اتصلتُ به بهذا الصدد وافقَ على الفكرة! وبعد الحصول على موافقة المؤلف، أبدأ المشروع وأترجم بضعة صفحات كل يوم (في واقع الأمر كل صباح) حتى أُكمل النص الأول للترجمة، ثم أترك هذا النص جانبا لمدة شهر أو شهرين حتى أحس ببعض البعد مما ترجمت. وبعد ذلك أراجع هذا النص الإنجليزي الجديد وأحوِّله إلى ما أسمّيه بنص إنجليزي – إنجليزي (يعني، نص يريد أيّ قارئ ناطق باللغة الإنجليزية قراءته). ثم أترك هذا النص جانبا كذلك لمدة زمنية مماثلة. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة (والأصعب) أقوم بعملية المقارنة بين النص العربي الأصلي والنص الإنجليزي الجديد وأنا آخذ في الاعتبار عندئذ كل العناصر المتعلقة بتلقي الترجمة في الثقافة “المضيفة” كما هو المصطلح في تنظير الترجمة: الاختلافات الثقافية مثلا ومناسبة اختيار العنوان للنص المترجم وطرق التسويق للنص المنشور.. إلخ. وإذا نجحت في القيام بكل هذه المراحل على مرور أشهر عديدة، فتبدأ المرحلة النهائية في المشروع وهي إقناع دار نشر بامتياز النص الأصلي وإفادة نشر النص المترجم.
الجديد: من خلال بعض النماذج، وأخص بالذكر التوفيق، وحميش ونجمي، كيف ترجمت أعمال التوفيق ونحن نعرف أنه مؤرخ كبير في بلده وله اهتمامات دينية وصوفية، فضلا عن موقعه كرجل دولة في المغرب (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية)، وترجمت أيضا بعض الأعمال الروائية لبنسالم حميش أستاذ الفلسفة، ورجل الفكر، والشاعر؟ كيف تقرأ رواية “جرترود” لحسن نجمي التي تمثل تجربة الجيل الروائي الجديد؟
روجر ألن: فيما يخص علاقاتي بهؤلاء الكتّاب المغاربة المشهورين والمهمّين – زملائي وأصدقائي في مشروع نشر نتائج الإبداع الروائي العربي في ميدان أوسع ألا وهو جمهور القراء على المسرح العالمي – كانت البداية في كل حالة هي النص: “مجنون الحكم” و”جارات أبي موسى” و”جرترود” على وجه الخصوص. يعني أني قرأت النص وأعجبني فاتصلتُ بالمؤلف. ومن المعلوم أني كنت مسرورا جدا فيما بعد بفرصة اللقاء معهم وبالتعاون معهم وبصداقتهم وأنا أقوم بعملية ترجمة بعض مؤلفاتهم.
أما ما لاحظته فورا أثناء قراءاتي لروايات حميش وأحمد التوفيق فكان اهتمامهما بتفاصيل تاريخ المغرب والعالم العربي عامة ومعرفتهم العميقة بالمصادر المحلية منها والعربية – الإسلامية الأكثر اتساعا (وهنا أشير إلى ما هو معلوم، أنهما حصلا على شهادة دكتوراه جامعية ودرّسا موضوع اختصاصهما في الجامعة). وفي عدة محادثات معي وعلى المستويين الشخصي والعمومي، ألحّ حميش مثلا في أن بعض رواياته ليست روايات “تاريخية” ولكنها (وحسب آراء الناقد المجري المشهور جورج لوكاش) روايات فحسب. ومن المعلوم كذلك أن كلاًّ من هذين المُبدِعَيْن في الإبداع الروائي يصفان في مؤلفاتهما كثيرا بعض الأمثلة من العنف والجَبَر ونماذج متنوعة للسلطة والسيطرة السياسية والدينية، ظواهر لا توجد لها أمثلة في العصور ما قبل الحديثة فقط.
أما حسن نجمي وروايته “جرترود” فقابلته للمرة الأولى أثناء سنة بحث قضيتُها في الرباط. ومن المعلوم أني كنت على معرفة بمؤلفاته كشاعر فإذا به يخبرني بأنه كان يكتب رواية عن جرترود شتين. ما أثار اهتمامي بالموضوع وبحثنا إمكانية ترجمة الرواية بعد إكماله لها. عندما نُشرت، أرسل إليَّ نسخة منها وأثارت النتيجة المنشورة اهتمامي مثل الفكرة التي بحثناها من قبل إكماله لها. وعندها بدأت قراءة النص، كان من الواضح أن حسن نجمي قد قام ببحوث طويلة مدققة في حياة جرترود شتين المعقدة من عدة نواحٍ، الفنية منها والشخصية والنفسية والجنسيةَ وقد بحث كذلك المشهد الفني العام الذي كان سائداً في باريس في العقود الأولى من القرن العشرين والدور المركزي الذي لعبته جرترود شتين فيه. فإذا رواية “جرترود” تُصوِّر مجموعة الشخصيات المعقدة هذه بدقة بالغة، فتقدّم للقارئ في نفس الوقت حكاية راوٍ مغربي عاد من باريس إلى وطنه وعاش حياة ذكريات بعضها مثيرة وبعضها الآخر محزن فعلا. وينظم لنا كقرّاء الراوي هذه العلاقات وهذه المواقع وهو يلجأ إلى سرد “إطاري” يوصل تفاصيل ذكريات الماضي بواقعيات المغرب الحديث بكل تعقداته السياسية والثقافية. فأكثر ظني أن ما يثير اهتمام القارئ لرواية جرترود (وأتكلم هنا عن النص المترجم إلى اللغة الإنجليزية) هو هذا المزيج من المعلومات المعروفة عن حياة جرترود شتين وعن شخصيته ومن المشهد المغربي الذي يسكن ويشتغل فيه الراوي.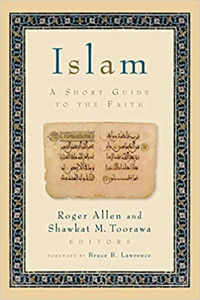
الجديد: ما هي الوضعية الراهنة للثقافة العربية في المتخيل الغربي، خصوصا في ظل التطورات التي يعيشها العالم اليوم على إيقاع ما يحدث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
روجر ألن: هنا نواجه عدة مشاكل أغلبها متعلق بالتعاريف: معنى “العربية” (الشعب أم اللغة؟) وعدم إمكانية التفريق (ولكن لهُ لزومه) عند أكثر الناس في الغرب بين العرب والشرق الأوسط والإسلام. وإذا تكلمنا عن “الغرب” (يعني أوروبا وأميركا) فأكثر ظني أن الناس لا يعرفون الكثير أو القليل عن الثقافة العربية وأكثرهم لا يريدون أن يتعلموا أيّ تفاصيل عن ثقافة المنطقة. وفيما يخص مجال الثقافة وظواهرها الفنية (والأدب منها) فمن المعلوم أنه هناك اختلافات عميقة في الاهتمام بمنتوجات المنطقة بين بعض البلدان الأوروبية (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مثلا) والأخرى (مثل ألمانيا والولايات المتحدة خاصة). الحق يقال، هناك بعض علامات تَحسُّن الوضع في مستوى اهتمام المجتمعات الأوروبية الشمالية والأميركية في هذا المجال ولكن من الواضح والمعلوم – وللأسف الشديد – أن أكثر اهتمام هذه المجتمعات يتركز على الوضع السياسي والاجتماعي السيئ في أكثر بلدان الشرق الأوسط وعلى بعض الطوائف الإسلامية التي قد نجحت إلى حدِّ ما في جذب اهتمام “الغرب” إلى آرائها وأعمالها الفظيعة.
الجديد: كيف عشت سؤال ظاهرة الاستعراب في الثقافة الأدبية الغربية؟
روجر ألن: قضيت أغلبية حياتي الأكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية وإن تخرجت من جامعة إنجليزية وهي جامعة أكسفورد في سنة 1968. وفي بداية حياتي الأكاديمية في الولايات المتحدة كان الاختصاص في موضوع اسمُه “الأدب العربي الحديث” شيئاً نادراً وغريباً وجديداً تماما. ولكن من المعترف به الآن أن الوضع تحوّل إلى أبعد الحدود حتى وصلنا إلى فترة تكون فيها دراسة الأدب العربي أثناء القرون قبل الحديث شيئاً ليس بالعادي المنتظر عند أكثر الطلاب بل موضوعاً أقل شعبية بكثير.
وإذا تحسنت الأوضاع فيما يخص الاستعراب في العقود الأخيرة (ولحوادث سبتمبر 2001 دور مهم في هذه التطورات، وفي الازدياد المرموق في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون اللغة العربية في الجامعات الأميركية وفي بعض المناطق داخل أميركا، في المدارس الثانوية أيضا)، فالاهتمام الأكثر تركيزا عند الحكومة التي تموّل أكثر البرامج، وعند الطلاب الذين يقومون بدراسة اللغة هو على تطور المهارات المطبقة والأكثر عملية وفي ميادين أكاديمية مثل السياسة والتاريخ الحديث خاصة وليس على المواد الفنية. ولكن والحق يقال، من الواجب علىّ أن أضع هذه التعاليق في سياق عام وهو “أزمة” الإنسانيات في المجتمع الأميركي وفي أنظمته التعليمية وفي الجامعات والكليات على وجه الخصوص.

الجديد: ما هو وضعك الاعتباري ما بعد إدوارد سعيد؟ ما معنى أن تكون مترجما وخصوصاً للنصوص العربية؟
روجر ألن: لعب كتاب إدوارد سعيد “الاستشراق” دورا مهما غاية الأهمية بالإشارة إلى المشاكل المتعلقة بمواقف بعض المختصين (وألح هنا على استعمال كلمة “بعض” وليس “كل”) فيما نشروا من دراساتهم للثقافة العربية والإسلامية. ولكن يمكن أن نقترح أن هناك بعضَ التحسن في معرفة المختصين باللغة العربية وإمكانية تطبيقها في البحوث (وكذلك لغات شرق – أوسطية أخرى) وازدياد مرموق في تبادل الزيارات البحثية بين المختصين العرب والغربيين؛ وأكثر ظني أننا نعيش الآن فترة مختلفة تماما فيما يخص المواقف الثقافية والمناهج المطبقة. وكما فسّرتُ عدة مرات للمراسلين العرب أثناء محادثاتنا، لستُ بمستشرق، بل أنا مستعرب، بمعنى أنّني مختص يريد أن يشتغل مع زملائه العرب والغربيين في مشروع مشترك هو دراسة إنتاج العرب الإبداعي (والأجناس السردية خاصة) وتوصيل هذه الآثار إلى جمهور أوسع.
الجديد: في تقديرك، ما هي طبيعة الإسهام الحقيقي الذي أنجزه المستعربون في إثراء الثقافة الغربية الحديثة؟
روجر ألن: لقد أشرت إلى بعض أبعاد هذا المجال من قبل. والمستعربون هم أقلية صغيرة جدا في ميدان الثقافات الغربية ومؤسساتها الأكاديمية والتعليمية. وكما فسرت أيضاً، فالمستعربون في المجتمعات الناطقة بالإنجليزية يواجهون جمهورا لا يعرف الكثير عن العالم العربي وما يعرفونَهُ أكثره سبلي جدا. ونحن – المستعربين القلاقل نسبيا – نواجه حواجز كثيرة في القيام بموضوعنا المفضل، وفي الحصول على آمالنا وأغراضنا. ولكن أضيف هنا وأقول إن النتائج التي حققناها إلى حد الآن في هذا السياق كانت مثيرة للعجب!





