سلطة المعيار
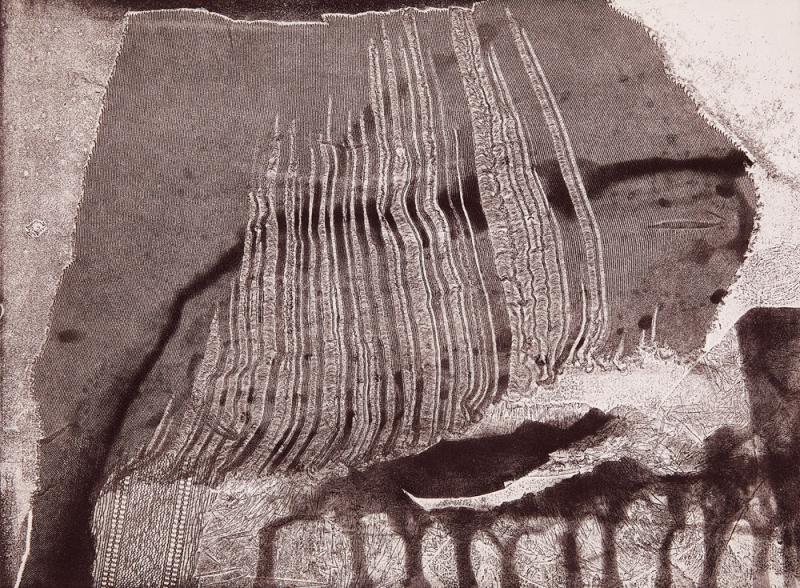
المعيار في اللغة هو العيار؛ أي المقياس الذي يُقاسُ به غيرُه بغرض الحكم والتقييم، وفي المنظور الفلسفي يشير هذا المفهوم إلى أنه نموذج متحقق أو متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء. وعند الحديث عن استقرار المعايير نجد أنه لا يمكن ثباتها في أيّ حال من الأحوال، وذلك لتغير الشرط الزماني والنسق الثقافي الذي تتشكل خلالهما القوانين الحاكمة للممارسة النقدية، ولتعدد محاولات التجريب المستمرة التي تخضع لها الكتابة الإبداعية، ومن ثم يتغير المعيار طرديا.
والمعيار في النص الشعري أساسه اللغة والشكل – وإن كانت هناك بعض الآراء التي تفصل بين المعايير اللغوية باعتبارها المقياس الجمالي للنص الشعري قديما وبين الشكل الخارجي باعتباره المعيار الأهم في إصدار الحكم في العصر الحديث – إلا أن المعيارين قائمان قديما وحديثا باختلاف الاصطلاحات الرائجة في كل عصر.
وتتعدد المعايير ما بين نصية تتشكل من مجموعة قوانين أسلوبية وعلاماتية وسيميائية ودلالية ولغوية، ومعايير أيديولوجية تتحدد وفق الخلفيات المرجعية والثقافية الخاصة بمُشكّل النص، ومعايير قرائية تعتمد على الممارسة النقدية والتفعيل القرائي للنص بواسطة الناقد والمتلقي.
عيار الشعر: أدوات الشاعر قديما
ويمكن اعتبار كتاب ابن طباطبا العلوي (250هـ – 864م) وآراؤه الخاصة ببيان صناعة الشعر من أهم الآراء التي أثبتت حيويتها عبر العصور المتفاوتة ومواءمتها لتطور الخطاب الشعري حتى عصرنا الحديث.
ففي كتابه “عيار الشعر” يحدد ابن طباطبا أدوات الشعر التي يجب على الشاعر امتلاكها، ومنها “التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب في الشعر” ويجمل ما فصله باعتبار “جماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميز الأضداد، ولزوم العدل، وإيثار الحسن، واجتناب القبيح، ووضع الأشياء مواضعها”، وهي المعايير الجمالية التي تحتكم إلى الخلفيات المعرفية للشاعر وروافده الثقافية المتعددة.
فيهتم ابن طباطبا بتعداد معايير الشعر وأدواته التي تفرقه عن النثر؛ حيث يرى ابن طباطبا أن بناء القصيدة يمر بأربع مراحل هي تكوّن الفكرة واختيار الصورة الشعرية وصياغة القصيدة والتثقيف. فالشاعر يبني القصيدة وفق المعنى الذي يطرأ في فكره نثرا أولا، ثم “يلبسه الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي سلس له القول عليه” وهي المعايير الشكلية التي تجنّس النص وفق الطرح الحديث لمفهوم جامع النص الذي يخصص للشعر سمات نوعية تفرّقه عن غيره من الأجناس الأدبية الأخرى.
ولم يتجاهل كذلك خصائص كل عصر، فيحدد مميزات الشعر الذي في وقته وخصائصه التي تميزه عن الشعر الذي سبقه، ويشير إلى اعتماد القصيدة على فكرة الأغراض التي كانت هي روح الشعر؛ فالوحدة الموضوعية كانت أساس القصيدة الجاهلية وفي صدر الإسلام، ثم تعددت الأغراض واختلفت؛ مشيرا إلى بعض المعايير الأيديولوجية التي تكشف توجهات الشاعر وتحدد المسارات التي وفقا لها يتم تلقي نصوصه.
وعن نظرته في تعامل الشاعر مع الموروث، نجد أن ابن طباطبا لا يعني أن يتكئ الشاعر على الموروث ويرتكز عليه، بل يدعو إلى التعامل معه بوصفه رافدا مهما يرفد القصيدة بتعابير فصيحة وأساليب بليغة. فالقطيعة عن الموروث ليست كاملة، فمن الممكن استعارة الشاعر لمعنى سابق شريطة أن “يبرزه في أحسن مما قيل فيه سابقًا وهنا تأتي مقدرة الشاعر في صياغة المعنى”؛ وهو ما يتوافق مع التعريف الحداثي للتجريب الذي لا يقترن بفكرة التجديد بقدر ما يطمح إلى توظيف عناصر شكلية ودلالية بطرائق مغايرة، دون أن يعني ذلك أن هذه العناصر لم توجد من قبل في نصوص سابقة، إلا أن طرق توظيفها وسياقات إنتاجها يكسبانها دلالة وتحققا مختلفين تبدو معها جديدة قياسا لفترات ماضية.
الإبداع الشعري وخرق المعيار
ارتبط النص الشعري منذ بدايته بمفهوم “الانحراف” الذي حدده ابن جني، وكذلك بمفهوم “العدول” الذي عدّه عبدالقاهر الجرجاني ميزة أساسية للشعر؛ باعتبار أن المفهومين بحث في الخروج عن القاعدة والمألوف؛ فكانت الاستعارة والتقديم والتأخير وغيرها من الأساليب البلاغية التي تحقق معنى الانزياح بمعناه الحداثي – اللغوي والتركيبي والدلالي.
يكاد يتوافق الجرجاني مع الأسلوبيين المحدثين في كثير من مقولاته وخاصة في الإمكانات الاستبدالية والقدرة التوزيعية للغة، وفي مقولته عن انتهاك اللغة وانحرافها عن النمط المألوف، وذلك بإخضاع المجاز لسيطرة النحو وعلاقاته التركيبية، وربما جاوزهم بمقولته عن تجدد المواصفة تبعًا لتجدد الاستعمال، وذلك لأنه دعا إلى نقد يعمل داخل النصوص ويكشف تراكيبها.
واشتهر مفهوم الانزياح في الدراسات النقدية والأسلوبية الحديثة باعتباره “خروجا عن المألوف والمعتاد، وتجاوزا للسائد والمتعارف عليه وخرقا للنظام المعروف، وهو في الوقت نفسه إضافة جمالية يمارسها المبدع لنقل تجربته الشعورية للمتلقي والتأثير فيه، محققا قيما جمالية وتعبيرية”.
ويرى جون كوين أن “الشعر انزياح أو انحراف عن معيار هو قانون اللغة، إلا أن هذا الانزياح ليس فوضويا أو نهائيا، فهو محكوم بقانون يجعله مختلفا عن المعقول، فالانزياح الذي يستعصى على التأويل تسقط عنه السمة المميزة للغة وهي التواصل، وإذا كان الانزياح يخرق قانون اللغة؛ فإنه لا يقف عند الخرق بل يعود في لحظة ليعيد إلى الكلام انسجامه ووظيفته التواصلية”.
وقد حقق الشعر في العصر الحديث انزياحا سواء على مستوى النوع أو على مستوى النص؛ وهذا الانزياح لا يلغي وجود المعيار؛ فيرى تزفيتان تودوروف أنه “لكي يحدث الخرق يجب أن يكون المعيار محسوسا”، وفي المقابل يشكك ميكائيل ريفاتير في جدوى المعيار لارتباطه بالمتلقي، الذي يحدد العدول وفق ما يعتقد أنه معيار ليصبح المعيار مطردا.
ورغم أن “عمود الشعر” قد شكل نظاما فنيا غير قابل للاختراق في القصيدة قديما؛ نجد أن قصيدة النثر مثلت أحد أشكال الخروج على نظام النوع؛ حيث أسقطت الوزن باعتباره معيارا للشعرية، وتحمل قصيدة النثر في حد ذاتها الوعي المتمرد على قواعد الكتابة التقليدية للشعر الخاضعة للوزن والقافية لخلق الإيقاع الشعري، لتتخلى عن تلك القواعد وتنساب حرة طليقة – بتعبير إليوت – وتخلق لنفسها إيقاعا خاصا يتنصل من كل محاولة تقييد شكلية أو رؤيوية؛ فقد نفت قصيدة النثر التعارض بين الشعر والنثر لتوجد نصا جامعا – بتعبير جيرار جينيت – له خصائصه النوعية ومعاييره الجمالية وسماته الشكلية الجديدة.
فاعتبر إليوت الوزن ليس معيارا للشعرية، والشكل الشعري لديه ليس مجرد وزن، بل هو نوع من البناء الحركي، ويتفق أدونيس معه في إسقاطه للوزن كمعيار للشعرية، وهذا ما عناه بقوله “وراء التناغم الشكلي الحسابي، تناغم حركي داخلي وهو سرّ الموسيقى في الشعر”، ومثلما أسقط إليوت الوزن دعا كذلك إلى التحرر من سلطة القافية التي يمكن الاستغناء عنها، لكن يجب تعويضها من خلال اختيارات الكلمات وبنية الجملة.
لتتحدد دعوة إليوت في الحد من القيود التي قيدت شعراء التقليد، تلك الدعوة التي نجدها كذلك في تبني الرومانسية فهما جديدا لنظرية الأنواع وإمكانية خرق معايير النوع الأدبي وامتزاجه بنوع أدبي آخر. فيقيم رولان بارت تصوّره عن خرق معيار النوع على مفهومه للنص وللكتابة، فالنص لديه تعددي وهذا التعدد يجتمع عند القارئ، كما أن الكتابة هي خلخلة تتحدد كمتعة. ويرى جاك دريدا أن قانون النوع يعتمد على قانون مضاد؛ أي أن الإمكانيات المتاحة أمام حدود النوع هي امكانيات تضعفها دوما استحالة الاحتفاظ بتلك الحدود في حد ذاتها.
من هذا المنطلق فإننا لا نستطيع إنكار حقيقة حدوث انزياح بين الشعر والأنواع الأدبية المختلفة؛ وربما يرجع هذا الانزياح إلى تعدد التجارب الإبداعية والضرورات الحداثية التي تطلبت من الذات الشاعرة الولوج بخطابها الأدبي إلى آفاق لم تكن تعهدها من قبل؛ فقد أفاد الشعراء من تقنيات الفنون الأدبية وغير الأدبية في تطوير مستويات نصوصهم وتشكيلها، وتطويعها بما يخدم طبيعة الخطاب نفسه والشروط الفنية الخاصة بكل نوع أدبي.
ومن هنا تميّزت لغة الشعر الحديث بالأشكال الحوارية الممتزجة بالنزعة القصصية والمسرحية حيث تتداخل الأصوات وتتعدّد، مما أضفى بعدا دراميا على بنية القصيدة وأبعدها عن الغنائية، كما طالبت القصيدة بتحقيق البنية البصرية داخل النص الشعري المكتوب، مفيدة من تقنيات الفنون السينمائية والتشكيلية، ومع ذلك، فإن امتزاج الأنواع لا يلغيها فيظل لكل نوع سماته الخاصة التي تميزه ومعاييره النوعية التي تفصله عن الأنواع الأخرى، ويبقى القصد من التداخل هو التخفيف من سلطة النوع ومسايرة النمط الحداثي الذي طال التجربة الشعرية الإبداعية بكل عناصرها.
الشاعر وسلطة الناقد

وفق الاعتبار السابق القائل بأن المعيار الشعري ما هو إلا مكوّن نصي داخلي، يمكن القول إن لكل نص معاييره الخاصة النابعة من خلفية الشاعر المرجعية وروافده الثقافية، الأمر الذي يصبح منطقيا معه وجود معيار خاص لكل نص شعري يختلف، بصورة كلية أو جزئية، عن معايير النصوص الأخرى، تؤطره القوانين اللغوية والنحوية والبلاغية التي تظل قائمة بين مختلف النصوص.
فالكتابة في مجملها تقوم على التجريب والخصوصية الإبداعية، التي هي خصوصية الذات الشاعرة دون انقطاع كامل عن خصوصية الموروث أو التواضع، لكن بتطويعه والتطوير فيه. كما أن كل كتابة – وفق الطرح السيميائي – هي إعادة كتابة، ومن ثم انتفت معها ثنائية “الأصيل” و”الدخيل” التي كانت معيارا ثنائيا لقسمة الكتابة الشعرية.
فأصبح النص محققا للطرح الباختيني الخاص بمفهوم الحوارية، وأصبح نسيجا من النصوص الأخرى وإعادة إنتاج لها، وأصبحت قراءته واستنباط معاييره تتطلب شراكة فعّالة من القارئ، ومن ثم تتعدد المعايير بتعدد القراءات؛ لأن القراءة تختلف باختلاف الإطار التاريخي والمكوّن الثقافي للمتلقي؛ فلا توجد قراءة نهائية لأن النص مفتوح ولا يرتبط بمركز معين.
أشار جيروم ستولينيتز في كتابه “النقد الفني – دراسة جمالية وفلسفية” إلى أن الفعل القرائي يقوم على ما أسماه بحكم القيمة الذي هو حكم موضوعي على العمل الفني، يعتمد السمات الخاصة بالعمل لذاته، وهي في أغلب الأحوال سمات خارجية/شكلية، إلا أنه حكم غير قطعي، ذلك أنه يختلف من شخص إلى آخر، فهناك مستويات ذاتية تتدخل في هذا الحكم، لذا يصبح حكم القيمة بحد ذاته حكما ذاتيا/موضوعيا إلى أن يتم الاحتكام إلى المعايير العامة للنوع الأدبي نفسه.
ومن هنا ينطلق الناقد في إطلاق أحكامه من خلال معايير جمالية ونوعية ونقدية يسبقها ذائقته الأدبية، ويبقى لكل ناقد معايير خاصة به تتحدد وفق ما يرغب فيه عبر استنطاقه للنص، إلى جانب وجود مستويات ذاتية تتدخل في الحكم أحيانا. وفي النهاية تبقى “مستويات ثقافة الناقد هي التي تحدد ثبات هذه المعايير وتغيّرها، فثقافة الناقد الانطباعي تختلف اختلافاً كلياً عن ثقافة ناقد بنيوي، أو ذلك الذي يمتلك ثقافة تاريخية يتوجه بنظرته إلى النص من وجهة تاريخية”.
مثلما تتغير المعايير النصية الشكلية تتغير بالتبيعة المعايير النقدية، ومن المعروف أن التقاليد النقدية تستقر بعد استواء النصوص الإبداعية. فقد انتقل الدرس النقدي من البلاغة إلى منظومة المناهج الحداثية، وبعد اعتبار النص ممارسة ثقافية، لم تعد مهمة الناقد الكشف عن العلاقات بين وحدات العمل الفردي أو بناه من ناحية، وعلاقتها مع النظام أو النسق اللغوي العام من ناحية أخرى فقط، بل أصبحت مهمته هي فتح النص على خارجه وربطه بالنصية الثقافية والاجتماعية التي تم بناؤه منها.
ولا تختلف المنظومة الحداثية عن البلاغة العربية – في أغلب الأحيان – إلا في بعض إجراءاتها الاصطلاحية وتطورها فيما يناسب الشرط الثقافي للعصر الحديث، فـ”الالتفات” نجده حاضرا في معاني التخييل بالذات، و”العدول” يتحقق في الانزياح وفق الأسلوبية ومحددات الشعرية، و”الاقتباس” يتحول إلى اصطلاح سيميائي هو التناص في أبسط صوره، والاستعارة هي القناع بالمفهوم الحديث حيث الفصل بين الدال والمدلول.
ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن المعيار ما هو إلا مكوّن نصي، يتم استنباطه من شبكة العلاقات النصية، يتغير بتغير العلاقات وبمدى الانزياحات الدلالية والفنية الداخلة عليه بفعل التجريب، فيتحدّد المعيار وفق مجموعة الصفات والملامح والعلامات المميزة في النصوص أو الظواهر التي يتم العمل على تعميقها وإبراز الواضح منها حتى تصبح مقاييس يحاورها الشاعر أثناء كتابة نصه الخاص من ناحية، ويحتكم إليها الناقد أثناء اختبار الكفاءة الجمالية للنص أو الظاهرة التي يدرسها من ناحية أخرى.




