ليلى أبوزيد تجربة مغربية بين عالمين
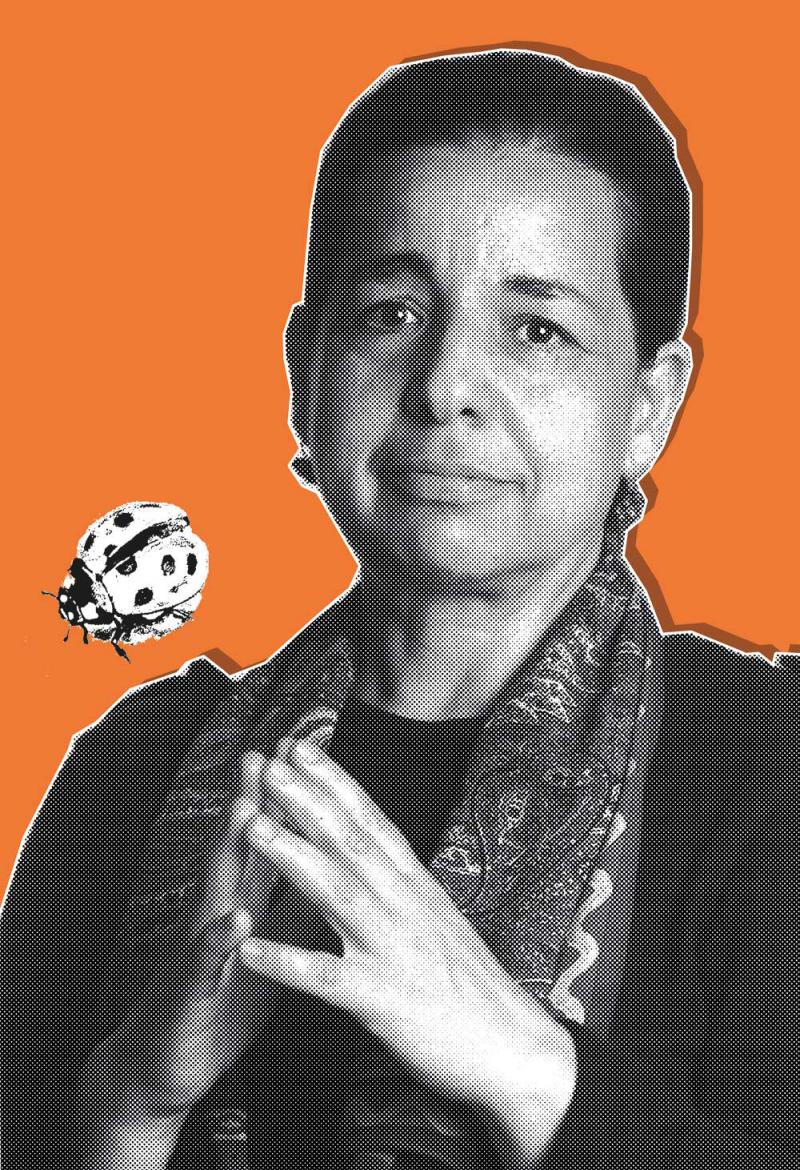
نَعتتْها صحيفة “Cairo Times” بالمؤلفة الموهوبة… دوروثي باركر “Dorothy Parker” المغربية. سليلة أسرةِ مقاوِمةٍ ببلدتِها القصيبة قلعةِ مقاومةِ الاستعمارِ الفرنسي، بشرق مدينة بني ملال في المغرب. لم يقف وراءها لا مؤسسة ولا حزب ولا جمعية، أوَّلُ كاتبة ومترجمة وإعلامية ورحّالة مغاربية تُرجِمت أعمالها إلى الإنكليزية (Year of the Elephant ـ Return to Childhood ـ The Last Chapter ـ Life of the Prophet) قبل أن تجِدَ طريقها إلى العربية وتكسر طوق التجاهل والإقصاء، هي التي لم تكن تجرؤ في البداية على توقيع عملها.
دُرِّست إبداعات ليلى الأدبية وسردها الحميمي في الجامعات والمدارس الثانوية الأميركية، بل كُتبت عنها دراسات لمنشورات أكاديمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تهتدي وزارة التعليم المغربية إلى جعل سيرتها الذاتية “رجوع إلى الطفولة” ضمن مادة دراسة المؤلفات للسنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي. ولذلك لم تكن تتوقع يومها إلا رأي القراء لأنه لم يكن بالمغرب في ذلك الوقت ما يمكن أن نسميه نقدا بالمعنى العلمي للكلمة، بل مجرد انطباع ورأي ما كان يعرف بمثقفي الأحزاب أو ما يسمى بـ«النقد الأيديولوجي»، الذي كان ضحيته كاتبات أخريات كالرائدة خناثة بنونة وعالِمة الاجتماع فاطمة المرنيسي.
وأيضا قبل أن يهتدي إلى أعمالها الناشر الأوروبي الراصد لما يترجَم في الولايات المتحدة من أدب عربي للسير على منواله. ومن المفارقات الغريبة أن يكون الأميركيون هم من يدل الفرنسيين أيضا على ما يجري في مستعمراتهم السابقة.
اعتراف الداخل
لم يَسُرَّ ليلى أبوزيد الاعتراف بها في الجامعات الأميركية، أو خارج الوطن، بل سعت جاهدة لتحقيق الاعتراف النقدي الداخلي في بلدها أولا، وهذا هو ما تصبو إليه دائما، وهذا هو الأمل الذي يشدُّها إلى الحياة. لم تكن تتلقّى بعين الرضى كونها دخلت إلى الجامعات المغربية والعربية ـويا لَلْمفارقَة!ـ عبْر شُعبة الإنكليزية، هي التي كرستْ حياتها للكتابة بالعربية دون أن يهتدي النقاد المغاربة إلى أعمالها، ودون أن ينتبه النقاد المشارقة إلى تجربتها الإبداعية، لأن المشرق ـفي اعتبارهاـ لا يبذل مجهودا لاكتشاف الكتّاب المغاربة. ولذلك فهي تأسف أن يَمُرّ حضور الكاتب عبر الترجمة لكي يعود إلى بلاده فيُعرَف ويُعترف به، علما بأنها لا تنكر حاجة الكاتب العربي إلى الترجمة. وهنا يحق لنا أن نتساءل مع المتسائلين في الحقل الثقافي المغربي: لماذا انتبه إليها القراء في المغرب عند صدورها بالعربية ولم ينتبه إليها الأكاديميون؟ ولماذا انتبه إليها الأكاديميون الأجانب بمجرد صدور الترجمة الإنكليزية ولم ينتبه إليها الأكاديميون المغاربة والعرب إلا بعدما جاءت التزكية من الولايات المتحدة الأميركية؟
الاعتزاز بالهوية
ليلى أبوزيد شخصية مغربية حتّى النخاع تعتز بمغربيتها أيَّما اعتزاز، لم تغير منها إقامتها الطويلة في أميركا شيئا، وبقيت وفية لذاكرتها الثقافية واللغوية، رغم أنها تكتب أحيانا بالإنكليزية كما فعلت مع سيرة الرسول. إنها ترفض الانسلاخ عن الهوية، وأكثر من ذلك تراها تعلن بكل وضوح وجسارة أن المرأة المغربية أكثر مُحافظةً من الرجل. وهو ما أكدته على لسان زهرة بطلة “عام الفيل” التي ليست سوى نموذج ضاجٍّ بالصراحة لنساء كثيرات عانين المصير نفسه: “المرأة المغربية في نظري أكثر أصالة ومحافظة من الرجل. إنها حارسة القيم والتقاليد”.
مثقفة عضوية
مَنْ تعاطى مع ليلى يعرف أنها امرأة قوية الشكيمة، صعبة المِراس، شديدة اللهجة في الانتقاد لا تخشى في ذلك انتقاد ناقد، وهي فوق كل ذلك لا تتهيَّبُ الخوض في المواضيع السِّجالية الشائكة كفرْض الدارجة في البرامج التعليمية وقضايا المرأة والتمييز وتمدرس الفتاة وسؤال الهوية والتنوع الثقافي ونظام الكوطا أو نظام الحِصص والتهميش والهشاشة والاختلالات والتناقضات والعنف الأسري والسياسي والفردانية والانتهازية وتزوير الانتخابات وأعطاب السياسة وانتقاد «اليسار المغربي» وكائنات البرلمان والإسلام والموديرنيزم والشطط في استعمال القوة والسلطة والمال والتحولات الشائهة التي انخرط فيها بعض أطر الحركة الوطنية، وغيرها من الطابوهات الحارقة…
المرأة المغربية أكثر مُحافظةً من الرجل. وهو ما أكدته على لسان زهرة بطلة “عام الفيل” التي ليست سوى نموذج ضاجٍّ بالصراحة لنساء كثيرات عانين المصير نفسه: “المرأة المغربية في نظري أكثر أصالة ومحافظة من الرجل. إنها حارسة القيم والتقاليد
تكتب ليلى دون أن تمارس الرقابة الذاتية على بوحها الطافح بالصراحة والوضوح الشديديْن. تملك حسًّا متوثبا نفّاذا، خبرت به قاع المجتمع المغربي وهوامشه، استغورت عالم النساء، لتصوغ نصوصا عميقة تدخل دائرة السهل الممتنع، بجمالية مخصوصة، لا تدير ظهرها لما هو سوسيوـسياسي، دون الوقوع في لَغَط الوعظيات المباشرة، والكليشيهات الجاهزة، والبيانات الأيديولوجية الفجّة والمجّانية.
كاتبة جريئة
دفعتها جرأتها المكتومة أواخر ستينات القرن العشرين إلى أن تكتب أول مقال لها وهي ما تزال طالبة بجامعة محمد الخامس باسم مستعار “لم تكن عندي الجرأة حتى على توقيعه باسمي الحقيقي. وعندما كتبتُ أول رواية تركتُ بلدة البطلة دون اسم، لأنها بلدتي”، وسرعان ما ألَّفَت بعد ذلك في الرواية والترجمة والقصة والسيرة الذاتية وأدب الرحلة والسيرة النبوية، بعد أن تلقت تكوينا في جامعة محمد الخامس بالرباط في اللغة الإنكليزية وآدابها، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية للدراسة بجامعة تكساس في أوستن، كما تلقت تدريبا في المعهد العالي للصحافة في سان بول بمينيسوتا. وفي سنة 1992 تركت الصحافة لتكرّس نفسها للكتابة الأدبية. من أهم أعمالها التي صدرت في عدة طبعات:
“رجوع إلى الطفولة” (سيرة ذاتية)؛ “عام الفيل” (رواية)؛ “الفصل الأخير” (رواية)؛ “الغريب، قصص من المغرب” (مجموعة قصصية)؛ “المدير وقصص أخرى من المغرب” (مجموعة قصصية)؛ “بضع سنبلات خُضْر” (أدب رحلة)؛ “أمريكا الوجه الآخر” (أدب رحلة).
تَرجَمت من الإنكليزية إلى العربية سيرة الملك محمد الخامس: (محمد الخامس: منذ اعتلائه عرش المغرب إلى يوم وفاته) والسيرة الذاتية لمالكوم إكس. تُرجِمت أعمالها إلى الإنكليزية والألمانية والهولندية والإيطالية والإسبانية والفرنسية والمالطية والأردية.
روائية ما بعد الاستعمار
استطاعت ليلى -التي صُنِّفت أعمالها ضمن رواية ما بعد الاستعمار ونظرية «الكتابة النسائية»ـ أن تختطّ لنفسها مجرى ثابتا متميزا في خريطة الكتابة بالمغرب بشاعرية وفنية مخصوصتيْن، ولغة مُحمَّلة بدلالات ثقافية ومعرفية خصيبة. كَتَبت بالعربية -لأن الفكر واللغة بالنسبة إليها لا تنفصم عراهماـ رافضة أن تكتب بلغة المستعمر التي هي الفرنسية، علما بأنها تتحدث بطلاقة العربية والإنكليزية والفرنسية، لكنها تُصرُّ على استخدام اللغة العربية، كي لا تسقط في الاغتراب داخل الثقافة الأجنبية التي استعمرت بلدها. فاستعمال الفرنسية يعني لها الانبطاح للمستعمر ولو لم يعد له وجود “كنتُ أقرأ كتبا باللغة العربية، ولا أقرأ كتبا بالفرنسية رغم أنني كنتُ أدرس اللغة الفرنسية في المدرسة، كردّ فعل على كونها لغة الاستعمار”. في روايتها شبه السير ذاتية “الفصل الأخير” تشرح استعمالها للفرنسية في الفصل الختامي، حيث كانت في إحدى المدارس الخاصة بالرباط مجبرة على الدراسة بالعربية والفرنسية معا، لكنها كانت تكره القراءة بالفرنسية، وتنفر من استخدامها خارج الفصل الدراسي. وهذا الموقف المبكّر من لغة المستعمِر هو الذي جعلها تعتبر نفسها محظوظة بحيث لم تصبح واحدة من كتاب ما بعد الاستعمار المغاربيين الذين ينتجون أدبا وطنيا بلغة أجنبية. ونفورها من الفرنسية وازدراؤها للفرنسيين وتذمّرها من الالتحاق بالمدارس الفرنسية هو الذي يفسر التفاتها إلى لسان شكسبير وسيلةً للاتصال مع الغرب. كما أن لِلَيلى أكثر من سبب شخصي لكره الفرنسية منذ طفولتها، ففرنسا اعتقلت والدها ونكَّلت به، وفرضت عليها لغتها. ولم تُبْدِ أيّ كره لأيّ لغة أجنبية أخرى ـمثل الإنكليزيةـ لأنها لم تتسبب لها في أي ضرر شخصي.
مأساة المرأة في المجتمع المغربي

عبّرت في روايتها الأولى “عام الفيل” (1980) -التي أصدرها في آن واحد ناشران أميركيان هما مصلحة النشر في كل من جامعة تكساس والجامعة الأميركية في القاهرةـ عَنْ حسٍّ نقدي ضارٍ لواقع الهشاشة والفقر والتصدع الأسري والطلاق التعسفي، ممهِّدة الطريق أمام مُدوَّنة الأسرة التي ستعزِّز مكانة المرأة في المجتمع المغربي ذي العقلية الذكورية. فعرَّت واقع الصراع بين الثقافة التقليدية والموديرنيزم، القيم الإسلامية والغربية، واستنكرت الصورة التي يكوّنها المجتمع المغربي عن المرأة، داعية إلى التحرر على المستوى القومي والذاتي.
وهي حينما كتبت روايتها الأولى “عام الفيل” (1980) كان المجتمع المغربي ما زال يرزح تحت وطأة مدونة الأسرة القديمة، حيث كان الطلاق في المغرب أداةً لإخراج المرأة من بيت الزوجية؛ فتجد المرأة نفسها فجأة مطرودة ومُلقاة في الشارع؛ وذلك بكلمة واحدة ينطقها الزوج في لحظة غضب.
اليوم صار الوضع مختلفاً. فقانون الأسرة الجديد جاء ليُعطي المرأة والأطفال ضمانات أكثر، ستجعل الرجل المغربي يفكّر طويلاً قبل أن يشهر في وجه زوجته ورقة الطلاق، على حدّ قولها.
ولذلك لم تخفِ ليلى ابتهاجها بهذا التحول الإيجابي في المغرب المعاصر، فعبرت عن مشاعرها قائلةً “إن الأهم هو ما أحسّه اليوم وأنا أعيش في ظل قانون الأسرة الجديد. أحسّ بنوع من الفخر في الواقع. فقد قمت بدوري ككاتبة على أكمل وجه. لقد سلّطتُ الضوء مبكّراً على منطقة مظلمة في الواقع والتشريع المغربيين. عبر الرواية، جعلت الكل يحس بمأساة المرأة التي تُطلَّق هكذا وتُرمى إلى الشارع. اليوم القانون الجديد جاء ليؤكد أن المغربية لن تعيش دائما في (عام الفيل)؛ وهذا تحول إيجابي”.
ظلت قضة المرأة والطلاق المدمِّر وتكريس الاختلاف بين الجنسين تشغل بالها ومخيالها في روايتها شبه السيرذاتيةsemi- autobiography “الفصل الأخير” (2000)، حيث تصدَّت لمعضلة تعليم المرأة، ولكره النساء في واقع الحياة المغربية التمييزي، الذي لا تتلقى المرأة فيه تربية جيدة. في المدرسة أبلت ليلى البلاء الحسن لأنه لا يُتوَقَّع أن لها دماغا، فالرجال يرون أن المرأة خُلِقت دون ذكاء، وليلى ترى أن الحكومة السلطوية الأبوية هي التي خنقت التربية الجيدة وجعلت منهن أميات وجاهلات.
ضحية تجاهل الناشرين العرب
في سيرتها الذاتية “رجوع إلى الطفولة”، التي أشفقَتْ من ردود الفعل تجاهها، ولا سيما ردود فعل أسرتها، فوضعت المخطوط في درج ونسيته حولين كاملين، تناهض ليلى استبعاد المرأة واستعبادها وحَمْلها على الصمت. ومن الصُّدَف الغريبة أن هذا العمل الذي تُرجم إلى الإنكليزية قبل أن يصدر بالعربية بسنوات، لمّا عزمت صاحبته على نشره بالعربية اتصلت بناشر لبناني فقال لها “ليتها كانت مذكرات بريجيت باردو!“، وذلك “لأنه يظن أن القارئ العربي لن يهتم بسيرة امرأة عربية عادية”، على حد قولها بمرارة وخيبة أمل.
قضية الدارجة
تجدر الإشارة إلى أن ليلى أبوزيد كانت من الأوائل الذين تجرؤوا على الكتابة بالدارجة إلى جوار الفصحى، مقتديةً في ذلك بالأدب الزنجي الأميركي الذي قرأته بعمق كبير، معتبرة أن اللَّكنة لا تضُرُّ بقيمة العمل إن وُظِّفت بقدر محدود، لا يتجاوز مقدار الملح في الطعام، أو حين تصير العامية أبلغ من الفصحى. لكن الزوبعة التي أُثيرت في المغرب حول استعمال اللغة العامية بدل اللغة الفصحى لمبررات واهية كاستفحال الأمية واستصعاب الفصحى وضرورة القطع مع التراث للبدء من الصِّفر، لم تتركها في الحياد، بل انخرطت في التعبير بشراسة وبكثير من الحكمة والرصانة عن رأيها الجريء مواجِهَة بذلك رأي بعض «الحداثيين» الفرنكفونيين كالمفكر عبدالله العروي والفاعل الجمعوي نورالدين عيوش عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (في برنامج «مباشرة معكم»، أذيع على القناة المغربية 2)، اللذيْن يمثلان -في تصورهاـ فريقيْن ذيْليْن لفرنسا “يتفقان على الاستراتيجية ويختلفان على التكتيك“. فالأوّل يريد إبعاد الفصحى من المدارس دفعة واحدة وأن يكون التعليم بالعامية والآخر يريد الإبقاء على الفصحى في المدارس «مع تغيير قواعدها بإلغاء المثنى وجمع المؤنث السالم وجزم أواخر الكلمات». بحيث تصبح الفصحى عامية في نهاية المطاف.
دفعتها جرأتها المكتومة أواخر ستينات القرن العشرين إلى أن تكتب أول مقال لها وهي ما تزال طالبة بجامعة محمد الخامس باسم مستعار “لم تكن عندي الجرأة حتى على توقيعه باسمي الحقيقي. وعندما كتبتُ أول رواية تركتُ بلدة البطلة دون اسم، لأنها بلدتي
وقد بدا لليلى أبوزيد أن التيارين لا يختلفان على ضرب اللغة العربية، ولكنهما يختلفان في طعنها تحت الحزام أو فوقه، لا لضرورة سوسيولوجية، بل إمعانا في “تركيع المجتمع المغربي عبر اللغة والثقافة“، ومحاربة اللغة العربية باللغة الفرنسية -التي أصبحت في مغرب اليوم شيئا من الماضي- لفرض “هيمنة فرنسا الثقافية على المغرب“، وإقصاء اللغة العربية من المدارس، وبالتالي “محاربة العربية بالعامية وليس بالفرنسية والمستهدف في المغرب الآن هو الإسلام وليس الثقافة“.
وبلهجة قاسية لكنها متفحِّصة وثاقبة تنتقد الرجلين بمثال تشريحي مُضاد، منبِّهة إلى أنه “في الوقت الذي يتعاون فيه العلمانيون والتلموديون في إسرائيل على الربط مع التراث بإخراج لغة نصف ميتة من تحت الأنقاض وإجلاء ما ران عليها من غبار آلاف السنين، نجد العلمانيين عندنا يتعاونون على ضرب اللغة العربية من فوقها ومن تحتها، وهي اللغة الحية التي قامت بها إحدى أعظم الحضارات في تاريخ الإنسانية. وفي الوقت الذي نجد فيه مؤسسات الإعلان والإعلام في الدول المتقدمة ترتفع بالناس بتقديم أحسن ما عندهم بأرقى مستويات لغاتهم نجدها عندنا تنزل إلى رطانة الشوارع وترتد بهم إلى الأمية التي تعد العامية بيئتها الطبيعية، ويعدّ تحويل هذه الأخيرة إلى حروف على ورق إخراجا لها من بيئتها كإخراج السمكة من الماء، حكما عليها بالموت”.
الواقعي ضِد الخرافي
الكاتبة تبدو الأشد تمسكا برصد الواقع في كتابتها بلغة سهلة، متحللة من التعقيد ومنتمية إلى خَطِّية السرد الكلاسي شأنها شأن أعمدة السرد الروائي والقصصي بالمغرب كعبدالكريم غلاب، وتنتقد بشِدَّة الظاهرة التي غزت العالم العربي بعد حصول غابريال غارسيا ماركيز صاحب “مائة عام من العزلة” على جائزة نوبل بكتابته الأقرب إلى الخرافة والتخييل السحري والابتعاد عن الواقع والحقيقة. وهي بذلك تنتقد الكُتَّاب العرب الذين لجأوا إلى السريالية والخرافة واللاواقع واللامعقول تقليدا لماركيز، معتقدين أنها المسلك نحو نوبل، والواقع أن ماركيز نفسه اعترف أنه تأثر بألف ليلة وليلة. من هنا تتساءل “ماذا يمكن أن نكتب بعد ألف ليلة وليلة من خيال ومن لامعقول؟!” (من شهادتها في برنامج روافد).
إنها ـفي سجالاتها الناريةـ لا تكتفي بالدعوة إلى كتابة الواقع؛ لأن ما يهمها أساسا هو الكتابة عن الواقع الحالي المعيش تحديدا، أمَا وقد وجدت أن الحاضر يعكس الماضي، فاستقت مادتها ونُسغَها من رحم المجتمع المغربي. لذلك لا تجدها متحمِّسة كثيرا للكُتّاب العرب المحدثين الذي لجأوا إلى التاريخ لكتابة رواية بعيدا عن واقعهم الزمني والجغرافي والاجتماعي، متسائلة مرة أخرى “ما الفائدة من الرجوع إلى الخرافة وإلى التاريخ وبين أيدينا واقع زاخر طري؟ بل ما الفائدة من الغرائبي الذي سقطت فيه بعض الكتابات في المغرب؟ كنتُ سعيدة وأنا ألتقي بقراء أميركيين أثنوا على رواية ‘عام الفيل’ وهم يقولون لي ‘كنا نحسب أن المغرب هو مغرب بول بوولز‘، يقصدون مغرب ما قبل 1912 الغرائبي الذي كتب عنه بوولز مجمل رواياته. وهذا في الواقع هو ما حفزني على كتابة سيرتي الذاتية ‘رجوع إلى الطفولة’، وبعدها عملي الشبه أتوبيوغرافي ‘الفصل الأخير’. كنتُ أريد أن أقدم المزيد عن هذا المغرب الجديد، وأساهم عبر الكتابة في صنع تحولاته. وأعتقد أن هذه هي مهمة الأدباء في المجتمع العربي اليوم”.
الترجمة رسالة

علاقتها بالترجمة مبكِّرة جدا تنمُّ عن عقلية متفتِّحة تأخذ وتعطي، فقد كتبت بالإنكليزية سيرة الرسول للقارئ الغربي مفيدة من سيرة ابن هشام، وترجمت إلى العربية سيناريوهات أفلام شهيرة، وقدَّمت قراءات درامية لها على أمواج الإذاعة المغربية.
من تلك السيناريوهات سيرة مالكوم إكس التي ترجمتها وبثَّتْها على الهواء في قراءة مسرحية. أجل بكل جَراءة جابهت صعوبات ترجمة نص مالكوم إكس الذي يعجُّ بالمصطلحات والتعابير والحوارات والأمثال اللصيقة بالعامية الزنجية بكل تعقيداتِ إيحاءاتها الثقافية، مدِركة تمام الإدراك أن على المترجم تجاوز مرحلة الفهم السطحي إلى استغوار طبقات النص عميقا حتى يتسنى له نقله بأمانة وجدِّية.
ولذلك لم تكن تنتكف عن الاستعانة بأميركيين سود لحلّ المشكلة. ولم تكن اختياراتها الترجمية اعتباطية، بل هي مرتبطة برسالتها الإعلامية والأدبية والفنية والأخلاقية. تقول هي نفسها عن هذه الترجمة الممتعة والماتعة لسيرة شخصية هامشية منحرفة أضحت عالمية بمعانقتها الإسلام “كانت الصعوبة جمَّة، ولولا أن الكتاب فريد من نوعه، ويتناول موضوع الساعة وكل ساعة (الإسلام)، وكيف أن زنجيا استطاع به أن يتحرر ويحرِّر سودا أميركيين من آثار العبودية والعنصرية ويرتفع بنفسه وبهم إلى الكرامة الإنسانية ويصبح شخصية عالمية، لولا ذلك لما منحت لترجمة هذا الكتاب أكثر من عام من العمل اليومي الكامل”.
شخصية الرحَّالة
بجرأة الرحالة المتفتح البصر والبصيرة، حاولتْ عبر إصداريْها في الرحلة وهما “بضع سنبلات خُضْر” عن لندن وحياتها الطلابية هناك، و”أمريكا، الوجه الآخر“، تجريد الغرب مما لفَّه من أسطورة السحر والتقديس الساذج والانبهار الأعمى والدهشة البليدة، لتعرِّي “الوجه الآخر” القابع خلف مساحيق شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات والمرأة والعولمة والفيمينيزم، والمجسَّد في رأسمالية متوحشة وبراغماتية عاتية وأوليغارشية ماحِقة تُجَرِّدانه من كل ملمح أخلاقي وإنساني وروحي.
لم تلتفت ليلى إلى الوجه البَرَّاق لحضارة الغرب، الذي فتن في ثمانينات القرن الماضي شباب البلاد النامية، عندما كان العالم لم يسمع بعد بأفغانستان والعراق والفلوجة والعامرية وأبوغريب وغوانتانامو، ولكنها ركزت على الوجه القميء للآخر، وما يقوم عليه نظامه الأوليغارشي من سطوة واضطهاد وتمييز وكيل بمكيالين.
شاهدة عصرها
لهذه الأسباب وغيرها اعتبر الناقد المغربي عبدالعالي بوطيب كتابتها قيمة رمزية وطنية لا تقدَّر بثمن، هي بنت جيل القنطرة أو العبور الذي عاش مرحلتي الاستعمار والاستقلال، بكل ما تشِع به لفظة قنطرة من وضع بَرْزَخِيّ مخاتل يغُصُّ بالمفارقات والتناقضات والمآسي.
ومن جهتنا نعتبرها شاهدة عصرها على تحولات المغرب المعاصر الاجتماعية والسياسية والثقافية والعقلية، ووثيقة نفيسة تنضح مغربيَّةً وهي تعانق القضايا المحلية والقومية والعالمية، كما نعتبر كتاباتها خير دليل على ضرورة وأهمية الرَّتْق بين الشأن النسائي والشأن الوطني حتى لا انفصام بينهما.




