مطالع روائية

تجمع هذه الأنطولوجيا 22 بداية لروايات عربية نُشرت بين عامي 2011 و2023، من 12 بلدًا عربيًا ويعتمد الاختيار على معيارين. أحدهما موضوعي وهو تاريخ النشر والآخر هو ذوقنا الشخصي. وحتى الآن، في المشهد الثقافي الإيطالي، هذا هو أول كتاب ترجمت فيه بدايات أحدث الروايات غير المنشورة باللغة الإيطالية، على الإطلاق وباستثناء 4 روايات، بلغات أجنبية أخرى.
في ملحق خاص أدرجنا جميع النصوص الأصلية، بدايات أقصر، بحدود حوالي 500 ـ 600 كلمة، لصالح كل من يرغب في خوض تجربة ترجمتها بمفرده أو تقييم ترجمتنا. لماذا انطلقنا من عام 2011؟ يعتبر هذا التاريخ نقطة تحول لبعض بلدان العالم العربي، هزتها ثورات أثّرت على التركيز على ثيمات معينة. على أيّ حال، فإن تحديد معيار زمني يبدو مفيدًا لإقامة مقارنة بينها من حيث الأسلوب ومعالجة المادة الدرامية و يمكنها أن تقدم مؤشرات حول الاتجاهات الجديدة في الرواية العربية.
يقوم تحليل البدايات التي نقدمها هنا انطلاقًا من العناصر السردية التالية: المكان والزمان والشخصيات. ونحن ندرك أنه ينبغي أيضا أن يقوم على علاقة بداية الرواية بالبنية السردية بأكملها، وارتباطها المحتمل بالنهاية، لكننا تجنبنا عمدًا هذا التحليل لكي لا نضطر إلى الكشف عن النهايات وحل الحبكات الدرامية الرئيسية.
بدايات بمثابة “فاتح شهية” لـ22 رواية، في محاولة لتقريب جمهور إيطالي كبير من الأدب العربي، كما تقدم بعض العناصر التي تحدد المسار الأدبي للمؤلفين الـ22.
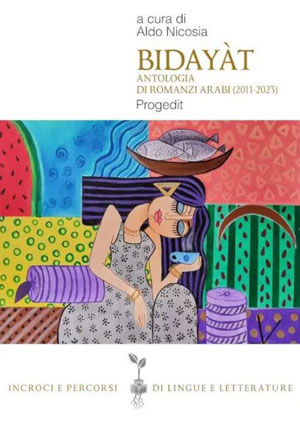
هنا يعتمد تسلسل عرضها على الزمن السردي الرئيسي الذي تجري فيه أحداث الرواية. فعلى هذا الأساس تم تقسيم المجموعة إلى قسمين. الجزء الأول يتضمن روايات تاريخية تدور أحداثها الرئيسية في الماضي البعيد. نبدأ من العصر الفاطمي، من تأسيس القاهرة، قبل أكثر من 1000 عام، مروراً بالفتح التركي للقسطنطينية، ومغامرات سلطان طموح ومنفي من قبل أخيه، وصولاً إلى منتصف القرن التاسع عشر، الذي يشهد النهضة العربية في الشرق الأوسط .
الروايات التاريخية التي تدور أحداثها في القرن العشرين تسلط الضوء على دور الاستعمار الإيطالي في ليبيا، عام 1911 ثم في الفترة الفاشية، وعلى حضور الإيطاليين في مصر، بدءًا من الثلاثينات من القرن 20. ثم نمر إلى النضال من أجل التحرير ضد الاستعمار الفرنسي في منطقة المغرب العربي والصراعات الكبرى الأخرى التي اجتاحت النصف الثاني من القرن: ضد إسرائيل، وإيران، وغزو الكويت، وحرب الخليج الثانية عام 1991، وأخيراً فترة ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية.
ويركز القسم الثاني على روايات تتناول قضايا معاصرة: مشاهد من الثورة التي أطاحت بمبارك في مصر، ومرحلة ما بعد الثورة في تونس. الحرب الأهلية الأخرى التي تحدد مصير الشخصيات الروائية هي الحرب السورية، بداية من ربيع عام 2011، النقاش حول المسائل النسائية في كل من الواقع التونسي والسعودي وفي الشتات العربي في أوروبا، لكنها تتبلور بوضوح في العديد من الروايات الأخرى.
وفي النهاية، اخترنا أن ندرج روايتين، إحداهما عمانية والأخرى مغربية، تقدمان عوالم ريفية غير ملوثة، بأجواء تمتزج فيعا الواقعية والسحرية وربما لهذا السبب لا يمكن تحديد زمن أحداثها بشكل دقيق. يُكسيها هذا الغموض المتعمد صبغة عالمية تنطبق على أي واقع إنساني.
تنتهي الأنطولوجيا بنصين مصريين يعرضان حقائق اجتماعية وسياسية دستوبية ترسم فكرة عن المستقبل القريب.
1– أين تنتهي بداية الرواية؟
للإجابة على هذا السؤال، لا بد من تحليل وظيفة بداية الرواية. يقول الناقد إيف رويتر إن “كل بداية هي نقطة إستراتيجية يمكن أن تبرمج كل النص وطريقة قراءته وأن تحاول حل التوتر بين الإعلام والإثارة”. وبالتالي يجب على الروائي أن يبني العالم الخيالي للرواية بالتوازن بين العناصر التوضيحية والوصفية من جهة والعناصر التي من شأنها أن تثير انتباه القارئ، من جهة أخرى، فيجعله يدخل بأسرع ما يمكن إلى قلب السرد.
تحتوي البداية على عناصر تكون بمثابة نقاطً مرجعية، وعلى أدلة ستحدد حبكة الرواية و تؤثر عليها.
غالبا ما تكون هناك علاقة وثيقة بين البداية والحدث المركزي للرواية، وعندما يحدث ذلك تنعكس آثار الأولى على بقية النص. وفي هذه الحالة يمكن النظر إلى الرواية كأنها نوع من بداية موسعة.
تحتوي بعض الروايات في هذه الأنطولوجيا على مقدمة (prologue) ذات وظيفة أكثر تعقيدًا. عادة ما تشكل، الخلفية التي تستبق الدراما الرئيسية قبل حدوثها أو تتنبأ بالنهاية في بعض الأحيان، من الواضح أن المؤلف سيحاول الكشف عمّا يراه ضروريًا لإشراك القارئ على الفور.
كم عدد الصفحات التي تكفي لتحدد، بطريقة واضحة ومفهومة، أين تنتهي بداية الرواية؟ هل تقع حدودها عند نهاية الفصل الأول؟
هنا لا نرى من المناسب الاعتماد على التقسيم الذي اتبعه المؤلف، إما بالفصول أو الأجزاء أو أنواع أخرى من التقسيمات، بل نعتمد على معيار كمّي بحت. فقمنا بترجمة ما يقارب 2000 كلمة أولية من كل رواية، (مع حذف الجمل المقتبسة عن كتاب آخرين والإهداءات التي تقع عادة في مستهل الرواية).
2– البحثً عن النفس والوطن
“الحلواني” ثلاثية الفاطميين (2022) (ترجمة وتقديم لأريانا توندي) هي الرواية قبل الأخيرة في سلسلة من الروايات التاريخية للمصرية ريم بسيوني (1973). تتمحور حول موضوع الهوية المصرية، التي حسب رأيها، تشكلت بفضل عوامل ومكونات متعددة على مر القرون. وتدور أحداث الرواية في عصر الفاطميين الذين سيطروا على مصر من عام 969 إلى عام 1171 وتركوا أثرًا عميقًا في تاريخها وحياتها الاجتماعية والثقافية، على سبيل المثال، بإقامة أعياد دينية خاصة وتحضير عدة الحلويات كعروس عيد المولد النبوي.
الرواية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء تروي الأحداث التاريخية المثرية بالعناصر الخيالية لثلاث شخصيات تاريخية، وجميعها ذات أصول أجنبية. هم جوهر الصقلي الذي أسس مدينة القاهرة (حسب بعض المؤرخين كان صقلبيًا وليس صقليًا) ؛ وبدر الشمالي، وزير الدولة الفاطمية من أصول أرمنية؛ وصلاح الدين الأيوبي، من أصل كردي، اشتهر بانتصاره على الصليبيين. القاسم المشترك بين الشخصيات الثلاث كان تعلقهم القوي بمصر.
كما تمثل الحلويات الخيط المشترك بين أجزاء الحلواني. وليس من باب المصادفة أنها في بعض الأحيان تصبح شخصيات في حد ذاتها ، كان جوهر الصقلى يجيد صناعة الحلوى قبل أن يصير قائد الجيش، ولذلك سمّي بالحلواني. شخصيته تظهر وتختفي في عصور مختلفة، حتى تتجسد في حلواني معاصر وهو أيضًا قاص ماهر. من بين محتويات الرواية هناك المعارك الملحمية والأساطير والمؤامرات والصراع على السلطة وحكايات حب .تعبر الحلواني عن الحنين إلى ماض مجيد من التعايش السلمي والبناء بين مختلف طوائف الأمة الإسلامية.
جرما الترجمان (2020)، للسعودي محمد حسن علوان (1979) تدور أحداثها في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، في سياق الصراع بين الأخوين بايزيد الثاني وجام، لعرش السلطنة العثمانية. بطل الرواية هو جرمانوس، من أم مسلمة وأب مسيحي وبفضل انتمائه الديني والعرقي المزدوج يجيد، إضافة إلى اللغتين التركية والعربية، الإيطالية والفرنسية.
في بداية الرواية، نراه راهبًا في دير بقبرص، ثم يصبح ترجمان جام في منفاه، فيتعين عليه أن يتبعه فيتنقل عبر بلدان البحر الأبيض المتوسط، من اليونان إلى صقلية، ومن الفاتيكان إلى فرنسا وإسبانيا.
تركز الرواية على شخصية الترجمان، على مراحل نضجه وتدريبه، على مدى فترة طويلة من الزمن.
إحساسه بالغربة، الذي يترتب على انتمائه المختلط، يتفاقم بسبب تجواله المستمر عبر البحار والأراضي البعيدة، لكن هذه التجربة تقوده إلى استكشاف عالمه الداخلي بشكل أفضل. كان المتصوف ابن عربي قد قال كبطل رواية موت صغير لنفس الكاتب: “الرحلة هي جسر نحو ذواتنا”.
علاوة على ذلك، يمثل جرمانوس جسرًا بين السلطان المنفي ومحاوريه. فيثني عليه لدوره الأساسي (“أنت لست مجرد ترجمان. أنت عيني وأذني ولساني”)، لكن جرمانوس تعلم من تجاربه الحياتية المؤلمة، فلم يعد يصدق كلامه .في أحد مونولوغاته الداخلية يرى نفسه فقيرًا، سجينًا، يحيط به البحر من كل جانب، مجبرًا على فعل ما لا يريد، للذهاب إلى أماكن لم يخترها .
من خلال شخصية الترجمان، ينوي الكاتب أن يجعل الناس يتأملون ليس فقط في وحدة الفرد في مسار حياته، ولكن أيضًا في دوره الذي غالبًا ما يعرّضه لسوء المعاملة. سنعود إلى هذه المسألة في رواية “باب الخروج” وتجربة بطلها في العصر الحديث، والذي بعد أن أمضى عقودًا في إعارة صوته للآخرين، يحاول أن يلعب دورًا حاسمًا في مصيره ومصير بلاده .
البحث عن وطن، بعد تجوال كثير، هو أيضًا محور رواية “تبليط البحر” (2011)، لرشيد الضعيف (1947)، فهي تندرج في مساق الأدب اللبناني حول المهجر إلى أميركا الذي ازدهر بفضل روايات ربيع جابر. نبرة الراوي ساخرة وفكاهية ويجعل القارئ يتأمل في نهضة لبنان وماضيها وحاضرها.
عنوان الرواية يشير بوضوح إلى مهمة مستحيلة، رغم توفر مقدمات النهضة فتغذت على مفاهيم مستوردة من الغرب (المواطنة، العلمانية، تحرير المرأة)، ثم صارت راسخة في عقول النخب الفكرية في بيروت ودمشق.
وكانت البعثات البروتستانتية التي وصلت المنطقة في القرن التاسع عشر بمثابة حافز لطاقات التجديد والنمو الثقافي الاجتماعي والسياسي، التي سعت إلى إخراج بلاد الشام من ظلام النظام العثماني القمعي. يعيد الضعيف قراءة تاريخ لبنان في نطاق سوريا الكبرى، بدءًا من تاريخ مهم، 1860، حتى نهاية القرن، ويخلق بطلًا شبه جدي يشعر بأنه مكلف بمهمة قيادة وطنه نحو التقدم المدني والاستقلال، هو فارس هاشم منصور. نشأ في أسرة مستنيرة بعلم وثقافة المبشرين، وبصحبة المثقف جورجي زيدان يخوض مغامرة الهجرة إلى الغرب.
يجعل الراوي مسار حياة الاثنين يتزامن مع مسار التقدم المدني والاجتماعي في لبنان. كنتيجة للبحث التوثيقي للمؤلف يتخلل الإطار التاريخي حكايات لشخصيات معروفة في تلك الفترة، مثل بطرس البستاني واليازجي وآخرين، فتعدد الخطوط السردية يبطئ ولكن لا يتعب الخط الرئيسي، أي ملحمة فارس وهو رمز لسوريا الكبرى. بعد أن يكتشف أميركا وتفوقها العلمي بفضل أولئك المبشرين، مقارنة مع مواطنيه الجهلة والمؤمنين بالخرافات، يلحق بوالده إلى أميركا، لمواصلة دراسته وبالتالي تحقيق حلمه، وتجربة الهجرة تذيقه مرارة العنصرية، وقسوة الحياة، ولكنه يصر على أن يباهي للعالم قيمة “السوري”. فارس شخصية علمانية وعملية وواقعية تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها بالعودة إلى البلاد في نهاية دراستها. فكيف ستخدم وطنها كما ينبغي؟
3– الاستعمار الإيطالي والأدب الليبي
“إن أيام 23 و24 و25 و26 و27 أكتوبر 1911 تمثل المذبحة العربية التي راح ضحيتها 4000 رجل و400 امرأة والعديد من الفتيات والفتيان والأطفال”. هكذا يبدأ الصحفي الملتزم باولو فاليرا بتصوير بالقلم والكاميرا، إحدى أكثر المذابح وحشية التي ارتكبها الإيطاليون في ليبيا، وهي مذبحة شارع شط.
عائشة إبراهيم (1967) في “صندوق الرمل” (2022) تستلهم روايتها من هذا الحدث الرئيسي ومن ملامح شخصية فاليرا. صورة العدو المستعمر، في النثر والشعر، كانت دائمًا مرتبطة بالعلاقات التي أقامتها إيطاليا مع مستعمرتها، حتى بعد الاستقلال. خلال الفاشية ما كان هدف إيطاليا احتلال ليبيا عسكريًا فحسب، بل أيضًا محو الهوية العربية الإسلامية للشعب الليبي وثقافته ولغته. وبعد قرن تقريبا، تقدم رواية إبراهيم منظورًا بعيدًا عن الكليشيهات التي تصور شخصية الإيطالي، دون أن تتخلى عن إدانة المجازر والإهانات التي تعرض لها شعبها على يد المستعمر. بطل الرواية هو ساندرو، شاب حالم ورومانسي يعزف على البيانو ويطمح لأن يصبح صحفيًا محترفًا. وفي الأجواء القومية لتلك الفترة التي تضلل الشباب الإيطاليين ليقاتلوا في ليبيا، عندما يصل ساندرو إلى طرابلس، تكون الصدمة قوية: فبدلاً من البساتين والأشجار المثمرة، التي أعلنتها الدعاية السياسية الخانقة، لا يرى سوى الحرائق والرمال المشتعلة والرصاص والخنادق.
وفي صباح أحد الأيام، من أحد تلك الخنادق، تمر فتاة جميلة على ظهر حمار، مع أخيها الصغير. فيقع في حب حليمة، بائعة الحليب، لكنه لا يستطيع التواصل معها.
عندما يُطلب من الجنود الانتقام من مذبحة شارع شط ، يضطر ساندرو إلى قتل امرأة تحاول مقاومته بالعصا. يكتشف على الفور أنها والدة حليمة. ثم يجرها مع أخيها الصغير إلى الشاحنة. وسيتم ترحيلهما على الفور على متن سفينة إلى جزيرة أوستيكا، مع الآلاف من النساء والرجال والأطفال. يموت الكثير منهم بسبب الكوليرا و الجوع قبل الوصول إلى وجهتهم.
يبدأ الفصل الأول بإصابة ساندرو في المعركة ونقله إلى إيطاليا، وإدخاله إلى المستشفى وإجازته غير المتوقعة، وأخيرًا اللقاء الذي طال انتظاره مع الصحفي الأسطوري فاليرا. بدءًا من الفصل الثاني، يعود الزمن السردي إلى الوراء بحوالي شهر أو شهرين، حتى عشية الحرب في ليبيا. يتم تقديم شخصيات ثانوية أخرى، ولمحات من الحياة الاجتماعية لبطل الرواية الإيطالي، ويتم وصف تناقضات الواقع الاجتماعي الإيطالي المتمثل في الفقر والبؤس. من هنا، يظل القارئ معلقًا بين سطرين روائيين متوازيين: تجربة ساندرو العسكرية، وتجوالات حليمة الليبية في السجون الإيطالية.
الرواية الليبية الثانية في الأنطولوجيا، “الهروب من جزيرة أوستيكا” (2018) لصالح السنوسي (1950)، تغطي فترة تلي تلك التي تؤطرها “صندوق الرمال”، وهي الحقبة الفاشية، وإجراءات السلطات لصد المقاومة الليبية الشجاعة. بالإضافة إلى المجازر وترحيل الناجين بأعداد كبيرة في معسكرات الاعتقال على طول الساحل الصحراوي، قام موسوليني بنفي آلاف الليبيين إلى الجزر الصغيرة التي تقع في جنوب إيطاليا. تبدأ الرواية بمشهد الترحيل من ميناء بنغازي إلى جزيرة أوستيكا. وهناك، بين الصخور السوداء وعمليات التعذيب والمشقات، تنشأ قصة حب بين ليبي وشابة إيطالية، كما تتطور صداقات قوية مع المعارضين السياسيين الإيطاليين للفاشية الذين سيكون لهم دور حاسم في حل دراما العاشقين.
الهروب من جزيرة أوستيكا هي أول رواية ليبية مخصصة بالكامل لقضية ترحيل المقاومين إلى إيطاليا. ومن خصوصياتها إبراز صوت للعديد من الشعراء الذين مدحوا المقاومة في معارك ملحمية. ومن بينهم فضيل الشلماني، الذي يقوم بدور هامشي في هذه الرواية، ويحظى بنوع من التكريم الأدبي في رواية إبراهيم عبر ذكر إحدى قصائده.
العجيب الغريب أن إبراهيم والسنوسي، في غضون 4 سنوات فقط ، كتبا روايتين تسلكان طرق المصالحة بين إيطاليا وليبيا، بواسطة حكايتين مختلفتين. القاسم المشترك هو الرغبة في إبراز الجانب الإيطالي المناهض للاستعمار، إضافة إلى تسليط الضوء على الفظائع التي ارتكبها الجيش الإيطالي في ليبيا.
4– الإيطاليون المتمصّرون
يمكن أن ننظر إلى المولودة ( 2018)، بقلم المخرجة نادية كامل (1962)، كأنها مذكرات التقطتها ابنة ماري إيلي روزنتال، من أب يهودي مصري وأم مسيحية إيطالية. فهي مولودة في القاهرة الكوسموبوليتانية في أوائل الثلاثينات، تلتحق بالحزب الشيوعي المصري والنضال السري وينتهي بها الأمر في السجن. تقع في حب الصحفي والناشط المصري سعد كامل ثم تتزوجه، وتصبح اسمها نائلة.
يقدم لنا هذا الكتاب رحلة إلى مصر التي لم تعد موجودة منذ أكثر من نصف قرن. يتقاطع التاريخ الوطني مع التاريخ الخاص لمرأة فريدة من نوعها، تتشابك قضايا وطنية مثل الصراع الطبقي بالعلاقات مع عائلتها الأصلية وعائلة زوجها، فضلاً عن صعوبات النمو والتطور في جو من التمييز الديني والعرقي والجندري. تم سجن ماري/نائلة في عهد الملك فاروق وتحت رئاسة عبدالناصر. شاركت مع زوجها بنشوة في الحياة الثقافية المصرية، إلى جانب أدباء من أمثال يوسف إدريس، وفؤاد حداد، وعبدالرحمن الشرقاوي، وصلاح شاهين، وغيرهم.
كما أنها توفر مفتاحًا لفهم أهم الأحداث التي شهدتها مصر الملكية والجمهورية منذ الأربعينات، مثل الحرب العالمية الثانية، وحريق القاهرة، وانقلاب الضباط الأحرار في يوليو1952، حتى حرب 1973 وسياسة الانفتاح. الانتماءات المعقدة والمتنوعة لعائلة ماري/نائلة، بالإضافة إلى الانتماءات السياسية والثقافية المختلفة للمثقفين الذين تتعامل معهم، تثري حياتها بأفكار وتجارب جديدة. يمتاز هذا النص، والذي لا يمكن أن يصنًّف في خانة “النوع الخيالي” (ولكن أليست الذكريات بذاتها مجرد خيال؟)، بلغة صريحة للغاية، بالعامية المصرية، التي تعطيها مصداقية وحيوية نادرة. يعتبر الكتاب ذا أهمية أساسية لفهم بعض الأبعاد للحضور الإيطالي البناء في مصر.
5– النضال ضد الاستعمار والصراعات الإقليمية في القرن العشرين

“زوج بغال” (2018)، للجزائري بومدين بلكبير (1979)، يأخذ عنوانه من الاسم الذي تُعرف به المنطقة الحدودية التي تفصل بين المغرب والجزائر. يتناول الكاتب فيها بشجاعة موضوعًا محظورًا في وسائل الإعلام المغاربية يتمثل في العلاقات الجزائرية المغربية. والجدير بالملاحظة أنه في الطبعات الموالية أخذت الرواية عنوانًا آخر لكي لا يثير أيّ جدل وهو ثلاث حيوات. بالفعل عبدالقادر، بطل الرواية، يعيش حيوات متوازية في كل من تطوان وطنجة المغربيتين، وثم في مغنية وتلمسان وعنابة في الجزائر. فيخوض ثلاث تجارب زوجية. يشارك في حرب التحرير الجزائرية، وبعد الاستقلال يجد نفسه في قلب أزمة سياسية بين البلدين. يتذوق أوجاع التعذيب حتى الموت وخانه بعض زملائه. يطارده العديد من الكوابيس والندم، ولاسيما ترك ابنته في منزل جدها. وعائلته المنتشرة بين البلدين لن تسلم من تداعيات فترة الإرهاب. يكتشف أن ابنه إدريس، الذي هرب من المنزل، تطوع مع احدى الجماعات الجهادية.
وحشة المقاتل عبد القادر تشابه وحشة شخصيات رواية [1] “أساتذة الوهم” (2011) للعراقي علي بدر. هي أنشودة الشعر والحب والموت في بغداد الثمانينات، بمقاهيها الأدبية، خلال الحرب العراقية الإيرانية. يموت بعض الجنود على الجبهة، في حين يتم إعدام الهاربين من الخدمة العسكرية. ينطلق وينفعل الراوي في تدوين قصة أصدقائه الشعراء: منير، عيسى، إبراهيم، وغيرهم.
يصوّر بدر، بنوع من الكآبة التي ينتاب من عاش تلك التجارب فعلاً، شوارع بغداد وأزقتها، والناس، والدكتاتورية. منير سليل الطبقة البرجوازية، من أمّ روسية، يمتلك بيانو ولا يعرف العزف عليه وله مكتبة مليئة بالكتب باللغة الروسية، دون أن يعرف تلك اللغة. يقرأ عيسى بودلير على الخطوط الأمامية بجبهة القتال، ويغمض عينيه ليتخيل أنه يعيش في شوارع لندن وباريس وبطرسبورغ.
ويمكن قراءة هذه الرواية، كما يتبين من العنوان، على أنها إدانة للأوساط الثقافية العراقية في تلك الفترة. إنها تهدف إلى كشف زيفها وفراغها، ورفض الواقع أو التقليد الأعمى للغرب.
“ساعة بغداد” (2016) هي الرواية الأولى للعراقية شهد الراوي (1986). خلال حرب الخليج الأولى، في بغداد، فتاتان صغيرتان، مختبئتان في ملجأ من الغارات الجوية، تحكيان لبعضهما البعض قصصًا لطرد خوفهما وتتشاركان الآمال والأحلام التي تتشابك مع الأوهام، فتنشأ بينهما صداقة عميقة. ولكن في حين أن العقوبات تسبب تفاقم أوضاع حياة الناجين ويبدأ الأصدقاء في الفرار من بغداد، يعتني الناس بالحدائق ويذهبون للرقص ويحتفلون بحفلات الزفاف، وتختبر الفتيات حبهن الأول. هدفهن هو كتابة تاريخ حيهن في سجل سري لحمايته من النسيان.
تعرض الرواية النضال اليومي الذي يعيشه أهل بغداد، وتكشف عن واقع المدينة التي تختفي ببطء بسبب الحرب المدمرة. في جو سحري إلى حد ما تتبلور الطفولة والمراهقة وقضايا النضج، و تمتزج الواقعية و السحرية، لطرد الكوابيس والسخافات. وحتى على المستوى الأسلوبي، فإن تشظي النص يعمل بمثابة نظير لعدم فهم الواقع، بحيث تبدو الحبكة مجزأة والدراما راكدة في الكثير من الأحيان.
عباءة غنيمة (2022) هي الرواية الثانية للكويتية عائشة عدنان المحمود (1978)، تتناول أكثر من نصف قرن من تاريخ الكويت، في سياق الأحداث الأكثر دموية على المستوى العربي. غنيمة امرأة فقيرة أو شبح خيالي ولها تأثير عميق على بطل الرواية، فيصل. رآها أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. كان يشعر بالرعب من الطريقة التي تنظر بها إليه، وتبقى صورتها مطبوعة في ذهنه. وتظهر له بين الحين والآخر، ربما لتوصيل رسالة، أو تحذيرًا له من شيء ما؟
شبح غنيمة هو تجسيد لمخاوف فيصل، وتمثل عباءتها العديد من الجوانب السلبية للمجتمعات العربية: التقليدية، القبلية، القومية، الرجولية، النرجسية وغيرها. تاريخ ولادته هو 15 مايو 1948، يوم النكبة الفلسطينية ويدرس في بيروت حيث سيشهد الحرب الأهلية اللبنانية، وهناك يلتقي بمدرسته لين التي ستقيم معها علاقة غير متوجة بالنجاح.
للرواية بنية دائرية، فتبدأ من عام 1990، وتعود إلى الوراء بنصف قرن لتتتبع كل النكبات والنكسات العربية، ثم تعود إلى سنة البداية. لكن فيصل، الذي يحلم بنهضة الأمة العربية، سيواجه مفاجأة حزينة أخرى. تهدي الكاتبة روايتها “للجهل والحب والهزيمة…”. فالحب محرك كل أحداثها على كافة المستويات، والجهل يؤدي إلى هزائم متكررة، على المستوى الخاص والوطني. والأمل هو أن يفهم الجميع من هذه الهزائم الدرس.
في “مستر نون” (2019) للبنانية نجوى بركات (1962)، نعود إلى أزقة وشوارع بيروت، بين الأحلام والواقع. يحمل بطل الرواية معه عبء ذكريات المدينة وهزائمه الشخصية: قسوة أمه وأخيه سعيد، وهجر محبوبته.
تقدم بركات رحلة إلى العقل المعذب في الشخصية الفصامية بشكل واضح. وعلى الرغم من تركيزه على ذكريات الطفولة، ينطلق من عالم أوراق الرواية التي يجد صعوبة في كتابتها، إلى أحشاء مدينته. ويتجول بين الناس، يتتبع وجوه الغرباء وكأنهم أبطال رواياته. ويضحي بنفسه من أجل إنقاذهم وحمايتهم. وجسده ينزف من جراحهم.
“مستر نون” هو النتاج الحتمي للحرب الأهلية اللبنانية، والشخصية التي يعيد البطل خلقها في روايته ، لقمان، هي تجسيد لنفس تاجر الحرب من رواية سابقة لنفس المؤلفة، يا سلام!
6– إحباطات ما بعد الثورة في مصر وتونس
تمتدّ أحداث رواية “ما رآه سامي يعقوب” (2019) لعزت القمحاوي (1961) لفترة زمنية لا تتجاوز نصف ساعة. فتبدأ عندما ينتظر سامي حبيبته فريدة للسماح له بدخول منزلها للاحتفال بعيد ميلاده، وفي تلك اللحظة يبدأ بتصوير قطة تتغازل مع قط في فناء أحد المباني. هذا الفعل الذي يبدو تافهاً سوف تكون له عواقب جسيمة في حياته. خلال هذا الإطار الزمني القصير، يظهر خطان سرديان آخران للارتجاع. يتناول الخط الأقدم حكي التقلبات التي يواجهها جده ووالداه في الثمانينات، ثم استعادة ذكريات طفولة سامي مع أخيه يوسف إلى أيام الثورة عندما يعود هو من ألمانيا ليمنع سامي من النزول إلى ميدان التحرير، لكنه هو بالذات يقتل برصاص قناص.
خط الفلاش باك الآخر أحدث ويحكي قصة حبه مع فريدة. يمتلك سامي طاقة روحية هائلة تجعله قادراً على التنبؤ المستقبل. إنه مبتسم دائمًا واستقامته الأخلاقية تسمح له بالتغلب على العديد من المحن الصعبة.
ثورة يناير 2011 لا يتم سردها بالتفصيل، باستثناء معركة الجمل الشهيرة، لأنها حاسمة في مصير يوسف. يقتصر الراوي على إعطاء رأي عام حول معنويات الناس “تحول الناس إلى حشرات مذعورة تنقل لقاح الخوف أينما تحركت”.
في الرواية تتكرر ثيمة الموت، كما في روايات أخرى للكاتب. لكن، بعد سنوات قليلة من تلك الأحداث المأساوية، تظهر فريدة وتمكنت من ملء الفراغ في حياة سامي. النهاية مفتوحة لخيال القارئ وتثير عدة تساؤلات يمكن تلخصها في الآتي : هل يمكننا الهروب من مصير حتمي ينذر بالقمع لنحلم بمستقبل مفعم بأمل الحرية؟
في “عطلة في حي النور” (2023)، يقترح الحبيب السالمي (1951) رحلة شبه إثنوغرافية ترصد التحولات التي حدثت في تونس ما بعد 2011. بطل الرواية وراويها هو عادل، الذي يعود من فرنسا لزيارة وطنه بعد غياب دام 12 عامًا. أول ما يلاحظه عادل هو تدهور الحي الذي يستأجر فيه شقة. حتى اسمه “النور” يبدو ساخرًا أمام مشاهد الظلام والانحطاط الذي لا رجعة فيه.
ومن خلال شخصيات أخرى، يظهر الراوي تحلل العلاقات الأسرية والزوجية، في ظل وضع اجتماعي واقتصادي متزعزع بشكل متزايد، يسوده الفساد والتطرف الديني والنفاق.
هناك مريم التي ترتدي الحجاب وتصوت لحركة النهضة ذات التوجه الإسلامي. وفي الجهة المقابلة، هناك لمياء، الصحافية العلمانية والمثقفة، في حين أن زرميط يجسد فئة الانتهازيين الذين يستغلون الفوضى السائدة في مراحل ما بعد الثورة، بالتدمير والحرق والنهب.
تتناول الرواية قضية المثلية الجنسية من خلال شخصيتين: فوزي، فنان عاش ودرس في فرنسا، يندم على عودته إلى تونس لأنه يدرك أن المجتمع غير مستعد لقبوله. وسامية، صديقة لمياء، بحجة التحرر النسوي.
تقدم الرواية مزيجًا من التراجيديا والكوميديا الساخرة، بأسلوب سلس وبسيط. يشير غموض المصائر النهائية لشخصيات الرواية إلى تفاؤل، أو ربما غموض بشأن نتيجة التحديات التي تواجههم.
7– الحب المحرم في العالم العربي وفي الشتات الأوروبي
7.1 – المجلد الأصفر
“الملف الأصفر” (2023) للتونسية أميرة غنيم ( 1978) (ترجمة و تقديم باربرا تيريزي) تخلق جوًا مشوقًا عبر سرد حب معذب وغير متبادل يتحول إلى شغف قاتل. منذ الصفحة الأولى، ينجرف القارئ إلى رحلة مذهلة وصادمة إلى أحلك أعماق نفسية لغسان الجوادي، البطل المضطرب، تحت رحمة العواطف الغامرة والأسرار المظلمة. هوسه بالجميلة هاجر، المرأة التي أحبها منذ الصبا، يؤديه إلى دوامة من الرغبة والخيانة والعذاب، حيث يندمج الواقع بالكابوس. في المقدمة يخاطب غسان، وهو يحتضر، عزرائيل، ويطلب منه أن يسلم زوج هاجر، المسؤول عن وفاتها، رسالته: سينتظره في الجحيم ليجعل آلامه أكثر فظاعة. وهذا يكفي لإثارة فضول القارئ: ماذا حدث لغسان، من أو ما الذي أوصله إلى حافة الموت؟ من هي هاجر التي يدعي غسان أنه عشيقها وكيف ماتت؟
خلال سنوات دراستها الجامعية، فضلت هاجر الزواج من زميلها الوسيم في كلية الطب، والذي سيسقط قناعه كرجل عنيف ومدمن على الكحول. فبسبب سوء المعاملة التي تلقتها من زوجها، عادت للبحث عن غسان. في مونولوغاته العديدة تأخذنا غنيم إلى أعماق نفسية غسان المريضة. في بعض الأحيان نتعاطف مع معاناته وأحيانًا نكرهه بسبب سلوكه المهووس وغير العقلاني. عبر لعبة من القفزات الزمنية نصل إلى المفاجأة النهائية، حيث يجمع القارئ قطع الفسيفساء السردية.
تحتوي الرواية على بعض المواضيع العزيزة على الكاتبة والتي تناولتها بالمزيد من التعمق في روايتها نازلة دار الأكابر (2020)، أي تعقد الروابط الأسرية وحالة المرأة في المجتمع التونسي.
7.2 – الجنون و الثورات
بروايتها “اختبال” (2019) التونسية بثينة الخالدي (1978) تأخذنا بصوت الراوية فايزة، أستاذة الأدب العربي والمقارن، إلى رحلة مثيرة إلى تونس قبل وبعد ثورة 2011، انطلاقا من رسالة غامضة تصلها من فريدة، بطلة الرواية الحقيقية، المثقفة التي وقعتها بالاسم المستعار “مي”، في إشارة صريحة إلى الكاتبة اللبنانية “مي زيادة” (1886 – 1941). وجدت فريدة نفسها في مستشفى الأمراض النفسية بمنوبة، بأمر من عائلتها، لتعالجها من هواها المتمرد. والحقيقة أنها عاشت تجربة حب مع أسباني يدعى خوليو، أستاذ الحضارة العربية الإسلامية في إحدى الجامعات التونسية، ويعتبر ذلك الشغف تمرداً خطيراً على تقاليد أهل الجنوب التونسي.
إضافة إلى تسليط الضوء على فترة مهمة من الماضي التونسي، ألا وهي هجرة الموريسكيين من إسبانيا، التي يجسدها خوليو، تهدف الرواية إلى تحديد العلاقة بين الحريات السياسية والاجتماعية: يتم التعامل مع العشاق على أنهم معتوهين أو مجانين حتى من قبل السياسة التي تخشى هذا النوع من الثورات.
منذ الستينات، نددت الروايات العربية بالقيم التقليدية التي تتميز بها الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي سيطرت على العالم العربي. ولم يتوقف انتقاد المجتمعات العربية بعد الثورات. ورغم شعارات الحرية والكرامة، يبرز نفاق بعض التشكيلات السياسية وممثليها، أو كل الذين يعتبرون أنفسهم “تقدميين”. وهذا يعني أن تطور وضع المرأة ودورها في المجتمع لا تزال تعوقهما العقلية المتخلفة، وليس القرارات السياسية ولا القوانين.
7.3 – المرأة العربية في الشتات الأوروبي
في “نساء بروكسل” (2019) تقدم الفلسطينية نسمة العكلوك (1986) تجارب حياة لخمس نساء يجتمعن في العاصمة البلجيكية. في الفصل الأول نتابع شخصية سارة، الفلسطينية، من خلال نظرة البلجيكية لور. فهي في بداية الانتفاضة الثانية، عاشت في فلسطين مع عائلة فلسطينية قتلت إسرائيل ربها. فوقعت لور في حب أكبر أولادهم اسمه عمر. سارة ولور يلتقيان بالصدفة خلال مسيرة تضامنية من أجل فلسطين في بروكسل. ستكون لور عبارة عن همزة وصل مع البطلات الأخريات: هناك مريم العراقية التي هاجرت من بغداد مع عائلتها، و انفصلت عن والديها بسبب علاقتها ببرونو، لأنه ينتمي إلى ديانة أخرى، مها، سورية فلسطينية، تصل إلى بروكسل قادمة من مخيم للاجئين في دمشق، وتستقبلها سارة في منزلها. والتونسية سعاد التي لا تريد قطع علاقتها بحبيبها، رغم العنف الجسدي واللفظي الذي تتعرض له منه.
تتناول الرواية قضايا اجتماعية ومعاناة وكوابيس وأحلام يقظة: لور تطرَد من شغلها بسبب حجابها، في حين لا يتم تعيين سارة في مكتب المركز الإسلامي في بروكسل،.. لأنها لا ترتديه. حجاب لور نفسه يسبب خلافات حادة مع ابنها توماس الذي يكره العرب و يتجاهل أصوله.
7.4 – المرأة السعودية
امرأتان (2016) للسعودية هناء حجازي (1965) تروي بأسلوب سردي مليء بتيارات الوعي والمونولوغات الداخلية، حياة ليلى ومرام، وهما صديقتان تعيشان في جدة. ليلى هي راوية الأحداث التي تؤثر على كليهما، وتأتي من عائلة محافظة للغاية، بينما مرام تترعرع في بيئة اجتماعية منفتحة. تروي الرواية الصعوبات التي يواجهها كلاهما في المجتمع وداخل الأسرة، بما في ذلك العنف الأسري والحب وتدخل القضاة والمثقفين والشخصيات الدينية.
وبعيدًا عن الإدانة المتوقعة للرجولة، خصوصًا دور الأب، فإن الرواية لا تظهر دائمًا نساء مضطهدات وضعيفات، ولا رجالًا عنيفين. في المخيلة الثقافية العربية، يستحضر اسم ليلى شخصية أدبية مشهورة في عصر الجاهلية: فهي مغرمة بالشاعر قيس. نفس الشيء يحدث لليلى في العصر الحديث، التي ترغم بالزواج من رجل لم تختره هي. أما مرام، فهي معلمة تحب مثقفًا مشهورًا لا يرغب في الزواج منها، لذلك لم تعد تؤمن بالحب، لكنها تمثل دعمًا نفسيًا كبيرًا لليلى. لا شك أن تمرد النساء ونضالهن من أجل تقرير مصيرهن رهينة الخلفية العائلية والاجتماعية. تهدف الرواية إلى جعلنا نتأمل في تناقضات المجتمع السعودي المعاصر، لكنها تبين أن مساحات الحرية يمكن أن تنفتح في الأفق أيضا، في جميع المجالات.
8– انهيار “البيت” السوري
“بيت حُدد” (2017) للسوري فادي عزام (1973) بيت دمشقي يحافظ على كنوز غير متوقعة ويدل رمزياً على موروث تاريخي للشعب السوري الذي ما زال ضحية لجلادين كثيرين. بطلا الرواية هما الدكتور أنيس والمخرج فيديل (أو فضل حسب أفراد عائلته المحافظين) اللذان يعودان إلى سوريا، بعد غياب طويل، في بداية عام 2011 لسببين مختلفين. أنيس ليبيع بيت حدد الذي ورثه عن عمه، في حين يصور فيديل فيديو إعلانيًا لرجل أعمال. كلاهما يشرعان في قصة حب سرية ، فيديل مع الدكتورة ليل، وأنيس مع سامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان التي تحاول منع بيع البيت المذكور .
تدور أحداث الرواية في فترة بداية الحرب الأهلية السورية، مسلطةً الضوء على التحولات التي شهدتها البلاد خلال ذلك العقد: مقاومة شعبية، ومظاهرات حاشدة، اعتقالات، تجارة الأعضاء، مجموعات مسلحة. يواجه كل الأبطال مواقف مفاجئة تشبه أحلام و سرعان ما تتحول إلى كوابيس مرعبة.
يبرع عزام في تتبع تطورهم النفسي، خاصة تطور فيديل، بتعقيداته وتناقضاته، التي ينذر بها اسمه المزدوج فيديل/فضل وأعلن عنها في الفصل الأول الذي يمتاز بكتابة ماهرة تجذب القارئ باستعمال عناصر فكاهية وسط مواقف درامية.
يتخذ الكاتب تقنية المونتاج الموازي كعنصر تشويق فيقطع كل فصل عند لحظة حاسمة، من بين محاور هذه الرواية الملحمية ، هناك محاولة تفكيك مفهوم الثورة: فهي في رأي الكاتب لم تعد عاملا يوحد الشعب ضد النظام ، بل أصبحت سببا للانقسام بين كافة مكونات المجتمع: تجار الدين، المرتزقة، المثقفون، عملاء النظام ، كلهم يحاولون الحفاظ على امتيازاتهم مهما كان الثمن، على حساب الوطن.
وفي دوامة الفظائع والأهواء الجامحة والمنفلتة، تبدي الرواية وحشية النظام الدكتاتوري وتعفن الواقع الاجتماعي.
9– الديستوبيا والاغتراب والعوالم الافتراضية

” باب الخروج” (2012 )، أول رواية لعزالدين شكري فيشير (1966) بعد الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك، تفتتح سلسلة طويلة من النصوص التي تظهر سمات ديستوبية. على سبيل المثال، نشرت في نفس العقد “الطابور” (2013) لبسمة عبدالعزيز، “نساء الكرنتينا” (2013)، لنائل الطوحي، و”عطارد” (2014)، لمحمد ربيع.
تم نشرها مسلسلة في جريدة “التحرير” لمدة 68 يوما. وبما أن الثورة لا تزال مستمرة، فإن الحبكة متأثرة بأحداث حقيقية ودراماتيكية حدثت في أواخر ربيع عام 2012، وكذلك بردود الفعل الشعبية، إلى درجة أن الكاتب قال إن الجنرالات والإخوان المسلمين قد اتبعوا نصه. زمن البداية هو أكتوبر عام 2020: علي، مترجم في قصر رئاسة الجمهورية، يكتب إلى ابنه يحيى، من سفينة غامضة تبحر من الصين إلى مصر. هكذا تبدأ الرواية التي تحمل عنوانُا فرعيًا: “رسالة علي المفعمة ببهجة غير متوقعة”.
عزيزي يحيى،
(…) حين تصلك هذه الرسالة، بعد يومين بالضبط من الآن، سأكون سجينًا أو جثة (…).و هذه الرسالة قد تكون طوق نجاتي الأخيرة إن فشلت كل الاحتياطات الأخرى. فاحرص عليها. فقد تكون هي الفارق بين الخيانة والبطولة، بين النصر والهزيمة.
يشعر علي بالحاجة إلى إخبار ابنه بحياته كلها، والتي تتشابك مع الأحداث المضطربة التي ستتعين على بلاده مواجهتها، حتى وصوله إلى تلك السفينة الملعونة. عمله كمترجم/ترجمان للرئاسة يقوده إلى أعماق مؤامرات القصر. يتزوج من ابنة أحد كبار الشخصيات في المؤسسة العسكرية. وفي 25 يناير/كانون الثاني 2011 يشهد المظاهرات الحاشدة، ومن ثم الأحداث العنيفة والدموية التي تلت الثورة. ومنذ ذلك الحين، ستشهد مصر احتجاجات أخرى وانقلابات وحكومات جديدة، حتى يصل إلى السلطة صهره القطان، الذي ينخرط في لعبة شد الحبل الخطيرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. علي، الذي قضى عقودًا من الزمن يترجم أفكار الآخرين، لن يكتفي هذه المرة بقول كلمته، بل يرغب في أن يُخرج مصر من النفق.
9.1 - التعلق بالأرض من المغرب إلى عمان
“تغريبة القافرّ (2022) للعماني زهران القاسمي (1974) ، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية بدورة 2023، تحكي عن سليم الذي جاء من رحم امرأة ميتة، غارقة في بئر. ربما بفضل تلك الولادة المعجزية، تتمتع بموهبة إدراك وجود الماء تحت الأرض. عندما كان طفلاً كان يشعر بإحساس عميق بالوحدة لأن المجتمع الريفي الذي يعيش فيه لا يقبل المختلفين، لذا فإن مصيره هو أن يقضي حياته منبوذاً، بسبب موهبته لا يستطيع أحد فهمها. ولكن عندما يكبر يتمكن من إنقاذ قريته من الجفاف الشديد والمجاعة، وفي تلك المرحلة يتحول سليم إلى بطل مشهور، مطلوب من جميع القرى المجاورة. لسوء الحظ، سرعان ما يصبح منبوذا مرة أخرى، وينسى الجميع مزاياه.
الإطار الزمني للرواية غامض وغير محدد، ربما للتأكيد على ثبات عقليات معينة أو لإبراز صبغة عالمية لقصته.
تعلق بطل الرواية سليم بالأرض يربطنا برواية “من خشب وطين” (2021) للمغربي محمد الأشعري (1951) الذي يجعلنا نشكك في قيم الحضارة التكنولوجية والفردية، فيدعو إلى العودة إلى الطبيعة وقيم المصلحة الجماعية. يقرر بطل الرواية، إبراهيم، في خضم أزمة وجودية، ترك مهنته في أحد البنوك والذهاب للعيش في غابة المعمورة، والتفرغ لتربية النحل. وفي أحد الأيام، يصادف قنفذًا مصابًا بجروح خطيرة ويقرر نقله إلى الرباط لتلقي العلاج على يد طبيبة بيطرية فرنسية. فتنشأ بينهما قصة حب كسر بها إبراهيم قالب التقاليد. تم القبض عليه في الغابة من قبل قوات الشرطة وقضى ما يقارب ستة أشهر في سجن سري. وفي هذه الأثناء ينظم أفراد مجتمعه كل جوانب حياته الخاصة بما في ذلك مصالحته مع زوجته وعودته إلى البنك وطلاقه من الفرنسية. ماذا سيحدث لإبراهيم بعد خروجه من السجن؟ تُدخل الرواية عناصر الحكاية الخيالية والكافكاوية في بنية واقعية، على غرار كليلة ودمنة، ربما للتنديد بطريقة أكثر استفزازية بخروج الإنسان عن قوانين الطبيعة. هناك العديد من الرموز في هذه الرواية: يشير العمل الجماعي للنحل في الغابة إلى مسار محدد يجب اتباعه للمساعدة في إنقاذ الجنس البشري من الانقراض والأرض من الدمار الشامل. تهدف رواية الأشعري إلى إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة المبنية على “الخشب والطين” فمن خلال هاتين المادتين يشير إلى البحث عن معنى جديد للوجود. إبراهيم الذي يبني بيتًا بهذه المواد البدائية، يستذكر النبي إبراهيم الذي يبدأ ببيته مرحلة جديدة من العلاقة مع الخالق.
دعوة مماثلة لاستعادة علاقة أكثر صحة مع الطبيعة الأم تأتي من الرواية الأخيرة في الأنطولوجيا، التي تدور أحداثها في مستقبل بائس ليس ببعيد: “يونيفيرس” (2023)، للمصرية رضوى الأسود (1974).
مقارنة بالقضايا البيئية التي أثارها الكاتب المغربي، تستنكر الأسود هنا أهداف السياسة العالمية والعلم والتكنولوجيا المستخدمة لاستعباد الإنسان، بطريقة بطيئة وغير محسوسة. “يونيفيرس” هو اسم لواقع افتراضي يختبر فيه الفرد أحلامه التي يصعب تحقيقها في الحياة الواقعية، لأسباب دينية أو أخلاقية. لكن شيئاً فشيئاً يتحول الأمر إلى هوس مرضي وفخ خطير لكثير من الناس. ومن بين هؤلاء هناك حاتم، رفيق الراوية، الذي أُعلن عن وفاته في بداية الرواية، دون أن يذكر الظروف. ميريت هو اسم بطلة الراوية، يمكن تشبيهه هنا بالضمير الحي للإنسانية، فهي تكافح للحفاظ على القيم والمبادئ الإيجابية، وإظهار التمييز بين الكذب والحقيقة. وستسلم للأجيال القادمة مذكرات تحتوي على تجاربها بالتفصيل. بشجاعتها وحكمتها، وباستخدام معرفتها كباحثة في علم الأحياء، ستحاول إبراز الوعي بأن الجنس البشري أصبح هجينًا بين الحيوان والآلة، قطيعًا من الأغنام الخاضعة والمطيعة التي تتبع الأوامر دون تفكير أو اعتراض. وذلك بسبب سنوات من المعلومات الكاذبة والكائنات المعدلة وراثيًا ومصادرة الحريات المدنية.
خاتمة
بعد هذه الرحلة في عالم الأدب العربي المعاصر شهدنا تنوع البدايات أسلوبيًا أو في تقنيات تقديم الأبطال أو الأجواء أو ديناميكية الحوارات، واستنتجنا أن البداية الناجحة و الناجعة هي التي تستطيع أن تحرر طاقات الرواية الكامنة فتعد بمواصلة خط أو خطوط درامية بجمل تمتزج فيها التشويق والإيضاح. تتشابه الرواية برقعة شطرنج فإذا كانت عناصر الفريق موزعة ومنتشرة بشكل ذكي ومتماسك منذ بداية المباراة، فستكون من الأسهل مواجهة أخطار اللعبة وفخاخها. من بينها الشعور بالملل أو كثرة استعمال أفكار مجردة. إذا وصلتم إلى هذا السطر دون أي قفزة إلى الأمام بعد حوالي 5450 كلمة وتغلبتم على شيء من الملل فتأملوا أن هذا الملل هو أرخص ثمن للاطلاع و لو جزئيًا على كل ما نعتبره ذا أهمية في 22 رواية.




