مفهوم المعيارية النقدية على المحك

“الزمان مكان سائل والمكان زمان متجمد”.
(ابن عربي)
I
ما المعيارية؟ سؤال خلافي يجيب عنه إدوارد سعيد بالقول إنها فعالية من صنع النقاد، “النقاد لا يصنعون القيم التي يحكم بها على الفن ويُفهم بموجبها فحسب، بل يدمجون بالكتابة تلك السيرورات والشروط المباشرة المتمثلة بالزمن الحاضر، بطرائق تسبغ على الفن والكتابة أهمية ودلالة” (1).
تتيح لنا نقطة الانطلاق هذه، في حالة نقد الشعر العربي، أن نقرأ في ضوء آخر، غياباً/حضوراً: غياب المعيار وحضور الافتعال، غياب النظر وحضور الرؤية المسبقة، غياب النص وحضور الأيديولوجيا.
في هذا كله ما يحيل الشعرية العربية مجدداً إلى مشكلية الأنا والآخر، القدامة والحداثة، الداخل والخارج، الفصل والوصل، المعيّن والمطلق.
تضعنا هذه المشكلية، بدءاً، في مواجهة مباشرة مع الواقع، والصلة مع إمكاناته. ويكفي لكي نرى في تلك الإمكانات ما يشكل قضية أن نلقي نظرة على الجدل المستمر حول التراث والحداثة.
ولكن ما مآل هذا الجدل؟ غاية هذا السجال في نظري أن الشاعر الحداثي، تأسيساً، ليس ملزماً لكي يشرعن نفسه أن يكون مجرد صدى للآخر، لمرجعية سوزان برنار، أو مرموزية ت. إس. إليوت، ومن ثم نسيان خصوصية الذات. ما يبحث عنه الناقد في هذه الخصوصية هو تجاوز مفهوم الأصالة بما هي صنوٌ للمنوالية. وليس هذا الابتعاد الجذري بالأمر السهل. قوام هذا التجاوز ماثل في حركية الشعر بما هي تجدد وابتكار. وهذا يعيدنا إلى البحث عن معيارية مفقودة، معيارية جمالية ذات محمول معرفي صادر عن النص مباشرة: شعرية تمليها التجربة الذاتية، تجربة إقامتها ليست في العراء، بل في واقع محسوس تفلت منه من حيث أنها تشير إلى ما يتجاوزه. ولعل نظرية إدوارد سعيد في البنوة والتبني، الموروث والمكتسب، أن تلقي ضوءاً على نجاعة هذا التأسيس لمعيارية نقدية شديدة الصلة بالنصوص التي تتحدث عنها.
في كتاب “بدايات: القصد والمنهج” (1975) الذي يعد أحد أبرز الإسهامات المعاصرة في النقد الأدبي، وفي مقدمة طبعته الصادرة في العام 1985، إشارة فطنة إلى أهميته الاستثنائية. ثمة تأكيد في هذه المقدمة على ثنائية التضاد بين البنوة (Filiation) وبين التبني (Affiliation) البنوة (Son-ness) من حيث هي نتاج أبوين، وأما التبني فهو خيار يختار المرء بموجبه أن يكون طرفاً في علاقةٍ مؤسسةٍ مع أب مجازي، أو أن يكون حفيداً لهذا الأب المجازي. مآل العلاقة المقترحة هو التركيز على مفهوم البداية، أو البدايات. ثمة مفهوم احتمالي يؤكده النقاد، على اختلاف ثقافاتهم، أن الأدب عموماً هو نتاج بنوة بيولوجية يسيطر ما مضى بموجبها على حاضر راهن. ليست ثمة بدايات بل هناك سلسلة أصول زائفة. ولكن هل يمكن أن يدرس أيّ نص، أيّ شيء، من دون التأكيد على أنه يتصل ببداية محتملة؟ يجيب سعيد بأن الجواب عن السؤال، بصرف النظر عن شرعيته، إنما يكمن في محاجات مفادها استحالة تعيين الأصل، فلكل أصلٍ أصل أبعد منه.
وفي نتاج سعيد النقدي سعيٌ لإعادة تعريف الأدب عموماً وذلك بتصحيح ما يدعى بـ”المُعْتَمَد” الغربي (The Western Canon) والمقصود هنا تصحيح العلاقة بين المركز والهامش على صعيد الأدب والثقافة، ويتم هذا التصحيح بإدراج أعمال أدبية عربية متميزة في سياق هذا المعتمد الغربي، ومن ثم عولمة قوامه وجعله مشتركاً.
وهذا شكل من أشكال إعادة تعريف المركز والهامش. أي شحن المركز بمسمّيات وإشارات ومفاهيم متميزة ومستمدة من الهامش (الذي ليس هامشا في الثقافة العربية) بهدف الوصول إلى “معتمد” عالمي للأدب والثقافة عموماً، على مقياس يفند شرعنة تنميطات الآخر السلبية للذات، ويتضمن المركز والهامش معاً. والتفنيد كما تقدم يكمن في قول سعيد إن لكل أصل أصلاً أبعد منه. الأصالة هنا بمعناها التقليدي تصير أصلا مصنوعاً، أصولية منافية للواقع.
والحال أنه لا بد من استعادة النقد لمعيارية تستند على الواقع الحي، إلى كينونة الذات في وجود الآخر فيها، وكينونة الآخر في وجود ذاتنا فيها.
وكما يشير محمد عابد الجابري فإن الطابع العالمي لتراثنا العربي الإسلامي والطابع العالمي للفكر الأوروبي المعاصر يجعلان طرح الأصالة في مقابل المعاصرة بمثابة وضع الفكر الإنساني في مقابل نفسه تحت تأطيرات واهية قومية أو دينية أو “حضارية مزعومة”.
وهكذا تنطلق معيارية الحداثة من “الانتظام النقدي في الثقافة العربية نفسها وذلك بهدف تحريك التغيير فيها من الداخل. لذلك كانت الحداثة بهذا الاعتبار تعني، أولاً وقبل كل شيء، حداثة المنهج وحداثة الرؤية والهدف: تحرير تصورنا لـ’التراث’ من البطانة الأيديولوجية والوجدانية التي تضفي عليه داخل وعينا، طابع العام والمطلق وتنزع عنه طابع النسبية والتاريخية” (2).
II

مقابسة أبي حيان التوحيدي التي تؤرخ للسجال بين السيرافي اللغوي وأبي بشر متّى المنطقي، والتي جرت ببغداد في عام 937 م هي في دلالتها العميقة مؤشر هام من بين مؤشرات أخرى، على بدء السعي للوصول إلى شكل من أشكال المعيارية النقدية في الأدب والفلسفة والحضارة.
ويبدو من سيرورة المناظرة أن اللغوي تمكّن من هزيمة المنطقي. وكان أبوبشر قد أثار السجال باستعراض ما يمكن للمنطق أن يفعله. وتأسيساً منه على شرّاح أرسطو أعلن أن المنطق أداة لا غنى عنها للتمييز بين صحيح الكلام ولغوه بهدف الوصول إلى المعنى.
والمنطق، كما نعلم، سيرورة من العقلنة الصحيحة. كما أن الفلاسفة يتوسلون بالمنطق وسيلة للوصول إلى الحقيقة، ومقابل ذلك أطلق السيرافي حجته القائلة إن ثمة حاجة لمعرفة اللغة معرفة حقيقية لتجنب الخطأ عندما يقلّب المرءُ الأمر على وجوهه. على المرء أن يكون على حذر من معاني المصطلحات الغامضة وأن يتقن النحو من أجل أن ينظم أفكاره على نحو صحيح.
هذا السجال الشبيه بنقار ديكة ثقافة ذلك الزمان والذي أسفر عن الانتصار للغة، يبدو مألوفاً بلغة النقد ومعياريتها في الوقت الحاضر. ويعود ذلك لسبب لا علاقة له بالمنطق الأرسطي، بل بحضور اللغة بمعناها المتجاوز والعميق.
حضور اللغة، كما يُطرح في فلسفة مارتن هايدغر، يثير لدى بعض الفلاسفة ردود أفعال شبيهة بردود الأفعال التي انطلقت إزاء مترجمي “دار الحكمة” في بغداد للفلسفة اليونانية في القرون الوسطى (3).
هذا الحضور، تأسيساً، ينطلق من دعوى هايدغر في “الوجود والزمان” (1927) في أن المحمول المعرفي للحقيقة ليس ماثلا في البيانات حول العالم، أو في تقديم أوصاف صحيحة له، بل في الكشف عن العالم باللغة، ويدعو هايدغر ذلك بـ”الحدث” (Event).
وفي كتابه “مقدمة في الميتافيزيقا” (1935) يحاول استعادة التجربة الإغريقية للكائن بنشاطاته وقيامه بتسمية الأشياء التي يرى قبل كل شيء أنها بمثابة استجابة تفوق الجهد الإنساني.
ويقول إن “حقيقة كون تطور النحو الغربي قد انطلق من التأمل الإغريقي في اللغة اليونانية، يمنح هذه السيرورة معناها الكامل. فاللغة اليونانية واللغة الألمانية بما يتصل بإمكانات التفكير تجعل من هاتين اللغتين الأشد قوة وتأثيراً من بين جميع اللغات” (4).
هكذا تصبح اللغة بمثابة الممرّ الجديد لوجود الكائن. بل تكاد تتجاوز الوجود إذ تلتهم اللغة الكائن “اللغة بيت الوجود حيث يوجد الإنسان بالإقامة. والكائن لا يتحدث اللغة، وإنما اللغة نفسها هي التي تتحدث عبر الكائن”.
وهذا يعني أن الشعراء وليس الفلاسفة هم القيمون على الوجود، وبخاصة الشاعر الألماني فريدرش هولدرلن. تلك هي الخصيصة المفتاحية للشعر. إنها تكمن في عملية إطلاق الأسماء (التسمية)، العملية التي تسفر عن “التحقق” بمعنى جعل الشيء حقيقياً.
وكما هو الشأن في نيتشه، فإن التراتبية الهرمية السقراطية تتعرض هنا للانقلاب رأساً على عقب.. وهكذا يصير الفنانون والشعراء لا الفلاسفة والعلماء هم الناطقون بالحقيقة. تلك هي النقلة المعرفية التي يحاجج فيها الفيلسوف الألماني بالقول إن الشعر هو الوسيلة التي يمكن بها التعبير عن أصالة الكائن. وبذلك لا تعود اللغة وسيلة بل تصبح مكان إقامة الكائن وتجليه الكلامي.
أدونيس يقتبس عبارة هايدغر نفسها، بل ربما يصح القول إنه يرتلها ترتيلا مع إغفال مرجعيتها، فيقول “كل شيء عندنا نحن العرب لغة، وليس الإنسان في الممارسة، وفي النظرية من يملك اللغة، بل اللغة هي التي تملكه. الإنسان العربي المسلم يحيا عملياً مملوكا للغة وللواقع الذي تتحدث عنه، وليس هو الذي يفكر. اللغة هي التي تفكر عنه” (5).
يقودنا الكلام على اللغة إلى تطابق ظاهري. ويحيلنا التطابق إلى غائيتين بدلالتين متعارضتين. غائية هايدغر تكمن في الكشف عن عظمة الألمانية واليونانية إلى الحد الذي يجعل اللغة هي التي تكتب الكائن. وأما غائية أدونيس في سياق ترتيل اللغة وجعلها ذات معيارية نقدية مشتركة بين الأنا والآخر، فإنها تحيل العربية على نحو جامع مانع دون تعليل عقلاني مقنع، إلى لغة أقل شأناً بكثير من الألمانية واليونانية، بينما يصبح العربي عبداً آبقاً، مملوكا للغة لا يملكها، لغة تفكر عنه لأنه لا يفكر!
III
نقد المحك: قراءة المحك، أو المقياس النقدي عند العرب المعاصرين تحيلنا إلى “المُعْتَمَد”، أي القانون النقدي كما يفهمه الغربيون. كلمة قانون (Canon) أترجمها بكلمة “معتمد” لتمييزها عن القانون بمعناه العام، وهي ذات مصدر يوناني (Kanon) وتشير إلى القضيب المعدني أو الخشبي الخاص بعملية القياس وذلك ضماناً لتحقق مشروعية الاستقامة.
وأما الأعمال المعتمدة في الأدب فهي التي اجتازت وضعها على المحك فتشرعن وجودها واستمرارها. وبكلام آخر، سيطرت على القارئ بسلطتها (الشبيهة بسلطة القانون ومرجعيته)، بطاقتها على الصدم والمفاجأة، بقدرتها على السيطرة والإدهاش. وحتى عندما لا تكون على هذا المستوى فإن الأعمال الفنية المتميزة، الأعمال المعتمدة مستمرة بإقناعنا وجذبنا بحيث نظل مخلصين لها.
ويصف “المعتمد” مجموعة من النصوص التي تشكل قواماً متسقاً ويستجيب واحدها للآخر، وتبدو محددة للثقافة التي تعترف بقيمتها.
والأعمال المعتمدة، من جهة أخرى، هي النصوص المفضلة والمعترف بها، النصوص التي تدرس في المدارس والجامعات، وتعد جزءاً مرشحاً لقراءة معمقة تؤخذ على محمل الجد.
وإذا كانت أعمال شكسبير ووردزورث وجين أوستن هي الأعمال المعتمدة في مثال الأدب الإنجليزي فثمة أعمال أخرى غير معتمدة، أي أعمال تتسلل من الهامش إلى المركز.
ومن جهة أخرى، يوصف “المعتمد” بأنه دائب التغيير. وفي النصف الثاني من القرن العشرين صار ييتس وإليوت وباوند يشكلون جزءا من قوام المعتمد بتحولاته الحداثية.
وفي مثال الأدب الأميركي يشمل القوام أعمال رالف إمرسون وهرمان ملفل وإدغار ألن بو.
ويذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت أياماً خصصت للاحتفال بلغات الأمم المتحدة الرسمية الخمس: الفرنسية التي اعتمدت يوماً دولياً للفرنكوفونية، والإنجليزية التي اختيرت تتويجاً لذكرى وفاة شكسبير، واختيرت الصينية تخليداً لذكرى سانغ جيه مؤسس الأبجدية الصينية، بينما اختير الشاعر الروسي بوشكين احتفاء باللغة الروسية، وثرفانتس عن اللغة الإسبانية.
وأما الاحتفاء باللغة العربية في سياق البحث عن معتمد عربي فقد ظل تحديد رمزه اللغوي أو الأدبي أو النقدي معلقاً.
ومن البدهي أن ثمة أعلاماً كثيرين يمثلهم الجرجاني والقرطاجني من النقاد، والدؤلي مؤسس علم النحو والفراهيدي واضع علم العروض وابن جني مبتكر علوم اللغة، والمتنبي الشاعر الأسطورة مالئ الدنيا وشاغل الناس، والمعري فيلسوف الشعراء.
ويبدو أن غياب الرمز المحتفى به عربياً لا يعكس اختلافاً، بل خلافا يعكس غياب الإرادة وهيمنة الأيديولوجياً.
IV
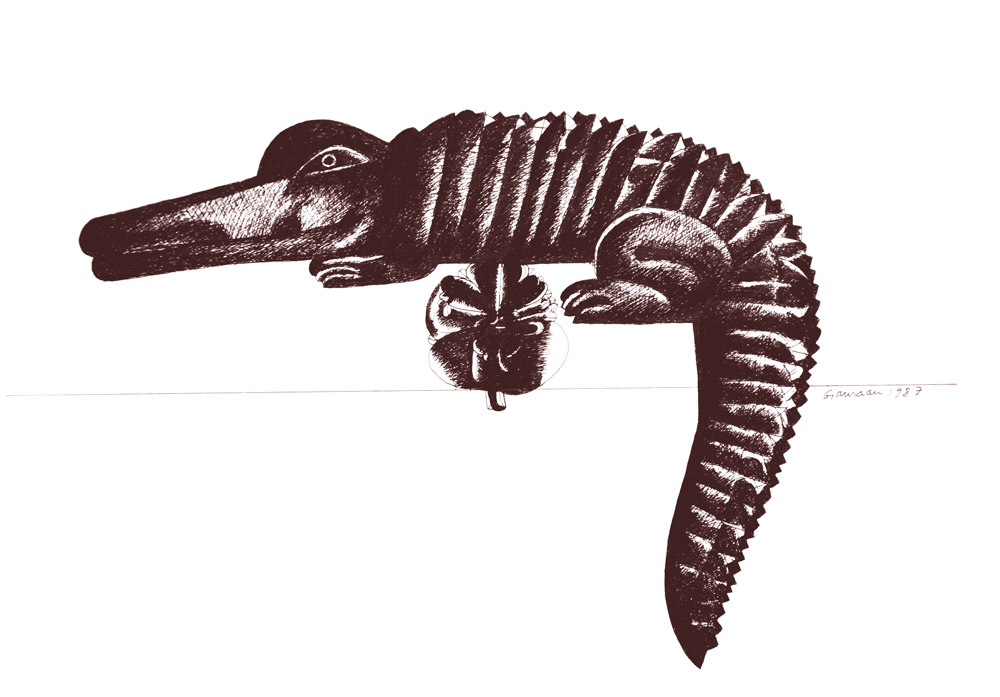
تمثل الترجمة، فكرة وإنجازاً، ما يشبه الانقلاب المعرفي. وتجربة “دار الحكمة” في بغداد، ربما كانت أساساً لهذا الانقلاب الذي يوصف بأن منطلق عصر النهضة العربي، فضلاً عن أنه من ناحية أخرى جسر اتصال أسهم في وصل الحضارة الغربية باليونان.
ولعل أحد أبرز نتائج ترجمة التراث الفلسفي الإغريقي إلى العربية، الإلحاح المستمر على غياب الدقة في الترجمة. وهذا مأخذ يتكرر اليوم في كتابات فلسفية وأدبية ونقدية عربية وغربية. وقد تمحورت هذه الكتابات على القول بأن المترجم خائن للأصل. وبما أن الدقة غاية، فلا بد من اعتبارها قيمة غائبة، مادامت المطابقة مع الأصل غير متحققة.
ولكن يمكن القول إن النقد الأدبي قد برهن على أن ما يدعى بـ”سوء القراءة” (Misreading) أي سوء قراءة النصوص، أو عدها غير قابلة للترجمة الدقيقة، ينطوي على قيمة يتعين أخذها على محمل الجد.
ولكن ماذا عن سوء القراءة المتعمد؟
في النقد الغربي ما يدعى بـ”الباروديا”(Parody) وهو مصطلح ظهر في الموسيقى قبل أن ينزاح إلى الكتابة التي تسخر من أسلوب كاتب معين أو أعماله أو من جنس أدبي محدد. ولعل من أبرز أعمال الباروديا كتاب “قراءات خاطئة” (Misreadings) للروائي والناقد السيميائي إمبرتو إيكو صاحب “اسم الوردة”.
هذه “القراءات الخاطئة” تتضمن أعمالاً مهمة يسخر فيها الناقد الإيطالي من رواية نابوكوف “لوليتا”، ومن “الأوديسة”، و”دون كيشوت”، و”نقد العقل المحض” للفيلسوف كانط.
وبالمقابل هناك القراءات العربية الخاطئة ولكن غير المقصودة، والمتمثلة في بعض ترجمات التراث الفلسفي اليوناني. ماذا استطراداً عن أثر هذه القراءات؟
في كتاب “نظريات الشعر عند العرب – الجاهلية والعصور الإسلامية” لمصطفى الجوزو، يشير المؤلف إلى اكتشاف مفاده أن “الترجمة المشوهة لنظرية أرسطو في الشعر” أبدعت فكرة “التخييل” التي يرى أنها “قفزت بالشعر العربي من الميدان العروضي البلاغي الجامد إلى حقل الصور المؤثرة في النفس، ولاسيما على يد عبدالقاهر الجرجاني الذي لم يبد كبير العناية بالفلسفة، وهو ذو ذائقة فنية رفيعة وثقافة عربية إسلامية سمحت له أن يمنح الفكرة اليونانية المصادر طابعاً عربياً أبعدها عن جذورها”.
ويضيف الباحث أنه وقف على مصطلحين للفارابي هما “القول الشعري” و”القول الخطبي”، ومصطلح لابن خلدون هو “الكلام المنظوم”.
ثم يعلق بقوله “القول الشعري خطوة متقدمة على طريق الشعر، لأنه يعني الكلام الشعري غير الموزون، مما يعني أن غياب الوزن لا ينفي الشعرية.”
وأما القول الخطبي، فيرى الباحث أنه الكلام الإقناعي الذي فيه من المحاكاة أكثر مما ينبغي. وهو مصطلح يصفه بأنه قليل الأهمية، لكنه جدير بالملاحظة. وأما “الكلام المنظوم فهو الكلام الموزون الذي يخالف الأساليب الشعرية، أي هو نقيض القول الشعري، وأهميته أنه يميز بين الشعر وبين النظم”.
ثم يضيف “ثمة وصف ابن رشد للمنطق الشعري بجعل الصورة الشعرية بمثابة المقدمة في القياس والتأثير في المتلقي بمثابة النتيجة. وهذا أمر شديد القرب إلى العقل.. ويعد حلاً وسطاً بين من ينفي المنطق عن الشعر وبين من يقحم الشعر في حومة المنطق الشكلي” (7).
أختتم هذه الملاحظات حول المعيارية في النقد بالقول إن تحقيقها ليس منوطاً بالناقد وحده. فالنقد في رأيي ماثل في عمل الناقد والشاعر معاً. الشاعر يمارس الفعالية النقدية في إبداع، والناقد يمارس الفعالية الإبداعية في نقده. ربما يصلح هذا الرأي كرد محتمل، بل ربما اختزال لرد، على المشكلية التي يواجهنا بها جاك دريدا ومدرسته عندما يتساءل عن طبيعة العلاقة بين ما هو نقدي وبين ما هو إبداعي.
هوامش:
1- العالم، النص والناقد” ص 53 (الطبعة الإنجليزية).
2- التراث والحداثة ص 16.
3- بيتر أدامسون: “الفلسفة في العالم الإسلامي” ص 29 (بالإنجليزية).
4- “مقدمة في الميتافيزيقا” ص 60 (بالإنجليزية).
5- أدونيس: “مدارات” – الحياة، 18 سبتمبر/أيلول 2014.
6- إمبرتو إيكو: Misreadings”” (الترجمة الإنجليزية).
7- مصطفى الجوزو: “نظريات الشعر عند العرب” ص 217.




