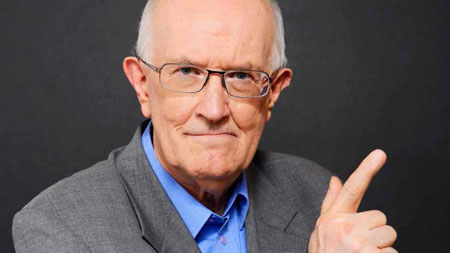منذ أشهر والجدل قائم في الأوساط الفكرية بفرنسا حول تنامي الراديكالية: هل ما نشهده هو راديكالية الإسلام أم أسلمة الراديكالية؟ هل هو نزوع الإسلام من جهة التنظير والمِراس نحو راديكالية ذات صلة بتاريخه، كما يقول جيل كيبل، أم أن الجهاديين “نيهيليون” انخرطوا في راديكالية سياسية طبعوها تجوّزًا بطابع الإسلام؟ ومع تصاعد النبرة الهووية في خطاب السياسيين للتشديد على الجذور المسيحية لفرنسا، برز جدل آخر حول حضور الدين في بلد علماني فصَل منذ أكثر من قرن بين الدين والدولة: هل يمثل ذلك عودة الديني أم توسلا بالديني لأغراض سياسية؟
فيما يرى آخرون أن الحديث عن عودة الأديان لا يصحّ، لأن الأديان لم تزُل، حتى في البلدان الغربية المتقدمة، فرغم “قتل الرب”، لم يزَل هذا الرّب حاضرا ولو على المستوى الفردي، ولم يفتأ الدين على مرّ الأحقاب يؤدي وظائف اجتماعية تعجز المؤسسات الحديثة عن النهوض بها على الوجه المرضي، بل ثمّة من يعتبر العلمانية ديانة هي أيضا، فيما يذهب غيره إلى القول من القائلين بالخروج من الدّيني الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي مارسيل غوشيه، ففي رأيه أن الدين نظّم على مرّ العصور حياة المجتمعات، ثم جاءت الحداثة لتبتكر أنساقا فكرية ومعرفية وتقنية تنوب عنه في تنظيم المجتمع، وتمهّد شيئا فشيئا للخروج من الديني.
والخروج من الديني لا يقتصر على المجتمعات الغربية وحدها بل يشمل العالم كله، فهو المقصد النهائي للعولمة، التي تعتبر في نظره تغريبا ثقافيا للعالم تحت ملامح علمية وتقنية واقتصادية، ناتجة بدورها عن خروج الغرب من الدين، ما يجعل انتشارها يفرض على كافة المجتمعات قطيعة مع التنظيم الديني للعالم. ولا نستغرب، يقول غوشيه، أن تعاش الحداثة في بعض الظروف كعدوان ثقافي يثير ردة فعل عنيفة لرصيد ديني بصدد التفتت، ولكنه حاضر بما يكفي لإعادة لملمته وحشده، وخاصة في العالم الإسلامي، حيث توجد ضغينة في الوعي الجمعي تجاه وضعية ملتبسة.
فالإسلام بالنسبة إلى معتنقيه هو الأفضل والأسمى ولكنهم خضعوا للغرب عبر الاستعمار، ولا يزالون يخضعون له اقتصاديا. وهذا لا يطابق الوعي الديني الذي يحمله المسلمون عن موقعهم في هذا التاريخ المقدّس، ومن ثَمّ كانت غاية الأصولية الإسلامية العودة إلى الدين بحثا عن أسباب قوة تمكّنهم من الصمود أمام الغرب ولمَ لا قهره. أما المجتمعات الأوروبية فتقع، لأسباب تاريخية، في طليعة الخروج من الدّين، ما يجعلها الأَوْلى بالتألّم من هذا النقص، لا سيما على المستوى الفردي، ولكنّ المساعي الذاتية ذات الطابع الروحي لا تأخذ بتاتًا شكل حركة سياسية.
أما الأصولية فهي مشروع سياسي ذو منطلقات ثورية، يهدف إلى إعادة تنصيب الدين في السلطة، وتنظيم حياة الناس، كما هو الشأن في الإسلام، الذي تمثّله رمزيا العودة إلى الشريعة، كقانون يشمل مختلف نواحي الحياة المشتركة.

فنسان دولاكروا
فهو إذن مشروع مجتمعي راديكالي، وإن كان يختلف عن التوتاليتارية كما عرفها القرن العشرون، ولكنه مشروع محكوم عليه بالفشل، لأنه لا يمثل بديلا للحداثة، بل إنه سيدخل فيها رغما عنه ولو على أعقابه.أما الهندي سنجاي سوبراهمانيام، أستاذ التاريخ الشامل بالكوليج دو فرانس، فله رأي آخر.
أولا، أن مسألة “عودة الديني” التي تثار منذ عشرين سنة يقصد بها الإسلام أساسا، ولا تجادل بمثل هذه الحدة إلا في فرنسا. ففي الولايات المتحدة، لا يكاد يوجد مثل هذا الخوف من ممارسة المسلمين شعائرهم، برغم بعض الأحداث العنيفة، وما يشغل الأميركان بالدرجة الأولى هو عداء الإسلاميين وبعض الدول الإسلامية لبلادهم وتهديدهم لمصالحها، وهذا لا يستلزم منهم غير ردّ سياسي قبل شيء.
أمّا في أوروبا فالموقف من الإسلام يختلف من بلد إلى آخر. ففي فرنسا، تعكس ردود الأفعال المعادية للإسلام خوفا من المستعمَرين القدامى، الذين يقال إنهم يهددون القيم الوطنية، ما يعيد إلى الواقع الصراع السابق في بلدان شمال أفريقيا. مثل هذا الشعور موجود أيضا في بريطانيا، ولكن معالجته يسَّرها البعد الجغرافي للمستعمَرات القديمة، إذ يمكن للأجانب أن يجهروا باختلافهم من جهة الثقافة واللباس والتقاليد، والترقّي الاجتماعي لا يأخذ بعين الاعتبار ذلك التميز البادي في العرق والهيئة ما دام الفرد يحترم المؤسسات وطرق اشتغالها.
حسبه أن يكون محايدا ثقافيا ودينيا كي يتمتع بالمصعد الاجتماعي. بينما ظلت العلمانية على الطريقة الفرنسية، بجعلها الدين محصورا في المجال الفردي، تعيش على الشك، إذ ترى في الأجنبي حصان طروادة، وفي المهاجرين تهديدا أصوليا ظلاميا.
ثانيا، أن المجتمع الأميركي الذي يدين بما جاء في دستور الآباء المؤسسين من كونه أمّة بروتستانتية، يشهد ظهور ديانات جديدة أهمهما الديانة الكاثوليكية للشعوب ذات اللغة الأسبانية، المتحدرين من أميركا الوسطى ومن أميركا الجنوبية، وهي شعوب عميقة الإيمان في عمومها، متمسكة بإقامة شعائرها، ولا تساورها فكره ترك الدين أو الخروج منه.
ثالثا، أن النظر إلى المسألة الدينية من هذه الزاوية يكاد لا ينطبق إلا على أوروبا، فلكي يقع الفصل بين الكنائس والدولة، ينبغي أن تكون ثمة كنيسة وأن تتشكل الدولة على ضوئها، والعكس صحيح. ولكن الهندوسية مثلا ليست لها كنيسة، ما يجعل السلطة في الهند تعيش داخل الدين وخارجه في الوقت نفسه، مع الحرص الدائم على احترام المسافة بينهما. فكيف يمكن في ظل هذا الاختلال، يقول مؤرخ الثقافات الهندي، أن تُدار العلاقات بين الجاليات المختلفة في الهند، ويُحترم الفصل الضروري بين المدني والديني؟ وفي رأيه أن ما يقترحه غوشيه ليس سوى مسلك خاص بالمغامرة الديمقراطية في الغرب.
حتى هذا المسلك يضعه الفيلسوف فنسان دولوكروا، الأستاذ المحاضر بالمعهد التطبيقي للدراسات العليا بباريس والمتخصص في كيركيغارد، موضع مساءلة، فهو يستغرب من الحديث عن “عودة الديني” والحال أن الديمقراطيات المعاصرة لم تستطع التحرر من مفاهيمه. ويستشهد بمقولة نيتشه، مستكشف “الإلحاد غير الأمين” والقائل بموت الرب “ألا يزال يجري دم رجل دين في عروقنا؟”، والسبب في رأيه تصوران مرتبطان ببعضهما بعضا وإن كانا غير متماثلين.
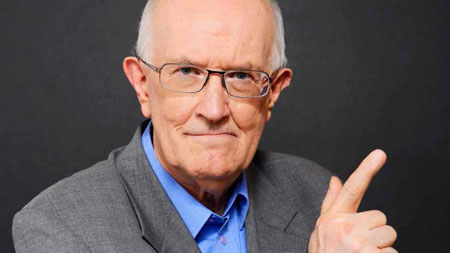
مارسيل غوشيه
باسم الأول ننزعج من انتهاكات الديني للحقل السياسي، والحنين الفقهي السياسي والمطالبة الثيوقراطية العنيفة. ذلك أن استقلالية الوعي، وحرية التفكير، والأنوار، ونهاية الوصاية التيولوجية، واستقلال السياسي، وكل تلك الأشياء المكتسبة بعسر، تجعلنا جافلين نافرين. بالنسبة إلى الفكر الفلسفي، كان يلزم جهد كبير لمرافقة النكوص التاريخي للمؤسسة الدينية وتراجعها الاجتماعي البطيء لبلوغ المعجزة غير المكتملة للمجتمع الحديث. وباسم الثاني، نتساءل عما يتيح هذه العودة المزعومة، إصرار الأشكال الدينية القديمة، أو بروز أشكال غير مسبوقة، بعضها غريب عن تشكل الغرب، ولكن قوّته تسائل المجتمعات الغربية بعمق. وهي ظاهرة تكذّب الأفكار المسبقة التي ترتكز عليها السردية السيرذاتية الكبرى للحداثة. هذه السردية التي وصفها الفيلسوف تشارلز تايلور في “العصر العلماني” بكونها تاريخا بالطرح، أي أن الحداثة تتنامى والدين ينحسر، فإن تبقّى شيء من الدين فمعناه أننا لسنا حداثيين حقّا، أو أننا لا نريد أن نكون فعلا كذلك.
بقيت اللائكية، هذه التي تخاض حولها الآن حروب أيديولوجية حامية الوطيس، فبعد أن وُضعت أساسا لتأمين حرية الضمير، صارت تهدد بأن تنقلب سلاحا لحسم الجدل، وحتى حظره. لقد ألغى قانون الفصل بين الدين والدولة عند إقراره في 9 ديسمبر 1905 الاتفاقية (كونكوردا) التي ضمنت البعض من الحقوق للكاثوليكيين، ووضعَ حدّا لعداء الدولة للكنيسة، مع التأكيد على “حرية المعتقد” و”حق ممارسة الشعائر” في إطار “نظام عام” ديمقراطي، دون أن يتضمن عبارة “لائكية”، ولكنه اتخذ على مرّ السنين وجهة أخرى، فجرى الحديث عن “الجمهورية اللائكية” وجذورها المسيحية، وكاثوليكية ثقافية منزوعة من بعدها الإيماني كعنصر أساس للهوية الفرنسية.
مثلما كانت حركة العمل الفرنسي اليمنية تجعل المسيحية الهووية مرجعيتها وجدارها الرمزي ضد مواطنين أقلّ فرنسية من سواهم فيما تزعم، أي أولئك الذين أخذ المسلمون اليوم مكانهم. وتعددت تأويلات العلمانية بين خطاب اليسار، وخطاب اليمين “غير المعقد” بعبارة ساركوزي، واليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، حتى باتت في نظر بعضهم تتعارض مع حقوق الإنسان (كما جاء في تقرير لفرنسوا باروان أحد وزراء جاك شيراك بعنوان “من أجل لائكية جديدة” عام 2003) أي أن العلمانية الآن لم تعد ترفع ضد الكاثوليكية بل ضد الإسلام، بمناسبة وبغير مناسبة، حتى ليخال المرء أنها ديانة تخشى المزاحمة.
وصفوة القول أن الدين سواء عاد أو لم يعد، فإن اتخاذه علاجا هو أشدّ من الدّاء، والذين يستعملونه لا يعرفون ما يصنعون. فالدين وإن كان “أفيون الشعوب” كما قال ماركس، يمكن أيضا أن يعبّر “عن احتجاج ضد البؤس الواقعي” حسب عبارة ميشيل فوكو، و”روح عالم بلا قلب”، كما استخلص من الثورة الإيرانية، وكما ينطبق على واقع الجاليات المسلمة في فرنسا، ولكن توسّله بالعنف ينقله إلى مجال السياسة. يقول عالم الأديان الألماني يان أسمان “العنف ينتمي إلى حقل السياسة، لا الدين، والديانة التي تتخذ العنف تبقى جامدة في إطار المجال السياسي، وتخطئ وظيفتها الحقّ.