جاد الكريم الجباعي: بعد ثقافة العبيد تأتي ثقافة الحرية

بداية هل هناك في نظرك ثمة كوسمولوجيا معينة، أو رؤية عامة للكون، خلف التصورات المختلفة للمستقبل؟
الجباعي هذا مؤكد. ذلك لأن العلاقات الاجتماعية والإنسانية وسائر القيم المعيارية والأشكال المؤسسية ترتبط أوثق ارتباط بالرؤية العامة للكون، للطبيعة والعالم والمجتمع والإنسان، وللمرأة بوجه خاص، ومدى انفتاح هذه الرؤية على واقع التنوع والاختلاف.. أي إنها ترتبط أوثق ارتباط بالثقافة التي يتبناها الأفراد والجماعات ويعدّونها هويتهم، على اعتبار الثقافة أول رأسمال بشري. فالرؤية الكوسمولوجية العامة لنشأة الكون ونظامه ونشأة الإنسان والاجتماع البشري ونظامه تحكم الأفكار والتصورات والقيم وعمليات إنتاجها اجتماعياً. ومن ثمة لا يكتمل تفسير الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية التي أنتجتها الثورة من دون الكشف عن خلفيتها الكوسمولوجية، الأسطورية، والدينية ذات البعد الأسطوري، ولا سيما أسطورة الخلق التوراتية وفكرة الخليقة ومركزية الذات الفردية والجمعية (ego-centralism)، فهي التي تحدد إمكانية أو عدم إمكانية الاعتراف المتبادل بين الأفراد والجماعات بالتساوي في الكرامة الإنسانية والحقوق المدنية والسياسية، والتشارك الحر في الشؤون العامة وفي حياة الدولة، وتحدد من ثمة إمكانية أو عدم إمكانية أن تكون الدولة فضاء عاماً ووطناً سياسياً لجميع مواطناتها ومواطنيها بالتساوي، بلا استثناء أو تمييز، على أساس العرق أو الدين والمذهب أو الجنس أو لون البشرة أو اللغة والثقافة أو الانتماء الفكري والسياسي.
فلا يمكن لمن يعتقدون بفكرة “شعب الله المختار”، وبأنّ “الأمّة الإسلامية” خير أمّة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي تأمر بما تراه هي وحدها، أو الناطقون الرسميون باسمها، معروفاً، وتنهى عما تراه هي وحدها، أو الناطقون باسمها، منكراً، لا يمكن لهؤلاء أن يقبلوا بتساوي الأفراد المختلفات والمختلفين في الكرامة الإنسانية والحقوق المدنية والسياسية والمشاركة المتساوية في الحياة العامة، ولا يمكن أن يقبلوا بحقيقة أن العدالة تدبير بشري للكون الاجتماعي، لا تدبير إلهي للكون. هذه الرؤية الكوسمولوجية تستعاد دوماً في الوعي واللاوعي، ولدى ممارسة الطقوس والشعائر.. وهي مبثوثة في العادات والتقاليد والأعراف، علاوة على “التراث”، ولكنها تغدو متوترة في أوقات النزاع، وتشكل أساس الخطاب الأيديولوجي.
في ضوء التوتر الحاصل، من الصعب تعيين الحد الفاصل بين “القراءة الأصولية” للنصوص التأسيسية وما يسمى “القراءة المعتدلة”، فالأصولية قاسم مشترك بين القراءتين أو التأويلين، إذ ما الفرق بين قراءة تنظيم دولة الخلافة في العراق والشام وممارساته الهمجية، المستندة إليها، وبين فتوى الأزهر، رمز الاعتدال، في جواز حرق أعضاء هذا التنظيم وتقطيع أوصالهم، رداً على إحراق الطيار الأردني، الذي يقاتل في صفوف “الصليبيين” وحلفائهم، ناهيك عن القراءات الإخوانية؟ هذا لا يعني أن ثمة قراءات معتدلة بالفعل لمفكرين مستقلين عن المؤسسات الدينية.
“القراءة الثورية” قراءة أصولية أيضاً، تنبثق من كوسمولوجيا مادية أو مادوية وُضعت أسسها منذ ما سمي الثورة الكوبرنيكية (نسبة إلى كوبرنيكوس)، التي نفت مركزية كوكب الأرض في الكون، وفي المجموعة الشمسية، وأسست لنفي مركزية الإنسان، ورفدتها النيوتنية، التي رأت الكون آلة متقنة الصنع، والداروينية في ما يخص نشأة الإنسان. المادية المشار إليها مادية ميكانيكية، تجاوزتها المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، عند ماركس وإنغلز، ولكن هذه الأخيرة باتت عتيقة، بعد نسبية آينشتاين العامة والخاصة ومنجزات الفيزياء الأحدث والنظرية الهولوغرامية. الأصولية والتطرف سمتان للعصبية، بالمعنى الخلدوني، وهذه تحمل جرثومة العنف والإرهاب، فلا فرق كبيراً بين أصولية وأخرى، سوى الفرق الذي يقيمه الهوى. المشهد الثقافي العربي مشهد أصوليات متنافية ومتعادمة، لم يفلح التلفيق، القومي والإسلامي والاشتراكي، سوى في تأجيل التنافي والتعادم اللذين نشهد تظاهراتهما في صفوف “النخبة” وصفوف العامة على السواء؛ فقد كشف انفجار المنطقة عن انحطاط ثقافي وأخلاقي مريع، بفعل اكتساح الأيديولوجيا للمجالين الثقافي والسياسي، وإلا كيف يمكن تفسير هذا النكوص إلى الهمجية؟
النخب والشعب
أين ترى دور الخطاب الشعبي الراغب بمتابعة شؤون حياته بعيدا عن صراعات القوّة التي تشهدها المنطقة..؟ وهل هناك من قنوات قادرة على إيصال صوت الناس..؟ ومن هو المعني بسماع أصواتهم في ظل التناقضات المتصارعة على الأرض والخطاب والتوجه..؟
الجباعي يطرح هذا السؤال عدة مشكلات جدية، أولاها أن أكثرية الشعب مفقرة ومهمشة ومستبعدة من مجالي السياسة والثقافة، (تقدر نسبة الفقراء السوريين فقراً متعدد الأبعاد، اليوم، بنحو 80 بالمئة من السكان)، فمنذ أزيد من نصف قرن لم يسأل أحد عن الشعب، ولم يصغ إلى صوته، وتطوعت نخبة ثقافية وسياسية للنيابة عنه، في حين عملت السلطة كل ما تستطيع من أجل كتم صوته كلياً، وحين حاول أن يتعلم الكلام عاجلته بترسانتها العسكرية والأمنية والأيديولوجية والإعلامية. والثانية هي انفصال النخبة عن الشعب، وهو ما يضمره السؤال عمداً أو عفواً، منطلقاً، على الأرجح من هشاشة النخبة وخلافاتها التي لا تنتهي، وعجزها عن التوافق على رؤية وطنية مشتركة، وتحوّلها إلى استطالات للقوى الإقليمية والدولية وأدوات في أيديها. والثالثة أن الاستقطاب الحاد بين السلطة و”المعارضة” أحدث تصدعاً عميقاً في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت طويل لرأبه. فتراجعت إمكانية التوافق على المستقبل تراجعاً خطيراً، في ظل تمادي العنف والإرهاب وتقطيع أوصال البلاد وهيمنة الأيديولوجيات الإثنية والدينية والمذهبية على معظم النفوس والعقول. والرابعة أن الثقافة القومية، التي فرضت على الشعب وأريد لها أن تتحول إلى “دين شعبي”، لأنها محوَّلة عن عقيدة دينية أساساً، لم تحل دون إعادة إنتاج “الثقافة الشعبية”، التقليدية، بل حفزت ذلك بطرق شتى. وأخيراً لم يبذل المثقفون والمؤسسات الثقافية أي جهد لردم الهوة بين الثقافة الشعبية الشفوية والثقافة “الرفيعة” المكتوبة، على افتراض أن ثمة ثقافة رفيعة ذات شأن.
من البديهي أن جميع أفراد الشعب غير المنضوين في جماعات مسلحة ومؤسسات عنف، وغير منخرطين في القتال يتوقون إلى متابعة حياتهم بهدوء، بعيداً عن صراعات القوى. ولكن هذه البداهة غير كافية للحكم في وجود “خطاب شعبي” أو توجه شعبي من هذا النوع. لأن فئات الشعب المختلفة ليست خارج علاقات القوة وصراع القوى، وإلا فإن صراع القوى يجري في فراغ. الأرجح أن هناك من النخبة من ينتحل خطاباً “شعبياً” على مجرى العادة، مؤداه التوق إلى “عودة الحياة إلى مجاريها”، ولا يستبعد أن يكون هذا الخطاب ملغوماً، يتجاهل أربع سنوات كانت أربعة عقود من التوتر والمعاناة على الأقل. يبدو لي أن هذا الخطاب المنتحل أو المنحول، خطاب مصنوع أو مطبوخ في مطابخ السلطة /السلطات، فلم نسمع عن أي مسح جدي أو بحث ميداني يثبت أن ثمة صوتاً للشعب أو أكثريته، أو أن ثمة ميلاً فعلياً يتشكل ويبحث عن أدوات مناسبة لإمكان تحققه. يتعلق الأمر، هنا، بتحديد من هو الشعب. المثقفون والأحزاب السياسية يتحدثون عن شعب في رؤوسهم، لا عن شعب له وجود عياني وتنظيمات ومؤسسات ذات نظم مستقرة وقيم حاكمة. لنتساءل: أليست النقابات على أنواعها والأحزاب السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية و”المنظمات الشعبية” الرسمية ونظيراتها مما أنشأته المعارضة هي الشعب؟ أم بقية الأفراد المنعزلين واللامبالين والمنكفئين على أنفسهم؟ أليس الشعب بنية علائقية بين أفراد حرائر وأحرار ومنظمات ومؤسسات، أم هو مجرد معطى إحصائي؟
المثقف النقدي

إثر التغيرات التي تمر بها المنطقة رأينا العدد من الشخصيات الثقافية والأدبية تتوزع وتنقسم، بعضها شارك الشارع/الشعب همومه والتحم به، والبعض الآخر نأى بنفسه، لنجد أنفسنا أمام شكلين: المثقف المنخرط في خطاب التغيير والآخر مشاهد يقوم بالتقييم، لكن ما رأيك بانخفاض صوت النقد لحراك التغيير نفسه، وكيف تصف الانحيازات التي اتخذها البعض في ظل طغيان خطاب الخوف على خطاب التحرر؟
الجباعي هذا سؤال يثير كثيراً من الشجون، وينطوي على التباسات. في الشجون، سألتني في بدايات الثورة السورية صبية، تعرف أنني “معارض مرّ”: لمَ لا نراك في المظاهرات والاعتصامات؟ فأجبتها ببساطة، لأنني أعتبر هذه الثورة ثورة عليَّ وعلى أبناء جيلي، وليس من حقي وحق أمثالي أن يركبوا موجها، فنحن مسؤولون عما وصلت إليه بلادنا من فقر وحرمان واستبداد وطغيان، ولا سيما من كانوا مثلي منخرطين في أحزاب أيديولوجية معارضة أو موالية، ولا فرق، أو مع فروق ضئيلة، لكي لا ننفي مبدأ الفرق والاختلاف. أحد الفروق الضئيلة أن الأحزاب الموالية تدافع عن سلطة قائمة ومكاسب وامتيازات فعلية، والأحزاب المعارضة تناضل من أجل سلطة ممكنة ومكاسب وامتيازات ممكنة. وكل واحد من هذه الأحزاب ملة ناجية قائمة بذاتها، وله مشروعه الخاص لوطن لا يتسع لغيره، وشعب هو شعبه الخاص، كشعب الله المختار.
أما في الالتباس، فالأمر يتعلق بمن هو المثقف، من جهة، وبالقسمة التي أقامها غرامشي، وصارت سنَّة، بين المثقف العضوي والمثقف القابع في برجه العاجي، فضلاً عن المثقف البورجوازي(=الليبرالي). بالمعنى الواسع للثقافة، جميع الناس مثقفون، على ما بينهم من اختلاف وتفاوت. وبالمعنى الضيق، المثقف هو من ينتج أفكاراً وتصورات جديدة ومعاني وقيماً جديدة، وينقد ما هو سائد ومحفوظ ورثّ ومتخلف، والمثقفة كذلك. بهذا المعنى الضيق المثقفة هي الفاعلة في الحقل الثقافي والمثقف كذلك. ومن ثمة فإن السؤال يتحول إلى الفاعلية الثقافية شكلاً ومضموناً واتجاهاً وغاية. في سوريا جفاف ثقافي مزمن، منذ تسيّدت “الثقافة القومية الاشتراكية” طيّبة الذكر، فأنتجت مثقفة السلطة ومثقف السلطة، سواء كانت السلطة هي السلطة القائمة بالفعل أم السلطة الممكنة، ولو نظرياً. بهذا المعنى الأكثرية العظمى من المثقفات والمثقفين عضويات وعضويون بالمعنى الغرامشي، وبعضهن مخبرات وبعضهم مخبرون، وهذا شكل مبتكر من النضال.
من البديهي، وهذه الحال، أن يكون صوت النقد خفيضاً وخجولاً، وأن يكون المثقف الناقد منبوذاً، والفكر النقدي مهمشاً، لأننا إزاء عقائد يندرج نقدها في باب المحرمات ويوصف بالانحراف والتحريف والهرطقة والزندقة والكفر، ولا سيما نقد الثورة التي رفعت إلى مصاف المقدسات والثوريين الذين رفعوا إلى مصاف القديسين. التقديس عنصر في الشعور، يظل مقبولاً في إطار الرؤية الشعورية والموقف الشعوري، ولكنه غير مقبول في إطار الرؤية النقدية والموقف النقدي. النقد إبداع وشرط من شروط الإبداع، فليس بوسع الكثيرين أن يكونوا نقاداً، إلا إذا اعتبرنا السجالات العقيمة الدائرة اليوم نقداً. النقد غير المساجلة والمجادلة والملاسنة والكيد، لأنه يذهب عميقاً إلى الجذور والأساسات ويهدم ما يتغذى منها وما بني عليها، ويكشف عن خيط الحياة الرهيف القابل للنمو والتطور في الظاهرات والنصوص التي تناولتها وتتناولها. النقد موقف شاق ومكلف، وكذلك الانحياز إلى الثورة أو إلى المستقبل الممكن.
أنا أتفهم الخوف البشري، لأنني أخاف، ولا أدين الخائفين، بل أدين الشروط الاجتماعية والسياسية والدينية والنظم الاستبدادية، التي تنتج الخوف وثقافة الخوف، وأتفهم حق الأفراد في الاختيار، وأحترم خياراتهم، إذ قلّما يتوقف أمر من الأمور على خيارات فلان وفلانة من المثقفين والمثقفات، في أوقات النهوض، إذا كان المقصود من السؤال الغمز من قناة هذا المثقف أو ذاك. ثمّة مثقفون هنا وهناك يشمئزون من التسلط والاستبداد والفساد، ولكنهم لا يجرؤون على مواجهتها ومواجهة المستبدين والمتسلطين والفاسدين بأعيانهم. هكذا هي الأمور، وهكذا كانت على الدوام، عندنا وعند غيرنا. لقد مرّ وقت طويل في سوريا كنا ننقد الاستبداد والتسلط والفساد والانحطاط الأخلاقي.. ولكننا لم نكن نجرؤ على تسمية المستبدين الصغار والمستبد الكبير الذي يتربع على قمة هرم الاستبداد، حسب وصف الكواكبي، ولم نكن نجرؤ على تسمية المتسلطين والفاسدين والمنحطين أخلاقياً بأسمائهم. ومن علامات خوفنا أننا كنا، ونحن نعاني من استبداد حافظ الأسد، نضرب مثلاً على الاستبداد بصدام حسين تحديداً، لأنه خصم حافظ الأسد.
ثقافة العبيد
هناك أصوات ومواقف هامشية شهدتها المنطقة انبعثت في ظل التغيرات، وقد وجدت لنفسها قنوات مختلفة لإيصال أصواتها، هل يمكن التعويل على هذه الأصوات في ظل غياب الرؤية الواضحة للمستقبل، وأين دور النخبة المثقفة (في حال وجودها) في التأسيس لحضور هذه الأصوات التي تمثل رؤية جديدة لمستقبل المنطقة..؟
الجباعي حسنٌ إذا كان للأصوات والمواقف الموصوفة بالهامشية، وهو وصف إيجابي، في نظري، قنوات لإيصال أصواتها، فهذا تقدم كبير، ولكنني لا أرى الأمر كذلك. ويحزنني موقف “النخبة المثقفة” السورية، إذا كان من الجائز أن نتحدث بهذه العمومية. فحين أشرت إلى جفاف الحياة الثقافية في سوريا، كنت أقصد من جملة ما أقصده هزال النخبة المثقفة وتنثّرها وعجزها عن القيام بالدور الذي يفترض أنه منوط بها، في لحظة تاريخية نادرة (لا نزال فيها). لعل مرد هذا العجز والتنثّر وأشياء أخرى من هذا القبيل إلى تبعية الثقافة للسياسة على مدى أكثر من نصف قرن، وتبعية المثقف للسياسي. يبدو أننا محتاجون إلى تحوير قولة كارل ماركس “نقد الدين مدخل إلى نقد السياسة”، لتصير نقد الثقافة مدخل إلى نقد السياسة. السياسة عندنا حرب، هي منظومة حروب صغيرة وتافهة، تديرها مصالح خاصة عمياء، لا علاقة لها بتدبير الشأن العام وتقدم المجتمع وإثراء الحياة الإنسانية. و”السياسي” الأميّ غالباً والمنتفخ فساداً وغطرسة هو أستاذ المثقف ووليّ نعمته. طوبى للأصوات المهمشة التي وجدت لها قنوات “إعلامية”.
ليس للنخبة السورية المثقفة أي دور مختلف عن الدور الذي تقوم به اليوم، ما لم تستقل الثقافة عن السياسة، والمثقف عن السياسي، وتعود الأمور إلى نصابها حيث يعود المثقف أستاذاً للسياسي، لتحرير السياسة من الجهل، وتحرير الثقافة من الشطارة، ووضع للأيديولوجيا التي التهمت الثقافة، وتعرية المثقف الذي يلعب بالبيضة والحجر، ويقدم خدماته، غير مشكور، لمن هو أدنى منه معرفياً وأخلاقياً. التبعية هي التبعية، سواء كانت لقوى التسلط المحلية أم لقوى إقليمية ودولية. وظيفة المثقف الحر هي مناهضة التبعية، وهذه اسم آخر للعبودية. العبد، حسب أرسطو، هو من ضعفت روحه وقلت حيلته، فأتبع نفسه لغيره. يجب أن يفتح في سوريا ملف ثقافة العبيد وأخلاق العبيد.
المنظمات المدنية
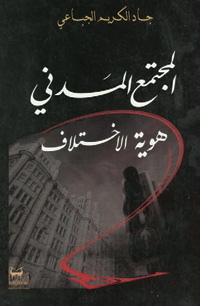
هناك آراء ترى أن جهود المؤسسات المدنية في سوريا التي تشهد حربا ضارية هي جهود عبثية، إذ الشارع مشغول بقوت يومه، إضافة إلى أن التهديدات تستهدف وجوده، ما رأيك بهذا الرأي…؟
الجباعي قد تكون هذه الآراء مغالية قليلاً أو كثيراً، إذ لا غنى عن انتظامات المجتمع المدني وتنظيماته. بل أذهب إلى أن مستقبل سوريا منوط بنمو التنظيمات المدنية، على اختلافها وتعدد وظائفها وأهدافها المحلية والوطنية. فإن خنق المجتمع المدني في سوريا وحظر تنظيماته المستقلة، واختراع “منظمات شعبية” وتشكيلها بمراسيم فوقية، وجعلها أدوات توتاليتارية علاوة على خنق مؤسسات الدولة وتحويلها إلى إقطاعات خاصة، من أبرز أسباب الانفجار الربيعي عام 2011. واليوم ليس للشعب السوري من قوة يواجه بها إرهاب السلطة وإرهاب الجماعات الجهادية سوى انتظامات المجتمع المدني وتنظيماته ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وعمليات الإغاثة الجارية على الأرض تؤكد ذلك. ولا بد في هذا السياق من تفهم مصاعب الولادة والنمو، وضرورة نقد المنظمات الناشئة لتنصبّ جهودها في مشروع إنتاج عقد اجتماعي جديد. لذلك لا أرى أيّ عبثية في جهودها أو لا جدوى منها، مع الحذر من ارتهان بعضها كلياً أو جزئياً لقوى سياسية محلية أو خارجية، فإن ما يجعل من هذه المنظمات منظمات مدنية حقاً وفعلاً هو استقلالها وعمومية وظائفها وقيمها الأخلاقية، سواء كانت هذه الوظائف محلية أم وطنية.
منظمات وظيفية
هل مؤسسات المجتمع المدني وما ينضوي تحتها قادرة على الوقوف في وجه الخطابات المختلفة التي تقدمها النخبة المثقفة، التي تحتكر المنابر وتمارس عنفا من نوع ما (رمزيا) على صوت الشارع..؟ وهل هناك من حلّ لحالة الفصام بين ما تراه النخبة وما يعانيه الشارع في المنطقة وخصوصا في سوريا؟
الجباعي أفترض أن منظمات المجتمع المدني ومؤسساته ليست خطابية، وليست معنية بالخطابات، التي تقدمها النخبة أو تعتاش عليها، على اختلافها وتعارضها، إنها بالأحرى منظمات وظيفية تتشكل بدواعي الحاجة، بمبادرات مدنية ذاتية، لتقوم بالوظائف الاجتماعية التي لا تقوم بها الدولة أو تقصّر عن القيام بها، بل هي معنية في المستقبل بانتزاع بعض وظائف الدولة، لكي تحول دون تجاوزات السلطة على حريات الأفراد وحقوقهم المدنية والسياسية، وتكون قوة ضغط ورقابة على الحكومات.
في جميع الأحوال، لا تزال ثقافة المجتمع المدني جنينية عندنا، ولا تزال روح المبادرة المدنية ضعيفة، وكذلك الشعور بالمسؤولية، ولا تزال الهوة قائمة بين الحياة الشخصية للأفراد وبين حياتهم النوعية، أي حياتهم الإنسانية، الاجتماعية والسياسية والثقافية العامة، وذلك بسبب هدر مبدأ العمومية، ولا سيما عمومية الدولة، التي غدت في سوريا “دولة البعث”. وهذا ما يفسر سيطرة السلطة العسكرية-الأمنية سيطرة مطلقة على المجتمع وعلى الحيوات الخاصة للأفراد والجماعات، فمن البديهي أن هدر العمومية هو هدر للخصوصية.
هناك منظمات أقامتها السلطة والأحزاب “السياسية”، توصف بأنها منظمات مجتمع مدني، وليست كذلك بالفعل، بل هي استطالات سلطوية، لأن السلطات والأحزاب العقائدية لم تعن وليست معنية اليوم بالمجتمع المدني ومسائل الاندماج الاجتماعي، بل لعلها من العقبات التي حالت ولا تزال تحول دون ذلك. هذه المنظمات ضرب من احتيال على المجتمع المدني. وبالمناسبة لم توصف هذه المنظمات بالمدنية إلا في سياق “ربيع دمشق”، عام 2001، لقطع الطريق على المبادرات المدنية المستقلة.
قطيعة معرفية
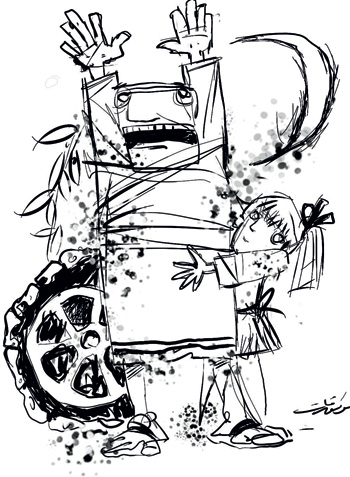
رسمة لموفق قات
يشهد الشارع السوري عددا من التصورات التي ترتبط بمستقبله وتختلف باختلاف وضعية السوري، فهناك من يعيش في ظل الحرب والقصف، وهناك من يعيش في المناطق الآمنة وهناك من في الخارج، كل التجمعات ترى لنفسها مستقبلا يختلف عن الآخر هل من طريقة لإيجاد صيغة تجمع كل هذه الرؤى في ظل دولة سورية مدنية ديمقراطية وذلك لاختلاف الظروف التي تمر بها كل فئة..؟
الجباعي لعل كثرة التصورات وما تنطوي عليه كل منها من رغبات يعني عدم وجود تصور قابل للتحقيق، وإلا لكنا في وضع مختلف عمّا نحن فيه. كل التصورات مشروعة، من وجهة نظر أصحابها، ما دامت تصورات ذاتية ورغبات. لم يصل السوريون بعد إلى نقاش عام حول عقد اجتماعي جديد، ولا تزال القوى الخارجية تحول دون ذلك، وتعمل على إضعاف جميع الأطراف، لتكون طيّعة لها وأدوات لتحقيق مصالحها. هذا “التشاؤم”، لمن يريد أن يصفه كذلك، نابع من غياب المصلحة الوطنية العامة عدة عقود، إذا لم نذهب إلى أبعد من ذلك. مفهوم الوطنية المرادف للعمومية، التي لا تنفي الخصوصيات ولا تلغيها، غائب عن الوعي والثقافة. كل فئة أو جماعة تريد لخاصِّها أن يكون عاماً. هذا هو الاستبداد، الذي لا نزال في أحضانه، وهو من أبرز أسباب خلافات “النخبة”. هذه الوضعية تحتاج إلى كسر، وقطيعة معرفية وفكرية وأخلاقية مع الاستبداد. لعل الأصدقاء الروس والإيرانيين أو الأتراك والسعوديين، فضلاً عن الأميركيين والأوروبيين صاروا أدرى بمصلحتنا منا. من المؤكد أن ثمة صيغة يمكن أن تجمع الرؤى المختلفة، يعرفها الجميع، ولكنهم لا يريدونها، أو ليسوا جاهزين لها بعد. يجب أن تكون سوريا لفئة ما، لشخص ما، لا وطناً للسوريين، المطلوب سوريا للأسد أو لأسد آخر أو نمر أو كلب.
المسألة الكردية
كتبت عن المسألة الكرديّة، كيف تقيّم ما يحصل الآن في المنطقة وخصوصا في ظل آخر الأحداث المرتبطة بكوباني والتحالفات المختلفة ضد الدولة الإسلامية؟
الجباعي المسألة الكردية، بما هي مسألة وطنية، ومسألة حق قانوني وأخلاقي للأكراد في أن يقرّروا مصيرهم بأنفسهم، هي اليوم موضوع تلاعب من قبل النظام والأتراك والإيرانيين، وموضوع غش وتحايل من قبل الأميركيين والأوروبيين، ومسألة كوباني، في أحد جوانبها تعبير عن ذلك. أنا أتطلع إلى سوريا فدرالية، تكون دولة وطنية، بالمعنى الحديث، يتمتع فيها الأكراد والجماعات الإثنية والدينية والمذهبية كافة بحقوق المواطنة المتساوية، ومن حق الأكراد أن يقرّروا ما يريدون، ولا يحق لأحد أن يصادر هذا الحق. وبالمناسبة، تعبير الدولة التعددية مراوغ، وتعبير الدولة المدنية ينم عن جهل العلمانيين ومكر الإسلاميين.
قضية مصير
كيف من المكمن إعادة إدخال الخاضعين ضمن الدولة الإسلامية سواء بإرادتهم أو لا في ظل دولة مدنية بعد الوحشية التي يشهدونها في كل يوم.؟ أي هل من الممكن تجاوز خطاب التوحش الذي تمارسه دولة الإسلام للوصول إلى خطاب يلائم الفئات الشعبية بعيداً عن تصورات البعض التي ترى أن وجود الدولة الإسلامية مؤقت ولا تتجاوز كونها حدثاً عابراً؟ ومن جانب آخر ماذا عن الشخصية التي طالها عنف النظام بطريقة جنونية هل يمكن لها أن تقبل بوجود النظام بعد الآن، وهل يمكن لها أن تتجاوز الشرخ الطائفي الذي يزرعه والهويات الطائفية التي يكونها..؟ وهل الباقون على الحياد قادرون على الانخراط في ظل الدولة الجديدة في سبيل إعادة تكوين النسيج الاجتماعي في ظل دولة المواطنة والديمقراطية؟
الجباعي هذا حشد من الأسئلة، يمكن جمعه في قضية مركزية هي قضية المصير، فيغدو السؤال: كيف يدبِّر سكان سوريا الجغرافية-السياسية مصيرهم، أو كيف سيشكلون وجودهم الاجتماعي ونظام حياتهم، بصفتهم سوريين، لا بأيّ صفة أخرى، عربية أو إسلامية؟ هذا لا يعني إلغاء العروبة والإسلام أو الكرودة وغيرها، الإلغاء الفعلي، لا الخطابي، ليس بمقدور أحد غير التاريخ. ولكن ثمة إلغاء سياسي للقومية العنصرية والدين، إسلامياً كان الدين أم مسيحياً..، على نحو الإلغاء السياسي للملكية الخاصة في النظم الديمقراطية الحديثة، المستوفية شروط الديمقراطية، كما تصورها كارل ماركس، أي التي يشرِّع فيها غير المالكين للمالكين، على اعتبار غير المالكين لوسائل الإنتاج هم الأكثرية. المجال الطبيعي للعروبة والإسلام والكرودة والمسيحية.. هو المجتمع المدني وفضاؤه الثقافي، على اعتبارها جميعاً معطيات ثقافية، لا يجوز أن تنتج منها أيّ نتائج سياسية، على صعيد الدولة ومؤسساتها، وإلا فلا مواطنة ولا وطن ولا دولة حديثة ولا ديمقراطية ولا من يحزنون.
مصير السوريين اليوم على المحك، ومن الصعب توقع ما سنكون عليه، في ظل إمعان جميع الأطراف المسلحة في القتل والتدمير والتهجير، ولا فرق في ذلك بين إرهاب النظام السوري وإرهاب داعش، ولا بين النظام السوري وبين داعش، ولو من غير إرهاب، لأن المشترك بينهما أكثر من غير المشترك. عندما تطرح قضية المصير جدياً، ويتوافر نوع من توافق على دولة وطنية فدرالية ديمقراطية يغدو بالإمكان إعادة تكوين النسيج الاجتماعي الوطني، وإن من غير صعوبات، بعضها صعوبات كبيرة، كإعادة الإعمار وإجراءات العدالة والمصالحة، التي لا بد منها، فلا مصالحة دائمة بلا عدالة دائمة.
حدث تاريخي

هل مازال من الممكن التعويل على “الربيع العربي” بوصفه حالة تغيير تشمل كافة الجوانب أم بالإمكان تجاوز العقبات الظلامية والديكتاتوريّة، في سبيل استعادة حضور الكلمة الشعبية وإسقاط زيف الأقنعة النخبوية التي تخدم مصالح شخصية أو جهات ومنظمات خارجية تستثني الوجود الشعبي والتاريخي ورغبات قاطني المنطقة وخصوصا سوريا وما حولها؟
الجباعي أنا من الذين ما زالوا يعولون على “الربيع العربي”، لأن ما حدث في المنطقة المعنية في هذه الأسئلة، وفي سوريا خاصة، ليس شيئاً عابراً، ليس زوبعة في فنجان، بل حدث زلزالي بجميع المعاني وعلى جميع الأصعدة، وحدث تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، وله تداعياته وارتداداته، والثورة المضادة (الظافرة) ستزيد من هذه الاحتمالات، بما في ذلك احتمال “انتصار” النظام السوري على الشعب. وما زلت أعتقد أن الربيع العربي لا يزال في خلفية الأحداث التي تجري على السطح أو فوق خشبة المسرح. الربيع العربي افتتح مرحلة جديدة طويلة المدى، فلم يعد بوسع الأنظمة المعنية سوى الإمعان في القمع وتصدير أزماتها، لتأجيل الاستحقاقات التاريخية، والقمع أحد عوامل الثورة. ولن تكون أي دولة من دول المنطقة في منجى من ذلك. وقد فرقت من البداية بين الثورة السلمية التي تنشد الحرية والحياة الإنسانية الكريمة، وبين الحرب التي تتغيّا أطرافها السلطة ومغانمها، واعتبرت الثورة والحرب ظاهرتين مختلفتين لا تتعايشان معاً، فما أن تضع الحرب أوزارها، حتى تستعيد الثورة وهجها، فالحرية ليست مطلباً عابراً يسقط بالتقادم.
إن اعتبار الحرب الدائرة امتداداً للثورة يهدر القيمة المعرفية والثقافية والأخلاقية للثورة السلمية، وما تعبّر عنه من تحوّلات غير قابلة للانعكاس، على جميع الصعد، ويخضعها قسراً لنموذج الثورة المستقر في الأذهان، ويخفي أو يريد أن يخفي دور الفئات أو الشرائح الاجتماعية التي نهضت بها والمبادئ والقيم التي وجهتها. فإنّ من أولى ميزات الثورة السلمية أنها غيرت مفهوم الثورة وفصلته عن العنف والحرب، فأهدت لعالم القرن الحادي والعشرين بشارة بإمكانية تغيير قواعد السلطة وقواعد السياسة بما يتناسب وثورة المعرفة، وارتقاء الفكر والعمل، ونموّ الروح الإنسانية، ومهدت الطريق لاستيلاد سلطة المجتمع المدني وتنظيماته الحرة والمستقلة عن السلطة المركزية، وزعزعت قواعد المركزية الذكورية ذاتها، فأضافت شيئاً جديداً، بل أشياء جديدة إلى علم السياسة والفلسفة المدنية، يضع حداً لمفاهيم السياسة التقليدية، التي لا تزال تحكمها تصورات ماكيافيلية، وقد تكون موضوعاً للفكر السياسي في مستقبل قريب. والأهم من هذا وذاك أنها بشارة بإمكانية وضع حد نهائي للحرب، لأنها هي ذاتها ثورة على الحرب، وعلى السياسة بصفتها حرباً، وعلى السلطة بصفتها حرباً، وعلى الجيوش والمخابرات، بصفتها عيباً، وشيئاً بدائياً متوحشاً، ومرضاً خبيثاً لا تتعافى الجماعة الإنسانية منه إلا بالقضاء عليه باستئصال أسبابه.
حديث حماقة
هل لا بد لنا من تفكيك أجهزة الدولة السورية ومؤسساتها في سبيل بناء مؤسسات جديدة تقوم على أساس خطاب المدينة والديمقراطية واستئصال جذور العنف والقمع؟ أم هل هناك صيغة يمكن من خلالها إعادة هيكلية المؤسسات التي تغلغلت بها القوة القمعية للتأسيس للدولة الجديدة؟ وهل قدمت سواء المعارضة كأشخاص مستقلين أو كهيئات رؤية جديدة بعيدة عن النخبوية والبعد عن الواقع وأقرب للمطالب الشعبية؟
الجباعي الذين يتحدثون عن تفكيك المؤسسات وبناء مؤسسات جديدة، وهو حديث حماقة، لا ينم عن معرفة بما هي الدولة وما هي المؤسسات، ولا ما هو المجتمع المدني وانتظاماته الحرة ومنظماته المستقلة. هؤلاء عينهم على مؤسستي الجيش والمخابرات، وهما أصل الداء وسبب كل بلاء. فلا أحد من هؤلاء يتحدث عن تفكيك البنك المركزي والنظام المصرفي، مثلاً، أو وزارة التربية أو التعليم العالي أو وزارة الزراعة أو الصناعة.. إلخ، وكلها مؤسسات فاسدة لأن النظام فاسد. فإذا ما كان بالوسع تغيير النظام من نظام خاص بحزب وعائلة إلى نظام عام، أي وطني، تتغير طبيعة المؤسسات وتغدو وظائفها وظائف عامة، بما في ذلك مؤسستا الجيش والمخابرات.
على صعيد التطلع الذاتي، أتطلع، على المدى البعيد، إلى دولة ودول بلا جيوش وبلا مخابرات، لأن ثمة تضامناً وظيفياً وسياسياً بين الجيش والمخابرات، ولا سيما في بلادنا، أي إنني أتطلع إلى عالم بلا أسلحة وبلا حروب. هذه يوتوبيا، لا مفر من الاعتراف بذلك، ولكن من حقنا أن نحلم. فإن مجرد وجود جيش هو حضور للحرب أو استحضار لها. لم توجد الجيوش للدفاع، بل للعدوان إما على الآخرين وإما على الشعب، كما هي الحال في سوريا. عبقرية الشعوب كفيلة باجتراح سبل الدفاع عن نفسها بلا جيوش.
المثقف الميت

هل بالإمكان أن نشهد الآن ظهور المثقف العضوي الحامل لهموم الطبقة أم أن انتشار وسائل التواصل الحديثة جعلت لكل فئة (بل حتى كل فرد)، القدرة على إيصال صوتها ورغباتها؟ وهل يمكن التعويل على هذه القنوات الجديدة أم لا بدّ من استعادة صورة المثقف القادر على إيصال صوته للملأ؟
الجباعي لقد بينت رأيي في مقولة المثقف العضوي، وآمل أن نودعه الوداع الأخير، مكللاً بالورد.
الثورة المضادة
ما رأيك في سلوك المعارضة السورية سواء في الداخل أو في الخارج، ففي الداخل نراها عقيمة أو مشلولة، وفي الخارج نراها تسعى وراء الدول الأخرى لنيل الاعتراف والتمويل، هل يمكن التعويل على هذه الأشكال لإقامة سوريا الجديدة؟
الجباعي المعارضة التي تعنيها هي التي أشرت إلى أن الثورة ثورة عليها، ويجب أن تكون كذلك. خلافاتها ومهاتراتها صارت مخجلة، وبعثت في النفوس شيئاً كثيراً من الإحباط واليأس. كثيرون من أشخاصها وقادتها أصدقائي وجلهم من أبناء جيلي وممن انخرطوا في الأحزاب العقائدية، ومعظمهم لا يزالون على قديمهم، ولهذا السبب يمكن أن يكونوا في عداد الثورة المضادة، موضوعياً، لا ذاتياً، أداؤهم داخل المؤسسات التي أحدثوها أو انتظموا فيها، وهو الأصح، وخارجها أيضاً يوحي بذلك. ولا أشك في أن بعضهم وجد نفسه في وضع مأزقي لا يحسد عليه، فلا هو قادر على المضي إلى الأمام ولا هو قادر على التراجع، وبعضهم استقالوا من هذه المؤسسات التي كثر اللغظ حولها. هؤلاء الأصدقاء وغيرهم يعرفون رأيي في المعارضة التي أصفها دوماً بالتقليدية، مع أنني عشت في صفوفها منذ شبابي الباكر حتى عام 1996، وقد بينت ذلك بوضوح، في كتابي “طريق إلى الديمقراطية”.
حصاد السرديات
هناك شعار رفع في سوريا هو (يا الله مالنا غيرك يا الله)، وكأن الشعب السوري قرّر اللجوء للغيب حين عجزت القوى المادية عن إنقاذه وتخليصه من مأساته، وكأنهم أيتام لجأوا للدعاء، هل ما زال السوريون على يتمهم؟ وماذا تثير فيك الحقيقة التراجيدية باللجوء إلى الغيب للخلاص في ظل انهيار السرديات الكبرى التي شهدها العالم؟
الجباعي نحن، في ما عدا حياتنا البيولوجية، ومتعنا الصغيرة، وخوفنا المقيم، أبناء سرديات كبرى ونصوص مقدسة، نحن أبناء نصوص شكلت وجودنا الاجتماعي والثقافي والسياسي والأخلاقي، وشكلت وجداننا وأجسادنا، وما نشهده من همجية هو حصاد هذه السرديات. لا مستقبل إنسانياً لنا قبل نقدها بمطرقة، كمطرقة نيتشه، وتفكيكها. وشعار “يا الله ما لنا غيرك”، ليس تراجيدياً، بل من نوع الكوميديا السوداء، لأنه مما جاء بالرايات السوداء والموت الأسود، (وفق الدلالة التقليدية والعنصرية للسواد)، أتساءل: متى كنا لا نلجأ إلى الغيب، والماضي غيب، مثله مثل المستقبل لدى الحالمين، أليست أيديولوجياتنا الكبرى ماضويات ومستقبليات؟ نحن لم نكن يوماً في الحاضر، ولسنا بعدُ من هذا العصر. هذه مسائل لا تهم المثقف العضوي، أو المناضل “الملتزم”، أو الكاهن، الذي ينافق الشعب ويتحدث باسمه.
سؤال فخ

هل أنتجت الثورة السوريّة مفكرا إنسانيا جامعا، أم أن المصالح والتدخلات كانت تجهض هذه الجهود لنرى الشعب السوري دون أي تمثيل بل يتخبط في ظل صراعات القوى الكبرى دون وجود مفكر أو مفكرين يحملون همه الإنساني؟ إذ تم تجاوز العديد من الأفكار التي أسس لها مثقفو اليسار بسبب تسارع الفعل في الشارع والتطور السريع للأحداث الذي ترك بعض المثقفين في صدمة وجعلهم يتخبطون في مواقفهم (أدونيس مثلا)؟
الجباعي هذا السؤال فخ، تعمّد خلط مسألتين مختلفتين، الأولى مسألة نتوج المفكر الإنساني، والثانية مسألة تمثيل الشعب السوري. المثقفون المرضى بأنفسهم فقط يظنون أنهم يمثلون الشعب. المثقفون لا يمثلون الشعب إلا رمزياً، وذلك بثقافتهم، لا بأشخاصهم. الذين يمثلون الشعب بأشخاصهم هم من ينتخبهم الشعب انتخاباً صحيحاً. المثقف الذي يجيز لنفسه أن يتحدث باسم الشعب أو باسم الثورة مثقف مريض بمرض الأنبياء والمتنبئين. لست مع الحملة الهوجاء على أدونيس الشاعر والمفكر، ثم على الدكتور صادق جلال العظم، المفكر النبيل، لأن كلتا الحملتين أرادتا تقزيم علمين من أعلام الثقافة السورية إلى مسخين طائفيين.
أجري الحوار في دمشق




