تابوهات شكلت هويتي وصنعت مآزقي
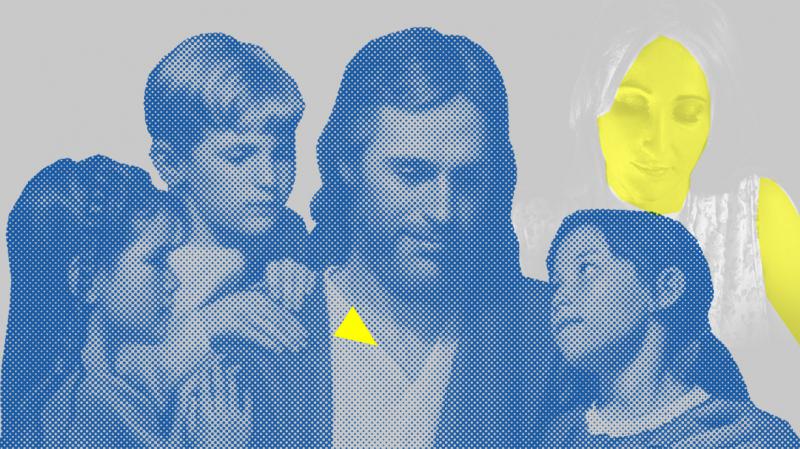
التابوه الإيماني
لعلّ أوّل التابوهات التي واجهتها في مجتمعي التعدّدي، وأعمقها تأثيرا في حياتي، يعود إلى تجربة طفليّة؛ حيث الذاكرة تتلقّى الانطباعات الأولى وتحفرها على صفحتها. عدت يوما من مدرسة “راهبات المحبّة”، وكنت في السّنة التمهيديّة، ما قبل المرحلة الأساسيّة، أحمل بيدي كتابا يضجّ بالحياة، حياة يسوع المسيح، بعالمه المتشكّل ألوانا وحبّا للأطفال والحيوانات. أقلّب الصّور طوال المسافة في الحافلة التي تقلّني إلى البيت، وأخال نفسي حملا في حضن ذلك الرّاعي الوسيم. حالما وصلت إلى البيت، وقبل التحيّة والقبلة على خدّ أمّي، أريتها الكتاب. كنت أزقزق كطائر وجد الشجرة الوحيدة في القفر، صارخة “انظري ماذا وزّعت علينا الرّاهبة الأخت (ma soeur)”. تناولت الكتيّب مني، وسرعان ما امتقع لونها هامسةً “يا ذلّي! بدهن (يريدون) يعملولي البنت مسيحيّة”، وأردفت “غدا، ترجعين الكتاب إلى الراهبة، وتقولين لها: ماما لم تسمح لي بالاحتفاظ به”. وأبقته في حوزتها.
لا أجد سبيلا إلى وصف حالتي، وكيف انقلبت من عصفور يزقزق إلى طائر مذبوح يفرّ من جهة إلى أخرى ويضيع في الاتجاهات. لم أفهم لم رفضها؟ ماما تحبّ الرّاهبات. حاولت إقناعها بجمال الصّور، وبأنّ المسيح يعلّمنا محبة بعضنا بعضا، ومحبّة الحيوانات. “هو لطيف جدّا!” لم أكن أفهم لم ترفض هذا اللطف كلّه؟ إلّا أنّني استيقظت في اليوم التّالي على تنهيدات عميقة وآثار نشيج على عالم انتزع مني.
كان ذلك قبيل الحرب الأهلية. والمفارقات السّاخرة، أنّ في قريتي ارتكبت مجزرة بحقّ بعض الأهالي المسيحيين، واتّهم جدّي بأنّه يخفي عائلات هاربة في قبو منزله، وفُتّش القبو. واتّهم أبي بأنّه يخفي أحد الفارين.
لن أنسى صراخ أمّي في وجه المسلّحين الذين ألمحوا إلى تفتيش بيتنا. وفي الواقع كنّا مراقبين. بعد عدّة سنوات، يعود أحد الناجين لينتقم من المقيمين في قريتي، وكانت عائلته قد قضت في المجزرة. عمّي، ابن جدّي المغضوب عليه، كان إحدى ضحاياه!
التابوه الطبقي

اكتشفت أولى دلالات التمييز الطبقي في صغري على يد إحدى المدرّسات في “مدرسة الرّاهبات”، حين طلبت إلينا ألا نتحدّث مع تلاميذ المدرسة الرسميّة المجاورة لمدرستنا، بحجّة أنّهم ”غير مهذّبين”.
ما هي إلا أيّام معدودة تمرّ على هذا الطلب – الحكم، حتى ألتقي مصادفةَ، بتلميذة تنتمي إلى تلك المدرسة في الزاروب المؤدّي إلى كلا المدرستين. لا فارق في السنّ بيننا. كانت تعود أدراجها، لسبب ما يخصّها. ابتسمت لي من بعيد، فكان من البديهي أن أستجيب بابتسامة مماثلة. لكنّني سرعان ما تراجعت، وعبست، خافضةَ نظري حالما تذكّرت ”البيان رقم 1” لمدرّستي. غير أنّني لم أقو على الاستمرار في خفض نظري، عدت لأنظر في عينيها لدى اقترابها. ما أذكره أنّ سماتها كانت تنبض بالحبّ والفرح والرّقّة. بادرتْ إلى إلقاء التحيّة، فرددت بالمثل. وسرنا في طريقينا، لكنّ الخشية من أن أكون قد اقترفت ذنبا ما بردّ التحيّة عليها رافقتني طوال دربي.
هذه الفتاة هي اليوم أعزّ صديقاتي وأرفعهنّ ذوقا وتهذيبا.
لم يكن ثمّة فارق اجتماعي بيننا سوى أنني، لسوء حظي أو لحسنه، أدرس في مدرسة خاصّة وهي تنتمي إلى مدرسة رسميّة. تابعت علومي في مدرسة رسميّة واستكملتها في الجامعة اللبنانيّة ”الوطنيّة”، ولم أكتسب بطبيعة الحال مبادئ التّهذيب من تلك المدرّسة.
التابوه العقديّ
بُعيد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، تطوّعت للمشاركة في مخيّم عمل شبابي، يضمّ شبّانا وشابّات من مختلف المناطق اللبنانية. و”المناطق” المتعدّدة تعني انتماءات مذهبيّة وسياسيّة مختلفة. ما علق في ذاكرتي من ذلك المخيّم قصّة بداياتي مع التّدخين.
ذات يوم، مرّ المدرّب أمام مجموعتنا، فرآني أمسك بسيجارة، كان قد عرضها عليّ أحد الأصدقاء. نظر إليّ، وابتسم رافعا حاجبيه، وقال “لا تكتسبي عادات سيّئة”، ومن ثمّ تابع طريقه. في اليوم التالي، وقد راقتني “السيجارة”، حاولت جاهدة إخفاءها عن ناظريه، غير أنّه أفهمني بإشارة لمّاحة أنّه رآني؛ وأكمل طريقه إلى أن سنحت له الفرصة ليتحدّث إليّ على انفراد. نسيت الكثير من الوجوه، والأنشطة، ونسيت وجه من قدّم لي السيجارة، لكنّ عبارة المدرّب، وما فاضت به من محبّة، ليس بالهيّن محوها: “حين تكونين واثقة من سلوكك، لا تقومي به في الخفاء، لا خوفا ولا خجلا؛ فهذا خيارك. لكن كلّما حملت السيجارة تذكّري هذا الموقف”.
ذهب كالطيف، وبكيت في صمت… المفارقة أنّني، بعد عدّة سنوات، أعرّج مع إحدى زميلاتي على متجر صغير وأطلب “علبة دخان”. لم أتوقّع سؤالها: هل أنت شيوعيّة؟ من المفاجأة سكت. فأردفت بسؤال ثان: أو قوميّة؟ لم أكن أدري أنّ الشيوعيّة تهمة اجتماعيّة في حينها، والقوميّة تعني خروجا على حصن الطائفة. منذ ذلك الحين، توالت المساءلات، وراقتني لعبة الأسئلة.
تابوه الهويّة الأنثويّة
لم تخرج تربيتي على القاعدة التربوية المحافظة بتابوه تواجهه الفتاة الشرقيّة مفاده أن ”لا تلعبي مع الصبيان” و”انتبهي لوضعيّة جلوسك وتحرّكك حين تلبسين التنورة أو الفستان”. غير أنّ هذه الصّرامة ولّدت في نفسي كراهية للفستان والتّنورة، لأنّي كنت أهوى ألعاب التحدي والمنافسة مع الأولاد لا البنات، وأصف صديقاتي الفتيات بالضعف والجبن. ترسّب هذا الموقف في لاوعيي، وتسرّب إلى مظهري الرّافض للأنثويّة. ولم أستطع التحرّر منه إلاّ منذ بضع سنوات خلت. فحين كنت يافعة اخترت تسريحة شبابيّة لشعري شديد القصر، وثيابا أرتديها لا تمتّ للفتاة بصلة.
قد تذهب بعض الأفكار إلى مقاصد أخرى، تصفني بالمثليّة، لكن ليس هذا من طبيعتي ولا علاقة لمشاعري بذلك. مع الزّمن، وتوالي الاحتلالات والوصايات على لبنان، تعاظمت كراهيتي لهويّتي الأنثويّة. وأذكر حالة الرّعب التي كانت تعيشها أختي الصغيرة، ولم تكن قد تجاوزت سنّ الخامسة، حين اجتاحت القوّات الصهيونيّة الجبل اللبناني. الخوف كان يوقظها ليلا محتجّة لدى أمّي بقولها “شامّة ريحة إسرائيلي”. باتت ترافقها الرّائحة المقلقة ليل نهار وأنّى اتجهت… إن تبدّلت الأسماء مع الزّمن في بلدي، يبقى الخوف الطفلي واحدا؛ رائحته لا تتبدّل داخل أنفها، ولا في أنفي. فللعنف رائحة، رائحة الرّعب الكبير من فكرة الخطف والاغتصاب.




