صنعة الكتابة
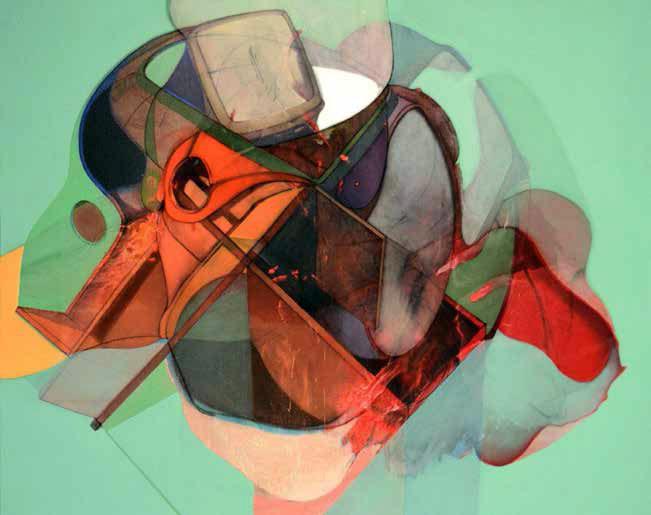
حينما ننظر إلى الجنس البشري تلفتنا الحقائق الآتية: كلّ الناس الأحياء يتكلّمون ما خلا من تعرّض منهم لعطب في لسانه، ونحو نصفهم يقرأون، وأقل من عشرهم يكتبون ما هم بحاجة إليه، وتنفرد من بين هؤلاء قلة قليلة جدا لها القدرة على الكتابة الأدبية أو الفكرية. يعود ذلك إلى كون الكلام ظاهرة عريقة حتى يتعذّر وضع تاريخ نشأة موثوق لها، وما أن يلد الطفل إلا ويتعلّم الكلام في محيطه العائلي؛ فالظاهرة الكلامية تحيط به في الزمان والمكان، ولكنه من أجل أن يقرأ ينبغي عليه اكتساب مهارات تمكّنه من فك شفرات الألفاظ، والتدرّب على إتقانها؛ فالقراءة مهارة يكتسبها بالتعلّم في مكان اسمه المدرسة، مهارة يمكن التحكّم فيها بتوفير الظروف المناسبة لشيوعها أو للحدّ منها، ولا يكاد يتعذّر على الإنسان معرفتها إذا ما توفرت له السُبل المناسبة لذلك، أما الكتابة فمهارة أرفع يتحصّل عليها من نجح في تحويل الألفاظ إلى رموز متتابعة حسب رتب معينة يصطلح عليها بالحروف والكلمات والجمل والفقرات، وتلك مهارة لا يحوز عليها إلا عدد أقل من بني البشر، وتنفرد من بين هؤلاء جماعة صغيرة جدا لها قدرة على التعبير عن هواجسها وخيالاتها وأفكارها بنسق مترابط من الكلمات، وهؤلاء هم الكتّاب الذين يعنينا شأنهم في هذه المقالة، فالكتابة صنعة يكتسبها صاحبها بالتمرس فيها والانكباب عليها، وذلك بأن يطلق الرغبة في الارتقاء بمدارجها نحو الإفصاح عن نفسه وعن عالمه، بجعل الأشياء تنطق بالألفاظ.
لكن ما سرّ هذه الصنعة البشرية العجيبة التي ما برحت تثير الأسئلة منذ زمن طويل؟ لم يفلح أحد في تقديم جواب شاف على ذلك السؤال، وعجز الإنسان عن حسم هذا الأمر يكشف ثراء هذه الظاهرة وقوتها؛ ولهذا سوف أقاربها من زاوية الخلاف بين القائلين بأنها صنعة والقائلين بأنها خطرة من الخواطر المرتجلة، وبعبارة أعم: هل الكتابة صنعة من صنائع الدنيا، أم هي جملة من خواطر حرة مرسلة؟ شغل قدماء العرب بشيء له صلة بذلك، فتحدثوا عن البداهة وعن الصنعة في أدبهم، وسأكتفي بمثل واحد له صلة بالكتابة السردية وافتراق سبل صيغتها في التعبير والتركيب؛ ففيما كان الهمذاني يهذّ مقاماته من خواطره المتدفقة كالسيول، كان الحريري يقاسيها كالصائغ ويتسقّط عباراتها كلمة بعد كلمة. ولا بأس من إيراد تفصيل يؤكد ذلك الانشقاق بين الموقفين من الكتابة.
أجمعت المصادر على أن الهمذانيّ صاحب استجابة سريعة لأيّ مطلب يُعرض عليه، فلديه قدرة فائقة يتدبّر بها المعاني المقترحة عليه من عويص الشعر والنثر بكلام تتضافر ألفاظه مع معانيه في اتساق يميّزه عن سواه من كتّاب عصره، يأتي به في لمح البصر، فيثير العجب من حوله. أجمل الثعالبي سرّ بداهته المذهلة “بديع الزمان، ومعجزة همذان، ونادرة الفلك، وبكر عطارد، وفرد الدهر، وغرّة العصر، ومن لم يلق نظيره في ذكاء القريحة، وسرعة الخاطر، وشرف الطبع، وصفاء الذهن، وقوة النفس، ومن لم يدرك قرينه في ظرف النثر وملحه، وغرر النظم ونكته، ولم يُر، ولم يُرو، أن أحدا بلغ مبلغه من لبّ الأدب وسرّه، وجاء بمثل إعجازه وسحره”. هذا قول فصل صاغه الثعالبي بجمل مترادفة أصبحت مثلا في تقريظ موهبة بديع الزمان. هام القدماء ببداهة الهمذاني، وتغنّوا بها، واستثارتهم براعته في الارتجال إلى درجة الاحتفاء بكلّ ما نُسب إليه، غير أن هذه البداهة سرعان ما تقوضّت أركانها بظهور الحريري الذي عُرف بالصنعة وجودة السبك في مقاماته، فجعل من الكتابة سرا لصنعة السرد، ثم تبوّأ مقامه الرفيع بأسلوب ما لبث أن أصبح عِيارا يوزن به كلّ كلام نثري فيُميّز بين جيده وسقيمه. قُبلتْ طريقة الحريري، وصاغت ملامح الكتابة النثرية العربية منذ القرن الثاني عشر حتى القرن التاسع عشر، فأصبح “حامل لواء البلاغة، وفارس النظم والنثر”. وبوّأته مقاماته مكانة رفيعة، فـ”فضلها أكثر من أن يحصر، وأشهر من أن يُذكر”. كانت البداهة سابقة في نيل اعتراف المجتمع الأدبي، فإذا بالصنعة تدفع بها إلى الخلف، وتجعلها أثرا بعد عين.
صار ينبغي، والحال هذه، الحديث عن الكتابة بوصفها صنعة. تقترن كلمة “صنعة” بتجشّم المشقّة في التأليف، وما يرادفها من تصنّع، وتكلّف، الأمر الذي يوحي بكتابة تخالف الطبع، فلا يصار إلى الاهتمام بجودة الصنعة وإحكامها والحذق فيها، بل التظاهر بها وتكبّدها من دون خبرة، وادّعاء المعرفة بها من غير دراية بقواعدها العامة. ومن أجل نزع الارتياب عن مفهوم “الصنعة” يلزم القول بأنّ الكتابة تقتضي خبرة بأعرافها، ومراعاة ما استقرّ عليه كبارها من طرائق في السبك وتهذيب في الأسلوب وتجويد في الأفكار، فلا تتزاحم فتتداخل أو تتفرّق فتتبعثر؛ فوقوع الكاتب في حبائل المحاكاة السلبية، وليس التأثّر الفعال هو إحجام عن الاستكشاف، وتقاعس عن الابتكار، وهو ضرب من الانتحال، وسيؤدّي إلى تخريب تجربة الكتابة، والأمور بخواتيمها.
وحذار من عدم الأخذ بأعراف صنعة الكتابة، لأنها، فضلا عن إرشاد الكاتب إلى السُبل الصحيحة للكتابة، تساعده في تلقّي ما يكتب. وقد انقضى عهد الكتابة القائمة على قاعدة الفطرة، وصار ينبغي على الكاتب الاطلاع على طرائق التأليف من مصادرها، والانكباب عليها في مظانها، فلقد اشتق السابقون مسارا ذهبيا للكتابة، واتخاذ هذا المسار طريقا يزود الكاتب بمهارات لن يتلقّاها عن طريق آخر؛ فالسير على هدي السابقين والتشبّع بأساليبهم قبل الخروج عليهم يغذّي الكاتب بأعراف الكتابة، والتشبّع بأسرارها. إنّ الاستنكاف عن التعرّف على التجارب الثرية في الكتابة له من الضرر ما لن يقدّره كاتب بدواعي الجهل، وما يتبعه من طيش، وسفاهة، ورعونة، فالانصراف عنها بذرائع كونها عتيقة، أو بالية، مبعثه تعلّق الكاتب بتصوّر ضيق للكتابة وجهل بشروطها، فكأنها تبدأ به وبجيله وبمجتمعه، وخير للمرء أن ينهل من نبع الكتابة الصحيحة من ادّعاء الارتواء من سراب.
وما وجدت كاتبا يشار له بالبنان لم يسع للاغتراف من عيون التجارب الكتابية الراسخة التي سبقته، والتشرّب بمعايير صنعتها، فللوصول إلى هدفه عليه السير في دروب السابقين أولا، والتهام ثمار صنعتهم، واستكمال عمله بفتح طريق خاص به؛ فالتجربة الكتابية مفتوحة على الاحتمالات كلها، وليس ينبغي لأحد الادّعاء بأنها تبدأ به، وتنتهي بمعاصريه. وتكشف تجارب كبار الكتّاب أنهم ينكبّون على الكتابة في إخلاص يضارع إخلاص المتعبّدين في عقائدهم، فانقطاعهم عنها يفصم حلقات السلسلة الذهبية التي تربط الشخصيات، ويعوق نمو الأحداث إلى الغاية المقصودة منه، ويبعثر الوحدة الدلالية القابعة تحت سطح النص. وبانبتات حلقة من هذه الحلقات المتداخلة تتفكّك الوقائع، فيلوذ الكاتب بالإنشاء، وينحسر تأثير المناخ النفسي والخيالي الذي يغذّيه بما يكتب، فلا يعود قادرا على استئناف عمله إلا بصعوبة بالغة، ويتعثر الشغف بالابتكار، ودونه تنطفئ رغبة الكاتب في المواظبة على الكتابة.

تعتبر الكتابة أسّ الأدب، وقد عرّفها “بلانشو”، بأنها “مجموعة من الطقوس، وهي الاحتفال الواضح، أو الخفي، الذي عن طريقه يعلن عن ذلك الحدث”. من المتوقّع أن يقابل إصراري على التقيّد بطقوس الكتابة، ومراعاة أعراف صنعتها، بالتبرم؛ فالالتباس في فهم القصد، وارد في كل حديث، يشدّد على جودة الكتابة؛ ويعود ذلك إلى الخفّة، وربما حدة الطبع، ومعظم المشمولين بالوصف، سيحاججون بأن عالم الكتّاب غير منظّم، في أصله وفصله. وهو خلط مريع بين طقوس الكتابة، ومضامين الكُتب، فيعرضون عن هذا الكلام، إعراض المنكر له والمستهجن له. ومنهم من يبدي تذمّرا من الوقت حينما لا يتوفّرون عليه، إنما يختلسون لحظات عابرة منه، ويصبح هذا الاختلاس قاعدة يعتادون عليها، ويدافعون عنها، ويربطونها بما يظنّون أنه الإلهام، الذي يلقي في رَوْعهم، جملة من الأفكار، والمعاني المخصوصة، فكأن الكاتب، شخص أُصطفي لذلك، وتلك مغالطة، يلزم التحذير منها؛ فالكتابة نوع أصيل من الشغف والمثابرة والعون فيها يأتي من الانكباب عليها.
ولكي تكتسب الكتابة مشروعيتها الثقافية فليس ينبغي التفريط بأعراف صنعتها تحت تأثير خواطر عارضة لم تثبت فائدتها، ولا تصدر الأحكام المستهجنة لطقوسها إلا من أشباه الكتّاب، فلا يقرّها كبارهم، بل يستبشعها عظامهم، وباقتراح إيقاع زمني منتظم للكتابة الخاضعة للتحرير والتدقيق والتنقيح، تتوارد الأفكار بيسر؛ لأن الأبواب تكون قد شرّعت أمام الكاتب. غير أنّ هذا لا يكفي، فالكاتب المجيد، بأمسّ الحاجة إلى مراقبة إيقاع الأحداث، ومسار الأفكار، فلا يسقط في الشروح المملّة، والأوصاف المُسهبة، والتعليقات الجانبية، والحكايات العارضة، فشرط الكتابة الإمتاع، وندر أن ظهرت نصوص عظيمة غير ممتعة. ولعلّي أفرّق بين الإمتاع والإثارة؛ فالإمتاع قرين المؤانسة والحبور بالأحداث والمؤالفة مع الشخصيات والتفاعل مع وقائع العالم التخيّلي، والتفكير بها، فيما الإثارة انفعال عارض يبعث الخوف أو الغضب أو الهياج أو الشهوة، فهي نوع من التحريض النفسي لا يجلب المتعة الفكرية والنفسية، لأنه يسدّ منافذ الاستغراق الذاتي بالعوالم المتخيّلة.
لا خلاف حول غموض منازع الإبداع، ولن ينكشف الإبهام بستره خلف دعاوى مُلغزة، ولا تُحمد المغالاة بالقول إن الإبداع نتاج استعداد فطري يتّصل بالطبع والسجية والبداهة، وأراني أشّدد على ملازمة الكاتب لعمله، والتعرّف إلى أسرار تركيبه، أكثر من تشديدي على “موهبة” الكاتب، وعندي الحجج الوافية على ذلك، فأنا أجهل مفهوم الموهبة غير القدرة على نسج النصوص بأسلوب مميز، واستعداد نفسي للتخييل المثمر، وذلك من نتاج المراس بالكتابة، وقوة الملاحظة في التفاصيل، والتفكير في بلوغ أفضل طريقة في الإفصاح عمّا يريده الكاتب، فالموهبة مفهوم مبهم، قد يراه غيري هبة، أو لُطفا يناله ذوو الحظ، أو استعدادا فطريا للبراعة في الكتابة، لكنني لا أرى في ذلك إلا محاولة تفلّت من الأخذ بأعراف الكتابة، فما بلغني، ولا أظنه بلغ غيري، أنّ وحيا هبط على كاتب، وناب عنه في كتابة قصة أو قصيدة. على أنني لا أبخس بعض الكتّاب حسّا عميقا بالكتابة لا يتوفّر عند جمهورهم، ولا أغفل تبصّرهم في شؤونها بأفضل من سواهم، فتلك من الاختلافات الطبيعية بين الكتّاب الذين يتباينون في رؤيتهم للكتابة، ويختلفون في معالجة موضوعاتهم.
حيثما يدور الحديث عن الكتابة، فيحسن الترفّع عن القول بالموهبة الخارقة، التي اختصّ بها هذا الكاتب، وحرم منها ذاك، فكأنها هبة إلهية، تُلقى في القلب وحيا، وتنفث سحرها في النفس خفية، وتأتي بالأعاجيب. ولا تجوز المبالغة في تقدير قيمة القول الشائع بأنّ النص الأدبي نفثة يطلقها المبدع في لحظة إلهام خاصة به، فذلك القول، يجانب حقيقة المقاساة التي يعانيها كبار الكتّاب، فقد تصحّ على خطرة شعرية موقّعة، لكنها لا تصحّ على عمل سردي طويل أو نص شعري مسترسل خضعا لتقاليد الكتابة.




