القصيدة العربية والصورة الزخرفية

اتسعتْ مداراتُ عملِ الدرس الشعري في العقود الأخيرة، لتشمل علاقة النص الشعري بـ”خارجه”، بغيره من النصوص تحديدًا. وهو ما ظهر في أعمال ميخائيل باختين، وفي أعمال الدارسة الفرنسية جوليا كريستيفا وغيرهما حول “التناص”. إلا أن هذا الدرس بقي – في توسعه وتقدمه – محصورًا في نطاق الشعر، بين القصيدة والقصيدة، ما عنى توسعًا لمفاهيم “السرقات الشعرية” في النقد العربي القديم، و”الأدب المقارن” في النقد الغربي، وإن انطلق “التناص” وطبقَ مفاهيم جديدة أكثر دقة في استبيان العلاقات التفاعلية بين النصوص.
هكذا لم يتم التوقف عند علاقة القصيدة بالرواية، أو بالمسرحية وغيرها من التداخلات الأدبية. أما ما غاب، في هذا النشاط الدراسي المتجدّد والمتحول، فهو التفاعلات بين القصيدة و”خارجها” من الفنون، على تنوعاتها واختلافاتها، من فنون بصرية على تنوعها وتعددها. وإذا كانت الدراسات الخاصة بـ”التناص الثقافي” قد شملت هذا الجانب، فإنها بقيت في حدود الكلام عن تفاعلات ذات نطاق ثقافي، أو تاريخي، من دون أن تستبين العلاقات “البنائية” (كما أسمّيها) بين المكوِّنَين المختلفَين، أي بين القصيدة والصورة الفنية.
هذا ما أتطلع للعمل عليه في هذا الفصل، متوقفًا عند إنتاجَين مختلفين في الشعر: عربي قديم مع الفن الإسلامي، وفرنسي متأخر في التفاعل مع اللوحة الزيتية والمحفورة الفنية.
المدبَّجة: من الأندلس إلى المشرق
قد ينساق بعض الدرس إلى الاعتقاد بأن القصيدة تفاعلت مع اللوحة، والعمل التصويري عمومًا، ابتداءً مما طلبَه وقام به الشاعر الفرنسي آلويزيوس برتران، وهو ما صرَّح به الشاعر الفرنسي نفسه في مقدمة كتابه الشعري النادر؛ وهو ما اتبعَه في بناء العديد من قصائد كتابه اليتيم. لا أريد التوقف، هنا، عند صحة أو عدم صحة هذا القول (ما أعود إليه في الفصل القادم)؛ أريد أن أتوجه بالبحث وجهة مغايرة، صوب كتاب قديم، جرى تحقيقه في السنوات الأخيرة. فما هو؟ وما فيه؟
يعود المخطوط، في أصله، إلى كاتب أندلسي: عبدالمنعم بن عمر بن حسّان الجلياني الأندلسي، وقد صدر في طبعته المحققة، تحت العنوان التالي: “ديوان التدبيج: فتنة الإبداع وذروة الإمتاع” [1]. يعود هذا المخطوط إلى الكاتب الأندلسي (531 هـ – 602 هـ)؛ ونعرف أن صاحبَهُ ألمّ بجملة علوم وصناعات وفنون، ما جعل البعض يطلقون عليه لقب “حكيم الزمان” [2]، له معرفة بعلوم الباطن، وفي صناعة الكيمياء والطب والكحل (حسب ابن أبي أصيبعة)، وفي كتابة الشعر. ومن المعروف عنه (حسبما روى محب الدين بن النجار) أنه هاجر من الأندلس، وأنه مدح السلطان صلاح الدين الكبير (- 589 هـ)، وصنف له كتبًا عديدة [3]، ما بلغ عشرة كتب بين منظوم ومنثور (التي عرض ابن أبي أصيبعة موضوعاتها)، وهي “مشارع الأشواق”، و”ديوان الغزل والتشبيب والموشحات”، و”ديوان الترسل والمخاطبات”، و”تعاليق في الطب”، و”وصفات أدوية مركبة” وغيرها [4]. ولقد وقعتُ، في نسخة مصورة، على “كتاب منادح الممادح” للجلياني نفسه؛ وهو “كتاب مُشَجَّر كُتِبَ بمختلف الأصباغ والليق”، حسب وصف المخطوط؛ وقد جاء في صدره “كتاب منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر رحمه الله”. ووصف الجلياني كتابه بأنه “صورة المدبجة المشجرة المبهجة ذات النهرين” (569 للهجرة). كما جاء، في “طبقات الأدباء” و”فوات الوفيات”، أن عبدالمنعم كان مشهورًا بعمل المدبجات. ولقد ذكر “كشف الظنون” لحاجي خليفة: “ديوان التدبيج (…) مشتمل على أعاجيب من المدبجات المعجزة النظم” [5]. فماذا عن “ديوان التدبيج”؟
ما يتوجب قوله، بداية، إن هناك أكثر من ظاهرة تستوقف الدارس في الكتاب المحقق: هناك نقص في مادة الكتاب، على ما أشار المحققان في النسخ التي عادا إليها؛ وهو نقصٌ معروف في المخطوطات: هذا ما وصلَ من الكتاب، في نهاية الأمر. إلا أن هناك خللًا مختلفًا، ويعود إلى جامع الكتاب على الأرجح، وهو ابن الكاتب: فقد استوقفني، في درس الكتاب، عدم وجود نظام تأليفي تتابعي لمواده المختلفة، فلم يتقيد الجامع بالتتالي الزمني للمدبجات، حيث إن مقارنة تواريخ المدبّجات توضح المراد من هذه الملاحظة [6]… يضاف إلى ذلك أن النسخ الثلاثة التي عاد إليها المحققان لا تعود أيّ واحدة منها إلى النسخة التي جمعَها ابن الجلياني، وهو ما يفسر ربما الارتباك في ترتيب المدبجات. وقد يكون الارتباك الماثل في تركيب الكتاب عائدًا إلى كون كلِّ مدبجة قائمة بنفسها، من دون أن تتقيد بالتتابع، أو أن مثل هذا الترتيب لم يخضع لتدبير نسقي… ويبدو من كلام ابن الشاعر أنه استجمع المدبجات، ولم تكن مجموعة من والده.
سأقوم، ثانيًا، بالتعرف إلى مواد الكتاب، وتواريخها: يعدد الجلياني، في مستهل كتابه، مجموع كتبه العشرة، عارضًا – باختصار – لأغراضها؛ ومنها الكتاب السادس: “ديوان التدبيج”، الذي “يشتمل على أعاجيب من المدبجات معجِزة النظم” (ص 74). ثم يضيف محددًا طريقته في التأليف “إن جميع هذه الدواوين والكتب ليس في شيء منها كلمة من كلام أحد غيري، بل كلها مما علَّمني ربي” (الصفحة نفسها). كما يفيد، عن كتابه، أنه يجمع “جمهورَ ما قلتُه من المدبجات”. وهي التالية، حسب ورودها في الكتاب:
– “المدبجة القدسية”: 589 هـ (ص ص 75 – 97)، في حروب الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي.
– “المدبجة الأشرفية”، الموسومة “نظم الجواهر بالثناء الزاهر” 602 هـ (ص ص 98 – 112)، للملك الأشرف مظفر الدين الأيوبي.
– “مدبجة صوب المواطر من ذوب الخواطر”: 575 هـ (ص ص 131-144)، من دون إهداء خاص.
– مخصصة للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي: 590 هـ، وفيها اثنتا عشرة “شذرة” (ص ص 145-231).
– “المدبجة المضاعفة ذات الأنهار الأربعة”: 602 هـ (ص ص 232-261)، من دون إهداء خاص.
– مدبجة قصيرة (بالقياس مع غيرها) للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وقد سقط اسمها (ص ص 262-266).
– “الرسالة المحبوكة”: للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي: 585 هـ (ص ص 267-269).
– “مدبجة رياض الارتياض”: 574 هـ ، للملك فخر الدين شمس الدولة (ص ص 270-277).
يتضح، من فحص المدبجات، وجوب التمييز بين ثلاثة أمور فيها:
أولها، أن المدبجات مخصصة للأسرة الأيوبية.
ثانية الملاحظات، أن واحدة من المدبجات ليست مهداة لأحد، لكنها تبدو أشبه بـ”معارضة” [7] (حسب القول القديم) لصنيع الحريري في “المقامات” (ما لي عودة إليه أدناه).
ثالثة الملاحظات، أن هناك نصًا، لا يرد في صيغة مدبجة، وإنما يشتمل على “شذرات”.
إلا أن ما يستوقف، ثالثًا، في الكتاب – على الرغم من نقصان مادته، وتعثر ترتيبه – فهو ما يوفره من معطيات دالة على موجب تأليف الكتاب، من جهة، وعلى أسباب إقبال الكاتب على كتابه، من جهة ثانية. فهو يحفل بمعطيات تقرب، في أحد النصوص، إلى ما يرسم معالمَ قسمٍ من سيرة الكاتب نفسه، إثر حلوله في القاهرة، قادمًا من الأندلس.
هذا ما تتيحُه قراءة نصٍ يتوزع في اثنتي عشرة “شذرة”، في العام 559 هـ (ص ص 145 – 231)؛ ويمكن، من خلاله، الوقوف عند تنقلات سيرية للجيلاني بين القاهرة والإسكندرية، قادمًا من الأندلس إلى حاضرة السلطان الأيوبي. ويرسم مسار الوصول، والوقائع التابعة له، ممهدًا للقاء الذي جمعه بالناصر الأيوبي في المسجد الجامع، في ابن طولون. وهي قراءة تتيح كذلك رسم العلاقة التي انتظمت بين الجلياني وعدد من أفراد الأسرة الأيوبية الحاكمة. ويمكننا الوقوف عند نصوص الكتاب من استبيان صلات الكاتب بعدد من السلاطين الأيوبيين، ابتداء من الملك الناصر صلاح الدين (569-588 هـ)، مرورًا بالملك فخر الدين شمس الدولة، أخ صلاح الدين (- 578 هـ)، وصولًا إلى الملك الأشرف (578-635 هـ). وماذا عن “المدبجات”، موضوع القول في الكتاب؟
بين المدبّجة والمقامة
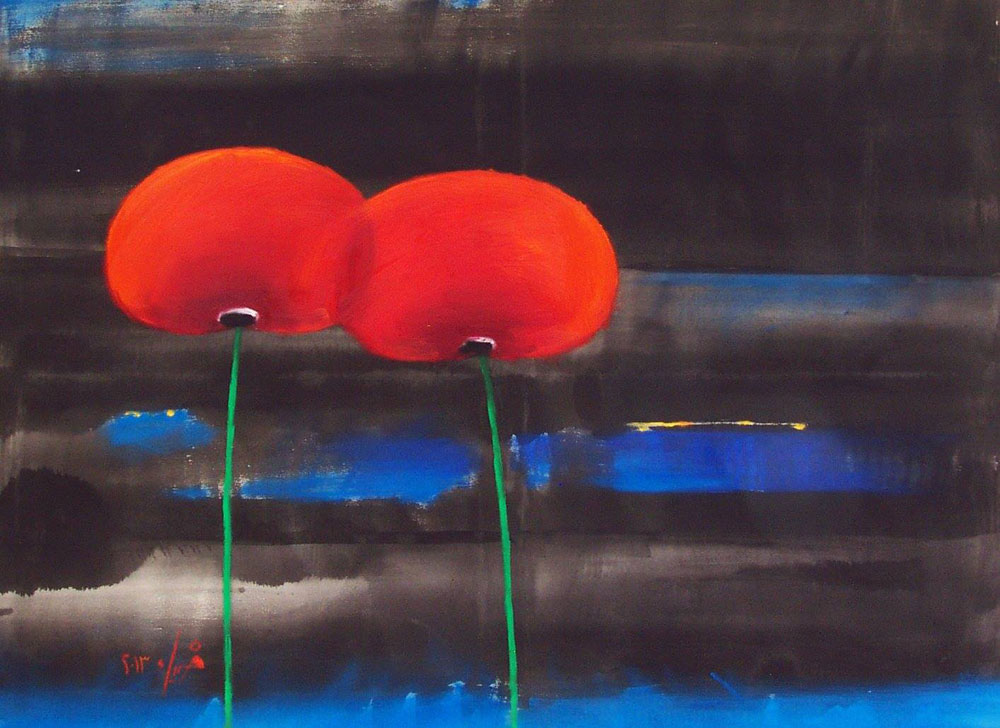
يفيد “لسان العرب” في المدخل المعجمي (د ب ج) أن الاسم يعني، وهو من الفارسي المعرب، “النقش والتزيين”؛ ومنه “الديباج”، أي “الثياب المتخذة من الإبريسم”؛ و”المدبّج” أي ما “زُينت أطرافه بالديباج”؛ و”الديباجتان: الخدّان” وغيرها. ويتبين أن اللفظ، في مشتقاته المحدودة، عنى الزينة عمومًا، بما فيها الجمال الطبيعي للوجه. غير أن معجم ابن منظور لا يورد ما ورد في كتب قديمة عن “الديباجة”، مثل “حسن الديباجة” الذي يوصف به صاحب الكتابة الجميلة. وإذا كنا نقع، في كتابات قديمة، على “الديباجة”، ما يعني مقدمة الكتاب أو صدره، فإنها عنت خصوصًا الكتابة المزينة. وهو المعنى الذي طلبه الجلياني، وجعلَه عنوانًا تعريفيًّا للقصائد التي ابتدعها. وهو ما يفيد بمثله، إذ يشدّد، في مطلع الكتاب، على أنه لم يتّكل على أحد في صنيعه؛ وهو ما شدد عليه أكثر من تحدثوا عنه وعما كتب.
أما “المدبّجة”، موضوع هذا الدرس، فهي نوعٌ متولد في سَوِيَّة المدح؛ وهو ما يوضحه الكاتب بنفسه، إذ يكتب، في “المدبجة الأشرفية”، في تعليلها “وجب أن أصوغ لذكره المنداح حليةً لم يُرَ مثلها في الأمداح” (ص 99). إلا أن للمدح سيرة أخرى في الكتاب، ما يرد في أحد أحلام المؤلف، في معرض شرح علاقة المؤلف بالناصر صلاح الدين الأيوبي: يروي الجلياني ما يشبه خطة تأليف الكتاب، وقد أتتْه في حلم “أرى في المنام ليلة (…) من سنة 569 (للهجرة)، التي فيها أنشأتُ هذا الكتاب، وكأني في بهو بين مجالس، والملك الناصر – أيّده الله – جالسٌ، وأنا ماثلٌ أنشر بين يديه لآلئ ويواقيت مؤثرة لديه، وهو يرنو إليها بطَرْفه، ويقلبُها بكفِّه، فهببتُ جذلان، وبشرتُ الخلان” (ص 146). ثم التقاه في الغد، في جامع ابن طولون (في القاهرة)، وطلب منه قراءة آي من القرآن؛ ثم ناقش الناصر الفروق بين ما يرد في المصحف وما يرد على ألسنة الكُتّاب. فكان أن ذكّره الجلياني بصنيعه التدبيجي السابق “وعدتُ، وأنا أقول هذا تأويلُ رؤياي (أي الحلم) المبشِّرة بما كان من لقياي” (ص 147). ثم يكمل الجلياني حكاية لقائه بالناصر “ثم إني نمتُ في الليلة التي بعدها، فرأيتُ رؤيا مثل الأولى، لم تتعدَّها (…). فبينا أنا أفكرُ ما عبرُ تلك الرؤيا، إذ ألقيَ في روعي دُبْرُ (أي آخر) هذا الكتاب رأيًّا، ليكون (…) تعبير ما قصصت (…)، فحبَّرّْتُه (…) محبورًا بفنون من الآداب” (الصفحة نفسها).
من المعروف ذكرُه – وهو ما ذكرَه بعض واضعي “ترجمة” الجلياني – أنه التقى بالناصر الأيوبي؛ وهو ما حصل له في المسجد الجامع، المذكور أعلاه، بلسان الجلياني نفسه. والظريف، في الحكاية، هو أن الكاتب يرسم علاقة لزومية، بين ما يراه في الحلم وبين ما يحدث له في النهار التالي. وهو ما يتكرر للمرة الثانية في الليلة التالية… ما يعني أن ما حلم به الجلياني ليس مِما خطط له، بل مِما أتاه “عفوًا”، بناء لحكمة خارجة عليه. وهو مفهوم ديني يتكرر في الكتاب، حيث إن الكاتب يأتي، في كتابه، بما أتيح له التعرف إليه، ولم يكن من “عندياته”، إذا جاز القول. وهو مفهومٌ معروف عند المتصوفة وغيرهم: الكتابة تتأتى من مصدر “عُلوي”، ما يزيد من قيمتها، وما يخفف – خاصة في المديح – من طلب الشاعر قول المديح في غيره.
يذكر الجلياني، في مدبّجة أخرى، سيرة أخرى لكتابته هذه أكثر قربًا وتماشيًا مع مسار العلاقات حينها بين سلطانٍ وشاعر “قد توَّجَ الله غرةَ جمالها، وبهجة إقبالها، بحلى مآثر السلطان (الملك الأشرف) (…). ولما استفاض إقبالُ هذا المَلك الكريم على العلوم وأربابها (…)، وجب عليَّ أن أصوغ لذكره المنداح حِلية لم يُرَ مثلها في الأمداح”. ثم يتابع الجلياني في شرح ما قام به، فيكتب “فكم مدَّعي بلاغةٍ لا يرى من هذه (المدبّجة) إلا أصباغها، عاجزًا عن قراءتها، فكيف له أن يذوق مساغها” (أي طيبَها)، وهذا بخلاف من له بصيرة، إذ “يُكبر صنعةَ من صاغها” (ص 99).
قد يكون الجلياني قد عملَ على إيجاد هذا النوع الكتابي الجديد من تلقاء نفسه، بمبادرة منه، ما لا يقوى الدرس على جلائه. ولكن ما اتضحَ أعلاه هو أن تدبيج عدد من الأعمال قامَ بناء لما انتظم بين الكاتب والسلطان، كما سبق القول. غير أن هذا التفسير أو القبول به لا يكفيان أبدًا في تفسير ظهور هذا النوع الأدبي المزيَّن. فقد بانَ أعلاه أن الجلياني أراد هذا الصنيع في تدبيرٍ مدحي مقصود بذاته، كما أوضح ذلك بنفسه. وهو يشير، في هذا، إلى تقاليد مدحية معروفة، سابقة، يتطلع فيها الشاعر إلى مجاراة غيره من الشعراء المادحين، بل إلى التفوق عليهم. هذا ما طلبَه الجلياني، واجدًا في السلطان ما يناسبه من “الصفات” الجديرة بمثل هذه الأعمال، ما دام أن المَلك يقتفي “أشرف سِيَرِ الملوك وآدابها”، ويصغو “إلى مبتكرات الأدباء والبلغاء”، ويفهم غوامضها “بحسن الاستماع والإصغاء”، ويعترف بقدر الفضلاء والنجباء، ويبسط لهم “رداء المبرَّة” (أي الإحسان)، ويقرِّبهم منه (الصفحة نفسها).
إلا أن التعرف إلى المدبجات ممكنٌ بصورة أيسر، لو جرى التوقف عند التي لم يُهدِها الجلياني لأحد، وكتبَها في العام 575 هـ. هي من المدبجات الأقدم في الكتاب، بأي حال، ويفيد الكاتب، في مطلعها، عن سبب نظمها. ذلك أن سبب إنشائها يبدو مثل نوع من “المعارضة” لصنيع القاسم بن علي الحريري، صاحب “المقامات” المعروف [8]. فهو يَذكر أن الحريري وضع بيتَين، في إحدى مقاماته، سمّاهما “البيتين المطرفين المشتهي الطرفَين”؛ وأن الحريري وضع رسالة أسماها “القهقرية”، “التي تُقرأ من طَرَفِها بدءًا وعودًا إلى أولها”، فكان أن وضع الجلياني قصيدة من اثني عشر بيتًا، لا من بيتَين وحسب في العام 575 هـ، وفق المثال الأول للحريري؛ ثم وضع، في المثال الثاني، رسالة بدوره، لكنه أسماها “الرسالة المنعطِفة” (إذ لم يَرُقْ له، حسب لفظه، اسم “القهقرية”).
هذه القربى بين الجلياني والحريري لافتة، ومناسبة؛ وتشير، أيًّا كان الأمر، إلى مساعٍ معروفة في التأليف قامت على إبراز التفوق اللغوي لكاتبها. وقد يَعني ما أوردتُه نوعًا من التشبه أجراه الجلياني بالحريري؛ فهما تتابعا الواحد بعد الآخر: الحريري (446-516 هـ)، ثم الجلياني (531 – 602 هـ)، ما يعني أن الجلياني لم يلتقِ بالحريري، وإنما لحق به، وطلبَ محاكاتَه، والتفوقَ عليه (كما يمكن التكهن، وفق الأخبار ودلالاتها). كيف لا، وقد أفادت أخبار كثيرة عن الشهرة التي طاولت الحريري إثر عمله على مقاماته… فقد قيل إن النسَّاخ تهافتوا على استنساخ مقاماته في بغداد، حتى إن الحريري نفسه وقَّعَ بخطه، في عدة شهور من سنة 514 للهجرة، على سبعمئة نسخة منها. بل تضيف الأخبار أن شهرة المقامات ذاعت حتى بلغت الأندلس، فكان أن أتى علماء منها، واستنسخوا المقامات: هكذا تكون قد اكتملت الدورة، بخطوطها العامة، بين الجلياني وبين الحريري، من دون تفاصيل مزيدة.
إلا أن الغريب، في أمر المقامة، هو أنها وُضعت، في بنائها كما في مادتها السردية، على “مقلب” حكائي يخص حياة “أهل الكدية”، أي المهمشين وأصحاب الألاعيب الظريفة، فيما يقوم صنيع “المقامة” اللغوي على لغة شديدة التقعر والندرة… لا يختلف صنيع الجلياني، في مدبّجاته، عن هذه اللغة، وإن شعرًا: لكي يقوى الشاعر على صنيعه اللغوي، يحتاج (مثل كاتب المقامات) إلى زاد لغوي واسع، لكي يستقي منه ما يحتاجه في التراكيب اللغوية – الشعرية التي يُلزم نفسه بها في صنيعه. وهو ما يذكره الجلياني في مقدمة “القدسية”، أي أنه لم يسمح لنفسه، في الأبيات الشعرية، بأيّ جوازات أو تضمين وغيرها… ما يزيد من غرابة صنيع الجلياني، هو أنه يتولى المديح في بعض ملوك الأسرة الأيوبية، وفي انتصاراتها، فلا يشير في الغالب (سوى بعض الذكر الحربي) إلى أعمالها، وإنما إلى “صفات” التعظيم والتفخيم المناسبة أو المطلوبة في المديح [9]. ماذا عن المدبجة شعرًا؟
يقسم الجلياني الكلام إلى ثلاثة أنواع: “نظم وتدبيج وكلام مطلق”، أي غير مقيد بقواعد (ص 74). ويعرِّف المدبجة كما يلي “نظمٌ في نظم مشتبك متداخل”؛ وهذا يعني أن تتابع الأبيات في الشعر القديم غير متوافر في المدبّجة، بل تقوم المدبّجة على تشابك وتداخل في ما بين أبياتها. هذا يعني، واقعًا، وجود قصائد متعددة في المدبّجة الواحدة، وأنها تتخذ، في توزّعها فوق الورق، شكلًا غير متتابع كما في الشعر القديم عادة، وإنما تتخذ شكلًا متداخلًا، ما يعني أن الأبيات والقصائد “يُداخل” بعضها البعض الآخر. ويتخذ هذا الشكل – الجديد في الشعر العربي بالتالي (وفق ما هو معروف) – عدة هيئات، فيذكرها الجلياني بالاسم: مبسوط (وهو التقليدي المعروف في الشعر)، مضاعف (أي المزدوج)، مصدَّر (أي الذي يتصدر غيره في الورقة)، منَهَّر (أي جارٍ مثل النهر)، مختَّم (أي الواقع في ختم طباعي)، ومنجَّم (أي الواقع في نجيمات) وغيرها. كما يشدد الجلياني على أن كل قصيدة، في المدبّجة الواحدة، تحتفظ بأبياتها كما بشكل نزولها على الورقة، إذ أن “كل صنف منها قائم بنفسه، تام الصنائع” (ص 76). هذا يجعل المدبّجة عملًا كتابيًا مبتكرًا، لكنه صعب القراءة بالتالي؛ وهو ما يسهله الشاعر لقارئه إذ يضع ما هو أشبه “خريطة طريق” للتنقل في المدبجة، ما يَرِدُ في بداية المدبّجة، وهو كيفية القراءة لها.
المدبّجة بوصفها شكلًا
رؤية المدبّجة تبلبل النظر، بقدر ما تُغريه. تبلبلُه حكمًا، إذ أن النظر إليها، أو فيها، لا يقود بالضرورة إلى القصيدة في شكلها العروضي، القالبي، المعروف. هكذا نقع على كلمات أو على سطور متقاطعة، ما لا يُذكِّر بالبيت الشعري المستوي في سطر، في سطور متوالية ومتشابهة. كما أن النظر في ألفاظها، في تتابعها، يُظهر أن بعضها متلون بأصباغ (وفق لفظ الجلياني) مختلفة، وليس بلون المداد وحده (كما يمكن العثور عليه في مخطوطات الشعر القديمة).
المدبّجة، بهذا المعنى، ليست قصيدة، بل هي – على المستوى الكمي – أكثر من قصيدة واحدة، إذ تلتقي فيها وتتقاطع أكثر من قصيدة، وبقواف مختلفة. المدبّجة، إذًا، كتاب، عملٌ كتابي وهندسي وصباغي يليق النظر فيه، ربما أكثر من القراءة فيه.
المدبّجة تُبلبل النظر، ما دام أنها تمثل للعين من دون الهيئة النسخية القديمة (الانتظام المتوالي في قالب مستطيل)؛ ولا تتابع العينُ فيها ما تتابعُه في سطور في كتاب. فالعين تتوزع في نقاط عديدة ومختلفة فيها (ما يشبه النظر إلى العمل الفني في مجموعه)، وما يغلب على تلقي هيئة المدبّجة هو أن لها هيئة شكلية مختلفة من مدبجة إلى أخرى.
خرجت القصيدة، مع المدبّجة، من القالب المتناظر، المستوي في سطوره المتوالية، صوب ما يمثل للعين مثل صورة خطية – شكلية – صباغية متبدلة من ورقة إلى ورقة، من قصيدة إلى أخرى، من مدبّجة إلى أخرى. كلُّ مدبّجة، بالتالي، عملٌ مبتكَر، مختلف، يخاطب عين الناظر قبل القارئ منذ الالتفاتة الأولى.
القصيدة القديمة، العروضية، في عهد الجلياني، كانت تمثل للقارئ كما للناظر في هيئة واحدة: تتألف من أبيات مستوية، ومن توالي هذه الأبيات التتابعي. هذا ما كان يرسم لهذه القصيدة شكلًا قالبيًّا، في هيئة مستطيل طولي في الغالب. هذا ما يتبدل مع مدبّجات الجلياني، إذ نجد أبيات القصيدة تنتظم (كما العادة) في سطور مستوية وأفقية، فيما نجد غيرها يرتفع عاموديًّا، أو يتلوى… أو نجد أبياتًا تدور في دائرة، وغيرها من التشكلات. هكذا يصبح للورقة في المدبّجة شكل بنائي مختلف عما كانت عليه القصيدة القديمة: بدل الشكل المستطيل، ستمثل المدبجة، في أحوالها البنائية الكثيرة، وفق صورة جامعة، تتوزع وتتفرق في أشكال يمكن التعرف إليها.
هذا ما يشرحه الجلياني بنفسه “ألفيتَ اللطائف جناها، فزهرُها المُلح أكمامها المُدح، وثمرها المِنح، ملتفة على ساقين تُسقى من شطين، نابتة في رياض النظم الأخضر حيث نجمت بدائع المنظر، في فروع تشتبك وأصول تشترك، حفَّتها أنامل مخضبة تشير إلى هذه الروضة المخصبة، وضِمنَها مربع معين تحلى بالعقيق فتعين، وأنهار مَسِيلُها نضار وأزهار تُجنى فلا تُضار، يحار البصر في مرآها وتَذهل الفِكَرُ في مبناها، مرسلةً جدولَين مذهَبين تقاطعا ليصلا ذات البين، إلى مختمة منمنمة، جادها الإحكام فأحياها وحَكَمَ الاشتراك على أطرافها وزواياها” (185).
هذا ما يتابعه بالقول “ازدحمت أشكالها ازدحامًا، والتحمَ إشكالها التحامًا، كأن المثل الإقليدسية صيرت إليه، والحِيَل الشاكرية صوّرت عليها، من مثلثات ضمن مساحتها، ومدورات خطرن ساحتها، ومربعات معينة ومخمسات مبينة ومسدسات متمكنة، ومسبعات تندرج ومثمنات تنعرج، ومتسعات موسعات ومعشرات منتشرات، واثناعشريات متناسبة ومخروطات متراكبة، وما يتولد بالتركيب منها أعم مما حكينا عنها” (186).
هذا ما يؤكده في مواضع أخرى من كتابه “صورة شجرتين ملتفتين تشتمل على أربعين بيتًا عينية لزومية، مزدوجة اللزوم، متناظرة متقابلة: الذي عن اليمين مثلُه عن اليسار في مثل موضعه وشكله مفرغًا من الأصل على هيئة الآخر” (233).
يحفل التعريف بصنيع الجلياني أعلاه بألفاظ واصطلاحات غير متأتية من الشعر ونظريته، بل من غيره، من مدونة أخرى: شجرة، الزهر، الثمر، الساق، الرياض، الفروع، الأصول، أنهار، جدول وغيرها، أي مما يتحدر من معجم “الواحة” (كما تحدثنا عنه في الفصل الأول)، وما يجمع بين الخضرة والماء، في المدبجة كما في الدار [10].
كما يتحقق الدارس من ألفاظ واصطلاحات، احتيجَ إليها للتعريف بالمدبّجة من خارج المتن الشعري، إذ يعود الجلياني إلى غيرها من زاد الهندسة وأشكالها: موضع، شكل وأشكال، مربع، مبنى، مختمة، منمنمة، مربعات، مخمسات، مسدسات، مسبعات، مثمنمات، متسعات، معشرات، اثناعشريات، أطراف، زوايا، المثل الأقليدسية، الحيل، المدورات، مخروطات، التركيب، هيئة وغيرها.
كما يمكن التنبه أيضًا، في كلام الجلياني، إلى أن له أوصافًا لتوزع الألفاظ والأبيات لا تتناسب مع متطلبات الوزن أو النحو وغيرها، فهو يطلب لمواد المدبجة أن تكون (حسب لفظه): ملتفة، متناظرة، متقابلة، تشتبك، تشترك، تتقاطع، تلتحم، ازدحمت، صورت، تندرج، تتعرج وغيرها.
لو شاء الناظر إلى المدبّجة تشبيهها بصنيع ثقافي قديم، لَمَا شبَّهَها بالقصيدة أبدًا، بل بتشبيكات خطية – زخرفية، فوق جدار قصر، أو على آنية، أو فوق أثواب وغيرها. فالمدبجة، مثل القصر المزخرف، أو الآنية المزينة، أو الثوب الموشى، تشتمل على أعمال متعددة، بين خط وتشكيل وصباغة. وما يصحُّ في القصر والآنية والثوب، يصحُّ في المدبجة، وهو أنها عمل مركَّب.
المدبّجة تتعين في شكل مبتكر، مُتئلِّف من عدة أشكال، بل قد يختار الجلياني شكلًا منها، مألوفًا، مثل الأشكال التالية: الشجرة ذات الأغصان، والدائرة، والخانات المربعة، والخطوط المتقاطعة بشكل هندسي مضبوط بين عامودية وأفقية وغيرها.
قصيدة ذات صورة زخرفية
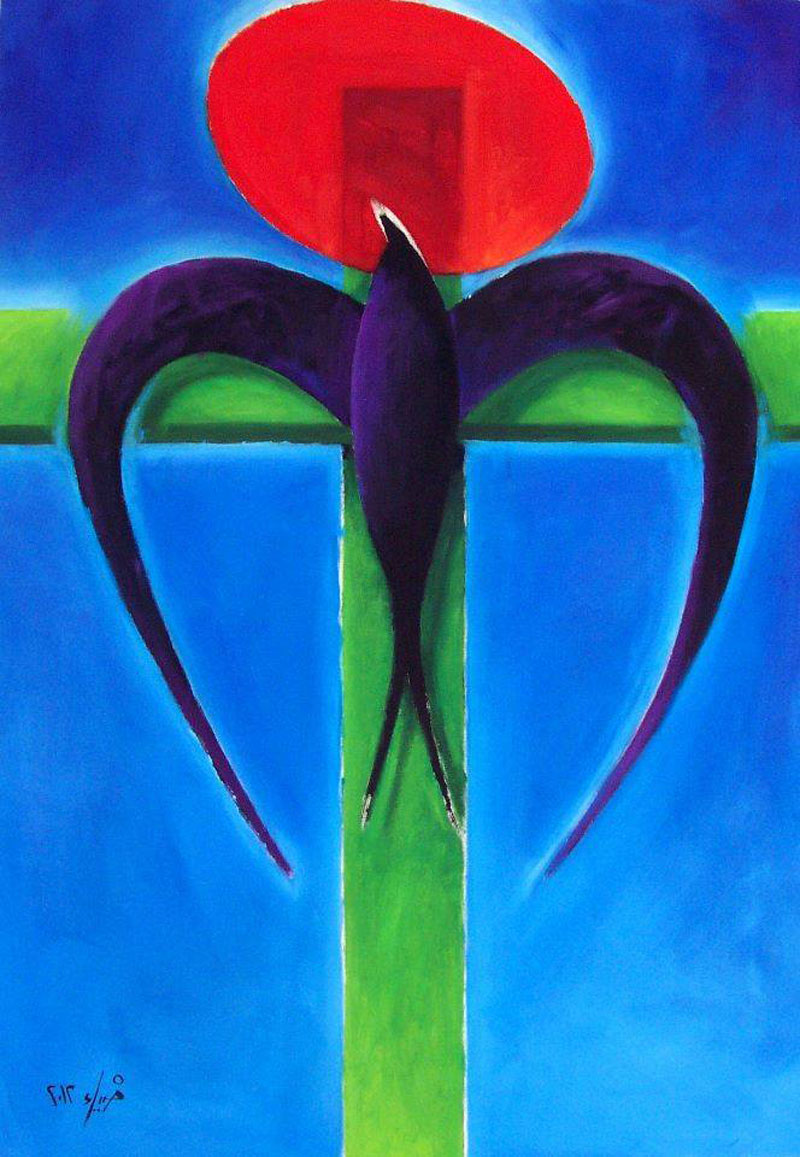
هكذا لم تعد قراءة القصيدة ممكنة كما في سابقها من الشعر: تحافظ الصنعة الشعرية على مبدأ “وحدة البيت”، بل تُطبّقه بصورة محكمة، وهو ما يوضحُه الجلياني ويؤكده بنفسه. إلا أن البيت يخضع في تأليفه إلى حسابات لا تتصل بالوزن والتفعيلات والمتحركات والساكنات وحدها، وإنما يخضع تنظيمُ البيت أيضًا لحسابات واقعة في الحروف، في تتابعها التلقائي أو في قلبها وعكسها. ومن المعلوم أن هذا الصنيع قائمٌ في بعض “مقامات” الحريري، إذ يقوم، في مقامة، على سبيل المثال، بإيراد كلمات، فتكون مرة منقوطة ومرة غير منقوطة؛ أو تتوالى الكلمات، في مقامة، بالتبادل بين النقط وعدمه، أو يرد مقطع في المقامة غير منقوط بكامل ألفاظه وغيرها، فضلًا عن السجع والمحسنات البديعية فيها.
هذه “الألعاب” اللغوية عديدة في أبيات قصائد الجلياني، وأكتفي بعرض عينات منها. قد يبدأ كلُّ بيت في قصيدة بواحد من هذين الفعلين:
أفاض…
عِمادُ…
أفاض…
عِمادُ…
وهكذا في الأبيات التالية: هذا التناوب الثنائي لهذين الفعلين هو ما يبني القصيدة بيتًا بيتًا، وبيتًا تلو بيت، مرتكزًا إلى فعل في بداية كل واحد منها.
أو نجد الجلياني يُقدِم، في افتتاح بيت، على استعمال عدد من الحروف، ثم لا يلبث أن يستعملها، هي ذاتها، ولكن… بالمقلوب، كما في هذا المثل:
يا مَنْح مَهْ (…) يأمنْ حَمَه
… وهكذا في كل بيت من هذه القصيدة.
هكذا يتمُّ “التلاعب” اللفظي والنحوي بالبيت تلو البيت في القصيدة الواحدة. إلا أن هناك “تلاعبات” أخرى تنادي الناظر أكثر من الفاحص اللغوي في الصفحة عند الجلياني. بات لترتيب الحروف، والألفاظ، في الجملة، في البيت الواحد، ترتيب… شكلي بالتالي، ما يخضع لحسابات أخرى، غير حسابات النحو والوزن. هذا ما يصيب البيت، وهذا ما يصيب القصيدة. هذا يعني، في واقع العمليات الجارية، أن القصيدة (والقصائد) تتنزل في أشكال مختارة؛ وهي ليست من صنيع الشاعر بوصفه مهندسًا، ومزخرفًا. ما يقترحه الجلياني في تصميمه العام هو ما يشبه قوالب الزخرفة في الفن الإسلامي. هذا مدعاة للتساؤل: أهي رسوم أم أشكال أم صور؟
يمكن القول، بداية، إنها من الأشكال، وإن تترسّم أحيانًا شكل الشجرة أو النهر وغيرها؛ وهذه معروفة ومستحسنة في الزخرفة، ما يوافق بالتالي قواعد متبعة في الفن الإسلامي. وإذا كان صنيع الجلياني الشعري جديدًا في الغالب، فإن صنيعه الشكلي ليس بالجديد، إذا أخذنا في عين الاعتبار ورودَ مثل هذه الأشكال في الكتب والعمائر القديمة. وتكون الجِدَّة الأكيدة ماثلة في المدبجة، في الكتاب، في الجمع بين التوليد الشعري وبين توظيف أشكال زخرفية في العمل عينه.
ما يعني الدارس، في المقام الأول، هو الوقوف عند هذه العلاقة بين البيت وبين الشكل. وهي علاقة يتضح، بعد درس معطياتها الشعرية والشكلية، أنها تتعامل مع الشعر تعاملًا زخرفيًّا؛ وهو ما يمكن تتبُّعُه في تشكلات القصيدة والبيت فيها. فهناك (كما جرى الذكر أعلاه) أكثر من شكل، ومن علامة، تضاف إلى هيئة كل قصيدة في المدبّجة، ما يجتمع في الأشكال الهندسية (لا اليدوية والمتفلتة من القيود والحسابات وأدوات الهندسة)، وفي بعض العلامات الهندسية التي تتشبه بإرث الواحة، من شجر وماء.
اتضح، في التحليل أعلاه، أن القصيدة تنبني، في بعض حروفها وألفاظها، وفق تتابع وحسابات شكلية، في التتابع أو التعاكس وغيرها. كما اتضح أن قالب القصيدة في المدبّجة “يتنزل”، أو ينتظم وفق شكل هندسي (وأكثر) مُختارٍ، بل مسبق. كما اتضح بالتالي أن انتظام “هيئة” القصيدة والمدبّجة بات يتكل على المسطرة والبركار وغيرها في عملية “إظهارها” و”تقديمها” للقارئ بوصفه ناظرًا أيضًا. إلا أن التحليل لم يستكمل الإجابة المطروحة، أو جميع عناصرها: هل تعوِّل القصيدة، والمدبجة، على الصورة أـم على غيرها في تشكيل بنائها وهيئتها؟
يتلقى القارئ أو الناظر (المزامن للجلياني) المدبجة بعين… أليفة، إذ تشبه في “هيئتها” ما يعرفه، ما يلقاه (في تلك الأزمنة)، في قبة، في جدار، في آنية وغيرها. فكثير من هيئات الرسوم والأشكال في المدبجات يستعير منظرًا، شكليًّا وزخرفيًّا معروفًا، ما لا يُعتاد عليه في كتب الشعر، بل في أعمال الزخرفة والتزيين. فكثير مِما يَرِدُ في المدبّجات قابلٌ للتعرف إليه في متن آخر، هو متن الفن الإسلامي، ولا سيما الزخرفي والتزييني منه. وما تستعيره المدبّجة، لا يقوم على استقراض صورةٍ، أو وجهٍ، وغيرها، وإنما على استقراضِ أشكال أليفة، مثل الشجر وغيرها، في جدران المساجد أو القصور وغيرها. لهذا لا يمكن الحديث عن “صورة” في المدبّجات إلا وفق معنى محدد، وضيق: الصورة، فيها، لا تتمثل وجهًا أو مشهدًا، ولا ترسم حكاية وغيرها (مثلما نلقاها، في المقامات، بتدبير من المصور يحيى الواسطي [11])، وإنما هي تنتج صورة، وتعرضها، وفق معنى الصورة… التنزيهي، أي الساري في الفن الإسلامي. هي صورة هندسية في المقام الأول، طبيعية في بعض رسومها، وتعمل على زخرفة العناصر وتجميلها بالتالي.
صورة تنزيهية
هكذا انبنى نظام متباين بين “نظمية” القصيدة وبين “صورتها” فوق الورق: تحافظ القصيدة الواحدة على عروضها وقافيتها، لكنها متبدلة في توزّعها فوق الورقة، ما يمنح القصيدة هيئة جديدة، غير مسبوقة: هيئة صورية. وهي صورة مسبوقة، إذا جاز القول، إذ إن الجلياني يقترب من السطر (بمربعاته وخطوطه النظامية فوق الورقة، وفق المسطرة)، ومن الدائرة (بخطها الواحد أو المضاعف، فوق الورقة، وفق البركار)، ومن الشجرة ذات التقسيمات الهندسية المتفرعة منها (بخطوطها، وفق المسطرة)، ومن الدوائر والرسوم الفلكية، ومن القناطر المعمارية وغيرها. لكن الجلياني كان راسمَ أشكالٍ هندسية، مقتديًا بما هو مألوف في الزاد الهندسي الزخرفي في تلك العهود، من دون أن يَخرج عليه، أو أن يضيف إليه: لا يُقدِم على خرق أيّ من العادات والقواعد المتبعة في تلك العهود، فلا يرسم هيئة آدمية، أو منظرًا بالمعنى الفني للكلمة. وهو ليس بمصوِّر بالتالي، عدا أنه يُبقي أشكاله في دائرة “النهي” الإسلامي، أي اتِّباع “التنزيه”. هذا ما يجعل كلام المحقِّقَين، منذ عنوان الكتاب، وخصوصًا في مقدمتهما، عن “التجسيد” كلامًا غريبًا للغاية، إذ يضعان للمقدمة العنوانَ التالي “مع دراسة للشعر المجسد بصريًّا”.
هكذا يكون الجلياني، في صنيعه، يرفع من قيمة القصيدة بجعلها ذات هيئة وأصباغ وأشكال، ما يعني طلبَ إنزالِ القصيدة في الصنيع الفني. وهو أمر يكاد أن يكون ناشئًا في التعامل مع الكلمة الأدبية، وفي ربطها أو عرضها وفق مثالات بصرية. فإذا كان الخط العربي أظهر جمالات الحروف، والكلمات، ولاسيما في الآيات القرآنية، وإذا كان هذا الصنيع قد انتقل من المخطوط إلى حيطان المسجد والقصر والآنية والثوب وغيرها، فإن ما يحدث، مع الجلياني، يطلب تمثلًا “فنيًّا” للقصيدة. هذا ما يشير إلى “استمداد” القصيدة لفنون متأتية من خارجها الأدبي، ومن قواعدها وجماليتها. غير أن هذا الاستمداد “أنزل” القصيدة (بين حروفها وأبياتها) في لعبة الشكل والأشكال، لكنه أبقى الكلام غير “متفاعل” بالضرورة مع الرسم، عدا أنه بات صعبًا، بل متعذر القراءة. وهو ما يصح في المقامة قبل ذلك…
أبطلَ صنيعُ الجلياني، مثل الحريري قبله، “مقروئية” اللغة، إذ جعل القراءة (وعمادُها الفهمُ) غير ممكنة إلا للمقتدرين في اللغة، أو لمن يصطحبون معهم، في القراءة، أكثر من معجم. كما يمكن القول أيضًا إن العلاقة بين القصيدة والرسوم المصاحبة لها، تبقى شكلانية، زخرفية، ما دام أن الشاعر – المصمِّم لا يقيم أيّ علاقة تواصل (تعبيري وغيره) بينهما، فيما بنت مزوقات يحيى الواسطي وصورُه، في مقامات الحريري، علاقة تفاعلية أكيدة، تقوم على الإظهار والتعيين، بل زادت على الصورة معطيات ليست متوافرة في المقامة بالضرورة [12].
مع الجلياني، لم تعد القصيدة مكتفية بذاتها، بما توارثته من تقاليد صنعية، وبما يتدبره لها من نَسْخٍ (والوراق من استنساخات مزيدة). بات الشاعر، مثل الجلياني، يوفر لقصيدته عنايات مزيدة متأتية من خارج تقليد الشعر. ومن أولى هذه العنايات والتوصلات الناشئة هو أن القصيدة لم تعد للسماع والتدوين فقط، أي الحفظ في ذاكرة وفي ورق، وإنما باتت ما لا يُسمع، بل يُقرأ: يُقرأ وفق تعليمات إرشادية لتوزيعها و”لألعابها”، وفق عين الفهم والتواصل، ووفق عين البصر (خصوصًا وأنه يعدد الأصباغ في الخطوط).
القصيدة تحفة للاقتناء
لم يكن الجمع بين المقامة والمدبّجة، في التواريخ وفي الصنع الأدبي، جمعًا استنسابيًّا، بل هو جمعٌ موافق للزمن التاريخي، وللزمن الكتابي، على ما يمكن الاستنتاج. هذا ما جرى عرضه أعلاه عن علاقات بين الحريري وبين الجلياني؛ وهو ما صرّح به الأخير بنفسه. كما أن التحليل عزز هذه التلاقيات، إذ كشف عن تشابهات في الصنع التأليفي بين النوعَين الأدبيين المذكورين. إلا أن هناك ما يستدعي التحليل المزيد في هذه المسألة، ويتناول أمورًا متفرقة، لكنها قد تكون مجموعة في الزمن التاريخي والتأليفي. فعمَّ أتكلَّمُ؟
توقف غير كاتب عربي وأجنبي عند العلاقات الخصبة بين المقامات (لا سيما لدى الحريري) وبين تناولها الفني (لا سيما عند الواسطي). فقد كشف غير كتاب ودراسة، وبغير لغة، عن وجود نسخ متعددة، في غير زمن، عن تصوير المقامات في مخطوطات فنية [13]. ولو تتبَّعَ الدارسُ جملة من التواريخ، بين صنع الواسطي (ابتداء من القرن الثالث عشر الميلادي) وبين صنع الجلياني القريب زمنًا منه، لأمكنه تتبع خطوطَ اتصال واجبة الدرس. لا يسع الدارس معرفة “البدايات” هذه، إلا أنه يستطيع التكهن والتخمين ووضع الفرضيات، ومنها: ألا يمكن أن يكون هناك مساع للتشبه بين الصنيعين؟
مثل هذا الاحتمال وارد، وممكن، إذ يبيح التفكير في ما يمكن أن يصيب التأليف الأدبي من مساع تجديدية، سواء في مادته الأدبية أو في صنعه المادي. هذا ما يمكن التفكير به ابتداء من “العنايات” التأليفية التي بات يوليها بعضُ كُتاب النثر “الديواني” بكتاباتهم؛ وهو ما تحفل به كتب عديدة قديمة، في فترات متقاربة من زمن الجلياني، وفي الأندلس، ما يزيد من تأكد الوجهة التأليفية الحادثة. فبين كتاب “نقد النثر” لقدامة بن جعفر (المتوفى في العام 337 هـ) و”كتاب الصناعتين” لأبي هلال العسكري (المتوفى نحو 395 هـ) وغيرهما، قبلهما وبعدهما مباشرة، يتحقق الدّارس من كون هؤلاء المؤلفين يتدبرون – مع الإقرار المسبق بـ”علو” الشعر عن غيره – مكانة “أدبية”، لا “ديوانية” وحسب للنثر. إلا أن “أدبية” النثر (ابن المقفع، الجاحظ، أبو حيان التوحيدي…) لن تتأكد وتتنامى بعدهم، بل يمكن الحديث عن مكانة باتت ممكنة لـ”الديوانيين” في القرون التالية، كما يمكن معاينة ذلك في “المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر” لابن الأثير، الكاتب “الديواني” (المتوفى في العام 637 هـ) وغيره [14]. هذا ما يمكن تتّبعه بصورة أوفى، قبل ذلك، عند الكلاعي الإشبيلي (في القرن الهجري السادس) في كتابه “إحكام صناعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس” [15]. ففي هذا الأخير، يمكن الانتباه إلى أن الناقد الأندلسي يستخلص عددًا من أنماط الكتابة “الديوانية” وأنواعها، مثل المرصَّع”، و”المغصَّن”، و”المفصَّل” و”الموزى” وغيرها (م. ن.، ص ص 104-195). وهي – كما يمكن الملاحظة – تتلاقى مع ما كان الجلياني قد اختطه لمدبّجاته. وفي خلفيات موقف أكثر من كاتب أندلسي، من الجلياني إلى الكلاعي، يتحقق الدارس من أنهم يتصرّفون من قبيل استكمال ما بدأ به المشارقة في هذه النزعة “البديعية”، والتفوّق عليهم، وإنتاج أعمال أدبية ونقدية “مخترعة”، حسب لفظ ابن الأثير.
لا يسع الدارس، ولا البحث، التمهل والتتبع المزيدين في المسار، إذ يتعدى تمامًا استهدافات البحث. فيكتفي وحسب بالتنبه إلى أن “العناية” بالصورة، ومنها الزخرفة والتوشية والصورة وغيرها، تنامت حضورًا في مخطوطات الأدب، مثلما تنامت صناعات تأليفية متفاعلة معها، ما يمكن تسميته بـ”زخرفة الكتابة”. ولو أجرى الدارس نقلة في هذا التاريخ المترامي، لأمكنه الوقوع، على سبيل المثال، على “ديوان” في القرن الهجري العاشر لابن معتوق، يقوم فيه كاتبه بإنتاج “مقطعات” (حسب لفظه)، وهي تُقرأ طولًا وعرضًا وطردًا وعكسًا على أنحاء شتى” [16].
هذه الكتابات باتت تجعل من “التفرّد” اللغوي (أي صعوبته، واقعًا)، “البديعي”، عنوانًا لتفرد كاتبها، ولمكانته بالتالي. وهو مسعى من قبلهم لرفع المكانة بما يدانيها من مكانة الشعراء… المدّاحين. هذا ما أمكن التفكير به في مساعي النثر “الديواني”، وهو ما يمكن التفكير به في المقامة نفسها، حيث اجتمع “التقعير” اللغوي مع “المقلب” الحكائي المسلي. وهو ما يمكن أن يجمع – في تتابع الفرضية ذاتها – بين “الفرادة” اللغوية التي في المقامة وبين العناية التصويرية التي بات الواسطي وأقرانه يُتْبِعونها بالمقامة.
ما لا يتّضح كفاية في انتظام هذه الفرضية هو أن الرفع من مكانة الناثر أو المصور قد يستجيب إلى ذائقة لدى الحكّام باتت تتخفف من الإرث الأدبي والشعري (أو لا تتوافر لهم مَلَكات هذه الذائقة)، فيعولون على… الصورة، أو على الانبهار بـ”الألاعيب اللغوية” القابلة للتعداد، للملاحظة، مسقطين “وعورتها” اللغوية. وهو ما يقود بالتالي إلى صوغ الفرضية في منتهاها المطلوب لها، وهو: ألا تكون المدبجة إنتاجًا مناسبًا ومتولدًا من التواصل والتشارك بين هذه الإنتاجات الأدبية والتصويرية في هذا التاريخ، حيث يطلب الشاعر، مثل الجلياني، أن “يتفنّن” بوجوه المواهب المختلفة؟ ألا تكون المدبجة إنتاجًا متساوقًا مع بعض ما يُنتج من قبل المنتجين الثقافيين، ووفق ما يستسيغه الحاكم، ويتقبله في مقتنياته؟ فالمدبجة ليست قصيدة مخطوطة، يقتني الحاكم كلماتها، لا صنعها الخطي والمادي، بل هي عملٌ قابلٌ للاقتناء، للتمتع بها، للتباهي بملكيتها. تستعير المدبجة من الفن البصري الساري حينها ما يجعلها: تحفة نادرة، مقتنى فاخرًا، ما قد يناسب تغيرات في الذوق وأحكامه، من جهة، وفي كفاءة المقتني اللغوية والأدبية، من جهة ثانية.
لا تسعف الدارس قراءة المدونة القديمة في التعرف إلى أحوال الاقتناء والذوق: قد يساوي ثمنُ جاريةٍ أكثر من البدل المادي لقصيدةِ مدحٍ باهرة. ومن المؤكد أن بدلَ عملٍ كتابي ملوّن ومصور يساوي أكثر من قصيدة مدح… كما يميل الدارس إلى الاعتقاد والتخمين بأن ميلاً متعاظمًا إلى الاقتناء ترافق مع افتقار متعاظم للكفاءة اللغوية والأدبية لدى الحكام.
باتت القصيدة، إذًا، تحتاج إلى “خارجها”، ما يُنعش حضورَها الفني والجمالي. فما كانت عليه القصيدة – بوصفها مرجعية أدبية وجمالية – منذ الجاهلية، لم يعد – مع الجلياني – مقبولًا ومساويًا لما باتت عليه عروض العين: الفاهمة والمغتوية بنظرها. ذلك أنه، في موازاة القصيدة في عليائها، ولَّدَ التمدن الإسلامي، في المصحف كما في المقتنيات المادية المختلفة، أشكالًا للمتعة البصرية، ما تمثل خصوصًا في: الخط، والعمارة والزينة؛ وهي متعة متاحة لكل ناظر، حتى لو كان أمّيًّا. أيمكننا القول، بالتالي، إن عمليات المقامة أو المدبّجات، كان يُقصد منها – عمليًّا – إبطال الحاجة إلى العين الفاهمة، والإعلاء من العين الناظرة – عين الجميع، والحاكم في أوّلِهم؟
هكذا جرى رفع القصيدة الى مصاف الأثر البصري، ما جعلها تستفيد من أساليب الشكل والخط والزخرفة؛ إلا أنها استفادة “خارجية”، شكلانية، مظهرية، من دون علاقة تفاعلٍ خصبٍ ومنتج بين القصيدة وبين الشكل.
البحث في اتجاهات مغايرة
استندَ التحليل أعلاه، إلى المعاينة والفحص، كما بنى فرضية تبعًا لمعطيات وتقديرات. إلا أنّ مؤدى هذا التحليل ارتكز إلى علاقة أكيدة، ممكنة، بين القصيدة والصورة، الزخرفية تحديدًا. إلا أن في إمكان التحليل التوجه في وجهات أخرى، مختلفة، تُظهر حصول التفاعل المذكور، في أزمنة سابقة، ولا سيما في الحقبة العباسية. فعمَّ أتكلم؟
مثل هذه الأسئلة ضرورية، إذ تثير أسئلة حول ما لم يُدرَس في النقد العربي، سواء القديم أو المتأخر، أي وجوه علاقات بين داخل القصيدة وخارجها من أساليب الفنون والآداب. وإذا كان مسار التفاعل هذا بقي استعماليًّا، غير مجدّدٍ بالضرورة للشعر، ولا للفن البصري، إلا في حدود خفيفة، ظاهرة، وزخرفية، فإن علينا – هذا ما أسعى إليه – البحث عن التفاعل في تجارب أخرى غير تجربة الجلياني: هذا ما أبحث عنه وفق السؤال التالي: هل ترى القصيدة إذ تكتب أبياتها؟ هل دخل فن البصر إليها؟
لقد توقفت، لهذا الغرض، عند قصائد مختلفة، لقصيدتين عند أبي نواس والبحتري، وعند اقتباسات عديدة من شعر ابن الرومي [17].
أخترتُ هذه القصائد، وكان في الإمكان اختيار غيرها، لدى شعراء آخرين، لإظهار ما لم يستوقف الدرس العربي، وهو حصول علاقات خافية، أكيدة، بين العين والقصيدة. هذا ما يمكن للدارس أن يتابعه في كثير من شعر أبي نواس (145 – 199هـ؛ 762 – 813م)، في ما تعمل عينُه على التقاطه، في حانة، في مجلس، وما يترافق في الغالب مع نزعة سردية بيّنة. فالعين تبصر لكي تروي: هذا ما ترصده، وترويه عن الخارجة من حمّامها، في لعبة في المعنى، في الإظهار، تقوم بين الظلام والضياء، بين الليل والصبح، في لعبة “لونية” تعززها الحركة السردية في القصيدة.
هذه العين التي ترى، مع أبي نواس، حميمةٌ، “جوّانية”، تسترق النظر (إذا جاز القول)، بينما تميل عين البحتري (205 – 284هـ؛ 821 – 897م) إلى أن تكون عينًا قريبة من حيث يجري المشهد الذي تنقله – الذي تصوره، وهو “مركب” الخليفة المنطلق إلى المعركة… يصف البحتري غيرَ أمرٍ في المركب، في جنوده، في سلاحه، في معاركهم، في هياج البحر وغيره؛ وهو ما يرد في لغة تُسَمِّي، مادية، دقيقة في حركاتها، في أفعالها.
أما عينُ ابن الرومي (221 – 283هـ؛ 836 – 896م) فتبدو ذات اشتغال متمادٍ بالنظر؛ بل باتت القصيدة عنده أشبه ببناء منظر. فمن يسترجع عددًا من قصائد المدح لديه يتحقق من أنه يمهد لها بعشرات الأبيات الراسمة لمنظرٍ حسن. ومن يتصفح أبياتًا مختلفة من شعره يتحقق من ورود ألفاظ واصطلاحات معنية بأساليب الفن الإسلامي، مثل: الخط، الشاهد والغائب، التأليف ذو النِّسَب، المنحوت الخشبي، سطور الكتاب، دمية المحراب، الوشي، التماثيل، زرابي وشي، التصاوير وغيرها الكثير. فهي ألفاظ واصطلاحات أليفة في لغة قصيدته، عدا أنها تشير إلى معرفة ابن الرومي بها.
ما يستوقف في شعره، هو أن قصيدته تتملّك “خارجها”، كعين “الناظر الضاحك”، أو “أيام أستقبل المنظور مبتهجًا”، حسب لفظ ابن الرومي. لهذا لا يحتاج الدرس إلى إظهار فنون الوصف في شعره، بل التنبه إلى تأليف شعري يقوم على العين، وعلى بهجتها، وصنعها الحسن لما تراه، كما في هذه القصيدة التي تتحدث عن العنب “الرازقيّ” المعروف في العراق:
“ورازقيٍّ مَخْطَفِ الخصورِ
كأنه مخازن البلّور
قد ضُمِّنَتْ مسكاً إلى الشطور
وفي الأعالي ماءُ وردٍ جوري
لم يُبقِ منه وهجُ الحرور
إلا ضياءً في ظروف نور“.
هذه العين لا تصف فقط، ولا تصور وحسب، وإنما تُبصر لمتعة في البصر، في إشراك المتلقي بما ترى، وتذوق ما ترى.
هكذا أمكن التنبه إلى مسار سردي في عدد من قصائد أبي نواس، وإلى وصف سردي وإخباري في بعض شعر البحتري، وإلى بصرية وصفية وحركية في بعض شعر ابن الرومي… وهي، في مجموعها، لا تربط القصيدة بالزمن وحسب، وإنما تستدخل، في القصيدة، ما كان يتعين وينوع ويجدد تجليات الأدب وتمثلاته في عدد من فنون الأدب والنظر [18].
الهوامش:
[1] عبدالمنعم بن عمر بن حسّان الجلياني الأندلسي: “ديوان التدبيج: فتنة الإبداع وذروة الإمتاع”، حقّقه وعلق حواشيه: كمال أبو ديب ودلال بخش، دار الساقي ودار أوركس للنشر، بيروت-إنكلترا، 2010.
[2] أديب، من أهل جليانة في أحد حصون غرناطة بالأندلس، هاجر إلى دمشق، وكانت معيشته من الطب، وفيها التقاه ياقوت الحموي، وقد زار بغداد في العام 601 للهجرة، ثم توفي في دمشق.
[3]من هذه الكتب: “أدب السلوك”، تحقيق وتقديم: د. بكري علاء الدين، بيروت، كتاب-ناشرون، 2017.
[4]خير الدين الزركلي، “الأعلام”، ص 167.
[5]تمكن العودة إلى مقالة عبدالله مخلص في منشورات مجمع اللغة العربية، دمشق: وقد عدت إليها في نسخة إلكترونية مصورة بالتعاون مع شبكة الألوكة، ص ص 263 – 239. www.arabacademy.gov.su
[6]وهناك غيرها من الملاحظات، ما لا حاجة لذكره، ويتعدى غرض هذا الكتاب.
[7] تعني “المعارضة”، في الشعر العربي القديم، محاكاة صنيع شاعر في قصيدة له، والتفوق عليه فيها، على أن يتَّبِع الشاعر ذات النوع والوزن والقافية.
[8]القاسم بن علي الحريري، المعروف بأبي محمد (446 – 516 هـ)، وهو من أدباء البصرة، وصاحب “المقامات” الشهير، بعد بديع الزمان الهمذاني، وقد بدأ بكتابتها في العام 495 هـ، وذاع صيته الكتابي بها إثر استنساخها، وجرى تعيينه في ديوان الخلافة في منصب “صاحب الخير”.
[9] أكتفي بإبداء هذه الملاحظة، على أن أعود إلى معانيها الكتابية والاجتماعية في فقرة تالية.
[10] هذا ما يجده الزائر، حتى أيامنا هذه، في دُور أندلسية، في قرطبة على سبيل المثال، بين الفسقية والشجر ذي العطور الفواحة.
[11] يحيى بن محمود الواسطي الذي اشتهر بصوره لمقامات الحريري في القرن الثالث عشر الميلادي.
[12] هذا ما درستُه بتوسع في: “الواسطي، ذلك المجهول”، في كتابي: “الفن الإسلامي بين اللغة والصورة”، دائرة الثقافة، الشارقة، 2018، ص ص 177 – 194.
[13] تمكن العودة إلى أكثر من كتاب ودراسة حول المسألة، وقد يكون ما كتبه د. ثروت عكاشه، من أغناها وأوسعها: د. ثروت عكاشة: “التصوير الإسلامي الديني والعربي”، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1977.
هذا ما يمكن تتبعه أيضًا، في دراسة متأخرة لأولغ غرابار، في مقدمة خاصة بإعادة طبع “طبق الأصل” لمخطوط الواسطي الشهير المحفوظ في “المكتبة الوطنية” بفرنسا.
يحيى الواسطي: “المقامات الحريرية”، نسخة طبق الأصل للمخطوط المحفوظ في “المكتبة الوطنية”، باريس، وأصدرتها شركة “تاتش آر”، لندن.
[14] ضياء الدين ابن الأثير: “المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر”، و “الوشي المرقوم في حل المنظوم”، تحقيق: يحيى عبدالعظيم، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2004، و”المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء”، وغيرها.
[15]أبو القاسم محمد بن عبدالله الغفور الكلاعي الإشبيلي: “إحكام صناعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس”، تحقيق: محمد رضوان الداية، الطبعة الثانية، بيروت، عالم الكتب، 1985.
[16] ابن معتوق الموسوي: “ديوان ابن معتوق”، تحقيق: سعيد الشرتوني، المطبعة الأدبية، بيروت، 1885، ص 211.
مثل هذا النقاش واسع في التاريخ الأدبي والفني، ولاسيما في الحقبة العثمانية، التي ستتأكد فيها النزعة “البديعية” لصالح “الألاعيب” الشكلية والحسابية والزخرفية، كما يمكن أن نتحقق من ذلك في عدد بالغ من إنتاجات تلك الحقبة حتى القرن التاسع عشر، مثل “التواريخ” الشعرية و”الألغاز” و”الأحاجي” وغيرها.
[17]يمكن الاطلاع على هذه المدونة في نهاية الفصل الجاري.
[18] شربل داغر: “بين النوع الشعري والزمن”، في كتابي: “القصيدة والزمن: الخروج من الواحدية التمامية”، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2015، ص ص 249 – 276.




