أثر فكر الكواكبي في المدونة الثقافيّة العربية

“الاستبداد أشد وطأة من الوباء. أعظم تخريبًا من السّيل، أذل للنفوس من السؤال” (الكواكبي)
يُعد عبدالرحمن الكواكبيّ (1855 – 1902) المولود في حلب الشهباء ببلاد الشام، من أكبر روّاد النهضة العربيّة في القرن التاسع عشر الميلاديّ، وقد اعتبره أحمد أمين واحدًا من زعماء الإصلاح في العصر الحديث، وفقًا لعنوان كتابه الذي حَمَل الاسم نفسه، فقد أوقف جلّ حياته من أجل قضيتيْن شغلتاه زمنًا طويلاً؛ الأولى قضية البحث في أسباب تأخّر الأمم، ولاسيما أمم العالم الإسلامي، والقضية الثانيّة هي قضية البحث في عوامل الاستبداد في حكم الدول، ولاسيما الدولة العثمانيّة.
ويعزو الفضل لشهرة الكواكبيّ لكتابه ذائع الصيت “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”. الكِتاب الذي صدر عام 1900، وقد سعى فيه إلى مُعالجة ظاهرة الاستبداد السياسيّ المتفشيّ في العالم الإسلاميّ والعربيّ. فالاستبداد عنده هو “التَّصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى”، ومن ثمّ يذهب – مباشرة – إلى أصل الداء، فيقول “إنّ الداء الذي سبّب هذا الانحطاط هو الاستبداد السياسيّ” (طبائع الاسبتداد: ص 131)، أما العلاج فهو “بالشورى الدستورية” ويقول في هذا الشأن “الاستبداد هو نار غضب الله في الدنيا، كما أن الجحيم نار غضبه في الآخرة، وقد خلق الله النار أقوى المطهرات، فيُطهِّر بها في الدنيا دنس من خلقهم أحرارًا وجعل لهم الأرض واسعة، فكفروا بنعمة الحرية، ورضوا بالاستعباد والظلم”.
الكتاب في أصله مجموعة من المقالات نشرها في جريدة المؤيد المصرية – لصاحبها علي يوسف – وذلك ما بين عامي 1900 و1902، عندما كان في مصر (1318 هـ) ثمّ جمعها – بعد أن أضاف لها – في كتابٍ مُستقل تحت عنوان “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد”. والكتاب يطرح نفسه منذ التقديم العام والتصدير بوصفه معالجة “للمسألة الاجتماعيّة التي يُعاني منها الشرق”.
الكتاب يُقدّم صورةً للمستبِدّ الذي يجمع إلى الغدر والخسة والفظاظة الرغبة العاتية في إبادة كل مغاير ومخالف ومنشق. فيعرّي المُستبدّ وأمراضه النفسيّة، كما أنّه يُدين الشرائح الاجتماعيّة التي تكون عونًا للمستبدّ. وإنْ كان يهوّل مِن أمر المُثقفين الذين يتخذهم الحَاكِم سدَنة له يروّجون لأفكاره، واذا قضى منهم وطره نكّل بهم وأبعدهم عن مجلسه، ويصف الكواكبي هؤلاء بأنهم “الجهّال والخبثاء المراؤون”.
الكاتب والكتاب
ألّفَ الكواكبيّ كتابيه “أم القرى وطبائع الاستبداد” قبل زيارته إلى مصر، على عكس ما أشار أحمد أمين في “من زعماء الإصلاح” بأنّ الكِتاب نتيجة دراسته بعد أن سَاحَ في سواحل أفريقية الشرقيّة وسواحل آسيا الغربيّة ودخل بلاد العرب وجال فيها، واجتمع برؤساء قبائلها ونزل بالهند وعَرف حالها، وفي كل بلد ينزلها يَدْرسُ حالتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة وحالتها الزراعيّة ونوع تربتها وما فيها من معادن ونحو ذلك، دراسة دقيقة عميقة، ونزل مصر وأقام بها وكان في نيته رحلة أخرى إلى بلاد المغرب يتمّ فيها دراسته ولكنه عاجلته منيته..”.
صدر الكتاب في طبعات مُتعدّدة، تحت توقيع الرّحالة (ك) منها طبعة مطبعة الجماليّة، دون تاريخ في 126 صفحة. وهناك طبعة مطبعة الدستور العثماني في شارع محمد علي، على نفقة إبراهيم فارس صاحب المكتبة الشرقية في مصر، وتقع في 152 صفحة من القطع الصغير. أيضًا هناك طبعة أنجزتها المكتبة التجاريّة في مصر في مجلد واحد مع كتاب أم القرى، عام 1931. وتوجد كذلك طبعة الدار القومية للطباعة والنشر في القاهرة ضمن سلسلة كتب ثقافية بتاريخ 5 ديسمبر 1959، وتقع في 102 صفحة. وطبعة مطبعة الأمة وهي على نفقة محمد عطية الكتبي جاءت في 127 صفحة من القطع الصغير، وَصُدِّرَتْ بأنّها “لفيلسوف الإسلام وعلاّمة الشرق المرحوم المبرور السّيد عبدالرحمن الكواكبيّ المُلقب بالسّيف الفراتي”.
هذه الإشارات تؤكّد تُعدّد طبعات الكتاب، مع وجود بعض الاختلافات التي تشير إلى الزيادات أو الإضافات التي حرص الكواكبيّ على إضافتها لأصول المقالات التي هي أصل الكتاب.
أصدر للكواكبيّ كتابه الأول “أم القرى” وهو عبارة عن جلسة متخيّلة؛ إذْ تخيّل أن اثنيْن وعشرين شخصًا يُمثّلون العلماء والفقهاء في اثنين وعشرين قطرًا من أقطار الإسلام؛ اجتمعوا في مكة لأداء فريضة الحج وبعد تبادل الآراء في أكثر من اثنتي عشرة جلسة رسميّة، اتفقوا على تشكيل جمعية غايتها بعث الإسلام. الكتاب في خطه العام بحث عن القضايا التي يُمكن من خلالها بعث الإسلام ونهضته من خلال انتقاده للشعوب الإسلاميّة.
أفكار الكواكبيّ التي ضمّنها لكتابه كانت نتيجة لوعي حقيقي بأحوال الأمّة العربيّة، فيها من الذّاتيّ والعام، فقد كانت نتيجة لتجربته المُتصِلة بنظم الحكم؛ إذْ تعددت الأعمال التي قام بها الكواكبي من محرر للصحيفة الرسمية، إلى رئيس كتّاب المحكمة الشرعية، إلى قاضٍ شرعي، ثم رئيس البلدية، وفي كل هذه الأعمال يصطدم بنظام الدولة وباستبداد الحكم وفساد رجال الإدارة، فينازلهم وينازلونه، ويحاربهم ويحاربونه، وينتصر عليهم تارة ويهزمونه تارة أخرى حيث يعتمدون الدسائس والمكائد التي يتهمونه فيها بالخروج على النظام.
وعلى المستوى العام، كانت البلاد تنوء تحت حكم السلطان عبدالحميد (1842 – 1918)، فلا يستطيع أن يعيش فيها حرٌّ صريح أو تاجر نزيه، ولا موظف جريء مستقيم، وهو ما أوغر الصدور ضدّ نظامه فراح الكواكبيّ يكتب المقالات تلو الأخرى واصفًا هذا الجور والعسف الذي يعيشه الناس، ولا يجرؤون على التمرُّد والعصيان، وهو ما كان إيذانًا بالعمل السري؛ فنشطت الجمعيات السرية التي تسعى إلى مقاومة السلطات والتصدي للظلم، وتعمل أيضًا لوضع نظام ديمقراطي لا يكون فيه السلطان الحاكم بأمره.
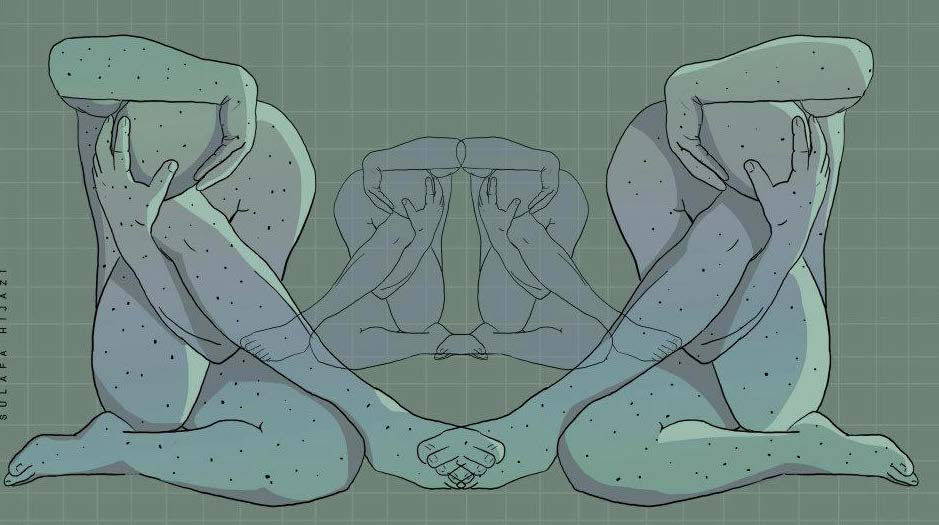
استقبلت الدعوة التي صاغها الكواكبيّ في كتابه استقبالاً رائعًا، حيث تماست وقتها مع الحركات التحريرية التي ماجت في البلاد كردة فعل على السياسات الاستعمارية والأنظمة المستبدّة، بل ترجمت هذه الحفاوة باستقبال باهر للكِتاب في الأوساط الثقافيّة، فتناول الكثير من الكُتّاب العرب هذه الأفكار والرؤى، وسعوا لقراءتها قراءة واعية واستخراج دلالاتها، بل صارت قراءة ما جاء في كتابه من أفكار حقّ واجب بعد تنامي الدكتاتوريات في البلاد العربيّة، وبعد سقوط العديد منها مع هبّات الرّبيع العربي، إيذانا بحلول نسائم الحرية وإزاحة الطواغيت من أنظمة الحكم التي تكلّست على الكراسي والعروش.
لكن مع حدوث رِدّة أو رجعة بعد الصّحوة التي أعقبت ثورات الربيع العربي، كان لا بدّ من إعادة قراءته من جديد؛ أولاً، لفهم الأزمة وأسباب هذه الردّة. هل هي أزمة في أنظمة الحكم؟ أم أزمة في وعي الشعوب في مفارقة تدعو للتعجب والمساءلة في آنٍ معًا: كيف كان وعي الشعوب في مستهل القرن التاسع عشر ناضجًا بما فيه الكفاية، والدليل ما اتخذه من أدوات – أيًّا كانت طبيعتها – لمقاومة/مُجابهة المُستبِدّ سواء أكان مُستبِدًّا أجنبيًّا عن طريق الاحتلال، أو مُستبدًا وطنيًّا (أي الحُكّام الذين ينتسبون إلى هذه الأوطان)؟ في حين صارت الشعوب، مع أنها تنتمي إلى عصر الجماهير الغفيرة – بتعبير جلال أمين – شعوبًا مدجنة وصامتة، اكتفت بأنْ تتجرع هزيمتها وانكسارها في صمت، في مقابل الجموع التي انخرطت تحت عباءة الأنظمة الجديدة، كانت ثمة حشود مستلبة الإرادة، دورها لا يتعدى التصفيق، والتهليل له وهو ما يعود بنا إلى ما وصفهم – من قبل الكواكبي- بأنهم “الجهّال الخبثاء المراؤون”.
أجنحة الأفكار
حازت الأفكار التي طرحها الكواكبيّ في كتابه عن المُستبدّ وأسباب الانحطاط اهتمامًا كبيرًا، فذُكر الكواكبي – بكتاباته – كواحدٍ ممن عملوا على يقظة الأمة، بل سعوا لإخراجها من كبوتها، وتبصير الشعوب بحقوقهم المسلوبة، وهو ما يجعل من هذه الأفكار والأطروحات – مع قدم الدعوة إليها – صالحة بامتياز لزماننا. ومن ثم وجب قبل التحدُّث عن الصدى الذي تركه كتاب الكواكبيّ، التوقف عند الكتاب، عارضًا لأهم النقاط الأساسيّة التي كانت مثار حِجاج دام لعقود طويلة. ثمّ بعد ذلك أتعرض لتقاطعات الكتابات مع هذه الأفكار، وكيف تمّت قراءتها في ظل سياقات ثقافية وأيديولوجيات مختلفة بعد زوال الاستعمار، وقدوم أنظمة وطنية لم تقلّ استبدادًا عن الحِقبة الإمبرياليّة/الاستعماريّة، مع فارق أن هذه الحقب نشطت فيها التيارات الفكرية والحركات السّرية التي أخذت تقاوم تارة بالقلم، وتارة أخرى بالبندقية، في حين في ظل هذه الأنظمة الوطنيّة أُخمدت المُعارضة واتّهم أصحابها بالخيانة والعمالة للغرب.
الكتاب جاء في عشرة فصول وافتتاحية ومقدمة. فصول الكتاب جاءت كالتالي “ما هو الاستبداد، الاستبداد والدين، الاستبداد والعلم، الاستبداد والمجد، الاستبداد والمال، والاستبداد والإنسان، الاستبداد والأخلاق، الاستبداد والتربيّة، الاستبداد والترقي، وأخيرًا العلاج: الاستبداد والتخلّص منه”.
تدور فصول الكتاب – في مجملها – في إطار أسئلة شائكة طرحها المُفكّر النهضوي/الكواكبيّ ذي الخلفية الدينيّة، وهو ما ينفى أيّ راديكاليّة (رجعيّة) لحاملي مثل هذه الأيديولوجيا، فمعظم الفكر التنويري خرج من عباءة هؤلاء الرجال الذين انتموا للمؤسسات الدينيّة على اختلاف طبيعتها (رسمية أو غير رسميّة). فينتسب عبدالرحمن الكواكبي إلى (الكواكبيّة في حلب)، ورفاعة رافع الطهطاوي (1801 – 1873) (مؤسسة الأزهر الشريف)، والإمام محمد عبده (1849 – 1905) (درس في الجامع الأحمدي في طنطا، ثمّ التحق بالأزهر الشريف) وجمال الدين الأفغاني (1838 – 1897) (درس في مدينتي النجف وكربلاء الشيعيتيْن) ورشيد رضا (1865 – 1935) (درس في الكتّاب في أوّل عهده، ثمّ استفاد من التربيّة الحديثة بتأثّر محمد عبده، وخير الدين البستاني التونسيّ (1810 – 1899) (تربيّة دينيّة). وهو في ذلك يستلهم تجارب أمم مختلفة عن الاستبداد وأصوله وعلاقته بالدين والعلم والأخلاق، وتأثيره على حياة البشر.
أسئلة من قبيل: ما علاقة الاستبداد بحالة الانحطاط التي تعيشها الأمة؟ وما مصدر الاستبداد؟ مَن المتسبِّب في الاستبداد؟ هل الدين براء من فكرة الاستبداد؟ كيف سعى التصوُّف إلى ترسيخ فكرة المُستَبِدّ؟ والربط بين الإله والمستبد؟ هل الاستبداد جديد عنا أم أننا أمّة عبيد؟ وغيرها أسئلة كثيرة على هذا المنوال تعمل على تفكيك مفهوم الاستبداد، وكيف ترسخت أصوله في ثقافتنا العربيّة؟ وفي نفس الوقت يقدّم الحلول لهذا الداء.
فاتحة الكتاب تحدّث فيها عن ارتحاله إلى مصر، وقصة تأليف الكتاب، وسبب الداء الذي أصاب الأمة. ثم يتطرق بعد ذلك لمفهوم الاستبداد، فيراه “هو استبداد الحكومات خاصة” ومرجع هذا عنده لأن “أضرارها جعلت الناس أشقى ذوي الحياة” ثم يعرّج لتعريف الاستبداد لغويًّا، وعند السياسيين، وهو غاية الكتاب، ويوجز في شرح أشكال الحكومات المستبدة، وتستوى عنده صفة الاستبداد فتشمل “حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولّى الحكم بالغلبة، أو الوراثة، وأيضًا الحاكم الفرد المقيّد المُنتخب متى كان غير مسؤول”، كما تشمل “حكومة الجمع ولو كان منتخبًا”، وبالمثل يدخل تحت إهابها “الحكومة الدستورية المفرّقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن قوة المراقبة”. أما أشدّ مراتب الاستبداد التي يُتعوّذ بها من الشيطان فهي “حكومة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينيّة”.
ويرى أن أيّ حكومة من أي نوع (وراثيّة أو مُنتخبة) لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تُسامَح فيه. ومرجع استبداد الحكومات عنده هو غفلة الأمّة (أو إغفالها) من محاسبتها، ومن ثمّ تعمّد هذه الحكومات إلى وسيلتيْن هما: جهالة الأمّة والجنود المنظمة، وإن تخلّصتِ الأمم المتمدّنة من الجهالة، إلّا أنّها ابْتليت بشدّة الجنديّة الجبريّة العموميّة، وهذه الشّدّة كان لها بالغ الأثر في جعلها أشقى حياة من الأمم الجاهلة؛ لِما للجندية من تأثير بالسّلب في إفساد أخلاق الأمّة، حيث تُعلِّمها الشَّراسة والطاعة العمياء والاتّكال، وتُميت النّشاط وفكرة الاستقلال، وتكلِّف الأمّة الإنفاق الذي لا يُطاق.
ويُقدّم مُلخصًا موجزًا بآراء بعض الحكماء في الاستبداد التي تصوّر شقاء الإنسان، في إشارة إلى تبصيرهم بعدوّهم الحقيقي، وبعبارته “هذا عدوك، فانظر ماذا تصنع”. وفي نظره أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل.
وبالنسبة إلى العلاقة بين الاستبداد والدين يميل إلى الرأي القائل – وهو بإجماع العلماء – إلى أن “الاستبداد السياسي متولّد من الاستبداد الديني”، فالتعاليم الدينيّة تستلبُ العقول وتجعلها ترتكن للخبل والخمول، وهو الأمر الذي يجيده السياسيون ببراعة، فيسترهبون الناس بالتعالي الشخصي، ويسترهبونهم بالقهر والقوة وسلب الأموال. والتشاكّل بين القوتيْن (الدينيّة والسياسيّة) ينجر بعوام البشر – وهم السواد الأعظم – إلى غياب الفرق بين الإله المعبود بحقٍّ، وبين المُستبِدّ المُطاع بالقهر، وقد سهّل امّحاء الفرق في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين بالألوهية على مراتب مختلفة.
وينتهي الأمر بهؤلاء العلماء إلى القول بأن بين الاستبداديْن (السياسيّ والدينيّ) أواصر التقاء لا تنفك، فما إن وُجد أحدهما وجد الآخر بالتبعيّة. والعكس صحيح، فمتى زال أحدهما زال قرينه، ومن ثمّ فيرون أن إصلاح الدين هو أسهل وأقرب طريق للإصلاح السياسيّ، ومن واقع مقارنته للأديان ووضعية الاستبداد ينتهي إلى أن الإسلام بريء من تأييد الاستبداد، معتمدًا على مئات الآيات البينات، فالإسلام مؤسس على أصول الحريّة مجرّدة من كلِّ سيطرةٍ وتحكُّم. فالإسلام لا يعرف سلطة دينيّة ولا اعترافًا ولا بيع غفران، ولا منزلة خاصّة لرجال الدين. وفي ضوء هذا لا ينسى أن يُحمِّلَ البشر تبديل آياته وتطويعها وفقًا لرغباتهم الاستبدادية، فدخل عليه الفساد ما دخل على كل دين. ولذا يحمل على الصّوفيّة فكرة الخضوع للولي، وسوق الناس كالأنعام في جعل الأمير وليًّا من أولياء الله، ولا يأتي أمرًا إلّا بإلهام من الله، وإنه يتصرف في الأمور ظاهريًّا، ويتصرف قطب الغوث باطنيًّا.
وبالنسبة إلى علاقة الاستبداد بالعلم، يشير إلى أن المُستبِدَّ يُدرك جيدًا أنّه لا استعباد ولا اعتساف إلا ما دامت الرعيّة حمقاء تتخبط وترفل في ظلام وجهل وتيهٍ. وأنّ ما يخشاه المستبد ليس علوم اللغة أو حتى علوم الدين، وإنما علوم الحياة؛ إذْ ترتعد فرائصه من الحكمة النظريّة والفلسفة العقليّة، وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع والسياسة المدنيّة والخطابة والتاريخ المفصّل وغيرها من علوم تكبر النفوس وتوسّع العقول، وتعرف الناس ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، كما يبغض المُستبدّ العلم ونتائجه؛ لأنّ للعلم سلطانًا أقوى من كل سلطان.
وينتهي إلى أن العلاقة بين العلم والاستبداد علاقة حرب ضروس، وأن العوام هم قوة المُستبِد وقوته ومع ذلك فهم يذبحون أنفسهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة. وعن العلاقة بين الاستبداد والمجد، يرى أن المجد – كما يقول الباحثون – مفضلٌ على الحياة عند الملوك، ويفرِّقُ بين المجد والتمجّد؛ والتمجد – عنده – خاصّ بالإدارات المُستبِدّة؛ وذلك لأن الحكومات الحرّة – وهي نقيضة للحكومات المستبدة – التي تمثّل عواطف الأمّة تأبى كل الإباء إخلال التساوي بين الأفراد إلا لفضل حقيقي.
فالمتمجدون يريدون أن يخدعوا العامة، وهم بهذا يكونون أعداء للعدل أنصارًا للجور، لا دين ولا وجدان، ولا رحمة، وبذلك يتخذ المستبد المتمجدين سماسرة لتغرير الأمة باسم خدمة الدين أو حب الوطن أو توسيع المملكة أو تحصيل منافع عامة، أو مسؤولية الدولة أو الدفاع عن الاستقلال، وما هذا إلا أوهام وتخييل، الغرض منها تهييج الأمة وتضليلها، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة المستبدة تكون مُستبدّة في كلّ فروعها من المُستبِدّ الأعظم إلى أقل فردٍ في منظومتها سواء أكان فراشًا أو كَنّاس الشوارع. والمُحصلة أن المستبِدَّ فرد عاجز لا حول له ولا قوة إلا بالمتمجّدين.
وعن علاقة الاستبداد بالمال يقول إن المستبد يرى أن شرفه هو المال، فالقوة مال وكل ما ينتفع به في الحياة مال، وبما أن الإنسان ظالم لنفسه، حريص على اختطاف ما في يد أخيه. وطبيعة الاستبداد تجعل المال في أيدى الناس عُرضة لسلب المستبد وأعوانه وعماله غصبًا أو بحجة باطلة، وأيضًا عُرضة لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتعين في ظل أمان الإدارية الاستبدادية وأن حفظ المال في عهد الإدارة المستبدة أصعب من كسبه، لأن ظهور أثره على صاحبه مجلبة لأنواع البلاء عليه، لذا يضطر الناس أيام الاستبداد إلى إخفاء أثر النعمة.
وعن علاقة الاستبداد بالأخلاق، يرى المفكر النهضوي أن “الاستبداد يُضعف الأخلاق ويفسدها أو يمحوها، ويجعل الإنسان حاقدًا، ويفقده حُب وطنه ويكرهه عائلته، فيصبح به الناس غير حريصين على أيّ شيء. يسلب الراحة الفكرية، ويمرض العقول ويخلّ بالشعور، ويضعف الإدراك ويقلب الموازين، فمطالب الحق فاجر، وتارك الحق مطيع، والمُشتكي مُفسد النية، والباحث مُلحد، والخامل صالح، والغيرة عداوة، والشهامة عتوا، والحمية حماقة، والرحمة مرض، والنفاق سياسة، والتحايل كياسة، والدناءة لُطف، والنذالة دمث”.
كما أنه يسلب الرّاحة الفكرية فيضيء الأجسام فوق ضناها بالشقاء. فأسير الاستبداد لا نظام في حياته، بل إن للاستبداد القدرةَ على أن يفقد الأخلاق دورها في النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ، وأسير الاستبداد يرث شر الخصال ويتربى على شرها، كما أن فساد الأخلاق يُخرج الأمم عن أن تكون قابلة للخطاب. وفساد المستبد لا يعود عليه – وحده – بالضرر وإنّما فساده يستشري ويعم وبذلك تمسي الأمة يبكيها المحب، ويشمت بها العدو.
والاستبداد يفقد الثبات في الخلق، فقد يكون الرجل شجاعًا كريمًا، فيصبح بعوامل الاستبداد جبانًا بخيلاً، ولا أخلاق ما لم تكن ثابتة مطّردة، كما أن الاستبداد يفقد الناس الثقة بعضهم ببعض، ويحلّ الخوف محل الثقة، فيقلّ التعاون بين الأفراد والتعاون حياة الأمم كما يقول.
وعن علاقة الاستبداد بالتربية يقول إن الحكومات العادلة تعني بتربية الأمة من وقت تكوّن الجنين، بل قبله، بسن قوانين للزّواج الصّالح، ثمّ بالعناية بالقابلات والأطباء، ثمّ بفتح بيوت اللقطاء، وإنشاء المكاتب والمدارس، ثم تسهيل الاجتماعات والإشراف على المسارح، ثم تشجيع النوادي وإنشاء المكتبات. وفي الحكومة العادلة يعيش الإنسان حرًّا نشيطًا، بينما يعيش الإنسان في الحكومة المستبدة خاملاً ضائع القصد حائرًا. فالتربية الصحيحة لا يكون الاستبداد بيئة صالحة لتحقُّقها. ويمنع الاستبداد الترقي؛ الترقي في الجسم صحّة وتلذذًا، ثمّ الترقي في الاجتماع بالعائلة والعشيرة، ثم الترقي في القوة بالعلم والمال، ثم الترقي في الملك بالخصال والمفاخر، وهناك نوع من الترقي الروحي، وهو الاعتقاد بأن وراء هذه الحياة حياة أخرى يترقّى إليها على سُلم الرحمة والإحسان.
وينتهي إلى وسائل التخلّص من الاستبداد، ويرى أن الاستبداد لا يقاوم بالقوة، وإنما باللين وبالتدريج، وبالتعليم والتحميس، وأيضًا المقاومة بالحكم في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة. ويؤكد على أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ما يحلّ محله، ومعرفة الغاية معرفة دقيقة واضحة.
هذا عن الكتاب، ولما كان للأفكار التي طرحها الكتاب من تأثير كبير فيمن جاء بعده، فقد حدث تلقي مهم وواسع له بالنقاش والجدال وعرض الأفكار لكل ما جاء في كتاب الكواكبي، ومن ثم سنتوقف عند أثر كتاب الكواكبي في المدونة الثقافيّة العربيّة.
الكواكبيّ والتلقي

من الكتابات الرائدة التي توقفت عند كتاب أو أفكار الكوكبي، ما ذكره أحمد أمين (1986 – 1954) في كتابه “من زعماء الإصلاح في العصر الحديث” فقد قرن الكواكبي بتسعة من رموز الإصلاح في عالمنا وهم “محمد بن عبدالوهاب، مدحت باشا، جمال الدين الأفغاني، أحمد خان، أمير علي، خيرالدين باشا التونسي، على باشا مبارك، عبدالله النديم، وأخيرًا الشيخ محمد عبده”.
الكتاب أشبه بتراجم لهؤلاء المفكّرين الإصلاحيين، الرابط بينهم على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم، هو تبنّيهم للفكر الإصلاحي، ودعوتهم لأبناء جلدتهم لليقظة والتمسُّك بالحرية والخروج على الاستبداد. في الجزء الذي خصصه للكواكبي، يتحدث – أولاً- عن نشأته في حلب، وثقافته الدينيّة التي نهلت من المدرسة الكواكبية، ذاكرًا أثر هذه التنشئة/التربية في أن جعلته منه “رجلاً يستعصي على ناقد الأخلاق نقده”، معرجًا على الوظائف التي كُلِّف بها، وهو ما رَفَعَ من قدره وكان وبالاً عليه حيث أوغرت صدور منافسيه، فدسُّوا له عند أولي الأمر.
ثمّ يتطرق إلى أثر رحلاته التي كانت أشبه بمشاهدات لأحوال الناس وما يعانونه من قهر وظلم، فألّف المقالات التي تُحرِّض الناس على الثورة وعدم تحمُّل هذا الظلم. وقد استفاد الكواكبي مما نَقَل عن الغرب. ثمّ يتوقف عند كتابيْه “طبائع الاستبداد” و”أم القرى”. وبالنسبة على الجزء المُخصّص للكتاب الأول “طبائع الاستبداد”، يشير إلى أنه اقتبس فيه الكثير من أقوال “ألفياري” الكاتب الإيطالي. ويستعرض لأهم ما دار حوله الكتاب، فيقول إن كتاب طبائع الاستبداد يدور حول تعريف الاستبداد الذي هو “صفة للحكومة مطلقة العنان، التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء”. وفي بحثه عن علاقة الاستبداد بالدين، يقول “لقد بحث بحثًا مستفيضًا في علاقة الاستبداد بالدين، ونقل عن الفرنج رأيهم، في أن الاستبداد في السياسة متولد من الاستبداد في الدين أو مساير له، فكثير من الأديان تبث في نفوس الناس الخشية من قوة عظيمة لا تُدرك كنهها العقول وتهدّدهم بالعذاب بعد الممات تهديدًا ترتعد منه الفرائص”.
ومع إشادته بنفي علاقة الإسلام بالاستبداد حيث الإسلام مؤسس على أصول ديمقراطية، يأخذ على الكواكبي ما يوحيه تصوير الله بالقوة والعظمة والسيطرة من خضوع النفوس للمستبد. وعنده أن الإسلام بجعله “لا إله إلا الله” محور الدين، تتكرّر في كل أذان وفي كل مناسبة، كان كفيلاً أن يُذكِّر النفوس دائمًا بأن العزة لله وحده، وأن النفوس لا يصح أن تذل لأحد سواه، وأن هذه الكلمة تُوحي بالضعف أمام الله، والقوة أمام من سواه، ولكن بتوالي القرون، ودخول الدخيل من العقائد أصبحت “لا إله إلا الله” عند المسلمين كلمة جوفاء، لا روح فيها، تبعث الضعف ولا تبعث القوة، وتبيح أن يشرك مع الله الحاكم المستبد والرئيس المستبد، بل المال والجاه والمنصب.
يشير أحمد أمين إلى أن الكواكبي – في كل هذا – كان يقرأ نتائج القرائح التي كتبت في الاستبداد، وينظر إلى الدولة العثمانية في عهده، ويستملي منها آراءه وأحكامه.
في حقيقة الأمر أن أحمد أمين قام بعرض دقيق لكتاب طبائع الاستبداد، وفي عرضه نستلمح موافقة تامة على كل ما جاء فيه من آراء بنّاءة بخصوص علاقة الاستبداد بالدين والأخلاق والعلم. والاستبداد بالتربية وغيرها. ويخلص إلى أن عبدالرحمن الكواكبي في هذا الكتاب “قويّ مخلص، مملوء غَيْرَةً وأسفًا، وتلهفًا، على رفع نير الاستبداد عن الشرق، وهو إن استمدّ الفكرة من العرب، فهو يبسطها ويعدّلها ويُعنى بتطبيقها”. أما ما يؤخذ عليه، فقد حصر نفسه في دائرة النظريات، وكان الكتاب أوقع في النفس لو ملأه بالشواهد وما رأى وسمع من أحداث، وكان يجب عليه أن يقرن النظريات بالشواهد. ويبرّر ذلك بأنه أخفى اسمه ولم يضعه على الكتاب.
العقاد والبرنامج
لم يختلف عباس محمود العقاد (1989 – 1964) في كتابه “عبدالرحمن الكواكبي: الرحالة ك” عمّا فعله أحمد أمين في فصله، فجاء الكتاب أشبه بسيرة غيرية عن الكواكبي، وإن كان العقاد وسّع من مجال دراسته، فجاء كتابه في قسميْن (كتابان حسب تبويبه) الكتاب الأوّل قصره على دراسة شخصيّة الكواكبي، بادئًا ببيئته (حلب الشهباء)، وعصره الذي نشأ فيه (في منتصف القرن التاسع عشر)، ويصفه بأنه كان حقبة امتداد لعصر الكشوف العلميّة والنزعة الفكريّة إلى التمرد على القديم، وأيضًا كانت حِقبة عامرة بأسباب القلق والاندفاع إلى المجهول، كما تمخضت عن أخطر مذاهب الفكر والأخلاق، حيث ظهرت نظرية داروين، والمخترعات الحديثة. وبعدها ينتقل إلى أسرة الكواكبي وثقافته، وأسلوبه والجامعة الإسلامية والدولة العثمانية، ويتطرّق إلى مؤلفاته بصفة عامة، ثم يقوم بالتعريف بكتابيه “أمّ القرى” و”طبائع الاستبداد” وأخيرًا يتحدث عن رحلته إلى مصر.
في حقيقة الأمر، شغل كتاب طبائع الاستبداد حيزًا لا بأس به من كتاب العقاد، فأفرد له في الكتاب الأول جزءًا تناول فيه الكتاب وعرض لأهم القضايا التي طرحها الكواكبي، وقد وصفه بأنه “آية الكواكبي”، ويعترف بأن مقالات الكتاب جميعها “تنبئ عن دراسة وافية للعوارض التي شرحها أو أجمل القول فيها، كما تدل على تأمل طويل في موضوعاتها يستفاد من النظر والتجربة، كما يستفاد من الاطلاع والمراجعة.
قبل أن يتوقف عند كتاب طبائع الاستبداد، ويعرض لقضاياه، نراه يحيط الكتاب بدراسة تستوضح بعض النقاط المحيطة بالكتاب، عن وقت تأليفه، فنفى أن يكون كتبه في مصر كما زعم أحمد أمين، بل أكد بناء على ما نشره حفيده الدكتور عبدالرحمن الكواكبي، وأيضًا ما ذكره الأستاذ سامي الكيالي صاحب مجلة الحديث، وقد نشره في مجلة الكتاب (1947) وكلاهما يؤكد أنه ألّف كتابيه قبل سفره إلى مصر. النقطة الثانية التي أشار إليها العقاد أن الكواكبي كان بإمكانه أن ينشر مقالاته في صحيفة من صحف الاحتلال التي كانت تجاهر بمحاربة السيادة العثمانية خدمة للسيادة الإسلاميّة، لكنه لم يفعل، فلو فعل لكان بهذا خرج عن صفته الإصلاحية الإسلاميّة، وعرّض نفسه لشبهات الدعاية الأجنبية.
أما بالنسبة إلى اختياره حرف الكاف توقيعًا بديلاً عن اسمه الحقيقي، فيفسّره العقاد، لأنّه “لم يكن قد وَطَن العزم على ذلك عند وصوله إلى القاهرة، وأنّه أراد أنْ يختبر الحالة فيما حوله قبل أن يقطع بالعزم الأخير على المسلك الذي لا رجعة فيه” كما يسعى إلى المقارنة بين الطبعة الأولى وبين طبعة الدكتور أسعد الكواكبي، مؤكدًا الإضافات التي وضعها الكواكبي على المقالات، ويضرب مثالا بالتغيّرات التي حدثت لمقالة الاستبداد والتربية، وينتهي إلى حكم قاطع بأن مقالات طبائع الاستبداد لم تخلُ مقالة من مثل هذا التنقيح أو مثل هذه الزيادة، والفارق بين النسختيْن كالفارق بين المسودّة المُعدّة للتذكير والتحضير والنّسخة التي فرغ منها عمل التأليف.
كما يدافع عن الكواكبي خاصة ما أثير من اقتباسات ضمّنها كتابه، فيقول إن المطالعات التي اضطلع عليها قد اضطلع عليها غيره المئات كما اضطلع عليها الكواكبي، ولم يستخرجوا منها الكتاب الذي انفرد به، ولم يسبقه أحد إليه، وإنْ كان يُرجِّح أنَّ الاقتباس يَصْدُق على مؤلف واحد لم يذكره الكواكبي، وهو يقصد الكاتب الإيطالي فتتوريو ألفياري، وهو فيه متأثِّرٌ بروسو ومونتسيكو، ومكيافيلي.
ويشير إلى أن التشابه بين الكتابيْن في “رؤوس الموضوعات باد من النظرة العابرة” وهو ما جعل أحمد أمين يتساءل عن كيف وصلت الرسالة الإيطاليّة إلى علمه؟ فيجيب العقاد بأنّه من المرجّح أن الكواكبي اطّلع على نسخة من الكتاب باللغة التركيّة من عمل كاتب من أحرار التُرك المهاجرين إلى سويسرا يسمى عبدالله أمين، وقد دلّل على عدم الاقتباس بما ذكره السيد رشيد رضا عندما قال “إن مباحث طبائع الاستبداد لا يكتبها قلم أوروبي ولا يقتبسها شرقي من المراجع الأوروبية”، بل وقد بالغ في قوله إن “ألفياري نفسه لا يستطيع أن يصوّر عناصر الاستبداد كما صوّرها الكواكبي من وحي خياله وتجاربه وتأمّلاته في البلاد العثمانيّة وفي بلده وإقليمه بصفة خاصة” .
في الكتاب الثاني يتحدّث عن بعض المسائل التي تطرّق إليها الكواكبي في “طبائع الاستبداد” مثل برنامج الإصلاح والدين والدولة والنظام السياسي والنظام الاقتصادي والتربية القومية والتربية المدرسية والأخلاق ووسيلة التنفيذ وخاتمة المطاف.
لا يعيد العقاد ما طرحه الكواكبيّ على نحو ما فعل أحمد أمين، وإنما يعمل على تقييم هذه الأفكار واختبار جدواها في بيئتنا، كما يتطرّق إلى المنهج؛ حيث يشير إلى أنه اختار منهج العلم التجريبي أو الفلسفة العلميّة، فنظر إلى جميع العلل وقدّر جميع الوجوه، واعتمد البحث في تلك العلل من ناحية النفي ومن ناحية الإثبات، وبالنسبة إلى أسلوبه في كتاب الطبائع يقول إنه يخضع لأسلوب التقسيم واستيفاء الكلام على كل موضوع من الموضوعات، أخذًا وردًا، وشرحًا واستدراكًا، ومع أنه يستنكف أن يُسمي دعوة الكواكبي فلسفة اجتماعية، أو مذهبًا فلسفيًّا ينتظم بين مذاهب الحكماء المصلحين، وإن كان هذا جائزًا، إلا أنها تتجاوز هذا وذاك إلى البرنامج، فهو يقدم برنامجًا يتبعه عمل، وقرارًا تنتهي إليه مذاهب الخلاف. وهذا البرنامج يأتي استجابة للبيئة التي نشأ فيها، وما امتلكه من عقل واستعداد فطري، حيث كانت قديمًا مُلتقى لحركة النشاط والدأب من أنحاء العالم، كما تربّي في أسرة تعرف الصناعة كما تعرف تكاليف الرِّئاسة الدينيّة والدنيويّة.
ويرى أن الإصلاح الدينيّ يتلخص عند الكواكبيّ في تحرير الإسلام من الجمود والخرافة، كما يذكر صفة العالم الذي يؤهّله علمه للاجتهاد بالرأي والإقناع بالدليل. وينتهي إلى أن الكواكبيّ يهتمُّ أشد الاهتمام بإغلاق الباب على طوائف المتوسطين في المسائل الدينيّة. كما أنّ المُتشدّدين من رجال الدين مسؤولون كالحكّام المستبدين في شيوع التصوُّف الفاسد بين العامة وأشباه العامة من المسلمين المتقدمين والمتأخرين، وبذلك ينأى بالكواكبي بأن يكون مُصلحًا دينيًّا بالمفهوم الضيّق، بل كانت عنايته بالشعائر والظواهر المحسوسة سبيلاً إلى تصحيح جوهر الدين في أصوله التي انطوت عليها الطبائع الإنسانيّة. ويربط بين أيّ إصلاح دينيّ وصحة الإيمان، كما أن الإصلاح الديني عنده غير منفصل عن إصلاح المجتمع كله في شؤونه الدنيوية.
وعن الاستبداد كما جاء في مقدمة “طبائع الاستبداد” يقول العقاد “إنّ الكواكبي يُقرّ بأنّ الاستبداد لا يمتنع بامتناع حكومة الفرد، ولا يتحقّق الحكم الصالح باشتراك الكثرة فيه أو بتأييد الكثرة للحاكمين المتعددين، كما أنّه لا يمتنع مع غفلة الأمة وقدرة الحكام على تضليلها والتمويه عليها. وعنده أنّ الطبقة العُليا ليس كما راجَ عنها من أنهّم حملة الألقاب والرُّتب ولا أصحاب الوجاهة المنقولة من الأسلاف إلى الأعقاب، وإنما الطبقة العُليا – في تعبيره – هي الطبقة التي استعدت بكفايتها ودرايتها لقيادة الأمّة والاضطلاع بالخدمة العموميّة والسَّبْق إلى تكاليف العمل والمعرفة، وبذلك يكون قوام النظام الصّالح في أن تتساوى الطبقات في الحقوق القانونية وأنْ تتقارب في الثروات والدرجات المعيشيّة. فهو في الأصل يَعتبر أنّ التفاوت في الثروة من أقوى دعائم الاستبداد”.
الغالب على دراسة العقاد أنه يربط فيها بين كتابي الكواكبي “أم القرى” و”طبائع الاستبداد” وكأنه يريد أن يقول إن الدعوة إلى الإصلاح واحدة، فإذا كان كتاب “أم القرى” دعا فيه الكواكبيّ إلى الإصلاح الاجتماعيّ، فإنه في “طبائع الاستبداد” دعا إلى الإصلاح السياسيّ. كما يشيد بسعة إطلاع الكواكبيّ عبر الاستشهادات التي يضربها ليوضح فكرته. فالدراسة أشبه بقراءة مقارنة بين ما طرحه في “أم القرى” وما جاء في “طبائع الاستبداد”، وبهذه المقارنة يؤكد بل ويشيد – دون تصريح مباشر – بتكامل البرنامج – وفقًا لتسميته – الذي دعا إليه الكواكبي للإصلاح؛ إذ هدف الكواكبيّ الدعوة إلى يقظة الشعوب، وهذا نابع لأنّه كان عربيًّا بتفكيره وشعوره في ثقته الكبرى بقوة الكلمة أو قوة الدعوة المنتظمة، متُخِذًا منها وسيلته الأقوى في التعبير عن فكرته ودعوته الإصلاحيّة التي كان غايتها استقلال العرب بالحكم الذّاتي أو بالانفصال من الدولة العثمانيّة.
ويختتم العقاد كتابه بتقييم دعوة الإصلاح عنده بقوله، إنها كانت في موضعها، وأصاب من حيث أخطأ الدعاة في زمنه بين مخلصين منهم ومدعين. كما أن دعوة قضية الجامعة العربية لم تكن تناهض الدعوة إلى الجامعة الإسلامية. بل إن الجامعة الإسلامية – أصلاً – لم تكن أمامه هدفًا يرميه ويُعاديه.
وهو يراه أنه كان مقتدرًا بعقله على التمييز بين الأشكال والعناوين وبين الحقائق والأعمال وكان خبيرًا بالتفرقة بين عوامل البقاء والنهضة في الأمم وبين مراسم السمت والزينة في الدول والحكومات، كما أنه كان يدرك موقع الخطر وموقع السلامة. وهذه هي فضيلة العقل الثابت في هذه العبقرية.
الدّهان والبحث عن المصادر
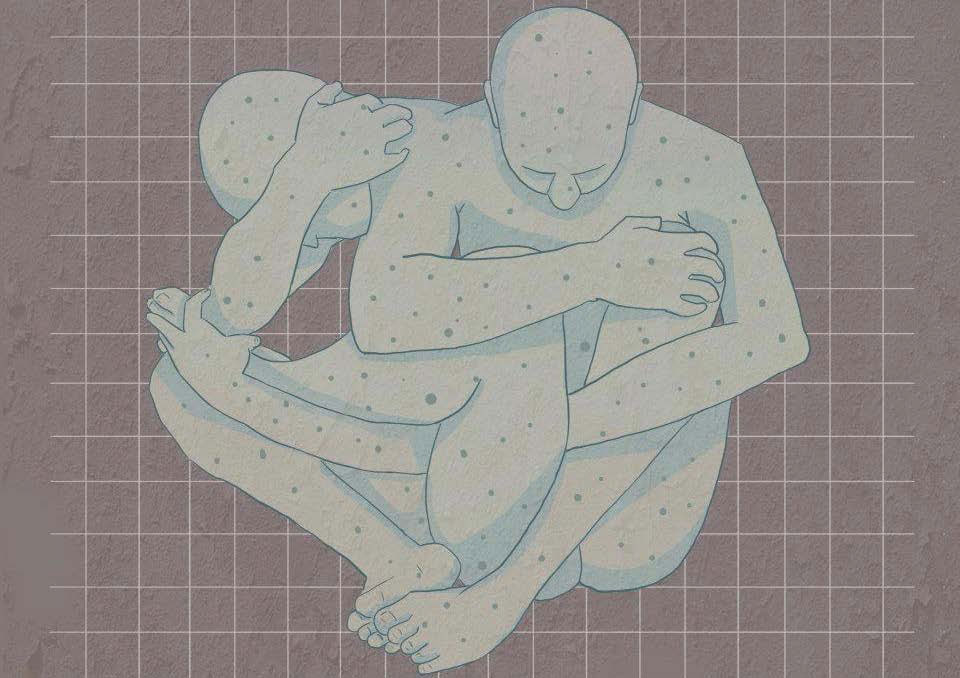
يُقدّم سامي الدّهان (1910 – 1971) في كتابه “عبدالرحمن الكواكبيّ” (1958) الصادر عن سلسلة نوابغ الفكر (دار المعارف – مصر) حالة قريبة مما قدمها أحمد أمين في “زعماء الإصلاح”، فالكتاب أشبه بترجمة عن الكواكبي، وقراءة لمنجزه الفكري الإصلاحيّ، ومن ثم نراه يعمد إلى ما اِئْتَلَفَتْ عليه كُتب الطبقات في تناول الشخصيات، فيتحدث عن عصره، وبيئته ونسبه، وصورته الجسمانية والنفسية، ثم يعرض لجوانب من عبدالرحمن الكواكبي، ويقسِّمها إلى أقسام الأول منها تناول كتاباته: طبائع الاستبداد، وأم القرى، وصحائف قريش، وعظمة الله، وأشعاره، والقسم الثاني أشبه بإحصاء لجوانب شخصية الكواكبي، في كافة صورها؛ السياسية والاجتماعية والوطنية، والأدبية (الأديب والعالم)، وبعد أن يفرغ من استجلاء هذه الجوانب في شخصيته، يقدم فصلاً كاملاً (الفصل الرابع) ليشمل منتخبات من آثار الكواكبي في كل المجالات التي ذكرها سابقًا.
على الرغم من إسهاب الدّهان في ذكر عصر الكواكبيّ وتأثير بيئته عليه، إلا أنه يتخذ من هذه المؤثرات مؤشرات ليقظة الوعي السياسي وتنامي الشعور الوطني إزاء أمته. وهو ما يتقاطع بشكل كليّ مع ما كتبه العقاد عن الكواكبي، في دلالة واضحة لتأثير المنهج الاجتماعي السائد في الدراسات الأدبية في ذلك الوقت.
ويخص الدّهان كتاب “طبائع الاستبداد” بمبحث مهم يتناول فيه الكتاب، وصورته الأولى قبل أن يتبلور – بصورته النهائية – في هذا الكتاب، وهو كلام تكرّر- كثيرًا – عند أحمد أمين والعقاد، وإن كان العقاد بحث في مصادر فكر الكواكبي التي أثرت في كتاباته، وهو ما تطرقنا إليه سابقًا. الإشارة الوحيدة عند الدّهان وهو يستقرئ هذه المصادر، أنه نفى أن يكون الكتاب “اقتباسًا من الإيطالية كله، وليس جمعًا من مصادر عربية وحدها” وهو في هذا يأخذ برأي رشيد رضا الذي ذكره في المنار بقوله “إن ينبوع علم هذا الرجل صدره، وإنه كان يزداد في كل يوم فيضانًا وتفجيرًا”. وإنما هو متعدد المصادر والروافد. ويخلص إلى أن الكتاب في صورته – ومع هذه الاقتباسات – “هو مجموعة مقالات وفصول أخذت من كل مصدر بنصيب من القرآن، والحديث وأمثال العرب والكتب التاريخية العربية والمترجمة، أضاف إلى مادتها ما خبر من حال الشعوب الإسلامية، فأعمل فيها الفكر وأشرك فيها العقل والعاطفة فجاءت في أساليب مختلفة ترتفع طورًا إلى ذروة البيان، وتنخفض طورًا إلى درجة المقالة العادية السطحية” (سامي الدّهان، ص 45).
يقوم الدّهان بتجريد فصول الكتاب باختصار شديد، متحدثًا عن كل فصل على حدة، موجزًا لأفكاره الأساسية، وإن كانت لم تأتِ بتعليق أو تعقيب عكس الكتابات اللاحقة التي فندت ما أثاره الكواكبي من آراء. لا يفوّت الدّهان الفرصة فيذكر بعض المآخذ على الكتاب، كأن يصفه بأنه “خيالي بعيد عن الواقع” وكأنه يتحدث عن أحلام وأمان لا يمكن أن تتحقّق لعصره وزمانه، ومرة ثانية إلى أنّه نظري وإن كان في هذه يتوارى خلف آراء آخرين لم يُسمهم فيقول “ويؤخذ عليه أنه نظري فحسب لم يدعم كتابه بمشاهداته وهي كثيرة، فلم يبسط حال بلاده الشام، ولم يضرب الأمثلة صريحة عن العثمانيين وتسلّطهم على العالم العربي ولم يتطرق إلى الأشخاص”. وقد برّر هذا “لغاية واحدة هي سيرورة الأفكار في الناس من غير أن يصطدم بالمخدوعين والمحبين للدولة العليّة العثمانية آنذاك” (سامي الدّهان: ص 52). وهذا الرأي الذي ساقه سامي الدّهان في ختام مبحثه عن كتاب “طبائع الاستبداد” يأتي عكس ما ذكره العقاد، واعتباره الكتاب “آية الكواكبي”. ومع هذه الملاحظة – التي أكّد أكثر من شخص نقيضها – يقول إن الكتاب “على جرأة نادرة حين يُطالب بالحرية وقلع الاستعباد، وخلق مدينة فاضلة وجمهورية مثالية كجمهورية أفلاطون ومدينة الفارابي” بل يقرنه – أو يبز – بما كتبه الوزير المغربي في الشرق، وما كتبه مكيافيلي في الغرب. أو أنه لم يؤلف مثله بعد ابن خلدون في معالجة مشاكل الشرق في ضوء ما يصنع الغرب، وما يكتبه مفكروه.
الثائر العربي
وقد تعاملت بعض الكتابات مع الكواكبيّ باعتباره ثائرًا، ودعوته صرخة يقظة من الغفلة، ومن ثم تمّ استغلال دعوته لشحذ هِمّة الجنود بإشعال فتيل الثورة داخلهم، على نحو ما فعل العقيد أركان حرب إبراهيم رفعت، في كُتيّب “الثائر العربي: عبدالرحمن الكواكبي” الكتيب (45 صفحة من القطع الصغير) جاء في سلسلة “اخترنا للجندي” نظرًا لأن الكواكبي “في طليعة الثوّار العرب على الظلم والاستعمار، ومن المنادين بالاشتراكيّة والمساواة الاجتماعيّة ” لذا فهو “خليق بأن نقتفي آثاره.. ونسترد تاريخه، ونعيش مع ذكرياته”. فيتحدث عن نشأته في بلدة حلب السورية، والظروف التي أحاطت بنشأته، وهو في هذا الجانب يتكئ على كتاب العقاد اتكاءً واضحًا لا مراء فيه، وينتقل من عنصر إلى عنصر دون إسهاب وإنما في إيجاز شديد ليتحدث عن سبيل الكواكبي في الحياة، وكفاح الكواكبي، وفي هذا الجزء يتوقف عند كتابه “طبائع الاستبداد” ويقول إن “الكتاب الذي بسط فيه بالرأي القاطع والحجّة الواضحة، وسائل مقاومة الاستبداد في صوره المُختلِفة، وظروفه المتباينة”، وهو بالتعبير الرياضي “أوّل مصارع عرفته الحلقة واجه الاستبداد بقلبه وعقله وكان على استعداد فاق الحدود لكي يبذل روحه ودمه في هذا الصّراع الذي لم ينتهِ إلا بموته.
ويرى أنه في سبيل هذه الإصلاحات، وجّه الكواكبي إلى تصحيح المعتقدات الدينيّة لأنها أساس الإصلاح الوطني. كما يستعرض لآرائه في الدولة، ومنها ضرورة فصل المُلك عن الخلافة، مع عودتها – أي الخلافة – إلى الأمّة العربية، وأن تقوم على أساس الانتخاب والشورى والتعاون المتبادَل على سنة المساواة بين الأقطار الإسلاميّة. ومناداته بتحرير المرأة من الجهالة.
ويعتبر الكواكبي واحدًا من رواد العرب القلائل الذين وضعوا لأنفسهم غاية معينة تتمحور في علاج أسباب تأخُّر الأمم والقضاء على أسباب الظُّلم والاستبداد وتحرير الوطن والمواطنين من الاستعباد المتوارث، عن طريق تجريد الدين من الشوائب وتطهيره من المعتقدات التي دُست عليه، وإبعاد الرجعيين المتخلفين من رجاله من احتكار تفسيره وشرح أهدافه. ويعتبره ثائرًا على الرجعيّة والتخلُّف والجمود في جميع ألوان الحياة، وبخاصّة في الدين.
الكواكبي ويقظة اعرب
كان تأثير الكواكبيّ واضحًا وملموسًا في معظم الكتابات التي تحدثت عمّا يُسمى “يقظة العرب” سواء أكانت كتابات عربية أو غربية. فعلى سبيل المثال يخصُّه جورج أنطونيوس في كتابه “يقظة العرب” (1946) وهو من تعريب على حيدر الركابي، بمبحث مهم وهو يتحدّث عن الحركة في طفولتها، فيتحدث عن الدور الذي لعبه عبدالرحمن الكواكبي، عبر كتابيه “أم القري” و”طبائع الاستبداد”، فيصفه بأنه “ساهم في سير الحركة مساهمة قيّمة بمؤلفيْن لماعين تشع من سطورهما آثار فكر مبدع وفطنة مرحة، وساهم كذلك بأحاديث كثيرة تفيض حيوية وملاحة” (يقظة العرب: ص، 99)، أما عن أفكاره فيرى أنها “كانت هادئة وواضحة برغم النار المتأججة في نفسه” ويقول عن كتابه “طبائع الاستبداد” أنه يعكس “تأملاته، وعميق تفكيره كما يتدفق في شرح فلسفته بهدوء وسلاسة”.
ويشير إلى أن الكتابين “يحويان معًا تحليلاً عميقًا ورائعًا لحالة التداعي التي بلغها العالم الإسلامي بصورة عامة وأجزاؤه العربية بصورة خاصة وفيه كذلك كل تحليل لعلل هذا التداعي، وعلاجه المحتمل مع الدعوة بحرارة إلى وجوب الأخذ بالدواء الناجع”.
ويرى أن عنصر الإبداع في الدعوة التي حركها الكواكبي، فهو تفرقته ما بين الحركة العربية والحركة العامة التي تستهدف الوحدة الإسلامية والبعث الإسلامي والتي تولّى جمال الدين الأفغاني إثارتها، ويربط بين الدعوة التي دعا إليها الأفغاني ودعوة الكواكبي.
نفس هذا الأثر نراه في كتاب” الفكر العربي في عصر النهضة: 1798 – 1939″ لألبرت حوراني، وهو كتاب في مجمله يتناول مجهود العرب الفكري السياسي، عندما تنبهوا – وبخاصة المثقفين – إلى أفكار أوروبا الحديثة ومؤسساتها وبدؤوا يشعرون بقوتها.
ويرى المؤلف هذا المجهود – في جميع مراحله – قد انّصب على محاولة التوفيق بين نظرية الإسلام في الحكم، على مفهومها الإسلامي الأصلي، وبين التغيُّرات التي طرأت على واقع الحُكْم، في مختلف أطوار تاريخ الأمة الإسلاميّة، وما أن جابه الإسلام – فجأة – في أوائل القرن التاسع عشر، عالم أوروبا الحديث، فشعر المسلمون شعورً حادًا بضرورة القيام بمحاولة جديدة للتوفيق بين آخر ما كانت قد وصلت إليه النظرية الإسلامية في الحكم، وبين هذا الحدث الجديد.
لم يحضر الكواكبي بصورة مباشرة إلا في موضع مقتضب، وإنما كان الحضور الطاغي لأفكاره، وبالمثل أفكار قرنائه الذين ساروا على نفس درب الفكر النهضوي، كالأفغاني والطهطاوي وخير الدين والبستاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وصولاً إلى طه حسين. كما اشتمل على حضور قوي لطلائع العلمانية متمثلة في جورجي زيدان (1861- 1914)، وفرنسيس مراش (1830- 1870) صاحب “غابة الحق”، وقد كانت روايته الرمزية تمثيلاً واضحًا للأفكار الأوروبيّة المنتشرة في ذلك الوقت، كفوائد السلم وأهمية الحرية والمساواة، وتمثُّل حقيقي لمفهوم المدنيّة، وشبيلي الشميل (1850 – 1917) وفرح أنطوان (1874 – 1922) ونظريته للدولة التي كانت نقاشًا فعالاً لأفكار ابن رشد، فالدولة لديه يجب أن تقوم على الحرية والمساواة ، ويجب أن تتوخى بقوانينها وسياستها السَّعادة في هذه الدنيا والقوة الوطنية.
ويشير إلى تأثير أفكار الكواكبيّ – المُلْهِمة – التي تَركها في كتابيه “أم القرى” و”طبائع الاستبداد” إذْ وجدت التيارات الفكرية السّابقة تعبيرًا لها في هذين الكتابين، وما راجَ فيهما من أفكار تدعو (أو تُحَرِّض على) إلى الإصلاح، ويقول إنّ مبعث اهتمام الكواكبي بهذه القضية – أي مسألة الإصلاح – يتمثّل في شدّة غيرته، ومن ثمّ انطلق في آرائه من فكرة انحطاط الإسلام – بتعبيره – ويعزوها إلى قيام البدع ولاسيما الصُّوفيّة المتطرفة الغريبة عن روح الإسلام والتقليد الأعمى ونكران حقوق العقل والعجز عن التمييز بين الجوهري والعرضي في الدين. ومع إلحاج الكواكبيّ على هذا العامل المؤدّي بحد ذاته إلى الفساد والانحطاط، أضاف أن الحكام المستبدين لم يكتفوا بعملهم الشرير بتأييد الانحراف عن الدين الصحيح، بل أفسدوا المجتمع بأكمله، ولتحرير الإسلام من هذه الشرور يجب إصلاح الشرع وإنشاء نظام شرعي موحّد وحديث عن طريق الاجتهاد، ويجب – أيضًا – قيام تربيّة دينيّة صحيحة، وإن كان في رأيه – أي الكواكبي – أن هذا لا يكفي وحده، فمن الضروري تعديل ميزان القوة ضمن الأمّة، بنقلها مجدّدًا من أيدي الأتراك إلى أيدي العرب، فالعرب وحدهم يستطيعون حفظ الإسلام من الفساد؛ وذلك لمركز الجزيرة العربية في الأمة، ولمكانة اللغة العربيّة في التفكير الإسلاميّ، علاوة على أن الإسلام العربيّ قد نجا نسبيًّا من المفاسد الحديثة، وأن البدوي بقي بعيدًا عن الانحطاط الخلقي والخنوع الملازميْن للاستبداد.
عَودٌ على بدء
على الجُملة، نستطيع أن نقول إن حديث الكواكبيّ عن الاستبداد وطرق التخلُّص منه يتأتى من عدّة منطلقات أولها ما عايشه في بيئته المحليّة، حيث الفساد مُستشرٍ في كافة أجهزة الحكم، وهو ما قاده في النهاية إلى الاستغناء عن وظيفته، وثانيًا لاطّلاعه على تجارب الأمم السابقة، وثالثًا، لشعوره باستبداد الدولة العثمانية، وهو في هذا مأخوذ بدافع الغيرة على بني جلدته، والإسلام الذي اُتخذ ذريعة في غير محلها، لتكريس الاستبداد. ومع هذه الغيرة التي دفعته لإعلان صيحته المدويّة في صورة مقالات تنتقد الاستبداد ونظام الحكم، غير آبهٍ لما قد يجره عليه موقفه الصريح من هلاك، وقد كان حيث دُسّ له السمّ في القهوة.
المحزن – حقًا – أن تأثير صيحة الكواكبيّ لم يكن بالأثر الملموس سوى في الاستجابة على مستوى الكتابة، والتلقيّ، أما بالنسبة إلى الجماهير العريضة التي كان يستحثّها على الخروج والثورة على ميراث الاستعباد، ففضّلت العيش تحت نير ووطأة الاستبداد، فنأت وأعرضت عن الصيحة، وهو ما تجلّى بصورة واضحة بعد صيحات الربيع العربيّ، فمع ما عانته الشعوب من أنظمة استبداديّة لا تقل وحشيّةً وقسوةً، عمّا عانته في منتصف القرن التاسع عشر، مُستغلة الجنديّة (القوة) والدين (الترهيب) في توطيد دعائمها الاستبداديّة، وقهر مواطنيها، إلّا أنّ دعوات الحرية والإصلاح والنهضة – جميعها – ذهبت سُدىً، وعادت الشعوب التي خرجتْ عارية بصدورها تواجه الدبابة والرصاص، مهزومة إلى مربع الصّفر، تارة بتغوّل الدكتاتوريّة، وتوحُّش آلتها العسكريّة التي قضت على الأخضر واليابس، وتارة باعتلاء الأيديولوجية الدينيّة سدَّة الحُكمِ، ولم تكن أحسن حالاً من الأنظمة العسكرية، بل فاقتها سوءًا، باستغلالها الدين لتمرير مشروعها الظلامي الذي يعود بالمدنيّة إلى عقود وحقب هيمنت فيها الأصوليّة الدينيّة المتزمتة.
والأهم أنه – كما يقول الشّاعر الفرنسي بول إيلوار – “لا يوجد خلاص على الأرض طالما أنّنا نستطيع الصّفح عن الجلادين”. هذا هو المحك، فالمواطنون الشرفاء لم يرتدوا بالثورات إلى عهود الاستبداد بتأييدهم الدكتاتورية في كافة صورها (بما فيها الدكتاتورية الدينيّة عندما وصلت إلى الحكم في مصر وتونس)، وإنما قضوا على أيّ بارقة أمل أو نقطة ضوء، بدعواتهم إلى الصّفح والتغاضي عن مآسي الدكتاتوريات بعد إخفاق ثوراتهم، وقد أخذت لديهم – دعوات الصفح – أشكالاً عِدّة، منها العفو عن الدكتاتوريين السّابقين، أو بالبكاء على زمانهم، أو بتماهيهم مع مَن خلفهم من أنظمة لا تقل استبداديّة عن تلك التي خرجوا عليها! وهو ما يشير إلى فشل مشروع الإصلاح برمّته، فالخوف الذي سعى الكواكبي وأقرانه إلى تحرير الشعوب منه صار سمتًا وسمةً أصيلتيْن في تكوينها حتى ليصدق قول محمود درويش “ومشى الخوف بي ومشيت به حافيًّا”؛ ليس لأنها جُبلت عليه، وإنما لأنّ الاستبداد تغلغل في البنيّة الاجتماعيّة، وصار ليس عبئًا فقط، بل صار راسخًا ومتأصّلاً، وأضحت مقاومته أشبه بمستحيل رابع يُضاف إلى المستحيلات الثلاثة، فقد نجحت النُّخب الحاكمة (على اختلاف أيديولوجياتها) على مدار تاريخها الطويل من استئصال منافذ الحرية وجابهت وسائل التعبير بكل قوة ممكنة. ومن ثمّ لم يَعُدْ أمامنا – وهو حال العاجز – سوى الأسف والتأسّي على هذه الدعوات الإصلاحيّة (أوالتنويريّة) التي إن تحقّقت – كما أراد لها حاملوها – لتغيّرت خريطة العالم الإسلاميّ والعربيّ على حدّ سواء.




