أدب الداخل وأدب الخارج

أفرزت ظروف ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين في العراق كثيراً من الإشكالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأدبية، وإذا ما عددنا الأدب هو حصيلة طبيعية ونوعية وانعكاس وجداني وعاطفي ونصيّ لهذه الظروف والمتغيرات فبوسعنا معاينة ما حصل بوصفه إجابة نموذجية عن شبكة الأسئلة التي يمكن اقتراحها في هذا السبيل، إذ لا شكّ في أنّ سلسلة الانقلابات التي حصلت ابتداءً من انقلاب عبدالكريم قاسم على الملكية وما تبعها من انقلابات عشوائية هدفها المصالح الحزبية والفئوية والشخصية الضيّقة، وما صاحبها من تغيّرات واسعة وعميقة عمودياً وأفقياً في البنية الثقافية والاجتماعية والحضارية للمجتمع، كان لها أكبر الأثر في إحداث فجوات ثقافية وأدبية هائلة في بنية العقل العراقي المعرفي على أكثر من صعيد، ولعلّ من أبرز تمثّلاتها هجرة كثير من الأدباء والفنانين والمفكرين والمثقفين إلى بلدان العالم المختلفة وفي مقدمتها دول أوروبا الغربية والشرقية، أملاً في الحصول على حياة أفضل وأهدأ وأكثر أمناً وحرية وإنسانية ومعنى، حاملين معهم مواهبهم ومشاريعهم وآمالهم فقط كي يفتتحوا بها أفقاً جديداً لحياةٍ مختلفة ومجدٍ مغاير.
على الرغم من أنّ أسباب الهجرة لا تعدّ ولا تحصى لكنّ النتيجة واحدة في الأحوال كلها، وتتمثل في ترك الوطن واللجوء إلى بلدان أخرى ستصبح لاحقاً أوطاناً بديلةً ليكون الوطن الأصل وطناً احتياطياً وهامشياً قياساً بالوطن الجديد، وأذكر أنّ أحد الشعراء الأصدقاء من جيل السبعينات العراقي قال فرِحاً لكثير من أصدقائه بعد أن حصل على الجنسية الأسترالية “الآن أشعر أنني إنسان حقيقيّ”، بكل ما تنطوي عليه هذه الجملة القاسية من ألم ومرارة وعنف ولذّة وانتقام من خسارات ماضية لا عدد لها، غير أنّها تمثل في الطرف الآخر من المعادلة حقيقة لا يمكن إنكارها في ظلِّ أنظمة بوليسية غاشمة تعاقبت على حُكم البلد وما زالت حيث صار الحصول على جنسية أجنبية حلم الأحلام لأيّ أديب عراقي لا قيمة لجنسيته العراقية عالمياً، فجواز السفر العراقي على مدى سنوات أحد أسوأ الجوازات في العالم إذ لا تسمح له أيّ دولة في العالم مهما كانت صغيرة من دخول أراضيها (بما في ذلك الدول العربية الشقيقة!) إلا بتأشيرة دخول لقاء ثمن، والأغلب من هذه الدول لا تمنحه تأشيرة دخول مطلقاً حتى للأدباء والمفكرين الذين تتمّ دعوتهم من مؤسسات ثقافية وأكاديمية لهذه الدول.
الشاعر محمد مهدي الجواهري كان أحد أبرز المنضوين تحت لواء المهجرية الجديدة من الأدباء العراقيين أو حامل لواء المهجرية الجديدة، إذ قضّى أكثر من نصف قرن في رحلته المهجرية شرقاً وغرباً يتجوّل بقافيته بين البلدان والأمصار، فبعد خلافه مع عبدالكريم قاسم زعيم أول انقلاب في العراق هاجر (مختاراً أو مضطراً) إلى عدد من دول أوروبا ليستقرّ أخيراً في مدينة براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاُ، الجيك حالياً، وتصبح منفاه المفضّل الذي اقترن به على مدى سنوات طوال، فهي عنوانه وموطنه ومهجره ولكلّ من يرغب في لقائه ما عليه سوى أن يشدّ الرحال إلى براغ كي يرى الجواهري في أحد مقاهيها مع ثلّة من أصدقائه ومريديه.
وعلى الرغم من أنّه عاد مرات عديدة إلى العراق بدعوات من حكوماتها المتعاقبة إلا أنه كان ما يلبث أن يعود بعد ذلك إلى منفاه، حيث استطاب العيش هناك ولم يعد العراق سوى ملاذ روحي يلجأ إليه في عالم الأحلام والذكريات والأبيات الشعرية التي تتغنّى بماضيه، ومن ثمّ استقرّ قبل وفاته في مدينة دمشق ليموت ويدفن هناك في مقبرة الغرباء عام 1997 بعد استحواذه على لقب “شاعر العرب الأكبر”، وربما تحتاج قضية قياس تأثير الهجرة على نموذجه الشعري وتطوره إلى دراسة معمّقة تكشف قيمة ما كتبه من شعر قبل هجرته من العراق وبعدها، لكنّ اختياره ظلّ مشروعاً شخصياً للحياة أكثر منه للشعر لأنّ الحياة ليست شعراً كلّها حتى لأعظم شاعر في العالم.
الشاعرة الرائدة نازك الملائكة هاجرت مبكراً لأسباب شخصيّة غير سياسية واستقرّت في الكويت مدرّسةً في جامعتها، لكنّ مشروعها الشعري الحداثي توقّف تقريباً بتوقّف تجربتها الشعرية المتوهجة بعد تركها العراق، وتوقّف معه مشروعها النقديّ الحداثيّ بوصفها المنظّرة الأولى في تحديث الحركة الحديث الشعرية التي قادها الروّاد في العراق، واكتفت بما حققته شعرياً ونقدياً في المهجر ولم تضف جديداً إلى ما حققته في ذلك فقد أصيبت بنوع من الشلل منعها من التواصل المنتج في هذا السبيل، وبقيت كذلك حتى وفاتها في القاهرة عام 2007.
أما الشاعر الرائد الآخر عبدالوهاب البياتي فقد كانت الهجرة جزءاً من مشروعه الشعري وجاب دولاً كثيرة حتى استقرّ طويلاً في إسبانيا مستشاراً في السفارة العراقية هناك، وكانت الهجرة جزءاً لا يتجزّأ من شخصيته وتجربته الشعرية، وأتاحت له هذه الهجرة في بلدان مختلفة التعرّف بكثير من أدباء العالم الكبار وأسهمت هذه المعرفة في تطوير تجربته خلافاً لزملائه الروّاد الآخرين، حتى عاد مؤخراً إلى العراق قبل الاحتلال الأميركي ثم ما لبث أن استقرّ مدة لا بأس بها في عمّان، وكان عرّاباً للأدباء والفنانين العراقيين والعرب هناك إذ كان مقهى الفينيق عراقاً مصغراً ضمّه صحبة كثير من الأدباء والفنانين العراقيين والعرب المقيمين في الأردن والزائرين لها، وانتقل قبل وفاته بقليل إلى دمشق ليتوفّى هناك عام 1999م.
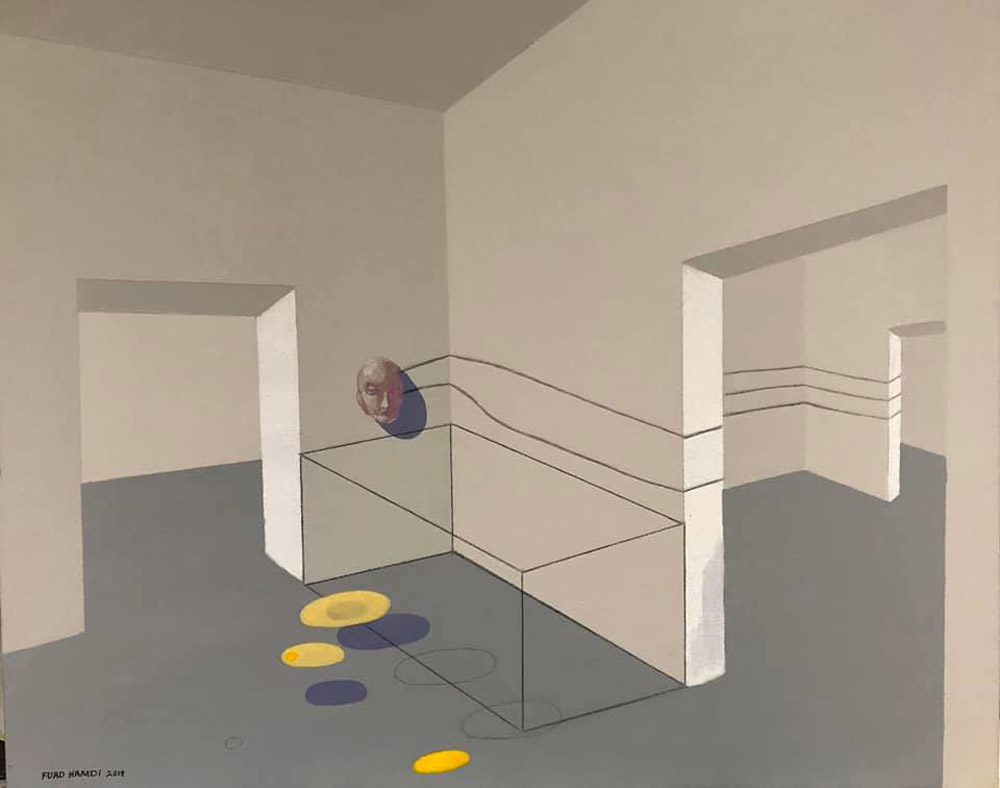
الشاعر الرائد الآخر بلند الحيدري ترك العراق مبكراً واستقرّ في لندن بعد سنوات وصفها بالجميلة والثرية في بيروت قبل الحرب الأهلية، لكنّ ما أنتجه من شعر في الغربتين بيروت ولندن لا يضيف شيئاً مهماً لتجربته الرائدة الأصيلة قبل هجرته، وهو نفسه يعترف بذلك في أكثر من حوار ومقابلة لأنّ التجربة الشعرية حوار بين شاعر ومتلقٍّ على أرض مشتركة وفضاء مشترك وحياة مشتركة.
وما يقال عن هؤلاء الشعراء الروّاد المهاجرين من العراق يقال عن زملاء لهم عزفوا أحلامهم وآمالهم في غربات ومهاجر متنوعة، لكنهم ظلّوا يتغنون بموطنهم الأصلي يكتبون له ويتمنون أن يصلهم ما يشعر به مواطنوهم حين يقرأونه، فكان الشاعر سعدي يوسف في غربته الشهيرة التي ما زالت قائمة حتى الآن، والقاصان الروائيان غائب طعمة فرحان وفؤاد التكرلي بوصفهما أيقونتين سرديتين عراقيتين مهمتين، ومن ثم بدأت هجرة أخرى لأدباء الستينات في العراق إذ هاجر فاضل العزاوي وفوزي كريم وصلاح نيازي وسركون بولص وصلاح فائق وغيرهم، وحاولوا تطوير تجاربهم الشعرية والأدبية والفنية عموماً في مفاصل كثيرة إذ نجح من نجح منهم وأخفق من أخفق، إذا كان الهدف الجوهري الأساس هو الشعر على نحو فني دقيق ومخصوص، غير أنهم عاشوا حياة أخرى لا تخلو من التباس تتقاسمها الحرية والحنين.
ثمة موجة هجرة أخرى كانت لأدباء الموجة السبعينية في الترتيب الجيلي العقدي لأدباء العراق، حيث انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها وخاضوا تجارب مضنية على أكثر من صعيد، وربما يحتاج الأمر الكثير من الفحص والدرس والمعاينة لتجاربهم الأدبية بين الوطن والغربة كي يتأكد الدارس من مدى الإفادة الفنية والجمالية من فضاء الغربة في تطوير هذه التجارب وتحديثها، لكنها في الأحوال كلها على مستوى الحياة فقد تمكّن هؤلاء من تغيير مصائرهم ضمن اختياراتهم الكبرى في الحياة، وهم فقط يعرفون ما تحقق لهم من منجزات على هذا الصعيد.
ومن ثم أعقبتهم موجة أخرى هي موجة أدباء الجيل الثمانيني الذي ذاق ويلات الحروب وبحث عن خلاص في الغربة، وواصل أدباؤه تجاربهم هناك في حياة أخرى ومصير آخر وحلم آخر، وينطبق الحال نفسه على الموجة التسعينية وما بعدها حيث ظلّ نزيف الهجرة بلا توقّف وازدانت المهاجر القريبة والبعيدة بهذه الكوكبة من أدباء العراق وفنانيها ومثقفيها ومفكريها، وهم يبحثون عن مصير جديد وفضاء جديد وحياة جديدة قد تسمح إمكاناتهم ومواهبهم وشخصياتهم ببلوغها وقد لا تسمح، لكنّ الكثيرين منهم راحوا يتآلفون مع حياة المهاجر الجديدة ويعيشونها بحلوها ومرّها بين تطّلع نحو حرية مقترنة بالأمل وحنينٍ مشوبٍ بالألم، فمنهم من واصل المسيرة ومنهم من عاد خائباً إلى بلده، وفي مثل هذه الأوطان العربية الطاردة كل الخيارات سيئة كما يقول الروائي يوكيو ميشيما وهو أبلغ وصف لهذه الحالة.
كانت آخر سلسلة الهجرات العراقية إلى الخارج بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي لبعض المدن العراقية الغربية، وعلى الرغم من أنّ مدن إقليم كردستان كانت ملاذاً متاحاً لبعض أدباء العراق ومفكريه ومثقفيه وأكاديمييه وعلمائه، غير أنّ البعض الآخر هاجر نحو دول الجوار ودول أوروبية قبلت اللجوء إليها لهذا السبب، وكنتُ أنا (محمد صابر عبيد) واحداً ممن لجأوا إلى تركيا واخترت مدينة “VAN” في أقصى الشرق التركي، وعرض عليّ صديقي الشاعر والأكاديمي عقل العويط الكتابة في الملحق الثقافي لجريدة النهار البيروتية بمكافأة مجزية، أعانتني كثيراً في توفير متطلبات العيش الجيد لي ولأسرتي في هذه المدينة حتى دبّر لي صديقي البروفيسور الدكتور محمد شيرين تشكار عقداً في جامعة “Yüzüncü Yıl Üniversitesi” التركية، لأدرّس مادة الأدب المعاصر لطلبة الماجستير، ومادة الأدب القديم لطلبة الدكتوراه في كلية “الإلهيات”، فبقيت لمدة سنتين أدرّس في هذه الجامعة وناقشت عدداً من طلبة الدراسات العليا ممكن كتبوا رسائلهم وأطاريحهم باللغة العربية في أكثر من تخصّص إنسانيّ، حتى تحررت مدينتي الموصل من براثن الإرهاب وعدت مجدداً إلى جامعتي جامعة الموصل، فلم تطل هجرتي كثيراً لكنّ مصير أولادي تغيّر تماماً حيث انضمّوا إلى جامعات تركية وأجنبية وصارت هجرتهم كليّة، أما أنا فعدت على مضض حتى أحصل على تقاعدي وربما أترك البلد نهائياً، فما أراه الآن لا يتعدى أن يكون سوى أفق مغلق بحاجة إلى معجزة كبيرة في زمن غابت فيه المعجزات.
إنّ حلم التغيير والخلاص والحرية هو حلم إنساني مشروع لكلّ آدمي على وجه الأرض فكيف بالأديب والفنان والمثقف والمفكر، ولا شكّ في أنّ هجرة الأدباء العراقيين هذه تمثل ظاهرة حقيقية تستحق البحث والدراسة والتحليل والكشف، وما أطروحة “أدب الداخل وأدب الخارج” وما صاحبها من اتهامات متبادلة بين طرفي الأطروحة إلا عتبة مهمة لهذه الظاهرة السوسيوأدبية، ففكرة التخوين المتبادلة بين الطرفين يمكن أن تكون منطلقاً سوسيولوجياً لإدراك طبيعة العقل الأدبي العراقي الذي مازال قسم كبير منه للأسف يفكر بطريقة حزبية تافهة وضيّقة في الممارسة الحضارية وتشكيل رؤية ناضجة حول المستقبل.




