الرواية والانتماء ووعي الخراب

ينتمي رشيد الضعيف (1945) إلى تجربة في الكتابة الروائية، يمكن اعتبارها الأكثر وفاء لفضائها وزمنها الحاضنين، ضمن مسار الرواية اللبنانية المعاصرة، سواء بالاستناد إلى موضوعات الحرب الأهلية، والغزو الإسرائيلي، والمقاومة، وبطولة بيروت، أو بالنظر إلى الحضور الكثيف للخلفية الثقافية، في سجل الكلام الروائي؛ وانغراس النماذج البشرية المشخصة، عبر مجمل نصوصه الروائية، في تربة الطائفية الدينية، التي تحاصر المجال السياسي والمدني اللبناني. وحتى بتداخل لغات التخاطب اليومي، والصحافة، والإعلام المرئي، على ألسنة الرواة، وفي تفاصيل الفضاءات الروائية.
والحق أن العالم الروائي لرشيد الضعيف، ليس حالة استثنائية في مسار الإبداع الروائي اللبناني المعاصر، بقدر ما يشكل تنويعا، وامتدادا، لذلك المشهد النصي المتناغم والمتنوع، الذي أرسى دعاماته الجمالية روائيون لبنانيون، حظوا بانتشار واسع في العالم العربي، وترجمت أعمالهم إلى أكثر من لغة؛ لعل أبرزهم إلياس خوري وحنان الشيخ وهدى بركات وحسن داود وعلوية صبح وغيرهم، من الجيل ذاته، أو من أجيال لاحقة، ممن وقعوا كلهم في دائرة سحر الموضوعات اللبنانية الخالصة.
وكشأن عدد كبير من الكتاب العرب، الذين أغواهم المنتج الشعري، المهيمن على صوت الإبداع، في بدايات النهضة الأدبية العربية الحديثة، ووجدوا أنفسهم في عوالم البين – بين، في زمن الفورة الفكرية والسياسية، وتدفق الأسماء والتجارب والأسئلة الثقافية، فقد تقلبت كتابات رشيد الضعيف بين هموم المثقف المنخرط في أجواء الصراع العقائدي والسياسي التي استوطنت لبنان، والتجربة الشعرية خلال عقد الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين، لتكون أعماله الشعرية: “حين حل السيف على الصيف” (1979)، و”لا شيء يفوق الوصف” (1980)، و”أي ثلج يهبط بسلام” (1993)، تنويعا على مقام تعبيري طاغ زمن الحرب، وهو ما حدا به، بعد ذلك، إلى إنجاز أطروحته للدكتوراه، في باريس، عن التجربة الشعرية الرائدة لبدر شاكر السياب، من خلال ديوانه “أنشودة المطر”. قبل أن ينصرف لبناء عالمه الروائي الخاص، الذي تواتر بغزارة وانتظام، من مطلع ثمانينات القرن الماضي، إلى اليوم، بدءا بنص: “المستبد” (1983)، وانتهاء برواية “الأميرة والخاتم” (2020)، مرورا بروايات “فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم” (1986)، و”أهل الظل” (1987)، و”تقنيات البؤس” (1989)، و”غفلة التراب” (1991)، و”عزيزي سيد كواباتا” (1995)، و”ناحية البراءة” (1997)، و”ليرنينغ إنغلش” (1998)، و”تصطفل ميريل ستريب” (2001)، و”إنسي السيارة” (2002)، و”معبد ينجح في بغداد” (2005)، و”عودة الألماني إلى رشده” (2006)، و”أوكي مع السلامة” (2008)، و”تبليط البحر” (2010)، و”هرة سيكيردا” (2014)..
ولعل أول ما يسترعي الانتباه في هذا المتن الروائي المتساند، والمتلاحق في الصدور، هو مزجه الواعي، والخفي، على حد سواء، بين رواسب التراث القديم، متمثلا في تصانيف “الأخبار” و”التراجم” و”الطبقات”، ومؤثرات الحاضر الممتد، من التجريب الروائي المعاصر؛ مزج يطل من العناوين أحيانا، باستحضار بغداد (معبد ينجح في بغداد)، والسيد كواباتا (عزيزي سيد كواباتا)، “الأغاني” والرواية اليابانية،… وكأنما التاريخ بأمكنته، وأسمائه، ورموزه، ولغاته، وإيحاءاته الغامضة والمنتهية، وعبثه بمصائر الحب والعنف، وتقلبات الشهوة والسلطة، مجرد تعلّة للتغلغل في مفارقات الحاضر، واستشراف متاهات المستقبل، في محيط عربي منذور للتشظي، والانكفاء على الأنوية الطائفية والقبلية الصلبة والمتجددة.
لهذا يمكن اعتبار رشيد الضعيف، على الدوام، روائي الزمن الحاضر، وإن تلفّعت محكياته بمجازات قديمة أحيانا، ذلك أن هواجس ما يجري في تربة لبنان من التباسات اجتماعية، وتقاطب فكري وعقدي، وكبت جسدي، واحترابات عاطفية،… ما هو إلا صيغة أخرى لحرب أهلية مخفية بين التلافيف والحنايا، لا تلبث امتداداتها أن تستعر مع ازدهار عوامل النكوص إلى المحافظة وتراجع مكتسبات النهضة.
لكن حرب رشيد الضعيف ليست هي الكليشيهات التاريخية المأثورة عن الحروب الأهلية في واقع ثابت، هو لبنان، تتخذ لها أبعادا وصورا واستعارات متباينة، عبر التنويعات النصية لمشروعه الروائي؛ فسرعان ما تجتبي تلك الحرب إبدالات واقعية تتخطى النطاق المحلي، إلى المحيط العربي، والأفق الكوني، كحربي الخليج الأولى والثانية، اللتين تومضان في بعض مقاطع رواية “تصطفل ميريل ستريب”، أو مساهمات الجيوش الأميركية في غير ما حرب كونية كما في رواية “تبليط البحر”، فضلا عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الجوار العربي عموما واللبناني تحديدا الذي يستثار في أغلب نصوصه.
هل هو – إذن – روائي “الحرب”؟ كما يحلو لعدد كبير من النقاد والصحافيين نعته، مع التركيز على الوقائع والمضامين الروائية دون سواها؟ الشيء الأكيد أنه “يستحضر بشكل وافر الآثار التي خلفتها الحرب الأهلية في الأنفس والأجساد، لكن السرديات التي ينشئها لا تمثُل بوصفها ترجمة دقيقة لحالة الحرب… إذ سيكون من غير جدوى أن نبحث عن مشاهد للمعارك، مثلما كان الأمر عند روائيي القرن التاسع عشر الفرنسيين، مع معركة واترلو،.. إنه “لا يصف الحدث الحربي، فما هذا الأخير إلا خلفية وذريعة للتمادي في رصد أعماق الكائن البشري، ورصد انفعالاته، حين يجد نفسه في مواجهة الخصاصة وتهديدات الموت” [1].
الرواية حرب مفتوحة
ففي رواية “هرة سيكيريدا”، لا نكاد نعثر، فعليا، على أيّ مشهد لمعركة مستعرة، شأنها في ذلك شأن رواية “أوكي مع السلامة”، أو “لورنينغ إنغلش”، على سبيل المثال، لا الحصر؛ لكن المبنى الروائي في تلك الرواية، التي تحكي عن خادمة أثيوبية، ونزقها الجنسي، ومغامرات ولدها غير الشرعي، سرعان ما تحبل بالإشارات المتكررة إلى خلفية فضائية غير سوية، تنقسم فيها المدينة إلى كونين متنابذين، “بيروتين”، شرقية وغربية، يفصل بينهما خط أخضر، وزمن ملتهب، ومجتمع تتوزعه الطوائف، ويرتهن إلى عصابات الخطف، والتصفيات على الهوية، وهوس الهجرة إلى حيث الأمان والثروة هناك في مغتربات أفريقيا.
نجد في الرواية كل ذلك، ولا نجده في الآن ذاته، تقوله وتحجبه، من خلال بطولة الولد غير الشرعي (رضوان) الذي يترك المدرسة لخدمة فتاة معاقة (أمل)، قبل أن ينخرط في علاقة حب فطرية معها، تذهب إلى نهايتها، وتتحول إلى تواصل جسدي، يمنح كلا المراهقين شهوة العيش والفرح، في محيط كل ما فيه يدعو للاكتئاب، ولا يلبث أن يثمر حملا، يشرخ العلاقة الفطرية، ويدفع رضوان إلى الهروب. وهو الاختفاء الذي يعيد الرواية (شأن غيره من الاختفاءات في أعمال أخرى للكاتب) إلى قلب الزمن الحربي غير السوي، ويتيح للسارد أن ينتقل من الحرب الخفية والمعتادة لأجل تحصيل لقمة العيش، إلى الحرب المعلنة بين الطوائف والجماعات، ومن تحصين السكينة التي يناضل فيها الباعة والموظفون وسواقو التاكسيات والمدرسون، للبقاء عند عتبة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية، إلى المتاريس وخطوط التماس، حيث “تعلق القوانين ويصبح كل شيء مباحا عند فئات كثيرة من الناس، ولا يعود الخارج خارجا، ولا تعود للبيوت حرمة، ويختلط إيقاع الليل بإيقاع النهار، وتتبدل الأحلام والآمال. فالحرب الأهلية وضع اقتصادي جديد، وسوق عمل جديد ومصدر رزق جديد” [2] ، يتجاوز الوظيفة الحكومية والتجارة والخدمات الطبية والتعليمية والسياحية، إلى خدمات الأمن والتحصين ومبادلة المخطوفين.
بالطبع تبقى روايات رشيد الضعيف حريصة على استبعاد مشاهد الوصف الفيزيولوجي الصادم للمجازر والتصفيات، توحي أحيانا أن لا شيء هناك، فالتلاميذ يذهبون إلى مدارسهم، والشبان يعيشون حياة النزق المعتادة، لكن في النهاية قد يُخطف شخص ما، أو يُهاجر، أو يُحتلّ منزله، أو يُغتال قريب له، لنحسّ أن تلك الحياة لم تكن يوما ما طبيعية، هي لحاء روائي سميك يوهم بالاعتيادية ويضمر الفوضى. ذلك ما يطالعنا في رواية “أوكي مع السلامة” التي تروي عن علاقة عابرة بين البطل (السارد) المثقف والكاتب، وطالبة جامعية تدعى “هامة”، دعته للمساهمة في نشاط طلابي بمحاضرة، فكانت بداية علاقة معقدة تختصر الكون في دوائرها الصغيرة. تنتهي العلاقة بمكالمة هاتفية مقتضبة تعبر فيها “هامة” عن رغبتها في إنهائها، وبجملة قصيرة تستبق الهيجان وتختصر مسافة الكلام، يجيبها “أوكي مع السلامة”. جملة تنهي كل شيء في الآن ذاته الذي تشرع مسارات السرد على احتمالات الاسترجاع التأملي لأطوار علاقة محمومة وبالغة التعقيد بين رجل وامرأة والعالم الكبير حولهما، حيث تسكن الحرب اليومي الباهت الذي تسطّحه الرؤية، بعيدا عن الصور الملغزة للصراع بين الفرقاء العقائديين كما تنقلها وسائل الإعلام. فرشيد الضعيف ممن أتقنوا الانفلات من دائرة المفاهيم الثابتة، والمثيرات المكرورة لتفاصيل “المتاريس” و”الألغام” و”السيارات المفخخة” والصراع الطائفي، بامتداداته الخارجية. هو لا يبعث برسائل إدانة، ولا بدروس وحكم. وينفر من الأفكار الجاهزة، عن الميليشيات والفرق المتحاربة، تبدو الرواية غير معنية بها، هي معنية بالكنه البشري الخفي الساكن في صلب المدينة المتشظية، حيث السعي إلى رسم مدار علاقة جنسية مكتملة يوازي في خطورته وعمقه حرب الشوارع، وكأنما الروائي يبحث عن جبلة التوازن التي تجعل الناس يعيشون.
الرواية والنسق العائلي
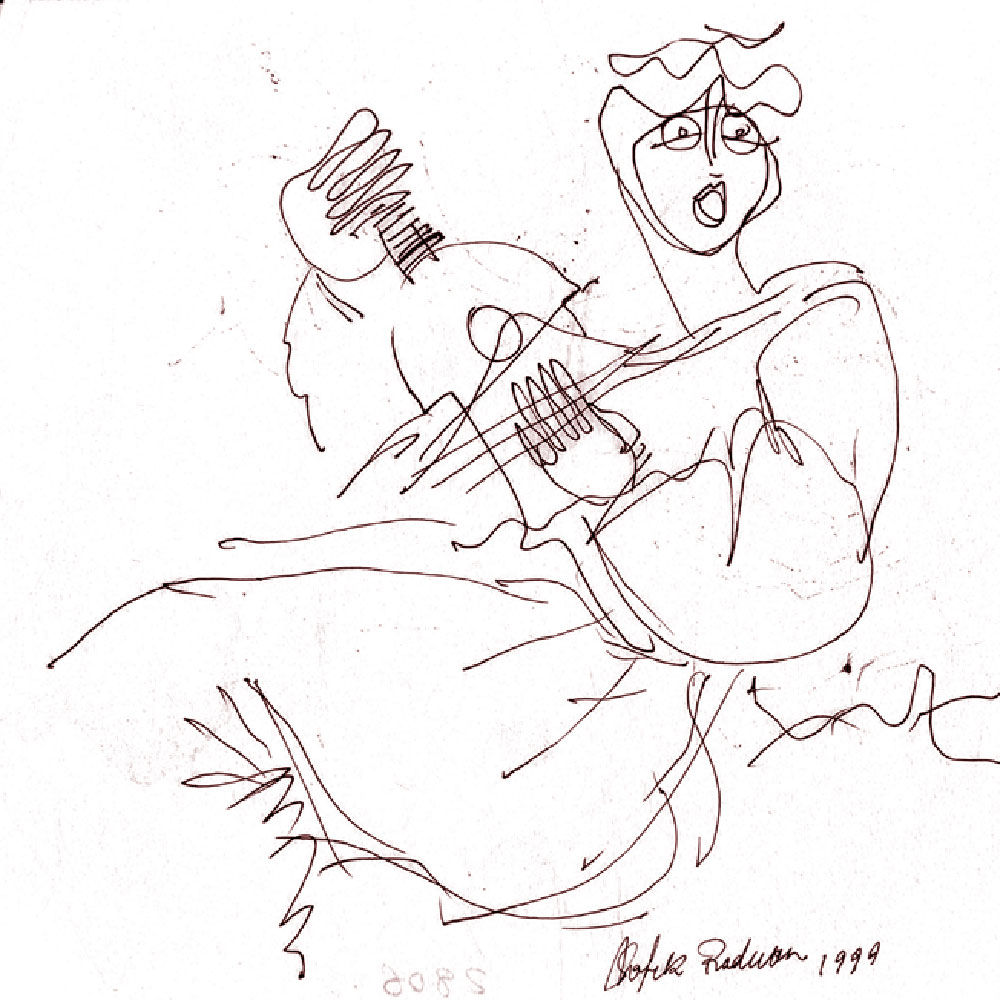
ولأن الحرب لا تكتسي خطورتها دونما إيهام بالفقد، فقد القريب وابن الحي والطائفة والحزب، وفقد السكينة، واللحمة المولدة لها، فإن روايات رشيد الضعيف لن تبتعد يوما عن مدارات العائلة بمعناها الضيق والواسع معا، حيث ينطلق الصوت السردي باحثا عن امتدادات الفقد العائلي لـ”لأب” كما في نص “لورنينغ إنغلش”، أو “الزوجة” كما في “تصطفل ميريل ستريب”، أو “الابن” كما في “هرة سيكيردا”، أو “الحبيبة” كما في “أوكي مع السلامة”… أو غيرها. وهو فقد يستلهم جوهر الفن الروائي، إذ لا رواية دون تعقيدات عائلية، فمحن الأقارب هي التي تولد الشخصيات والأفكار الروائية الخالدة، مشاكل الإرث والطلاق والمرض والاحتياج والخيانة والثكل والعقوق.. إنها التفاصيل التي جعلت بالزاك يكتب “الأب غوريو”، ودوستيوفسكي يكتب “الإخوة كرامازوف”، ففي الروايتين معا ليس الجوهري هو السياق الاجتماعي الذي يكسب الأحداث والشخصيات دلالات تاريخية، الأهم هو تلك التفاصيل الدرامية المرافقة لتصرف الأبناء والإخوة، وكيف تختصر الكنه الإنساني الملتبس.
من هنا نفهم كيف ينهض بين الخطاب الروائي عند رشيد الضعيف وبنية العائلة تلازم رمزي مسترسل، وجدل في المضامين والقيم، ينطوي على ثراء مغر بالاستكشاف، فكلاهما ينهض على أصول، ويسعى إلى إعلان صور، بقدر ما يثوي أسرارا وألغازا؛ فالرواية إظهار لوعي ذوات فردية، في صراعها وتواؤمها مع الآخرين، والعائلة نظام لأواصر الحب والكراهية بين الأقارب، ومواضعة على أسباب العيش والطموح وتخليد الأثر. ومثلما يسعى الكون الروائي إلى اختزال الزمن والشخوص والفضاءات في رحابة ممكنة، تختصر العائلة التوق الاجتماعي وقيمه، وتناقضاته الوجودية. ولما كانت الرواية حكاية بؤس وسعادة، وموت وحياة، فسرعان ما باتت مدارا لمحاكاة القدر العائلي، إنه القدر الذي جعل السارد في رواية “تصطفل ميريل ستريب” يقول في مقطع دال من النص الراصد لإيقاع التباعد في علاقة زوجية معطوبة “الإنسان فعلا يتعلم بالزواج أشياء كثيرة لا يمكن أن يتعلمها دون زواج. الإنسان قبل الزواج شيء وبعد الزواج شيء آخر، هذا ما خبرته أنا بنفسي. الزواج يعلم المسؤولية، والرجل الذي لا يعرف ما هي المسؤولية، والذي لا يعي أهميتها، هو إنسان ناقص” [3].
لعلها الفكرة الجوهرية التي تسكن ذوات الشخصيات الروائية لرشيد الضعيف، وتحكم تصرفاتها في العوالم البيتية والمدينية، وجدلها مع التخوم الوجدانية المنهكة، والعلاقات المتوترة بفعل الحرب، وإيقاع اليومي المتسارع، ففي كل مرة تطل نواة العائلة الصغرى من تفاصيل الحبكات الروائية، كمرجع لتوليد الحكاية الشاذة والغرائبية والمارقة عن سكينة المسؤولية، بهروبها المتكرر إلى هوامش النزوات المتحررة، والخيانات التي لا تعترف بالخطيئة، وتلك التي تبدو قدرا ليس منه برء.
وتدريجيا ينتظم المبنى السردي على شبكة من الأفعال المنطلقة، والحوارات الساخرة من العرف والعقيدة والمواضعة الاجتماعية، للتعبير عن مناقضة الصوت الروائي للواقع المتكلّس، الكابت للانطلاق العاطفي والجسدي؛ حيث تتجلى العائلة نموذجا مصغرا للمجتمع الأبوي المستحدث، الموهوم بقيم الحداثة والرافض لها في آن [4]. وهو ما يتجلى بوضوح في رواية “تبليط البحر”، عندما يسترجع الروائي أحلام النهضة والتنوير في يفاعتها البهية، عبر مؤسسة الزواج ذاتها قائلا على لسان السارد “كان أسعد خياط نهضويا يحلم بأن تتخلص بلاده من تخلفها وبأن تترقى إلى مصاف الدول الأوروبية، وكان لذلك يحارب الجهل، ويدعو إلى تحرير المرأة، وينادي بالاختلاط بين الرجال والنساء في الأماكن العامة، لذلك فاجأ الجميع في عرسه عندما أجبر زوجته على أن تقف إلى جانبه عند استقبال المهنئين، رجالا ونساء معا، وكانت العادة جرت منذ أقدم ما يذكره الناس، على أن تستقبل العروس المهنئات، والعريس المهنئين، في مكانين منفصلين” [5].
هكذا يبدو رشيد الضعيف مسكونا بالشأن العائلي، المختزل لجوهر النهضة، ولأسئلة الرواية في الوقت ذاته. ففي هذه الرواية وغيرها، تنطق الشخصيات من خلال ما يعترضها من مآزق وتوترات سردية، قد تبتدئ بسوء الفهم وانعدام التواصل العاطفي والجسدي، ولا تنتهي بالطلاق والعنف والاختفاء؛ وهي الملامح التي تربط النواة الجسدية بجوهر الحرب، إذ في كل مرة ثمة سعي إلى الهيمنة والإخضاع والتحكم، ضمن ثنائية عائلية متغيّرة الأطراف، قد تتمثل في الزوج والزوجة (أو العشيقة أو الصديقة)، الأب والأبناء (أو الأحفاد)، الأخ والأخوات، الكبار والصغار،… بقدر ما تصلها بمرجعية المدينة، التي تحتضن جدلية الجسد والعائلة والحرب على حد سواء.
الجسدانية والتوتر السردي
وغير خاف أن رشيد الضعيف هو بمعنى ما روائي المدينة الشرقية المنطوية على المتناقضات الإنسانية والفكرية والجسدية، الناجمة عن تساكن التقليدية والحداثة، الطائفية والعقلانية الليبرالية، التي تمثل بيروت أحد أبرز رموزها، والأكثر دلالة على هذا الانفصام. ففضلا عن تكرار ثنائية بيروت الغربية والشرقية، المتصلة بأنساق طائفية ذات مراجع عائلية، ثمة البؤر البيروتية الأصغر، التي تسكنها العائلات الصغيرة، المنهكة من قبل الحرب، والتي تضحى تشظياتها كناية عن العنف المزدوج، المتأتي من تلاحم الحرب الأهلية والمدينة المشطورة بين كياني الأبوية والحداثة الوهمية.
لكن النسق العائلي المختل، في امتداداته التخيلية والبلاغية، التي تلتبس بموضوعتي “المدينة” و”الحرب”، يجد تحققاته الأبرز في سمة “الجسدانية”، وما يتصل بها من توتر سردي، والمقصود بالجسدانية هنا نزعة التخييل إلى استثارة الانكسارات والأفراح عبر ارتداداتها الجسدية، وهو ما يتحقق، على نحو جليّ، في رواية “تصطفل ميريل ستريب” حيث يبدو “التنابذ” بين جسدين (زوج وزوجة) كناية عن علة كبيرة في التواصل بين ذهنيتين، تسكنان المدينة الشرقية. تُمثّلُ الجسدانية هنا بوصفها لعبة الروائي المفضلة في الابتعاد عن ساحات المعارك الملتهبة، في الشارع وخارج الأبواب المغلقة، تتجلى كمعركة رمزية بين ثنائيات كبرى، قد تمتد من بنية العائلة (المحافظة والمتحررة) إلى صراع الشرق والغرب، وهو ما يؤكده الروائي نفسه في أكثر من حوار له [6].
لكن الجسدانية تتجاوز أحيانا كنه ذلك الصراع النكد، بين طرفي ثنائية محكومة بالتلاقي والتقاطع، إلى الرغبة في تعرية مناطق شديدة الحساسية في الذهنية التقليدية، بل تكاد تختصر صلب الفروق الثقافية الكبيرة بين وعي متحرر بالجسد ومتعه وهواجسه، وإدراك محافظ منكفئ على محرماته واستيهاماته. يقول الكاتب في هذا السياق ضمن أحد مقاطع كتابه “عودة الألماني إلى رشده”، وهو شهادة روائية عن تجربة عيش مشترك له مع كاتب ألماني صاحب ميولات مثلية، ما يلي “المسألة ليست مسألة نوايا، بل مسألة ثقافية. أذكر أنني عندما تعرفت إلى فتاة فرنسية في الفترة الأولى من إقامتي في باريس… دعتني هذه الفتاة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في بيت أهلها في ضاحية باريس، وكان أهلها في عطلة خارج فرنسا، وليس في البيت سوى أخيها الأكبر… وفي المساء، وبعد أن تعشينا ثلاثتنا وأمضينا بعض الوقت نتحدث في الصالون، جاء وقت النوم، فنهضت صديقتي إلى غرفة النوم، وذهب أخوها يعمل في مكتبه، وبقيت أنا وحدي جالسا حائرا لا أدري ما عليّ أن أفعل، ثم بعد حوالي ساعة عادت صديقتي وقالت لي معاتبة “ماذا تفعل هنا؟ لماذا لم تتبعني؟” قلت”أتبعك أين؟” قالت متعجبة “كيف هذا؟ إلى أين؟ إلى غرفة نومنا”… وسألتها ونحن نتعانق في الفراش لكن بمبادرة منها، “ألا يزعج هذا أخاك؟” ففوجئت بالسؤال ولم تفهم قصدي، فتابعت معانقتها حتى أبدي لها أن سؤالي كان فكرة عابرة” [7].
في هذا الكتاب يسترسل رشيد الضعيف في تقليب معاني الجسد، وفخاخه ومزالقه وأوهامه، من موقع الوجود في صلب تجربة نفسية وحياتية مختلفة؛ بالطبع سيقدم تلك الأفكار والهواجس في صيغة تخييل سردي، لا يسمّيه رواية، ولا يقدم أيّ وسم تجنيسي له في المقابل، فغلاف الكتاب يحمل عنونا ذا طبيعة خبرية (وحكما قيميا إلى حد ما)، صيغة توقع الكثيرين في التباسات قرائية شتى؛ لكن المباني التصويرية في النص لا تخرج عن الترسيمات المعتادة لروائية رشيد الضعيف، حيث تسكن الجسدانية تلافيف الصراع والالتباس بين حدود متقاطعة ومتباعدة للذكورة والأنوثة. مع قيمة مضافة تجعل سؤال التطبيع مع انفعالات الجسد ورغائبه وصبواته تمتد من شهوة “النقيض” إلى “المثيل”، وتعبر بالنص حدودا شائكة تمتد على طول المسافة الفاصلة بن الرؤيتين الحضاريتين المتباعدتين للشرق والغرب.
السارد وتذويت الكتابة

والظاهر أن الالتباس التي يستنبته نص “عودة الألماني إلى رشده”، بصدد طبيعة الحكي، وصلاته بالوقائع والمرجعيات، يرتد بالقيم الروائية لـ”الجسدانية” و”الحرب” و”العائلة”، إلى نطاق سؤال أشمل عن الذات (ذات الكاتب) ومدى تورطها في النص المسرود واستبطانها لثناياه، وعلى من يحيل السارد في الصيغ الروائية المتراكبة، فرشيد الضعيف لن يكف في أيّ من إنتاجاته عن الإيحاء بأن الأمر يتعلق بذاته هو “شخصيا”، لاسيما حين يسمّي أبطاله الرئيسيين، في أكثر من نص، باسم “رشيد” ويضيف أحيانا صفة “الأستاذ الجامعي”، بل ويوغل في التخصيص حين يتحدث عن شخص “مطلق”، ويتقن الفرنسية، وأنجز أطروحته الجامعية في “السوربون” بفرنسا؛ كما في روايتي “لورنينغ إنغلش” و”أوكي مع السلامة” على سبيل المثال. كل ذلك في تماه مع تجربة شخصية تطل في كل مرة بوجه مختلف، وهي مسار المثقف العابر لمعترك الحرب الأهلية، الذي يتحدث في السرد بضمير المتكلم، وكأنما في الأمر سعي قصدي من الكاتب إلى تزكية تصور معين للكتابة الروائية، بما هي تنويع على مقامات السيرة الذاتية، وإعادة تأمل لمحطاتها ومساراتها المتحققة والممتنعة، مع نزوع إلى إسناد المبنى التخييلي بخلفية تاريخية ولسانية وأسلوبية تحكم تشكيل المعنى المقصود.
من هنا لا يمكن فهم الاختيارات السردية لرشيد الضعيف دون الوقوف على سمة “التذويت” الأسلوبي، التي تراوح بين صيغة “الأنا” التي تتلبس السارد تارة، وتطريز الجمل العربية الواصفة والحوارية بنتف من الكلام الدارج، وتراكيب فرنسية وإنجليزية، تارة أخرى، التي بقدر ما تهجّن الأسلوب، وتقرّبه من صورة اللغة الاجتماعية، ومساراتها التداولية، فإنها تحوّل التشكيل اللغوي إلى جزء من الرهان التخيلي على ذاتية الحكي وواقعيته الشديدة. يقول السارد في رواية “لورنينغ إنغلش”، “أنا أحب أن تكون المرأة أكثر Disponibilité لكن هذه بلادنا، ولا بد من التصرف على أساس ما تسمح به الظروف. ‘جود من الموجود’ يقول المثل. وأنا سعيد بما هو معروف عنّي بين الناس من هدوء وروية وحكمة، … ثم إني شخص معاصر. ألبس نظارات صغيرة ‘ريترو’، ‘لوك’ مثقف باريسي شهد أحداث الحركة الطلابية عام 1968 في فرنسا… وأجيد الفرنسية كتابة وقراءة ومحادثة” [8].
وكأننا بالكاتب يرسم صورة شخصية له، وهو يتوجه بالكلام إلى قارئ بعينه من لحم ودم، فيستعمل نفس تلك التوليفة الهجينة التي تسوّي الكلمات العربية والفرنسية والعامية في سبيكة واحدة، مثلما يحدث في الكلام اليومي، لتركبها على لسان وجه له ملامح (لوك) رشيد الضعيف دون سواه، وفي مقطع سابق من الرواية نفسها يتحدث السارد عن حالة الطلاق من زوجة فرنسية وعن ابنته (بدل ابنه كما هو في الواقع) التي تعيش مع أمها في فرنسا، كل ذلك ليس بقصد النزول بأسلوب التخييل إلى تبسيطية مباشرة، كما قد يخيل لأول وهلة، وإنما لتلوين المبنى الروائي بسمة “التذويت” الكاشف وشديد الحساسية، والمولد لطاقة التأويل.
تركيب
في حوار مع الروائي، أجري مطلع العقد الماضي، قال ما يلي، “إنني أود كتابة رواية دون معنى، وهذا شيء أساسي بالنسبة إليّ، وأقصد بذلك ألا تنطوي علي أيّ سياقات فلسفية، وأحاول أن أضع رواياتي خارج هذه السياقات، وأريد أن أكتب من أجل أن يتمتع القارئ، ونبراسي في ذلك ألف ليلة وليلة التي أعتبرها أجمل الكتب في العالم لأنه كتب خارج المعاني والنضالات، وهذا سر خلوده، وعندما أقول رواية دون معنى، هذا لا يعني أنها رواية تافهة، لأن هناك قارئا سيجد فيها معنى يريده ويبحث عنه” [9].
سيتردد مثل هذا الزعم في العديد من حوارات الكاتب، وسيحاول دوما أن يقنعنا بأنه غير مهووس بالفخامة وبالأفكار الكبيرة، بل ويسعى لأن يوحي في أحيان أخرى أنه غير جدي بما يكفي في كتاباته، بالمعنى الذي يقرن الجدية بمجافاة المتعة، والإيغال في مجاهل “التعقيد النثري”، حيث تنسلخ الكلمة عن خفة الاستعمال، وتكتسي إهابا لفظيا بعيد الغور، فكتابات صاحب “إنسي السيارة” و”تصطفل مريل ستريب” و”لورنينغ إنغلش”، وغيرها من العناوين الخارجة عن المألوف، تسعى إلى أن تخلق من الخفة اللفظية بلاغة مؤثرة وماتعة الأعطاف، حيث تتراسل الأحاسيس المتناقضة والتفاصيل اليومية، باعتياديتها وبساطتها أحيانا، وشذوذها وفجائيتها أحيانا أخرى، لتعبر عن الحميمية والوحدانية والتيه، والرغبة والعنف والأحقاد، والوجدانية والجنس، وبرودة العيش على إيقاع العادة. بجمل قصيرة وتعابير حادة، والتماعات تبرق كنيازك سحرية؛ هو ما سيدعوه الكاتب “اللامعنى”، الذي يشكل بالأحرى معنى مضادا لذلك المتداول.
على هذا النحو كتب رشيد الضعيف لطبقات مختلفة من القراء، للمتخصصين في الرواية، والباحثين في شؤون الشرق الأوسط، ومستهلكي سرديات الحرب والجسد والحياة اليومية، وكان لقدرته على تشخيص طبقات اللغة الاجتماعية بعمق ساخر، ونفاذه إلى قرار التعقيد المكتنف لمجتمع الحرب المتوالدة في لبنان والمشرق العربي، واسترساله في تقليب حنايا الذهنية التقليدية، أثرها في بلورة تجربة سردية، بطعم خاص، ونسغ آسر، في مسار التجريب الروائي العربي المعاصر.
هوامش:
[1] – Edgard Weber, L’univers romanesque de Rachid El-daif et la guerre du Liban, ed : L’Harmmattan, Paris, 2001, p 22.
[2] – هرة سيكيردا، دار الساقي، بيروت، ط1، 2014، ص 172.
[3] – تصطفل ميريل ستريب، دار الساقي، بيروت، ط 3، 2013، ص 22.
[4] – أنظر في هذا السياق: -هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1993 ص 21 وما بعدها.
[5] – تبليط البحر، دار رياض الريس، بيروت، ط1، 2011، ص20.
[6] – أنظر عينة من هذه الحوارات ضمن موقع الروائي :
www.rachideldaif.com [7] – عودة الألماني إلى رشده، دار الساقي، بيروت، ط3، 2013، ص 51-52.
[8] – لورنينغ إنغلش، دار الساقي، بيروت، ط5، 2013، ص 18.
[9] – أجرى الحوار سيد محمود حسن، ونشر بجريدة “الأهرام” المصرية يوم 16 اغسطس سنة 2003، وضمّن في موقع رشيد الضعيف www.rachideldaif.com.




