القصيدة والفاجعة
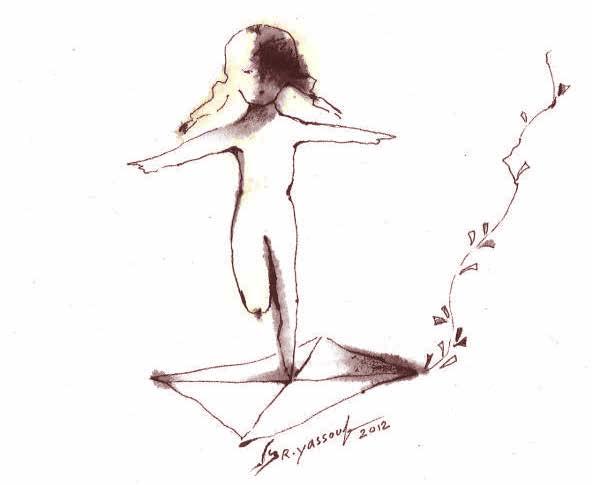
ما الذي يحدث عندما يقيّض للشعراء أن يزوروا الأماكن التي بلغتها مخيلاتهم قبل أن تطرقها أقدامهم؟
كتب فرناندو بيسوا (1888 – 1935) صاحب المخيلة الانشطارية، والشخصيات الشعرية المتعددة قصيدة مسرحها وفضاؤها مدينة لندن. ليس في سجله شيء يشير إلى زيارة لندنية رغم أن عائلته انتقلت إليها من جنوب أفريقيا حيث نشأ وترعرع، قبل أن يترك عائلته ويعود إلى لشبونة ليواصل حياته حيث ولد. ليس في مقدورنا أن نعرف إن كان الشاعر أَسف في وقت ما لكونه شارف على الموت ولم يزر تلك المدينة المتخيلة.
في كل حال ليست التجربة المتخيلة لبيسوا مع لندن وغيرها فريدة. مدونات الشعراء حافلة بمغامرات المخيلة وجموح الخيالات، فكما غامر الشعراء في خلق الكلمات غامروا ويغامرون في خلق الأمكنة والأزمنة.
***
لم تكن رحلتي اليونانية بعد صدور الطبعة الأولى من كتابي “قارب إلى ليسبوس”، رحلة للكتابة، أو لاستكمال الكتابة، ولعلها كانت أشبه ما تكون برحلة لاستكشاف الفضاء الإنساني والجغرافية الواقعية لما غامرت مخيلتي في استدعائه وكتابته شعراً ملحمياً في ديواني “قارب إلى ليسبوس- مرثية بنات نعش”. كنت أشبه بشخص ذهب ليحوم حول مكان ابتكرته مخيلته ليعبر المسافة الفاصلة بين “القصيدة” و”الفاجعة”. وصلت على ظهر سفينة، وعندما اقتربت من شواطئ ليسبوس، بدأت محنتي. محنة تصوراتي وأفكاري بإزاء مشاعري، وعندما وطئت أرض الجزيرة شعرت كمن يطأ جسده ويمشي على ذلك الجسد، هنا رمت المياه على الشواطئ جثامين أطفال وفتيات وشبان لفظتهم الأمواج التي ابتلعتهم في عرض البحر… في المسافة الهائجة بين إزمير وليسبوس.
***
خلال الأيام التي قضّيتها في جزيرة شاعرتي المحبوبة سافو وأهلي المعذبين التقيت بسوريين قانطين، سوريين كل واحد منهم كان يملك قلب أوديسيوس وروح بنلوبي وآلام تيلماخوس، سوريين غدر بهم البحر وتنكرت لهم الجغرافيا.
***
في يوم من أيام إقامتي في ليسبوس، صعدت إلى جبل يطل على البحر، لأفاجأ بقلعة بناها العثمانيون، من هناك رأيت البحر كله أزرق عميقاً، وبدا المنظر فاجعاً من شدة جماله. وبينما كنت نازلا من تلك القلعة وقد اشتدت عليّ حرارة الشمس، لاحت لي سروة ووجدتني ألجأ إلى ظلها. وليتني ما فعلت. كانت تلك شجرة الأمنيات. شجرة أولئك الذين رماهم البحر في ليسبوس، تتدلى من أغصانها قصاصات كتبوا عليها أمنياتهم ووقّعوها بأسمائهم. كانوا من دمشق وحمص وحلب، وإدلب والقامشلي ودير الزور، وبينهم عراقيون كرد وإيزيديون وإيرانيون وأفغان وجدوا أنفسهم في هذه التغريبة السورية، فتاة مخطوبة تفكر بخطيبها وترسل له قلبها مطعوناً بسهم، وامرأة تسأل الله أن يجمعها بزوجها المريض في فرنسا، وأم حائرة كيف تصل إلى أولادها الموزعين على ألمانيا والنمسا والمجر، وأب يفكر بأطفاله الذين عبروا صربيا وضاع أثرهم، وأخت تسأل الله أن تكون أختها الصغرى قد وصلت صحبة المهرب سالمة إلى هولندا أو إلى بلد أوروبي آخر.. و.. و… و… و… مئات القصاصات البلاستيكية والكرتونية والورقية الشاحبة بألوانها الباهتة وقد هرأتها الريح وامتصت أطراف حروفها الشمس.
***
والآن إذ أستعيد تلك الرحلة أتفكر بتلك الشجرة التي التقطت لقصاصاتها صوراً احتفظت بها ربما لأجل أطفال سيولدون على دروب هذه الملحمة الكبرى في أربع جهات الأرض لعلهم يقلبونها بأبصارهم ويتفكرون في الآلام التي عاشها آباؤهم وأمهاتهم ليصلوا بهم إلى أرض لا تطالها الحرائق ولا تطأها أقدام القتلة.
كل من التقيت به من اللاجئين، هناك، على شواطئ ليسبوس كان يفكر بالمستقبل ويسأل عن المستقبل. يريد أن ينجو بنسله، لا بشخصه، بالأطفال أولاً بوصفهم المستقبل.
***
لن أنسى وجه تلك الطفلة، شقراء بعينين خضراوين وقد جلست على رخامة بيضاء تشبه العتبة، وراحت تلهو بشيء في يدها وعيناها تتابع حركة الزوارق في البحر. بدت كأنها تجلس بباب بيت ألفته، ولم تكن تلك العتبة سوى حافة في قاعدة تمثال أقامته المدينة للشاعرة سافو، وكنت اجتزت الشارع لألتقط له صورة.
نهضت من مكانها وراحت تتابع حركتي. بادرتها بالعربية: أنت سورية؟ نعم، من حلب. لم يباغتها سؤالي، لعلها سُئلت مراراً هذا السؤال. قلت أنا أيضاً سوري. صحفي؟ سألت. لا، قلت. أضافت: لماذا تصور الرئيسة؟ أيّ رئيسة؟ هذه، وأشارت بيدها نحو التمثال. قلت هذه ليست رئيسة. كان طبيعياً أن تتخيل التمثال لحاكم، فما من تمثال في البلد الذي جاءت منه إلا تمثال الحاكم.
في هذه الاثناء هرعت أمها نحونا وقد راعها أن يقترب من ابنتها رجل غريب.
هتفت الطفلة: ماما ماما … هو سوري.
***
ما من حكاية من حكايات اللاجئين هنا في ليسبوس تشبه في تفاصيلها الأخرى، ومع ذلك فأصحاب الحكايات يشتركون معا في حكاية واحدة.
***
شخص واحد قصدت بيته في ليسبوس ووقفت بالباب وكان الباب مقفلا ولم يكن الساكن هناك، لأنه غادر العالم.. أوديسيوس إيليتس.
***
في المسافة الفيروزية والزرقاء العميقة بين مكونيس وتينوس وليسبوس ومن ثم في الطريق إلى أثينا، وعلى مرأى من شغب الزبد أمام العين كتبت سطوراً كنت أحسبها بعضا من انطباعات وجذاذات يوميات. في لندن بعد أسابيع، اكتشفت أنها تتمة الكتاب في طبعته الثانية، إحدى عشرة قصيدة قصيرة. وهكذا أقفلت دائرة الكتاب.
قبل أن أدفع بالكتاب إلى الطبع، انتزعت منه قصيدة، واحتفظت بها في أوراقي جريا على عادة اتبعتها كلما أقدمت على نشر كتاب جديد. سلوك لا أجد له تفسيرا محدداً لعلي أحتفظ بتلك القصيدة تميمة تحرس مخيلتي، أو بوصلة ترشدني إلى طريق أخرى في الشعر، عتبة أقفز منها إلى مغامرة أخرى.
القصيدة:
وشاح أُرجواني
بجيوبٍ ملِيئَةٍ بالحَصى
أَعودُ مِنْ هُناك
بالخُضْرَةِ التي وَشَّحَتِ الحِجَارَةَ بالضَّوْءِ،
بالأَسَى،
بحُطامِ صَرَخاتٍ،
وبالصَّمْتِ بعد الأَنْفاسِ مبْهُورَةً وهارِبَةً،
بالزَّبَدِ وقد تَلاشى،
وبالخَدَرِ الذي طافَ على نُعاسِ الماءِ،
وبالغُروبِ
أَعودُ..
بحُزنِ العاصِفَةِ
وبالمَوجَةِ التي أَجْهَشَتْ.
الصَّرَخاتُ التي أَرسَلَها الغَرْقى وصَلَتْ قبلَ مَلابِسِهُمُ.
لكنَّ المَراكِبَ لمْ تَصِلْ.
بمُخَيِّلَةٍ أَدْماها حَجَرٌ قَدِيمٌ في قاسِيونَ
أَعودُ مِنْ تلك الجَزيرَةِ
وبقَلْبٍ حَطَّمَتْهُ مَرْساةٌ ثَقِيلَةٌ.
وبماذا تُريدين أَنْ أَعودَ إليكِ، يا صَغيرَتي
مِنْ هذه الجَزيرةِ التَّائِهَةِ التي يُسَمُّونَها ليسبوس،
بحِلْيَةٍ مُزَيَّفَةٍ
أَمْ بوشاحٍ أَفْلَتَ مِنْ كَتِفِ فتاةٍ طَفَتْ على الماءِ؟
سأَتْرُكُ مَرْكَبِيَ الجريحَ في عُهْدَةِ بَحَّارٍ مِنْ كْرِيْتْ
وأَمْضي مَع الغُروبِ جِهَةَ الغَرْب.
(أثينا في 17آب/أغسطس 2016).
***
سألتني كاتبة تركية عن معنى “الصخرة الملساء” تحت قدم الشخص الذي وطئ الصخرة بعد أهوال البحر في مقطع من قصيدة:
“أمس وصلت،
قدمِي التي وَطِئتْ الأرْضَ
تنَعَّمَت
أخِيراً،
بِصَخْرة ملسَاء”.
تلك صورة في قصيدة ” شخصٌ في غُرفَة”، وهذا الشخص هو الناجي الوحيد من مركب غالبته الأمواج، ولعله الشاعر الذي هبط الجزيرة أخيرا، باحثا عن نفسه التي نجت من عاصفة بحرية ابتلعت سواه من المبحرين من شواطئ تركيا إلى جزر اليونان في مراكب الأوديسة السورية. إنها إعادة تصوير للأمل، الذي ملأ أرواح من لم يغرقوا في بحر إيجه إلا لأن صدورهم كانت تضم قلوبا تخفق بفكرة الأمل. الصخرة الملساء هي لحظة ملامسة الحياة بعد تجربة الموت، والشعور بجمال الحياة مرة أخرى على إثر العودة من الموت.
***
وإذا كانت الحياة بعد الموت اكتشاف مذهل، فإن مثل هذا الاكتشاف يفتح مغامرة القصيدة “في قارب إلى ليسبوس” على تخوم تتكسر معها الحواجز بين الأزمنة والتواريخ والتجارب والهويات ولا يعود مستغربا أو غريبا أن تستدعي القصيدة لوقيانوس السميساطي، وسافو، وشمس، وجلال الدين في فضاء متصل.
وفي ذلك إشارات إلى المشترك الحضاري عبر العصور بين السوريين والأمم القاطنة في الجغرافيات المجاورة لاسيما في العصر الهيلينيستي، ففي سميساط على الفرات الأعلى ولد أحد أكابر الكتاب السوريين الذين كتبوا وأبدعوا باللغة اليونانية هو لوقيانوس السميساطي، الأديب الساخر والفيلسوف الذي طبقت شهرته الآفاق وعمت في سائر أنحاء الجغرافيا الهيلينيستية، صاحب المحاورات الشهيرة المسماة “مسامرات الأموات”، وهو مقيم اليوم في محفل عباقرة العالم وأعماله في خزانة كنوز الإنسانية. وفي ليسبوس، حيث تقوم اليوم مخيمات السوريين الهاربين من الموت هناك ولدت الشاعرة العظيمة سافو التي، مثلها مثل السوريين، عرفت ألم المنفى. أما جلال الدين الرومي الراقد في قونية فهو ينتمي إلى الحضارة العربية – الإسلامية، ودمشق عاصمة أرواح جميع السوريين والقبلة الحضارية لأهل الشرق، لها في “مثنوي معنوي” وغيرها من أعمال الرومي حضور لا يضاهى. إنها بالنسبة إليه مدينة الأبدية. وعندما يتكلم هؤلاء الأيقونيون أو يحضرون في شعري إنما تحضر معهم تلك المعاني والأفكار والقيم والصور والخيالات التي ارتبطت بهم، وارتبطت بدمشق، وبالجغرافيا الحضارية لسوريا التي يحرقها الطغيان اليوم، ويدمّر ليس شعبها وحسب، وإنما جغرافيا مترامية نهض عليها بعض أعظم ما أنجزته الحضارة الإنسانية.
استدعيت لوقيانوس السميساطي ابن مدينة سميساط على الفرات الاعلى ليكون شفيعي لدى الإغريق، وأنا مبحر بين جزرهم، وتائه كما تاه أوديسيوس، وباحث عن الخلاص وقد تركت ورائي مدني السورية محترقة كما ترك إينياس وراءه طروادة المحترقة واتجه نحو الغرب. لوقيانوس هو بمثابة جد لجميع السوريين، وله قيمة كبيرة ومكانة رفيعة عند الإغريق بوصفه أحد كبار أدبائهم في التاريخ.
فهل تقبل لدى أغارقة اليوم شفاعة لقيانوس بالشبان والشابات الهاربين من طروادة العصر؟
القصيدة:
المُسَامَرَةُ الوَاحِدَةُ وَالأَرْبَعُون
أيْنَ أنْتَ يَا لوقْيَانُوس السّميساطِي منْ سميساط
على الفراتِ الأعْلى،
أيْنَ أنْت
هاتِ قُرْطُاسَكَ وَقَلَمَكَ،
وتعال
لِتَتَهَجَّى لهُؤَلاَء الهيلّينيّين المُولَعِينَ بك
اسمي السُّوري.
الشُّهُودُ لم يتعرّفُوا وجْهِي
وقائدُ المئة المقْدُوني فِي المِينَاء
تفحّص عَلَى مَلاَبِسي الأصدَاف والطَّحَالب وهشيم الأشنَات..
القَاضِي الذِي قلّبَ شَفَتَيه في الأَمْر
خرَجَ وتَرَكَنِي
في عُهْدة حُرَّاسٍ لَهُم عُيُونٌ من المَرْمَر.
لوقيانوسُ، أيُّها القانطُ الهازئُ، أوَلَسْتَ المُواطنَ الهيليني
ولكَ فِي أثينَا كلمةٌ لا تُرَدّ؟
تعالَ،
إذنْ
وتشفَّعْ لِي..
ولو لم يقبلْ هؤُلاء الأَغَارِقةُ التيَّاهُون بالمُوبَايلات
على المِينَاء
دَراخْمَاتِي القَدِيمة،
فلتُرسلْ مَعِي، إذنْ، إلى العَالمِ الآخرِ، دليلاً في زَوْرَق،
ولتَكْتُبْ لأجْلِي هذه المُسَامَرة.
(ليسبوس في 3 آب/أغسطس 2016).
عقد كامل مر على مراكب التراجيديا الطرواديين الجدد في بحار العالم، ولا إجابة عن مستقبل سوريا يمكن أن يحملها اليوم أيّ سوري أيّا كان ملجأه اليوم تحت سماء عالم لم يشهد في عصوره الحديثة اضطرابا وضياعا وانهياراً للقيم كالذي يشهده اليوم، هناك الأمنيات والآمال وهي كبيرة، أما التوقّعات والتصورات الواقعية لما يمكن أن يحدث فهي تكاد تكون كلها مظلمة. ما من يقين أبداً يتعلق بالمستقبل السوري في ظل عالم صمت على نحو مرعب عن أكبر جرائم العصر ترويعاً: تمزيق أمة بأكملها هي الأمة السورية، بشراكة لئيمة بين دول وقوى وجماعات دولية وإقليمية وعربية وسورية وجدت حلا لتنافسها الأناني وخاضت الصراع الشائن في ما بينها، بطريقة وحشية، على جسد شعب كتب اسمه بجدارة في أكثر صفحات الحضارة تألقاً، وها هي تكتب فيه مجتمعة هذه الصفحة المظلمة من كتاب التاريخ.
إن نظرة الأمل التي يمكن أن يحملها هؤلاء الطرواديون الجدد أكانوا داخل سوريا أو خارجها نحو مستقبلهم الجماعي، على رغم المصاعب والعذابات والخسائر والتضحيات المهولة التي قدموها حتى الآن، هذه النظرة إنما تنبعث من عدالة قضيتهم، ومن توقهم إلى الحرية وإلى العودة للعب دورهم الحضاري بين الأمم الأخرى كأمة عريقة ومبدعة. وهم إذ يصرّون على الخلاص إنما يصرون أيضاً على وحدة بلادهم التي مزقتها أعمال الدكتاتورية والاحتلالات الأجنبية، وقوى الظلام، وهم يبرهنون مع شمس كل يوم على أنهم عازمون على طي تلك الصفحة القاتمة والكئيبة التي سيقوا إلى هاويتها مكرهين.
لندن 1 أيار/مايو 2021




